نبذة عن حياة الكاتب
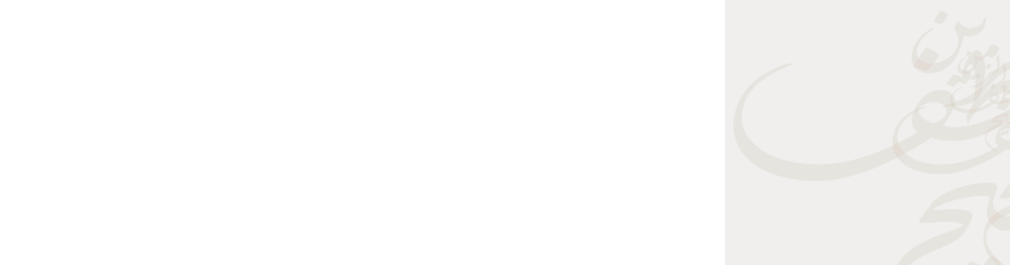
X
عالمية الإسـلام وماديـة العولمـة
الفصل الرابع - الوَسَطِيَّة أو الحلول الوسط
المساواة.. بين ملابسـاتها وواقعهـا
دعاة المسـاواة بين المرأة والرجل في عصرنا الحاضر
قضية المساواة في مفهومها الغربي مغايرة للواقع
الرجل والمرأة.. أيـن يلتقيان وأيـن يفترقان
الوسطية (أو: الحلول الوسط)
الوسطية هي من المصطلحات التي وفدت إلينا من الغرب، والتي لم يَسْبق أن عُرِفَتْ كمفهوم عند المسلمين. وقد تَحَدَّرَتْ من المبدأ الرأسماليّ الذي بني في الأساس على الحلّ الوسط، وهو الحل الذي اخْتِيرَ بعد الصراع الدمويّ الذي حصل بين الملوك وساندهم فيه رجال الإكليروس الذين كانوا يعتبرون النصرانية ديانة كفيلة بمعالجة شؤون الحياة جميعاً، وبين الفلاسفة والمفكرين الذين رفضوا وجهة النظر هذه وردوا أسباب الذل والتخلف إلى اعتماد الديانة النصرانية مَرْجعاً لتنظيم شؤون الحياة، ورأَوْا أن العقل وحده هو الذي يعوَّل عليه لوضع نظام صالح، وهو القادر على دفع الحياة باتجاه التطور.
وكان احتدام الصراع بين الفريقين طويلاً ومريراً، إلى أن تَمَّ الوصول إلى ما سُمِّيَ بالحل الوسط، ولكنه في الحقيقة انتصار لوجهة نظر الفلاسفة والمفكرين، إذ أدى إلى الأخذ بفكرة فصل الدين عن الحياة، فأصبحت هذه الفكرة عقيدةً لمبدإ يُطَبَّق عملياً في المجتمع، ويجري تنظيم شؤونه على أساسه، مقابل الاعتراف بالدين كعلاقة بين الإنسان (الفرد) والخالق. وبهذا يكون الفلاسفة والمفكرون قد نجحوا في إقصاء الدين عن التدخل في شؤون الحياة، وترك الأمر للناس لتنظيم أوضاعهم وأحوالهم بعيداً عن سلطة الكنيسة والملوك.
وكان من الطبيعيّ أن يأخذ هذا الحل الوسط، الذي تطور إلى عقيدة، طريقه إلى التطبيق على المستويين التشريعيّ والسلوكيّ عند أصحاب المبدإ الرأسماليّ، وعلى مجمل القضايا الأخرى، ولا سيما القضايا السياسية.
ويُرَى بشكل واضح كيف تَعْمَدُ الدول الغربية التي تقول بالحل الوسط إلى ممارسة طريقتها على ضوء هذا المبدإ في كل المسائل والمشكلات الدولية، مثل قضية فلسطين، إذ في العام 1947م طرحت الدول الغربية الرأسمالية مشروع تقسيم فلسطين إلى كيانين، أحدهما للعرب، وآخر للصهاينة اليهود، مع أن فلسطين هي في الأساس من بلاد المسلمين، وغالبية سكانها مسلمون فلسطينيون، وهم أصحاب الأرض. ولكنَّ الدول الغربية باتجاهاتها المغرضة فرضت حالة سياسية تتوافق مع نظرتها إلى العالم الإسلاميّ، وبهَوَسِها المبدئيّ بإيجاد حلول وسط، ضَربت بحق أصحاب البلاد الشرعيين عُرْضَ الحائط، فَسَلَبَتْ ممَّن له كل الحق لتعطي مَن ليس له حق، وفرضت حلاً لإنهاء ما سُمّي بمشكلة فلسطين، هي في الأساس من تدبيرهم. وما ينطبق على فلسطين في هذا السياق، ينطبق على كثير من القضايا الدولية، ولا سيّما تلك التي يكون للمسلمين وجود فيها، مثل قضية كشمير، وقبرص، والبوسنة وغيرها، إذ يعمد الغربيون إلى جعلها مشكلات، ليبرروا تدخلهم وفرض حلولهم المسمّاة بالحلول الوسط.
ومن هنا نجد أن منهجية الغرب في إيجاد حلول للمشاكل الدولية تنطلق من معيارين: المصلحة وما تجلبه من منافع سياسية واقتصادية، ووسطية الحلول وما ينتج عنها من ظلم لفريق لصالح فريق آخر. ومن هنا نكتشف أيضاً ضحالة العدالة في المبدإ السياسيّ لدى الغربيين، حين يضعون الحق في كفةٍ مُساوِيةٍ للباطل، فيجعلون مغتصِبَ الشيء والمستوليَ عليه بالقوة هو وصاحبه الأصيل سواءً بِسَواءٍ، فينبرون لطرح فكرة الحل الوسط لإنهاء أيّ مشكلة. وهذا يقودنا إلى اعتبار تلك المنهجية في إيجاد الحلول منهجية استنسابيّة، وهي من حيث الممارسة خطة قائمة على المُراوغَة لتطويع الفريق الأضعف في طَرَفَي المشكلة ومساومته لكي يتخلى عن قسم من حقوقه. وهذا يتناقض تناقضاً تاماً مع وجهة نظر الإسلام.
غير أن تيار الوسطية هذا تسلل إلى أذهان البعض من المسلمين، فقبلوا مفهومه، وأرادوا أن يثبتوا موافقة الإسلام عليه، ظناً منهم أنهم يقدمون برهاناً جديداً على مرونة هذا الدين وقدرته على احتواء مستجدات الحياة ومتغيراتها، فأخذوا بتفسير بعض الآيات الكريمة من كتاب الله لإثبات وجهة نظرهم وما ذهبوا إليه، وقالوا: إن فكرة الوسطية أو الحل الوسط فكرة موجودة في الإسلام، بل إنه قائم عليها، فالإسلام وسط بين الروحية والمادية، وبين الفردية والجماعية، وبين الواقعية والمثالية، وبين الثبات والتغير، وهو كما لا يجنح إلى غُلُوّ لا يجنح إلى تقصير، فلا إفراط فيه ولا تفريط. وردَّدوا القول: «إن خيرَ الأمور الوسط» حتى أصبح مثلاً يقاس عليه عندهم.
واندفعوا في هذا الاتجاه فعرضوا الأشياء في تَكَلُّف، بغيةَ تأييد فكرة الوسطية وإقامة البراهين على صحتها، فقالوا: إن لكل شيء طرفين ووسطاً، والوسط هو منطقة الأمان، أما الأطراف فمعرضة للخطر والفساد، وإن الوسط مركز القوة، وإنه منطقة التعادل والتوازن لكل قطبين، وإنه ما دام للوسط (والوَسَطِيّة) كلُّ هذه المزايا فلا عَجَبَ أن تتجلَّى الوسَطيّة في كل جوانب الإسلام، فالإسلام وَسَطٌ في الاعتقاد، ووسَط في التشريع والأخلاق.
ثم أوْغَلُوا أكثر فاعتمدوا القياس العقليّ، إذ قاسُوا أحكامَ الإسلام على واقِع الإشياء، فأخضعوا بعض النصوص الشرعية للبحث وأسقطوا فهمهم الجديد عليها، وهو ما لا يتفق بحال مع منهج الإسلام. وبدلاً من أن يجعلوا الواقع موضع البحث وإسقاط النصوص عليه، عكسوا المنهج فأسقطوا فهمهم الجديد للواقع على النصوص، وذلك بغية تبرير دعوتهم إلى فكرة الوسطية وتبنّيهم لها، فقالوا في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}(+) وقالوا: إن وسَطِيَّة الأمة إنما هي مُسْتَمَدَّة من وسطية منهجها ونظامها، فليس فيها غلو اليهود، ولا تَسَاهُلُ النصارى. وقالوا: إن كلمة (وسط) تعني العدل ـ وإن العدل، على حد زَعْمهم ـ توسط بين طرفين متنازعين، فجعلوا العدل بمعنى الصلح، ليخدموا فكرة الوسطية. ذلك كله نوع من التبنّي المصطنع لاصطلاح غريب عن الإسلام، وقولبته في قالبٍ ظاهره إسلاميّ، بينما باطنه طمس مفاهيم الإسلام.. ولذلك فإن المعنى الصحيح للآية هو أن الأمة الإسلامية أمةُ عَدْل، والعدالة من شروط الشاهد في الإسلام، وهذه الأمة ستكون شاهدَ عدلٍ على الأمم الأخرى على أنها بلَّغتْهم الإسلام. والآية وإن جاءت بصيغة الإخبار، فهي طلب من الله للأمة الإسلامية أن تبلِّغ الإسلام لغيرها من الأمم، وإن لم تفعلّ أَثِمَتْ، فهي أُمَّةٌ حجة على الأمم الأخرى، كما أن الرسول (ص) حجةٌ عليها {لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ} في تبليغه الإسلام لكم، وطلبه منكم أن تبلغوا غيركم «أَلا فليبلّغ الشاهِدُ الغائب» كما قال رسول الهدى والحق في حجة الوداع.
كذلك استدلّوا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا *} فجعلوا للإنفاق طرَفين: الإسراف والتقتير، وجعلوا له وسَطاً وهو القوام. وهذا في رأيهم دليل على الوسطية في الإنفاق، وتناسَوْا أن معنى الآية أن هناك ثلاثة أنواع من الإنفاق: الإسراف، والتقتير، والقَوام. فالإسراف هو الإنفاق في الحرام، قَلَّ ذلك أو كثُر، سواء أنفق شخص درهماً في شراء الخمر أو في لعب القمار أو في الرشوة فإنه إسراف، لأنه من الحرام الذي يتعدى به حدود الله. قال تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *}، وقال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}. وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ *} وأما التقتير فيكون على من تجب نفقته من الأهل، أو امتنع عن الزكاة. والقوام هو الإنفاق حسب أحكام الشرع كثيراً كان أم قليلاً لأن الله تعالى قال: {بَيْنَ ذَلِكَ}. وأين الوسطية الإسلامية والحل الوسط في قول رسول الله (ص) لعمه أبي طالب، عندما عرض عليه قومُه المنصِب والمال والشرف لينكر الإسلام مقابل ذلك: «والله يا عم، لو وضعوا الشمسَ في يميني، والقمرَ في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركْتُه»، وفي قوله لقبيلة بني عامر بن صعصعة، عندما طلبوا منه أن يكون لهم الحكم من بعده مقابل أن ينصروه: «الأمر لله، يضعه حيث يشاء».
إذن، فكيف يمكن القول بأن الوسَطيّة بمفهومها الملتوي هي من الإسلام؟ بل إن القول الفَصْلَ فيها إنها فكرة غريبة عن هذا الدين الذي لا يعرف الحلول الوسط في القضايا المحقة، وليس في منهجه منطقة وسطى يمتزج فيها ما هو حق وما هو ليس بحق، كما يريد الغربيون، والمتغرّبون الذين ما فتئوا يعملون على أن يُلصقوا بالإسلام ما ليس منه، بغَرَض تمرير مفاهيم دخيلة، من طريق الإيهام بأن لها أساساً في النصوص، والنصوص منها براء. وهم يفعلون ما يفعلون تارةً باسم الاعتدال والموافقة والتسامح، وطوراً باسم مماشاة العصر واستيعاب مُسْتَجَدّاتِه. ووراء ذلك قَصْدٌ واضح، هو إلحاقنا بثقافة العَصْر، بصدّنا عن التمسّك بالثوابت الإسلامية وبحدود الإسلام وأحكامه الفاصلة، وهي لا تقبل الزيغ والتحريف.
المسـاواة بين ملابساتها وواقعها
إن مسألة المساواة وجعلها في المُطْلَق، كتعبير عن العدل، من المسائل التي تشغل حيّزاً هامّاً في التكوُّن الفكريّ، وتنبىء عن اقتناع بأن جميع الناس مُتَسَاوُونَ كحالَةٍ إنسانيةٍ عامّةٍ تحمل صفة الثبات وغير محكومة بالتغيُّر، سواءٌ أكان ذلك في المجتمعات التي تتلمَّس طريقها نحو النهوض، أم تلك التي بلغت مستوياتٍ متقدمةً في صعودها المادّي. ويجهد مَن يناقشونها من مفكّرينا الإسلاميين وغير الإسلاميين، كلٌّ من وجهة نظره، في التدليل على صحة مفهومه لها وتعبيره عنها.
وهي، في الحقيقة، تندرج في سلسلةٍ من الملابسات التي تحتاج إلى بيانٍ من منظور إسلاميّ يحلّل جوانبها وأبعادها في عمق، آخذاً بالاعتبار ما تغشّاها من فهمٍ مُغَايِرٍ لواقعها، وما تراكم عليها من تفسيراتٍ ليست من نسيجها. وهي من المسائل التي تنبني عليها أفكارٌ تتعلق بالسلوك العام على مستوى الجماعات بإفرازاتها السياسية والاقتصادية وتطلعاتها إلى بناء المستقبل، وبسلوك الفرد في تعاطيه مع شؤون الحياة على أساس فهم حقيقتها فهماً يمكّنه من تصويب مسيرته وبما يجعله حقيقاً بِحَمْلِ فكرٍ صحيح.
لأجل هذا، وبهَدَفِ الوصول إلى نقطةٍ تلتقي فيها نتائج الجدَل الفكريّ في هذه المسألة، بما يتيح إيجاد شواهدَ على وجهات النظر المختلفة، ينبغي أن يبادرَ الذهنُ إلى إلغاء التفسيرات المسبَقَة وعدم اعتبارها من المسلَّمات، والخروجِ من نَفَق الذاكرة المُلَقَّنة التي ملأها التكرارُ الإعلاميُّ بمقولات المروّجين الذين أَتْقَنُوا لغةَ إعطاء المسائل صفةَ المطلق.
من الحقائق الثابتة، أن الناس خُلِقُوا على تَفاوُتٍ واختلافٍ في القدرات والطاقات، وفي الصِّفاتِ الجِبِلِّيَّة؛ فثمَّةَ مَن هم أقوياء البُنْيَة قادرون على حَمْلَ أَثْقَل الأحْمال، غير أنهم في جانبٍ آخرَ قد يكونونَ ضعفاءَ في تحمّل المهامّ لا يَقْدِرون على إنفاذِ أمرٍ ذي شأن. وقد يَتَيَسَّرُ لأحدهم أو بعضهم الجَمْعُ بين قوة البُنْية والقدرة على حَمْل المسؤولية ولكنْ يحتاج إلى مَنْ يُخطِّط له أو يُرْشده إلى اتخاذ المبادرات والقرارت. وهناك مِن يَتَمتّع بذكاءٍ خارقٍ فَتَتَفَتَّق فيه مَلَكَةُ الابتكار والتخيُّل فيخترع من الأشياء ما يُصْلح أحوال الناس ويطوّر وسائلَ العيش، وآخَرونَ تَقْصُرُ قدراتهم عن ذلك، ولكنهم مُجدُّونَ نَشِطون مُتْقِنونَ أعمالاً تُسْنَدُ إليهم.
هكذا خُلِقَ الناس، وهم على هذا التفاوُت يتحرَّكون في الحياة، كلٌّ بما وهَبَهُ الله تعالى من قُدْرة، وبما تكوَّنَ فيه من نَزْعَة. وهو نَسَقٌ مَعيشيّ تفرضه حتميَّةُ احتياج الواحد إلى الآخر من ناحية، وما ينتج عن عمل الفرد بناءً على ما يعتقده أو يتبنّاه من أفكارٍ من ناحيةٍ أخرى.
وبملاحظةٍ لا يُعْوِزها كثيرُ نَبَاهَة، نجد أن تفاوُتَ الناس واختلافَهم فيما وُهِب لهم من قدراتٍ وطاقاتٍ وصفاتٍ إنما هو نظامٌ ضروريّ للتكامل المعيشيّ بين البشر جميعاً، وأن أعمالهم إنما تخضع لقانون الثواب والعقاب، إنْ خيراً فخير أو شراً فشرّ.
ولقد لَفَتَ القرآنُ العظيمُ الذهنَ إلى هذا النظام المعيشيّ، فقال تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا}.
لذلك فإن البَدَاهَة أن يكون التفاوتُ والاختلافُ بين الناس في القدرات والطاقات والمَلَكات مَدْعاةً إلى تفاوُتٍ واختلافٍ في قسمة المعايش فيما بينهم، وأن تتراجع مسألةُ المساواة عندما يتعلق الأمر بالحكم على الأعمال التي يقومون بها ويؤدونها.
ولكن، هل يُعْتَبَر وَهْبُ القدرة أو الطاقة أو الصفَة الأعلى تفضيلاً لمخلوقٍ على مخلوق، أم أنه تَفَضُّلٌ من البارىء سبحانَه على خلقه، واختبار في الوقت نفسه لهم، بأنْ جَعَلَ التزاحُمَ على التعاون بينهم سِمَةً من سِمَاتِ الرقيّ لصلاح الحياة، ودفعهم إلى التلاقي والتنافس البنّاء، فكان هذا النظامُ العادلُ الذي يُكَافَأُ فيه العمل الأرقى أكثرَ من الأدنى، ويكون الأداءُ في ناحيةٍ مكمِّلاً لأداءٍ في ناحيةٍ أخرى، وحيث يُسَخَّر الأفرادُ لخدمة بعضهم بعضاً لتتمَّ عمارة الحياة بين البشر.
وربّ معترضٍ يعترض: وما هو الهدفُ من عدم المساواة هذا بين الناس؟
والجواب: إن الله سبحانه أعطى الناسَ جميعاً من القدرات ما يمكنهم من السعي في الحياة لاكتساب الرزق وجلب المنافع لأنفسهم، مفسحاً لهم مجال الترقي والتقدم فيها دونما قيد، ولم يَحْجُرْ عليهم ولوجَ الطرقِ الموصلةِ إلى تنمية قدراتهم وتفعيل ما أوْدَعَه فيهم من طاقات. فعلى الناس اكتشافُ ما وهبهم الله من ملكات، وما مكَّنهم به من قدرات، للسعي إلى إنفاذ مهمَّاتهم في الحياة. لقول الله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}. فالناسُ، إذن، من ناحيةِ وَهْبِ القدرات والطاقات والمَلَكات غيرُ متساوين، وتفاوتُهم واختلافُهم يعودان إلى مَدَى استخدامهم لما وُهبوا بإخراج ما رُكِّبَ فيهم إلى حيّز العمل، وعلى ذلك يكون التقدمُ والتنافسُ في هذه الدنيا.
مثالٌ على ذلك:
لو افترضْنا أن طبيبين ظروفهما مُتشابهة، تخرَّجَا من كلية واحدة، وحَصَلا على درجةٍ واحدة، وافتتح كلٌّ منهما عيادة، فاكتفى أحدهما بعد تَخَرُّجه بما حَصل عليه من العلم والخبرة ولم يتابع ما يظهرُ من أبحاث في عالم الطب، وانكبّ الآخر، على الاطّلاع والتزوُّد بالجديد في مهنته فإن من الطبيعيّ أن يؤديَ اطّلاعُ الآخر ومعرفتُه إلى تنمية قدرته، ومن ثَمَّ إلى تحسين أدائه، مما ينعكس إيجاباً على مستواه، وبذلك يكون أحدهما أقدرَ من الآخر.
المساواةُ بمفهومها الغربيّ مُغَايرَةٌ للواقع:
إن رسوخَ مفهوم المساواة في كثير من الأذهان بمعنى العدل وإعطاء الحقوق مفهومٌ خاطىءٌ مُغَايِرٌ للواقع، ويحتاج إلى تَصْويب، وهو غير صحيح في المنظور الإسلاميّ وعلى أرض الواقع، عَدَا كونه من الأفكار الوافِدَة من خارج الدائرة الإسلامية. فالمساواةُ بمفهومها الغربيّ لا وجودَ لها في الإسلام، لا بالاسم ولا بالمُسَمَّى. أما المطالبةُ بالحقوق وإعطاءُ كلّ ذي حق حقَّه فلا يُسَمَّى مساواة، وإنما يُسَمَّى عَدْلاً، والفَرْقُ كَبير بين الكلمتين. وأما قول الرسول (ص) : «المسلمون تتكافَأُ دماؤهم»(+) فالمقصود بالتكافؤ القصاص والدِّيَات وفق الشريعة الإسلامية، وقد فرض الإسلامُ التكافؤ بين المسلمين في الحقوق والواجبات.
وأما مَن قال من المسلمين بالمساواة بين الناس في المطلَق مستشهداً بقوله (ص) : «الناسُ مُسْتَوونَ كأسنان المشط لا فضلَ لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوى»(+) فقد قصَّروا في إدراك المعنى المقصود، ونَحَوْا مَنْحَى التوفيق بين الإسلام والأفكار الحديثة (الوافِدَة) من غير تبصُّرٍ فيما يحمله مَنْحَاهم من أخطار على صحة المفاهيم، ولو ردُّوا ذلك إلى الله ورسوله لَمَا وَقعوا في لُجَّةِ تفسير الأشياء على غير وجهها الصحيح، ولَتَبَيَّنَ لهم أن المقصودَ هو نظرةُ الإسلام إلى الناس عند الحكم على أعمالهم التي لا تفرِّق بين أحد منهم، فالناس مُتَسَاوُونَ فقط في تطبيق الأحكام عليهم وفي تكليفهم بالأحكام الشرعية لقول رسول الله (ص) : «وأنَّ الناسَ في المسجدِ الحرامِ سواء»(+)، وهو ما تؤكده الآيةُ الكريمة: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، فيكون الفضلُ والتكريمُ لمن اتّقى، إذ إنّ التقوى مقياسٌ جامعٌ لمعنى العمل الصالح.
وتأكيداً لصحة مفهومنا حول هذه المسألة ونَفْيِ ما أُلصِقَ بها، عن جهلٍ بواقعها، نتيجةَ الغَزْو الثقافيّ الغربيّ الذي ابتليَتْ به أمتنا، فتفكّك كثير من المسائل، ورُكّبَت عليها معانٍ مغلوط فيها، مّا أنتج ارتباكاً وقلقاً وتعقيداً في آنٍ معاً، نرى أنْ لا مَنْجَاةَ من ذلك الغزوِ إلا بتأصيل(+) المفاهيم بالرجوع إلى فهم النصوص من كتاب الله تعالى والسنَّة المطهَّرة فهمَ الواعي الملتزم، والمتفقّهِ الحصيف، المتيقِّظِ لما يحاول بعضهم إدخاله على مفاهيمنا، فيرصدُه ويتعمَّق في معناه، مستنيراً بقول الله تعالى في قرآنه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبِهَدْي الرسول الكريم (ص) الذي لا ينطق عن الهوَى(+).
فآياتُ الله الحكيم في كتابه المجيد وأحاديثُ رسوله الكريم، خيرُ شاهدٍ على بطلان دَعْوَى القائلين بالمساواة بين الناس في المطلَق، وبيانٌ واضحٌ على أن مقصودَها غيرُ مقصودهم، وتفسيراتِها غيرُ تفسيراتهم.
يقول عَزَّ من قائل: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ *} {قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *} {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} {مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً}.
أفبعد هذه الآيات البيّنات الدالة على أن المساواةَ بمعناها الغربيّ مفهومٌ خاطىء، وأنها ليست من الإسلام في شيء؟
نخلص من هذا إلى أن الإسلام أقرّ العدل وطالب به وحث على تنفيذه، ولم يطالب بالمساواة، ولذا لا نجد لفظةَ المساواة واردةً في أية آية في القرآن الكريم، بينما نجد الآياتِ الكثيرةَ التي تتحدث عن العدل. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، والعدل هو في المكافأة، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والإحسان أن يقابل الخيرُ بأكثرَ منه، والشرُّ بأقلَّ منه. ونجد هذا المعنى في دعاءٍ لعليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: «اللهمّ احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك»(+).
دُعاةُ المساواة بين المرأة والرجل في عصرنا الحاضر:
هنا يبرز السؤال عن قضيةِ ما يُسَمُّونه المساواة بين المرأة والرجل.. وهي القضية التي يُراد بها إلغاءُ ما جاء به الإسلامُ من تشريعٍ في ما هو خاصّ بالرجل وما هو خاصّ بالمرأة.
قضية المساواة بين الرجل والمرأة:
لا جدال في أن هذه القضية بمفهومها الغربيّ الجامح، أو المحافظ، قد آتت أكلها لدى كثير من المسلمين والمسلمات، إنْ من ناحية جعلها قضيةً تقتضي عملاً نضالياً في مجتمعاتٍ رافضةٍ لمضمونها مبنًى ومعنًى، أو من ناحية تأثيرها في السلوك العام والخاص، إذ يُرَى على المستوى العام أن كثيراً من الحكومات في العالم الإسلاميّ أقرّ المساواةَ بين المرأة والرجل باعتبارها قضيةً نهضويةً، إضافة إلى وضعها في قائمة الأولويات الحقوقية للمرأة، وذلك تحت ذريعة ردِّ الاعتبار إليها وتصحيح مسيرةٍ اجتماعيةٍ انعدمت خلالها إمكانيةُ إنصاف المرأة. أما على المستوى الفرديّ فإننا نرى رأي العين تدنِّي الوعي في عصرنا الحاضر عند النساء والرجال، وما نضح عنه من ابتزاز لجمالية الجَسَد، بتحويله إلى سلعةٍ أو ضَرْبٍ من ضروب التّسَرِّي والإمتاع. وأدلّةُ ذلك واضحة لا تحتاج إلى تقديم. ومثالها واضح في عارضات الأزياء، والإعلانات والأفلام الفاضحة، وفي ترك المرأة تعاشر مَن تشاء دون رابطٍ شرعيّ أو قانونيّ. وحتى أصبحنا نرى النساءَ المسلمات على صورة النساء الأوروبيات في أزيائهن، ولا يجدن حرجاً في ارتداء لباس البحر الذي يُظهرهنّ شبه عاريات أمام الرجال.
غير أن الإشادة بالمرأة المنجزة للعمل الجاد والمفيد، بعيداً عن هذا الإسفاف والتدني، شاهد مُنصف على ما للمرأة من حضور خارجَ دائرة مهمتها الأساسية التي هي رعايةُ شؤون البيت في حدود ما كُلّفت به شرعاً إن في المجال العام أو الخاص.
إن بعض المسلمين المتأثرين بالحضارة الغربية العاملين على تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، تحت مظلة الحقوق، يظلمون المرأة ويظلمون أنفسهم من حيث لا يعلمون.. وبالتالي، فهم على توهّمٍ بإنصافها عندما يريدونها أن تقومَ بدور الرجل إضافة إلى دورها الطبيعيّ الذي لا يمكن أن يقوم به الرجل. وليس ثمة مَنْ يَعْزُف عن الإقرار بأن لكل من الرجل والمرأة خصوصيةً نوعيةً غيرَ قابلةٍ للتماثل، وأن كلًّا منهما ينفرد بطبيعةٍ بدنيةٍ وبطاقاتٍ حيويّة متباينةٍ في الغرائز والحاجات العضوية، وفي ما ينشأ عنها من مظاهر، من المحالِ التحلّلُ منها أو التخلّي عن نتاجها الذي يتمثل في الحمل وعدمه، والإرضاع واللاإرضاع، وما شابه ذلك من تفردٍ في كل من الأنوثة والذكورة.
هذه أولى القواعد الطبيعية في اللامساواة بين الرجل والمرأة، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا تبديلَ لخلق الله.
وعلى الرغم من ذلك فإن القائلين بهذه المساواة يستثنون هذه القاعدةَ في الحوار ويعتبرون تباين النوعين غير جوهريّ، وينتقلون في النقاش إلى مجالٍ آخرَ ليس محلَّ خلاف، وهو المتعلق بالصفات البشرية المشتركة بين الرجل والمرأة، بغية تغليب مبدأ المساواة بينهما بمعناه المطلق، من حيث كونهما مخلوقين متماثلين عقلاً وقلباً وروحاً وحركةَ حياة.
لهؤلاء نقول: نعم، إن الناس جميعاً من ذكر وأنثى متساوون في خَلقهم، ولكنهم بتفرُّعهم إلى نوعين تنعدم هذه المساواة، ولذا سُمِّيَ كلُّ نوع بمسمّاه، واختلافُ التسمية لا يكون إلا نتيجةَ خصوصيةٍ في المسمَّى، فالذكورةُ لها مسمّاها لخصوصيتها، والأنوثةُ لها مسمّاها لخصوصيتها، إذن، لكل نوع مَهمَّةٌ خاصةٌ في حركته مع الحياة.
أما القولُ الفصلُ والجادُّ في هذه المسألة، فيكون من خلال ما ورد في كتاب الله الكريم وعلى لسان نبيّه الصادق الأمين (ص) ، وهما المصدران اللذان يلوذُ بهما المسلمُ الحقّ وأصحابُ العقول عند التباس الأمور واختلاف المذاهب.
لقد قال الله تعالى على لسان امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي}(+)، {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى}، لأن الأنثى لا تصلح لما يصلح له الذكر لخدمة بيت المقدس، بسبب ما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس.
وعندما أتى الله سبحانه وتعالى على ذكر الرجل والمرأة في موضوع تعدّد الزوجات قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، ولم يقل فإن خفتم ألا تتساوَوْا، فذكر العدل ولم يذكر المساواة. وقال: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} هذا إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة، فإنه لا يستطيع أن يعدل بالمحبة والرغبة والميل.
ثم إن مسألة عدم المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية الشرعية تتوضح في أجلى صورها في إباحة أن يتزوج الرجلُ بأكثرَ من امرأةٍ واحدة، وكذلك من الناحية الواقعية التي تنبىء عن التفاوت بينهما في القدرات، ولا سيما في الميل الجنسيّ، وهو ما يلاحَظ بوجه عام. وكذلك فإن عدمَ المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات كثيرة من الحياة ظاهرٌ في أحاديثِ المصطفى (ص) حيث يقول: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»(+)، «يا عليّ ليس على امرأةٍ جمعة.. ولا تتولَّى القضاء»(+).
وفي نهيه عن أن تتشبَّه الذكورةُ بالأنوثة أو العكس يقول (ص): «لعن الله المتشبهاتِ من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء»(+) ويقول: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء»(+).
فإذا كان مجردُ تشبُّهِ أيٍّ من النوعين بالآخر ملعوناً من الله وعلى لسان رسوله، فكيف تكون درجةُ اللعن منه سبحانه وتعالى عندما يريد البعض إلغاءَ التفاوت وعدمَ الإقرار بسُنَّة الله في خلقه، إذ يصرّون، عناداً منهم، على جعل المساواة بين النوعين في المطلق منهجاً فوق منهج الله الذي جاء رحمة للعالمين. قال الرسول (ص) عن نفسه: «إنما أنا رحمةٌ مهداة»(+) ويقصد بقوله هذا الرسالة المنهج التي جاء بها للبشرية جمعاء. والرحمةُ بمعناها الكامل تعني أن الله سبحانه رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد (ص) لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، وعلمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى.
الرجلُ والمرأةُ.. أيْنَ يلتقيانِ وأَيْنَ يَفْتَرِقَانِ:
إن الخطابَ الإسلاميَّ، في نصوصه القرآنيَّةِ، لم يُفَرِّقْ بين الرجلِ والمرأةِ من حَيْث مَخْلوقِيَّتهما، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}، فخاطبَ سُبحانَهُ الإنسانَ بِنَوْعَيْه، وجعله موضِعَ الخِطابِ والتكليفِ. وقد أنزل الشرائعَ على هذا الأساس، فالمرأةُ إنسانٌ والرجلُ إنسانٌ، ولا يختلفُ أو يمتازُ أحَدُهُما عن الآخَرِ في الإنسانيةِ. وقد هَيَّأهُما سبحانه وتعالى لِخَوْضِ مُعْتَرَك الحياة، وجعلَهما يعيشانِ في مجتمعٍ واحد، وجعل بقاءَ النوعِ متوقّفاً على اجتماعهما وعلى وجودهما في كل مجتمع، وقد خَلق الله في كلٍّ منهما طاقةً حيويّةً هي الطاقة الحيويَّة نفسها التي خلقها في الآخَرِ: فجعلَ في كلٍّ منهما الحاجاتِ العضويةَ كالجوعِ والعطَشِ وقضاءِ الحاجةِ، وجعل في كلٍّ منهما غريزةَ البقاءِ، وغريزةَ النوعِ، وغريزةَ التدينِ، وجعل في كل منهما قوةَ التفكيرِ الموجودةَ في الآخر. فالعقلُ الموجودُ عند الرجل هو العقل نفسُه الموجودِ عند المرأة، إذ خلقه الله عقلاً للإنسان وليس عقلاً للرجل أو للمرأة. إلا أن غريزةَ النوعِ، وإن كان يُشْبِعُها الذكرُ من ذكرٍ أو حيوانٍ، أو غير ذلك، لكنها لا يمكنُ أن تؤديَ الغاية التي من أَجلها خُلِقَتْ في الإنسان إلا في حالةٍ واحدةٍ، وهي أن يُشْبِعها الذكرُ من الأنثى، وأن تُشْبِعَها الأنثى من الذكر. ولذلك كانت صِلَةُ الرجل بالمرأة وصلةُ المرأةِ بالرجل من الناحية الجنسية الغريزية صلةً طبيعيةً لا غرابةَ فيها، بل هي الصلةُ الأصليةُ التي بها يتحقَّق الغرضُ الذي من أجله وُجِدَتْ هذه الغريزة وهو بَقَاءُ النوع، ويتضح ذلك من الآيةِ الكريمة: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}.
هذا فيما يخصُّ الإنسانَ عامةً، ذكراً كان أم أنثى، ولذلك يُرَى أنه حيثما وَرَدَ في القرآن الكريم: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} أو {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} يكون الخطابُ للرجل والمرأةِ على حدٍّ سواءٍ، من ناحية كونهما مخلوقَيْنِ إنسانيين، دون تفريقٍ أو تمايُزٍ بينهما. ولكن يُرَى أيضاً أنه عندما يتعلَّقُ الأمرُ بالنوعيةِ المخلوقيةِ فإن الخطابَ يَنْحو إلى التخصيص، مثل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ}، كذلك يُرى أنه سبحانه قد خصَّ كلاًّ من الذكَر وَالأنثى بما لم يخصَّ به الآخَرَ، مثل قوله تعالى: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى *إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى *}، وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}. ومن حيث الثوابُ والعقابُ نجد الخطابَ واحداً لكل منهما، قال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ً ïوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ}. فنظرةُ الإسلامِ إذن إلى كلٍّ من الرجل والمرأةِ تُسَاوي بينهما من حَيثُ الإنسان كجنس في تميزه عن جميع المخلوقات الأخرى، ولكنها تَخُصُّ كلاًّ منهما بأمورٍ من حيثُ الذكورة والأنوثة.
ومن ذلك شَرَعَ الإسلام أن تكون القَوَامَةُ للرجل وليسَ للمرأةِ، وقد بَيَّنَت الآية الكريمةُ ذلك: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.
غير أنه يخطىء مَن يفسّر أن هذه القَوامَة قَوامة حكم وسلطان، ويضعها موضع التحكُّم بالمرأة وإرغامها على أن تطيع الرجل طاعةً عمياء، أو أن تقوم بما يتعارض وحقوقها الشرعية، زوجةً كانت أو أمّاً أو أختاً أو ابنةً. وقد قال الرسول (ص) في حجة الوداع: «فاتَّقوا الله في النساء، واستوصوا بهنَّ خيراً...». وما دام الرجل مكلفاً من الناحية الشرعية بالإنفاق على المرأة فمن الطبيعيّ أن تُسْنَدَ إليه أيضاً من الناحية الشرعية مهمّة الرعاية، وذلك باعتباره الأقدر على تحمُّل أعباء الحياة، ولأنه مهيءٌ لتحمّلِ مسؤولية الرعاية وما يترتب عليها من تَبِعَات.
ثم إنّ رعاية الرجل لزوجه ينبغي أن تكون على أساس عِشْرَتِه معها عِشْرَةَ صُحْبَة. وقد وصفها الله بذلك فقال «صاحبته» يعني زوجته. وقد كان رسول الله (ص) في بيته صاحباً لزوجاته ولَيْس أميراً عليهن، وكنَّ يراجعنَه ويُناقِشْنَه.
ولكن المتجرّئين على شَرْعِ الله، أولئك الذين حُرِموا نِعمةَ فَهْم اللغة والنصوص القرآنية، بابتعادهم عن إدراك مقاصد الشريعة، وإصغائهم لمفتريات الحاقدين على الإسلام، تنكَّبوا الطريقَ الأعوج(+)، وحَمَلوا المعنى حَمْلَ الجاهل بما يحمل، ففسَّروا القَوامة قهراً وتسلُّطاً، وتحكّماً بالمرأة. ثم أوغلوا في التفسير وحرّفوه بحيث جعلوه دليلاً على أن الإسلام في هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمة، إنما ينظر إلى المرأة باعتبارها إنساناً من الدرجة الثانية، وتجاهلوا الآيات القرآنية الأخرى التي تكرّم المرأة الإنسان وتضعها في المكان اللائق بها باعتبارها أُماً وعرضاً يُصَانَ وربَّةَ بيت، كذلك تجاهلوا قول الرسول (ص) : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وقوله: «استوصوا في النساء خيراً».
لذلك يمكننا القول إن الإسلام نظر إلى الرجل والمرأة نظرة إنسانية، ولكنه لم يساوِ بينهما، وثمة فرق شاسع بين المعنيين، أو المفهومين. فقد كُلّف الرجل بالمهام التي تتناسب مع ما وُهِبَ من قوة، وما رُكب فيه من طاقات، إلى جانب ما تَفَرَّدَ به من صفاتٍ خَلْقِيّة، وكُلّفت المرأة بالمهام التي تتناسب مع ما وهبها الله تعالى وما رُكّبَ فيها، إلى جانب ما تفرَّدَت به من صفاتٍ خَلْقِيَّة. ولكل منهما دور في الحياة يستحيل أن يقوم به الآخر.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢