نبذة عن حياة الكاتب
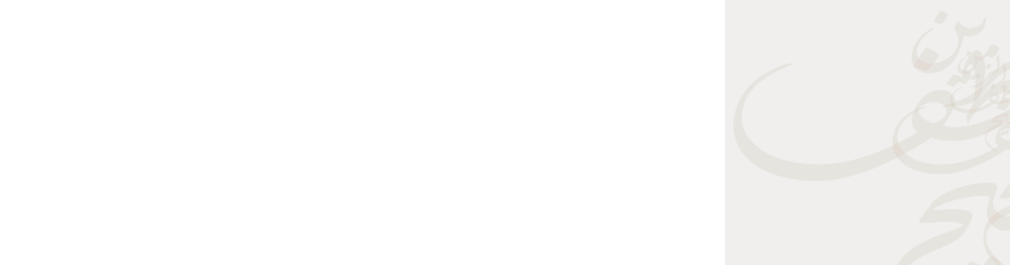
X
عالمية الإسـلام وماديـة العولمـة
الفصل الأول - عالمية الإسلام
الدعاة المسلمون وتـأثيراتهم داخل وخارج محيطهم
العـمل الإسلامي المعاصر
وحدة العمل الإسلامي: دواعيها ـ أهدافها ـ مهامها ـ أساليبها
عالمية الإسـلام
الحمد لله وليّ النعم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الأبرار، وصحابته الأخيار، أُنزل عليه الكتاب بالحق لهداية الناس أجمعين، صَدَع بأمر ربّه فبيّن الدين، وأرسَى القواعد ليكون الناس في منأًى عن الزَّلَلِ والضلال، والجَوْرِ والطغيان، فسار على هَدْيه الخلفاء الراشدون، الذين اقتدَوْا بهَدْيه، وتأسَّوْا بسيرته، واجتهدوا فيما جاء به من شرع، فكانوا قِمةً في الفهم والقيادة، وروّاداً في إصدار الأحكام، رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد بذلوا الجهود في تركيز دولة الإسلام وتثبيت دعائمها، وتوحيد حركتها، ونَبْذِ ما يؤدّي إلى الفُرْقَة بين رعاياها، فكان لهم الفضلُ في القضاء على العصَبيّات القبلية، تلك التي بقيت من جاهلية. وكانت الأمة أيامهم أمةَ خير وعطاء، عطاءٍ في الفكر، وعطاءٍ في التضحية، وعطاءٍ في شحن العقليات بالطاقة الإسلامية. فتكونت ذهنياتٌ أطلقت العنان لقدراتها ومَلَكَاتِها، فأنتجت من الإبداع ما غيَّرَ وجه العالم وأخرجه من ظلمات الجهالة والصَّنَمِيَّة إلى أنوار الحق ورحاب التوحيد.. وكانت دولةُ الإسلام الرائدةَ في ميادين المعرفة والاقتصاد والسياسة والفكر المتقدم على مدى قرون، ليس في محيطها فحسب، بل على مستوى الساحة العالمية، لأن الإسلام بما فيه من فكر لم يأتِ ليكون مقتصراً على جنسٍ معيَّن، وإنما هو للناس كافة، ولم يُخَصَّص للعرب وحدهم ـ على الرغم من عربية القرآن ـ بل كانت اللغة العربية هي ما أرادها الله العليم الحكيم لوحيه لتكون لغةَ كتابه المبين وسنة رسوله الكريم، فتتوحد بها لغةُ الدين الواحد للعالم بأسره، وتُحْمَل بهذه اللغة الرسالةُ ـ الكتاب والسنة ـ إلى جميع الشعوب، فكانت من هذه المنطلقات الرسالةَ السماويةَ من رب العالمين للبشرية جمعاء، قال تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}، وقال تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً}.
وعلى أساس عقيدة التوحيد تنزَّل الإسلام، فحمله المسلمون دعوةً إلى العالم، ومن هنا تَتَبدّى عالميةُ الإسلام بمعناه الرساليّ الشامل، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}.
فالإسلام القائم على التوحيد جعل مقياس الحكم على الناس، أفراداً وجماعاتٍ، بمقدار ما هم عليه من تقوى، والتزامٍ بالشريعة التي أرادها الله تعالى منهاجاً للبشرية، بعدما أزال عنهم خَبَثَ الجاهلية وظلامَ الشرك، وجَوْرَ العصبية، وحرَّم الاسترقاق وعالج الرق(+) لقوله عز من قائل: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} وليس على أساس الانتماء إلى العِرْق أو اللون أو الجنس، أو المرتبة في المنصب أو في المجتمع، ولا على أساس القيمة المادية التي يريدها دُعاة المذهب الرأسماليّ الذين يجعلون مقياسَ العلاقات بين الناس المنفعةَ الماديةَ فقط، في حين أن الإسلام يجعل مقياس الأعمال والعلاقات بين الناس مَبْنِيّاً على الحلال والحرام، أي على أوامر الله ونواهيه بعيداً عن تلك المنفعة المادية التي تسود الحضارة الغربية، والتي ينادي أصحابها اليوم بعَوْلَمَة الاقتصاد والتجارة والثقافة، بهدف احتواء الشعوب وإخضاعها لحضارتهم الناجمة عن مبدئهم الرأسماليّ، وهو المبدأ الذي أجهز على القيم الإنسانية، وحوّلها إلى مجرد سلعٍ استهلاكية، ونَحَا بالإنسان مَنْحَى الجَشَع دون وازع من ضمير، أو رادعٍ من دين.
إن الدولة الإسلامية التي استمر نظامُ حكمها ما يزيد على 1300 عام هجري، وانضوى تحت لوائها كثير من الأجناس، والأعراق، والشعوب، كانت النموذَج الأمثل ـ من بين جميع الدول على مر العصور ـ من كل النواحي، ولا سيما من ناحية ترسيخها وممارستها مفهوم العدل، وحكم العدالة بين الناس، أفراداً وجماعات، دونما تمييز إلا على أساس الحق، والحق وحده..
إن تاريخ الأمم وآثارها هما خيرُ الشواهد على حياة كل أمة ورسوخ أصولها في عمق التاريخ البشريّ بأسره، لأنهما يؤلِّفان تراثَها الذي هو المقياسُ الدالُّ على مدى عراقتها ودرجات تقدُّمها ورقيِّها من جهة، أو الكاشفُ عن دركات انحطاطها وما تمرَّغت فيه من ضعفٍ وتخلُّفٍ من جهة ثانية. إن تراث الأمم يعبِّر أصدق تعبيرٍ عن كل شأن من شؤونها الفردية والجماعية، ويبيِّن اهتمامَها وعنايتها في التنشئة على صعيد الأفراد من أجل صُنع لَبِنَاتٍ صالحة لبناء أمة صالحة، وعلى صعيد الجماعات من أجل حفظ الكيان والاحتفاظ بالمركز السامي الذي تحتلُّه إن هي تدرَّجت في مراقي الحضارة، أو أنه ـ على العكس ـ يُنبىء عن فشلها إن هي عاشت في ظل الخمول والخنوع والمَسْكَنَة..
إذن، فتراث الأمم هو مرآة حياتها إذ تنعكس عليه صور نهضتها موضّحاً خطواتها في مجال البناء والإنشاء، أو مُظهراً وهنَها الذي يدبُّ فيها ويؤدِّي بها إلى الانحدار بعد السموِّ فيما لو أصيبت بالتقهقر بعد التقدم في فترةٍ من الفترات.
إن حياة الأمم لا تُقاس بالشهور والأعوام، بل تُحسب عادةً، بالقرون والأحقاب الزمنية الطويلة، لأن كلَّ دور من أدوار أعمار الأمم يَقصر أو يطول بنسبة ما يَعرض لها من ضعفٍ أو قوَّة، وبحسب ما تكون حرةً سيدة، أو مغلوبة على أمرها، وبحسب ما تقدِّم من جهد وكفاح وما تبذل من عطاءٍ وتضحياتٍ في مراحل التغيير التي تتخطاها للنهوض بعد كبوتها وغفوتها. وبين أيدينا شواهدُ كثيرة على أن أمماً كان لها سلطانها الواسع الذي يمتدُّ إلى جملة أقاليم في أنحاء المعمورة، وكان لها جيشها الذي يُرهب القاصيَ والداني، ومع ذلك انحدرت عن مكانتها وتقلّص ظلّها بعواملَ مختلفةٍ توالت عليها، فقبعت في زوايا الإِهمال حقبةً طويلةً قبل أن تعاود استئناف النهوض، أو وقفتْ واستسلمت للخمول والاستكانة إذا ما عجزت عن ذلك. وبين كلِّ مرحلة من هذه المراحل كانت تمضي أحقاب وأحقاب، لا أيامٌ وشهورٌ في معرض التقدير والحساب.
إن الإسلام في نظرته إلى الإنسان، تجاوز بما لا يقاس جميع المبادىء الأخرى التي ابتدعها الناس، حيث تعاقب على الحكم في الدولة الإسلامية سلاطينُ وأمراء من مختلف الأجناس، كما تولى حكمَ الأقاليم والأمصار وإدارتها أناسٌ من أجناسٍ شتى، فكان انتماؤهم الإسلاميّ هو المعوّل عليه. ولم يكن المسلمون، بما ترسّخ في نفوسهم من مفاهيمَ نتيجة إيمانهم وتبنّيهم لما أمر به الدين من التزام بالشريعة، وما حدَّد من معاييرَ لضبط سلوك المسلم في حركته مع الحياة وتعاطيه شؤونها.. أجل، لم يكن المسلمون جراء ذلك لينظروا إلى الحاكم إلا بمقياس واحد: هو تطبيقه أحكام الدين وإقامة شرع الله، بغض النظر عن تحدّره من أصول عرقية أو قبلية معينة، وهو ما لم يحصل في أي مجتمع ودولة، لا في الحاضر ولا في الماضي.
والإنسان المفكر والمتمعن في أسباب هذا التلاقي الإنسانيّ ورقيه يدرك إلى أي مدى تمكَّن الإسلام من إلغاء الفوارق المظهرية التي تحول دون إقامة عدل حقيقيّ يشعر الناس بالتوادّ والتراحم فيما بينهم، كما دعا إليه رسول الله (ص) بقوله: «مثل المسلمين في توادِّهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهَر والحمَّى»(+).
على مثل هذه المرجعيات في النصوص تم بناء الشخصية الإسلامية في المجتمع على امتداد العالم الإسلاميّ، وعلى أساسها نُشِّىء الفرد المسلم ليتفاعل في الكيان العام ضمن أطر الدولة. ومن هنا نجد بروز وحدة الأمة الإسلامية في: الأفكار، والمشاعر، والتوجهات، والحكم على الأشياء من منظور إسلاميّ واحد، رغم تعدد المستنبطات الفقهية بين المذاهب في الظنيات فقط. أما في القطعيات فإن الإمة الإسلامية لا تَعارُضَ بينها، فهي مُسَلّمةٌ بها تسليماً كلياً(+).
وهذا ما سيترجم إلى واقعٍ أكثرَ بروزاً حين يمكِّن الله تعالى المسلمين من استعادة موقعهم الفاعل على المستوى العالميّ.
وثمة ناحية مهمة تحث المتمعن في الطريقة التي يعالج بها الإسلام شؤون الحياة على تتبع تلك الميزة التي انفرد بها الإسلام في نظرته إلى الإنسان ككائن بشريّ، رُكِّزت فيه غرائز، وحاجات عضوية، وملكات، وطاقات. وهي من النواحي الفكرية التي تستحق التمحيص والتدقيق والمراقبة الفعلية ببصيرة واعية.
ذلك أننا حين نمعن النظر فيما أودع الله تعالى في الإنسان نستطيع أن نجد أنه مستوعَبٌ حوى مجموعة من الغرائز والحواس والخاصيات(+)، إلى جانب طاقات تحدد ماهية وجوده، كما تعطيه ذاتية معينة، بحيث ترتبط بها علاقاته جميعاً: بخالقه، وبنفسه، وبالآخرين من جنسه، وبكل ما يحيط به من كائنات متحركة وثابتة.
ونتبيَّن أن تركيبه العضويّ والنفسانيّ لا يماثلهما تركيب في سواه من المخلوقات على الأرض. فهو مميز بخصائص تمكنه من تطويع ما حوله من الكائنات والأشياء، فيعمل من خلالها على دفع مسيرته في الحياة نحو الترقي، وتؤهله لأن يتبوأ مركز السيادة على الكائنات الأخرى.
وأبرز تلك الخصائص فِكرُه، وهو المركز الأساسيّ الذي يحصل به التمييز والإدراك، والذي من خلاله يتمكن من الحكم على الأشياء.
فالحمد لله الذي كرّمَ الإنسان بعقله، وأنعم عليه بهذا الدين الحنيف الذي سيبقى منارة هُدى على مدى الدهر، وسيظل ظاهراً على ما عداه من بِدَع المبادىء الضالّة المضلّة، قال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا *قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَناً *مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا *}.
وعلى هذا فإن هذا الكتاب يبحث في المواضيع التي تهم العالم اليوم، ويحدّد موقف الإسلام منها بطريقة واضحة وسهلة (إن شاء الله الملهم الوهاب الكريم).
الدعاة المسلمون وتأثيرهم داخل محيطهم وخارجه
ليس بالمسْتَغْرَب على مَن يدرك قوة العقيدة الإسلامية وتأثيرها في النفوس أن يلمح الصعود المتزايد في استقطابها موجات المؤمنين من أجناس شتى.
يحدث هذا في الوقت الذي يشهد فيه العالم تراجعاً مستمراً في الأداء السياسيّ بكل مظاهره الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وما يندرج في إطارها من أخلاقيات، بينما يسجّلُ الإسلام بالمقابل خطّاً تصاعدياً باعتباره الأقوم.
ولا بد هنا من وقفةٍ تستلزم بعضاً من أناةٍ لاستشراف جملة اعتبارات ينبغي تقييمها بحيادٍ، بمقدار ما ينبغي تتبّعها ومراقبتها بدقة وتفكير معمَّق. إذ لا شك في أن ثمة أمراً جوهرياً يميز الإسلام عن سواه من العقائد فيدفع بمن يطّلع عليه، اطّلاَع المتعلق بمعرفة الحقيقة، إلى التسليم بأفكاره واعتناقه.
حقائق القرآن:
إن القرآن العظيم يعرض المسائل جميعاً على الإنسان للتفكر بها، أي لوضع ما يُرى ويُحس في ميزان العقل ومن ثَمَّ الحكم عليها.. وإنَّ عَرْض القرآن للمسائل والأشياء مُسْتَوْفٍ كل الشروط الموضوعية الضرورية للحكم عليها بصفتها واقعاً محسوساً، ولأن لها هذه الصفة الواقعية والحسية فإن الإنسان بوصفه كائناً عقلانياً، مفكراً، مَسُوقٌ إلى معرفة أسرارها، ومن ثَمَّ إدراك الحقائق فيها وعنها. فالسماء والأرض وما فيهما أشياء محسوسة، وهي من هذا الباب واقع محسوس، فيأتي القرآن مخاطباً عقل الإنسان ليحثه على التفكير بهذا الواقع المحسوس: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآَيَاتٍ لأُِولِي الأَلْبَابِ *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *}.
والحقيقة في معرفة الأشياء تتطلب معرفة مبتدَءاتِها: من أين أتت؟ ووظائفها: لماذا وجدت؟ وخاصّياتها: مهماتها في دائرة الوجود.
القرآن العظيم يجيب على هذه المسائل معرّفاً الإنسان أنها من صنع الله تعالى، موضحاً له حقائقها. ففي مجال خلق الإنسان يقول: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا}، ويقول: {قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ}. وفي مجال خلق الأشياء يقول: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ *أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ *}. وفي مجال التعريف بخصائصها يقول: {وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا *وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا *وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا *وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا *وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا *وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا *لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا *وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا *}. ويقول في مجال ما طبع في الأشياء من خاصيّات: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ}. ويقول: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *}.
حين تتحرك مَلَكةُ التفكير في الإنسان بتدبُّر معاني هذه الآيات وما تقصد إليه من ردّ المخلوقات إلى الخالق يَبْرزُ العقلُ كَمَرجعٍ حَكَمٍ ليقرر ما إذا كانت تفسيراً لواقع، أم أنها ادّعاء لمتصوَّرٍ غير موجود. ولنا أن نتخيل خَطَلَ التفكير في وجود موجود بغير واجد، أو في وجود مُوجِدٍ وقف عند حدّ الإيجاد، أو أن الأشياء الموجودة موجِدَةٌ لذواتها.
إنَّ مواطِنَ الخلل في خَطل التفكير على هذا النحو أنها تدور في دائرة منطق فلسفيّ بحت يحاول تلمُّسَ الحقيقة تبعاً لفرضيات مُفَسِّرة لموجودات لم يشهد الإنسان بدء تكوينها وخلقها، قال تعالى: {مَا أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا *}.
ويرتفع القرآن بتربية الإنسان إيمانياً فيعلمه أن ثمة أشياء موجودة ولكنه لا يحسّ بها، حين يقسم تعالى بالأشياء التي نحسّها والتي لا نحسّها: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ *وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ *}، وهنا يكمن مدى تكريم الله للإنسان إذ يخبره حتى بما لا يحسّ ولا يبصر، ولكنه تعالى يُفهم مخلوقه أنه بما قدره فيه من قوى الإبصار والسمع والحسّ مقيد بمعرفة الأشياء التي يحتاجها في حركته مع الحياة، وأنه أعجز من أن يدرك الأشياء غير المحسوسة إلا بخبر يأتيه من الله من طريق الرسل والأنبياء.
نخلص من هذا إلى بَديهيةٍ عقلية، هي أن كل ما في الكون من مخلوقات ليست موجودة لِذَواتها، وأن موجدَها هو الله الذي خلق كل شيء. وعلى الرغم من كون هذه البديهيّة قد سبقت إلى الإقرار بها عقائدُ وأديانٌ قبل نزول القرآن، فإن القرآن بيَّنَ بتفصيلاتٍ أدق هذه البديهيّة، وقدم للإنسان البراهين والأدلة مدعَّمَةً بالحجج والأمثلة التي لا يستطيع العقل إلا الإقرار بها إقراراً حتمياً لا مجال للشك في صحته. والقرآن العظيم بهذه الخاصيّة مكّن أهلَ القرآن من أن يقدموا للعقل ـ على قواعد الإقناع ـ أوضحَ السُّبُل لمعرفة الحقائق معرفة اليقين.
بهذه المعرفة الحيّة اليقينية المُقْنِعة يتحرك الدعاة المسلمون في محيطهم وخارجه، مقتحمين عقائد الإلحاد والمادية، مصحِّحين ومصوِّبين مسيرةَ الإنسان لاستئناف حياته على هَدْي الإسلام، منادين بالعودة إلى الينابيع الحقيقية التي كوّنَت أنقى علاقة اجتماعية عرفتها البشرية في تاريخها.
وبهذا الزخم الإيمانيّ وصف الله سبحانه واقع هذه الأمة الإسلامية حين قال: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}. فالدعوة إلى الخير هي الدعوة إلى الإسلام، الدين الذي ارتضاه ربُّ العزة ليُصيبَ خيرُهُ جميعَ أهل الأرض. وتبعاً لهذا المفهوم المؤسَّس على قاعدةٍ قرآنية نلمح أفواجَ الدعاة إلى دين الله وقد حملوا رايتَه عالياً غير آبهين بأموالٍ تُبذَل، ولا بنفوسٍ يحاصرها العسف، ولا بأقدارٍ مهدَّدةٍ بقطع سُبُلِ العيش... كل ذلك في سبيل مَرضاة الله تعالى.
وثمة ناحية انفرد بها القرآن العظيم، هي تلك المحورية الثابتة في تركيز الوحدانية، وفي جعلها الأساس الذي بدونه لا تستقيم حركة الكون. يتمثل ذلك في كل نص قرآنيّ، لفظاً، ومعنًى، وإيحاءً، واستنتاجاً {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *}، {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}، وفي قول الرسول (ص) : «ما قلت قولاً أنا ولا نبيّ من قبلُ أحبَّ إلى الله من قول لا إله إلا الله» ، وكذلك في تنزيهه نفسه تعالى عن المثلية: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
إن هذه المحورية في الوحدانية لا يخلو منها خطاب القرآن في جميع سوره. فشهادة «أن لا إله إلا الله» هي المبتدأ في الإيمان الحق، وعليها ترتكز جميع القواعد والمفاهيم والأفكار التي تسوس حركة الفرد في الجماعة، وحركة الجماعة فيما بينها، أو مع غيرها من الجماعات. وهي حركة قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن خلال هذه القاعدة يتوجب التكليف بإقامة نظام يتولى إنفاذ هذه القاعدة القرآنية لرعاية شؤون الناس، وصيانة الحياة من العبثية وضلالية السلوك، وصولاً إلى تحصين المجتمعات من تفشّي الإلحاد ومساوىء الاستعباد المبطَّن الذي يُمارس على الناس بأشكال كثيرة.
إن الإسلام، برسالته العالمية يقف باستمرار وبتلقائية صارمة ـ كما سنرى في المواضيع الموجزة في هذا الكتاب ـ في مواجهة كل الأفكار التي تبغي السيطرة على العالم بمسَمّيات مختلفة، متذرعة بمبادىء أنتجتها عقول فلاسفة يدّعون زوراً إشاعة العدل والمساواة والحرية بين البشر، إلا أن هذه المبادىء سرعان ما ينكشف زيفها، فتنهار بعد أن تكبّد البشرية ملايين الضحايا فضلاً عن تعريض العالم للدمار، مثلما كان يحدث إبَّان سيادة النازية في ألمانيا وسيادة المبدإ الشيوعيّ فيما كان يعرف بالاتحاد السوفياتيّ، ومثلما هو متوقع حدوثه الآن بعد انفراد أميركا بالسيطرة على العالم ومحاولات فرض مبدئها الرأسماليّ على الشعوب، وجرّها عن طريق العولمة للاحتواء، والتحكم بمقدراتها.
هنا نلمح بروز الإسلام، لا كعقيدة فحسب، بل وكمبدأ في مواجهة المبادىء الأخرى ومنها المبدأ الرأسماليّ الذي تتزعم الدعوة إليه أميركا، وتعمل عن طريق جديدها الاقتصاديّ (العولمة الاقتصادية) كخطوة أولية لمحاصرة الإسلام، كونه المبدأ الشموليّ الوحيد والرحمة المهداة من قبل الله سبحانه وتعالى لينير ظلمة هذا الكون. قال عز من قائل: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا}، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ *}. وقال الصادق الأمين: «أنا الرحمة المهداة»(+). فالإسلام بشموليته النورانية هو المؤهل لقيادة البشرية، والمناهض بمفاهيمه الإيمانية لمبدإ العولمة الرأسمالية.
العمل الإسلاميّ المعاصر
إن حتمية المواجهة بين الإسلام وخصومه من أولى القضايا التي ينبغي على المسلمين استنفار إمكاناتهم وقواهم للتصدي لها. ومقدمات المواجهة باتت من الوضوح بما لا يدع مجالاً للشك في تصميم الخصوم على إنهاك الشعوب الإسلامية اقتصادياً ونفسياً وسياسياً عبر ما يفرض على دولها من قرارات وإجراءات مقنّعة بشرعية دولية، لتدجينها وإرغامها على الدخول تحت عباءة النظام العالمي الجديد الذي هندست له دكتاتورية رأس المال الغربي.
إزاء وضعٍ بهذه الحدة التدميرية، ماذا يمكن لحكام العالم الإسلاميّ، باعتبارهم المؤتمنين على مصالح شعوبهم، أن يقدموا لا على المستوى الاقتصاديّ فحسب، وإنما على مستوى فكريّ شامل، وخاصة بما لديهم من مخزون حضاريّ متجذر في أعماق أبناء الأمة، وفي تراثها المنبثق عن عقيدة إيمانية راسخة تستوعب معالجة شؤون الحياة. وبالتالي ماذا يمكن للمجموعات الفكرية ونُخبها المدركة جسامةَ الخطر المحدِق بالمسلمين والمستهدِف تكبيلهم بنظمٍ وقوانينَ ومعاهداتٍ دوليةٍ تحت شعار العولمة أن تقدمه ليس فقط في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، بل من حيث كون الإسلام مبدأً قادراً على تصويب المسيرة الإنسانية: فكراً وسياسةً واقتصاداً وسلوكياتٍ وإبداعاً حضارياً؟!
تأسيساً على هذا الواقع بغَرَض تغييره وإحلال واقع بديل متميز بأنْسَنَةٍ حقيقية فإن المنطلق ينبغي أن يتركز في وضع العقيدة الإسلامية ـ مبدأً ونظاماً وما يتفرع عنهما من قوانين وتشريعات وعلاقات بين الناس والدول ـ موضع التنفيذ.
ويتأتّى ذلك من طريق إرساء قواعد فكرية تضع نصب أعينها تجاوز ما نبتَ على هامش الفروع الفقهية من خلافاتٍ لا ينشأ من تجاوزها إضرار بجوهر العقيدة ولا يمسّ المسلّمات الأساسية فيها، أي لا يمسّ القطعيات في الإسلام، لأن القطعيات لا تَعارُضَ فيها ولا عليها.
وذلك أن الملاحظ في حركة العمل الإسلاميّ في أكثرَ من موقع: في تنظيماتها، وتياراتها، وجمعياتها، وأنشطتها، تبعثرُ جهودها، من غير قصد منها، وبحسن نية، في تبنّي أفكار ترفض التراجع عنها بسبب تَجَذُّرها في الأعماق. ولو أنها أعادت النظر فيها وربطتها ربطاً فكرياً بالأصول لَوَجَدَت الكثير منها قد نشأ إما عن استنباطات تعوزها الأدلة والأسانيد الصحيحة، وإما عن وقائعَ تاريخيةٍ زُرعَت في مناخات الفتن وتراكمت تحت مظلة التراجع عن إعمال الفكر لكبح جماح العصبيّات، وشحنه بالطاقة الإسلامية المستنيرة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه، وإما أن أعمالها كانت نتيجة ردّات فعل للظلم الذي مُورِسَ عليها من قبل أعداء الإسلام. وللارتقاء فوق كل الخلافات الفرعية فإن السبيل الأقوم للحركات الإسلامية هو أن تتّبع قولاً وفعلاً توجيه رب العالمين في كتابه الكريم حيث قال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، وقال: {وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} وقال: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا}.
فالمسلم الحق ملتزم بهذه القواعد القرآنية التزاماً جبرياً لا خيار له فيه، لأن وحدة العقيدة تقتضي التوحيد في كل ما يعود على المسلمين بالخير: في مجابهة خصومهم.. في وقوفهم كتلة واحدة متراصّة.. في ردهم على كل المشاريع التي تستهدف وجودهم وتعمل على تفتيت كيانهم بتفتيت شعوب هذه الأمة.
كما أن على الفئات المتنورة أن تدرك أن خطابها لكي يكون شرعياً يجب أن يكون مستمداً من خطاب الشارع وأن يستوفيَ شروط الشرعية التي مناطها التوحيد، توحيد الأفكار والمفاهيم والخطط، وأن يكون خطاباً عالمياً، موجهاً إلى كل الناس، على اختلاف أجناسهم وثقافاتهم وانتماءاتهم وأفكارهم ومبادئهم. كذلك على تلك الفئات أن تدرك إدراكاً يقينياً لا يعتريه شك، أن المسلمين لم ينهزموا كأمةٍ إسلامية، وإنما هُزِمَ المسلمون عندما تخلَّوا عن الإسلام. وإن تركيا في الحرب العالمية الأولى لم تحارب على أساسٍ إسلاميّ بل حاربت كدولة أوروبية وقفت مع ألمانيا ضد الحلفاء.
كذلك على الحركات الإسلامية أن تعمد إلى تغذية أذهان الناس بالعقلية الإسلامية وأن تشحن طاقاتهم بالإسلام لتكوين النفسية الإسلامية. ونتيجة تكوين العقلية والنفسية تغدو الشخصية الإسلامية متحركة وفاعلة، فنكون بذلك قد عالجنا ما ترسّبَ في الأذهان من مفاهيم دخيلة تركزت نتيجة الغزو الثقافيّ الغربيّ، وانتزعنا ما علق في النفوس مما لا يستند إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) . وهي إذا تمكنت من ذلك تكون قد وصلت إلى درجة من الوعي لن يعود معه بإمكان الخصوم إنفاذ المؤامرات والدسائس، كما تكون قد حطمت تلك الحواجز التي تحول دون عمل إسلاميّ واحد موحَّد.
إن الصحوة الحقيقية هي الصحوة على كتاب الله وسنة رسوله، لا على المذهب والطائفة. والمسلم الذي يحمل همَّ الأمة هو الساعي إلى إصلاح طوائفها وجمع كل فئاتها، من تياراتٍ وأحزابٍ وتنظيماتٍ وجمعياتٍ وأنشطة، على كلمة سواء وهي أنه: آن الأوان لأن نكون في مستوى الدعوة، وأن نتبيَّنَ أن هذا الإسلام العظيم كفيلٌ حقّاً وصدقاً أن يجمع ولا يفرق.
وهنا لا بد من استدراك ناحية مهمة ينبغي النظر إليها بكثير من العناية، منعاً لتفسيراتٍ وتأويلاتٍ قد يثيرها من لا يريدون وحدة المسلمين ويسعون إلى الوقيعة والدسيسة بينهم، وهي أن دعوتنا إلى وحدة العمل الإسلاميّ ونبذ ما نبت حول الفروع من أفكار ومفاهيم دخيلة، ليست دعوةً إلى طبعة إسلامية جديدة أو منقحة، ولا عملاً سياسياً مقوداً برؤية توافقية، ولا استحداثاً يقصد منه تأسيس فرقة أو طائفة أو مذهب أو حزب يُضاف إلى الفرق والطوائف والمذاهب والأحزاب، بل إن هذه الدعوة إنما انبثقت من قاعدة قرآنية واضحة وَعَتْ قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}.
وحدة العمل الإسلاميّ دواعيها ـ أهدافها ـ مهامها ـ أساليبها
بالرغم من كون الإسلام بجِدّيّته الصارمة مناقضاً للعولمة الرأسمالية، فإن الحركات الإسلامية لم تتمكن بعد من بناء مشروعها بناءً على رسالته العالمية. والقاسم العمليّ المشترك والوحيد الجامع بين تلك الحركات هو وقوفها موقف الرافض لتلك العولمة نظراً إلى تناقض قيمها مع القيم الإسلامية. وهنا نلحظ أشكالاً من الرفض متمثلة في التصدي على مستوى الدفاع والمقاومة من قبل الشعوب والكيانات الإثنية الإسلامية، وذلك بمجابهتها قوى السيطرة الاستعمارية المباشرة في: فلسطين، الشيشان، البوسنة، الصين، والفليبين.
كما نلاحظ أن أساليب الحركات الإسلامية تختلف باختلاف الجغرافيات والأُطُر السياسية التي تتحرك من خلالها. وهنا ينبغي أن لا نغفل النقاط الجامعة بين تلك الحركات، والتي بالإمكان تلخيص عواملها بما يلي:
أولاً: وحدة العقيدة أي عقيدة التوحيد.
ثانياً: وحدة الشريعة التي ترى فيها أفضل وأرقى نموذج لإقامة العلاقات الإنسانية.
ثالثاً: حال الاستضعاف المشترك بسبب مواجهة قوى استكبارية متسلطة في كل المواقع.
غير أن هذه العوامل بين الحركات تطغى عليها الناحية التمايزية، إما بسبب اختلاف الجغرافيا أو الأطر السياسية، وإما بسبب اختلاف المهام المطروحة أمام هذه الحركة أو تلك، وإما بسبب الاختلاف المذهبيّ أو الطائفيّ الذي ما يزال يؤثر في تحركها وسلوكها، ولكن على الرغم من هذا التمايز فإنه عندما يتعلق الأمر بضرب العالم الإسلاميّ وتفتيته فإن تلك الحركات يتوحد موقفها، لأن ذلك الأمر يعتبر القاسم المشترك الذي لا يُختلف فيه.
أبْعَدُ من ذلك.. يلاحظ في علاقات الدول فيما بينها أن الغرب لا يمانع في أي علاقة أو رابطة تقام بين دولة وأخرى ما دامت أنها غير قائمة على أساس الاندماج والتوحد.. ولكن يُلْحَظ في المقابل محاربة أميركا وأوروبا كل الحركات الإسلامية التي تعمل لإعادة بناء الدولة على أساس الإسلام.. وما حدث لجبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر ولحزب الرفاه في تركيا ليس ببعيد.
وكمحصّلةٍ مشاهَدَةٍ على المستوى العالميّ فإن أميركا حددت خياراتها العملية بفرض قواعد العمل السياسيّ والعسكريّ المؤمِّنة مصالحها الاقتصادية، ومن ثم إملاء طرق عيشها وجرّ العالم للسير على أساسها. ولكن، ومن خلال رصد ما في الساحة العالمية من أفكار فإننا لا نجد بعد انهيار الماركسية فكراً بديلاً مقارناً أو موازياً لزحف الفكر الرأسماليّ بطبْعَتِهِ الأميركية. والأمر الأدهى أنه بالرجوع إلى المحاورات السياسية وجَدَليّاتها المنتشرة في ما يُكتب ويُذاع في العالم الإسلاميّ، وفي ما يتردد حتى على ألسنة الناس العاديين، يُرَى إلى أي حدٍّ تمكن الإعلام الأمريكيّ من تطويع لغة الفكر السياسيّ وطبعها بطابع الديموقراطية، وإلى أيِّ حدٍّ انطوت هذه اللغة على معلوماتٍ فضفاضة فقولبت ألفاظاً مُبْهَمَة تفسَّر حسب ما تقضي المصلحة، مثل الحرية، والمساواة، وسيادة القانون، والتقدم، والإرهاب، وحقوق الإنسان، إلى آخر هذه المنظومة من الألفاظ الموضوعة لصالح الثراء في مقابل الفقر، والإبهام في مقابل الوضوح.
حيال هذه الموجة العاتية من التحدي، وهذا المخطط الشرس، فإن على الحركات الإسلامية الارتفاع بمستوى خطابها، ليكون خطاباً عالمياً على مستوى العقيدة، وقائماً على قاعدة السموّ الذي يتمتع به الإسلام: أفكاراً ومفاهيمَ، ومبدأً جامعاً لكل مناحي الحياة في تفريعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وإن من شأن هذا الخطاب أن يزيل المباعدة بين الحركات الإسلامية، التي هي الآن في دائرة الانكفاء على الذات، والتي تؤدي إذا لم تعالج إلى منطقة الخطر.
كما يلاحظ أنه في غياب الدولة الإسلامية الواحدة، فإن تنوع أنظمة الدول في العالم الإسلاميّ، وطبيعة كل منها، يُعْتَبَر من العوامل السلبية المؤثرة في العمل الإسلاميّ ككل، حيث يُطْبقُ نظام كل دولة وطبيعة الحكم المتغاير فيها على حركة العمل، وهو ما ينشأ عنه تغاير واضح يضطرها للاختلاف ومن ثم إلى التشتت. فهناك ملكيات منغلقة على الحكم الفرديّ المطلق، وجمهوريات علمانية، وجمهوريات ليس لديها من الجمهورية إلا التسمية، وإمارات ودول تُدار بأنماط العشائرية والقبلية أو العائلية، ودول تعيش حال عزلة مفروضة، ودول مرتبطة بالسوق العالميّ، ودول مناوئة لأي شكل من أشكال الممارسة الدينية.
وإنه لمن الطبيعيّ أن يُلقي هذا التباين بظلاله على طرائق العمل لدى الحركات الإسلامية، فيطبعها بطابع التشتت.. وعند مقارنة هذا الواقع بواقع العولمة الموحّد بقيادة قوة بحجم الولايات المتحدة الأميركية ومن ورائها القوى الغربية، يظهر الفرق الكبير في إمكانات العمل وتفعيله ومن ثمّ الوصول به إلى وضعية التأثير.
وإذا أُضيف إلى ذلك نجاح أميركا والغرب، على مدى عقود، في تكوين دويلات على أنماط مختلفة وترسيخ كيانات مصطنعة وهشة، ندرك إلى أي مدى بلغ المخطط الغربيّ في تحويل العالم الإسلاميّ إلى دويلات تدفع بمحاولات التلاقي إلى منطق التصادم، وبالتالي إلى الرد على هذه المحاولات بتنظيرات عرقية وإقليمية، وعن طريق إثارة مَقولات المحافظة على المكونات الوطنية والهويات المستقلة. وما إقامة التجمعات على أساس القومية وغيرها في البلدان الإسلامية إلا تكريس لهدم التوحيد وإغراق المسلمين في مزيدٍ من التفريق والتشتيت.
وبناءً على هذا، كان لزاماً على الحركات الإسلامية أن تعمل على التصالح مع نفسها، وأن لا يكون اختلافها في الأسلوب سبباً للاختلاف في الطريق. وعليها أن تدرك أن العالم على اتساعه، بعد الثورة الهائلة في وسائل المواصلات والاتصالات، قد تحول إلى ما يشبه القرية، وأن الحدود بين الدول والقارات لم تعد تلك الحدود المانعة لإيصال الفكر وبثه في الناس، وأن فهم الواقع العالميّ فهماً مجرداً عن طريق استحداث أساليب لتغييره بعيدٌ عن طريقة الإسلام في التغيير.
لذلك فإن أساليب وأدوات العمل ينبغي أن تكون على مستوى التحدي الذي يُجابَه به الإسلام.
كذلك على الحركات الإسلامية إجراء نقد معمّق لمنهجياتها، والاقتداء اقتداءً واعياً بمعلِّم هذه الأمة وقائدها، وأن يكون هَدْيُهُ هو المرجع الذي تلجأ إليه، والأسوة به هي السبيل الذي تحتذيه، تطبيقاً لأمر الله الحكيم الخبير حيث قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}.
فإعمال البَصيرَة في هذه المرحلة التي تعيش فيها الأمة حالةَ استرخاء، على الرغم مما يحيط بها من أخطار، يدعو الحركات إلى أن يكون عملها منصباً على التثقيف بالإسلام، واستعادة مناخ الحالة السياسية في مكّة عندما كانت الدعوةُ في بدايتها، وعلى اتباع طريقة الرسول الكريم في التعامل معها.
فنحن اليوم بلا دولة تلتزم الإسلام منهجاً عاماً، ونعيش حالة إسلامية أشبه ما تكون بالحالة المكية، فعلى الدعاة إدراك هذا الواقع والتصرف على أساسه، شرط أن لا يغيب عن الأذهان أننا نعمل وصولاً إلى حالة مدينية لتأسيس المجتمع الإسلاميّ على قاعدة الدولة.
وهنا ينبغي أن نتتبَّع كيف تعامل دعاة مكة مع محيطهم قبل ترسيخ الدولة في المدينة. لقد اقتصر عملهم في مكة على الناحية الفكرية، فخاضوا معاركهم على أساسها، وعلى الرغم من تعرضهم لشتّى ألوان التنكيل فإنه لم يؤذَن لهم بقتال، ومن لم يستطع منهم تحمل الأذى سمح له الرسول الكريم بالهجرة إلى الحبشة، وَمَنْ تَحَمَّلَ أذى المشركين بقي مع الرسول في مكة، يخوض المعارك الفكرية، حتى كانت بيعة العقبة الثانية.. أُمر بعدها الرسول (ص) بالهجرة إلى المدينة لتقام نواة دولة الإسلام، والمسلمون المتدبرون قرآنهم الكريم يعلمون ذلك عند تلاوتهم الآية الكريمة في سورة الحج: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *}.
إذن، فالآية صريحة بأنه لم يُؤذَنْ بالقتال أثناء وجودهم في مكة، لأن المعركة كانت معركةً فكرية محضة، وتربية جديدة على المفاهيم والثقافة التي تؤسس طريقة للتفكير الهادف إلى التغيير. وهذا ما أراد الغرب إبعادنا عنه حيث استطاع أن يُخضع، بواسطة عملائه والمطبوعين بثقافته، دراسة النصوص الإسلامية لطريقة التفكير الرأسمالية التي تجعل الواقع مصدراً للحكم وليس موضعاً للحكم، مع أن الإسلام يجعل الواقع موضعاً للحكم لا مصدراً له.
ولما جعلوا الواقع مصدراً للحكم صار مقياس أخذ الحكم أو تركه هو النفعية المادية وليس الحلال والحرام، أي أوامر الله ونواهيه، مما دفع بعض المسلمين، عن حسن نية جاهِلَة، أو سوء نية عَالِمَة، إلى استحداث بعض القواعد التي لا تستند إلى نصوص شرعية لفهم الإسلام من مثل: فقه الواقع(+)، وفقه الموازنات(+)، والضرورات تبيح المحظورات، وغيرها مما نتج منه بعض أحكام إسلامية مشوهة، لعدم التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين ما هو إسلام وما هو كفر. فصار الربا مباحاً، والاستشهاد انتحاراً، والإنفاق في سبيل الله إسرافاً، والعمل على إعلاء كلمة الله لجعلها هي العليا تهلكةً، مستشهدين بقول الله عز وجل: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} مع أن العكس هو الصحيح، أي: إنْ لم تتفقوا وتعملوا وتنفقوا في سبيل الله فستلقوا بأيديكم إلى التهلكة وسوف تصبح الغلبة لأعدائكم، يحتلون بلادكم ويسلبونكم خيراتكم، كما هو حاصل معكم اليوم.
كذلك هَدَفَ الغربُ إلى صياغة شخصية المسلم صياغة جديدة بحيث لا يجد غضاضةً في ترك الواجب وفعل الحرام، ولا يأمر بعدها بمعروف ولا ينهى عن منكر. ولذلك عمل الغربيون، نتيجة الحوار المكثف بين الأديان الذي بدأوا فيه منذ سنة 1933م، على إزالة المناعة الثقافية في الأمة الإسلامية، واللّه سبحانه وتعالى أعلمنا بهذا في كتابه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد بقوله تعالى: {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} وبقوله تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً *ولَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً *إِذًا لأََذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا *}.
إن شعار الغرب الإعلاميّ هو: «أن لا يُرينا إلا كما يَرَى»، حتى أصبحنا لا نقرأ إلا ما يكتبه ولا نسمع إلا ما يذيعه، ولا نشاهد إلا ما يبثه، لأنه جعل وسائل الإعلام في الدول تابعة لشبكاته.
وهكذا كان فرعون من قبل لا يُري قومه إلا ما يرى قال تعالى: {قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ *}.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢