نبذة عن حياة الكاتب
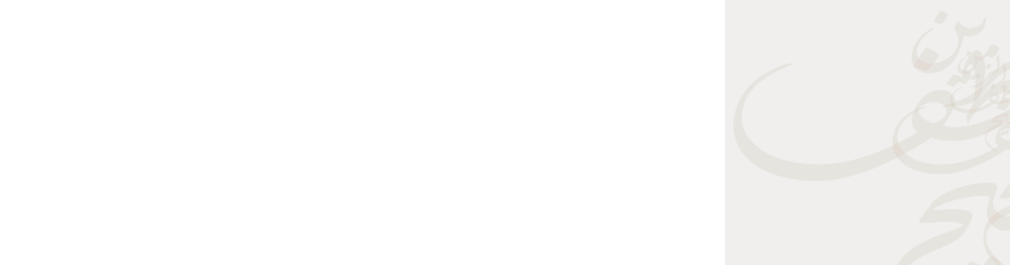
X
عالمية الإسـلام وماديـة العولمـة
الفصل الثالث - العلمـانـيـة
الديموقراطيـة والشـورى
الديموقراطيـة الرأسـماليـة
تـعـريف الديمـوقراطيـة
مسوىء الديموقراطيـة
تأثير الديموقراطية على بلاد المسلمين
ما يجـوز أخذه مما عندهم وما لا يجوز أخذه
حكم الأكثريـة
الحريات العامة
الإنتخـابـات
العلمانيـة
العلمَانية لفظة مضلّلة توحي بأن لها علاقة بالعلم، ولكنها تعني باصطلاحها الأصلي (اللاَّدين) فهي مضادة للدين وتقوم على إقصائه عن الحياة العملية. أي أن العلمانية قد تركت للناس حرية التدين، وأبقت الدين مجرد علاقة فردية يقيمها كل فرد وفقاً لمعتقده الإيمانيّ.. فتكون العلمانية بالمفهوم المتداول فصلَ الدين عن الدولة وعن الحياة.
ولقد نشأت العلمانية في أوروبا، يوم كان رجال الدين يتدخلون كثيراً في شؤون الحياة بصورة غير صحيحة، ما أدى إلى نفور الناس من الدين(+) ووقوفهم إلى جانب المفكرين والفلاسفة في حربهم على رجال الدين. وبعد صراع مرير بين الكنيسة من جهة والفلاسفة والمفكرين من جهة أخرى انتصر أعداء الكنيسة على رجال الدين والحكام، وهذا ما أدى ببعض المفكرين والعلماء في الغرب إلى نفي وجود الدين مطلقاً، واعتباره بدعة، وهؤلاء هم العلمانيون(+). ووصفه آخرون على أنه نمط من التفكير لا دخل له بشؤون الحياة، متخذين شعاراً لهم «دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر»، وهو قول مأخوذ من الإنجيل كدلالة على عدم رفض الدين كلياً، بل حصره في الكنيسة.
والفكر الأساسيّ الذي قامت عليه العقيدة العلمانية هو فصل الدين عن الحياة، وبالتالي فصل الدين عن الدولة، وسرعان ما استجاب الناس في أوروبا لهذه الدعوة للتخلص من رجال الدين.
وهكذا نشأت العلمانية(+) كنقيض للدين وكخصم لدودٍ له، وصار عندها أن الناس هم الذين يقررون، وأن الأكثرية هي صاحبة التشريع في كل شيء، بخلاف الإسلام الذي يقول: إن المشرّع هو الله الواحد الأحد.
لقد اعتبر العلمانيون أن الإنسان إنما يخضع للدين بسبب العجز والجهل، وزعموا بعد انطلاق العلم وتحقيقه اكتشافات مهمة في ميادين عديدة شعر الإنسان بالقوة، وأنه يستطيع الاستغناء عن الإله. وصدق الله العظيم إذ يقول: {كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى *أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى *}. وصار الدين هو عندهم الأغلال التي كانت تمنع الفكر من الانطلاق، والعلمانية هي التي فكته من إساره بالعلم.
وقد أراد الغرب أن يفرض خِواءَ علمانيته من الروحانيات على عالمنا الإسلاميّ الذي يمزج المادة بالروح، بينما هو يفصل المادة عن الروح، معتمداً على القياس الشموليّ، فكما اعتبر أن علمانيته باتت بديلاً صالحاً عن الدين النصرانيّ، فهي كذلك عنده بالنسبة للإسلام. نعم، الغرب طوَّر وسائل الحياةِ وأساليبها ولكنه غفل(+) عن الآخرة حتى بات لا يذكرها إلا لماماً، فصدق قول الله سبحانه وتعالى فيهم {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ *} وراح يبث أفكاره ويروّجها بين الشباب المسلم في جامعاته وعن طريق وسائل إعلامه قائلاً بالفم الملآن: ما على المسلمين إذا أرادوا النهوض إلا أن يَدَعُوا الدين الإسلاميّ جانباً، ويبعدوا تأثيره عن حياتهم، ويعتنقوا العلمانية اقتداءً بما فعله الغرب. وهذا القياس الشموليّ غير صحيح، لأن الإسلام هو الطريقُ الأمثلُ للعيش في الحياة الدنيا، والهادي إلى نعيم الآخرة بمعانيه السامية، والمتميزُ بمعالجاته الناجعة في كل أمر وشأنٍ عن بقية النظم الأخرى. والمسلمون طبقوا الإسلام على أنفسهم ودعَوْا إلى تطبيقه طيلة ثلاثة عشر قرناً، ولم يعترض على هذا التطبيق عالمٌ ولا مفكرٌ ولا جماعة، بل كان الاعتراضُ دائماً على الذين يسيئون تطبيقه، والمطالبةُ منصبَّةً على حُسن تطبيقه.
الديموقراطية والشـورى(+)
الديموقراطية هي إعطاء حق التشريع للشعب وحصره فيه، وهي تتناقض تناقضاً قطعياً مع الإسلام، لأن حق التشريع كله في الإسلام لله سبحانه وتعالى.
والشورى لا تكون للتحليل أو التحريم، بل هي لأخذ الرأي وإعطائه للوصول إلى الرأي الأصوب، أو لمعرفة رأي الناس أو الجماعة أو رأي الأكثرية في هذا الموضوع أو ذاك. وأما الحلال والحرام فلا يُعْرَض للاستفتاء، ولا يُسْتَشار فيه أحد، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله وحده، وحكم الله يُؤْخَذ من الكتاب والسنة. وإذا كان للتشاور مكان فإنه يكون لمعرفة الأصْوَب والأدق في فهم نصّ، أو في ثبوت حديث، أو في التحقق من صحة واقع معين أو فعل معيّن، وكل ذلك لمعرفة الحكم أو النصّ المتعلق به.
فالتشاور يمكن أن يكون في عملية الاستنباط أو التفريع، ولا يكون في تقرير الإذن أو المنع.
وبناءً على ذلك فالنظام الذي يجعل زواج الذكر للذكر أو الذي يجعل الإجهاض خاضعاً للاستفتاء ومن ثَمَّ للتشريع، أو الذي يشرع قوانين الخمر أو الربا، هو نظام لا يمتُّ إلى الإسلام بصلة، لأن الحكم الشرعيّ يؤخذ من الكتاب والسنة، حصراً، من الوحي، وليس من الشعب، ولا بد عند أخذه من إدراك الصلة بالله عز وجل.
وفي المقارنة، إن الشورى حكم شرعيّ من جملة أحكام الشريعة الإسلامية، بينما الديموقراطية هي مبدأ أو فكرة تعطي حق التشريع والتحليل والتحريم للشعب عن طريق الأكثرية.
الديموقراطية الرأسمالية:
وعلى هذا فإن الديمقراطية، التي تطبقها الأنظمة السياسية في العالم اليوم، هي فكرة جاء بها الغرب إلى بلاد المسلمين، ليتخذوها نظاماً للحكم، دون أن يكون للإسلام علاقة بها. بل هي تتناقض وأحكامَ الإسلام تناقضاً كاملاً في الكليات والجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الذي قامت عليه، وبالتالي فهي مناقضة للإسلام فكرة ونظاماً. لذلك فإنه يحرم على المسلمين أخذها، وتطبيقها أو الدعوة لها، تحريماً جازماً.
تعريف الديموقراطية:
الديموقراطية هي نظام حكم وضعه البشر من أجل التخلص من ظلم الحكام، وتحكّمهم بالناس باسم الدين. فهذا النظام مصدره البشر، ولا علاقة له بوحي أنزله الله العليّ الحكيم.
ويقوم تعريف الديموقراطية على أنها: «حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب». فالشعب هو السيد المطلق، وهو صاحب السيادة، يملك زمام أموره، ويمارس إرادته ويسيرها بنفسه من خلال القوانين والأنظمة التي يشرعها حكامُهُ الذين يختارهم، وكلاء عنه، بالانتخاب. وهو الذي يختار الحاكم، ويقلِّده زمام الحكم.
وحتى يكون الشعب سيّد نفسه، في شتى تلك الأمور، فقد جعل الغرب الحريات العامة التعبير الأمثل عن المبدإ الفرديّ الذي يوجب توفير هذه الحريات لكل فرد من أفراد الشعب حتى تكون السيادة فعلاً للشعب، وحتى يمكن للشعب ممارسة إرادته دون ضغط أو إكراه. وقد تمثلت هذه الحريات العامة بأربع هي:
ـ حرية الاعتقاد
ـ حرية الرأي
ـ حرية التملك
ـ الحرية الشخصية
ومن المبادىء الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية «فصل الدين عن الدولة». وأساس هذا المبدإ، الذي صار فيما بعد، عقيدة الرأسمالية، أو عقيدة الحل الوسط المائعة، هو ما تمخَّض عنه الصراع في أوروبا إبان القرنين الماضيين.
فمن ناحية كان يسود أوروبا الحكم القائم على الحق الإلهيّ، الذي كان يمارسه الملوك والأباطرة بصورة مطلقة لاعتقادهم أنهم يستمدون سلطتهم من الله، ولهم بمقتضى الصلاحية المطلقة المفوضة لهم من الله حق تقرير ما يريدون دون محاسبة من أحد، فهم يملكون سلطة التشريع، والقضاء، والأمن، والإدارة... والشعب هو رعية لهم، يخضع للحكام خضوع العبد للسيد، وعليه الطاعة والتنفيذ..
ومن ناحية ثانية قام الفلاسفة والمفكرون يدعون إلى إلغاء الأنظمة القائمة على الحق الإلهيّ، وإسقاط الملكيات والأمبراطوريات واستبدالها بأنظمة حكم جديدة تقوم على جعل التشريع والسلطة للشعب، لأنه هو سيد نفسه، وهو مالك إرادته التي يسيِّرها، وليس عبداً يُسيَّر بإرادة غيره. كما تقوم على فصل الدين عن الحياة، باعتباره مصدراً لحكم الاستبداد، والظلم، والجور والفساد. فكان منهم من أنكر وجود الدين مطلقاً، ومنهم من اعترف به، ولكنه نادى بفصله عن الحياة، وبالتالي عن الدولة والحكم.
وقد انجلى ذلك الصراع الذي أدى إلى ثورات دامية أزهقت الأرواح وأهلكت الممتلكات عن فكرة الحل الوسط، فكرة فصل الدين عن الحياة، وتعمقت هذه الفكرة في النفوس حتى صارت العقيدةَ التي قامت عليها الديموقراطية الرأسمالية. وعلى أساسها عالج الغرب جميع مشاكله في الحياة.
ومن هنا كان انبثاق النظام الديموقراطيّ عن فكرة فصل الدين عن الحياة، ثم صارت هذه الفكرة بمثابة العقيدة والقاعدة الكلية التي تبنى عليها جميع مفاهيم الديموقراطية.
وأهم النظريات التي تقوم عليها الديموقراطية:
أ ـ السيادة للشعب.
ب ـ الشعب هو مصدر السلطات.
وبذلك صار الشعب هو المشرع باعتباره صاحب السيادة، وصار الشعب هو المنفذ باعتباره مصدر السلطات.
وتحقيق هاتين النظريتين يقوم على حكم الأكثرية. فأعضاء الهيئات التشريعية يُختارون بأكثرية أصوات المقترعين من الشعب. وجميع القرارات المتعلقة بسن القوانين، ومنح الحكومات الثقة ونزعها عنها تُتخذ بالأكثرية في المجالس النيابية. وكذلك الأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، وجميع قرارات المجالس والمؤسسات والهيئات الحكومية فإنها أيضاً تُتخذ بالأكثرية.
ومن هنا كانت الأكثرية هي السمة البارزة في النظام الديمقراطيّ. وكان رأي الأكثرية هو المعيار الحقيقيّ المعبر عن رأي الشعب حسب وجهة نظر الديمقراطية الرأسمالية. ومن هذا البيان الموجز للديموقراطية نتبيَّن باختصار الأمور التالية:
1 ـ إن الديموقراطية هي من وضع عقول البشر، ولا تستند إلى وحي من الله تعالى، أو إلى رسالة سماوية أو كتاب سماويّ، بل هي مجافية لدين الله تعالى إلى عباده.
2 ـ إن الديموقراطية كانت نتيجة الاعتقاد بفصل الدين عن الحياة، وبالتالي أدت إلى فصل الدين عن الدولة.
3 ـ إنها ترتكز على نظريّتَيْ: السيادة للشعب، والشعب مصدر السلطات.
4 ـ إنها حكم الأكثرية، واختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية يتم بأكثرية أصوات المقترعين، وجميع القرارات تُتخذ بأكثرية الآراء.
5 ـ إنها تجعل الحريات الأربع أساساً لسيادة المبدإ الفرديّ. بحيث يجب توافر هذه الحريات لكل فرد ليتمكن من ممارسة إرادته، وبالتالي ممارسة سيادته في اختيار ممثليه وحكامه وقوانينه وأنظمته.
مساوىء الديموقراطية:
وقبل أن نبين مناقضةَ الديموقراطية للإسلام، وحكمَ الشرع في الأخذ بها أو تحريمها، لا بد من إظهار مساوىء هذه الديموقراطية حتى بالنسبة إليها هي، كأصلٍ لنظامٍ يُحكم العالم به، أو بالنسبة للشعوب المحكومة بها.
وأهم هذه المساوىء:
1 ـ أنها مبنية على التضليل والخداع، وهي غير قابلة للتطبيق، بل ولم تطبق في أعرق الدول ادعاءً بالديموقراطية. فهي في الواقع تعني اجتماع الشعب كله في مجلس واحد، واتخاذ قراراته، وهو ما لم يحصل قط، حتى في عهد الإغريق الذين اخترعوا فكرة الديموقراطية كان هناك تمييزٌ ـ في اتخاذ القررات ـ بين المواطنين الإغريق والأرقاء والعبيد والغرباء. وتعاقبت تطبيقات الديموقراطية على مثل هذا التمايز، فلم تُعطَ النساء في أوروبا حق التصويت إلا في القرن العشرين. فكيف الحال في القرون السابقة.
فالبرلمان الذي يجسد الإرادة العامة للشعب يُنتخب أحياناً من أقلية منه وليس من الأكثرية. ذلك أن مركز العضو الواحد في البرلمان يجري الترشيح له من قِبَلِ عدة أشخاص، فتتوزع أصوات المقترعين ـ الذين لا تتعدى نسبتهم في أقصى الاحتمالات 80% ـ في الدائرة على عدد المرشحين، وبالتالي فإن من يفوز يكون قد حصل على أصوات نسبة قليلة من المقترعين، وليس على أصوات الأكثرية، أي بمعنى أن التفويض قد جاء من الأقلية الشعبية وليس من الأكثرية(+).
وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الدولة، سواء جرى انتخابه من الشعب مباشرة، أم من قبل أعضاء البرلمان.
هذا فضلاً عن أن رؤساء الدول وأعضاء البرلمانات، ورؤساء الحكومات وأعضاءها، يمثلون أصحاب رؤوس الأموال الذين يدفعون المبالغ الطائلة لإيصالهم إلى الحكم، لكي يعمل هؤلاء الحكام بدورهم على تأمين مصالح الذين موّلوهم. وهذا معروف في غالبية الدول الرأسمالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا التي يمثل حزب المحافظين فيها كبار الرأسماليين من رجال الأعمال والملاك، وطبقة اللوردات الارستقراطيين. ولا يأتي حزب العمال إلى الحكم إلا عند حصول حالة سياسية تستدعي إبعاد المحافظين.
2 ـ القول إن الحاكم، أوالحكومة ـ أو السلطة التنفيذية ـ مسؤولة أمام البرلمان الذي يجسِّد الإرادة العامة للشعب، وأنه لا تتخذ القرارات الكبرى إلا بعد موافقة أكثرية أعضاء الحكومة، هو قول مغاير للواقع. ومن الأمثلة على ذلك إيدن (رئيس وزراء بريطانيا) الذي أعلن حرب السويس على مصر دون أن يعلم لا البرلمان، ولا حتى وزراء حكومته، إلا بعضاً منهم. ودالس (وزير خارجية أميركا) الذي طلب منه الكونغرس أيام حرب السويس، ملف السد العالي والأسباب التي أدت إلى سحب العرض بتمويله، فرفض أن يسلم الملف إلى الكونغرس. وديغول الذي خوَّله دستور الجمهورية الخامسة سلطات استثنائية واسعة، تمكنه من اتخاذ القرارات الكبرى قبل الرجوع إلى البرلمان، وكما حصل أخيراً في ضَرْب العراق، فإن أميركا وبريطانيا لم ترجعا إلى مجلس الأمن لأخذ الموافقة، مع أن هيئة الأمم تعتبر أكبر صرح للديمقراطية في العالم؛ وقِسْ على ذلك. وحتى في أكثر البلدان المتخلفة التي تدعي أنها تطبق الديموقراطية فإن حكامها يتخذون القرارات المهمة والخطرة دون أن يدري بها مجلس النواب، ولا الوزراء في أغلب الأحيان.
3 ـ فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات فإنَّ الحكومة هي التي تضعها وتقدمها على شكل مشاريع قوانين للبرلمان أو على شكل اقتراحات قوانين يقدمها بعض أعضاء البرلمان الذي يصدرها، بعد دراسة اللجان المختصة، بالأكثرية من أعضائه الحاضرين في الجلسة. وهم عادة لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من الإرادة الشعبية، ناهيك أن الذين يصوتون على هذه القوانين قليلاً ما يعرفون واقعها، لأنها ليست من اختصاصاتهم.
لذلك فإن القول بأن التشريعات في البلاد الديموقراطية تعبر عن الإرادة العامة للشعب هو قول يخالف الحقيقة والواقع.
4 ـ إن البلد الديموقراطيّ الذي لا يوجد فيه أحزاب كبيرة قادرة على أن تحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، غالباً ما يقع في أزمات سياسية نتيجة لاختلاف التكتلات البرلمانية، وما يجر إليه هذا الاختلاف من تأخير في تشكيل الحكومة، أو تأليف حكومة غير متجانسة، مما ينعكس بالتالي على الأوضاع العامة من عدم استقرار سياسيّ، وأزمات اقتصادية، ومشاكل عمالية ونقابية إلخ... بل وغالباً ما تتحكم الأحزاب الصغيرة في تشكيل الحكومة التي تشارك فيها مما يجعل الحكم قائماً على رأي الأقلية وليس على رأي الأكثرية.
5 ـ أما أهم المثالب والمساوىء التي تقود النظام الديموقراطي فهي فكرة الحريات المطلقة:
5 ـ 1 ـ فمن ناحية حرية التملك، وكون المنفعة هي مقياس الأعمال، وكون المبادرة الفردية هي أساس النظام الاقتصاديّ الحر، فقد ترتب على ذلك وجود الرساميل الضخمة، والاحتكارات في أيدي فئة معينة من رجال الأعمال الذين يحتكرون معظم الثروة العامة، ويتركون لمعظم الشعب أن يتخبط في مشاكله وأن يتعب ويشقى حتى يؤمن لقمة العيش، أو المظهراللائق من العيش أو أن يعيش عاطلاً عن العمل، بلا مورد رزق يقيم أودَ عياله(+).
والرأسمالية كما هي بحاجة إلى المواد الخام لتشغيل مصانعها، فإنها بحاجة إلى أسواق استهلاكية لتصريف منتجاتها، وهذا ما جعل الدول الرأسمالية تتنافس على استعمار البلاد المتخلفة، وتستغلُّ مواردها وثرواتها الطبيعية، وتتحكَّم بلقمة العيش لشعوبها مما يتنافى وشتى القيم الخلقية والإنسانية. ناهيك عن الحروب العسكرية، والانقلابات والفتن التي تثيرها الدول الكبرى في مناطق شتى من العالم كي تبقى قادرة على تصريف صناعاتها العسكرية التي تدر عليها الأموال الطائلة.
وكم هو مثير للسخرية تبجُّحُ الدول الديموقراطية، ولاسيما الكبرى منها، بالأخلاق، وبالحفاظ على حقوق الإنسان، وهي ـ في الحقيقة ـ التي تهدر الأخلاق والقيم، وتهدر حقوق الإنسان بل ودماء الناس. والأمثلة لا تعد ولا تحصى: فلسطين، البوسنة، أفريقيا السوداء، أميركا اللاتينية، جنوب شرقي آسيا. وأحداثها شواهد على وقاحة تلك الدول الكبرى في ادعائها الحفاظ على تلك القيم وهي عدّوها اللدود.
5 ـ 2 ـ ومن ناحية الحرية الشخصية فإنها أوصلت المجتمعات في الدول الديموقراطية إلى مجموعات من الناس منحطة خلقياً، لما يسودها من الإباحية، ومن ركضٍ وراء المتع الرخيصة والأهواء المبتذلة فصدق فيها قول الله تعالى:{أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً *أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً *} ولذلك أصبحت مظاهر الإباحية والخلاعة من أنماط الحياة العادية في المجتمعات الديموقراطية، وخاصة في الغرب، حيث ترى:
ـ تبادل القبل والضم والعناق في الشوارع، وفي الحدائق العامة، والحافلات، والأتوبيسات وفي أي مكان، دونما خجل من أحد.
ـ تعرّي النساء، فهن يستلقين تحت الشمس عاريات تماماً سواء أكان في حدائق البيوت أم على شرفاتها، أو على الشواطىء. والمحتشمة منهنَّ قد تضع ورقة التوت التي تغطي السوأة.
ـ أفلام الجنس العاهر للمتاجرة وكسب الأموال، سواء على الشاشات الكبيرة، أم على شاشات التلفزة.
ـ استعمال المرأة سلعة إما للدعارة وإما للإعلان.
ـ الممارسة الجنسية الشاذة، فكثرت اللواطة بين الذكور، والسحاق بين الإناث، وتعاطي الجنس مع البهائم والحيوانات، وممارسة الجنس الجماعية بين عدة أشخاص معاً وبالتبادل مع بعضهم البعض.. إلى آخر ما هنالك مما لم تشهده حظائر البهائم.
وقد نشرت إحصائية قديمة في إحدى الصحف الأميركية تبين أن هنالك 25 مليون شاذ في أميركا يطالبون بالاعتراف بشرعية الزواج بينهم. ونُشرت إحصائية أخرى تبين أن مليون شخص في أميركا يمارسون الجنس مع أرحامهم من الأمهات والبنات والأخوات.
وقد نتج عن هذه الإباحية انتشارُ الأمراض الجنسية وأشدها فتكاً «الأيدز». كما نتج عنها أبناء الزنى، ومثاله ما نشرته إحدى الصحف من أن نسبة 75% من الإنجليز هم أبناء سفاح.
ـ تفسّخ الأسرة في المجتمعات الديموقراطية، وفقدان التراحم والتواصل بين الآباء والأبناء. ولذلك فإن الظاهرة البارزة عند المتقدمين في السن تربية الحيوانات من القطط، والكلاب خاصة، ومشاركتها في المسكن والمأكل والنوم، لتكون عوضاً عن الأبناء، ومؤنساً في الوحدة.
وأغرب ما في ظاهرة التهتك والتبذل والانحراف في الدول الديموقراطية إصدار التشريعات التي تبيح الزواج من الشاذين جنسياً بحيث يتزوج الرجل رجلاً مثله، وتتزوج المرأة امرأة مثلها..
5 ـ 3 ـ وأما من ناحية حرية العقيدة فحدث ولا حرج، إذ سيطرت الأفكار المادية البحتة على العقول والنفوس، واستشرى الإلحاد، واعتناق العبادات الوثنية بما فيها عبادة الشيطان، وما تجرّ إليه هذه العبادات من الكفر، والشرك، وإباحة كل شيء دون أدنى اعتبار لحلال أو حرام..
5 ـ 4 ـ وأما من ناحية حرية الرأي فقد باتت طبولاً جوفاء لا أكثر ولا أقل، تطغى عليها المؤسسات الإعلامية الموجِّهة، والقادرة على تسيير الرأي العام كما تشاء، حيث بإمكانها تضليل الناس، وسلب إرادتهم، والطغيان على عقولهم ومشاعرهم فينقادون وراء ما تبثُّه وسائل الإعلام دونما تمييز أو تمحيص..
تلك هي بعض النماذج عن المساوىء التي تغرق فيها المجتمعات الديموقراطية، وخاصة في الغرب، والتي تدل بذاتها على فساد الديموقراطية التي يتغنّون بها..
تأثير الديموقراطية على بلاد المسلمين:
وعلى الرغم من كل مظاهر الفساد والفسق والفجور التي أفرزتها الديموقراطية كنظامٍ للحكم، ومن التضليل الذي أشاعته بأن الشعب هو سيد نفسه، وبرلماناته هي وكيلة عنه في هذه السيادة، وعلى الرغم من الويلات والكوارث وإهدار الحقوق التي تسببت بها الدول الديموقراطية للشعوب المتخلفة، وعلى الرغم من أن الديموقراطية فكرة مكذوبة وغير قابلة للتطبيق في الواقع...
أجل على الرغم من ذلك كله، فقد استطاع الغرب أن يوجد لأفكاره الديموقراطية تلك من يؤمن بها من المسلمين..
أما كيف؟ فذلك أن دول الغرب ـ وأوروبا بالذات قبل ظهور أميركا قوة عظمى ـ قد أدركت أن الإسلام عقيدةً ومنهجاً هو سر قوة المسلمين، فوضعت خطة تقوم على غزو العالم الإسلاميّ غزواً تبشيرياً، وغزواً ثقافياً يكون من شأنهما حملُ المسلمين على الاقتناع بالثقافة الغربية، والأفكار الديموقراطية فيتخذونها مصدراً لتفكيرهم وتعبيراً عن وجهة نظرهم في الحياة، وبذلك يتم إبعادهم عن إسلامهم، وعن التقيد بتعاليمه، والالتزام بتطبيق أحكامه. أما الأسلوب الذي اعتمدته فيقوم على ما يلي:
ـ الحط من شأن الإسلام، وتشويه أحكامه، وإفهام المسلمين أنه سبب تأخرهم وانحطاطهم في الوقت الذي تمجّد فيه الديموقراطية، والحضارة الغربية، ويُعمل على إبراز علو شأنهما في كل شيء.
ـ التضليل بإيهام المسلمين أن حضارة الغرب لا تناقض حضارة الإسلام، بل تأخذ منها، وأن قوانينها وأنظمتها لا تخالف أحكام الإسلام ولكن جرت قوننتها بشكل عصريّ..
ـ القول بأن الشورى في الإسلام لا تعني إلا الديموقراطية بعينها، وأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام هي القواعد الأساسية في النظام الديموقراطيّ مثلها في النظام الإسلاميّ..
وقد أدى الغزو التبشيريّ والثقافيّ وأساليبهما إلى التأثير في المسلمين تأثيراً كبيراً، فأخذوا الأفكار الغربية، وصنعوا لها قوالب لسن قوانينهم وأنظمتهم ولا سيما بعد القضاء على دولة الخلافة في تركيا، حيث ظهر هذا التأثير على الفئة المثقفة، ورجال السياسة، وعلى حملة الثقافة الإسلامية، بل وعلى بعض حملة الدعوة الإسلامية أنفسهم... وبالتالي على جمهرة المسلمين.
أما الفئة المثقفة، وسواء من درسوا في الغرب، أو في بلاد المسلمين، فإنهم تأثروا بالثقافة الغربية، خاصة وأن مناهج التعليم قد وضعت، بعد الحرب العالمية الأولى، على أساس فلسفة الغرب وأفكاره، ووجهة نظره إلى الحياة. وكل ذلك من جراء استمراء كثير من المثقفين هذه المناهج وتلك الثقافة، حتى وصل بهم الحال لأن يستنكروا الثقافة الإسلامية وأحكام الإسلام كلما تناقضت مع ما أتى به الغرب. بل إنَّ فئة من هؤلاء المثقفين ـ ويا للأسف ـ مقتت الإسلام كما يمقته الغربيّ، وحملت العداء لكل ما يمت إلى إسلامها بصلة، حتى صارت أبواق دعاية للغرب، وأبواق مهاجمة للإسلام.
أما معظم رجال السياسة فقد أخلصوا بدورهم للغرب وأنظمته، وربطوا أنفسهم به، فصاروا يتكلون عليه في إدارة شؤون بلادهم، وبما يوحيه إليهم من السياسات، والمخططات والتوجيهات، بل ويتعهدون له بتنفيذ أوامره ومؤامراته. وبذلك ناصبوا الله ورسوله العداء، فكانوا حرباً على الإسلام السياسيّ، وعلى حملة دعوته المخلصين.
وإن عدم إدراك كثير من المسلمين حقيقة الأحكام الشرعية، وعدم وعيهم ما في واقع حضارة الغرب وأفكاره وأنظمته المنبثقة عن النظام الديموقراطيّ الرأسماليّ من تباين مع تعاليم ومفاهيم وأحكام دينهم، قد جعلهم ذلك كله يتغنّون بالديموقراطية، كما ظهر على ألسنة الحزبيّين الإسلاميين في انتخابات المجالس النيابية والبلدية في بلدان عديدة من العالم الإسلاميّ، وهم يتحاورون مع الناس على أساس المفاهيم الديموقراطية، والأساليب الديموقراطية. والعلة، حقيقةً، ليست في حملة الثقافة الإسلامية، بقدر ما هي في الأجواء الثقافية المسيطرة في البلاد الإسلامية، حيث طرأ على أذهان المسلمين ضعف شديد في فهم الإسلام وأحكامه، وفي تطبيقها على المجتمع. وهكذا شاع الخطأ في فهم الشريعة، وفي تفسير المفاهيم والمعاني التي تنبثق عن الإسلام بما لا تحتمل نصوصه، وصارت أحكامه تؤوَّل بما يتفق مع الواقع، بدلاً من تغيير هذا الواقع بما يتوافق وأحكام الإسلام. فأخذوا بأحكام لا سند لها من الشرع، أو كان لها سند ضعيف، بحجة القاعدة الخاطئة التي وضعوها: «لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغير الزمان». وكان من مقولاتهم: إن النظام الديموقراطيّ في الحكم، والنظام الرأسماليّ في الاقتصاد لا يناقضان أحكام الإسلام. وإن الديموقراطية من الإسلام. وإن الحريات العامة من الإسلام... وبذلك التبس عليهم ما يجوز لهم أخذه من العلوم والمعارف التي لا تخالف الإسلام، وما لا يجوز لهم أخذه في كل ما يتعلق بالعقيدة، وبالأحكام الشرعية على أساس أن القاعدة في ذلك تقوم على: الأخذ بما آتاه الرسول (ص) من كتاب وسنة، وما دلّ عليهما الكتاب والسنة.
ما يجوز للمسلمين أخذه مما عند غيرهم وما لا يجوز أخذه
1 ـ إن جميع الأفعال التي تصدر من الإنسان، وجميع الأشياء التي تتعلق بها أفعال الإنسان، الأصلُ فيها، كما يدل عليه عموم آيات الأحكام، وجوبُ الرجوع إلى الشرع، ووجوبُ التقيد بأحكام الشرع، أي اتباع الرسول (ص) والتقيد بأحكام رسالته. والأدلة على ذلك:
قول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، وقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، وقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.
قال رسول الله (ص) : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»(+) أو «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»، رواهما البخاري ومسلم.
فالأصل إذن في الأفعال والأشياء وجوب اتباع الشرع والتقيد به. فلا يجوز لمسلم أن يقدم على فعل شيء، أو تركه إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه: أهو واجب أو مندوب فيقدم على القيام به. أم هو حرام أو مكروه فيقدم على تركه. أم هو مباح فيكون مخيِّراً فيه بين الفعل والترك.
هذا بالنسبة للأفعال.
أما بالنسبة للأشياء التي هي من متعلقات أفعال الإنسان، فإن الأصل فيها هو الإباحة، ما لم يرد دليل التحريم. فالنصوص الشرعية جاءت عامة وتشمل إباحة جميع الأشياء وذلك لقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ}، ومعنى التسخير هو إباحة كل ما في السماوات وما في الأرض للإنسان. وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا}، وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}.
وعموم الآيات يدل على إباحة جميع الأشياء. فإذا حُرّم شيء فلا بد من نصٍّ مخصصٍ لهذا العموم، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}.
ومن هنا: كان الأصل في الأفعال التقيد.
وكان الأصل في الأشياء الإباحة.
2 ـ الشريعة الإسلامية كاملة، حاوية لأحكام الوقائع الماضية كلها، والمشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن أن تحدث بأكملها. فلكل شيء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل حكم في الشريعة، قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ *}. وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}.
فالشريعة الإسلامية لم تهمل شيئاً من أفعال العباد مهما كان. فهي إما أن تنصب دليلاً للفعل في القرآن والحديث، وإما أن تضع أمارة في القرآن والحديث تدل على الفعل لعموم قوله تعالى: {تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} وللنص الصريح {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}.
أ ـ ما يجوز أخذه:
إن جميع الأفكار المتعلقة بالعلوم والاختراعات والصناعات، وجميع الأشكال المدنية الناتجة عنها التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالأحكام الشرعية، إنما هي من الأشياء المباحة التي يستخدمها الإنسان في شؤون حياته. ودليل ذلك الآيات العامة الواردة في إباحة الانتفاع بجميع الأشياء الموجودة في السماوات، وفي الأرض.
وروى مسلم أن النبيّ (ص) قال: «إنما أنا بشر مثلكم، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر».
ولما ورد في حديث تأبير النخل من قوله (ص) : «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(+).
ولإرساله (ص) بعض الصحابة إلى جُرَش اليمن لتعلم صناعة السلاح.
وعلى ذلك فإنه يجوز أخذ جميع العلوم المتعلقة بالطب والهندسة والرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء والزراعة والصناعة والاتصالات وعلوم البحار والجغرافيا وعلم الاقتصاد (الذي يبحث في الانتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينها، لأنه علم عالميّ) فكلها يجوز أخذها ما دامت لا تخالف الشريعة. أما إذا خالفتها فقد امتنع أخذها من أي مصدر كان بل ويمكن اعتبار هذا الأخذ نوعاً من الحرام. ولذا فإن نظرية داروين مثلاً التي تقول: «إن أصل الإنسان قرد» لا يجوز أخذها لأنها تخالف الشريعة في قوله تعالى: {خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ *}، وقوله تعالى: {وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ *}، وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ}.
وكما يجوز أخذ الأفكار والعلوم كما أشرنا إليه فإنه يجوز أخذ منتجاتها، وأشكالها المدنية، فيجوز مثلاً: أخذ المصانع بجميع أنواعها وصناعاتها عسكرية كانت، أو غير عسكرية، من الرصاصة إلى الطائرة فالدبابة فالصاروخ، والقنابل الذرية والهيدروجينية والالكترونية والكيمياوية، والجرارات والشاحنات والقطارات والبواخر.. وآلات المختبرات، والآلات الطبية، والزراعية، والأثاث، والسلع الاستهلاكية..
إذن فيجوز أخذ كل شيء من ذلك إلاَّ ما حرَّم الشرع مثل مصانع الخمر ومنتوجاتها، والتماثيل وما شابه لوجود النص الشرعيّ على تحريمها..
ب ـ ما لا يجوز أخذه:
إن الأفكار المتعلقة بالعقيدة، والأحكام الشرعية، والأفكار المتعلقة بحضارة الإسلام، ووجهة النظر في الحياة، والأحكام التي تعالج مشاكل الإنسان.. إنَّ هذه لا يجوز أن تؤخذ إلا من الشريعة الإسلامية حصراً، أي مما جاء به الوحيُ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وما أرشدنا إليه الكتاب والسنة. فلا يجوز أن تؤخذ إلاَّ من هذه المصادر حصراً دون أي مجال لمصادر غيرها ولا في حال من الأحوال.
وذلك:
ب 1 ـ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ كل ما آتانا به الرسول وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فـ«ما» في الآية من صيغ العموم. ومفهوم الآية أن لا نأخذ من غير ما آتانا به الرسول (ص) .
ب 2 ـ أن الله سبحانه وتعالى منع على المسلمين أخذ أي شيء من غير الشريعة الإسلامية حيث قال عز وجل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *}.
فمقارنة (ما) في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ} {وَمَا نَهَاكُمْ} مع قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ...} تظهر جلياً وجوب حصر الأخذ بما جاء به الرسول (ص) ، وإن الأخذ من غيره (ص) إثم يُعاقَب عليه فاعلُهُ وخاصة أنه سبحانه وتعالى كما حذَّر الذين يخالفون عن أمر رسول الله (ص) فإنه ـ جلت عظمته ـ قد حذر رسوله نفسه من أن يفتنه الناس عن بعض ما أنزل إليه، حيث قال تعالى: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}.
وفوق ذلك فإن القرآن المجيد قد نهى الذين آمنوا أن يتحاكموا إلى غير ما أتى به الرسول (ص) ، وخاصة تحاكمهم إلى أهل الطاغوت، بقوله العزيز الحكيم: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا *} أي يريدون أن يتحاكموا إلى من هو كثير الطغيان...
مناقضة الديموقراطية للإسلام
تناقض الديموقراطيةُ الإسلامَ مناقضة تامة في كل شيء، وخاصة بالمقومات الأساسية، وفقاً لما يلي:
أولاً ـ المصدر:
فالديموقراطية جاءت في مصدرها من الإنسان، ويُرجع فيها لإصدار الحكم على الأفعال والأشياء، بالحسن والقبح إلى العقل، فهي في الأصل من وضع الفلاسفة اليونان، ثم تابعهم الفلاسفة والمفكرون في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر الذين برزوا أثناء الصراع الرهيب بين الأباطرة والملوك في جانب، وبين الشعوب في جانب مواجه للتخلص من آفات ومآسي (الحكم الإلهيّ).
أما الإسلام فهو من الله تعالى أوحى به إلى جميع الأنبياء والمرسلين، وحمله في نهاية مطاف الرسالات السماوية إلى الأرض، محمد بن عبد الله، رسول الله (ص) إلى جميع الناس بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً. وما جاء هذا الرسول بشيء من عنده، إنما كان كله وحياً منزَّلاً لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *}. وقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ *}.
ويرجع فيه لإصدار الأحكام إلى الشرع ـ الذي أنزله الله ـ وليس إلى العقل. قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}، وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}. وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.
ثانياً ـ العقيدة:
انبثقت الديموقراطية عن نظرية فصل الدين عن الحياة، وبالتالي فصل الدين عن الدولة، فكانت عقيدة الحل الوسط بين رجال الدين النصارى ـ وعلى رأسهم مركز الباباوية ـ الذين كانوا ينازعون الأباطرة والملوك على الحكم. ثم كانت النظريات الفلسفية والأفكار التي تدعو إلى التحرر من العبودية، وظلم الحكام وجورهم واستغلالهم لشعوبهم. وهذه النظريات هي التي أقامت الثورات التي أطاحت بالحكم الاستبداديّ، ونزعت سلطة الحكام وسلطة الكنيسة عن الشعب على حد سواء.
وتعتبر الديموقراطية عقيدة الحل الوسط لأنها لم تنكر الدين نهائياً، بل أعطت للكنيسة دورها في مجال العبادات وبعض الأحوال الشخصية فقط، وألغت بالمقابل دور الدين في معترك الحياة، وتسيير شؤون الحكم والدولة. فكانت الديموقراطية هي القاعدة الفكرية لهذه العقيدة وعنها انبثقت جميع النظم في الغرب عندما حدَّدت اتجاهاتها الفكرية، ووجهة نظرها في الحياة على أساسها.
أما الإسلام فهو بذاته عقيدة، وهي عقيدة التوحيد، وعقيدة الإيمان بما أنزل الله تعالى من الأحكام الشرعية، ومن الأوامر والنواهي التي لا يجوز بدونها تسيير شؤون الحياة وشؤون الدولة، فيكون كل نظام منبثقاً عن هذه العقيدة، ولا يملك الإنسان أن يضع نظامه، وإنما عليه أن يسير وفق النظام الذي أنزله الله العليم الحكيم.
ثالثاً ـ الأساس في السيادة والسلطات:
في الديموقراطية السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، لأنه وحده يملك إرادته، أي الإرادة العامة لجماهير الشعب، الذي يختار سلطاته لتحكم باسمه، وتشرع لمصلحته. وتتوزع هذه السلطات بين ثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتقوم هذه السلطات على مبدإ الفصل فيما بينها في الوظائف والصلاحيات، وعلى مبدإ التعاون في تسيير الشؤون العامة.
وعلى هذا فإن تلك السلطات، وبحسب اختصاصاتها، يعود لها وضع الدساتير، وتشريع القوانين، وإصدار الأنظمة، كما يعود لها إلغاؤها، فيما يراه العقل من مصلحة. ولذلك وجدنا تحويلاً وتبديلاً في الأنظمة من ملكية إلى جمهورية، ومن جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية، وكذلك من ملكية إلى حكم جمهورية الحزب الواحد وعقيدته الشيوعية، أو إلى التحويلات التي جرت باسم الديموقراطية من أنظمة الحكم الليبراليّ إلى الاشتراكي، وشَرْعَنَة الأنظمة الاجتماعية التي تبيح الشذوذ، والزواج اللواطيّ أو السحاقيّ، وإباحة حرية المعتقد الدينيّ في الارتداد عن الدين إلى دين آخر، أو عن الإيمان بالله الواحد الأحد إلى الإلحاد والوثنية.
كما تملك السلطات المختصة صلاحية اتهام الحكام ومحاسبتهم وخلعهم، وتنصيب غيرهم..
أما في الإسلام فإن السيادة للشرع، والسلطان للأمة.
ـ فمن ناحية السيادة فهي للشرع وحده وليس للأمة، فالله ـ رب العباد ـ هو وحده المشرع، ولا تملك الأمة، ولو اجتمعت، أن تشرع حكماً واحداً مخالفاً للإنتظام العام. فلو أجمع المسلمون مثلاً على إباحة الربا لإنعاش الحالة الاقتصادية، أو أجمعوا على إباحة أماكن للقمار من أجل السياحة والاقتصاد، أو أجمعوا على إلغاء الملكية الفردية، أو على إلغاء فريضة الصيام (ليتمكنوا من زيادة الإنتاج)، أو أجمعوا على إباحة الحرية الاقتصادية من أجل أن ينمي الفرد ماله، بأية وسيلة ولو كانت عن طريق الحرام، أو أجمعوا على إباحة الحرية الشخصية ليتمتع الفرد في حياته كيفما يشاء من مثل شرب الخمر، واقتراف الزنى، أو أجمعوا على إباحة حرية العقيدة بحيث يرتد المسلم عن إسلامه إلى غيره... فإن هذا الإجماع لا قيمة له، ولا يساوي في الإسلام جناح بعوضة. وإذا أقدمت عليه فئة من المسلمين وجب أن تُقاتَل حتى ترجع عنه.
فما يملك المسلمون أن يعملوا عملاً يتناقض مع أحكام الإسلام، بل هم مقيدون في جميع أعمال حياتهم بأوامر الله ونواهيه. ولذلك كانت السيادة للشرع، وكان الله عز وجل هو المشرِّع، بدليل نصوص القرآن في آيات عديدة، وبدليل الأحاديث القطعية التي تبين أن السيادة للشرع، وأن أعمالنا نحن البشر في هذه الحياة يجب أن تكون متوافقة ومتطابقة مع أوامر ربنا تعالى ونواهيه. قال الله عز وجل: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}. وقال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ *}. وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *}.
ومن البداهة أنه إذا لم يكن الحكم لله فهو من البشر، وما لم تكن السيادة للشرع فهي للبشر أيضاً، وهذا ما يخالف منطوق الفطرة البشرية، ومنطوق الوجود البشريّ، لأن ما يشرعه الخالق غير ما يشرعه عباده..
ـ ومن ناحية السلطان فقد جعله الإسلام للأمة، فهي تختار الحاكم ليقوم بتنفيذ أوامر الله ونواهيه، إذ يقع على عاتقه تنفيذ الأحكام الشرعية، والأنظمة التي تتوافق مع الكتاب والسنة.
واختيار الحاكم هو أمرمن الله سبحانه وتعالى كما دلَّ عليه كتابه الكريم، وكما طبقه رسوله الأمين في البيعة التي حصلت عدة مرات في حياته، قال رسول الله (ص) : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(+) وعن عبادة بن الصامت أنه قال: «بايعنا رسول الله (ص) على السمع والطاعة في المنشط والمكره»، وأحاديث كثيرة تبين أن الأمة هي صاحبة السلطان في تنصيب الحاكم عن طريق البيعة على كتاب الله وسنة رسوله.
ولا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا أظهر الكفر البوَاح، كما ورد في قول رسول الله (ص) : «من رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرم الله، عاملاً في عباد الله بالإثم والعدوان، ولم يغيِّر عليه بقول ولا بفعل، كان على الله أن يدخله مدخله»(+). وكما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة أيضاً أنه قال: «.. فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرَةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلاَّ أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان».
والذي يملك عزل الخليفة إنما هو محكمة المظالم، وذلك عند حدوث أي أمر من الأمور وفيه مظلمة من المظالم يقتضي إزالتها. ولكن هذه المظلمة تحتاج إلى القاضي لإثباتها. وبما أن محكمة المظالم في الدولة الإسلامية هي التي تحكم بإزالة المظالم فإن إثباتها لأية مظلمة أقرها القاضي، تؤدي إلى عزله.
حكم الأكثرية
بما أن الديموقراطية تعني حكم الأكثرية: في اختيار أعضاء المجالس، وفي التشريع، وفي اختيار الحاكم، وفي اتخاذ المقررات على مختلف المستويات.. لذا كانت الأكثرية ملزمة في النظام الديموقراطيّ للجميع من حكام وغير حكام، لأن رأي الأكثرية هو المعبر عن إرادة الشعب، وما على الأقلية إلا أن تخضع وتنصاع لرأي الأكثرية.
أما في الإسلام فالأمر مختلف تماماً، ففي حالات يجوز الأخذ برأي الأكثرية، وفي حالات أخرى يجوز الأخذ برأي الأقلية لأنه الرأي الصواب. ولمعرفة متى يؤخذ برأي الأكثرية بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطأ، أو متى يجب الأخذ بالرأي الصواب دون النظر إلى كونه رأي الأكثرية أو الأقلية، فلا بد من معرفة واقع الآراء في العالم، حتى يمكن فيما بعد تطبيق الأدلة على واقع الرأي تطبيقاً تشريعياً. وعلى هذا فالآراء في العالم لا تخرج عن أربعةٍ لا خامسَ لها وهي:
1 ـ أن يكون الرأي حكماً شرعياً، أي رأياً تشريعياً.
2 ـ أن يكون تعريفاً لأمر من الأمور كأن يكون تعريفاً للحكم الشرعيّ، أو تعريفاً لواقع كتعريف العقل أو تعريف المجتمع.
3 ـ أن يكون رأياً يدل على فكر في موضوع، أو على فكر في أمر فنيّ يدركه ذوو الاختصاص.
4 ـ أن يكون رأياً يرشد إلى عمل من الأعمال للقيام به.
وفي تطبيق هذه الآراء على المفاهيم الإسلامية نجد ما يلي:
1 ـ من حيث التشريع فإن الأمر فيه لا يتوقف على رأي الأكثرية أو الأقلية، وإنما يتوقف على النصوص الشرعية، التي هي من الله ـ سبحانه وتعالى ـ وليس من الأمة، وترجَّح فيه قوة الدليل فقط.
وصاحب الصلاحية في تبني الأحكام التي تلزم لرعاية شؤون الناس، وتسيير الحكم إنما هو الخليفة وحده، فيأخذ الأحكام من النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله بناءً على الدليل الأقوى باجتهاد صحيح. وليس من الواجب على الخليفة أن يرجع لمجلس الأمة ـ أو للأكثرية ـ كي يأخذ الرأيَ فيما يريد تشريعه من أحكام، وإن كان يجوز له ذلك كما كان يفعل الخلفاء الراشدون عندما كانوا يرجعون إلى الصحابة لأخذ رأيهم عندما يريدون تبني حكمٍ من الأحكام. وإذا رجع الخليفة إلى مجلس الأمة ـ أو إلى الأكثرية ـ كي يأخذ الرأي في الأحكام التي يريد أن يتبناها، فإن رأي المجلس ـ أو رأي الأكثرية ـ لا يكون ملزماً له. فالرسول (ص) لم يرضخ لرأي الذين اعترضوا على عقد صلح الحديبية ـ وكانوا كثرة ـ ورفض رأيهم، ومضى في إتمام العقد، وقال لهم: «إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيِّعني».
والصحابة الكرام قد أجمعوا على أن للإمام أن يتبنَّى أحكاماً معينة مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله، ويأمر بالعمل بها، وعلى المسلمين طاعته، وعدم العمل بآرائهم الخاصة بشأنها. ومن ذلك استنطبت القواعد المشهورة:
«أمر الإمام يرفع الخلاف».
«أمر الإمام نافذ ظاهراً وباطناً».
«للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يَحدُث من مشكلات».
وأما طاعة المسلمين للإمام فهي أمر من الله تعالى، لقوله العزيز: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}. وأولوا الأمر: هم الحكام.
2 ـ ومن حيث تعريف أمرٍ من الأمور، فإن التعريف إذا كان جامعاً مانعاً، أي محيطاً بكل شيء، بحيث لا يستطيع أحد أن يزيد عليه شيئاً أو أن ينقص منه شيئاً، فهذا هو الذي يجب أن يؤخذ من أية جهة أتى، لأنه وصف للواقع.
3 ـ ومن حيث الرأي الذي يدل على فكرٍ في موضوع فإنه يرجَّح فيه جانب الصواب، مثل مسألة النهضة: أتكون بالرقيّ الفكريّ أو الاقتصاديّ؟ أو مثل اتخاذ قرار في موقف معين، فينظر فيه إلى الوضع الداخليّ والوضع الدوليّ وما إذا كانا مؤاتيين لاتخاذ هذا القرار وما يتطلبه من عمل سياسيّ أو عسكريّ، أو كليهما معاً.. ففي هذه الحالات يرجع إلى الرأي الصواب، لأنه مهما كان نوعه فإنه يدخل تحت قول رسول الله (ص) : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» .. وذلك عندما سأله الحباب بن المنذر حول نزول المسلمين عند أدنى ماء بدر: «يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكموه الله، فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟» فكان جوابه (ص) : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة».. ومثله الرأي الفنِّي، فإنه يرجع فيه إلى الصواب. فالرأي الذي أبداه الحباب بن المنذر في انتقال المسلمين إلى منزلٍ آخر كان رأياً صواباً لأنه ناتج عن معرفة الحباب وخبرته بالمواقع في بدر، أي كان رأياً فنياً.
4 ـ إن الرأي الذي يرشد إلى القيام بعمل من الأعمال يُرَجَّحُ فيه رأي الأكثرية، لأن الرسول (ص) نزل وكبارُ الصحابة عند رأي الأكثرية في الخروج من المدينة يوم أحد، مع أنه (ص) كان يرى خطأً في رأي الداعين إلى هذا الخروج، وهم الأكثرية.
وعلى ذلك فإن الانتخاب (كانتخاب رئيس أو عزل والٍ) أو إقرار مشروع، أو العزم على عمل معين، فإنه يرجَّح فيه رأي الأكثرية، ويكون ملزماً للحاكم، أي للخليفة، بصرف النظر عن كونه خطأ أو صواباً. وخلاصة القول: إن الرأي الذي يرجَّح فيه جانب الأكثرية هو الرأي الذي يبحث في العمل من أجل القيام به، وهو محصور في هذا النوع وحده دون غيره من أنواع الآراء الثلاثة الأخرى.
الحريـات العامـة(+)
وهذه الحريات أبرزنا مساوئها في النظام الديموقراطيّ عندما بحثنا في قالب الديموقراطية، ونبرز هنا، باختصار، مناقضتها لأحكام الإسلام بصورة تامة، وذلك:
1 ـ إن حرية التملك ـ وهي الحرية التي أنتجت النظام الاقتصاديّ الحر ـ إنما تعني أن يتملك الإنسان المال ابتداءً، أكان ينمّيه بأية وسيلة، وبأية كيفيّة، سواء باستغلال ثروات الآخرين، أم بالاحتكار والمضاربة، أم بالربا والتدليس والغش والخداع والغبن الفاحش، أم بالقمار والزنى وصناعة الخمر والمتاجرة بها، أم بالرشوة ونفع الحكام وإقامة قوى الضغط إلخ....
إنَّ الإسلام يحارب كل ذلك: فهو يحرم استغلال الفرد مثلما يحرم استغلال الشعوب وسلب ثرواتها، كما يحرم الربا سواء أكان بفوائد بسيطة أم بفوائد مركبة.
وقد حدد الإسلام أسباب تملك المال، ووسائل تنميته، وكيفية التصرف فيه، وقيَّده في ذلك بما شرع له من أحكام، ومنها تحريم تنمية المال بالسلب أو السرقة أو الرشوة، وتحريم القمار والزنى، وتحريم التدليس والغش والغبن الفاحش، وتحريم صناعة الخمر وبيعها إلخ...
2 ـ إن الحرية الشخصية إنما تقوم على أن من حق الإنسان أن يتصرف في سلوكه الشخصيّ، وفي حياته الشخصية بما يروق له من غير أن تملك الدولة أو غيرها حق الحؤول بينه وبين القيام بما يريد. ولذلك عندما طالب الناس مثلاً في بعض بلدان الغرب بسن قانون زواج الرجل بالرجل، أو المرأة بالمرأة استجابت الدولة وأصدرت القوانين اللازمة لذلك. فالحرية الشخصية تعني، إذاً، أن يتصرف الفرد كما يشاء، وفقاً لنظرته إلى المثل العليا، باعتبارها القيم التي يختارها الإنسان لنفسه. والمثل الأعلى الذي ينشده الفرد في الغرب هو تحقيق السعادة ووسيلتها الرئيسية الأخذ بأكبر نصيب من المتع الجسدية، بل هي السعادة التي تولي الفرد كامل الحرية في التصرف من أجل الحصول عليها.
أما في الإسلام فالحرية الشخصية مقيدة بأوامر الله تعالى ونواهيه، فكل ما يقوم به الإنسان من فعل أو تصرف محكوم بقاعدة الحلال والحرام، فإن كان حلالاً أقدم عليه، وإن كان حراماً امتنع عنه، وإلا عوقب عقوبة وفقاً لأحكام الحدود.
ثم إن الإسلام أمر بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، التي تصون كرامة الإنسان، وتحفظ المجتمع بالطهر والعفاف، والخوف من الله، وطلب رضوانه، والقاعدة العامة في ذلك قوله تعالى لرسوله الكريم: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ *}.
3 ـ إن حرية الرأي إنما تعني أن الفرد يملك أن يحملَ أي فكر، وأن يبديَ أي رأي، وأن يدعوَ إلى أي فكر أو رأي، وله أن يعبر عن ذلك بشتى الوسائل والأساليب، دون أن يكون للسلطات العامة أي حق في منعه من ذلك ما دام أنه لا يتعدى على حرية الآخرين. والفرد بمقتضى هذه الحرية يشارك في تقرير الحياة العامة من خلال وضع الخطط، وسن القوانين، وتعيين الحكام الذين يتولون السلطات العامة لإدارة شؤون المجتمع. وقد انبثق عن حرية الرأي ما يعرف برأي الأكثرية، أي أن ما تقرره الأكثرية هو الذي يُعمل به، سواء أكان قرارها خطأ أو صواباً، وهذا ما يعطي للديموقراطية مفهومها الشامل في بناء الحياة في الغرب على الأسس الديموقراطية وما ينبثق عنها من نظريات وأفكار وأنظمة وغير ذلك مما تقرره الأكثرية.
أما في الإسلام فالأمر مختلف. إنَّ المسلم مقيد في جميع أقواله وأفعاله بما جاءت به النصوص الشرعية التي أنزلها العليم الحكيم. ولذلك كان من حق المسلم أن يحملَ أي رأي، وأن يدليَ بأي رأي، وأن يدعوَ إلى أي رأي إذا جاءت الأدلة الشرعية بجوازه لأنها هي الحق، وإلا امتنع عليه ذلك في حال عدم الجواز، وإن فعل عوقب.
بل وقد أوجب الإسلام قول الحق، دون أي تردد أو خوف، وفي أي وقت، وفي كل مكان يقتضي الجهر فيه بالحق، وذلك لحديث عبادة بن الصامت في البيعة: «...وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم».
4 ـ إن حرية الاعتقاد إنما تعني أن يعتنق الإنسان الدين الذي يراه وأن يتخذ العقيدة الدينية التي يراها، فيعبد الله تعالى أو تكون له عبادة أخرى، كما له أن يترك دينه إلى دين آخر أو إلى الوثنية، ودون أن يكون للدولة أو غيرها حق منعه من ذلك. فالأمر سيان تجاه الدولة، أو تجاه المجتمع، لأنه لا علاقة لهما بمعتقدات الأفراد، بينما الإسلام يحرِّم على المسلم أن يتركَ عقيدته ويرتدَّ إلى دين آخر. ومن ارتدّ عن الإسلام يستتاب، فإن رجع كان به، وإن لم يرجع يُقتَل ويصادر ماله، ويفرَّق بينه وبين زوجته، قال رسول الله (ص) : «من بدَّل دينه فاقتلوه»(+).
وإذا كان المرتدون جماعة، وأصروا على ارتدادهم فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا. كما حصل في أيام أبي بكر رضي الله عنه، إذ قاتل الذين ارتدوا حتى أنهى فتنة الردة، وأعاد الأمور إلى نصابها.
وخلاصة القول: إن الحضارة الغربية التي يريدون عولمتها بحيث تصبح حضارة أمم الأرض من مسلمين وغير مسلمين لا تناسب البشرية أبداً، لأنها تفسد قيمها ومثلها الرفيعة. ومن الجهل والتضليل أن يقال للمسلمين، أو أن يعتبر بعض المسلمين أن الديموقراطية من الإسلام، لأنها هي الشورى بعينها، وأنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها محاسبة الحكام. فهذه الأمور هي في الإسلام أحكام شرعية، شرَّعها الله سبحانه وتعالى وألزم عباده العمل بها. وهي تختلف في مضامينها ومفاهيمها في الإسلام عما هي عليه في الديموقراطية، فلا يغش المسلم نفسه عندما يحاول مقارنة الأحكام الشرعية في الإسلام بالأفكار الديموقراطية..
لذلك يحرم على المسلمين اعتناق الديموقراطية، أو الدعوة إليها، أو إقامة أحزاب على أساسها، أو اتخاذها وجهة نظر في الحياة، أو تطبيقها بجعلها أساساً للدساتير والقوانين، أو مصدراً للدساتير والقوانين، أو جعلها أساساً للتعليم أو لغايته. بل يجب على المسلمين أن ينبذوها من حياتهم لأنها لا تمت إلى إسلامهم بأية صلة.
الانتخـابـات
هل الديموقراطية مطلبكم أم تقصدون سواها؟
نقول للذين يتحدثون عن الديموقراطية ويطالبون بها، أولاً: إن الديموقراطية هي فصل الدين عن الدولة، أو بعبارةٍ أخرى هي إبعاد الدين عن شؤون الحياة، والإسلام هو دين الحياة ودين الممات، فلا يمكن فصل الإسلام عن شؤون الحياة.. وثانياً: إن الداعين للإسلام، والعاملين به ـ طبعاً ـ لا يقصدون الديموقراطية بذاتها، بل هم يتوهمون أن فيها شيئاً لا يتعارض مع دينهم فيقصدونه بذاته.
وإننا نقول لمن يطالبون بالديموقراطية أو لمن يظنونها لا تتعارض ودينهم، نقول للجميع بصدقٍ وأمانة: اطلبوا ما تقصدونه وسمّوه باسمه، ولا تقولوا إذا سئلتم عن أمر: لم نقصد هذا، وإنما قصدنا ذاك... بينما تكونون في الواقع تدعون وتروِّجون لمفهوم يخالف عقيدتكم، كما هو الحال في دعوتكم وترويجكم للديموقراطية ـ ربما عن غير قَصْد ـ ولكنها مخالفة واضحة لما تعتنقونه، في الانتخابات المحلية أكْثَرْتُم من ذكر الانتخابات الديموقراطية ومن ديموقراطية الانتخابات، وأنتم تقصدون حرية الاختيار. وإنه واجبٌ على جميع الناس أن يعلموا أن فكرة الانتخابات ليست جزءاً من أنظمة الحكم الديموقراطيّ، ولا من الحكم الإسلاميّ، لأنها ليست من صميم المبادىء والأديان، ولا هي متعلقة بالحضارات والدعوات، بل هي أسلوب يُسْتَخْدَم لتحقيق أهداف المبادىء أو الأديان، أو الحضارات أو الدعوات. كما أن الانتخابات هي من الأساليب المستخدمة لاختيار شخص أو هيئة أو دولة، أو دُوَل يمثلون مَن اختارهم للقيام بأعمال تتعلق بالحكم أو الإدارة. وفكرة الانتخابات ـ أي الاختيار ـ أو فكرة التعيين وُجِدَتا كأسلوب طبيعيّ مع وجود الإنسان، وليس لأحد شرف السَّبْق في التوصُّل لأيّ منهما.
والثابت أن الحضارات المتعاقبة منذ فجر التاريخ عرفت الأسلوبين، واستخدمتهما في تطبيق أفكارها وأحكامها مع شيء من الفروقات في كيفية التطبيق كي تتماشى مع أفكار وأهداف تلك الحضارات. فمثلاً طغى على اليونانيين القدامَى الأخذ بفكرة الانتخابات كأسلوب يوصل إلى تطبيق أفكارهم، والمسلمون بدورهم أخذوا بفكرة الانتخابات كأسلوب يوصل إلى تطبيق الكتاب والسنة في حالة اختيار الخليفة مثلاً، والشيوعيون استخدموا الانتخابات كأسلوب مُوصِل إلى تطبيق القيادة الجماعيّة، بينما استخدمها الغربيون للوصول إلى الديموقراطية بالمعنى المتعارَف عليه اليوم.
ولذا فإن الانتخابات ليست حكراً على أحد، بل هي أسلوب استعمله الإنسان في جميع مراحل حياته، للتدليل على حرية الاختيار، التي هي أصلاً من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وعلى هذا الاختيار في الدنيا يتوقف مصير الإنسان في الآخرة.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢