نبذة عن حياة الكاتب
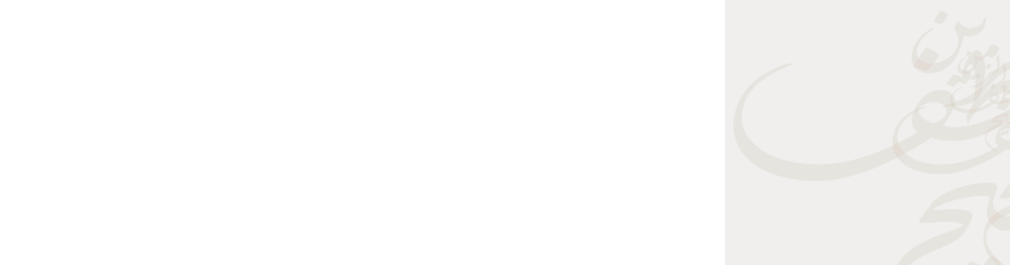
X
الأمـة والطائفة والـمذهب
تعريف الأمّة: الأمّة هي كل جماعة من الناس يجمعهم أمر واحد. وقد يكون هذا الأمر ديناً واحداً، أو زماناً واحداً أو مكاناً واحداً. وسواءٌ أَكان هذا الأمرُ الجامعُ تسخيراً - بحكمِ التواجد والانقياد - أو تخييراً - بفعلِ الإرادة والاختيار -.
وكلمة «أمّة» مأخوذةٌ من فعل «أَمَّ»، أي قَصَدَ وعَزَمَ وتقدّمَ ودَخَل.. وهذا يعني أن الأمّة - في أصلها - تنطوي على مفهوم التقدم الذي يقتضي له القصد، والعزم، بحيث تكون أبرزُ مضامينه وأبعاده: الاختيار، والحركة، والتقدم، والهدف..
وأمّةٌ جمعها أمم كما في قول الله تعالى: {وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأنعَام: 38]. والمعنى أنه مثلما أنكم، أيّها الناس، أممٌ متعدّدة، فكذلك أصنافُ الحيواناتِ التي تدبّ على هذه الأرض، وأصنافُ الطّيور التي تحلِّق بأجنحتها في الفضاء، هي أممٌ ومجتمعاتٌ مثلكم، ولكن لكل نوعٍ أو جنسٍ منها طريقة خاصة في الحياة، فَطَرَهُ عليها الخالقُ من طبيعةٍ وغريزة. ولذلك نجدُ من بينها: الناسجة كالعنكبوت، والبانية كالنحلة، والمدَّخرةَ كالنملة، والمعتمدةَ على قوت يومها كالعصفورة، كما نجد من بينها: السابحةَ في أرجاء البحار والأنهار، والسائبةَ في البراري والقفار، والجارحةَ في أعالي الجبال، والأليفة التي تعيش في كنف الإنسان إلخ... وكلّ نوع منها يشكل أمةً ذاتَ خصائصَ مميّزةٍ، تماماً كالذي أنتم عليه أيّها الناس في هذه الحياة الدنيا..
وقد وردت في القرآن الكريم معانٍ عديدةٌ للفظة «الأمة»:
يقول الله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} [البَقَرَة: 213]، أي كان الناس صنفاً واحداً في سيرهم على نفس الطريق في الكفر والضلال، فبعث الله تعالى فيهم النبيّين والمرسلين مبشرين ومنذرين.
ويقول جلَّ وعلا: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً}، أي لجعلهم على ملَّةٍ واحدة في الإيمان (بأن يكونوا جميعاً مؤمنين ولا يعرفون الكفر) ويقول تبارك اسمه: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *}. وهنا يحثُّ الله سبحانه وتعالى المؤمنين ليكون بينهم جماعةٌ تتخيَّر العلمَ والعمل الصالحَ وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبذلك تكون هذه الجماعةُ قدوةً للناس، ورائدةً لهم في طريق الإيمان والحقّ والاستقامة.. وفيما خصّ المشركين الذين لا يرغبون في ترك عبادة آبائهم يتبيّن حالهم في قول الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *} [آل عِمرَان: 104]. وهنا يحثُّ الله سبحانه وتعالى المؤمنين ليكون بينهم جماعةٌ تتخيَّر العلمَ والعمل الصالحَ وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبذلك تكون هذه الجماعةُ قدوةً للناس، ورائدةً لهم في طريق الإيمان والحقّ والاستقامة.. وفيما خصّ المشركين الذين لا يرغبون في ترك عبادة آبائهم يتبيّن حالهم في قول الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} [هُود: 118]، أي لجعلهم على ملَّةٍ واحدة في الإيمان (بأن يكونوا جميعاً مؤمنين ولا يعرفون الكفر) ويقول تبارك اسمه: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *}. وهنا يحثُّ الله سبحانه وتعالى المؤمنين ليكون بينهم جماعةٌ تتخيَّر العلمَ والعمل الصالحَ وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبذلك تكون هذه الجماعةُ قدوةً للناس، ورائدةً لهم في طريق الإيمان والحقّ والاستقامة.. وفيما خصّ المشركين الذين لا يرغبون في ترك عبادة آبائهم يتبيّن حالهم في قول الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *} [آل عِمرَان: 104]. وهنا يحثُّ الله سبحانه وتعالى المؤمنين ليكون بينهم جماعةٌ تتخيَّر العلمَ والعمل الصالحَ وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبذلك تكون هذه الجماعةُ قدوةً للناس، ورائدةً لهم في طريق الإيمان والحقّ والاستقامة.. وفيما خصّ المشركين الذين لا يرغبون في ترك عبادة آبائهم يتبيّن حالهم في قول الله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ *} [الزّخرُف: 23-24]، أي أننا مقتدون بآبائنا ومستقرُّون على عقيدتهم في عبادة الأوثان ولن نتركها.
وفي معانٍ أخرى للأمة: يقول الله عزّ وجلَّ: {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} [يُوسُف: 45]، فهنا معنى الأمة: زمنٌ معين. أي أنَّ أحد صاحبَيْ يوسف (عليه السلام) في السّجن تذكّره بعد انقضاء بضع سنوات على خروجه، وأخبرَ سيّدَه عنه بعد تلك السنين الطويلة.
ويقول تبارك وتعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} [النّحل: 120]، أي أن أبا الأنبيا إبراهيم (عليه السلام) كان يقوم مقام جماعةٍ كاملةٍ في عبادة الله تعالى، بحيث يمكنُ لكل مؤمنٍ أن يقتديَ ويأتمّ به، وبحيث يكون إماماً له في التقوى والعبادة. ومثل هذا التعبير نجده في اللغة العربية كأن تقول: فلانٌ في نفسه قبيلة وهو أمةٌ في رجل.
ويقول الله العليُّ العظيم: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَةٌ قَائِمَةٌ} [آل عِمرَان: 113]، أي ليس أهل الكتاب كلّهم متساوين في الصلاح والفساد، والخير والشر، بل إنّ منهما جماعةً مستقيمةً على طريق الإيمان، وقائمةً بالعمل الصالح والعدل وطاعة ربّ العالمين.
ومن الآيات القرآنية التي أوردنا، يتبيّن أن مفهوم الأمّة يقوم، بصورة رئيسة، على الفكرة أو العقيدة التي يجتمع عليها فريق كبير من الجماعة الواحدة.
وقد تتكوّن الأمّةُ في زمانِ ومكانٍ معيّنين، أو على مدّة من الزمن، شرطَ أن تبقى العقيدةُ ذاتُها للجماعة التي تتكوَّن منها هذه الأمة.
ونجد في المؤلفات الحديثة تعريفاتٍ عديدةً للأمّة، منها أن الأمّة جماعةٌ من الناس يعيشون في رقعةٍ جغرافيةٍ واحدة، ويكون لهم تاريخٌ مشترك، وتجمعهم أهدافٌ وآمالٌ مشتركة.
ولعلَّ أفضلَ تعريفٍ جامعٍ للأمّةِ ما يصفها بأنها كلُّ جماعةٍ تعتقدُ عقيدةً واحدةَ، وينبثقُ عن عقيدتها نظامٌ لمعالجة مختلف قضاياها وأمورها وشؤونها.
وحدة الأمة الإسلامية:
قلنا إن الأمّةَ هي الجماعةُ من الناس الذين يعتنقون عقيدةً واحدةً وينشئون منها نظامهم في الحياة. وبهذا تكون الأمّةُ الإسلاميّةُ شاملةً لكل الناس الذين أقرّوا بالإسلام واعتنقوه عقيدةً واتخذوه نظاماً، مما يعني أن كل إنسان يشهدُ «أنْ لا إله إلاّ الله وأنَّ محمداً رسولُ الله» ويقرُّ بكل شيءٍ جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وخاصّةً ما ورد فيه نصٌّ قطعيُّ الثبوت، قطعيُّ الدلالة، سواءٌ كان في العقيدة أو في الأحكام.. من يشهدُ هاتَيْن الشهادتَيْن، ويؤمنُ بهذا الإيمان، هو مسلمٌ، وهو من أبناء الأمّة الإسلاميّة، أيَّاً كان البلدُ الذي يعيش فيه هذا العالم، ولأيّ نظامٍ أرضيٍّ خضع، طالما أنَّ الجامعَ بين المسلمين هو هذا الدينُ الحنيفُ الواحدُ الذي ينضوي كلُّ مسلمٍ تحت لوائه.
ومن البديهيّ القول إن الأمّةَ الإسلاميّةَ تتألف من عدّة شعوبٍ، مختلفةِ العاداتِ والتقاليد، والنظمِ السياسيّةِ والمجتمعية، وتعيش في أوطانٍ عديدة. بل هنالك مجموعاتٌ إسلاميّةٌ يزداد عديدها، وبصورة تلقائية، يوماً بعد يوم، وتنتمي إلى شعوبٍ متفرقة، إلاّ أن ذلك لا يمنع أفرادها من انتمائهم إلى الأمّة الإسلاميّة الواحدة، التي تشكل مجموعَ المسلمين في بقاع الأرض كافة.
والاختلافُ بين أبناءِ الأمة الإسلامية في الأمور الدنيوية شيءٌ، وفي أمور دينهم شيءٌ آخر، وإن كان المطلوب وحدة الكلمة الجامعة على سائر الأمور، دينيَّاً ودنيويَّاً.. ولكن ما دامت الخلافاتُ قائمةً فعلاً - والواقع لا يجوز إنكاره - فإن ما يعنينا هو الاختلافُ في الرأي حول مضامين ديننا ومفاهيمه، وهذا الخلافُ لا يضرُّ الأمّةَ في الحقيقة، إن أُخِذَ بمعانيه التي ترمي إلى فهم الدين وجعله المنهاج في التعامل بين أفرادها وجماعاتها. فآياتُ القرآن الكريم منها ما هو قطعيُّ الدلالة ويُفهمُ منه معنًى واحدٌ فقط، ومنها ما هو ظنّيُّ الدلالة، أي حمّال أوجهٍ في التفسير والتأويل. وأحاديثُ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) منها ما اتُّفِقَ على صحته، ومنها ما اختُلِفَ على صحته أي من حيث نسبته إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه. وإن ما اتُّفِقَ على صحته نجد منه ما هو قطعيّ الدلالة، ومنه ما هو ظنّي الدلالة.
وبما أن بعضَ نصوص الكتاب أو الحديث حمّالةُ أوجهٍ، فلا بدّ من الاجتهاد. وحيث يحصلُ الاجتهاد، يحصلُ الاختلاف في الرأي. ولا بأس في ذلك، فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (+). وقد حصل الاجتهاد في أيامه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقرَّه على رغم تباين الآراء فيه. فحين رجع المسلمون من غزوة الخندق، واجتمعوا في المسجد لصلاة الظهر، أمرهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالسير لحرب بني قريظة قائلاً: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يُصليَنَّ العصر إلا في بني قريظة»(+).
وانطلق المسلمون إلى قريظة... فمنهم من وصل وصلَّى العصر هناك. ومنهم من خشي أن تغربَ الشمسُ قبل وصوله فقال: إنما قَصَدَ رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الإسراعَ، فصلّوا العصرَ قبل الوصول. ومنهم من أخذ بالأمر على ظاهره، واعتبر أن عليه أن يصلِّيَ العصرَ في قريظة، ولكنهم وصلوا بعد العشاء متأخرين عن أداء صلاة العصر، فصلّوها قضاءً بعد فريضة العشاء. ولما أدركهم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلم ما كان من الفريق الذي صلَّى قبل الوصول، والفريق الذي صلَّى العصرَ قضاءً، أقرَّهم جميعاً ولم يؤاخذْ أيَّ فريق منهم.
وحين أرسلَ رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذ بن جبل إلى اليمن سأله: «كيف تقضي يا معاذ»؟ قال: بكتاب الله. قال له: «فإن لم تجد؟» قال: فبسُنّة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال معاذ: أجتهد رأيي» فقال عندها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الحمد لله الذي وفَّق رسولَ الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»(+).
وحين يقول معاذ رضي الله عنه: «أجتهد رأيي» فهو يعني أنه يجتهد مسترشداً بالكتاب والسنة، ولا يألو بذل الجهد للوصول إلى الصواب.
والأصل، كما في القاعدة المعروفة أن «لا اجتهاد في مورد النص». أي حين يكونُ النصُّ واضحاً، وقطعي الدلالة فإن المعنى فيه يكون أيضاً واضحاً ومتعيِّناً، ولا يحتاج إلى اجتهاد. أما حين يكون النصُّ غيرَ واضحٍ، أي ظنِّي الدلالة فإن الاجتهادَ لازم.
وأما من يُعمِلُ رأيَهُ المحضَ، دون استرشادٍ بالكتاب أو السنّة، فإنَّ عمله ليس اجتهاداً، وما يتوصَّلُ إليه ليس حكماً شرعياً، بل هو حكمٌ عقليٌّ، لا يجوز العملُ به حتى يُردَّ إلى شيءٍ من الكتاب أو السنّة.
وقد وُجد في الأمة الإسلاميّة مجتهدون كثيرون، وبخاصَّة إبَّان الحكم العباسيّ، فوجدت بالتالي مذاهبُ عديدةٌ من صنع الاجتهاد، وكانت بينها اختلافاتٌ كثيرةٌ في الرأي حول الأحكام الشرعية. ولكنَّ هذا الاختلافَ، والتعدّدَ في الآراء لا يضرُّ في الحقيقة الأمَّةَ، بل هو ينفعها، لأن الاجتهاد فرضٌ عليها من الفروض الكفائيّة في كل زمانٍ ومكان. ولذا قال أحدهم: «اختلافُ الأئمة رحمةٌ للأمة».
ومن البديهيِّ أن لا يكون هذا الاختلافُ هو الخلاف الذي يقودُ إلى التفرُّق الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى بقوله الكريم: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا} وبقوله العزيز: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *}، وبقوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *} [آل عِمرَان: 105]، وبقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا} [آل عِمرَان: 103] وبقوله العزيز: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *}، وبقوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *} [آل عِمرَان: 105]، وبقوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ *} [الرُّوم: 31-32]..
فالتفرُّق المنهيُّ عنه هو هذا التفرُّقُ في الدين، وفي العقيدة، وفي المنهاج الواحد، الذي يؤدي إلى تفرقةِ وحدةِ الصف، والضعف، والتخاذل، وبالتالي إلى الانقسام جماعاتٍ، وطوائفَ، وأحزاباً متنافرةً متنابذةً، يَظُنَّ كلٌّ منها أنه وحده على الصواب..
وهذا التفرّق هو الذي قصده رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: «افترقت اليهودُ إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمّتي إلى ثلاثٍ وسبعين فرقة كلّها في النار إلاَّ فرقة واحدة» . قالوا: من هي يا رسولُ الله؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما أنا عليه وأصحابي» (+).. مما بات معه واضحاً أن كلَّ الفِرق التي تنفصل عن جسم الأمّة الإسلاميّة، وتخرج عن حدود عقيدتها ودينها، هي التي قال عنها ربُّ العالمين بأنها من المشركين الذين فرّقوا الدين، وهي الفِرق التي قال عنها رسولُ الرحمة بأنها كلها في النار. بينما الفرقة الواحدة التي تنجو من النار - بإذن الله - هي التي تتمسّكُ بشرع الإسلام، وتحافظُ على هذا الدين القيِّم، وتصونُ نفسها من المعاصي والمفاسد. إنَّها الفرقةُ التي تؤلف «الذين آمنوا وعملوا الصالحات»، وسعَوا مصلحين في الأرض، وغايتُهم إعلاءُ كلمة الله ونيلُ رضوانه ورضاه.
ومن الطبيعيّ أن تكون هي الفرقة نفسها التي تؤلف الجماعاتِ الإسلاميّة الملتزمَة بما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابُه المنتجبون لأنها الفرقةُ التي تعملُ وفق المنهج الربّانيِّ وحده، فحق أن تكون هي الفرقة الناجية.
وعليه فإن كلَّ المسلمين الذين يشهدون «أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله» ويؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بما آمن به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمؤمنون، ويعتنقون الإسلام ديناً حقّاً، ويمارسون عباداته وشعائره بإخلاصٍ لله تعالى، ولم ينكروا شيئاً من قطعيات الدين الإسلاميّ، ويتعاملون مع الناس في الحياة وفقاً لمقتضيات المنهج الإسلامي.. كل أولئك يشكّلون الفرقة التي سوف تفوز برضى الله عزَّ وجلَّ، وتكون الفرقةَ الناجيةَ من النار ـ إن شاء الله ربُّ العالمين ـ.
من هنا فإننا نربأ بهذه الأمّة الكريمةِ أن تبقى ماضيةً على ما هي عليه من التفرقة، التي ورثتها بحكم الجهل والتقليد ونرجو لها - بمذاهبها السنية الأربعة وبمذهبها الشيعيّ الإماميّ وما تفرَّع عنه - أن تلتفًّ حول مفهوم الفرقة الناجية، وبذلك ينتهي ما بين مذاهبها من تنابذٍ وتباعدٍ، وتنصهر كلّها في رحاب الدين الإسلاميّ كما أُنزل من عندالله تعالى، وكما بلَّغه رسولُه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم). وتصبح - من ثمَّ - فرقةً واحدةً تكوِّن الأمّة الإسلاميّة الواحدة التي تنعمُ برضى الله تعالى ورضى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفوزُ في الدارِ الآخرةِ من بين سائرِ الفرقِ الأخرى.. بل وتكونُ جديرة - في هذه الحياة الدنيا - بهذا الوصف الكبير الذي أطلقه الله - سبحانه ـ عليها حين قال عزَّ من قائل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عِمرَان: 110].
أما أن نقولَ بأن هذا سنيٌّ، وذاك شيعيٌّ، والآخر زَيديٌّ... فإنه قولٌ لا يُجدي فتيلاً، ولا يُغني في ميزان العمل شيئاً. بل إنَّ المعقولَ الذي لا بُدَّ منه هو أن نعودَ إلى أصالتنا كخيرِ أمّةٍ أخرجت للناس، وإلى أصالةِ ديننا كخاتم الأديان، وخيرِ الأديان، وأن نعملَ بأوامر الله تعالى، ونتنافس على طاعته وطاعةِ رسوله لنكون من عباده الصالحين.. وإنّا بذلك نؤلف - إن شاء الله - أمّة الإسلام التي تقفُ صفًّا واحداً متراصَّاً في وجه أعداء هذا الدين، وأعداءِ الله تعالى، وأعداءِ رسوله الكريم.
وإننا نستلهمُ الله تعالى فنقولُ بأنَّ أبناء المذاهب الإسلاميّةِ الذين يسيرون على الفقه السنّي، وعلى الفقه الجعفري، وعلى الفقه الزيديّ، هم جميعاً من الفرقة الناجية - إن شاء الله - ما لم يتعصَّبوا لمذاهبهم تعصّباً أعمى يُبقي على التفرقة والخلاف، وما لم يَعصوا الله تعالى ورسولَهُ العظيم، فيُحاسب الذين عَصَوْا - في ميزان العدل الإلهيّ يومَ الدِّين - على المعاصي والذنوبِ التي ارتكبوها، وليس على المذهبِ الإسلاميّ الذي انتموا إليه.
ونحن عندما نَذكرُ المذاهبَ الإسلاميّةَ - السنيّة أو الشيعيّة وحدها - ونرجو لها أن تنخرط في فوجِ الفرقةِ الناجية، فليس كلامُنا هذا على سبيل الحصر، إذ لا ندَّعي الغيبَ، ولا نزكّي أحداً عند الله تعالى، بل جُلُّ قصدنا أن نوضِّحَ ما توصَّلْنا إليه بالوعي والإدراك، وما أمكننا الاطلاع عليه، والذي أتاح لنا التمييز بين المذاهب على أساس معيارٍ واحدٍ وهو الالتزامُ بالدينِ الإسلاميِّ وتطبيقُه تطبيقاً كاملاً متوافقاً مع الكتاب والسنَّة.
أما من خرجوا عن الإسلام ديناً ودنيا، وكفروا، وكانوا من الذين أشركوا، فهم الذين يؤلفون تلك الفرقَ التي قال عنها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنها كلَّها في النار.. وهذا مع التأكيد على الفارق بين تلك الفرق الهالكة، وبين غيرها من المسلمين الذين عصَوْا وأذنبوا وحسابُهم على الله ربِّهم الذي يعلم - سبحانه - من حالهم ما لا نعلم، ولا أحد غيره - عزَّ وجلَّ - يعلم، لأنه هو علًّام الغيوب.
وبعد كل هذه التأكيدات رُبَّ قائلٍ يقول: ولكنّ هنالك بين السنّة من يكفِّر الشيعةَ، وبين الشيعةِ من يكفِّر السنةَ. بل وبعضُ السنّة يكفّر بعضُهم بعضاً، وبعضُ الشيعة يكفّر بعضهم بعضاً، فهل يبقى هؤلاء، وهؤلاء من جسم الأمة الإسلامية، ويكونون من الفرقة الناجية؟.
الواقع أنه لا يحلُّ لمسلمٍ أن يكفِّر مسلماً، ولا أن يسبَّ مسلماً أو يؤذيه. فكلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُهُ ومالُهُ وعرضُهُ. وحكمُ عدم التكفير هذا عامٌَّ ومطلق، فكيف إذا كان التكفيرُ بسبب انتماءِ المسلمِ الفقهيِّ أو المذهبيّ؟!.. فأنت أيها المسلمُ إذا آذيت مسلماً آخر - أو حتى أيَّ إنسانٍ آخر - من غير سببٍ مشروع، فإنك تكون قد أثمت، ولكن إذا كفَّرت مسلماً فهل ترتكب الإثمَ أو تقع في الكفر؟! الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)يقول: «أيّما رجلٍ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدُهما» (+).. وهنا لا بد من التوضيح: فهل قولُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا محمولٌ على الحقيقة فيرتكبُ المسلم بذلك الكفرَ، أم أنه محمولٌ على المجاز ففيه تهويلٌ لبيان عظم الذنب؟ الصحيحُ أنه قول يجب أن يحمل على المجاز ففيه تهويلٌ لبيان عظم الذنب؟ الصحيحُ أنه قول يجب أن يحمل على المجاز، وهو من قبيل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمُ من سلم المسلمون من لسانه ويده» (+)، ومفهومه ظاهريًّا أن مَن لم يسلم المسلمون من أذاه فليس بمسلمٍ. ولكنَّ الفقهاء لم يحملوا هذا القولَ على نصِّه، بل على المبالغة المجازيَّة لإظهار قوّة الذنب وشدته. ذلك أن المسلم الذي يؤذي المسلمين، هو الذي لا يُطبّقُ منهج الإسلام، في تعامله معهم، فيكون إذن مأثوماً، ولكن ليس كافراً، ما دام ينطق بالشهادتين، ويؤمن بأحقيتهما في قرارة نفسه..
وقد أخذ بعضُ الفقهاء بظاهر بعض الأحاديث المتعلقة بالقتال بين المسلمين، وقالوا: إن قتالَ المسلم ليس معصيةً كبيرة وحسب، بل هو كفرٌ صراح. ومن هؤلاء فقهاء الخوارج الذين يعتبرون الكبائرَ تكفِّر وتخرجُ من الملًّة. وقد ردَّ عليهم أميرُ المؤمنين عليٌّ (عليه السلام) بقوله: «وقد علمتم أن رسولَ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجم الزانيَ المحصن، ثم صلَّى عليه، ثم ورَّثهُ أهلَهُ. وقَتَلَ القاتِلَ وورَّثَ ميراثَهُ أهلَهُ. وقطعَ السارق، وجلَدَ الزانيَ غيرَ المحصن، ثم قَسَمَ عليهما من الفيء، ونَكَحا المسلماتِ، فأخذهم رسول الله بذنوبهم، وأقام حقَّ الله تعالى فيهم، ولم يَمْنعهم سهمهم من الإسلام، ولمُ يخْرِجْ أسماءَهم من بين أهله».
وهذا يعني أنه رغم تلك الذنوب التي ارتكبوها، فقد ظلُّوا مسلمين، ولم يكفِّرهم رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
من هنا نقول: إن قتالَ المسلمين بعضِهم بعضاً ليس كفراً، ولكنه كبيرةٌ من الكبائر التي قد تودي بأصحابها إلى النار، إنما أمرهم إلى الله تعالى، وهو خيرُ الشاهدين على فعالهم.
وقد وصف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قتال المسلمين بالكفر ليكون وصفُهُ ذا دلالةٍ على عظمِ فداحةِ هذه المعصية الكبيرة، لأن القتالَ بين المسلمين ليس من أخلاقهم بل هو من أخلاق الكفّار.
ونشير هنا إلى أن الفقهاءَ يفرِّقون بين قتال الكفّار وقتال البُغاة. ولكنَّ أمْرَ المسلمين وتكفيرهم شيءٌ آخرُ مختلفٌ تماماً، ولذلك يرى الفقهاءُ أن من يكفِّر المسلمين يرتكب كبيرةً من الكبائر وحسب..
وهؤلاء الذين يكفّرون إخواناً لهم في الدين، لأي سبب من الأسباب، يتنصَّلون من التهمة تلك عندما يقولون، وبكلّ بساطة: نحن لا نكفِّر المسلمَ، بل نكفِّر الكافِرَ بتعالِيم الإسلام.
وإلى هؤلاء نقولُ: رويدَكم!.. فقد جاء في الأثر: «إِدرأُوا الحدود بالشّبهات» ، فالمسلم الذي حكمتم بكفره، إنما اعتبرتموه مرتدّاً عن إسلامه، وجعلتموه واقعاً تحت حدِّ المرتد، وهذا غير صحيح، فالأَوْلى أن نلتمس له شبهةً لتبرئته من الحدِّ، أي من تهمة الردَّة، ولو وجدنا تسعاً وتسعين حجة ضدّه، ووجدنا حجَّةً واحدة معه، لكانت تكفي، ولأخذنا بهذه الحجة الواحدة وبرَّأناه، ثم وكلنا أمرَه إلى الله تعالى، وذلك التزاماً منا بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، «إدرأُوا الحدود بالشبهات» ، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «التمس لأخيك عذراً» (+)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إلاَّ أن تَرَوْا كفراً بَواحاً، عندكم من الله فيه برهان» (+). والبرهان هو الدليل القطعي، وليس الدليلَ الظنيّ.
ولنعدُ الآن، إلى النقطة المحوريَّة، التي تعنينا في الأصل، ألا وهي وحدةُ الأمّة الإسلاميّة، فنتساءل: إلى أي مدىً يمكن أن نعتبرَ هذه الوحدةَ قائمةً، وهذا الخلاف بين السنّة والشّيعة ما زال قائماً؟ نقولها - وبكل صراحةٍ ووضوح - إن الخلافَ الذي حصل، في فتراتٍ من التاريخ الإسلاميّ، إنما كان اختلافاً في الرأي بين الفقهاء، ثم عَمَّقَتْهُ السياسةُ، وأعوانُ السلطان والشيطان، ثم ذهب الذين اختلفوا، ولكنَّ آثارَ الاختلاف ما تزال قائمةً ولم تذهبْ حتى يومنا هذا. وهذا ما يطرح بعضَ التساؤلات:
- هل الاختلافُ في الرأي الفقهيّ هو نفس الخلافِ الذي جرَّته السياسة؟
- وهل تلك الآثارُ الباقيةُ هي من النوع الاجتهاديّ الذي لا يضرّ أم هي من النوع الذي يضرُّ بوحدة الأمّة ويوقع في الإثم؟
- وهل نحن ملزمون بآثارٍ موروثةٍ أم يمكن تلافيها والتلافي على سُبُل تقرِّبُنا إلى الله تعالى؟
الحقيقةُ أن جميعَ الفقهاء المسلمين كانوا من أخيار هذه الأمّة، وقد توصلوا إلى ما هداهم الله تعالى في تفسير الأحكام الشرعية. ولكنَّ الحكَّامَ وبطانتَهم الخبيثة استغلُّوا اختلافَ الآراءِ الفقهيّةِ ليفرقوا بين الناس، ويحقّقوا مآربهم ومصالحهم الخاصّة. ولهذا يجب أن نفرّقَ بين ما يَجمعُنا من فقهٍ إسلاميّ وبين ما تفرقنا به السياسة الخاطئة، فنتمسك بتراثنا الفقهيّ، ونَنسى كلّ آثار السياسية الماضية المفرِّقة.
ومما لا ريب فيه أن الاختلافاتِ التي تضرّ بالأمة، وتوقع في الإثم لم تعد قائمةً في حياتنا الحاضرة، لأنه ليس بيننا اليوم اختلافٌ على منصب الخلافة، ولا على تأمير هذا الوالي أو تنحية هذا القائد.. وأين هو هذا الاختلافُ على أركان ديننا وعلى الأمور الجوهريّة والأحكام الشرعيّة الأساسيّة المنزَّلة؟ بل أين هو القتال لأجل فرض الدين الإسلاميّ وتطبيقه في هذا البلد أو ذاك، ما دام كل بلدٍ يحكم نفسه وفقاً لأوضاعه وظروفه الخاصة. ولكنْ يبقى الكلُّ أمةً مسلمةً واحدة والحمد الله.. من هنا نقول بأن تلك الخلافاتِ السّياسية القديمةَ قد ولَّت وانقضت، وأما الآثار التي بقيت حتى اليوم - والتي تشكل خلافاً بين السنَّة والشّيعة - فهي ناتجة عن تنوّع الاجتهادات، وما نشأ عنها من مذاهب يجب ألاَّ تكون سبباً للخلاف على الإطلاق، ولا أن تُعتبرَ مذاهبَ مغايرةً لبعضها بعضاً.. ولعلَّ أهم ما يدعو إلى نبذِ الخلاف بين السنّة والشّيعة، أن هنالك اختلافاً بين مذاهب السنّة نفسها، واختلافاً بين مذاهب الشيعة نفسها أيضاً، أي أن الخلافَ هو بين المذاهب، وليس بين السنّة والشّيعة كما يُظن.. بل ونحن نذهب إلى أبعدَ من ذلك، فنقول: حتى لو اعتبرنا أن الخلافَ محصورٌ بين السنّة والشّيعة - مع أنه في الواقع ليس كذلك - فأيُّ ضيرٍ في ذلك إذا أخذناه بمفهومه الحقيقيّ على أنه خلافٌ على الطُّرُقِ العمليّة في تطبيق الأحكام الشرعية، ولا يستدعي ذلك اعتباره خلافاً يؤدِّي للتفرقة وإظهار العداوة بين الغالبيّة العظمى من المسلمين... فما دام للسنّة والشّيعة كتابٌ واحدٌ وصلاةٌ واحدةٌ، وزكاةٌ واحدةٌ، وحجٌ واحد - وجهادٌ واحدٌ عندما يستدعي الأمر - وما دام السنّةُ والشّيعةُ يتفقون اليومَ - والحمد لله - على معظم السنّة النبوية الشريفة، فقد بات الأمر إذن سهلاً وميسوراً لحصر حدود ما تبقى من اختلافٍ بينهم - أو حتى من خلاف - واتّباع أفضل السبل لإزالة الآثار الماضية، التي يتوهم البعض أن الزمن لا يمحوها.. وفي يقيننا أنه متى وُجدَ في الأمّة الأكفاءُ المخلصونَ، الذين يوحِّدون الرأيَ بالدليل القطعيّ على ما يزالُ مدارَ اختلافٍ حول السنّة النبويّة الشريفة، فإنه لن يبقى بعد ذلك أيُّ خلافٍ ظاهريٍّ، أو خفيٍّ - بإذن الله تعالى - وتعود حينئذٍ الوحدةُ للأمة الإسلاميّة بكامل مقوّماتها وأركانها وفعاليتها.
إننا نصارحُ المسلمين فنقول: إن المسلمين قد ورثوا الخلافاتِ الفقهيّةَ منذ زمنٍ بعيد، وإن بعضَ النفوسِ قد فُطرت على حبّ التقليد الموروث، فالسنيُّ يتعصَّب لما وجَدَ عليه أبوَيْه، والشيعيُّ يتعصَّب لما وجَد عليه أَبَوَيْه، وهذا ما عناه قولُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه» (+). وذلك يعني أنَّ النفسَ البشريةَ تميلُ إلى التأثّر بما نشأت عليه من عادات وتقاليدَ منذ الطفولة. ولكنَّ هذا التقليدَ شيءٌ، وما يدعو إليه الإسلامُ شيءٌ آخرُ. فالقرآنُ الكريمُ، وهو كتابُ جميع المسلمين، لم يتضمّنْ أيةَ أحكام تفرضُ على المسلم أن يرثَ عقيدته عن أبَوَيْه، كما يرث متجرَهُ، أو بستانه، أو سيارته أو بيتَه.. بل إن اللهَ تبارك وتعالى قد نهى عن اعتناق العقيدة بالإرثِ، أو بحكم العادة والتقليد، فقال في محكم التنزيل العزيز: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ *} وقال عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ *} [لقمَان: 21] وقال عزَّ وجلَّ: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ *} [الزّخرُف: 23-24].
إذن فالله سبحانه وتعالى يرفضُ للإنسان التقليدَ الأعمى. وقد بعث - عزَّ وجلَّ - أنبياءَهُ ورسلَهُ لينذروا الناسَ بالإقلاع عن موروث كفرهم ويدلُّوهم على الطريق المستقيم فيهتدوا إلى الإيمان الصادق، والحقائق الكلية عن طريق العقل والاسترشاد.. وما دام التقليدُ الوراثيُّ مرفوضاً فكيف الحال بالتقليد المتعصّب المذموم؟.. وها هو القرآنُ الكريم من جديد، يُلقي الحجّة على المشركين، ويدعوهم إلى إثبات عقيدتهم الموروثة وذلك بقوله تعالى: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *} [النَّمل: 64].
فهي إذن الحجّةُ البالغةُ على الإنسان... أن يعقلَ، ويُعملَ التفكيرَ حتى يقدِّمَ البرهان على ما يعتقدُ ويعمل.. فإذا كان الأمر كذلك فالأحرى بالمسلم أن يهتديَ إلى الإيمان بكتابه، وأن يهتديَ إلى الحقائق عن طريق العقل، والاقتناع، الذي يوصل إلى البرهان، لا عن طريقِ التقليد، والاكتفاءِ بما وجَدَ عليه آباءه. ونحن نُسهِّلُ على المسلم ونقولُ له بأنه يجوزُ له التقليدُ في المسائل الفقهيّة، لأنه ليس مطلوباً من كل واحدٍ من المسلمين أن يكون فقيهاً في الأحكام الشرعية، ولكن إذا كان ذلك جائزاً له، فإنه ليس بجائزٍ أن يكون مُقلِّداً في العقيدة وفي الأمور المعقولة. وهو حين يقلِّد في المسائل الفقهية، فإنه يقلِّد هذا العالِمَ، أو هذا المجتهدَ، عندما يجد في عمله أو في اجتهاده الدليلَ الذي يوصله إلى فهم الكتاب، وإلى اتّباع سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). لأن الاهتداءَ بأحكام القرآن، واتّباع سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واجبٌ على كُلِّ مسلم، مهما بدا له من أمور، لقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} [آل عِمرَان: 31] فهذا الخطابُ من الله تعالى أنَّما تنزَّل على سيّدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لكي يبلّغَ الناس ويدعوهم إلى اتّباعه. وقد قرَنَ ربُّ العالمين اتّباعَ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بحبّه - عزَّ وجلَّ - وليس هذا وحسب، فمن أحب اللهَ ربَّهُ، واتَّبعَ رسولَهُ كان ذلك سبباً لحبّ الله - تبارك وتعالى - له، ومغفرته لذنوبه، فطوبى لمن أحبَّه اللهُ العليُّ العظيم ونالَ مغفرتَهُ السنيَّة.
ونحن في تقليدنا للعلماء والمجتهدين إنما نسعى وراء الاطّلاع على الأحكام الشرعيّة كما فهمها وشرحها أولئك العلماءُ والمجتهدون المخلصون لله تعالى، وهي المعرفةُ التي توصل إلى الإلمام بحقيقة الدين.
ومن هنا كان على المسلم، أيّاً كان مذهبه - سنيّاً أو شيعيّاً - أن يعمل جهدَه لتحقيق تلك الغاية التي تُوصله إلى اتّباع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومحبّة الله تعالى وغفرانه، فيكون بذلك قد بلغ الحقَّ الذي يرتجيه، أي الحقَّ الذي يتفق مع صريح الكتاب وصحيح السنّة، وليس الحقّ الذي يتّفق مع أهوائه، لأنَّ هذا ليس حقّاً، بل هو ظنون وأوهامٌ غالباً ما تكون خاطئة. فعندما يتبع الإنسانُ هوى نفسه يقوده ذلك إلى التمسّكِ بمذهبٍ معيّن والتعصب له، دون معرفة سائر المذاهب الأخرى، واكتشاف حقيقتها. وهذا ما لا يُرضي الله تعالى ولا رسولَهُ الكريم.
والحقّ لا يمكنُ أن يقود إلى اتّباع الهوى. وإلاّ فسدت حياةُ الإنسان، بل وفسد كلُّ شيءٍ في السماوات والأرض لقوله تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} [المؤمنون: 71].
الطائفية والـمذهبيـة
تعريف الطائفة:
يقال: طاف يطوف طوفاً: إذا دار الشيء، قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البَقَرَة: 158].وقال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ *} [الحَجّ: 29].
وأطاف به: أحاط به، ألمّ به وقاربه.
والطّواف هو حركةٌ مستمرةٌ دائمةٌ حول محورٍ ثابت، كما هو الحال في الطواف حول الكعبة الشّريفة، إذ يدور حولها الطائفون بحركةٍ مستمرّةٍ طوال فترة الطواف، باعتبار أنها هي المحورُ الثابتُ لهذا الطّواف. قال تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ} [البَقَرَة: 125].
والطائفُ أيضاً هو ما يَغْشَى القلب من وسواسه بصورةٍ مستمرّة، ويكون من فعل الشيطان لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ *} [الأعرَاف: 201].
والطائفة: الجماعةُ من النّاس الذين يجمعهم رأيٌ أو مذهبٌ واحد يمتازون عن سواهم. قال تبارك وتعالى: {وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ} [آل عِمرَان: 69]، وقال تعالى: {فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ} [الصَّف: 14]، وقال سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحُجرَات: 9]، فلو أنَّ جماعتين من المؤمنين وقع بينهما خلافٌ في الرأي أدى إلى اقتتالهما، فأصلحوا الحالَ بينهما، ولا تدعُوا هذا القتال يتفاقمُ ويستمرُّ، لأنكم إن فعلتم - وأنتم قادرون على إحلال الصلح - تكونوا مأثومين.
والطائفةُ من الشيء: القطعةُ منه.
وبناءً على هذا الفهم اللغوي والاصطلاحيّ تكون الطائفةُ هي الجماعةُ التي هي قطعةُ من الأمة.
تعريفُ المذهب:
يقال: ذَهَبَ مَذْهَباً في المسألةِ إلى كذا.. إذ رأى فيها ذلك الرأي.وتمذهَبَ بالمذهب: اتّبعه.
وتعرفُ المذهب أنه الطّريقةُ المتّبعةُ في اتجاهٍ معيّن أو حولَ فكرةٍ معيّنةٍ، وجمعه: مذاهب.
وهناك بَوْنٌ شاسع بين الطّائفةِ التي تؤدّي إلى الطائفيّة والتعصّب، وبين المذهبِ الذي يعبِّر عن التفكير والاتجاه والرؤية لفكرةٍ معيّنة أو لموضوعٍ معيّنٍ أو لمعتقدٍ معيّنٍ، بحيث يصبح مع الزمن تراثاً فكريّاً للأمة.
ومن تلك التعاريف يمكن القول بأن محوَ الطائفيّة، وإزالتَها من حياتنا، واجبٌ دينيٌ، حتى لا تبقى هناك خصوماتٌ بين أبناء الدين الواحد. فالخلافُ الطائفيُ يشبه أن يكون نزعةً عنصريّةً، وليس في الإسلام مكان لنزعةٍ عصبيّةٍ أو جاهليّةٍ أو عنصريّةٍ أو أيّة نزعةٍ أخرى فيها افتئاتٌ على حقوق الناس وكراماتهم. بل لقد جاء الإسلام لمحاربة مثل هذه النزعات والقضاء عليها، ولذلك لا يجوزُ لمن يعتبرون أنفسهم مسلمين أن يشكّلوا طوائفَ. ويقال عنها طوائف إسلاميّة، وإلاّ فإنَّ معنى ذلك إقرارٌ منهم بعدم وحدةِ الشّعورِ الإسلاميّ، وعدم وحدةِ التفكيرِ الإسلاميّ. ونؤكد تكراراً أنه لا داعي لوجود طوائفَ إسلاميّة، إن كانت قد وجدت في فتراتٍ زمنيّةٍ من تاريخنا، فقد كان ذلك لدواعٍ سياسيّة، ومصالحَ فئويّة، ونزعاتٍ جماعيّةٍ محدودة. ولا نظنّ أن هذه الدواعي هي ممّا يرضي اللهَ تعالى ورسولَه الكريم. ونقول، وبكل اطمئنان - تجاه ربّنا أوّلاً وقبل كل شيء - أن لا مانعَ من اختلافِ آرائنا، شرطَ أن يكونَ اختلافَ آحاد، لا اختلافَ جماعاتٍ يؤدّي إلى تفرقة الأمّة الإسلامية إلى طوائفَ متنازعة.
وقد كانت المذاهبُ الإسلاميّة، في اعتبارنا، تُعدُّ تنوّعاً في الآراء، واجتهاداً في الإفكار، وحلولاً للمسائل، وفهماً لحقائقِ الدين على نحوٍ معيّن. وكان من غير الجائز المطالبةُ بالعمل على إلغاء تلك المذاهب الفقهيّة والاجتهاديّة الإسلاميّة، لأن مثل هذا الإلغاء لا يصلحُ لأن يكون عملاً ذا فائدة يحمدها العلماء والمفكرون. إذ إن كلَّ مذهب هو عبارةٌ من مجموعةٍ من المفاهيم والأحكام، أقيمت على منهج يتَّجهُ إلى النصوص الإسلاميّة والبناء عليها. وكل إلغاءٍ لأحد تلك المذاهب، أو كلُّ إدماجٍ فيما بينها يؤدّي إلى إفناء ما لا يجوز إفناؤه، وهو ليس من المصلحة العلميّة بشيء.. بل على العكس، يجب الإبقاءُ على تلك الثمراتِ الفكريّةِ من أجل الرجوع إليها كلما دعت الحاجة، واختيار الصالح منها والأقربِ اتصالاً بالكتاب والسنّة، لأنه يكون أكثرَ انطباقاً على الوقائعِ والأحداثِ التي تواجه المسلمين.
من هنا كانت الضرورةُ في الحفاظِ على تراثنا الإسلاميّ، بما فيه جميع المذاهبِ الإسلاميّة التي هي لجميع المسلمين، وليس لهذه الجماعة أو تلك منهم - كما يظنّ البعض ويتوهّم - فالمذهبُ تراثٌ علميٌّ حقّاً، يجب أن يبقى تُراثاً مُصاناً يحفظُ جهودَ أئّمةِ المسلمين وعلمائهم وأصحاب الفكر والاجتهاد منهم.
وربَّ مَنْ يسألُ: ولكنْ كيف يمكنُ محوُ الطائفيّة مع وجودِ مذاهبَ مُتَعَدِّدَة؟
قلنا إنّ الطائفيّة هي غيرُ المذهب، لأنها تقومُ على وجود جماعةٍ محدّدةٍ ذاتِ اتّجاهٍ معيّنٍ حول فكرةٍ معيّنة، أو حول مذهبٍ معين، إلاّ أنها تَعتبرُ كلَّ جماعةٍ أخرى لا تنتمي إلى أفكارها، أو إلى مذهبها، جماعةً مناهضةً لها في أمورٍ كثيرةٍ، إن لم يكن في كلّ الأمور. وهذا بخلاف ما هو عليه المذهبُ الذي يقتصر على آراءٍ وأفكارٍ تتعلقُ بأحكامٍ دينيّةٍ، أو بنظريةٍ علميّة، وتعتنق الجماعاتُ التي تؤمنُ بالأفكار التي ينادي بها، أي أن المذهبَ، في الحقيقة، نتاجٌ فكريٌ وشيءٌ معنويٌ منفصلٌ(+) عن الجماعة التي تعتنقه، وإن كان يمثل اتجاهاتها في الحياة. ولأن الطائفيّةَ تتّصف، في أغلب الأحيان، بالتعصّب، والعداء لغيرها من الجماعات الأخرى فهي مضرَّة بالأمّة الإسلامية، وكانت الدعوةُ إلى محوها واجبة.. بينما بالمقابل يجب الحفاظ على المذاهب الإسلاميّة، لأنها تفيد أفرادَ الأمّةَ في جوانبَ عمليّةٍ عديدةٍ في حياتهم، وخاصة عندما يكون الفردُ المسلمُ مطلقَ الإرادة في الاختيار منها بما يتوافق مع تيسير شوؤنه، وبما يراه أقربَ إلى الكتاب والسنّة.
والدعوةُ إلى محو الطائفيّة في حياة المسلمين فيها قربةٌ إلى الله تعالى ومرضاته - سبحانه - لأن غايتَها وحدةُ الأمّة، وتكاتفُ جهودها وخاصّةً في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها من الفرقة والتشتّت. وتلك الظروف هي نفسها التي آلمت أئمّة المسلمين على مرِّ العصور، والتي دفعت الإمام محمد الباقر (عليه السلام) - منذ حوالي ثلاثةَ عشر قرناً - لأن يقول: «إيّاكم والخصومةَ في الدين فإنها تحدثُ الشّكَّ وتورثُ النفاق». ولقد حذّر (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين بهذا التحذير لعلمه ويقينه بأن الخصومةَ في الدين، وبما تبعثُ في نفس الإنسان من ريبٍ وشكّ، إنما تورثُ الاضطرابَ النفسيَّ والفكريَّ، فيضيع صاحبه عن الحقائقِ، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ لأن المصابَ بالاضطراب في نفسه وفكره لا يمكنُ أن يكونَ صادقَ الإيمان، بل يُخشى عليه من اضطرابه ذاك أن يقودَه إلى النفاق. والمنافقُ يكون فكرهُ غيرَ مستقرٍّ، وقلبُه غيرَ مطمئنٍّ، يستوي عنده العلمُ والجهلُ، والحقُّ والباطلُ، فهو في مطلق الأحوال من هؤلاء المنافقين الضالّين الذين وصفهم الحقُّ تعالى بقوله العزيز: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً *} [النِّسَاء: 143]. وصدق الله العظيم، إذا كيف يكونُ للمنافق سبيلٌ وهو يمالئُ ويخادعُ، ويكذبُ ويكيدُ ويتلوَّنُ سلوكُه مع أهوائه، فيهوي في متاهات الضّلال.. من هنا كان ضررُ الطائفيّة على الأمة وأفرداها جميعاً، ولذلك كانت مختلفةً تماماً عن المذهب.
أمَّا لماذا توجَدُ مذاهبُ متعدّدةٌ، فهذا أمرٌ طبيعيُّ طالما أن لكلّ مجتهدٍ أو فقيهٍ طريقَتَه في استنباطِ الأحكام الشرعيّة، والاختلافُ في طُرُقِ الاستنباط الذي لا يكون إلاّ عن تنوُّعٍ في التفكير، وعمقٍ في الاطّلاع، واستقلال في النهج، هو الذي يظهر تعدّدَ الآراء حول الأحكام الشرعيّة، مما يُشيع معرفةً أوسعَ نتيجةً لتباين الآراء عند العلماء. ولهذا قال أبو حنيفة (رضي الله عنه): «أعلمُ الناسِ هو أعلمهمُ باختلاف العلماء»، أي وقوفه على مختلف آرائهم، ومعرفتها حقَّ المعرفة. ولقد اعتُبر الإمامُ جعفرُ الصّادق (عليه السلام) أعلمَ أهل عصره لأنه كان أعلمَ الناس بوجوه الاختلاف عند العلماء. يقول الإمام أبو حنفية (رضي الله عنه) بأنه سأل الإمام جفعرَ الصادقَ (عليه السلام) أربعين مسألةً فكان يجيب على كل مسألةٍ بحسب المذاهب كلها. وكان يقول: الحجازيّون يقولون كذا، وأنتم معشرَ العراقيين تقولون كذا، ونحن نرى كذا. وتلك السعةُ في الاطّلاع كانت أهمَّ الأسباب لإعجاب أبي حنيفة، أيَّما إعجاب، بالإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
وإذا كانت الخصومةُ في الدين هي الخلاف بعينه، بل هي سَببُ الشِّقاق والنزاع في تفرّق الأمّة، فلأن تلك الخصومةَ لا تنظر إلى عين الحقائق إلاّ بنظرةٍ متحيّزة، وفكر متزمِّتٍ. وهذا يُعمي القلوب والأبصار، ويوجِدُ الجهل والضّلال، ويغضبُ الله ورسولَه. وإذا كان المسلمون قد شهدوا في الماضي خصوماتٍ دينيةً مقيتةَ، فإن تلك الخصوماتِ هي التي أدّت بهم إلى حال الضعف والانحطاط. وقد آن الأوان لكي يرجعَ المسلمون إلى ربِّهم أوَّلاً، ثم إلى ضمائرهم، وينسَوْا كلَّ ماضٍ بغيضٍ قام فيه تخاصمٌ بينهم، لا سيّما وأن خصوماتِهم الدينيّةَ كانت أقوى الأسلحة التي استعملها أعداؤهم ليشغلوهم بها، وينفذُوا من خلالها إلى تفرقةِ صفوفهم، وتمزيقِ وحدتهم، والوقوفِ في وجه رسالتهم الإسلاميّة، لمنعها من الانتشار فلا يعرفها الناس، ولا تصل إلى نفوسهم.
أما اليوم، ونحن ندرك تلك الحقائقَ، فعلينا أن نكونَ كالبنيان المرصوص يشدّ بعضنَا أزْرَ بعض، فإذا اتَّجَهَ إلينا أعداؤنا صُدموا بجدران بنائنا الإسلامي الذي باطنُهُ فيه الرحمة، وظاهرة من قِبَلِهِ العذاب. ونحن اليوم مصابون بعوراتٍ كثيرةٍ في حياتنا، والمصائبُ تجمعُ ولا تفرِّق، فالحريق في الغابة يُنسي الوحوشَ المفترسةَ فرائسَها، فتمرّ أمامها ولا تعيرها التفاتاً أو اهتماماً... نعم لقد حلَّت بنا الكوارثُ بسبب الخصومات الدينيّة، فعلينا أن نزيل كلَّ أسباب الحقد أو الكراهية أو التعصب التي ورثناها، رغْماً عنا، بحكم البيئة والتقليد.. وإن لم نفعل ظلَّت أحوالُنا على حالها، وبقينا غرضاً يُنال، وهذا منتهى ما يطمع إليه أعداؤنا، الذين لا يجدون سلاحاً لمحاربتنا أقوى من الخصومات الدينيّة، وإبقاءِ تلك الخصوماتِ بيننا بصورةٍ دائمة.
وإذا كان يحلو للبعض أن يصوِّر الخصوماتِ الدينيّةَ القديمةَ بين المسلمين على أن مردَّها إلى المذاهب الفقهيّة، فإن ذلك هو الخطأ ذلك أنه عندما تكوّنت المذاهبُ الإسلاميّةُ، وأخصبَ الفقهُ الإسلاميّ وبسقت أشجارُهُ وأينعت ثمارُه وتنوَّعت ألوانهُ، وأثناء سيره في طريقه التصاعديّ النامي، فوجئت الأمّة بقرارٍ رسميٍّ يقضي بأن تحصرَ المذاهبُ الفقهيّة بأربعةِ مذاهبِ، أما الدولة فكانت تعملُ بمذهبٍ واحدٍ فقط.
ولا يخفى ما كان للقرار الرسميّ ذاك من آثارٍ سيّئةٍ على الأمّة الإسلاميّة بأسرها. ونحن لا ندري لماذا اتّخذ ذلك القرارُ، وهل كان عن قصدٍ، أم عن غفلة. ولا ريب بأن آثاره تلك كانت أقوى من القرار نفسه، لأنها أدَّت إلى الجمود الفكري الإسلاميّ، ووضعته ضمن الحدود التي توصّلت إليها المذاهبُ الأربعة، ومنعت عليه أيَّ اجتهادٍ أو إبداع جديدين... فكأنما أريد من وراء ذلك إظهارُ رسالةِ الإسلام وكأنها رسالةٌ عقيمةٌ، وغيرُ قادرةٍ على تلبية متطلبات النّاس، وحلّ مشاكلهم.
ومما لا شك فيه بأن حصرَ الفكر في بعض العقول فقط، إنما هو ظلمٌ للفكر نفسه، من حيث هو قوةٌ للإدراك وطاقةٌ للعطاء. وعندما اعتكف الفكر الإسلاميّ - بعد ذلك الظلم الذي أوقعوه عليه - وظهرت الحقيقةُ للواقع، وذلك عندما رانَ الجفافُ والقحطُ على الفقه الإسلاميّ، مع أن هذا الفقهَ يمثّلُ مجملَ الحياة للمسلمين.. كانت النتيجةُ أن حصل ما كان لا بُدَّ من حصوله، إذ قوبل اعتمادُ المذاهبِ الأربعةِ بفرحٍ ورضًى من أتباعها في بادئ الأمر، ثم لم يلبث ذلك أن انعكس تفاعلاتٍ داخليّةً بين أتباع المذاهب أنفسهم، وخصوصاً عندما استخلصت الدولة لنفسها مذهباً واحداً ونادت به مذهباً رسميّاً، مما عكس واقعاً مريراً عبّرت عنه سلسلةٌ من التصادمات العنيفة - وأحياناً الدامية - بين الأتباع أنفسهم من ناحية، وبينهم وبين غيرهم من ناحية ثانية. وتلك الأمورُ مجتمعةً جذَّرت المذهبيّة، حتى صارت الأحكامُ التي قالت بها المذاهبُ الأربعةُ بمثابة نصوص مقدَّسة، لا يجوز مناقشتُها، ولا تقبلُ التفسيرَ أو التأويل، لكأنما أريد أن يحاط كلُّ مذهبٍ بجدرانٍ مسوَّرةٍ حتى لا ينفذَ منه شيءٌ، أو ينفذَ إليه شيءٌ جديد...
وكان من الطبيعيِّ أن يفقدَ الاجتهادُ - من جرّاء ذلك - دورَهُ الرائدَ، فلم يعد هنالك سوى تكراراتٍ مملَّةٍ على شكلِ حواشٍ وإضافاتٍ، لا تغني ولا تفيدُ الأحكامَ الشرعيّةَ بشيء، وسادَ الظنُّ عند أتباع كل مذهبٍ أنه وحدَه هو الصحيح، فأوغلوا في التعصُّب له.
وإذا أضفنا إلى ذلك تدخلَ الحكّام، والسلطاتِ العامّةِ إجمالاً، بالمذاهب عن طريقِ تقويةِ مذهبٍ على آخر، أو فرضِ مذهبٍ دون المذاهب الأخرى على المساجد، والإدارةِ، وعلى الناس، لظهر جليَّاً كيف أن الخلافاتِ السياسيّةَ قد وجدت هي الأخرى مكاناً لها في البنية المذهبيّةِ، وكان الصراعُ السياسي وما ينشأ عنه من خلافات يصلُ إلى ذروته في كلًّ مرة يريدُ أهلُ الحكم، وأتباعُهم، تثبيتَ مواقعهم، وتقويةَ مواقفهم وتدعيمَ مكانتهم. وهم يتذرَّعون لذلك بالاعتمادِ على الكتابِ والسنّة، حتى يتمكّنوا من استغلال سائر المذاهب للأغراض والمطامع التي يريدونها. وهذا ما جعل السياسةَ، ترتدي، في أكثر المناسبات، ثوباً دينيّاً، بينما هو في الحقيقة ثوبٌ مذهبيٌ وليس دينيّاً، لأنه ليس في الإسلام مكانٌ لأساليب ملتويةٍ، كما ليس في المذهب الفقهي سبيلٌ لأطماع شخصيّة، على حساب الدين والأمّة. ولكنَّ أهلَ تلك الأيام اصطنعوا لأنفسهم ذلك فأوجدوا نوعاً من الصلة بين المذهبيّة والطائفية، بل وتحوَّلت المذهبيّةُ إلى تعصبٍ أشدَّ عتوّاً من الطائفية.
من هنا كانت هذه الدعوةُ الصادقة لإلغاء العصبية المذهبيّة وليس فقط للقضاء على الطائفيّة، والإبقاءِ على المذاهب لأنها غنيّةٌ بما تحتويه من أحكام وأفكار وآراء.. أي أن الغايةَ إزالةُ كلِّ الأسباب التي تؤدي للخلاف بين المسلمين، والإبقاءُ - بدون حرج - على الاختلاف في الآراء لأن الخلافَ تفرقةٌ وضعفٌ، والاختلافَ في الرأي تفسيرٌ واستنباط.. ولأن الخلافَ تعصّبٌ وتجمّدٌ، والاختلافَ في الرأي تنوّعٌ وتعدّد. وليس المذاهبُ الإسلاميّةُ في حقيقتها إلا نوعاً من الاختلاف في الآراء، وهو لا يضرُّ الأمّةَ، في حقيقته، بقدر ما يضعُ بين يَدَيْ أبنائها سُبلاً وطرائقَ في المعاملات، هذا فضْلاً عن كونها تراثاً عظيماً للأمّة، ولذا فإنَّ هذه الأهميّةَ للمذاهبِ الإسلاميّةِ لا تعني اقتصارَها على أربعةِ، أو خمسةِ مذاهبَ، ولا أن تُحصرَ بعددٍ معينٍ، لأننا بالتحديد نحكمُ على أنفسنا بالجمود الفكريّ، ومنع العطاء الجديد، مما يُبقي دوامةَ الخلافِ قائمةَ، وسبيلَ التعصّبِ مستمراً. وليس من سبيل إلى تجاوز ذلك كله، والابتعاد عنه، إلاّ بإطلاقِ الاجتهاد من أسره، والسماحِ للفكر الإسلاميِّ - وخاصّة لفكر أهل العلم والإيمان والتقوى - بالتحليق في أجواء ديننا الفسيحة، والانطلاق في رحاب عقيدتنا السَّمْحَة، والغوصِ على لآلئ وكنوزِ منهاجنا، الذي هو منهاجٌ ربّانيٌّ لا حولَ ولا طَوْلَ فيه للإنسان، حتى تتوقَّدَ القرائحُ، وتتوهَّج الأذهانُ من جديد، فيشعّ علينا الإسلامُ بأنواره، وتتناسق مفاهيمُهُ الحضارية، وتتسامى قِيَمُهُ الإنسانيّة. إنَّ فتحَ بابِ الاجتهاد معناه الإيمانُ بعطاءِ الله تعالى لهذا العقل وما ينبثقُ عنه من فكر ورأي، ولأهميَّته في الحياة وقدرِته على السير إلى الأمام والتقدّم، والإقبالِ على المستجدّات والتطوّرات يعالجها بالرّوح الإسلاميّة التي تنهل من ينابيع كتابِ الله تعالى وسنّةِ رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وإنه لمن حقِّ كلِّ مسلمٍ قادرٍ، تتوفَّرُ لديه شروطُ الاجتهاد، أن يكونَ من أصحابِ الرأيِ والفكرِ في دراسةِ ديننا وأحكامه الشرعيّة، حتى يقدِّم للأمة، ولأجيالها المقبلةِ ما فيه نفعُها وصلاحُها.
من هنا كان الاجتهادُ البنّاءُ القادرُ ضرورةً في حياتنا، لأن من شأنه إيجاد الحلول لكلّ التناقضات والمنازعات التي عرفها المسلمون في سابق أيامهم. وعندما تتاحُ لعلماء الأمّة ومفكّريها المخلصين مجالات الدّرس والبحث الجديدة. وتتوفرُ لهم أجواءُ المقارنة والمقاربة بين المذاهب القائمة، فإنهم سوف يصلون، بحول الله وقوته، إلى استنباطِ الأحكامِ الجامعةِ الموحِّدة، والمواكِبة لحركة التطوّرِ والتقدم. وإنَّ بناءً فكريًّا جديداً، ومتناسقاً، على هذا النحو من الإخلاص لله تعالى، وخدمةِ أهلِ دينه لا يدفنُ رسوباتِ الماضي، ولا يزيل الطائفيّةَ المحصورة والمذهبيّةَ الضيِّقة من الأذهان وحسب، ولا يقضي على السموم والشرور التي نخرت عافيتنا الإسلاميّةَ بالذات، بل هو يعيدُنا إلى أصالة ديننا التي فقدنا، وينطلق بنا في ركب الحضارة الإنسانية ويرقى بنا إلى مصافِّ الأمم الراقية.
وإنه لدعاءٌ من القلب نسألُ فيه الله العليَّ القدير أن نصلَ - وقريباً إن شاء الله - إلى اليومِ الذي تزول فيه الخصوماتُ الدينيّةُ، ويأفل نجمُها ويولّي عنا إلى غير رجعة، فنُقبِلُ عندها على تركةٍ إسلاميّةٍ خلَّفها لنا علماءُ الأمة فيما تركوا من مذاهبَ فكريّة، ننْهلُ من معينها ونستقي منها ما يقرِّبنا من صريح الكتاب وصحيح السنّة، فنحفظ بذلك تراثَنا، ونبني حاضرَنا، ونخطّط لمستقبلنا بعونِ الله تعالى ورحمته.
ولئن كانت هذه أمانينا، وأماني جميع المخلصين الصادقين من أبناء هذه الأمة، إلاّ أنه لا يسعُنا أن نخدعَهم، وأن نُزيّن لهم ما هو محبّبٌ إلى القلوب، دون أنْ يعرفوا ما في تركتنا الماضية من مآسٍ قبل أن يقرّروا تركَها وعدَم الرجوع إليها بصورةٍ نهائية...
نعم أيها الإخوة المسلمون، لقد ورثت الأجيالُ المتعاقبةُ أموراً كثيرة لا دخلَ لها بها، وهي لا تمتُّ إلى الإسلام بصلةٍ في حقيقتها. وقد كانت تلك الموروثاتُ العقيمةُ الحاجز النفسيَّ، والمانعَ الذهنيَّ لتلاقي المسلمين، وتصافي أنفسهم على البر والتقوى.. وهاكم مثالاً لنا يُظهرُ ذلك الماضي البغيضَ الذي ما نزال نعيشُ آثاره حتى اليوم.. إذْ عندما ظهرت الفرقُ المتعصِّبةُ، ذاتُ النزعات الحادّة لم تلبث أن راحت تطلقُ النعرات التي تفتك بوحدة الأمّة. ومن قبيل ذلك ما رأت تلك الفرِق من: أنَّ الشيعةَ الإماميّةَ أرفاضٌ لأنهم يرفضون خلافةَ أبي بكرٍ وعمر وعثمانَ ، فلا يجوز بالتالي الزواجُ منهم، ولا السّيرُ معهم.. أو ما رأت فرقٌ أخرى من أن: سبَّ الشيخين أبي بكرٍ وعمرَ (رضي الله عنهما) أمرٌ يتعبَّد به، لأن في ظنِّ هذه الفِرَقِ أن خلافة الشيخين كانت غصباً، وأُخذت من عليٍّ (عليه السلام) صاحبِ الحقّ بها.. فهل هذا من الإسلام في شيء؟
ما من شك بأن كل إنسانٍ مسلمٍ صادقٍ، مخلصٍ لله ولرسوله، لا بُدَّ أنه يعرفُ مقامَ أهل بيتِ رسولِ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وشيعتهم، مثلما يعرفُ تماماً مقامَ الصحابة الكرام، وخاصةً مكانةَ أبي بكر وعمرَ وعثمان عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا الأوّلُ يربأ بأهل البيت وشيعتهم أن يُمسُّوا بسوء، ولا الثاني يسمحُ بسبِّ صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخيارهم، وهذا ما دعا الإمامَ الشافعيَّ (رضي الله عنه) لأن يقول:
إذا نحن فضَّلنا عليًّا فلم نزل
روافضَ بالتفضيل عند ذوي الجهلِ
وفضلُ أبي بكر إذا ما ذكرتُه
رُميتُ بنصبٍ عند ذكريَ ذا الفضلِ
فما زلتُ ذا رفضٍ ونصبٍ كلاهما
أدينُ به حتى أوسَّدَ بالرمل
أما الإمامُ محمد الباقر (عليه السلام) على أولئك المتعصّبين، عندما يدعو إليه أحَدَ أصحابه، وهو جابر الجعفي، ويقول له: «يا جابر! بلغني أن قوماً من العراق يزعمون أنهم يحبّوننا، ويتناولون أبا بكرٍ وعمرَ - (رضي الله عنهما)، ويزعمون أنّي أمرتُهم بذلك؛ فأَبلْغِهم أنّي إلى الله بريءٌ منهم. والذي نفس محمّدٍ بيده، لو وُلِّيتُ لتقرَّبتُ إلى الله بدمائهم».
فهل بعدُ أوضحُ من دعوةِ الإمام الباقر (عليه السلام) وهو يتقرَّبُ إلى الله بقتل من يسبُّ الشيخين، لأنه من المنافقين الذين يبذرون الكراهيةَ، والتفرقةَ في نفوس المسلمين، ومن المفسدين الذين يعيثون في حياة المسلمين فساداً بما يثيرون من نعرات الجهلِ والتعصّب القاتلة؟!
وذلك الماضي بما حمَلَ، وبما أَورثَ من أوهامٍ، دعواها: تكفيرُ بعض المسلمين - إما بسبب تهمة الرفض، وإما بسبب التعدّي على مقام أصحاب الرسول (عليه السلام) - هو مما يجب أن نعتبرَه من المكائد الخفيَّة التي وقع فيها المسلمون في غفلةٍ منهم، والتي ظلت إرثاً مقيتاً يحملونه على أكتافهم، فهل يجوز أن نُبقيَ عليه والله تعالى ينكرُهُ في عليائه، ورسولُه في خُلده، والمسلمون الصادقون في إيمانهم؟!... فعلامَ نُغضبُ اللهَ تعالى ورسولَهُ الكريم، ونُسيءُ إلى وجودنا الإسلاميّ، بأشياءَ دُسَّت على الحياة الإسلاميّة دسَّا، وهي لا تَمتُّ إلى ديننا في الأصل بأيّة صلة، ولا علاقَةَ لها بحياتنا الحاضرة بأيِّ شيء، اللّهم إلاّ الإبقاء على الجهلِ والضّلالِ والتفرقةِ والكراهيةِ، التي يجبُ شرعاً على المسلم محاربتها والقضاء عليها...
فنحن كلّنا مسلمون - إن شاء الله تعالى -. وبقدر ما نبتغي الإسلامَ ديناً، بقدر ما نعملُ بهدي رسوله الكريم الذي جاء عنه في الأثر أنه قال: «المسلمُ أخو المسلم أحبَّ أم كره» .. والأُخوّةُ لا يمكن أن تقومَ إلا على المحبةِ والتسامح، والتعاونِ، والتكافلِ في كلِّ برٍّ وخير.. فكيف إذا كانت هذه الأُخوّةُ في الإسلام لأجل طاعةِ الله تعالى، وطاعةِ رسولِهِ الكريم، ونيلِ رضوانِ ربِّ العاليمن وخاتم النبيين؟!
فيها أيها المسلمون!
نحن أمّةٌ كريمةٌ كانت خيرَ أمّةٍ أُخرجت للناس، بقوله الكريم: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عِمرَان: 110]. فلنأمرْ بالمعروفِ الذي يجمعُ كلمتَنا، وَلْنَنْهَ عن المنكرِ الذي يفرِّق وحدتَنا ليصدقَ فينا قول الله تعالى.
ويا أيها المسلمون السنّة نحن لسنا بالطائفة السنية..
ويا أيها المسلمون الشيعة نحن لسنا بالطائفة الشيعية..
بل إنَّ كلَّ من أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وآمن بـاللهِ إلهاً واحداً أحداً، وبملائكتِهِ وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد منهم، هو من أبناء الأمّة الإسلاميّة، ولا ينتمي إلى جماعةٍ معيّنةٍ منها لقوله تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ *} [المؤمنون: 52]، وقوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ *} [الأنبيَاء: 92].
وأخيراً لا آخراً نقولُ لأهل «لا إله إلا الله» القائمين على عقيدةِ التّوحيدِ لله ربِّ العالمين والناطقين بشهادةِ التّوحيد:
يجبُ أن توحِّد كلمةُ التّوحيد كلمتنا.
ويجب أن تكونَ مداراً لتحرّكاتنا ورصِّ صفوفنا.
ويجب أن ننضويَ تحت لوائها لنجمعَ شملَ أمّتنا.
وبغير ذلك نفقد قوتنا وَمَنْعَتَنا، ويبقى الأعداءُ متحكمين بحياتِنا، ومتنعمين بثرواتِنا.
وقد آن لنا أن نُفيقَ من كبوتنا الطويلة، وننهضَ من سباتِنا العميق، حتى نبنيَ مجدَ الإسلام الذي هو مجدُنا وعزّتُنا.
وآخرُ قولنا في هذا الموضوع: الحمدُ للهِ الذي أعزَّنا بالإسلام وجعلنا من أمة المسلمين.
رأي ونـداء
إنّ تناول الأحكام الشرعيةِ، وما قال الفقهاء والمجتهدون في كلّ حُكمٍ من تلك الأحكام التي كانت جزءاً مما استعرضناه - في هذا الكتاب، وما سيرد - إن شاء الله - في كتاب العقود والمعاملات، باستطاعة الكاتب أن يؤلّفَ فيه كتاباً قائماً بذاته، ولكنّ هدفنا من هذه الموسوعةِ الميسَّرةِ لم يكن ذلك، أي الإسهابَ وزيادةَ الشروحات، بل أن يطَّلعَ المسلمُ - وغيرُ المسلم - على خلاصةِ الآراءِ والاجتهاداتِ وأقربها إلى القرآن والسنّة، وأن يعلم في الوقت عينه - أنَّ جميع الأئمة قد استقوا من ينبوعٍ واحدٍ، واستناروا بمشكاةٍ واحدة، وأن يظهرَ له، بصورةٍ جليّةِ أن جميعَ الأئمةِ كانوا متَّفِقينَ على معظم الأحكام الشرعيّة. ولا نبالغ إذا قلنا بأنهم كانوا متفقين على نسبة تسعين بالمائة من تلك الأحكام. وهذه الكتاب، بحدِّ ذاته، يُفسح لنا المجال بالتفكير، ويُعطينا زاداً مقوِّياً للتمعّن والتعمّق، لأنه يأتي على ذكر أقوال الفقهاء الكبار جميعهم، أي أنه يمتاز بشيءٍ من التنوع الذي يفتحُ الأذهانَ، ويوسِّعُ آفاق القارئ.
ولنأخذ مثالاً على ذلك فريضة الصلاة.
لقد أمرنا اللهُ تعالى في مُحكمِ التنزيلِ العزيز بأن نُصلِّيَ وذلك بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} [البَقَرَة: 43].. فهذا الأمر الربانيُّ هو، في حقيقته، تشريعٌ للصلاة، أي هو حكمٌ شرعيٌّ بوجوب الصلاة. ولكن ماذا يُـبنى على هذا الحكم الشرعي؟ تُبنى عليه عدّة أمور:
- أنَّ عدمَ الإيمانِ بتشريع الصلاة، وبوجوب إقامتها في الأوقاتِ الخمسةِ كلَّ يوم، يكون كفراً.
- أَنَّ الإيمانَ بتشريع الصلاة، وبوجوب إقامتها، مع عدم ممارستها فعليًّا من المكلَّف، يكون فسقاً.
- أن الإيمانَ بتشريع الصلاة، وبوجوبها، ولكن مع إقامتها على غير الوجه الصحيح يجعلُها باطلةً، وغيرَ مُجزية، وغيرَ مُسقطةٍ للقضاء ولذلك كان على المجتهد أن يبيّنَ حكمَ الصلاة الصحيحة، ومن ثمَّ الأمورَ والحركاتِ التي يجبُ على المصلّي القيامُ بها، وتلك التي يمتنعُ عليه الإتيانُ بها، والتي يؤدّي وجودُها إلى بطلانِ الصلاة.
ومن الأحكام المتعلّقة بإقامةِ الصلاة أن اللهَ سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الذين يحافظون على صلواتهم بالفلاح والنجاح وذلك بقوله الكريم: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *} [المؤمنون: 1] إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ *} [المؤمنون: 9] والمعنى أن الذين يقيمون الصلاةَ في أوقاتها، وبشكلٍ صحيح وكاملٍ بحيث لا تشوبُها شائبةٌ، ولا يَدخلُ عليها أيُ مبطل، هؤلاء لهم الفوزُ والأجرُ والثوابُ في الآخرة.
ومن تلك الأحكام أيضاً ما توعّد به العزيزُ الجبّار المهملين لصلاتهم، الساهين عنها، بقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ *} [المَاعون: 4-5]. فقال المجتهدون: إن السهوَ معناه تركُ الصلاة وما يترتب على هذا الترك من أحكام. وقالوا: معناه ويلٌ للمصلّين الذين هم عن صلاتهم غافلون، يقيمونها حيناً، ويتركونها حيناً آخر بحيث تطغى عليها أعمالهم الدنيوية.
وقالوا: إن معنى السهو الوقوفُ في الصلاةِ بينما قلبُ المصلّي معلّقٌ بأهداب الدنيا.
وأما عن الخشوع الذي يدخل في أحكام الصلاة فيقول الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ *} [المؤمنون: 1-2].
فقد رُوِيَ عن رسوِل اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى رجلاً يعبثُ بلحيته في الصّلاة، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أمّا لو خشع قلبُهُ لخشعت جوارحُه» (+).. وهذا يعني أن الخشوعَ يبدأ بالقلبِ وينتهي في الجوارح، ولا يبدأ بالجوارح وينتهي في القلب.وبذلك يكون المصلّي قد أجمع الهمّة للصلاة، والإعراضَ عما سواها من الأمور والشؤون. وأما الخشوعُ في الجوارح فيكون بغضِّ البصر، والإقبال على الصلاة بكلّيته، وترِك الالتفاتِ والعبث. قال ابن عباس: «خَشَعَ فلا يعرفُ مَنْ على يمينه، ومَنْ على يساره».
ومن أحكام الصلاة أيضاً قولُ الله تعالى: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً *} [الإسرَاء: 110].. فالمعنى أنه يجب ألاَّ تجهرُ بصلاتك عند مَنْ يؤذيك بسببها، ولا تخافتْ بها عند من يتلمَّسها منك.
ولا تجهرْ بصلاتك كلِّها، ولا تخافتْ بها كلِّها «وابتغِ بين ذلك سبيلاً» بأن تجهرَ بصلاة اللّيل، وتخافتَ بصلاة النهار. ولا تجهرْ جهراً تُشْكِلُ به على من يصلّي بقربك، ولا تخافتْ بها حتى لا تسمعَ نفسك. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنهم قالوا: «المرادُ بالصلاة هنا الدعاء» فيكون المعنى فلا تجهرْ بدعائك ولا تخافتْ به، ولكن بين ذلك.
إن تلك الأحكامَ الشرعيّةَ التي تتعلّقُ بالصلاة لا يختلفُ عليها الفقهاءُ والمجتهدون. وكذلك الأحكام الشرعيّة المتعلقة بالزكاةِ والصيام والحجِّ والجهادِ وغيرها فهي موثوقةٌ من الجميع، وقد بحثوا أدلّتها بكثيرٍ من الاتفاق.
ولكنْ هنالك أمور تتعلّقُ بتلك الأحكام الأساسيّةِ المنزَّلة. فمثلاً نحن مأمورون أن نمتثلَ لأوامر رسولِ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والاقتداءِ به، فعندما يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «صلّوا كما رأيتموني أصلِّي» (+) فيجب أن نعرف كيف كان يصلّي رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى نصلِّيَ مثله.. وهنا يظهر الاختلاف حول كيفيّة أداءِ الصلاة، بمعنى أنه ليس ثمّةَ في الأصلِ خلافٌ على الحكمِ الشرعيِّ الذي هو وجوبُ إقامةِ الصلاة، بل الخلاف على الطريقة التي نقيمُ فيها الصلاة.
وتعودُ أسبابُ هذا الخلاف إلى كثرةِ الرواياتِ التي نُقلت عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يؤدي الصلاة، وإلى فهم ذلك الأداء، وعلى أي وجه كان يتمُّ فيه، حتى تكون صلاتُنا صحيحةً، مُجزية، مسقطةً للقضاء. أو بعبارةٍ أوضح حتى تكون صلاتُنا مقبولةً من الشرع، ولا قضاءَ فيها.
وكما ظهر الاختلافُ بين المذاهب حول كيفية أداءِ الصلاة، فقد ظهر هذا الاختلافُ حول كيفيّة تطبيقِ معظمِ الأحكامِ الشرعيّة الأخرى. لأنه في الأصل لا خلافَ ولا اختلافَ على الأَحكام الشرعيّةِ الأساسيّة التي أمر بها الشارعُ العظيم، فالأئمة جميعاً قالوا بوجوب العمل بهذه الأحكام، إنما كان اختلافُهم حول فهمها وكيفيّة تطبيقها. ونتيجةً لكثرة آرائهم واجتهاداتهم حول التطبيق وُجدتْ أحكامٌ كثيرةٌ جديدة تتعلّقُ بالأحكام الأساسيّة. ومما لا شك فيه أن نشوءَ الأحكام الجديدة المتعلقة بالأحكام الأساسيّة أو المتفرعة عنها إنما مردّه إلى اختلاف المراجع التي حصل عليها الفقيهُ أو المجتهد، والمصادِر التي أخذ عنها، والرواياتِ التي توصّل إليها، ثم مدى فهمه للحكم الشرعيّ وما جادَ به فكرُهُ حول كيفيّة أدائه أو تطبيقه.
أما الغايةُ من استنباط الأحكام الجديدة فكانت دوماً إيجادَ الحلول لمشاكل المسلمين. إذ من الطبيعيّ القولُ إن المسلمين اعترضتهم مشاكلُ عديدةٌ ومتنوعةٌ في حياتهم كانت تنشأ مع كل عصر، فكان لا بدّ من الوقوفِ على تلك المشاكل ووضع الحلول الشرعيّة لها. ولكن مع الزمن، وتعدّدِ المشاكل، واختلافِ الأحكام حول هذه المشاكل. نشأت الإشكالاتُ حول الأحكام التي أعطيت لحلّ المشاكل، فأضحت هذه الإشكالات تحتاجُ بذاتها إلى حلول. وهنا يأتي دورُ الاجتهاد لتوضيح كلّ تلك الأمور حتى لا تبقى عقبةً تعترضُ حياةَ المسلمين. أمّا غاية الاجتهاد في الأصل فهي حلُّ مشاكلِ الناس في حياتهم الدنيوية بينما غاية السياسة الإسلاميّة هي رعايةُ شؤون الناس في الداخل والخارج. فعندما تعترض الفردَ، أو الجماعةَ مشكلةٌ من المشاكل لا بدّ وأن يسعوا وراء حلها، وذلك، أوَّلاً وقبل كلّ شيء عن طريق فهم الكتاب والسنّة، فإذا لم يجدوا اجتهد الأكفاءُ منهم عن طريقِ الاستنباطِ من الكتاب والسنّة، أو مما دلَّ عليه الكتابُ والسنّة، ويكون عملُ المجتهد إيجادَ الحكم الذي يعالج هذه المشكلةَ أو تلك. وهذا ما سارَ عليه السلف الصالح. وأعطى عصارةَ فكرِه وجهدِه لاستنباط الأحكام التي تدلّ المسلمين على الطرق التي عليهم أن يتبعوها في أداءِ واجباتهم الدينيّة.
وعلى هذا الأساس، رأينا أن نضعَ بين يدي القارئ الكريم هذا الكتابَ مع الإشارةِ إلى الأمور التالية:
أولاً : لقد عملنا على أن نقدّم للمسلم كلَّ ما يحتاجه لفهم الحكم الشرعيّ ومن ثم للعمل به، فاقتصرنا بصورةٍ رئيسيّةٍ على ما يتطلبه المسلمُ في عصرنا الحاضر.
ثانياً : لقد تجنّبنا الكثيرَ من التفصيلات، لأنه لو فكر القارئ قليلاً بالقواعد والأحكام التي أوردناها لوصل إلى فهمها بكل سهولةٍ ويسر. ومع هذا فقد عدنا وتركنا له بعض الأمور التي يفكر بها بناءً على القواعد الفكريّة التي قدمناها له.
ثالثاً : ربما وجدت أيها القارئ الكريم آراءَ بعض الأئمة، ولم تجدْ رأيَ أحدهم أو بعضهم الآخر حول مسألةٍ جزئيّةٍ معينة، وهذا يعني أنّ رأيَ هذا الإمام أو هذا المجتهد حول المسالة لم نتمكن من العثور عليه.
رابعاً : لقد لاحظنا معاً، أيها القارئ الكريم، أن كلَّ ما فيه نص صريحٌ من القرآن المبين كان محلَّ اتفاقٍ عند جميع المذاهب الإسلاميّة. أما التباين في الآراء فيأتي نتيجة عدم وجود النصّ الصريح أو إجماله، أو معارضةِ تفسير النص مع تطبيقه، أو قد ينشأ من تضعيف الحديث لدى مذهبٍ من المذاهب، أو إذا ما بدا للفقيه أو المجتهد أن هذا الحديث يتعارض مع مفهوم نص آية كريمة أو مع نص حديث آخر، فهنا يميل المجتهد إلى التعادل والتراجيح، وبذلك قد يُعطي رأياً متبايناً ومفترقاً عن آراء غيره.
ولذا فنحن عندما نقول: اتفق الأئمّةُ، نكون قد عنينا أن دليلَ الحكم الشرعيِّ يوجد فيه نصٌّ صريحٌ لدى جميع الأئمة وهم متفقون عليه. لذلك فإننا لم نعرض للكثير من الأدلة حول الأحكام التي عليها اتّفاقٌ من الجميع أو من غالبيتهم. ولكن إذا وجدنا تعارضاً في أدلتهم نظرنا في جميع جوانبها حتى إذا انتهت برأينا إلى المساواة والتعادل رجّحنا الحكمَ الأيسرَ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البَقَرَة: 185] أو قول رسوله الكريم: «ما خُيِّرتُ بين أمرين إلا اخترتُ أيسرَهما»(+).
أيّها المسلمون
إن المشاكل التي تواجهون كثيرة، وهي إما مشاكلُ عامّةٌ في حياة كلّ أمّة، وإما مشاكلُ خاصّةٌ بكم أنتم. وقد وُضعت لكلِّ منها الاحكامُ التي تعالجها من قبل الأئمّةِ والمجتهدين. إلاّ أن كثرةَ الأحكام تلك وما رافقها من إشكالاتٍ هي التي أدّت إلى ظهور التناقض بين غالبيّةِ أفراد الأمة في تطبيقهم لها بصورةٍ غيرِ صحيحةٍ، وغيرِ متوافقة مع الأحكام الشرعيّة الأساسيّة، وحتى مع آراءِ الفقهاء في أحيانٍ كثيرةِ. والأدهى أن تعاملهم فيما بينهما كان على أساس هذه الإشكالات أكثرَ منه على أساس الأحكام، وهذا ما جرَّ الإساءة إلى سمعتهم، وسمعةِ الإسلام الذي ينتمون إليه. وفي محاولةٍ لتغطية التصرفات الخاطئة راحوا يتحرَّون عن أبسط الأمور في الأحكام الشرعيّة ويتركون مفاهيمها الصحيحة، ومن قبيل ذلك مثلاً تحرِّيهم عن كيفيّة الوضوء، أو كيفيّة الجلوس بعد السجود في الصلاة. واشتد تحاجُّهم ومناقشاتهم في ذلك دون النظر مثلاً في أهميّة الصلاة ومدى تأثيرها في الحياة الإسلامية، والحكمة منها، وكيف أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكيف يبرزُ أثرُها جليَّاً في جمعِ الصفوف، وتوحيدِ الكلمة، وتأليفِ القلوب.
أيها المسلمون
ليس هنالك من جماعةٍ بشريّةٍ، أو أمّةٍ من الأمم، قادرةٍ على تخليص البشريّة مما تعانيه إلاّ أنتم، وذلك لما تفضَّل به ربّكم الكريمُ عليكم من عقيدةٍ صحيحة ومستقيمة، أنزلها - سبحانه - وأتمَّ بها نعمتَهُ عليكم، بحيث تقدرون معها على تقويم الإعوجاجات وتصحيح الانحرافات التي نشأت عن العقائد الأخرى، وتقيمون على أساسها حدودَ الله تعالى، فتهنأُ البشريّةُ جمعاءُ بما نالت، وتهنأون أنتم بما قدمّتم لها.
أيها المسلمون
يجب أن نتنبَّه لأمرٍ هامٍّ وهو أن الغربَ عندما حكم عالمنا الإسلاميَّ إنما حكمَهُ بنظام لا يتّفقُ مع الإسلام بشيء، ولكنه لشدّة كيده ومكره ترك أَمورَ العبادات لاهتماماتكم، وراح يتظاهر بحرصه على ممارستكم بحريّةٍ لتلك العبادات، وكان يشجّع أحياناً على بناء المساجد والتعبّد فيها قياساً على ما عنده من طقوسٍ كنسيَّةٍ، ولكنه في الوقت نفسه لم يكن ليتوانى عن إقفالِ مساجدكم، ودورِ عباداتكم إذا ما وجَدَ فيها وسيلةً للخطر عليه، كما كان يحرِّمُ على المسلم أن يتعاطى أُمورَ الحكم أو الاقتصاد أو غيرها من النظمِ الإسلاميّة التي تخالف وجهة نظره في الحياة، وإلاّ كان مصيرُ من تفوَّه بمعارضته أو من دعا إلى الوقوف بوجهه السّجنَ أو القتلَ، وكثيرون هم الذين قضَوْا على يديه بسبب ذلك، ظلماً وعدواناً. ومن جراء ذلك انصرف فقهاءُ المسلمين إلى أمور العبادات، فشرحوها وأَسْهَبُوا في شرحها، ومارسوها ودعَوْا إلى ممارستها وفق الطريقة التي تأتلفُ مع نظرتهم إليها.. هذا في الوقت الذي أهملوا مُعظم الأحكام الأخرى - التي لا تدخل في العبادات - إما جهلاً بمكانةِ وأهميّةِ المعاملاتِ في الإسلام، وإما تقيّةً وخوفاً من الحاكم. في حين أن خوفهم من الله تعالى يجب أن يكون أقوى وأشدَّ لأنهُ هو - سبحانه - الذي أنزل الأحكام الشرعية وأمر بتطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً. على أن ذلك كلَّه لم يمنعْ من وجود تراث عظيم لدينا، يتمثّلُ بما قدَّمه الفقهاءُ، وأعطاه المجتهدون، وهو ما سار عليه أَهلُ المذاهبِ الإسلاميّةِ في حياتهم حافظينَ بذلك أمورَ دينهم ودنياهم. ومن هنا كان واجبنا أن ننظرَ إلى المذاهبِ الإسلاميّةِ بكل اعتزازٍ وإكبار، فلا نفرّقُ بين الشيعةِ الإماميّة والزيديّة والحنفية والمالكيّة والشافعيّة والحنيلية، تماماً كما يفعلُ اليوم المقلِّدون للمذاهبِ السنيّة الأربعة حيث لا ينظر أهلُ كلِّ مذهبٍ إلى الآخر نظرةَ بُعْدٍ وتفرقة.
ويمكن أن نسأل. لماذا تأخذُ هذه الجماعةُ من المسلمين بصحّة الأحكام من مذهبٍ واحد، وتقتصرُ عليه بينما تنفي صحةَ المذاهب الأخرى؟ بل لماذا نرى مسلمين كثيرين يتمسكون بالمذاهبِ الأربعةِ ويبطلون بقيّةَ المذاهب؟ مع أنّ من الواجب على جميع المسلمين، الذين يتمسّكون بالكتابِ والسنّة، أن يطلعوا على ما في جميع المذاهب الإسلاميّةِ الموجودِة في أنحاء الكرة الأرضيّة من أحكامٍ، كي يقفوا على ما توصّلت إليه في خدمتها للإسلام.
أيُّها المسلمون
عندما سجن كلٌّ منكم نفسه في نطاق طائفة معيّنة مسلمة، وآثر الانتماء إليها دونما نظر إلى ما يجمعه مع بقية الطوائف الإسلاميّة، حلّ بكم ما أنتم عليه اليوم من تشتّت وتفرّق، وذلٍ وصغار.
فماذا عليكم لو عدتم إلى ما كان عليه آباؤكم الذين آمنوا بالإسلام ديناً، وهو دين التوحيد والوحدة، وبالانتماء إلى أمّة الإسلام، وهي خيرُ أمّة أُخرجت للنّاس. فكانوا بهذا اليقين وذلك الانتماء إخواناً في السرّاء والضرّاء، وبُنياناً مرصوصاً يشدُّ بعضُه بعضاً.. مثل شجرةٍ طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تعطي أُكُلَها كلّ حين بإذن ربّها.
ألا ترون معي، أيها المسلمون، أنّ الذي ينتمي إلى أمةٍ عظيمة يشعر بالأمن والاستقرار، وبالحبّ الصادق لكلّ جماعاتها وطوائفها؟ وأن الذي يُوقِفُ انتماءه على طائفةٍ معيّنة يحسُّ بالخوف والقلق، وبالكره أحياناً لجميع الطوائف الأخرى، والانزواء عنها.. بل والكيد لها.
فيا أخي المسلم
قوِّ إرادتَك، واحزمْ أمرك، واخرجْ من قوقعةِ الطائفة إلى رحاب الأمة الإسلامية.. فسوف ترى أمّتك تنتظرُ انضمامك إلى بنيها الميامين.. فكن واحداً منهم ليتحوّل ضعفُك إلى قوّة، وكرهُك إلى حبّ، وقلقُك إلى استقرار، وخوفك إلى أمن.
أيها المسلمون
إن الأمّة الإسلاميّة تُهيب بكم أن تنبذوا الطائفيّة، وأن تتفيأوا ظلال أمّة نبيّكم الكريم الذي هو، عزيزٌعليه ما عنتّم حريصٌ على وحدتكم، بالمؤمنين رؤوف رحِيم.
أيها المسلمون:
عودوا إلى كتابِ اللهِ وسنّةِ رسوله، وانظروا في جميع المذاهبِ الإسلاميّة وتبنُّوا ما كان منها قائماً على كتاب الله وسنّة الرسول، لأنها معينٌ لكم، ورحمةٌ من الله العليّ الحكيم فيما توصل إليها فقهاؤنا الأبرار. وعلى كل حال، انظروا أيّها أقرب إلى الله ورسوله فاعملوا به، ولا تتنابذوا ولاتتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعاً وجددوا إيمانكم وأعمالكم.
وإذا كان هناك من فئةٍ تائهةٍ فستعود إلى رشدها، إن شاء الله ولو بعد حين.
ونحن بدورنا، أوضحنا في هذا الكتاب ما اتُّفق عليه عند جميع المسلمين - من أصحاب المذاهبِ الخمسة - حول المشاكل التي أفرزها تطوّرُ الأوضاع في حياة الأمة، وما نشأ عنها من أحكام وإشكالات.. والاجتهاد كما قلنا سابقاً لم يوجد إلا لحلّ المشاكل، فاجتهدنا الرأيَ وأعطينا ما قدّرنا ربُّنا تعالى عليه لنبيّن الحلول للإشكالات علَّ في ذلك ما يُسهِّل أمور المسلمين. وقد آلينا على أنفسنا ألا نبديَ رأياً ونوضحَ فكرةً أو نعطيَ مفهوماً قد يتعارض مع حقيقة الإسلام، فإنّ من أشدٍّ الكبائر تحليلَ حرام أو تحريمَ حلال، ومعاذَ الله أن يناديَ مسلمٌ مؤمنٌ بتحليل ما حرّم الله تعالى أو تحريمِ ما حلّل، فحلال محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الحلالُ إلى يوم القيامة، وحرامُ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الحرام إلى يوم القيامة.
ونستجير بـالله العلي العظيم أن نرتئِيَ رأياً ارتجاليَّاً لا يكون فيه مصلحة للإسلام وللمسلمين...
ونرجو الله تعالى، ربَّنا وخالقَنا أن نكون قد وُفّقنا - بعونه - لحلّ بعض الإشكالاتِ المتنازِع عليها في هذا المؤلَّف، إنه سميع مجيب.
تمَّ بعون الله وقوّته المجلّد الثاني (في العبادات)
ويليه المجلد الثالث
في
العقود والمعاملات والمطعومات
موسوعة الأحكام الشرعية الميسَّرة
بين يدي القارئ الكريم مصنف جديد في بابه، يتفيَّأ مصنفه ـ بصريح اللفظ والنية ـ تناولَ الإسلام ديناً كاملاً. ولهذا ركَّز وأكَّد ـ على ضرورة الرجوع في استنباط الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة، اللذين اكتملت بهما أحكامُ الشريعة، ولم يبق أمام أهل العلم والاختصاص إلاّ تتبع هذين المصدرين فحسب، وأن ينفسح المجال لذوي العقل والنُّهى في أيامنا أن يعالجوا اجتهادهم. وكأنه يؤيد المقولة المشتهرة: (نحن رجال وهم رجال)، فمثلما كان معظم الصحابة أهل علم واجتهاد، نحن بأمسّ الحاجة إلى الصحوة على الإسلام كما رَضِيَه الله ـ تعالى ـ للناس ديناً، ولسنا بحاجة إلى الصحوة على إسلام المذاهب والطوائف، لأن المذهب ـ أيّاً كان ـ يَحجُرُ على معتنقه أن يتفلَّت منه. وإذاً: فلينفتح المسلم على كل جديد وحديث، ويعتمد على نفسه في فهم الأحكام الشرعية واستنباطها.
ويرى المصنِّف أنَّ الاجتهاد ليس بالسهل الميسور؛ إلاّ أن يكون المجتهد الحديث على اتساع بمعرفة اللغة العربية وعلوم القرآن والحديث والشريعة، وبشرط الوقوف على مجالات الاجتهاد وشروطه كما قررها علماء التراث، وأن يحققها في نفسه، إلاّ أنه يبقى ميسوراً لمن اشتدت همته وصحّت عزيمته.
ولدى المصنَّف قناعةٌ واقتناعٌ بانبعاث هذا المجتهد المعاصر الذي يستند في اجتهاده إلى الأصلين ـ الكتاب والسنة ـ. ولذا أمَدَّ موسوعته هذه، وزكَّاها بدعواته وحماسته. ونسأل الله له ـ ولنا ـ التوفيق والسداد.
الدكتور محمد السعدي فرهود
رئيس جامعة الأزهر
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢