نبذة عن حياة الكاتب
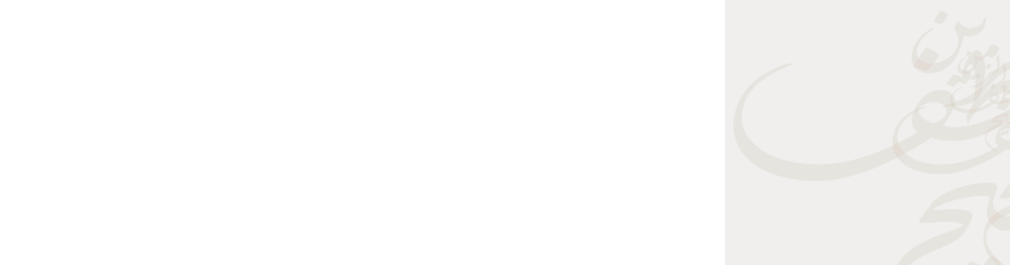
X
حكم الجهاد وقواعده
الجهادُ لغةً، مأخوذٌ من الجهد، أي المبالغة في العمل. أو هو مأخوذٌ من الجهد، كأنْ تقول: جاهدتُ العدوَّ جِهاداً ومجاهدةً، إذا حملت نفسك على المشقة في قتاله. والجهاد، في الاصطلاح الشرعي، هو بذل الجُهد، أي بذل الوُسعِ في قتال الكفار، ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان. وقد قال الله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التّوبَة: 41]. وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *} [التّوبَة: 111].
والجهادُ الذي يقوم بمقتضاه مجاهدٌ وهو يجود بنفسه في سبيل الله - عزَّ وجلَّ - هو في الحقيقة منتهى ما يجود به الإنسان. وهذا البذُل العظيمُ لا يقدَّرُ بمقاديرَ بشريةِ، ولا يقاسُ بمقاييسَ إنسانيةٍ لأن من شأنه أن يجعل لصاحبه لسانَ صدق، وذكراً عظيماً ومقاماً رفيعاً في التاريخ البشريّ من ناحية، وأن يخلّد صاحبَهُ في جنات النعيم من ناحية ثانية، لأنه يكون من الشهداء الأبرار الذين قال فيهم المولى تبارك وتعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *} [آل عِمرَان: 169-170]. وهذا يعني أن هؤلاء الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، والذين اختارهم واجتباهم - سبحانه وتعالى - لهذا الشرف العظيم - للشهادة في الدنيا - قد جعلهم فرحين بها، لما فيها من تضحية يقابلها نعيمٌ مقيم، وفي درجةٍ عاليةِ من درجات جنات الخلد. كما يعني أن التوفيق للشهادة فضلٌ كبيرٌ من الله العليّ العظيم لا يمكن أن يُدانيَهُ فضلٌ. ولا يكون الشهداءُ مطمئنِّين إلى العاقبة المحمودة التي تنتظرهم، إذ لا خوفٌ عليهم من عذاب الآخرة، ولا هم يحزنون يوم الحساب الذي ينتظرُ الناسَ جميعاً، بعد أن فازوا برضى الله تعالى. وذلك هو الجزاء العظيم، الذي تميّز به الشهداء والمجاهدون في سبيل الله، عن غيرهم من سائر البشر.
من هنا كان الجهاد في الإسلام، بمعانيه الحقة، أي الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس، هو ذروةُ السنام، وسياجُ الأحكام، والدرعُ الواقي للمسلمين ولبلادهم. لقد جعلَه اللهُ تعالى أسمى سبيلٍ لعزّة المسلمين وكرامتهم وسيادتهم، وأمره ماضٍ إلى يوم الدين. وما ترك قومٌ الجهادَ إلاّ ذَلُّوا، وغُزوا في عقر ديارهم، وخذلَهم ربُّهم، وسلَّطَ عليهم أشرارَ الناسِ وأراذِلهم.
وقد فرض الله تعالى الجهادَ على المسلمين في السنة الثانية للهجرة، وذلك عندما نزل قولُهُ الكريم: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ *} [البَقَرَة: 216].
ولذلك كان الجهادُ فريضةً عند جميع أئمة المسلمين. أما الإمامية فيعتبرونه فرعاً من فروع الدين التي هي عندهم: الصلاة، والصومُ والزكاةُ والحجُّ، والجهادُ في سبيل الله. ولذا دأبوا - منذ القدم - على تلقين أطفالهم الجهاد، وتنشئة أبنائهم على أصول الدين في العقيدة وفروعه، حتى يشبّوا وقد رسخت تلك الأصول في نفوسهم، وأصبحت تلك الفروعُ قوامَ حياتهم.
الجهاد فرض كفاية:
ليس الجهادُ فرضَ عينٍ على كل فرد من المسلمين بل هو فرضٌ على الكفاية، فإذا قام به البعض وحصلت به الكفاية سقط عن الباقين. وإذا وقع القتالُ ولم يرتدَّ العدو أو يرتدعْ أصبح الجهادُ فرضَ عينٍ على الأقرب فالأقرب، حتى تتحقق هزيمة العدو ودحره، ويتم النصرُ للمسلمين نهائيّاً بهزيمة عدوهم وكسر شوكته.
وبناء على ذلك فإن الجهادَ ينتقلُ من فرضِ كفاية إلى فرضِ عينٍ في ثلاثة مواضع:
أوَّلاً - إذا التقى الجمعان (المسلمون وأعداؤهم)، حرِّم على مَن شهدَ المعركةَ الانصراف عنها. وأصبح القتالُ فرضَ عينٍ على كل فردٍ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفَال: 45].
ثانياً - إذا هاجم الكفارُ بلداً من بلاد المسلمين، تعيّن على أهله جميعاً قتالُهم، ودفعُهم خارجَ البلاد.
ثالثاً - إذا استنفر الإمامُ أو نائبُهُ قوماً، لزمهمُ النفيرُ معه، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} [التّوبَة: 38]. وقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً} [التّوبَة: 41].. فإذا عمَّ النفيرُ خرجت المرأة من غير إذنِ زوجها، وجاز للولد أن يخرجَ بدون إذن والديه.
ذلك هو حكمُ الله تعالى في الجهاد، باتفاق جميع المذاهب.
والجهادُ بالمعاني التي تقدمت يمكن أن يكونَ له اتجاهان:
الأول : ما يتعلق بالغزو الذي يقوم به المسلمون لأعداء دينهم، فيكون هذا الجهاد فرضاً على الكفاية. ولا يكون - في هذه الحالة - إلاّ لإزالة الحواجز، والوسائل المادية من وجه الدعوة الإسلامية، ومن ثمَّ ترك الخيار للناس من أهل الكتاب كي يميزوا ما بين الدين الإسلاميّ وبين معتقداتهم الأخرى. وقد اعتبر هذا الجهاد فرضاً على الكفاية لأنه يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هنا وجب على المسلمين الغازين أن يبدأوا قبل الشروع بالقتال بالدعوة إلى الإسلام، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا أمَّر أحداً على جيشه، أو عيّن قائداً لسريّته أوصاه بتقوى الله تعالى، وبالمسلمين خيراً، ثم عيّن له القواعدَ التي يجب اتّباعها بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أُغُزُ باسم الله في سبيل الله قاتِلْ من كفر بـالله. اغزُ ولا تغلّ(+)، ولا تغدر، ولا تمثِّل، ولا تقتل وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعُهم إلى ثلاث خصال: الإسلام، والهجرة وإلاَّ فالجزية، فأيتهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكفَّ عنهم»(+).
الثاني : ما يتعلق بمهاجمة العدو لأرض المسلمين، فيصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلاد التي هاجمها العدو، ثم الأقرب فالأقرب من أهالي البلدان الإسلامية الأخرى، حتى يتحققَ النصر للمسلمين، وردُّ عدوهم من ديارهم.
حكمة الإسلام من الجهاد:
من المفاهيم الحقة التي يقوم عليها الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قد بعث لكل قوم نبيَّاً أو رسولاً منهم، إلاّ محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد بعثه للناس أجمعين بقوله عزَّ وجلَّ: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سَبَإ: 28]. كما أرسله - سبحانه - رحمة للعالمين لقوله العزيز: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ *} [الأنبيَاء: 107]. ولذلك يقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما أنا رحمة مهداة» (+).. ولما قيل له: ادعُ على المشركين، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إني لم أبعث لعّاناً وإنما بُعثت رحمة مهداة»(+).
ومَنْ أَصدقُ قيلاً من الله تعالى؟ فعندما يقول ربُّ السماوات والأرض إنه أرسل محمداً للناس كافة، ورحمة للعالمين، فمعنى ذلك أن الدين الذي بُعث به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الدين الذي أراده الله تعالى للبشرية كلها، كي يعمَّ أرجاءَ الأرض، وينعمَ الناسُ بهدايته، ويستظلون بظلاله الوارفة التي تضمن للناس الأمنَ والسلامَ والسعادةَ، ولا يتحقق لهم ذلك ما لم يبلَّغ هذا الدين للناس كافة.. ولكن على من تقع تبعةُ ذلك؟ إنّ تبعة إبلاغ الدين الإسلامي الحنيف لا تقع إلاّ على الأمة الإسلامية التي تسير على نهج محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتحمل الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه. وهو أمر يقع على عاتقها حملُهُ إنفاذاً لأمر رب العالمين، الذي انتدبها لنشر الإسلام، وإيصاله إلى الناس في كل بقاع الأرض، وإلى مختلف الأمم والشعوب. مما يفرض عليها واجباتٍ كبيرةً وعظيمةً يدخل في صلبها دعوة بني البشر إلى عبادة الله الواحد الأحد، وإعلاء كلمة الله وجعلها هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ومن ثمَّ تحرير الجماعات البشرية من الضلال، والجهل، والظلم، والتمييز العنصري... وكلِّ المثالب والشرور التي تجتاح الناس في مشارق الأرض ومغاربها.
وما دامت تلك مهمةَ الأمة الإسلامية، فقد بات لزاماً عليها أن تحافظ على كيانها الداخليّ، وأن تقوّيَ صفوف أبنائها لتصبح صَفّاً متراصّاً ويداً واحدة. ثم لتكافحَ وتجاهدَ في سبيل الله - تعالى - جهاداً منظماً اختارها له العليّ القدير من دون سائر الأمم. وكل تقصير في واجبها، أو إهمال في الحفاظ على وحدتها، وتماسكها لتعزيز قواها، يعتبر انتكاساً لها تجازي عليه بالذل والخسران، وبالتفكك والانحلال.. وما هذا الضعف الذي نراه في المسلمين اليوم، وما هذه المصائب التي تنزل بهم في عصر الضعف هذا، إلا نتيجة حتمية لتقاعسهم عن واجبهم الإلهي، وأوله الابتعادُ عن حقيقة الجهاد المنظّم في الدين الإسلاميّ، وثانيه عدم الامتثال لكثيرٍ من أوامر ربهم العزيز الحكيم.
ولقد نهى الإسلام، في الأساس، عن الوَهْنِ أمامَ الاعداءِ، ومنع الاستسلام إلى الدعة، ما دامت الأمة لم تصل إلى هدفها ولم تحقق ما انتدبت له. واعتبر السلم في هذه الحالة، لا معنى له إلاّ الخنوع والهزيمة، والقبول بالذل، والدون من العيش. وفي هذا يقول الله تعالى: {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ *} [محَمَّد: 35]. أي لا تضعفوا أيها المسلمون، ولا تستهينوا بقواكم، ولا تتوانَوا عن نُصرة دينكم، ولا تَدْعُوا الكفارَ إلى السِّلم والمصالحة، وأنتم الأعلَون عقيدةَ وعبادةً، وأنتم القاهرون الغالبون لهم بإذن الله تعالى. فالنصر دائماً من عند الله، ووعدُ الله حقٌّ بأن ينصر عباده المؤمنين الصادقين لقوله تعالى: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ *} [آل عِمرَان: 160].
والسلم في الإسلام لا يكون إلا عن عزٍّة واقتدار، ولذا لم يجعله الله تعالى مطلقاً، بل قيده بشروط ثلاثة:
1 - أن يكفَّ العدو عن عدوانه.
2 - إلاَّ يُفتنَ أحدٌ في دينه.
3 - ألاَّ يبقى ظلمٌ في الأرض.
وإذا وُجدَ أحدُ هذه المظالم الثلاثة، فقد أَذِنَ اللهُ تعالى للمسلمين بالقتال لأنه - سبحانه - قد حرَّم على نفسه الظلم، فكرهَهُ مِن عباده ولعباده «والله لا يحب الظالمين».
والقتال من أجل رفع الظلم والمظالم، هو قتال في سبيل الله، فوجب أن تُسترخصَ لأجله الأنفسُ، وأن يُضحى في سبيل دفعه كل غال ونفيس. وذلك لأمرين اثنين:
الأول : لأن الله سبحانه لا يحب الظلمَ وأهلَه وهذا هو الأساس والمنطلق.
والثاني : لأنه يرمي إلى الحفاظ على الجنس البشري، وعيشه عزيزاً، كريماً، مطمئناً على حياته، وماله، ودياره، وهذا هو الهدف والمبتغى.
وبعد هذا، أيةُ عقيدةٍ من العقائد، أو شرعةٍ من الشرائع، سماويّةً كانت أم أرضيّةً، تدفعُ بأهلها إلى خوض غمرات القتال، وتقذفُ بهم في ساح الوغى والمعارك بهدف حفظ الإنسان ورفع الظلم عنه، غير العقيدة الإسلامية، وغير هذا الدين الكريم الذي فرضَ على أتباعه الجهادَ لنصرة المستضعفين والمظلومين، ولإحقاق الحق، وإقامة العدل والمساواة بين الناس جميعاً، حتى يعيشوا حياةً كريمةً، طاهرةً، صافيةً، ويعمَّ الإيمان والسلامُ ربوعَ الأرضِ كلها، وينشرَ الخيرُ لواءَه على البشرية جمعاء؟. حقّاً ليس من دينٍ غير الإسلام أوجب مثلَ هذا الجهاد، وأقرَّهُ فرضاً دينيّاً ودنيويَّاً على أتباعه.
ولنستمع، أيها الناس كافة، إلى الأمر الربانيّ، وهو ينتدبُ فيه أبناء الإسلام، ويحضُّهم على بذل كل الوسع والطاقة كل يجاهدوا في الله حقّ جهاده، حيثُ يقول: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ *} [الحَجّ: 78].
أما الميادين التي يشملها الجهاد في سبيل الله فهي: جهادُ الأعداء، وجهادُ النفس، وجهادُ الشر والفساد والظلم.. وهي كلها سواء في عقيدة المسلم الذي ينبري لهذا الجهاد.
وإنَّها لَمَكْرُمةٌ حقّاً للمسلمين أَن اجتباهم ربُّ العالمين لحمل أعظم أمانةٍ أَودعَها بين أَيديهم، أمانةِ الجهاد في سبيله تبارك وتعالى. وإنه لفضلٌ كبيرٌ منه - عزَّ وجلَّ - أنه هو يلقي بهذه الأمانة على عاتقهم لم يجعل عليهم حرجاً في الدين، ولا ضيقاً في الجهاد، بل جعله تكليفاً يتناسب مع فطرتهم البشريّة، ويأتلف مع القوى الكامنة في تكوينهم الإنسانيّ، بما يؤهلهم للعمل، والبناء والارتقاء في مراتب السمو والرفعة التي يستحقها خَلْقُهم الآدميّ.
أفرأيتم أيها المسلمون هذه المكانةَ التي تفضَّل بها عليكم خالقكم العظيم، وهذا الاختيار الذي منَّ به عليكم ربّكم الكريم، عندما اجتباكم من دون الناس، لتجاهدوا في سبيله - عزَّ وجلَّ - عندما سمّاكم المسلمين، وعندما جعل الرسولَ الأكرمَ شهيداً عليكم، وجعلكم شهداءَ على الناس؟!.. فهل ترجو أمةٌ أعظمَ من هذا الرجاء، وهل يطلب بشرٌ أَوفى من هذا النصيب؟!
وتحقيقُ أمر ربكم فيكم، أيها المسلمون، وهو يخاطُبكم من عليائه «وجاهدوا في الله حق جهاده» إنما يكون - وباتفاق جميع أئمة المسلمين - لتحقيق هذين الهدفين الكبيرين:
1 - حماية الإسلام والمسلمين في الدفاع والهجوم، أي صون بلادهم وأعراضهم وكيانهم، ودينهم الذي ارتضاه لهم.
2 - نشر رسالة الإسلام، أي من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس.
أما من حيث الدفاع عن الإسلام والمسلمين فيجب على المجاهدين أن يتكوَّن لديهم اليقينُ في الأمور التالية:
- إعداد العدة للقتال، والأخذ بكل أسباب الأهبة والاستعداد لدرء كل عدوان، ومواجهة كل خطر، وبكافة الإمكانيات المتوفرة لدى المسلمين جميعاً، وذلك لقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفَال: 60].
والإعدادُ الذي يُرْهِبُ به المسلمون - والمجاهدون منهم خاصة - الأعداءَ، ويجعلونهم يحسبون لهم ألف حساب هو الإعداد الذي يأخذ بعين الاعتبار كل الظروف والأحوال والأوضاع، فيتغيّر تبعاً لتغيراتها، ويتطور بحسب المستجدات الدائمة والمستمرة، لأن لفظة «قوة» التي وردت في النص القرآني تتناول كل ما يتعلق بالحروب، وما تفرضه من مقومات وإمكانات مادية ومعنوية، وما تستلزمه من أدوات ووسائل وأساليب، أي القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها، وإلاّ فكيف يمكن صدُّ الغزاة، بل والانتصار عليهم؟ أما لفظة «رباط الخيل» فالمقصود منها أنه كان الأداة البارزة عند من كان يخاطبهم القرآن الكريم أول مرة.. ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين - مما سيجدُّ مع الزمن كما هو حاصل الآن في الطائرات المقاتلة والغواصات والصواريخ والآليات والقنابل - لكان الله سبحانه وتعالى قد خاطبهم بمجهولات محيِّرة - تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً - هذا فضلاً عن أن «رباط الخيل» يمكن أن يكنى به عن مفهوم «المرابطة» في كل زمان ومكان... والمهم هو عموم التوجيه: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة».
إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان.. وهذه القوّة تتطلب أموراً عدةً أبرزها:
الأمر الأول - أن يطمئن الذين اختاروا الإسلام عقيدةً على عقيدتهم، فلا يُفتنوا بعد اعتناقها.
والأمر الثاني - أن تُرهبَ القوةُ أعداءَ الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» التي تحميها تلك القوة.
والأمر الثالث: أن يبلغ الرعب بالأعداء أن لا يفكروا بالوقوف في وجه المدِّ الإسلاميّ وهو ينطلق لتحرير الإنسان..
والأمر الرابع: أن تُحطِّم هذه القوة كلَّ قوى الأرض التي لا تعترف بأَنَّ الأُلوهية لله تعالى وحده، وأن الحاكمية لله تعالى وحده.
والأمر الخامس: أنَّ الإسلام لا ينطلق بمنهجٍ من صنع البشر، ولا لتقرير سلطان زعيم، أو دولةٍ أو طبقةٍ أو جنسٍ، بل لإقرار المنهج الربّاني الذي أراده سبحانه وتعالى لدنيا الأرض، خاصة وأنَّ الإسلامَ هو منهجٌ عمليٌّ واقعيٌّ للحياة، فلا بد أن يواجهَ مناهجَ أخرى تقومُ عليها سلطات جائرة وتقف وراءها قوى مادية ظالمة.
وطبقاً لهذه الأمور فإنّ الإنسانَ المسلمَ يجب أن يدرك ما هو عليه، وأنه يجاهدُ من أجل إقرار منهجٍ من الله العليم الحكيم، وينبغي عليه أن لا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبرى، وأن لا يشعرَ بالخجل من طبيعة منهجه الربانيّ، وأن لا يقفَ بالدين موقفَ الدفاع، وكأنما يخشى العمل للمد الإسلاميّ، والجهاد في سبيل الله تعالى.
وعلى كل حال إن الله تعالى يأمر المسلمين المجاهدين في سبيله - عزَّ وجلَّ - أن يكونوا على بيّنةٍ من تلك الأمور، وأن يعدّوا للأعداءِ كل ما يستطيعون من القوة. ولذلك يدخل في هذا الإعداد:
- التجنيد لكل قادر على القتال والحرب.
- اتخاذ الحيطة والحذر الدائمين لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا *} [النِّسَاء: 71].
- الخروج لملاقاة العدوّ في العسر واليسر، لقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً} [التّوبَة: 41].
فهو إذن أمرٌ بإعلان النفير على العدو، في شتّى الأحوال التي يكون عليها المجاهدون.
وقد دعا الله تعالى المؤمنين إلى التحلّي بالصبر، والمصابرة على الألم والأذى، مما قد يصيبهم في فترة الإعداد وفي أثناء القتال والمواجهة. وذلك ليخففَ عنهم عبءَ تلك المواجهة، وليبينَ لهم أن أعداءهم لا يقلّون عنهم قلقاً وأذًى وألماً. فكما يتألم المؤمنون كذلك أعداؤهم يتألمون مثلهم، ولكن مع الفارق الكبير بين ما يرجوه المؤمنون من ربّهم، من خيرٍ كبيرٍ وفوزٍ عظيم، وبين ما يرجوه أعداؤهم من سلطانهم، وهو سلطانٌ أرضيٌّ زائلٌ مهما كان نوعه أو جبروته. وطبيعيٌّ أن ما يرتجيه المؤمنون هو أسمى مما يرغبه القوم المعادون. وقد قال سبحانه: {وَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ} [النِّسَاء: 104]. والحقيقة أن المؤمنين يرجون من الله تعالى إحدى الحسنيين: إما النصرُ وفيه اعتزازٌ واقتدارٌ، وهذا فضلٌ كبيرٌ من الله سبحانه. وإما الشهادةُ في سبيل الله، وهي الانتقال إلى ما هو أبقى وأرقى، لأن القتل في سبيل الله ليس فناءً - كما يتوهم الأعداء - بل هو عينُ الحياةِ الأبدية يحياها الشهداءُ وهم عند ربهم يرزقون من نعيمه وخلده، إذ قال عنهم تبارك وتعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *} [آل عِمرَان: 169].
2 - وأما من حيث العملُ لنشر رسالة الإسلام فإن الجهادَ يجبُ أن تتوفر له الشروط التالية:
- البلوغ والعقل. وهما من الشروط العامة لأي تكليفٍ شرعيّ..
- الذكورية، أي يكون المجاهدُ ذكراً.
- تأمين المجاهد نفقة عياله مدّةَ غيابه.
- سلامة البدن ليتمكن من القدرة على القتال، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ} [النُّور: 61].
- الاستطاعة المادية، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ *} [التّوبَة: 91-92].
ومن شروط هذا الجهاد أيضاً أنه لا يتحقّقُ إلاّ بإذن الإمام أو نائبه. والإمام هو الحاكم الشرعيّ على المسلمين. وعن هذا الجهاد يقول الله تعالى: {مَا كَانَ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *} [التّوبَة: 120-121].
فَمِنْ مجمل تلك الآيات الكريمة، يتضح لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يصوِّر للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) حالةَ مختلف فئات المسلمين من النواحي النفسيّة والجسدية والمادية، وذلك عندما دعاهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) للاستعداد والتهيئة للخروج إلى غزوة تبوك، لملاقاة جيش الروم بعد دعوة الامبراطور الروماني للدخول في الإسلام، واستعداد جيشه للزحف على أرض المسلمين.
وتبيّن تلك الآيات الكريمة مدى تأثير الدعوة للجهاد على المسلمين والحالات التي ظهروا فيها على الشكل التالي:
- تخلّف بعضهم عن تلبية الدعوة لأسبابٍ أبعدَ ما تكون عن حقيقة الإيمان والجهاد.
- اعتذار بعضهم الآخر بعدم قدرتهم على تأمين عدة القتال، وراحلة المسيرة، وبالتالي لإيجاد سبيل لهم للخروج من الجيش الإسلامي.
- تلبية أهل الإيمان الصادق أو المجاهدين دعوة الجهاد مهما كانت المشاقّ والمصاعب التي سوف يصادفونها، ومهما غلت العطاءات والتضحيات التي سوف يبذلونها.
وتتجلَّى في النصوص القرآنية الحقائقُ التالية:
- رأفةُ الله تعالى وعطفه الجميل على المعذَّرين الذين حالت ظروفهم الخاصة دون تلبية دعوة الجهاد والخروج مع الجيش الإسلاميّ. إذْ تولّوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعينهم تفيض من الدمع حزناً لعدم المشاركة.
- تأنيبُ الله - عزَّ وجلَّ - لكل من تخلَّف من أهل المدينة، ومن الأعراب، عن الخروج للجهاد بأبلغ أساليب التأنيب.
وترغيبُ الله - جلّ وعلا - للذين خرجوا مجاهدين بالأموال والأنفس في سبيل الله بأقوى أساليب الترغيب.
- نهيُ الله - سبحانه - المؤمنين عن الخروج جميعهم، لأن الغزو من أجل الدعوة ونشرها هو فرض على الكفاية. على أن ذلك كله كان في بداية العهد بالإسلام، وعندما كان المسلمون قِلّةً، بالمقارنة مع أعدائهم سواء في العدد أو في العُدَّة.
أما اليوم وبعد أن بلغ المسلمون ما بلغوه فإنَّه لا خيار أمامهم إلاّ تهيئةُ كل الأسباب والمقومات التي يفرضها الجهاد، ومراعاةُ شروطه بدقة قبل الإقدام عليه، حتى يكون جهاداً ناجحاً، لا مجرّدَ مظاهر أو دعواتٍ جوفاء يُفترى بها افتراءً على الإسلام والمسلمين، ومن ثَمَّ عدم الانقطاع عن التفكير بذلك أو التراخي عنه، لا سيّما بعدما أبان لهم القرآنُ الكريمُ أهميةَ الجهاد في حياتهم، وما ينتظر المجاهدين من مكرمات دلَّهم عليها ربُّهُم العليم الحكيم، وأظهرها لهم رسولُهُم الكريم بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من اغبرّت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار» (+). وقوله: «غدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ مما طلعت عليه الشمس وغربت» (+). وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الغازي في سبيل الله عزَّ وجلَّ، والحاجُّ والمعتمر، وفْدُ الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم» (+).
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ذروةُ الإسلام الجهادُ في سبيل الله لا يناله إلا أفضلهم» (+). وعن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «اتقوا أذى المجاهدين فإنَّ الله تعالى يغضب لهم كما يغضب للرسل، ويستجيب لهم كما يستجيب لدعاء الرسل» (+).
زمان القتال ومكانه:
- من حيث الزمان: لا يجوز القتال في الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لقول الله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التّوبَة: 5].
ولكن إذا حصل الاعتداء على المسلمين، وبدأ المعتدي بالقتال خلال تلك الأشهر، فقد أجاز الله تعالى لهم مواجهته بالقتال حينئذٍ دفاعاً عن أنفسهم، أو وجودهم، إذ قال سبحانه: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البَقَرَة: 194].. أي من شَهَرَ لكم العداء وأقدم على قتالكم في الأشهر الحرم فقاتلوه، كما يقاتلكم خلالها، وذلك قصاصاً له على عدوانه. فيكون الزمان الذي يجري فيه القتال ابتداءً هو كلُّ أيام السنة، ما عدا الأشهر الحرم، إلاّ في حالة الدفاع المشروع لصد الاعتداء فالقتال جائزٌ في كل وقت.
- من حيث المكان: لا يجوز القتال في المسجد الحرام وعنده إلاّ إذا ابتدأ المعتدي بالقتال، لقوله تعالى: { 2/191:1-25، 2/192:1-6 }.. فيكون المكان الذي يجوز القتال فيه، هو كلُّ مكانٍ من حيث الابتداء به، ما عدا المسجد الحرام.
قتال الجائرين:
كل من أعان جائراً ظالماً، بأيّة طريقة من طرق العون، فقد عصا الله - سبحانه وتعالى - واستحقَّ العقابَ، وضَمِنَ كلَّ ما أتلف، وكلَّ ما جنى عليه، وذلك حتى ولو كان يحارب باسم الدعوة الإسلامية. وأما إذا كان التطوعُ لأجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين، فهو جائز حتى ولو كان في جيشِ إمامٍ جائرٍ، وكذلك القتال في صفوف هذا الجيش.
الدعاء قبل البدء بالقتال:
عندما يكون الجهادُ لإعلاء كلمة الله تعالى، فإنه يَحْسُنُ بالمجاهدين، قبلَ البدء بالقتال، أن يستغيثوا ربَّهم وخالقهم، ويستنصروه على أعدائهم، مع إيمانهم بأن النصر لا يكون إلاّ من عند الله تعالى. ومن دعاه - سبحانه - في مثل هذا الموقف استجابَ له، ولا يردُّه خائباً لقوله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} [الأنفَال: 9]، وقول رسوله الكريم: «اثنتان لا تُردَّان: الدعاء عند النداء وعند البأس وحين يُلحِمُ بعضُهُم بعضاً» (+) وقد روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نصح قائلاً: «أيها الناس! لا تتمنَّوا لقاءَ العدو، وسلُوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» (+) ثم دعا الله تعالى، بهذا الدعاء الرائع: «اللّهُم منزِّلَ الكتابِ، ومجريَ السحاب، وهازمَ الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم».
من يجوز قتله من الأعداء:
من الجائز قتلُ الجنود الذين يشاركون في الحرب ضد المسلمين.
ولكن بالمقابل:
لا يجوز قتلُ القوم الأعداء غيرِ المقاتلين أو المشاركين فعليّاً في قتال المسلمين مثل: المرأة، والصبيّ والشيخ الهرم الفاني، والمريض المقعد، أو المعاق، والمعتوه، أو الراهب الذي يتعبًّد في صومعته وكذلك لا يجوز قتلُ الفلاحين في حقولهم، والصنّاع في مصانعهم، والتجار في متاجرهم، والموظفين في مكاتبهم إلاّ إذا شاركت هذه الفئات إفراديّاً في القتال بأي نوع من أنواع المشاركة، سواء كان بالفعل أو القول أو الرأي أو الإمداد بالمال وما إلى ذلك، وإذا كان لمشاركتهم تأثيرٌ على سير المعركة ونتائجها. فمثلاً يجوز قتل الشيخ الطاعن المقدِّم المشورة والرأي، أو قتلُ المُمَوِّل ومقدِّم الإمداد، لأن هذا القتل من شأنه أن يصدِّعَ صفوف الأعداء، وأن يخففَ من أسباب قوتهم، لما يكون له من تأثيرِ على النفوس وجمعِ الشمل والتكاتف.. وعلّةُ جوازِ هذا القتل هو مصيرُ المعركة. أي عندما تقتضي المصلحة العامة للمسلمين في تحقيق النصر جواز هذا القتل فيصبح ضروريّاً القيام به.
فالقاعدة الأساسية عدم جواز القتل لغير المشاركين فعليّاً في المعركة. والأدلّةُ على ذلك ثابتة بأقوال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنها: «لا تقتلوا امرأةً ولا وليداً» (+). وعن أبي العباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان إذا بعث جيشه أوصى قادته قائلاً لهم: «انطلقوا باسم الله، وبـالله، وعلى مِلّة رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأة. ولا تَغُلّوا(+)، وضمّوا غنائمكم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» (+).
ووفقاً لتعاليم الإسلام ومضامينها، فإنه بعد الانتهاء من القتال وأخذ الأسرى، فكلُّ من لا يحِلُّ قتلُه أثناء القتال، لا يحلُّ بعد الفراغ منه. أما من كان يحلُّ في حال القتال، فإن قاتل يباح قتله بعد الأسر إلاّ الصبيَّ، والمعتوه الذي لا يعقل - وإن كان يحلُّ قتلهما إبَّان القتال إذا اقتضت ظروفه ذلك - فإن قتلهما وأسرهما غيرُ مباحين بعد وقف القتال حتى وإن قتلا بعضاً من المسلمين، لأن القتل بعد الأسر يعتبر عقاباً، وهما ليسا من أهل العقوبة. أما مبرّرُ قتلهما أثناء سير المعركة فلدرء شرّ المقاتلين، أي عند وجود الشر منهما يباح قتلُهما لدفع هذا الشر. وعلى المسلمين ألاَّ يغدروا، ولا يغلّوا، ولا يمثّلوا بالأعداء.
التحرُّف والتحيّز:
لقد أمر الله تعالى المؤمنين بالثبات عند الزحف وملاقاة العدو، وذلك بقوله الكريم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *} [الأنفَال: 45].. ومع ذلك فقد يفرُّ البعض متحرّفين(+) أثناء القتال، عندما يغلب على ظنهم أنهم مقتولون لا محالة. ويكون هذا التحرّف كي ينحازوا (أي ينضمّوا إلى فئة من المسلمين غير فئتهم، ثم ليعيدوا إلى المعركة مطبقين على عدوهم، بعد إيهامه أنه فرُّوا من أمامه، وتركوا المعركة إلى غير رجعة).
وعن هذا التحرُّف أو التحيّز يقول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ *} [الأنفَال: 15-16].
وقد يكون التحيّز أيضاً بترك فئة مسلمة والانضمام إلى أخرى، في حال قتال الفئة الباغية. إذ عندما يتيقَّن المؤمن أنه كان في صفوف الفئة التي تبغي على الأخرى فإن الخروج من صفها والانحياز إلى الفئة العادلة قد أجازه الله تعالى حتّى لا يبوء المؤمن بغضب الله، من نصرة البغاة الطغاة.
وأخيراً فإنه يحرم على المسلمين بيعُ أهل الحرب السلاح ونحوه من الوسائل التي يتقوى بها الأعداء.
إذْنُ الوالدين للجهاد:
للوالدَيْن أن يمنعا ولدهما من جهاد الغزو، شريطة أن لا يأمرَه الإمامُ أو نائبه بذلك، أو ألاَّ يحتاجه الجيش لكفاءته العسكرية، أو خدمته في أرض المعركة، إذ يجب الجهاد عليه عيناً في مثل هذه الحالات، سواء أرضي الوالدان أم رفضا، إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.
فضل المجاهدين على القاعدين:
قال الله تعالى: {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا *} [النِّسَاء: 95].
فـالله تعالى، فيما يتعلق بالجهاد، يميِّز بين فئاتٍ ثلاثٍ من المؤمنين:
الفئة الأولى وتشمل المؤمنين القاعدين الذين لم ينفروا لدعوة الجهاد.
الفئة الثانية وتشمل أولي الضرر (الأعرج والأعمى والعاجز والمريض..) وهؤلاء لا شأن لهم هنا، ولا يتناولهم الذكر العظيم في هذا المقام.
الفئة الثالثة وتشمل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.
أما المؤمنون القاعدون، الذين تخلفوا عن الجهاد، وفضلوا القعود في منازلهم وعدم الخروج لملاقاة العدو، فهم لا يستوون، في الفضل عند الله تعالى، مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهؤلاء المجاهدون فضّلهم الله على القاعدين درجة. وهذه الدرجة يمثلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقامهم في الجنة كما ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض».
والله سبحانه وتعالى يعد المجاهدين القاعدين الحسنى. ذلك أنهم جميعاً مؤمنون، والإيمان له وزنه وقيمته في الحساب عند الله عزَّ وجلَّ، ولكن مع التفاضل بين أهله، بحيث لا تكون الحسنى واحدة بين مؤمن مخلصٍ ولكنّه مقصّر، وبين مؤمنٍ مخلصٍ غير مقصّرٍ في أية طاعة من الطاعات، وخاصةً بالجهاد..
ثم يؤكد - عزَّ وجلَّ - بأنه فضَّل المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً، بأن يرفعهم درجاتٍ في المقام، وأن يثيبهم مغفرةً ورحمة، بما ينبئ فعلاً عن الأجر العظيم الذي ينالونه على جهادهم والقيام بأعبائه.
وهذا الحكم الذي يتناول المؤمنين المقصرين وغير المقصرين لا يصح إلاّ عندما يكون الجهاد فرضاً على الكفاية. أما إذا أصبح الجهادُ فرضَ عينٍ فعلى القاعدين أن يجاهدوا، وإلاّ فيُعتبرون متقاعسين عن الجهاد، ومتخلفين عن القتال، أو فارِّين منه، وحينئذٍ فإن الأمر لله تعالى، يقضي عليهم بما يستحقون من عقاب على قُعودهم وتخلُّفِهم.
الاستعانة بأهل الذمة وأهل الشرك:
يجوز الاستعانة بأهل الذمة والشرك، إن لم يختاروا القتال مع جماعاتهم، وآثروا القتال تحت راية المسلمين، حتى لا يُنسب النصر إليهم.
ولكن يشترط لتلك الاستعانة أن يكونَ في المسلمين قلّة، وهم بحاجة لهم. وأن يأمنَ المسلمون غدرهم، ويركنوا حين القتال لأمانتهم.. وانطلاقاً من هذه القاعدة فقد استعان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصفوان بن أمية قبل إسلامه، وذلك في حرب هوازن. كما استعان الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) بيهود بني قينقاع قبل نكثهم العهد معه، وخصَّهم بشيء من المال. أما إذا كان الكتابيُّ، أو المشركُ، غيرَ مأمونِ العاقبة، أو إذا كان المسلمون بغنى عنه، فلا تجوز الاستعانة به إطلاقاً لقول الله تعالى: {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا *} [الكهف: 51].. أي عوناً. ذلك أنه لا يريد - سبحانه وتعالى - من المسلمين المؤمنين أن يتخذوا من الضّالين، أو من المغضوب عليهم، عوناً لهم في قضايا تخصّ المسلمين، ولا يريد عزّ وجلَّ - أن تحصل النصرة إلا بالمسلمين أنفسهم، لأن الضالين والمغضوبَ عليهم لا يمكن أن يكونوا أبداً عوناً لجند الله، أو سنداً لمن يقاتل في سبيل الله. فكان على المسلمين عدمُ الركون إليهم، واتخاذهم عضداً لهم.
الذميّ والحربيّ باصطلاح الفقهاء:
ليس معنى الحربيّ، عند الفقهاء، من أعلن الحربَ على المسلمين. بل إن كلَّ من لا كتابَ له، أو من يشتبهُ بأن له كتاباً، فهو من أصناف الكفار، وبالتالي فهو الحربيّ، الذي لا تقبل منه الجزيةُ باتفاق جميع الأئمة. أما من له كتابٌ، أو يشتبهُ بأنه من أهل الكتاب، كالمجوسيّ، فيكون أحد صنفين:
- إما ذميّ، وهو من يقبلُ بشروط الذم ويلتزم بها.
- وإما غير ذمّي، وهو من يمتنع عن قبول شروط الذمة، وحكمه حكمُ الحربيّ.
والذميّ الذي يدخل في ذمة المسلمين وعهدتهم، لا يجوز التعرضُ له بسوء. بل على المسلمين أن يدفعوا عنه كلَّ اعتداء ما وفى بشروط الذمة، وهي:
أ - أن يدفعَ الجزية.
ب - أن يتقاضى في المرافعات عند المسلمين ويقبلَ أحكامهم.
ج - أن يتركَ التعرضَ للمسلماتِ بالزواج منهن.
د - أن لا يبشِّرَ، أو يبثَّ الدعوةَ ضدّ الإسلام.
هـ - أن لا ينكح المحارم.
و - أن لا يتظاهر بارتكاب المنكرات كشربِ الخمر أو أكلِ لحم الخنزير وغيرها من المحرّمات.
ز - أن لا يُؤوي إليه أعداءَ الإسلام والمسلمين.
ح - أن لا يتجسّسَ على المسلمين.
انتهاء الحرب:
وتنتهي الحرب، ويوقفُ القتال، بطرقٍ عدة، ومنها:
1 - اعتناقُ الإسلام، من جميع المحاربين، أو من بعضهم فكل من دخل في الإسلام يصبحُ مسلماً، ويكونُ له ما للمسلمين وعليه ما عليهم من الحقوق والواجبات. 2 - رغبةُ المحاربين في وقفِ القتال، والبقاءِ على دينهم مع دفع الجزية، فيجابون إلى طلبهم، ويتمُّ من جرائه عقدُ الذمة بينهم وبين المسلمين.
3 - هزيمةُ المحاربين، وانتصارُ المسلمين عليهم. وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين.
4 - طلبُ المحاربين، أفراداً أو جماعاتٍ، الأمانَ من المسلمين، فيجابُون إلى طلبهم.
5 - طلبُ المحاربين، أفراداً أو جماعاتٍ، الدخولَ في دار الإسلام، فيجابون إلى طلبهم.
قتال الفئة الباغية:
يرتكز الدافعُ للقتال في الإسلام، دائماً، وبصورة رئيسيّة، على إحقاق الحقّ وإبطال الباطل. وقد يحصل الخلافُ بين المسلمين أنفسهم، وينشبُ بينهم القتال.. وهذا أمر طبيعي، تبعاً لسنّة الله في خلقه، بما ركّز في طبائع البشر من الدوافع والانفعالات، والأهواءِ والغايات المتناقضة.. فليس عيباً أن يحصل ذلك، ولكنّ العيبَ في عدم التصدّي له، ووضع الحلول الملائمة التي تحفظُ الحقوقَ وتعيدُها لأصحابها. من أجل ذلك وُجدت في الإسلام القواعد التي من شأنها إنهاءُ القتال، أو فض الخلافات التي يمكن أن تقومَ بين المسلمين. والغايةُ من القواعد الشرعيّة التي وضعها الإسلامُ كذلك هي صيانة المجتمع الإسلاميّ من الخصام والقتال، أو النزاع والتفكك، وإعادتُه إلى أوضاعه الطبيعية السليمة.
وأهم تلك القواعد، التي سنَّها ربُّ العالمين، ما ورد في قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *} [الحُجرَات: 9-10].
قلنا بأنه قد يحصل قتالٌ، لسبب أو لآخر، بين جماعتين من المسلمين. وفي هذه الحال أمر الله تعالى القائمين على شؤونهم العامة أن يصلحوا بينهما، ويُسووا الخلاف، وينهوا القتال بالطرق السلميّة العادلة..
فقد تظلم جماعة جماعةً أخرى مسلمة. وعند وقوع هذا الظلم الذي يكون فيه اعتداء، والذي يسميه الله تعالى بالبغي، لأنه اعتداء بدون وجه حق، يجب على المسلمين، والمسؤولين منهم خاصة، ردعُ الجماعة الباغية. فإن رجعت إلى طاعة الله، وتركت القتال كان خيراً لها وللأخرى، وإلاّ وجب قتالُها، لأن الإسلام يأمر بنصرة المظلوم على الظالم، ومنع المسلم عن الظلم، وإعادة الحق إلى أهله.
ولو أخذنا هذه القاعدة الإسلاميّةَ في محاولةٍ لتطبيقها على واقع العالم الحاليّ، فماذا نجد؟.
من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي تتزعم العالم اليوم، وهي تحاول فرض نظام عالميٍّ جديدٍ وفقاً لمفاهيمها، متخذةً «الأمم المتحدة» وأجهزتَها كافَّة وسيلة لذلك، ولا سيما مجلس الأمن الدولي الذي أناط به ميثاقُ المنظّمة حفظَ السلام والأمن الدوليين.. فلو أن الولايات المتحدة الأميركية، أخذت بتلك القاعدة الإسلاميّة التي تفرضُ قتال الفئة الباغية، أي المعتدية على غيرها، وذلك بأن تعمد فعلاً إلى ردع أو مقاتلةِ أيةِ دولةٍ تعتدي على غيرها من الدول الأخرى.. لو أنها تفعل ذلك لما كنا نشهد اليوم تلك الحربَ الضروسَ الظالمةَ على المسلمين في البوسنة والهرسك، ولما كنا نرى الحروبَ الداخليّةَ في الصومال، أو أثيوبيا، أو في السودان أو أيّةِ دولةٍ أخرى.. ولكانت الولايات المتحدةُ وجدت فعلاً تأييداً عالمياً، لا يضاهيه أيُّ تأييد، سواء في فرضِ نظامها الجديد، أو في مناصرتها لردع البغي والظلم في شتّى أنحاء العالم..
ولكن أنّى للولايات المتّحدة أن تفعلَ ذلك، بل وأنّى لها أن تطبّق قاعدةً إسلاميّةً، أمر بها الله تعالى، ونحن نراها تحزمُ أمرها، وتجيّش جيوشَها، ومعها أعظمُ القوى لمحاربة العراق في اجتياحه الكويت، زاعمةً أنها تقاتلُ الفئةَ المعتدية، في حين أن غرضها الأساسيَّ هو استغلالُ الخليج والتمركزُ في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وهي حين تفعل ذلك لا تحرك ساكناً اتجاه الاعتداءات الاسرائيلية التي تصب ناراً وتقذف حمماً على لبنان، كما أنها لا تحرك ساكناً تجاه المعتدين على المسلمين من عدو غاشم ظالم في أوروبا الشرقيّة.. فهل هذا هو العدلُ الدَّوليّ؟ وهل هذه هي مبادئ ُ شرعةِ حقوقِ الإنسان؟ وهل هذه هي أحكامُ ميثاقِ «الأمم المتحدة»؟!..
من هنا، ولأن الدّولَ، كافةَ الدّول، وزعيمتها الولايات المتحدة الأميركية، لا تبتغي إلا مصالحها، فقد بات لزاماً على المسلمين أن يعوا حقيقةَ واقعهم، وهو أنه لا يوجد ناصرٌ لهم، يأخذ بأيديهم، ويعملُ على حلّ خلافاتهم ونزاعاتهم، غير أنفسهم. وأن يدرك ذلك أولو الأمر فيهم - أصحابُ السلطة والحكم، وذوو الرأي والمشورة -. كما عليهم أن يعلموا تمام العلم بأن لا مرجعَ يحتكمون إليه إلا الإسلام، لأنهم جميعاً إخوةٌ في الدين، وهو الدينُ الذي يدعوهم لإصلاح ذات البين فيما بينهم، لعلَّ الله تعالى يرحمهم في الدنيا والآخرة.
وأهم ما يترتب على الإخوة في الإسلام أن يَسُودَ بينهم الحب والألفة، والأمن والسلام، والتعاون والتلاحم، وأن يكون ذلك كله هو الأصل في علاقاتهم ببعضهم بعضاً، وأن يكون الخصام والتنابذ، والنزاع والقتال من الاستثناء، وأن يُردَّ هذا الاستثناء إلى أصله، فور وقوعه، وبدون تأخير. ومن مقتضيات ذلك ألاَّ يخاف المسلمون، من قتال أية جماعة إسلامية تبغي على أخرى، من أجل ردّها إلى حظيرة الأخوة، إلى وحدة الصف الإسلامي، وإزالة كل خروج على الأصل، أي على القاعدة التي سنَّها الله تعالى، وجعلها فرضاً على المسلمين لإصلاح أوضاعهم، وإقرار الحق والعدل في ربوع ديارهم، وبين أبناء مجتمعاتهم..
ومن المقتضيات الشرعية لتلك القاعدة الإسلامية ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم، و ألاَّ يقتل أسير، و ألاَّ يتعقّب فارٌّ ترك المعركة وألقى السلاح، و ألاَّ تؤخذ أموال البغاة غنيمة، لأنهم مسلمون. بل أن يكون قتال هؤلاء المسلمين البغاة قتال تأديب لا قتال إفناء، لأن الغرض منه هو ردُّهم إلى جادة الصواب، وضمّهم - أخيراً - إلى رحاب الأخوة الإسلامية الرحيمة.
والجهاد في سبل نشر الرسالة هو اقترانُ الوسيلة بالهدف. وقد سنَّه ربُّ العالمين فريضةً على المؤمنين من أبناء الإسلام، لتأهيل كتلةٍ بشريةٍ معيّنة، تتحلى بصفات معينة تكون قادرة معها على حمل الإسلام للناس أجمعين.
والإسلامُ، في الحقيقة، لا يُنكر على أيّة جماعةٍ بشريةٍ جهودها، بل يعتبر تلك الجهود باباً من أبواب الجهاد. وما تقوم به الأقطار المتقدمة صناعيَّاً وإداريَّاً في عصرنا الحاضر، من اختراعات واكتشافات، وإنشاءٍ وعمرانٍ، إنما يدخل في مفهوم الجهاد، ولكنه جهاد بدون رسالة.
ولذا نعيش في عصرنا هذا أزمةَ العالم الحديث، حيث تبرزُ في مجتمعاتِ عديدةٍ منه المظاهرُ الماديّة للجهاد ولكنها خاوية، لأنها لا تحمل في طياتها، وفي مضامينها، الهدفَ الكبيرَ، ألا وهو إقامةُ شرعِ الله على الأرض، الذي لا يتحقق إلا بالدين الإسلاميّ. هذا في الوقت الذي ترقد في سباتٍ عميق شعوبٌ تختزنُ الرسالةَ الإسلاميّة في أسفارها وتستظهرُ نصوصها في بيوتها ومساجدها ونواديها، وتدرّسها أحياناً في مدارسها وجامعاتها، ولكن من دون أدنى جهاد لحملها ونشرها.
لذلك نقول للشعوب الإسلامية، حَفَظةِ الرسالة، مَنْ أراد الأمنَ والسلامَ، والتقدّمَ والرقيَّ، والعمرانَ والازدهار، فعليه بالجهاد. ومن أراد التخلّصَ من العجز والكسل، والمرض والجهل، وغلبة الديون وقهر الرجال، فعليه بالجهاد، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فمن تركَ الجهادَ ألبسَهُ الله ذلاًَّ وفقراً في معيشته، ومَحْقاً في دينه، إنَّ الله تعالى أغنى وأعزَّ أمّتي بسنابك خيلِها ومراكِزِ رماحها» (+).
وعن جعفر الصادق (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الخير كلُّه في السيف، وتحتَ ظِلِّ السيف، ولا يُقيمُ الناسَ إلا السيف، والسيوفُ مقاليدُ الجنّة والنار»(+)..
ومما قاله عليٌّ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) في خُطبةٍ له، كما وردت في (نهج البلاغة): «أما بعد فإن الجهاد بابٌ من أبوابِ الجنّة، فمن تركه رغبةً عنه ألبسَهُ الله الذلَّ، وسيمَ بالخَسفِ، وَدِيسَ بالصِّغار»(+).
إذن فالجهاد الذي يقوم على إيصال الرسالةِ السماويّةِ وتبليغِها إلى الناس، هو الجهادُ الحضاريُّ الذي يهدفُ إلى توفير البناء الفكريّ والماديّ، والسلامِ النفسيّ والمجتمعيّ، والأمن الدوليّ والإنسانيّ. وكل ذلك من أجل حفظِ النوعِ البشري، وسلامه ورقيّه.
والجهاد في هذا المفهوم الإسلاميّ، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الأمن والسلام للشعوب عن طريق توفير مناخات الإيمان والهدى، والعيش الكريم، والتربية والتعليم، وكلّ مقومات الحياة الإنسانية الرفيعة، إنما يختلفُ تمام الاختلافِ عن مفهوم الأمنِ القومي الذي ترفع لواءَهُ المجتمعاتُ المعاصرة، وتتخذُهُ ذريعةً لممارسة مختلف أشكال العدوان ضدّ غيرها من المجتمعات الأخرى، صديقةً كانت لها أم عدوّة، لأن التناحرَ والتجاذب والمطامع قائمة - كما هو ملاحظ - حتى بين الدول التي تبدو ظاهرياً متقاربةً من بعضها البعض، بينما هي في الحقيقة متباعدة لا تعمل إلاّ لمصالحها الخاصة، ولا تنظر إلى مصالح الآخرين إلا بمقدار ما يتوافق مع مصالحها تلك.
إن الجهاد في المفهوم الإسلامي هو جهادٌ حضاريّ في حقيقته لأنه يريد تثبيتَ حقائقَ أساسيّةٍ وهي التالية:
- الإقرار بحقيقة ألوهيّة الله تعالى، وعبوديّة الإنسان لربِّه وخالقه.
- محوُ جميع أسباب الاستعباد والقهر والتعدّي من كل المجتمعات على سطح الأرض، أي تحرير الإنسان من كل ما يرهقه ويؤخره.
- نشرُ رسالة الإسلام بين الناس لأنها هي التي توصل إلى الحقائق المطلقة عن الحياة والكون والإنسان.
- ممارسةُ الجهاد ممارسة فعليةً وعمليةً، طالما أنه جهاد في سبيل الله.
وهذا الجهاد الحقيقي لخّصَهُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: الجهادُ أربع: الأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكر، والصّدقُ في مواطنِ الصبر، وشنآنُ الفاسق» (+). ودولُنا المعاصرة تفهَمُهُ على عكس ذلك، فتُعينُ الظالمَ على ظلمه، وتنتظرُ فتكَه بالمظلوم، ولا تُراعي في حقوق الشعوبِ الضعيفةِ إلاًَّ ولا ذِمّةً، ولا تفعل إلاّ ما يتوافقُ مع مطامعِها ولو عاشت شعوبُها على اضطهاد الآخرين.
ويتخذُ الجهادُ الحضاريُّ وجوهاً مختلفةً، ولكنَّ أبرزَها ثلاثة: الجهادُ النفسيّ، والجهادُ التنظيميّ، والجهادُ العسكريّ.
الجهادُ النفسيّ:
من المأثور عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه بعد رجوعه من إحدى الغزوات قال للناس: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، فلمَّا سألوه: وما الجهاد الأكبر، يا رسولَ الله؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «هو جهاد النفس» (+).
وروي عن جابر: أنه قدم على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قومٌ غزاةٌ فقال لهم: «قدمتم خيرَ مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، إلى مجاهدة العبدِ هواه»(+). وعن أبي ذرٍّ (رضي الله عنه) أنه قال: «قلت: يا رسول الله، أيُّ الجهاد أفضل؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أَن يُجاهد الرجلُ نفسَهُ وهواه» (+).
وقد نُقلت عن الرسول الأعظم أحاديثُ كثيرةٌ عن جهاد النفس، ومنها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم» وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «جاهدوا أهواءكم كما تملكوا أنفسكم» (+).
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الشديد من غلب نفسه» (+)، أو قوله: «الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والجاهلُ من اتبع نفسه هواها وتمنَّى على الله الأمانيّ» (+).
وتلك الأحاديث تدلُّ جميعها على أن الجهادَ الأكبرَ والأصعبَ في حياةِ الإنسان هو جهادُهُ نفسَهُ، لأنه يستهدفُ تزكيةَ نفس المسلم قبل كلّ شيء، ورفْعَهُ إلى المرتبة الإنسانية التي تليق بخَلْقه، فلا يبقى المسلم خاضعاً لدوافعِ غرائزه الشديدة، وقابعاً تحت تأثير انفعالاته التلقائية، وأسيراً لشهواته الآنية.. إن هذا الجهادَ يجعل المسلمَ على عكس ذلك تماماً، ويرفعه إلى منازلِ الإنسان المؤمن، العاقل، العامل للصالحات، ويرشدُه دوماً إلى التفكير المنظم لمعرفة الحقائق التي تحيط بالإنسان والحياة، واكتشاف معالم الكون البعيد، فيهتدي إلى سرّ وجوده، ويعرف ما يتوجب عليه القيامُ به، وتحقيق ما يجب تحقيقه خلال فترة عمره القصير الذي يحياه على هذا الكوكب.
ولعلَّ أهم ما في هذه المعرفة هو معرفة النفس، وتهذيبها وقيادتها. فقد قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «من ملك نفسَهُ إذا رغب وإذا رهب، وإذا اشتهى، وإذا غضب وإذا رضيَ، حرَّم الله جسَده على النار»(+).
وعندما يجاهد الإنسان نفسَهُ لا بدَّ أن يواجه صعوباتٍ جمّةً لشدّة مراس النفس وقوة نزعاتها. ومن أجل ذلك حذَّر الإمام الصّادقُ (عليه السلام) في تفسيره قوله تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً *} [الإسرَاء: 36] قائلاً: «يُسألُ السمعُ عمَّا سمعَ، والبصرُ عمَّا أبصرَ، والفؤادُ عمَّا عُقِدَ إليه (أو عليه)»(+).
وتربيةُ النفس على الفضائل تحتاج حقَّاً إلى جهدٍ وجهاد، للوقوف في وجه أهوائها بقوّة وعناد، ليتمكَّنَ صاحبها من قهرها والانتصار عليها. ولقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم: إن نازعك بصرُك إلى بعض ما حرَّمتُ عليك فقد أعنتُكَ عليه بطبقين (أي الجفنين) فأطبق ولا تنظر. وإن نازعك لسانُك إلى بعض ما حرَّمتُ عليك فقد أعنتك عليه بطبقين (أي الشفتين) فأطبق ولا تتكلم. وإن نازعك فرجُك إلى بعض ما حرّمتُ عليك فقد أعنتك عليه بطبقين (أي الفخذين) فأطبق ولا تأتِ حراماً» (+). ومن هنا كان لكل امرئ ما اختار لنفسه، وكان الفارق بين من اتبعَ نفسَهُ هواها، وآثَرَ الحياة الدنيا بأمانيها الزائلة، ومتاعها الفاني، وبين من خاف مقامَ ربه، في عظمته وقدسيته وقدرته، وفي خلْقه وصنعه، فنهى نفسَهُ عن شهواتها ووساوسها، فيصحُّ في هذَينِ قولُ ربُّنا تعالى: {فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى *} [النَّازعَات: 37-41].
ولا بد من الإشارة هنا إلى التشويه الذي أصاب ميدانَ الجهاد النفسيّ في فترات التقليد والجمود، وذلك بتجزئة التربية النفسية الإسلامية إلى نظريات متعددة، لا تمتُّ جميعها إلى الإسلام بشيء لأن تلك النظريات قامت على اعتبار جهاد النفس عملاً فرديَّاً، والتربية النفسية عملاً عائليّاً أو مجتمعيّاً ضيّقاً لا دخل فيه للجماعة الإسلامية، أو للدولة المشرفة على شؤون الجماعات الإسلامية، ولا مسؤولية تترتب عليها. وقد أدى ذلك إلى دخول أبنائنا، كأفراد، في صراعات نفسيّة وعصبيّة مرهفة وقاتلة.. فكلما دلف أحدُهم إلى ميدان الحياة، طالباً العلم أو العمل في بيئةٍ بعيدة عن محيطه، ووسط عادات وتقاليد لم يألفها في بيته، أو مجتمعه، واجهته أمورٌ كثيرةٌ لم تكن تخطر على باله من قبل، أو لم يكن قد عاينها أو عايشها في الأصل، ولا سيما إغراءات المدنِيّةِ الحاضرة، ومتطلباتها المادية، ومظاهرها الفاتنة، فتجذبه الأهواء، ويسيطر عليه الضعف حتى تنتهيَ به تصوراته إمّا إلى تعاطي المسكرات والمخدرات، يائساً من تحقيق اللذات والشهوات، وإمَّا إلى الانخراط في تيارات وحركات لعلّ أخفها خطراً عليه - وعلى أمته - اتباعُهُ أحدَ نماذج الدراويش والمتزهِّدين الذين يقدّمون بؤسَ الحياة وفوضاها، على سلامها، وأمنها، وتنظيمها وجمالها..
وهكذا بات الإنسانُ المسلمُ يعيش في هذه الدوّامة التي تدور به مثل رحى الطاحون، بين اندفاعه وراء مظاهر الحياة الماديّة ومتاعها، وبين انشداده إلى دينه، ومحاولة تمسّكه بمفاهيم هذا الدين، وأصوله وفروعه.. دون أن يجد بين علماء الأمة وقادتها من يوضِّح له معالمَ الطريق، ويدلُّه على سبل الهداية والرشاد، عن طريق الاقتناع والاعتناق، لا عن طريق التهويل والتخويف من عقاب الله وجحيم الآخرة. وبهذا التقصير الفاضح، ضاع شبابُ أمتنا في صراعاتهم النفسية، بينما أصحاب الوعي والشأن غائبون عن هذا الواقع الأليم كلَّ غياب، وبعيدون عن تربية وحفظ أبنائهم كلَّ البعد..
إن واقع الشباب المسلم اليوم يُرينا بأنه منقسم إلى قسمين:
- قسم تاه عن حقائقِ دينه ومفاهيمه فانخرط في صفوف العابثين، اللاهثين وراء الانفلات والمجون.
- وقسم هرب من مواجهة الحياة، فانطوى على نفسه، لا يعرف ماذا يفعل، ولا كيف يقود نفسه في الطريق الصحيح. اللّهم إلاّ من عصم الله تعالى من أبناء هذه الأمة، وهداهم بفضله ورحمته، فقبضوا على دينهم، وتمسّكوا بمفاهيم هذا الدين وشعائره، فعاشوا متوافقين مع رسالة الإسلام قولاً وفكراً وعملاً، مما أبعدهم والحمد لله عن الصراعات النفسيّة والأمراض العصبيّة.
وهذا الشباب من المسلمين هو ذخرُ الأمة، فعلينا أن نعمل لنزيدَهُ ونكثّره بين أبنائنا حتى نلتمس الخلاصَ في مقبل الأيام.. ولعلَّ هذا العمل هو من أفضل أعمال الجهاد، وأكثرها قربة إلى الله تعالى.
الجهادُ التنظيميّ:
التنظيم فرع من فروع العلم المتقدمة، وهو أساس في مختلف ميادين الحياة. ولا يمكن أن يقوم جهادٌ في سبيل الله تعالى، أو حملٌ لرسالته السماويّة، بدون تنظيم علميٍّ هادف. وهذا التنظيم للجهاد يجب أن يُشرعَ به بقدر طاقات الأمة وإمكانياتها المعنوية، ووفق قدراتها وقواها المادية، والتنسيق بينها جميعاً بما يكفلُ حشدها وتكاملَها دون هدرٍ أو نقصٍ لتحقيق أهداف الرسالة.
وهذا الجهاد التنظيميُّ عندما تُتقنه الأمة، وتصبر، على تكاليفه النفسيّة والماديّة، فإن ما تحتاجه عندئذٍ للمواجهة مع العدوّ يكون بنسبةِ واحدٍ إلى عشرة، مقارنةً مع ما يحشده عدوّها الذي لا يتوخى هدفاً مشروعاً، ولا قيمةً إنسانيّة.. والسببُ الرئيس في تفوّق النخبة المجاهدة هو انسجامُ فهمِ المؤمنين لنواميس الخالق، أي لقوانين الخلق، وجهلُ أعدائهم لهذه النواميس واصطدامُهم بها، مما يجعلها تعمل لصالح المؤمنين وهزيمة معكسر أعدائهم، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ *} [الأنفَال: 65].
أي لا يفقهون تنظيمَ الحشدِ الماديِّ، والإعدادَ النفسيَّ بالأمن، والطمأنينة، والسلام الداخليّ الذي يتمتع به المؤمن، وأهميةَ الهدف الذي يصبو المجاهد للوصول إليه ألا وهو تمكين الإسلام، الذي هو تمكين الحق والسلام..
نعم لقد أطلق الإسلامُ، ومنذ طلعَ فجره، وأشرقَ نوره، صيحتهُ المدوّيةَ في آفاق الدنيا، يدعو إلى السلام، ويضعُ الخطّة الرشيدة التي تصلُ بالإنسانية إلى أعلى درجات رقيّها ومجدها، ومن أجل ذلك فإن الإنسانَ المسلمَ، الذي يحمل الرسالة الإسلاميّةَ، لا يمكنُه إلاّ أن يحبَّ الحياة، ويقدّسَها، ويحبَّ الناسَ، جميعَ الناسَ وخاصة الذين يحيا معهم. وهو يسعى دائماً ليحرّرَهم من الخوف على المصير، ويرسمَ لهم الطريقة المثلى ليعيشوا متجهين إلى أهداف الرقيّ والتقدم، رافلين في ظلال الأمن والسلام.
وحاملُ رسالة الإسلام هو حاملُ راية السلام، لأنه يحمل إلى البشرية الهدى، والنورَ، والخيرَ، والرشادَ.. ألم يجعل الله تعالى تحية المسلمين: «السلام عليكم، وعليكم السلام».. ليشعرَهم دائماً بأن دينَهم دينُ السلام والأمان، وأنهم أهلُ السلام، ومحبُّو السلام؟. وحتى في ميدان الحرب، أو القتال بالذات، فإن المقاتل الذي يعلن كلمة «السلام» على لسانه، يتوجب الكف عن قتاله وفي ذلك يقول لنا الله تبارك وتعالى: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} [النِّسَاء: 94].
وأهلُ الجنة، كما يعلّمنا الإسلامُ، لا يسمعون قولاً، ولا يتحدثون بلغةٍ غيرِ لغة الإسلام، ولا تسمع منهم إلاّ قولهم سلاماً سلاماً قال تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلاَ تَأْثِيمًا * إِلاَّ قِيلاً سَلاَمًا سَلاَمًا *} [الواقِعَة: 25-26].
وإن الغايةَ التي يتم من أجلها تنظيم الجهد والحشد والتضحية التي يبذلها المجاهدُ، والتي تعتبر أسمى غاية في الوجود، هي فقط رضوانُ الله تعالى، لأن الله - سبحانه - يحبّ المقاتلين والمجاهدين في سبيله، ومن أحبّه الربُّ العظيم رضي عنه. قال تبارك وتعالى: [Kerr] .
وإذن فالجهاد التنظيميُّ، بمفهوم هذه الآية الكريمة، لا يكون عملاً فرديّاً، وإنما هو جهدٌ جماعيٌّ يقتضي من الأمة أن تقيم له مؤسساتِه التدريبية، والتعليميَّة، ومراكزَ البحث.
هذا فضلاً عما يتطلبه الجهاد التنظيميّ من وسائل ولوازم. كما لا بد من تجدّد معلوماته، والارتقاء بمؤهلات العاملين فيه، وتوفير التكاليف التي يحتاجها، والخبرات التي يتطلبها. وذلك إنفاذاً لقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفَال: 60].
ولو أنّ الشباب المسلم أُنشئ وأُعِدَّ على الجهاد التنظيميّ ووجوبه في جميع بلاد المسلمين لاستحال على أعدائهم التعدّي على حرماتهم وبلادهم بالصورة السافرةِ التي كثيراً ما شهدها العالمُ الذي يَدَّعي التحضُّر، ولما كان حلَّ بهم ذلك البلاء في أسبانيا، وتركيا، ومن ثمَّ مع العَرب واليهود في فلسطين، ومع الأرمن في أذربيجان، وأخيراً لا آخراً ما يحلُّ بهم اليوم في البوسنة والهرسك. ومتى تحقّق ذلك كلُّه، أمكن للمسلمين القولُ بأنهم يقومون بالجهاد المنظم الذي يرضى الله ورسوله عنه وتكون له فائدتُهُ المرجوّة.
الجهاد العسكري:
إن غاية الجهاد الأساسيَّة هي إزالةُ العوائق التي تقف حائلاً دون انتشار نور الرسالة الإسلامية، من خلال الضوابط الربانية التي تحكمه وتُوجهه بحيث لا يخرج لحظةً واحدةً عن غاية الرسالة وأهدافها. وحين يتحقّقُ هدفٌ من أهداف الرسالة دون قتال يتوقّف الجهادُ القتاليُّ ويصيرُ ممنوعاً محرَّماً بالنسبة لهذا الهدف بالذات.
والأمثلة على ذلك كثيرة، نورد منها هذا المثل: فعن المقداد بن عمرو الكندي، وكان ممن شهدوا معركة بدر، أنه قال: «قلت لرسول الله: أرأيتَ إن لقيتُ رجلاً من الكفّار فاقْتَتَلْنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تقتلْهُ. قلْتُ: يا رسولَ الله، إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها»؟. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»(+).
وللرسول الكريم، في الجهاد العسكريّ، أقوالٌ كثيرةٌ، نورد منها هذه الأحاديثَ الشريفةَ:
قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (+).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضلُ الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سلطان جائر» (+).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من رأى منكم منكراً فَلْيُغيِّرْهُ بيده، فإذا لم يستطع فبلسانه، فإذا لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (+).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً: «حُرِّمَ على عينين أن تنالهما النارُ: عينٌ بكت من خَسشية الله، وعينٌ باتت تحرسُ الإسلام» (+).
كما أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «فوق كلِّ ذي برٍّ برٌّ حتى يقتَلَ في سبيل الله. فإذا قُتِلَ في سبيل الله فليس فوقه» (+).
وفوق ذلك كلّه ما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «للجنة بابٌ يُقال له بابُ المجاهدين، يمضون إليه، فإذا هو مفتوحٌ، وهم متقلِّدون سيوفهم» (+).
والجهادُ العسكريُّ يُطمعُ المجاهدَ في الجنة إذا التحم المتقاتلون، ورأى الشهداءُ منازلهم في تلك الجنة، وعاينوا درجاتهم العاليةَ مع الصدِّيقين والصالحين، في مرتبةٍ لا تخطر على بال مخلوق، كما دلَّنا عليه قولُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الجنة مئة درجة، وبين كل درجتين كما بين السماء الأرض» (+) والشهداء في أعلى درجاتها قطعاً.
وفي موضوع الجهاد أيضاً توجب التوجيهاتُ الإسلاميةُ دورانَ الجهاد العسكري في فلك الرسالة مدًى أبعدَ ممّا يتصوره الإنسانُ النبيل، فتحثّ الفردَ والجماعةَ على العفو، والامتناع عن الثأر.
وذلك كلّه تنبئ عنه مواقفُ الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع خصومه عندما انتصر عليهم وفتح مكّةَ، فقد عفا عنهم جميعاً، مع العلم أن ما ناله منهم من الأذى، قبل الفتح وهم أقربُ الناس إليه رحماً، لم ينله أيُّ رائدٍ من قومه. لقد ضبط أحزانه، وتناسى آلامه، وها هو (صلى الله عليه وآله وسلم) يعفو عن أبي سرح، الذي ابتدع أبشعَ الأكاذيب عليه، ويعفو عن أي سفيان لما جاءه ليلاً يريد الأمان، وهو الذي تزعَّم حربَ قريش ضدّه وضدّ المسلمين، وحشد كلّ طاقات قومه للقضاء عليه وعلى الدين الذي يدعو إليه، ويعفو أيضاً عن هند، زوجة أبي سفيان نفسه، المتآمرة الأولى على اغتيال عمّه وقائد جنده حمزة بن عبد المطلب، وآكلة كبده بعد استشهاده في معركة أحد..
وتتضحُ أهميةُ الجهاد العسكري، في حياة المسلمين، بل وفي حياة الإنسانيّة كلّها، حين نجد الأفكارَ والمعتقداتِ التي تسودُ العالم الغربيّ لم تتخلَّ، وقد لا تتخلى، عن فكرة الصراع والبقاء للأقوى، وحين نرى أن الغرب إنما ينطلق من تلك الأفكار والمعتقدات في جميع ممارساته على الساحة الدولية بأسرها. وذاك الغرب، الذي هو في الحقيقة ألدُّ أعداء الإسلام، يعتبر أن القتالَ إنما هو الأداةُ الحيويّةُ لتحقيق جميع أهدافه ومصالحه، وينظر إلى الحروب، والقتل فيها، كضرورةٍ بيولوجية لبتر العناصر الضعيفة لصالح العناصر القوية، لا بل وفي صميم معتقداته أن القضاءَ على الكتل البشريّة المسحوقة بالتخلف والجهل، والعوز والمرض، أمرٌ يُسَهِّلُ عليه قيادة الحياة، ويُوَفِّرُ لشعوبه الرفاهَ والازدهار ومن هنا اشتدت عنايةُ الغرب الرأسماليّ، بإخضاع الشعوب الضعيفة، وتبعتْهُ على ذلك الكتلة الشرقيّة، يوم أن قامت تنافسه، وتحاول أن تأخذ نصيبها بالتحكم في مصير الشعوب، بإنتاج الأسلحة وتطويرها، حتى جعلت منها ترساناتٍ لها من القوّة ما يقضي على الكرة الأرضية بأسرها، عشراتِ المرّات..
وأمام تلك العقليّة التي تعتمد الصراعَ أساساً في علاقاتها مع بقية الناس الذين يشاركونها العيش على وجه هذه الأرض، يبرزُ الجهادُ الإسلاميُّ رادعاً للحمق الغربي ومضاعفاته في الفتنة، والفساد الكبير. ويبرزُ الجهادُ العسكريُّ كإجراءٍ موقوتٍ هدفُهُ بترُ العناصر المترفة، من أجل إعادة التوازن والأمان بين جميع الشعوب، وذلك عن طريق تطبيق الرسالة الإسلامية.
ولذلك لا يكون الجهادُ إسلاميَّاً إلا إذا اقترن بالرسالة الإسلاميّة. ويوضِّح لنا ذلك الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: «إن الرجلَ يقاتلُ بشجاعة، والرجل يقاتلُ غضباً وحميّةً وعصبيةً، والرجل يقاتلُ للمغنم، والرجل يقاتلُ ليُذكر، والرجل يقاتلُ رياءً، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (+). فهو شرف الجهاد الإسلاميّ أنه يحقّقُ العدلَ والمساواةَ في دنيا الأرض، ما يحقق الأمنَ والسلامَ في حياةِ الناس، ويرفعُ عن كاهلِ البشريّةِ جميعَ الصعوباتِ التي يعاني منها الأفرادُ والمجتمعات.. قال أمير المؤمنين عليٌّ (عليه السلام): «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يُلقى السمُّ في بلاد المشركين»(+)، لئلا يلحقَ الضررُ بغير المقاتلين من الشيوخ والنساء والأطفال، والمرضى والعجزة..
وقد رأى أمير المؤمنين عليٌّ (عليه السلام) شيخاً كبيراً مكفوفَ البصر، يسأل الناس الصدقةَ، فقال: مَن هذا؟ قالوا: هذا نصرانيّ. فقال: «استعملتموه، حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال»(+).
من مجمل ما تقدّم يتبين لنا أن الجهاد في الإسلامُ لا يكون إلاّ في سبيل الله. ومعنى لفظة «في سبيل الله» يحتمل شؤونَ كلّ أمور الدنيا والآخرة.
والجهادُ هو العنوانُ الحضاريُّ الذي يقدِّمهُ الإسلامُ للإنسانيّةِ جميعها، ما دام يهدفُ لإقرارِ الألوهية الحقّة، والربوبيّة المطلقة، لله الواحد الأحد، ولمحاربةِ كلِّ أنواعِ وأشكالِ الشِّرك والكفر في الوجود. وما دام يهدف لتحرير الإنسان في كل الأرض من جميع أشكال الشرّ والفساد والإثم، ويرتقي به في معارج الإنسانيّة إلى أرفع درجاتِ الخَلْق..
ولئن كانت لهذا الجهاد وجوهٌ مختلفةٌ، يتّخذها سُبُلاً في سبيل الله، فإنه لا بد من القول بأن الجهادَ العسكريَّ الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر، لا بدَّ له من الارتكاز على أساسين قويّين هما:
- الجهادُ النفسيُّ الذي يُهيِّئ الإنسانَ ويُعدُّهُ إعداداً حقيقيّاً ليكون إنساناً سويّاً في الحياة.
- الجهاد التنظيميُّ الذي يقوم على معرفة الإمكانات والطاقات، وتنظيمها ضمنَ أطرٍ بشريّة وماديّة قويمةٍ تتفاعل بصورة مستمرة مع الأحداث والتغيّرات.
ومن ثمَ يأتي الجهادُ العسكريُّ، أي بعد أن يغدو الإنسانُ كاملَ الاستعداد للانخراط في صفوف المجاهدين، الملتزمين بسائر شروط الجهاد العسكريّ، والمحافظة على شرفه، والقيام به على أكمل وجه - حتى التضحية بالنفس والنفيس - مع الرضوخ لأوامر القيادة العليا التي تُشرف على الجهاد، وتديره بحسب ما تقتضيه رسالتُنا الإسلاميّةُ الكريمةُ التي لا تهدف من وراء ذلك كله إلاّ لحملِ الأمان التي انتدبها الله تعالى إليها، ألا وهي نشر الإسلام، الذي أراده للحياة وللناس ديناً ومنهجاً.
وليعلم المسلمون، وليوقنوا بأنه لا يتحقق بدون الجهاد عبادةٌ خالصةٌ لله تعالى، حتى ولا طمأنينة حقيقيّةٌ في دار الدنيا، وسعادةٌ مرجوّةٌ حقَّ الرجاء في الدار الآخرة.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢