نبذة عن حياة الكاتب
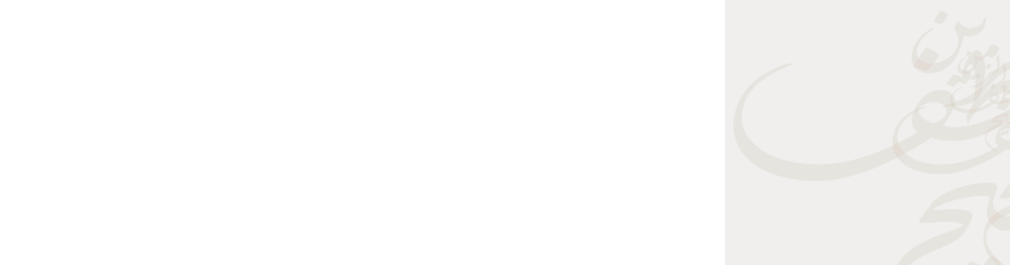
X
خَاتَمُ النَّبييِّن مُحَمَّد (ص) - الجزء الأول
المهَاجرونَ إلى اللّهِ (تعالى) - البحث الأول: الهِجْرة تداركاً للفتنة
وكثرت شكاوى المسلمين، وصاروا يخافون أن يُفتنوا عن دينهم من شدة غلواء قريش، واشتدادها في الأذى عليهم. فلمّا رأى رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) - حيال هذا الواقع المرير - ما يصيب أصحابَه من البلاء، وما هو فيه من العافية، بمكانه من الله، ومن عمّه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ممَّا هم فيه من البلاء، قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنَّ بها مَلِكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرضُ صدق، حتى يجعل الله فرجاً مما أنتم فيه»[*].
الهجرة الأولى إلى الحبشة
وحلَّ شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الموافقةِ لسنة خمسَ عشرة وستمئة (615) ميلادية، وكان فيه خروج للمسلمين في أول هجرة لهم، ابتعاداً عن أعين الكفار وأذاهم، وكانت عدة أولئك المهاجرين الأوائل اثني عشر رجلاً وأربعَ نساء، وهم: عثمان بن عفان - وبرفقته زوجته الفاضلة رقية بنت رسول الله التي تزوجها بعد أن طلقها عتبة بن أبي لهب، وقد ولدت لعثمان، في الحبشة، عبد الله، فكان يُكنَّى به؛ وأبو حذيفة بن عتبة - ومعه امرأته سهلة بنت سهيل ـ، ومصعب بن عمير، والزبير بن العوام، وعبد الرحمان بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد - ترافقه زوجه بنت أبي أمية ـ، وعثمان بن مظعون، وعبد الله بن مسعود، وعامر بن ربيعة العنزي - وبرفقته امرأته ليلى بنت أبي هيثمة ـ، وأبو سبرة بن أبي رُهْم، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن وهب بن بيضاء - من بني الحارث[*]ـ.
وفي هؤلاء المهاجرين، نزل قول الله تعالى: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ *كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ *} [العَنكبوت: 56-57].
ومن يتفكَّر في هذه الآيات يجد أنها تحمل ما يكفي من المواساة لأولئك المهاجرين؛ فهم يخافون الهجرة إلى بلاد ليس لهم فيها دار ولا عقار، ولا طعام لهم ولا سقيا، فكان لا بد من مواجهتهم بما هو أخوف من الهجرة، وأكثر إيلاماً على النفس، وليس أشدّ من الموت داهية يخافها الإنسان أو يكرهها - مع أنه حق على رقاب العباد - فإذا كانت الهجرة من شأنها أن تذيقهم مرارةً في القلب، وشظفاً في العيش، وخوفاً على المصير، فإنَّ ذلك يبقى أهون من الموت.. ولكن، مهما كان عبءُ الهجرة ثقيلاً فهو ليس بلا مقابل، فالهجرة في سبيل الله لها ثوابها العظيم عنده سبحانه وتعالى، ولذلك تنزَّلت الآيات المباركة، التي تحمل مع المواساة، الوعد بالثواب، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ *الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *وَكَأَيِّنْ مِنْ دَآبَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *} [العَنكبوت: 58-60] .. إذن، فلا يَخَفِ المهاجرون في سبيل الله من غربةٍ، ولا شدّةٍ، ولا عوزٍ، فإذا صبروا وهم على ربهم يتوكّلون، آتاهم الفرجَ والرزق في الدنيا، ونالوا ثوابَ هجرتهم، وصبرهم، وتوكلِهم في الآخرة.
وكان خروج المسلمين سراً متسللين، منهم الراكب ومنهم الماشي، حتى انتهوا إلى البحر، فوجدوا سفينة فأقلّتهم، فخرجت قريش في أثرهم حتى جاؤوا البحر فلم يجدوا أحداً منهم[*].
وإثباتاً لأمر الله تعالى، نزل المهاجرون في أرض الحبشة آمنين من أي خوفٍ أو حقد، أو بطش قد يلاحقهم به الكفار في مكة.. ولقد يسَّر الله - الرزاق الكريم - سبلَ عيشهم، فوجد البعض عملاً يكسب منه رزقه، ومن لم يستطع أن يجد له عملاً، أعانه إخوانه من ذوي اليسر والغنى (كما كان يفعل عثمان بن عفان، صاحب المال والنعمة)، فعاشوا متآلفين في وحدتهم الإسلامية، متماسكين، يذود بعضهم عن بعض غوائل الأيام، في ظل حياة كريمة، متواضعة. ولم يكن لهجرة تلك الثلة من المسلمين أية أصداء في أرض الحبشة الواسعة، إنْ بسبب قلة عددهم، وإنْ بسبب ما قد يلفت الأنظار إلى هجرتهم، ووجودهم.. ولكنْ، وإن لم تظهر لتلك الهجرة دلائل معيَّنة هنا، إلاَّ أن برهانها قد سطع في مكة، وغايتها قد أذهلت قريشاً؛ إذ ثبت لديها أنَّ المسلمين أشدُّ حرصاً على دينهم مما كان يعتقد زعماؤها - الأغبياء ـ، وأنهم متفانون في سبيل هذا الدين، ومستعدون لاحتمال الخسائر والمشاق لأجله؛ وإلاَّ كيف يهجرون أهليهم، ويتخلّون عن ديارهم، ويتركون أعمالهم وموارد أرزاقهم؟!
ولكنَّ هذا السلوكَ الإسلامي - في الإخلاص للدين والتضحية للحفاظ على العقيدة في النفوس - هل تدرك قريش معانيَه، فتظهر لها الحقيقة، وهي أن الإسلام قد أنزلَهُ ربُّ العالمين ليُظهرَه على الدين كلِّه ولو تألّبت عليه أعتى قوى الشر، أو قامت في وجه أتباعه ومريديه أشدّ العقبات والصعاب؟ أجل، إنه السلوك الإسلامي الذي يمثل الالتزام في ذراه[*] الإيمانية والإنسانية، فيترجمه المسلمونَ واقعاً حسياً بالهجرة هرباً من الفتنة، ومع ذلك فقد ظلت قريش على الوتيرة عَيْنها في ملاحقة المسلمين بالأذى المعنوي والماديّ، ما دام عتاتُها في طغيانهم يعمهون.. وها هُم يتخذون من الهجرة ذريعةً أخرى، يضيفونها إلى ذرائعهم السابقة، فلا تقتصر أعمالهم الإجرامية على المسلمين المستضعَفين، بل تتعدى إلى هؤلاء المسلمين الذين غلب عليهم الحِلم والمروءة في حياتهم الخاصة، وعلت بهم المكانة والشرف في القوم، فلا يتوقعون منهم مناوأة أو مقاومة تُذكر، لأنهم يأتمرون بأوامر نبيِّهم، الذي ينهاهم عن العراك والقتال..
ولا تقف دروس الهجرة عند هذه الحدود، بل إنَّ لها دلالات أخرى - وربما أهم - في حسبان القيم الإنسانية؛ فالرسول الأعظم لم يكن اختيارُه بلادَ الحبشة مهاجرَ للمسلمين إلاَّ بعد طول أناةٍ وتفكير، ليثبت في ضمير العالم كله أن أرض الحبشة، التي تغلب عليها النصرانية، هي أوْلى من أية بقعةٍ أخرى في الأرض لاحتضان أبناء دين الله، فلا يَلقوْن فيها أذىً ولا افتراءً، ولا يعانون تعذيباً أو جهالة.. إن الرسول الأعظم محمد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أرادَ أن يبرهن للدنيا أن أرضَ الأديان السماوية هي أحق بالمؤمنين، واستقبالهم بالأمن والسلام، ولذلك لم يأمر المسلمين بالمهاجرة إلى قبائل العرب في البادية، حيث الحميّة - بالسليقة - لطلب الجوار، أو إلى أرض امبراطورية فارس، التي تتمتع بالسطوة والهيبة والسلطان، ولا حتى إلى أرض الامبراطورية الرومية - مع أن فيها النصرانية - التي تعطي للرعايا الرومان الأولوية على مختلف الأفراد والجماعات غير الرومانية، بما لا يطمئن على مصير المهاجرين إلى تلك البلاد، وربما إلحاق الظلم بهم، ومن هنا كان اختيار النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لأرض الحبشة، دون غيرها من الأمصار الأخرى، «لأن فيها ملكاً لا يُظلم أحدٌ عنده» كما أبانَهُ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ..
ومن الأهداف الأخرى للهجرة، التي أرادها النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ضاربة في عمق الزمن، ويجدر بالناس التوقف عندها، وتقديرها كلما تقدمت العصور، أنها تجعل الشعوب تتعارف فيما بينها مما يفتح - في التعايش مع بعضها - مدارك التسامح والألفة والتعاون، ليس بين أهل الأديان السماوية وحدهم، بل وبين أبناء البشر جميعاً..
أما الهدف الأهم والأسمى من هجرة المسلمين - عندما تكون الهجرة في سبيل الله، أي: عندما تكون غايتها الحفاظَ على عقيدة المسلم، وسعيه للرزق الحلال، والحفاظ على كرامته الإنسانية - فهو الهدف الإيماني إذ «كما أن الإيمانَ فرض على كل أحد، فقد فرض الله - تعالى - عليه أيضاً هجرتين: هجرة إلى الله - عز وجل - بالتوحيد، والإخلاص، والإنابة، والتوكل، والخوف، والرجاء، والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالمتابعة والانقياد لأمره، والتصديق بخبره، وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه[*]. بمعنى أن الهجرة لله ورسوله بأبعادها الإيمانية غير الهجرة التي لا تبتغي إلاَّ أعراضَ الدنيا وحدها دونما حسبانٍ لتأثيرها على دين المسلم، والتزامه بأحكام الشرع في مختلف أنماط حياته، كما هي الحال اليوم، في حياة غالب المسلمين الذين يهاجرون إلى ديار الاغتراب، لسبب أو لآخر، حيث ينسون التزامهم الديني، وينغمسون في أجواء البلاد التي يهاجرون إليها، فيجرفهم - ويجرف أبناءهم - زخرفُ الدنيا ومتاعُها، بما يضيّع عليهم دينهم وآخرتهم.. من هنا يتبين كيف أن للهجرة معانيها التي تضرب في عمق الزمن، فلا تقتصر على عصر دون آخر، ولا تطالُ الأهداف الدنيوية دون الأهداف الإيمانية للمسلمين بخاصة، وللناس بعامة..
ومن أين لزعامة المشركين في مكة - يومئذٍ - أن تعي تلك الأبعادَ والمرامي لهجرة المسلمين، فلم يروا في تلك الهجرة ما يتخطَّى تفكيرهم الضيق، وهو أنها بداية تتيح لأتباع «محمد» الخروج من مكة، واللحاق ببعضهم بعضاً، حتى يتجمَّعوا، ويؤلفوا قوة منيعة من الرجال والمال والسلاح. ثم يعودون إلى مكة بتلك القوة، فتدور الدائرة على قريش، ويحل بها الويل والثبور، وتنزل بالآلهة التي تعبُدُها عظائمُ الأمور!.. هذا ما رآه كفار قريش من هجرة المسلمين، فقد خافوا أن تكون العواقب وخيمة عليهم، فمضوا على نفس الدأب في العنت والإرهاب، بل وبأشدَّ مما مضى، حتى تُوهَنَ عزائمُ من بقي من المسلمين في مكة، فلا يحقق «محمد» شيئاً من الهجرة التي فتح أبوابها لأتباعه!..
إسلام عمر بن الخطاب
وقد برز في تلك الفترة عمر بن الخطاب من أشدّ المتحاملين على الدعوة الإسلامية. فقد كان في طباع الرجل غِلْظة، وقلَّما تدخل الرحمة إلى قلْبه. كما أنه كان صاحبَ خمرة، يحبها ويسعى لمعاقرتها. وتلك الطباع قد حملته على ملاحقة المسلمين، ومشاركة جماعته في أذيَّتهم، وقد بلغت به الحماسة أن يُعلن على الملأ، أنه لم يعد قادراً على احتمال بقاء محمد بن عبد الله في مكة، وأنَّ على قريش أن تقتلَه، وتفرغَ من أمره.
وبينما كان في جلسة منادَمة، انبرت شلَّةُ السكارى تحرِّضه على أن يتولى هو بنفسه قتْلَ «محمد»، لأنه أقدر الناس على ذلك.. وما زالت به تلك الصحبة الخبيثة حتى أهاجته، فهبَّ خارجاً من الخمارة، ولكنَّ نعيم بن عبد الله النحام، «وهو رجل من قومه من بني عدي بن كعب، كان قد أسلم، وكان يستخفي أيضاً بإسلامه فرقاً من قومه»[*] استوقفه في الطريق، ليسأله عما يهيجهُ، فاعترف له عمر - تحت وطأة السكر - أنه ذاهب للقضاء على «محمد»، فما كان من نعيم إلاَّ أن قال له:
- لقد غشّتْك نفسك يا عُمر! أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت صاحبَهم؟! أفلا ترجع إلى أهلك وتقيمُ أمرَهم؟!
فقال عمر:
- وما قولك يا هذا؟
قال نعيم: إنها أختك يا عمر! فاطمة بنت الخطاب، وصهرك سعيد بن زيد[*] قد صبآ، وصارا على دين «محمد».
وبدون أن يعقِّب، طار عمر على جناح السرعة إلى بيت أخته، بعد أن طار كل أثر للخمرة من رأسه، وشاء المدبِّر العالم أن يكون خباب بن الأرت هناك وهو يتلو في تلك الساعة آياتٍ من الذكر الحكيم، فيسمع عمر، عندما يبلغ صحنَ الدار، التلاوة، مما يجعله يرغي ويزبد في صراخه، فيسرع أهل البيت ويخبّئون الصحيفة احترازاً منه، ثم يقفون قبالة الباب في محاولة لتهدئته، إلاَّ أن ذلك لم ينفع، لأنه استمرَّ في اندفاعه، وانقضَّ على صهره سعيد، يريد البطش به، لولا أن زوجَه ألقت بجسدها عليه، فنزلت ضربة عمر على رأسها وشجّته، وجعلت الدماء تسيل منه.. عندئذٍ هانت على سعيد نفسه، فصرخ غاضباً:
- نعم لقد أسلمنا يا عمر، وآمنّا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك..
وبمثل لمح البصر أحس عمر كأن قوة خفية تردعه عن هذا الرجل، وتقذفه إلى مقعدٍ بقربه، فيهوي بجسمه عليه، وكأنه لا يصدق ما يجري معه، وما يحلّ به من فتور في همّته، وخوار في قواه، جعله يستكين على تلك الحالة؛ ولكنه سرعان ما خرج على صمته، وطلب أن يعطوه ذلك الشيء الذي كانوا يقرؤونه فمانَعتْ أختُه، وهي ترنو إليه برقَّة وحنان، قائلة:
- بل لا تمسُّ صحيفةً فيها قولُ الله رب العالمين، حتى تغتسل وتتطهَّر. إنه قرآن كريم لا يمسُّهُ إلا المطهّرون.
وكأنَّ تلك القوة الخفيَّة، التي حجبته عن صهره، ما تزال تلقي بثقلها على هذا الغليظ الطبع فلم يحتجّ على قول أخته، بل سألها برويّةٍ وهدوء:
- وكيف تكون طهارتكم؟
ثم انتبه لما أصابها منه، فقام يرجو زوجها أن يأتيه بالماء ليغسل هو الدم عن وجهها، ويضمّد جرحها. فلما فرغ من ذلك عاد يسأل عن كيفية الطهارة، فقام صهره سعيد، وأتى له بثوب نظيف، ثم أخذه حيث يغتسل، لتكتمل طهارة بدنه مع طهارة الثوب الذي قدمه له.. وعاد عمر بعد الاغتسال، ليجد رجلاً غريباً يجلس إلى أهل البيت، فلم تدعه أخته يعقب بشيء بل بادرته بالقول:
- إنه خباب بن الأرت يا أخي، وهو من أتباع النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وقد كان يقرأ علينا القرآن، إلاَّ أننا أشرنا عليه بالاختباء خوفاً من سورة الغضب التي كانت تستبدُّ بك عندما أتيت إلينا، فهل ترى حيْفاً في ذلك؟
فالتفت إليه عمر وقال له:
- اجلس يا خباب ولا تخف..
وكانت المفارقة أن عمر هو الذي يطلب الآن أن يأتوا بالصحيفة ليقرأَها خبابُ على مسامعه فأخذ خباب، بعد أن تناولها من سعيد، يقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {طه *مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى *إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى *تَنْزِيلاً مِمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى *الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى *وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى *اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى *} [طه: 1-8] وارتعدت فرائص عمر مما يسمع على الرغم مما كان يداخله من استحسان لحلاوة القول في هذه الصحيفة وبلاغة تعابيره، مما جعل أخته تقول له: أرأيت أنه ليس من كلام البشر، إنه حقاً يا أخاه قولُ الله تعالى، وإنه لقرآن كريم يهدي للتي هي أقوم.
وتجيش العاطفة الإسلامية في نفس خباب، فينسى من هو عمر بن الخطاب، فيقول له:
- فاللَّهَ اتّقِ يا رجل، وكن من أتباع دين الله تعالى ويهدكِ ويُنجِك من عذاب شديد!
وتعاودُ فاطمة النصحَ لأخيها، وهي تلمسُ فيه غلبة البرِّ على الشقوة، فتقول له:
- فعسى أن يهديَك الله سبحانه وتعالى يا أخي، وينصرَ بك الإسلام.. ويثني سعيدٌ على قول زوجته، ويرجو لعمر أن يكون من أنصار الإسلام ودعاته، لاسيما أنه سمع من رسول الله (ص) كلاماً يوحي بنصرة عمر لدين الله.
واطمأنَّ عمر لكلام هؤلاء المؤمنين، مثلما اطمأنت نفسه إلى القرآن الذي سمع تلاوته، قبل قليل، فهبَّ يتّشح بسيفه، ثم يسأل صهره عن مكان «محمد» علَّه يجد الخيرَ على يديه؛ ولكنَّ سعيداً خاف بل وأخذه الظنُّ بعيداً لأنه يعرف هذا الرجلَ، وشدةَ انفعالهِ ولاسيما في حالة الغضب؛ فيسكت ولا يجيب عمرَ بشيءٍ.. إلاَّ أن التفاتة خباب كانت أكثر استشفافاً لدخيلة عمر، فلم يساوره الشك في السؤال عن مكان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولم تداخله أية خشية عليه من هذا الرجل، فقال له:
- إنني أعرف مكانه، فهيّا بنا إليه..
وحين بلغا دار الأرقم بن أبي الأرقم تقدم عمر، بعد أن استأذنَ رفيقَ دربه، ليكون هو الطارق بنفسه، فلما رأوه من ثقب الباب، أجفل بعض الصحابة لمجيئه، فما كان من حمزة بن عبد المطلب إلاَّ أن قال لهم:
- لقد جاءنا هذا الرجل سعياً على قدميه، فإن كان يريد خيراً بذلناه له، وإن كان يريد شراً رددناه عليه، وقتلناه بسيفه.
وأمر النبيُّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بفتح الباب. وتقدم يتصدى لهذا العدو اللدود، وهو يأخذ بمجمع ردائه، ويجذبه جذبة قويةً، ثم يأخذ بتعنيفه عمَّا يحمله على أن يفعل ما يفعل بحق المسلمين وكيف يتجرّأ على المجيء متقلّداً سيفه.. إلى أن يقول له: «فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله - تعالى - بك قارعة»[*].
واهتزَّ كيان عمر.. فقد كان لبضع ساعات يريد قتل «محمد بن عبد الله» وها هو الآن يرتجف بين يديه ويحسّ بكلامه ينفذ إلى أعماقه، وكأنه يريد أن يُلقي به إلى جحيم من النار، ثم لا يلبث أن ينتشله ويدعو له بالرحمة، فيظل ساكناً في وقفته، لا يبدي قولاً أو حركة، اللهم إلاَّ تلك الزفرات التي تنم عن استسلامه.. فيدعوه رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى الجلوس والاستماع، فيجلس كطفلٍ وديع، وينظر إلى هؤلاء الفتيان من حواليه، فلا يجد بينهم إلاَّ قريباً له، أو صديقاً، أو عشيرَ عُمْرٍ، فيقول في نفسه: ما بالي أراني في غربةٍ بين هذا الجمع وكنا من قبل ردفاً مردوفاً[*]؟ أم أنني قد نأى بي المزار فبعدت عنهم بجاهليةٍ ما إخال فيها إلاَّ الندامة والأسى؟!. أهكذا أنت يا عمرُ بينما هُم قد هداهم ربهم، فآمنوا بهذا النبي وصدَّقوه! إنه وأيمُ الله لفوز كبير قد أحرزوه، وسبقوني إليه!.
وانتشله رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من تفكيره، وهو يعاود عتابه الذي بدأه به قبل قليل عن قسوته وشدته على المسلمين، لينفذ، من ثمَّ إلى ما يريد له من الهداية والرشد، ودعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد، الرحمن الرحيم بعباده، والكفر بالآلهة التي تعبدها قريش، لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان، والحطّ من قدره، وهو يتلو عليه، بين الفينة والأخرى من آيات الله (تعالى) ما يفتح مدارك العقل المغلقة، ويرشد النفوس التائهة. وكان لكلام رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) التأثير البالغ، والسريع، فإذا بعمر ذي البأس والعنفوان، يشعر وكأنه تحوّل إلى إنسان آخر، ليس له همٌّ في هذه الدنيا إلا أن يكون مسلماً، فوقف بين يدي رسول الله يشهد بأن: «لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله».
وسُرَّ الجميع بإسلام عمر بن الخطاب فقاموا يهنئونه على هذا الفوز العظيم، والدخول في دين الله الحق.. ولشدة تأثره بما سمع من رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، لم يقبل إلاَّ أن يخرج ويذيع إسلامه على ملأ قريش بأسرها.. وبالفعل، وما إن انفض الاجتماع، حتى توجَّه إلى بيت عمرو بن هشام الذي هو من أكثر الجماعة القرشية حقداً على الإسلام وأهله، والذي صحَّ فيه لقبه أبو جهل لما تمتلىء به نفسه من جهالةٍ للحق، وعمىً للبصيرة..
وما إن أطلَّ أبو جهل، ورأى على وجه صاحبه ما ينبىء بنذير شؤمٍ حتى اكفهرَّ وجهه من العبوس، إلاَّ أنه غالبَ مشاعره، لأنه لم يجد مبرراً لعدم دعوته للدخول، فما كان من عمر إلا أن ابتدره بالرفض وهو يقول له مباغتاً:
- ما جئت لأدخل يا عمرو، ولكن لأخبرك بما تكرهه وتبغضه، فقد آمنت بالله عز وجلَّ، وصدَّقت محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالنبوّة والرسالة. وما رأيت إلاّك أوْلى بمعرفة هذا النبأ قبل غيرك من بني قومك المشركين، فأبلغهم بما علمت، وحاذرِ الكتمان..
وكأنما نزل خبر إسلام عمر على هذا المشرك الحاقد كالصاعقة، فانتفض مرتدّاً إلى الوراء، وهو يصفق الباب في وجهه، ويتمتم بالشتيمة والسباب، مما أهاجَ عمرَ فراح يصرخ، ويتحدّاه أن يخرج إليه ليقاتله، وهو يقول له:
- هيا أيها الكافر اللعين، اخرج إليَّ، أم أنك لا تُظهر شجاعتك إلاَّ بين أولئك الكافرين من أمثالك، وأنتم تجتمعون على الغي والحقد؟ ألا قبّحكم الله من قومٍ مفسدين!..
وأنَّى لكافر لفَّه الجبن في ثنايا زوايا بيته، أن يجرؤ على مواجهة هذا الفارس الذي قد هداه الله (تعالى) للإسلام، فزاده دينُهُ - من فوره - بأساً وشجاعة.. فقد غاب أبو جهل وراء بابه، لأن الحنق[*] القاتل قد أخمده، فارتدَّ إلى ظلمات نفسه ليقبع في مخازيها السحيقة، ولأن اللؤم الدفين قد أعياه فانطوى على جراح قلبه في أحقاده المقيتة.
وذاع خبر دخول عمر بن الخطاب في الإسلام، فذُهلت قريش!
وما كان ذهولُها إلاَّ لأنها فقدت نصيراً قوياً في محاربة «محمد»، حتى لترى وكأن النصرة كلها قد ذهبت من يدها، ولكنها ظلَّت على إصرارها للنيل من «محمد»، فهو من «فَتَنَ» عمر كما «فَتَنَ» من قبله حمزة بن عبد المطلب فخسرت بطلين من الأبطال كانت تعول عليهما.. بل وسوف لن يدع أحداً من فتيانها أو فرسانها إلاَّ ويجعله تابعاً له، ما لم تجعل القضاءَ عليه هدفَها الأوحد، فيصير هيّناً عليها التخلص من أتباعه، ولو كان فيهم حمزة وعمر، ومن ثم يسهلُ أمر اجتثاث دعوته من جذورها..
وراحت قريش تدبّر المؤامرة تلو المؤامرة، والمكيدة تلو المكيدة لنيل مآربها، إلاَّ أنها لم تحصد إلاَّ الفشلَ والندم، بل ويرتدُّ فشلها دائماً ربحاً على «محمد» والمسلمين، ولذلك رأت أن تعمَدَ إلى نمطٍ جديدٍ لم يألفه من قبل هؤلاء «الصابئون» ولن يخطر على بال أحد منهم شيءٌ مثله!.
عودة المهاجرين
وكانت خطة المشركين عاجلة في تنفيذ المؤامرة الجديدة، عندما بعثت من يفشي بين المسلمين في الحبشة الأخبار الملفقة بأن اتفاقاً قد جرى بين قريش ونبي المسلمين، وهو ألاَّ يتعرضَ لآلهتها بتحقير، أو يذكرها بسوء، مقابل أن تكفَّ هي - قريش - عن عداوة المسلمين وإيذائهم.
وسرت الشائعات بين المسلمين عن عودة الهدوء والأمان إلى ربوع مكة، وأفلحت عيونُ[*] قريش ببث الأخبار الكاذبة، حتى اقتنع بعض المسلمين بأن الاتفاق قد حصل، وأنه لم يعد لديهم سببٌ يبقيهم في ديار الغربة.. هذا في حين لم تنطل تلك المكيدة الخبيثة على المسلمين الآخرين، بل وجدوها حيلةً مبتكرة، وفناً جديداً من أفانين الكذب والتآمر التي يبتدعها شياطين قريش، ويرمون من ورائها إلى أغراض بعيدة ودنيئة.. فحاول هؤلاء أن يثنوا من عزم إخوانهم على العودة، والعدول عن رأيهم، ولكنَّ محاولاتهم لم تجد آذاناً صاغية، لأن الحنين إلى الديار، ورؤية الأهل والأقارب، كان أقوى تأثيراً في النفوس، فودَّعوا إخوتهم، وقفلوا راجعين إلى بلدهم مؤمّلين..
ولكن المفاجأة كانت بانتظارهم عندما وصلوا إلى مشارف مكة، إذ لم يجدوا شيئاً مما سمعوا، وما قيل لهم.. لأن الأوضاع ما تزال على حالها فلا اتفاق بين النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والمشركين، ولا مهادنة أو شفقة من قريش على المسلمين، بل كانت خطة مدبَّرة، لحمل المهاجرين على العودة من الحبشة، ليذيقهم المشركون مُرَّ العذاب مثل سائر المسلمين، وبذلك لا يفلت أحد من الصلف القرشي - إلاَّ من بقي بعيداً في غربته!..
ووقع المسلمون العائدون في الحيرة.. فرأى بعضهم أن لا مناص له من الرجوع إلى أرض الحبشة، إن أراد الفرار بدينه. بينما ارتأى البعض الآخر البقاء في بلده، والنزول إلى مكة في حماية من يجيره من أقاربه أو أصدقائه، ولو كانوا من المشركين.. فدخل عثمان بن عفان في جوار أبي أحيحة، سعيد بن العاص بن أمية، ودخل أبو حذيفة بن عتبة بجوار أبيه. ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المغيرة.
وإذا كان لمثل ذلك الجوار الذي التجأ إليه أولئك المسلمون دوافعه وهي عديدة ومعروفة، إلاَّ أنهم لم يلبثوا إلاَّ قليلاً، حتى راح كل واحد يعمل على إبراء نفسه من الجوار الذي أتعبَهُ وأشقاه، خصوصاً وهو يرى نفسَهُ آمناً في ذهابه وإيابه في مكة، بينما إخوته المسلمون يتعرَّضون لأسوأ أنواع الإهانة، ولأشنع أساليب الأذى...
ولعلَّ في ما كان يعانيهِ عثمان بن مظعون، ما يدلُّ على الندم والأسف الذي ينغِّص عليه أيامه، فلا يستطيب أي مقام، وفي النفس لومٌ دائم، وفي الضمير تقريع لا يكف، فيحدّث نفسه:
- أأكون في ذمة مشرك؟! إن جوار الله - تعالى - أعزّ وأبقى.
ويقرر عثمانُ التخلُّص من جوار الوليد، فيخرج باحثاً عنه في كل مكان حتى وجَدَه في مجلسٍ يغصُّ بالناس، الذين جاؤوا يستمعون إلى لبيد بن ربيعة، وقد أتى مكة لينشد شعْرَهُ على أهلها. فدخل، وجلس ينصت مثل الآخرين، بانتظار نهاية المجلس.. حتى إذا سمع لبيداً يقول، وهو يعتزُّ بإنشاده:
ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ
وقف عثمان وسط الجمع، مبدياً استحسانه لذكر الله تعالى، وهو يقول:
- صدقتَ والله يا ابن ربيعة!.
ويُسَرُّ لبيدٌ لقوله، فيعيد ويكمّل قائلاً:
ألا كلُّ شيء ما خلا الله بَاطلُ
وكلُّ نعيمٍ لا محالةَ زائلُ
وهنا ينتفض عثمان ويصرخ في وجهه:
- كذبت هذه المرة، فنعيم الجنة لا يزول.
ويتوقف لبيد عن الإنشاد، وهو يستشيط غضباً لهذه الوقاحة التي لم يعرفها في مجالس شعره، ثم يتطلع إلى القوم الذين يتحلقون من حوله، وكأنه يستحثُّهم على التخلص من هذا الرجل، فيقوم البعض يطيّب خاطره، ويسترضيه، وهو يرجوه ألاَّ يعيرَ اهتماماً لهذا الصعلوك عثمان بن مظعون الذي «صبأ» ولا شأن له عندهم، وأنه لولا جوار الوليد بن المغيرة له، لما كان تجرّأ ودخل إلى مجلسهم.. إلاَّ أن لبيداً ظل على غضبه، مما دفع بعض الأراذل للاعتداء على الرجل المؤمن، عثمان بن مظعون، والنيل منه بلطمةٍ على عينه اليمنى أدت إلى ورمها على الفور. ولم يتوقفوا عن ضربه، لولا تدخل الوليد بن المغيرة، وإبعادهم عنه، وهو يقول لهم:
- دعوه فإنه من ذوي الأرحام فينا.
ثم التفت إلى عثمان، وهو يقول له بشماتة وسخرية:
- ما كان أغناك عن هذا! أرأيت ما حل بعينك اليمنى؟
ويدرك عثمان ما يرمي إليه الوليد، فيجيبه من فوره:
- بل، والله، إن عيني اليسرى تشتكي ما أصاب أختَها في الله.. وإنني والله أردُّ عليك جوارك منذ الساعة يا عمّاه!
وظنّ الوليد أن الألم الذي حلَّ بعثمان هو الذي يدفعه إلى مثل هذا الحنق، وطلبِ رد جواره، فيسأله ألاَّ يتسرَّع، وأن يهدأ، بقوله:
- لا تتعجل يا ابن أخي، وخير لك أن تبقى في جواري.
ولكنَّ عثمان بن مظعون يرفض هذا البقاء بأنفةٍ وإباء، فيقول للوليد:
- لا! لن أعود إلى غير جوار الله، ولن أستجير بغير الله عزَّ وجلَّ.
فلما رأى الوليد بن المغيرة إصرار عثمان قال له: إذن فانطلق إلى الكعبة، فاردد عليَّ جواري علانية، كما أجَرْتك علانية. فانصرف معه ورد عليه جواره على مرأى الناس ومسمعهم[*].
ومثل هذه الحادثة وغيرها كانت من النتائج التي ترتبت على تلك المكيدة التي نصبتها قريش للردِّ على هجرة المسلمين إلى بلاد الحبشة. إذ لما عادَ بعض المخدوعين هجمت عليهم بزبانيتها[*] هجومَ الذئب الكاسر على فريسة وقعت بين أنيابه، في محاولة جديدة لتمزيق شتاتهم، فلعلَّ في ذلك ما يعيدهم عن «صبئهم» الذي وقعوا فيه!..
و لئن كان ذلك بعضاً من أفاعيل قريش الشنيعة التي كانت كلُّها حقداً وغدراً، إلاَّ أنها - والحمد لله - لم توصلها إلى ما تصبو إليه وتشتهيه...فالعداوة والاستهزاء والأذى صارت من الأمور المألوفة.. والمسلمون باتوا يعرفون أنه لن يطلعَ نهار عليهم أو يأتي ليلٌ، إلاَّ وسوف يلقَوْن من المشركين ما يُسيء إليهم.. ولكنَّ ذلك كله لا يعني لهم شيئاً مقابل الدعوة وحاملها، فقد وطّنوا نفوسهم على الاحتمال منذ اليوم الأول الذي دخلوا فيه في الإسلام، وعاهدوا الرسول على المضي في حمل هذا الدين وإيصاله للناس، وها هم للعهد حافظون، وعلى هدي الله (تعالى) ورسوله سائرون، وإن كان المجتمع المكي لم يستجب لهم، على الرغم مما يبذلونه لأجل خلاصه من الآفات التي تنخر بنيانه، وسلامته من الأمراض التي تفتِّت كيانه.
وكان متوقّعاً ألاَّ يتجاوب ذلك المجتمع الفاسد مع دعوة الإيمان، وزمام أموره بين يدي عصبة من المشركين، المستكبرين، الذين استحبوا الكفرَ على الإيمان، والضلالَ على الهدى، فلم تفلح معهم دعوات الحق، بل ظلوا يزدادون غيّاً وضلالاً، من غير أن يحققوا شيئاً من غاياتهم ومطامعهم، لأن الدعوة استمرت، ولو ببطء، والدعاة ثبتوا على الصبر والاحتمال...
إنما كان هناك شيء واحد يمكن أن يُعدَّ نجاحاً للمشركين، وهو التهديد بخطر القتال الشامل بين بطون قريش.. وسكوت المسلمين على هذا التهديد، مما جَعَلَ أولئك المشركين يتمادون في تلك الأساليب الرعناء التي ينالون بها من المسلمين!..
وإذا كان المسلمون قد ألفوا مثلَ تلك الأخطار التي تتهددهم، ورضخوا لها مرغمين خوفاً على دينهم وخوفاً من وقوع حرب أهلية، إلاَّ أن وقْعها على الرسول الأعظم كان الابتلاء بعينه، لأنها كانت ظلماً بظلمٍ، بل ويزيده (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ابتلاءً أنه غير قادر على ردّ الظلم، في ظل تلك الظروف الحرجة التي تتهدد الدعوة من أصلها، فلا يجد عزاءً إلاَّ بهذا الثبات للمسلمين، ومضيّهم على الاحتكاك بأهل مكة، حتى يأتي الله أمراً كان مفعولاً..
الهجرة الثانية إلى الحبشة
وإذا كان الصبر والاحتمال زادَ المسلمين قوةً وثباتاً، إلاَّ أن خبزهم اليومي بات قهراً تعجنه قريش وتنضجه على نار حقدها وجهالتها.. الأمر الذي يفرض - إزاءَ هذا الواقع المرير - إيجاد مخرج للمؤمنين، فعادَ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يأمرهم بالهجرة ثانية إلى بلاد الحبشة، ويستحثهم على الخروج من مكة، تفادياً لتلك الرعونات التي تنزل عليهم ظلماً وعدواناً!..
ويجد المسلمون أنفسهم أمام المصير المحتوم، وهو إرغامهم على الهجرة، فيذعنون لأمر نبيّهم، وفي العيون دمعة، وفي القلوب لوعة، لأنَّ ما يحزنهم أكثرَ هو فراق هذا النبي الكريم، وبقاؤه مع عدد من الصحابة، يتحمّلون وحدهم صلافة المشركين، ورعونة المستكبرين، فيأتيه عثمان بن عفان (رضي اللّه عنه) مهموماً، مكلوماً[*]، وهو يقول:
- يا رسول الله، لقد كانت هجرتنا الأولى، وهذه الثانية التي تأمرنا بها إلى النجاشي، ولستَ معنا..
فيقول له الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) :
»أنتم مهاجرون إلى الله ورسوله، لكم هاتان البُحرتان جميعاً»[*].
ويودع عثمان النبيَّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ويقول: حسبنا الله، ونعم الوكيل..
وينطلق في هذه الهجرة الثانية ثلاثة وثمانون رجلاً، وإحدى عشرة امرأةً قرشية، وسبعُ نساءٍ من غير قريش، يقصدون جميعهم بلاد الحبشة فراراً بدينهم، وخوفاً من فتنة قريش لهم. وكانوا يخرجون أفراداً، حفاظاً على عنصر السرّيّة[*].
ولم يكن رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ليرتاح إلى مصير المهاجرين إلاَّ بإمرة أحد يثق به، فطلب إلى ابن عمِّه جعفر بن أبي طالب أن يهاجر إلى الحبشة، ويحرص على رعاية المسلمين هناك؛ ثم بعث بعد مدة برسالة إلى ملك الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري، وقد جاء فيها «قد بعثت إليكم ابن عمي جعفر بن أبي طالب ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاؤوك فأقْرهم...»[*] ويقيم هؤلاء المهاجرون، مع مَن سبقهم في الهجرة الأولى، أحراراً، آمنين، مطمئنين إلى جوار ملك عادل، أكرمَ وفادتهم، وأحسن معاملتهم، بعدما عرف بأمر مجيئهم، مرتحلين عن قومهم الذين يناصبونهم العداء، ويسلبونهم الأمن والراحة.. وجن جنون قريش وهي ترى المسلمين ينأون عن أذاها، فلا يبقى في مكة إلاَّ تلك الجماعةُ التي تقدر على الصمود في مواجهة عداوتها، لشدة بأسها، وحماية عشائرها.. وزادها حدةً في الغضب أن تناهت إليها الأخبارُ من عيونها في الحبشة، بأن الملك قد آوى المهاجرين، وأمَرَ أن يعاملوا بالحسنى، فلا يُعتدى على أحد منهم، أو يُبخس حقاً، أو يُظلم من قريب أو بعيد.. فتنادى الدهاقنة، وائتمروا فيما بينهم على أن يبعثوا برجلين إلى النجاشي، لإقناعه بطرد المسلمين من بلاده على أن يغروه هو وبطارقته بالأموال والهدايا النفيسة، فبعثوا عبد اللّه بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص[*].
ولا ندري أيهما أكبر: الرَّهَجُ[*] في قريش، وهم يحمّلون هداياهم.. أم ما حملت نفسا مبعوثيهما من الإفك والاحتيال والمداهنة وهما ينطلقان - بأوزارهما وأوزار بني قومهما - ليزرعا الفتنة عند النجاشي؟!
وقد عمد ذانك الخبيثان منذ وصولهما إلى التقرب من بطارقة الملك، وتقديم الهدايا لهم، لأجل استمالتهم حتى تتمّ الاستجابة لرغباتهما، وتقديم العون لهما، كي يمكنهما تنفيذ المهمة التي ألقتها قريش على عاتقهما.. وإنْ هي إلاَّ أيام معدودة، وتمَّت الخطة التي رسمها البطارقة مع موفدَيْ قريش، فأدخلوهما على النجاشي، وهما يحملان الهدايا الثمينة، ويتملّقانه بأشد أنواع التذلل، وتقديم فروض الولاء، بما جعله يُسَرُّ لذلك الإطناب والمديح، ويسأل عن الحاجة التي ألجأت زعامة قريش إليه، فقال عمرو بن العاص:
«عفوك أيها الملك العظيم.. إنه قد ضوى[*] إلى بلدكم منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، بل جاؤوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا جلالتكم.. وقد بعثنا إليكم فيهم أشرافُ قومِهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، لتردُّوهم إليهم، فهم أعلمُ بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه..».
ولئلا يسترسل الرجل في كلامه، فقد قاطعه النجاشي، مشيراً إليه بالتوقف، ثم أومأ إلى عبد الله بن أبي ربيعة ليبدي ما عنده، فقال:
- إني لا أزيد شيئاً على ما قال صاحبي يا مولاي، وقد أتينا نرجو عطف جلالتكم، وردّ أولئك السفهاء إلى بني قومهم..
وحارَ النجاشي... فما كان يعلم عن أمر المهاجرين من مكة إلاَّ أنهم جماعة ضعفاء، قد لحِقَ بهم الظلم والقهر، فآثروا الاحتماء بجواره، نأياً عما يصيبهم وينزل بهم.. ومن منظار الملك العادل، أحبَّ أن يقف على رأي بطارقته وأعوانه، فكان إجماعهم على ما يؤيد أقوال مبعوثَيْ قريش التي هي من أكبر قبائل جزيرة العرب، وأكثرها مكانة ورفعة.. وإنها ما قصدت عاهل الحبشة المفدَّى إلاَّ حرصاً على حكمه، فلا يترك في بلاده نفراً من الأغراب مفسدين، اتخذوا من الهجرة ستاراً لينشروا ديناً ما سمعوا به في آبائهم الأولين!.. وإنَّ الأمر في نهاية المطاف يعود لمليكهم العزيز، الذي يمتلك كل الحكمة والرأي والتدبير في كل شأنٍ!.
أُفٍّ لمثل هذا الكذب، وويلٌ لهذا البهتان، يُفترى بهما على ملك عادل، تملُّقاً ورياء، وممن؟ من بطارقته الذين فعلت الهدايا فعْلها في نفوسهم، فانصاعوا للرشوة وصاحبَيها، وتركوا الحقيقة ونزاهتها.. لقد كان الأوْلى بهم، أن يقدموا لمليكهم النُّصْح، وذلك بأن يستمع إلى المسلمين، ويقف على رأيهم، ليأتي حكمُه عدلاً وصواباً، ولكنهم لم يفعلوا، بل تواطأوا وتآمروا، فقالوا لسيدهم ما قالوا... ولكنْ ما ظن هؤلاء البطارقة بمليكهم؟ إنه حقاً سيدٌ في القول والرأي، فلم يأخذ بما أشاروا عليه، بل وازن بين الرسالة التي جاءته من النبي في مكة، وبين ما سمع هنا في الحبشة، فما وجَدَ إلاَّ مكيدةً ودهاءً، ولذلك نراه - وهو رجل عدل وصلاح - ينتهر أعوانه وبطارقته فيقول لهم غاضباً:
- لقد أخطأتم جميعكم ولم تقولوا صواباً.. فلا والله لا أسلِّم قوماً جاوروني، ونزلوا بلادي، وقد اختاروني دون سواي، حتى أدعوهم إليَّ وأعرف من خبرهم ما يطمئنُّ إليه قلبي.. فإن وجدتهم على مثل ما يقوله رَجُلا قريش كان لي شأنٌ معهم، وإن كانوا على خلافه، كنتُ لهم مانعاً، وأحسنتُ جوارهم..
ثمّ أرسل النجاشي في طلب المسلمين على أن يكون على رأسهم جعفر بن أبي طالب، موفدُ «محمد» إليه، فلما دخلوا عليه في مجلسه، بادرهم قائلاً:
- يا معشر المهاجرين.. لقد جاءني من قريش من يقول بأنكم فارقتم دين قومكم، ولم تدخلوا في ديني، بل اتَّبعتم رجلاً جاء يدعو إلى الفرقة بين أبناء قومه، ويعيب عليهم دينَ آبائهم وأجدادهم، فماذا تقولون بالذي تُتَّهمون به؟!..
وتقدم جعفر بن أبي طالب يلقي على ملك الحبشة، ومَنْ ضمَّ مجلسُهُ الواسع، خطبتَه التاريخية التي تفرق بين الحق والباطل، وهو يقول:
»اعلم أيها الملك، أنَّا كنَّا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنامَ، ونأكل الميْتةَ، ونأتي الفواحشَ، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف»[*].
وسكت جعفر هنيهةً، ثم تابع قائلاً:
«وبقينا على ذلك حتى بعث الله - سبحانه - إلينا رسولاً منّا، نعرف نسبَه، وصدْقه، وأمانته، وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحِّده ونعبده، ونتركَ ما كنَّا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الأصنام والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصِلَة الرحم، وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش، وقول الزُّور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات. وأمرَنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً. وأمرنا بالصلاة والعبادة لله رب العالمين. وفقَّهنا بتعاليم الإِسلام، وحثَّنا على اتِّباع مكارم الأخلاق، فلا نأتي بقولٍ أو فعلٍ إلاَّ في سبيل خير الإنسان، ورفعته وصلاحه. فصدَّقناه وآمنَّا به، واتَّبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحللنا ما أحلَّ لنا. فعدا علينا قومنا، فعذَّبونا وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحلَّ ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيَّقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على مَنْ سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نُظلمَ عندك أيها الملك»[*].
فأشرق وجه النجاشي، وقال لجعفر (رضي اللّه عنه) :
- وهل معك مما جاء به رسولكم عن الله من شيء تقرأه علينا؟
قال جعفر: نعم. وكانت تلاوته من سورة مريم بقوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا *فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا *قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا *قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا *قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا *قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا *فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًّا *فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا *فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا *وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا *فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا *فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا *يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا *فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا *قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا *وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا *وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا *وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا *ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ *} [مَريَم: 16-34].
فلما سمع النجاشي وفهم ما قرأه جعفر، زادَ قلبه اطمئناناً، فسأل البطارقة:
فماذا تقولون؟!
فقالوا:
»هذه كلمات تصدر من النبع الذي صدرت منه كلمات سيدنا يسوع..».
.. لم يستطع أولئك البطارقة أن يدجِّلوا ويخادعوا، وكلمات الحق تُتلى عليهم صادقةً من لدُن عزيز حكيم، يتلوها مؤمن موقن مثل جعفر بن أبي طالب، فطَأطأوا لها الرؤوس، وأقروا بعظمتها وأحقِّيتها، ولم يجرؤوا على النّيْلِ من الحقيقة بشيء بعد أن أخفقت الرشوة وصنّاعُها. ولا ندري أكان ذلك خوفاً من الله (تعالى) في صحوة ضمير ووجدان، أم خوفاً من هذا الملك العادل الذي يُلهَمُ الحقَّ، فينطق به بلا محاباة ولا مواربة؟! إنها أمور في علم الله (تعالى) الذي يعلم ما تكنُّ الصدور، ولكن بدا واضحاً أن البطارقة أُخذوا لسماع القرآن، فقالوا حقاً، وهذا ما جعل وجهَ الملك يعلو بالبِشْر والسرور، فعاد يقول:
- «إن هذا والذي جاء به موسى وعيسى ليخرج من مشكاة واحدة»..
ثم التفت إلى موفَدَي قريش، وقال لهما:
»انطلقا، والله لا أسلِّمهم إليكما»..
وخرج المسلمون ظافرين، منتصرين، وقد علت كلمة الحق على الباطل، لأن كلمة الحق تصدر دائماً عن الحق، فأنَّى لحفنةٍ من قريش، أن يكون لها شأن في ميدان الحق، فخرج رجلاها يجرّان أذيال الخيبة والحسرة تأكل قلبيهما على ما أصابهما من الذل والهوان.
ولكن هل يهدأ بالدهاة المقام، أو يغمض جفنٌ لأصحاب المكائد، بعد أن داسهما الفشل بأرجله؟ أبداً... ولذلك قضى عمرو بن العاص ليلتَهُ مؤرقاً، وهو يفكر بأن يستغلَّ حظوةً سابقةً له عند ملك الحبشة، عسى أن تغيِّره فيما لو عادَ إليه يتملقه، ويخادعه، فصمَّم على الذهاب إليه وطلب مقابلته على انفراد:
وحاول عمرو بن العاص في خلوته القصيرة مع النجاشي أنْ يحرّضه على المسلمين، وهو يدّعي بأنهم يقولون بحق عيسى بن مريم قولاً عظيماً، وأنهم ينكرون أنه ابن الله.. وما كان من ملك الحبشة إلاَّ أن استبقاه في مجلسه، ثم بعث بطلب جعفر بن أبي طالب (رضي اللّه عنه) ليسأله على الملأ:
ماذا تقولون - أيها الرجل - بحق عيسى بن مريم، وهل تنكرون أنه ابن الله؟
قال جعفر (رضي اللّه عنه) :
نقول فيه الذي جاء به لنبيّنا.. إنه يقول: هو عبدُ الله ورسولُه وروحُه وكلمتُه ألقاها إلى مريم العذراء البتول.. وما كلام «محمد» رسول الله إلاَّ تصديقٌ لقول رب العالمين:
{ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ *مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ *وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ *} [مَريَم: 34-36].
وما كاد جعفر ينتهي من هذه التلاوة المباركة، حتى أخذ النجاشي عصاه، وخطَّ بها على الأرض خطّاً - وقد بلغتْ منه المَسرَّةُ أكبرَ مبلغ - ثم قال: «والله ما عدا عيسى بن مريم قال مثل هذا القول[*]. وليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط. اذهبوا فأنتم شيوم (آمنون) في أرضي، من سبَّكم غُرم، ما أحبَّ أن لي دبراً (جبلاً) من ذهب وإني آذيت رجلاً منكم، ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين ردَّ عليَّ ملكي، ولا أطاعَ الناس فيَّ، فأطيعَ الناس فيه»[*].
»فخرجا من عنده - مبعوثا قريش - مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به»[*].
وكان عمرو بن العاص أشدَّ حنقاً من صاحبه: مصفرَّ الوجه، عاقد الجبين، يكاد الغيظ والكمد يخنقانه.. فما عرف في حياته مثل هذا الفشل الذريع الذي لاقاه بالأمس واليوم.. وما عرف رجلاً أذكى ولا أقوى حنكة من هذا الذي يُسمى جعفر بن أبي طالب! إذ كيف أمكنه أن يأسرَ عقل النجاشي بمثل هذه السهولة؟! وهل إلاَّ قرآنه، الذي يقرأه، هو الذي يعطيه مثل هذه القوة، وتلك الحكمة؟..
وعاد موفدا قريشٍ إلى مكة، وهما يتجرعان كأس الفشل، لِتَذوقها قريش بدورها علقماً أشدَّ مرارة، وخيبةَ أملٍ أقوى حسرةً، بعدما رأت أن المهمة التي بعثت بها هذين الرجلين قد باءت بالخسران، كما في جميع محاولاتها من قبل، وسقطت كافة مكائدها التي نصبتها لوأد الدعوة الإسلامية في مهدها، ومنعها من الظهور.. وقد لجأت منذ أن أعلنت حربَها على هذه الدعوة إلى أسلحة متعددة:
سلاح استمالة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لإغوائه بعروض واسعة من المال والجاه والسلطان والحكم!..
وسلاح التعجيز، بما طلبت إليه أن يأتي به من معجزات وخوارق تشهدها بأم العين..
وسلاح الدعاية ضدّه، باتِّهامه زوراً وبهتاناً بأنه رجل مسحور، أو بأنه كاهن وساحر ومجنون، وضد الدين الذي يدعو إليه، عندما جنَّدت النضر بن الحارث، ليقول للناس بأن الآيات التي يتلوها «محمد» عن أخبار الماضي، وقصص الأمم الغابرة إن هي إلاَّ أساطير الأولين!..
وسلاح الاستهزاء، والأذى، والعذاب، تصيب به المسلمين كافة، أسياداً ومستضعَفين، وتطال به النبيَّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نفسه، رغم حمايته من بني هاشم وبني عبد المطلب..
وسلاح التكذيب والافتراء وعدم تصديق النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأن جبرائيل يتنزل عليه بالوحي من ربِّ العالمين.
وسلاحُ محاربة القرآن والدعوة إلى عدم سماعه، بل واللغو فيه...
وكان ذلك كله عبثاً، ولم يُجدها بأي نفع.. أما السبب فهو هذا القرآن الذي يفعل فعلَهُ في النفوس، والمثال الحيّ الأخير موقف نجاشي الحبشة، الذي لولا سماعه لآيات هذا القرآن، لما كان ردَّ لها طلباً، ولا رفض لها هدايا.. إذن فالحرب يجب أن تكون على هذا الكتاب!..
عودة إلى محاربة القرآن
لذلك عادوا للتآمر على القرآن المجيد.. إذ كانوا يرون بأن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يجلس أحياناً عند المروة، فيأتيه غلام للفاكه بن المغيرة اسمه «جبرا»، وهو على دين النصارى، فراحوا يزعمون أن جبرا هذا هو الذي يعلّم «محمداً» ما «يدّعيه» وحياً من السماء، لأنَّ كل ما يحدّث به من أخبار الماضي، أو ما يعدُ به من أمور الدنيا والآخرة - وهو أميّ لم يقرأ ولم يكتب - لا يعدو كونه من تعاليم النصارى التي يأخذها الرهبان من التوراة والإنجيل، ويعلّمونها لأتباعهم مثل هذا الغلام النصراني..
وزيادة في العنت والضلال، ولإيهام الناس بصحة دعواهم الكاذبة، جعلوا الفاكه بن المغيرة يهجمُ على غلامِهِ «جبرا» هجمةً شرسةً من التعذيب النفسي والجسدي حتى يعترفَ بأنه هو الذي يعلّم «محمداً» ما يقوله للناس، فلا يجد هذا المسكين ما يدفع التهمة عنه إلاَّ أن يقول:
- لا والله، بل هو الذي يعلّمني ويهذّبني، وأنا لا أحسن إلاَّ قراءة الكتب الأعجمية، وما بي من علمٍ بقراءة العربية أو كتابتها.
ويبيّن الحقُّ تبارك وتعالى دعوى المشركين الباطلة بقوله الكريم: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ *} [النّحل: 103].
ولو تفكَّر أولئك الكفار الفجرة قليلاً، لوجدوا سخافة ادّعائهم وزعمهم، فاللغة التي يعلمها «جبرا» قراءةً وكتابة، وهو الذي يضيفون إليه التعليم، ويحيلون إليه القول، كانت أعجمية، ولذلك لم يقل القرآن المبين لسان الذي يلحدون إليه «عجميٌّ»، بل قال: «أعجمي» لأن العجمي هو المنسوب إلى إيران وإن كان فصيحاً، والأعجمي هو الذي لا يفصح وإن كان عربياً، ألا نرى إلى سيبويه إذ كان عجمياً، ولكنَّ لغة الضادّ كانت لسانه؟!..
وهنا يأتي التساؤل - لشدة الاستغراب والاستهجان ـ: كيف وصل الغباء بأولئك الملحدين من قريش، في افتراءاتهم على القرآن الكريم، لأن يقولوا: إنَّ الذي يعلّم «محمداً» القرآن هو هذا الغلامُ النصرانيُّ «جبرا»، أليس هو أعجمياً؟ فهل يمكن لهذا الأعجمي اللسان أن يعلّم غيره كلاماً عربياً فصيحاً؟! هذا مستحيل!... ثم أليس القرآن قولَ الله - عزَّ وجلَّ - الذي يتنزَّلُ بلسانٍ عربي مبين؟! أليس القرآن معجزاً للإنس والجن فلا يقدرون على معارضته ولو بسورة واحدة حتى ولو كانت هذه السورة من ثلاث آيات؟!
أجل، إنه عجيبٌ أمر أولئك القوم!.. فكأنما صدَّقوا الكذبة التي ابتدعوها هم أنفسُهم، فأطلقوا مثل تلك الشائعات الزائفة التي لا تُصدّق، ولا يقبلُها لضعفها، عقلُ مُنصف. لذلك، ولمَّا تبين لدعاة الشرك والكفر أن زعمَهم ذاك وترويجَهم له لم يأتيا بأية نتيجة، جاء نفرٌ منهم إلى محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وفيهم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، يعرضون عليه أمراً جديداً أكثر غرابة وبلاهةً، وهم يقولون:
- يا محمد! هل تأتي بكتاب لا ينهى عن عبادة اللاّت والعزى، ومناةَ وهبلَ، وليس فيه ما يعيب آلهتَنا، ولا يسفه أحلام من يعبدونها؟ فإن لم تفعل، فأتِ بقرآن غير هذا أو بدّله بكلام من عندك تذكر فيه آلهتنا بخير، فنذكر إلهك بخير، وتعبدُ آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة!.. وطردَهم النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) شرَّ طردة، وما كان له إلاَّ أن يطرد هؤلاء الكافرين، لأنه هو مؤمن بالله الواحد الأحد فلا يعبد ما يعبدون، ولأنهم كافرون لا يعبدون ما يعبدُ، ولأن عبادتهم، التي جاؤوا يسوّون بينها وبين عبادة الله الحق ليست إلا هرطقة عقلية.. وكفى بهم، وبالناس من أمثالهم، أن يُذلّوا بها أنفسهم، وأن يهينوا بطقوسها كرامة خلْقهم.. وكان التنزيل المبين بقوله تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ *وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ *وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ *} [الكافِرون: 1-6].
وألحُّوا عليه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن، أو أن يبدِّله بقول من عنده، فأنكر الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عليهم ذلك إنكاراً شديداً، وبيَّن لهم أن القرآن هو قول الله تعالى، يَنزل عليه بالوحي، فلا يمكنه أن يأتيَ بمثله، وأنَّ ما يدْعونه إليه، كفرٌ وعناد.. فنزل في ذلك قولُه تعالى:
{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ *فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ *} [يُونس: 15-17].
واجتمع الرسولُ بأولئك الظالمين يتلو عليهم الآيَ الحكيمَ الذي يَردُّ دعواهم؛ ولكن بدل أن يستحوا من قول الحقّ الذي يفضح افتراءهم، عادوا يعرضون عليه مجدداً، أن يُنزّل كنزاً من السماء أو أن يأتي معه ملَك لكي يصدِّقوه، وفي ذلك نزل قول الله تعالى:
{فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ *} [هُود: 12].
هكذا كانت تتحرّكُ عقول دهاة قريش، لا لشيء إلاَّ لمضايقة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وإرغامِه على أن يترك بعضَ ما يوحى إليه من ربِّه.. ولكن هيهات، هيهات وزادُهُ الوحيُ الذي يطمئنه بألاَّ يغتمَّ ولا يضيق صدره بما يقولون.. «إنَّما أنت نذير»، لهؤلاء، ولكل من يكذِّب بآيات الله. وهذا الإنذار ليس فقط من أجل تخويفهم بما ينتظرهم من العذاب الأليم، بل إنه رحمة من الله القادر، الجبار، المهيمن، يفسح في المجال الأرحب لعباده وخلْقه، ولو كانوا من الكافرين، كي يرعَوُوا عن الضلال، ويهتدوا إلى الحق، فيتوبَ عليهم، وتشملهم رحمته الواسعة، وتكون لهم جنة عرضها السموات والأرض. فسبحان الله الرحمن بعباده، الرحيم بأوليائه، وإلا لماذا هذا التوكيد على ترك الكفر؟.
إنها عظمة القرآن وهو يحذّر، وينذر طغاة قريش، بل وينبّه جميع بني آدم بألاَّ يجدِّفوا[*] على الحقّ الذي يتنزّل عليهم من ربهم، ويأمرهم بأن يتَّقوا العذاب الأليم الذي ينتظرهم من جراء هذا التجديف، والافتراء على الله كذباً، ثم يدعوهم إلى هداية القرآن، والانضواء تحت لواء الإسلام، وهو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا، والفوز في الآخرة...
ولكن ماذا فعل عتاة قريش، على الرغم من كل ما يواجههم به القرآن، وكلِّ الأدلة والحججِ القاطعةِ التي يدفع بها أقاويلهم وافتراءاتهم؟ لقد أوصدوا على نفوسهم كلَّ منافذ الحق، وأغلقوا على قلوبهم كلَّ مسارب الإيمان، وطمسوا على عقولهم بالضلال والوهم، وكل ذلك لأنهم لا يريدون أن يستجيبوا لدعوة محمد بن عبد الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولا لآيات القرآن الكريم التي تبين الحقائق وتهدي إليها، والتي تقدم لهم من العظات ما يقود إلى النور المبين..
نعم لم تستجب قريش، بل ظلَّتْ على جهالتها، ممعنةً في الكفر، باذلةً كل ما تستطيعه من جهود لمحاربة الرسول، لأنها تعتبره خارجاً عليها وعلى دينها ودين آبائها.. بينما ظلَّ هو على عهده مع ربِّه يدعوها إلى الحق، ويجادلها بالموعظة الحسنة، مذكّراً وواعظاً، مبشِّراً ومنذراً دون أن يجدي معها شيء من ذلك!..
المقاطعة والحصار في شعاب مكة
وماذا بعدُ أمام قريش وقد ثبت لديها باليقين القاطع أن كل ما قامتْ به كان محضَ أباطيل، لأنه لم يوصلْها إلى الغايات التي ترجوها؟
وماذا عليها لو أقرّت بصدق ما يدعو إليه محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فتكون لها بهذا التصديق هدايةٌ إلى نور الحق، الذي ما فتىء النبيُّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ينشر ظِلاله على ربوعها، ويعمل على جذْب نفوسها الحائرة إلى هذا النور، حتى يخلّصها من أحقادها السامة، ويشفيها من أمراضها القاتلة؟ بل وماذا عليها لو اعترفت بأحقيّة الإسلام الذي يُخرج الناس من الظلمات إلى النور، فتنضوي تحت لواء الإِيمان بوحدانية الله - تعالى - وتدخل في هذا الدين راضية قانعة؟..
وهل بقي أمام قريش إلاَّ مثل هذا الإيمان الحق الذي يجعلها تدرك حقيقة وجود الله الواحدِ الأحدِ، الفردِ الصمد، وتفرّق بين الألوهية المطلقة وخرافةِ الأصنام، وأوهامِ الأوثان التي تتخذها آلهة لتقرِّبها زُلفى إلى الله؟..
لا، ليس أمامها إلا أن تهتديَ إلى الإسلام ،هذا لو كانت لها عقول غير عقولها، ونفوس غير نفوسها، وقلوب غير قلوبها.. ولكن، وهي قريش، وفيها تلك الفئة الطاغية الباغية من الذين يتسلمون زمام الزعامة، فإنها على كفْرها باقية، وعلى وثنيتها قائمة.. ولم يحن الوقت، الذي تدفعها فيه قوة الإِسلام إلى الإِذعان والرضوخ لأمر الله تعالى.. ومن أجل ذلك، فإنها لن تُهادِن في حربها الضروس على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ودعوته، وهي، لن تعدَم الوسيلةَ والحيلة، والأسلوب والخطَّة، للمضيِّ في تنفيذ سياستها الرعناء التي تظن بأنَّها لا بُدَّ من أن توصلها لتحقيق مآربها الوهمية.
وها هي قريش، وحيال فشل مختلف الخطط والوسائل، والأساليب التي استعملتها - سابقاً - ضد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وصحبه الكرام، نجدها تعمد إلى ابتكار نمطٍ جديد من أنماط عداوتها، فتفكِّر في مقاطعة شاملة، لا تقتصر على «محمد» وحده، بل وتشمل بني هاشم وبني المطلب جميعاً، لأنهم يحمونه ويمنعونه منها.
واجتمعوا في خيف[*] بني كنانة من وادي المحصب، وكلفوا منصور بن عكرمة[*]، أن يكون كاتب الصحيفة التي تعاقد فيها شيوخ الكفر، وأسياد الوثنية على قطع كل الصِّلات مع بني هاشم وبني المطلب: فلا يُنكِحون منهم، ولا يُنكِحون إليهم، ولا يبيعونهم ولا يَبْتاعون منهم شيئاً، ولا يقبلون منهم صلحاً أبداً، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلِّموا إليهم «محمداً».
وبعد الانتهاء من هذا التعاقد الخبيث، أمروا بصحيفتهم التي وقَّع عليها أربعون رجلاً - من قريش - فعلَّقوها في جوف الكعبة، توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم..
وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب - مؤمنهم وكافرُهم - إلى رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلاَّ أبا لهب فإنه ظاهرَ قريشاً على أهل عشيرته، وحُبِسَ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ومن معه في شعب أبي طالب ليلة هلالِ المحرَّم سنة سبع من البعثة[*]... ولا بدَّ هنا من الاعتراف لقريش بقدرتها على الثبات والاستمرار في نهجها العدواني، إذ كانت تعني كل موقف وقفته من دعوة الإسلام، وتدرك آثار كل سياسة اعتمدتها. ولذلك فإنها لم تكن قطُّ عبثية التفكير، أو ساديَّة التصرف، في هذه المقاطعة التي تفرضها، والتي هي في الحقيقة أشدُّ أنواع الأسلحة التي تستخدمها لمحاربة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والإِسلام، لأنها تؤدي حتماً إلى إخراج بني هاشم، وبني المطلب - حماةِ محمد - من مكة، فلا يكون أمامهم إلاَّ التشرّد في البلدان والأمصار، فترتاح بذلك من نفوذهم إلى الأبد.. أو تجعلهم يعيشون في البراري والفلوات، بلا رزق يصيبونه، أو زادٍ يتبلّغون به، فيموتون جوعاً وعطشاً...
وكان في ظن قريش أن حُماةَ «محمدٍ» ليسوا في وارد التشريد في الأمصار، أو اللجوء إلى البراري والقفار، وأنهم لن يقبلوا بشيء من ذلك أبداً لأنه يقوّض أركان وجودهم ويدمِّر حياتهم بأسرها.. وهذا ما سوف يضطرهم إلى التخلّي عنه، لأنه لا يُعْقلُ أن يُضحّوا بأنفسهم، كباراً وصغاراً، مقابل فرد واحد منهم!.. ولو كان هذا الواحد «محمداً»!..
أما بالنسبة إلى «محمد» بالذات، فسوف يجد نفسه وحيداً، بلا نصير أو معين، وعندها لن يكون أمامه إلاَّ الإِذعان لقريش، والتخلي عن الدين الذي يدعو إليه.. أو أنه - على أبعد تقدير - سوف يبقى مشرَّداً، من غير احتكاكٍ بالناس، فتضمحل الدعوةُ التي يحمل، ويزول خطرها على مكانة قريش وعلى الآلهة التي تدعوها فيعود لها سابق عهدها من العز والمجد!...
تلك كانت تصورات شياطين قريش من سياسة المقاطعة التي أقرّوها، ونفذوها بالفعل، ولكن هل حققت تلك المقاطعة الأغراض والمآرب التي أرادوها؟
لا، ونعم...
لا، من حيث الجوهر..
أما من حيث المظهر، فنعم..
فمن حيث الجوهر، لم تؤدِّ سياسة المقاطعة إلى القضاء على الدعوة الإِسلامية، لأن المسلمين ظلُّوا على إيمانهم ثابتين، ومن يمنعون محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من بني هاشم، وبني المطلب ظلُّوا على عهدهم قائمين في حمايته والذود عنه.. إذن فالدعوة باقية، ولا يمكن لإِرهاب قريش، ولا لظلم شياطينها، كما لا يمكن لأية قوة في العالم، أن تقدر على غلبة أمر هو لله سبحانه وتعالى..
فكيف إذا كان هذا الأمر هو دين الله، الإِسلام، والرسالة التي أرادها الخبير العليم في نهاية مطاف الرسالات إلى الأرض، الرسالةَ الخاتمةَ، الكاملة، المتكاملة التي تقدِّم للإِنسان معاني الحقائق المطلقة عن الحياة، والوجود البشري، بل والكون بأسره، والتي أنزلها الحقُّ - تبارك وتعالى - ليكون محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو حاملها ومبلِّغها؟!. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن لسياسة قريش الرعناء - سواء بالمقاطعة أو بغير المقاطعة - أن توقف الدينَ الذي يهدي إلى صراط الحميد المجيد؟! أو هل يمكن لحامل الشعلة الإلهية أن يرضخ لضغوط تلك السياسة فيطفىء النور المبين لمجرد تشريد، أو جوع، أو قهر أو مقاطعة؟!
أما وأيمُ الله[*] لا يكون شيء من ذلك أبداً.. فإن محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو رسول الإِسلام، وهو كلما اشتدَّ عليه الكفر وأعوانه، ازداد صلابةً وإيماناً.. وإنَّ في مقاطعة قريش لدافعاً جديداً له إلى الثبات والعزم، فلا يزيده بغيُها إلاَّ اعتصاماً بحبل الله تعالى، وتمسّكاً بدينه القويم، وتصميماً على إظهار أمر ربه... ثم إنَّ من ورائه أصحابَهُ الذين لا يزيدهم الظلم إلاَّ إيماناً وصلابةً وصبراً. بل ومعه أبناء عشيرته الذين يصهرهم القهر والجوع والعطش كتلة واحدة مع صحابته، فلا بأس بما يصنع الظالمون بهم.. إنهم يحتملون مشاقَّ المقاطعة، وفظاعة قسوتها، ويقنعون بما قدَّر الله تعالى لهم من ألم، وعذاب، واضطهاد؛ المهم أن يبقى المسلمون والدعوة الإسلامية صنوين، بها يحيوْن، ومن أجلها يعملون، وفي سبيل الله ربهم وبارئهم، أقسى أنواع المشاق يتحملون.. وأن يبقى أولئك الأباة ممن يحمون «محمداً» ويعاضدونه في أمره، على سلامة الصحة والأبدان، فلا تطالُهم المقاطعة بما يبخسهم حقوقَهم في الكرامة والنبل والشرف في القوم.
هذا في جوهر الأمر الذي قامت عليه سياسة البغي، فما نالت منها قريش ما توهمت.. إذ لم يُقضَ على الدعوة الإسلامية، بل على العكس أينعت للإِسلام ثمراتٌ جديدةٌ وأطيبها هذا التلاحم بين المسلمين وبين عشيرة النبي (ص) - وهو ما سوف يؤتي أُكلَه لاحقاً - ومن ثَمَّ هذه التربية النفسية في الصبر والثبات - والاحتساب عند الله كما كان يعلّمه النبيُّ للمقاطعين جميعاً... وبذلك خسرت قريش - في الواقع - ما ظنَّتْ أنه أكثر سياساتها حنكة وتدبيراً وأكثر أعمالها ربحاً...
أما من حيث الشكل، وفي ظاهر عمل قريش، فقد بدا أن المقاطعة حققتْ أهدافها المرسومة من العنت والظلم، إذ استطاعت أن تُخْرج الرسولَ الكريمَ والمسلمين، وبني هاشم وبني المطلب من مكة ليعيشوا ثلاث سنوات كاملة في الشعاب، وفي الفلاة، فيعانون من ألوان الجوع والحرمان أشدَّها، ومن أشكال الحاجة والعوز أكثرَها...
لقد تركوا ديارهم، وخلَّفوا الأرزاق والمواشي، بعدما منعت عليهم قريش حملها، أو سوْقَها حين خروجهم، إلاَّ بعض القوت والزاد، وكان قليلاً، إذ ما لبث أن نفد بعد مدة وجيزة، نظراً لكثرة عددهم، وقد ضمَّ جمع المسلمين، وبينهم جمع بني هاشم وبني المطلب، بشيبهم وشبابهم، وبنسائهم وأطفالهم.. فقد قبعوا في شِعاب مكة في عزلة تامة عن بلدهم الآمن، وفي مقاطعة شاملة عن أهل مكة، والعرب جميعاً.
فأية حالة من الضنك كانت تحيق - أيام الصيف - بأولئك الذين فُرضت عليهم هذه المقاطعة الجائرة عندما كانت تشتد حرارةُ الرمضاء المحرقة، فلا يجدون مقيلاً إلاَّ الرمالَ الملتهبة، والصخورَ الحامية، تلوذ بها أجسادهم النحيلة التي تتهاوى ضعفاً وتتضور جوعاً؟!.
وكيف استطاعوا - أيام الشتاء - أن يطيقوا البرد القارس، والصقيع القاتل، في تلك الشعاب، ولا غطاء ولا وطاءَ إلاَّ بعض الكهوف الضيِّقة، يُدخلون إليها النساء والأطفال والشيوخ، بينما يظل الآخرون في الخارج يلتحفون السماء، ويفترشون الغبراء تحت وطأة تلك الأحوال الجوية القاسية؟!
وكيف يمكن أن نتصوَّر حالة الشيوخ، وقد وهن منهم العظمُ ونحُلَ الجسم، واشتعل الرأس شيباً، وهم لا يقدرون على تحمل جوع أو عطش، ولا يطيقون حرّاً أو قرّاً؟
أم كيف يمكن أن نتخيَّل حالة الأمهات، وأطفالهن يذوون[*] على صدورهن، فتتحول فلذاتُ الأكباد من زهرات يانعة نضرة، إلى هياكل بشرية لا حياة فيها ولا رمق، غير لهاثٍ يتصاعد من الصدور بشق النفس؟. وكمْ هلكَ من أولئك الأطفال جوعاً وعطشاً، ولا حيلة للأمهات إلا ذرف الدموع، وتصعيد آهات اللوعة!...
لقد هانت الدنيا على أولئك الناس في الشعب، فراحوا يفتِّشون عن وسيلة يستعينون بها على ما يصيبهم، فلم يجدوا إلاَّ الحجارة يضعونها على بطونهم الخاوية اتِّقاءً للآلام التي تنهش أمعاءهم، أو الخِرق البالية يعصبون بها رؤوسهم، لتخفيف الأوجاع التي لا تفارقهم...
وكان لنبيُّنا (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو أول من شدَّ الحجرَ على بطنه، حتى يكون مثالاً يُقتدى به فتخفَّ على الآخرين أوجاعُ أجسامهم، وجراحات نفوسهم. وهو أول من دعا الشباب والرجال لكي يضربوا في البراري سعياً وراء نبات الأرض والأعشاب الصالحة للأكل، يسدُّون بها رمق أكثرهِم حاجةً، وأشدِّهم دنُوّاً من الهلاك، وهي في تلك الشعاب السوداء قليلة، إلاَّ من شيءٍ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع!..
وكيف لا تهون الدنيا على المسلمين، وقد كانوا، وما زالوا، أعزَّة على الكافرين الذين سعوا إلى طردهم؟
وكيف لا تهون الدنيا على بني هاشم، وبني المطلب وهم أصحاب الثروات، والمواشي، وأهل البيوت المفتوحة على مصاريعها، يُقْرون الضيف، ويُطعمون الجائع، وينصرون المظلوم، ويأوي إليهم السائل والمحتاج؟!. بل أليسوا هُمُ الأسياد الذين كانوا يسوسون الناس، فلا أمر يُقطَع في مكة إلا برضاهم، ولا شيء يُقام إلاَّ بإرادتهم؟ لقد توارثوا مناصب الكعبة ومقاليد مكة أباً عن جد، حتى صارت لصيقةً بهم طوال حقبات من الزمان.. أفلا تهون عليهم الحياة بأسرها، وقد طردتهم قريش إلى الشِّعاب، ووصلوا إلى تلك الحالة من البلاء؟!
ولكنَّ ما حلَّ بأهل الشعاب، وما أصابهم، كان في مقياس المكرمات وساماً لهم على جبين الدهر، لأنهم ظلوا يحافظون على العهد الذي قطعوه لشيخهم أبي طالب، ويتوشحون بكلمة الشرف التي أعطوها له، في منع محمد رسول الله، رغم كل ما يلاقون من جراء ذلك العهد. لمثلهم تكون العهود والكرامات، وخاتم النبيين وسيد المرسلين، محمد بن عبد الله، هو من هذه الشجرة الطيبة، التي أصلها ثابت في الأرض، وفرعها في السماء!..
لقد تخلّوا عن كل شؤون الدنيا وطيباتها في سبيل عهدهم، والوفاء به، حتى شارفوا على الهلاك دون هذا الرسول الكريم، وما خانوه.. وما تخلّوا عنه!.. فكانوا للناس نبراس النصرة، والالتزام بالوفاء. ويكفيهم شرفاً ما كان يفعله سيدهم أبو طالب، كما يروي عنه ابن كثير في تاريخه: «إذ كان إذا أخذ الناس مضاجعهم طلب إلى رسول الله فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك جميع مَن في الشعب، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته، فاضطجعوا على فراش رسول الله، أو دعا الرسول أن يأتي مكاناً آخر ينام فيه محافظة على سلامته».
وتظهر مشاعر أبي طالب فيما كان يعاني من المقاطعة، وهم في الشعاب، بقصيدة طويلة، ومنها هذه الأبيات، حيث يقول:
ألا أَبلِغا عنِّي على ذاتِ بَيْنِنا
لؤيّاً وخُصّا مِنْ لؤيٍّ بني كعبِ
ألمْ تَعلمُوا أنّا وجَدْنا محمداً
نبيّاً كموسى خُطَّ في أول الكُتْبِ
وأنَّ عليه في العباد محبةً
ولا ضيرَ مِمَّن خَصَّهُ اللَّهُ بالحُبِّ
أَفيقوا أَفيقوا قبلَ أنَ يُحفَرَ الثَّرى
ويُصِبحَ مَنْ لم يَجْنِ ذَنْباً كَذِي الذَّنبِ
ولا تَتْبَعُوا أَمْر الوُشاةِ وتَقْطَعُوا
أواصِرَنا بَعدَ المَوَّدةِ والقُرْبِ
فلسنا وربِّ البيتِ نُسْلِمُ أحمداً
لِدَهْماءَ مِنْ عَضِّ الزمان[*] ولا كربِ
فأولئك هم أصحاب الشعاب.. الأسياد الكرام الذين طردتهم قبيلتهم قريش ظلماً وعدواناً، فآثروا الحمد على الشتيمة، والعزَّ على الذل، والدينَ على الدنيا، فكانوا - في ميزان الحق - هم الفوارسَ الأحرار، وأعداؤهم هم العبيدَ المحاصرين...
أما محمد بن عبد الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، الإنسانُ البَرُّ، العطوف، الحليم، فهل كان يمكن أن يعايش المحنة التي أصابت أصحاب الشعب إلاَّ على أساس أنه رسول الله، والمثال الأعلى للمسلمين ولمانعيه الميامين؟ والقائد الحكيم للناس أجمعين؟ وعلى أنه النموذج الذي يحتذى في الصبر والرضى بقضاء الله العلي الحكيم ما دام مقصدُه الأسمى نشرَ كلمة الله وجعلها هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى؟.
فماذا كان يفعل، وهو من عُرِفَ عنه طوال حياته، متميزاً بتلك الصفات من الكرم والإحسان، والصدق والأمانة، والمروءة والنجدة، والشفقة والعطف، والصبر والجلد؟!... أجل ماذا كان يفعل هذا الإنسان وهذا النبي عندما كان يرى كل مَن حوله وأصحابه، يتحملون ما يتحملون، ويعانون ما يعانون؟..
إنه كان (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يعايش آلامهم فتهون عليه آلامه.. ويحس بجوعهم وعطشهم فيزول من نفسه كل جوع أو عطش.. ويرى حرمانهم وقهرهم فيتألَّمُ قلبه أسىً وحزناً..
إنه كان (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يجلس وحيداً حزيناً، متألماً، فيضرعُ إلى الله تبارك وتعالى متوسِّلاً، راجياً أن يُذهِبَ عن هذه الجماعة، التي تحيط به، كل كرب وضنك[*]، وأن يخلِّصها من تلك المأساة المروعة التي حلَّت بها دونما ذنب اقترفته إلاَّ أنها مع الحق، ونصير للحق..
كان يأتي إلى هؤلاء المظلومين، معتصراً آلامه في نفسه، مبدياً ابتساماته المشرقة، التي كانت تفرّج عنهم بعض الهمِّ والألم.. لا يتركهم قطّ، إلا لعبادةٍ أو ابتهال، ثم يقوم بينهم، مواسياً، مشجِّعاً، مبيِّناً مكرمة الصابرين عند الله، وفضائل المعذَّبين في سبيل الله...
لا يدَعُ ساعة من النهار إلاَّ ويمنِّيهم بالفرج والخلاص، وهو يضرب لهم الأمثال، عن مخلوقات الله في الأرض، فيذكِّرهم بأنَّ أضعف المخلوقات يرعاها ربُّ السماوات والأرض، وربُّ العرش العظيم، مالكُ الملك وهو على كل شيء قدير، يبسط الرزق لمن يشاء ويقْدر. ومن أجل ذلك، كان على الإنسان أن يتوكَّل على الله وحده، وأن يسلِّم أمره لربِّه، فلا يخاف بعده غائلة الجوع والفقر، ولا يهاب حرمان الأيام والسنين.
نعم كان رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يبيِّن لأصحاب الشِّعب تدبير الله - سبحانه - في مخلوقاته، ويرشدهم لأن يكون لهم هذا النهج من التوكُّل، وهو يقول لهم: «لو توكلتم على الله حق التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خِماصاً وتروح بطاناً»[*].
وبمثل هذا النهج النبوي من الرحمة، والحدب، والإيناس، والتدبير، وبمثل ذلك الدأب الرسولي من المواساة، والتشجيع، والتوكُّل على الله تعالى، أمكن لرسول الله أن يُعين أصحاب الشعب على بلواهم، فكان الزادَ المعنويَّ الذي يمنحهم به: قوةَ الاحتمال، على مغالبةِ الشدة، ومصارعة الضيق والشظف.
تلك هي الأحوال والأوضاع التي كان عليها أصحاب الشِّعب من جراء سياسة المقاطعة التي فرضتها عليهم قريش، والتي وصل الحصارُ فيها إلى حد يفوق التصوُّر، أين منه اليومَ أيُّ حصار قد تقرره بعض الدول لمعاقبة دولة، أو دول غيرها بذرائع تختلقها لذلك.. حيث تبقى منافذ العالم الأخرى مفتوحة على الدولة المحاصرة، فلا يموت شعبها من الجوع، بل ولا يقبل العالم الآخر أن يميت هذا الشَّعبَ بسبب السياسات المتضاربة.. هذا في حين أن سياسة المقاطعة التي اعتمدتها قريش قد جعلت أصحاب الشعب معزولين عن سائر الناس، دون أيةِ علاقات معهم، لا اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية، على الإطلاق.. اللهمَّ إلاَّ ذلك الاختلاط البسيط، الذي كان يُسمح فيه للمسلمين، بالنزول أيام الأشهر الحُرُم إلى الكعبة، فيجد فيه الرسول الكريم سبيلاً للخروج من العزلة المفروضة عليه، فيتصل بقبائل العرب التي تفِد مكة في المواسم، ويدعوها إلى دين الله الواحد.. فكان عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ينزل مع بعض الصحابة، كل يوم من أيام المواسم، ثم لا يلبثون أن يعودوا في المساء إلى الشعاب، من دون أن يتمكنوا من حمل شيء معهم، إذ كانت قريش بالمرصاد، تمنعهم، وتحول دون قيامهم بأية عملية بيع أو شراء، أو قبول هدية، أو سداد دين.. حتى إذا انقضت أيام الأشهر الحرُم، منع عليهم النزول إلى مكة، وظلّوا في الشِّعاب على أحوالهم المتردية...
السعي لخرق المقاطعة
..وقد بلغت قلوب شياطين الكفر من قريش حدّاً من القسوة والفظاظة، جعلهم يجدون في المقاطعة راحةً لهم، وشماتةً بأولئك المحاصَرين!.. فطاب لهم العيش بدونهم، وهنئوا ببعادهم، حتى صار محورَ أحاديثهم وَهَنُ أصحابِ الشِّعاب وضعفُهم، وتفكُّهُهُمْ بالمعاناة التي يلقونها، فلا ينقضي مجلس من مجالسهم إلاَّ بعد أن ينتهيَ أولئك الكفرة الفَجَرةُ من الشماتة والسخرية، بما يروي غليلَ أحقادهم...
على أن ذلك الحصارَ، على شدة قسوته، وطول مدته، لم يعد ليروقَ لأولئك البعض من القرشيين، الذين ما تزال في نفوسهم بقايا من الرحمة أو الإنسانية، فأخذوا يبعثون للمحاصَرين شيئاً من الزاد والماء، يحمِّلونه ظهورَ الدواب ثم يقودونها تحت جنح الظلام، وخفيةً عن عيون القوم، ليصلوا بها إلى طرق الشعاب، فيتركونها تسير وحدها حتى يمسكها الساهرون جوعاً!.
ومن أولئك الذين لامسَتْ قلوبهم الرحمة، حكيم بن حزام بن خويلد، إذ لم يعُد يهون عليه أن تبقى عمَّتُهُ خديجةُ بنت خويلد - زوجة رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) - بدون طعام، وهي صاحبةُ الفضل عليه، وعلى كثيرين غيرِه، فحمل، مع غلام له، بعضَ القمح يريد إيصاله إلى عمّته، ولكن لسوء الحظِّ، يصادفه أبو جهل في الطريق فيستوقفه معترضاً، مهدِّداً، متوعداً وهو يقول:
- ويحك يا حكيم! واللاتِ والعزَّى لا تبرح حتى أفضحَك أمام قريش!
ويمرُّ أبو البختري بن هشام، وهما في ذروة جدالهما، حتى إذا تبين جليَّةَ الأمر، قال لأبي جهل:
- وأيُّ ضيرٍ يا أبا الحكم بأن يحملَ حكيمٌ بعضاً من القمح إلى أولئك الذين عزلتموهم عن كل أسباب الحياة، حتى وصل بكم الجورُ لأن تُميتوهم جوعاً؟!.. فخلِّ سبيلَ الرجل ودَعْهُ يذهب لشأنِه!.
ولكنَّ أبا جهل أصرَّ على لؤمه وعناده، مما جعل الموقفَ يحتدم بينه وبين أبي البختري، ويدفعُ بهذا الأخير لأن يتناول لحيَ جملٍ ويشجّه به، ثم يأخذ بركله، إلى أن أمكن للحاقد أبي جهل أن يفلت، ويمضي هارباً، وهو يكيل للرجلين أشنع الشتائم وأقبحَها.
وشاع خبر حكيم.. فجاءَهُ الحاقدون يلومونه، ويتوعدونه بالإِيذاء - وربما القتل ـ، إن عاود المحاولة لمساعدة «الصابئين».. بينما كان الخبر ذاته حافزاً لغير الحانقين، لأن يحذوا حذو ابن حزام، وهم يشعرون بفداحة الجرم الذي يقترفه زعماء قريش بحق أهل «محمد» وأصحابه.. وكان هشام بن عمرو بن ربيعة أكثرَ الناس ندماً على المقاطعة، فصار يأتي بالبعير، فيحمِّله الطعام والبُرّ، ثم يسير به في جوف الليل حتى يصل إلى طرف الشِّعَب، فيخلع خطامَه من رأسه، ثم يضربه على جنبه ليأخذه المحاصرون ويقتاتون بحمله. فإذا لم يبق عندهم شيء، عمدوا إلى البعير فذبحوه، وجعلوه زاداً للجياع...
وبفضل تلك المساعدات - وما كان المسلمون يشترون، في الخفاء، من المؤن في بعض الأحيان - أمكنهم البقاء على قيد الحياة، وإلاّ لكان أكثرهم قضى جوعاً طوال سنوات الحصار، كما رغب طغاة قريش وجبابرة الكفر.
شقُّ صحيفة المقاطعة
وظلَّ هذا الوضع على حاله، إلى أن قاربتْ سنواتٌ ثلاث على الانتهاء، كانت كافيةً لأن يعاودَ البعضُ من قريش التفكيرَ ومحاسبةَ النفس على المشاركة في القطيعة، لاسيما أن بين المحاصرين مَن هم أقارب وأصهار وأبناء خال ومن ذوي الرحم من بني هاشم والمطلب وغيرهم... ووصلت مثل تلك المحاسبة إلى الشعور بالذنب، الذي يدفع باتجاه نقض الصحيفة التي كانت لا تزال، حتى هذا الوقت، معلَّقة في جوف الكعبة، من دون أن يجرؤ أحد على المساس بها..
وكان أوَّلَ من سعى لنقض الصحيفة هشام بن عمرو بن ربيعة نفسه. فقد رأى أنه طوال مدة الحصار، وعلى الرغم من إصرار قريش على الإمعان والغلوّ في التشدُّد والتعنُّت، فإن المقاطعة لم تُجدها بأيّ نفع، أو تَعُدْ عليها بأية فائدة، اللهم إلاَّ التشفي من «محمد» والمسلمين، والاستعلاء على بني هاشم وبني المطلب، الذين صمَّموا على البقاء بجانب سليل بني هاشم حتى النهاية.. فتساءل حينئذٍ: «ولِمَ البقاء على تلك المقاطعة؟».
وراح هشام يسعى في أمر النقض، فذهب إلى زهير بن أمية بن المغيرة المخزومي - الذي عُرف بغيرته على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، واحترامه ومحبته له، لاسيما أنه ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب - يحدثه في هذا الأمر الذي هو أوْلى الناس بالقبول به، والعمل على تحقيقه، قائلاً:
- يا زهيرُ! أرضيت أن تأكل الطعام، وتلبس الثياب، وتنعم بمباهج الحياة، وأخوالُك حيث علمتَ في الشعاب يكاد الجوع يقتلهم؟!. أما إني لأحلفُ بالله، لو كانوا أخوال عمرو بن هشام - أبي جهل - ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم، ما أجابَك إليه أبداً...
وتفكر زهير قليلاً، ثم قال لهشام:
- ويحك يا ابن العم، فماذا تراني أصنع وما أنا إلا رجل واحد.. والله لو كان معي رجلٌ آخر لَقُمت إلى تلك الصحيفة أنقضها..
قال هشام: قد وجدتُ رجلاً..
قال زهير: ومَنْ يكون؟
قال هشام: أنا..
قال زهير: ابْغِنا ثالثاً..
قال هشام: سوف أجده، فانتظرني..
وذهب هشام إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وكان أيضاً صديقاً حميماً له، يعرض عليه الأمر بقوله:
- أرَضيت أن يهلك بطْنان من بني عدي وأنت شاهد على ذلك وموافق؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذا، لتجدونهم إليها منكم سراعاً..
وتساءل المطعم عما عساه يفعل؟! فأخبره هشام بأنه توافق مع رجل آخر على النقض، وأنه ما جاء إليه إلاَّ لأنه يتوسم فيه خيراً.. فقال المطعم:
- وثلاثة نفر لا يكفون.. نريد رابعاً.
فقال له هشام: انتظرني، وسوف أوافيك به..
ثم اتَّخذ طريقه إلى دار أبي البختري بن هشام، يعرض عليه ويزين له فضل من يقوم بهذا العمل في العرب، وهو يقول له:
- فإن قُمتَ لها فأنا عونُك، ومعنا زهير بن أمية، والمطعم بن عديّ..
قال أبو البختري: لو تكون معنا عصبةٌ أخرى..
قال هشام: ذلك لن يكون.. ولكن سأجد رجالاً آخرين إن استطعت...
وراح هشام يبحثُ بين القوم، فما وجد أقربَ إليه من زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، فجاءه وكلَّمه، فوجد عندهُ قبولاً واستعداداً، ولكنَّه أبى إلاَّ أن يَعلمَ مَنْ هم الآخرون، فسمّاهم هشام له. ثم تركه، ليفتِّش من جديد على من يعينه في مسعاه، فوجَدَ أن ليس أحد يملك عزماً أو شجاعة، مثل هؤلاء القلة الذين لولا الرحم، وصلة القربى ببني هاشم وبني المطلب لما أقدموا على هذه الخطوة، لأنهم كانوا - في الأصل - ممن يعادون المسلمين أشدَّ العداوة. فعادَ إليهم واحداً واحداً، يدعوهم للحاق به إلى أعلى مكة، حيث اجتمعوا في خطْم الحجون، وتعاهدوا على نقض الصحيفة، على أن يكون زهير بن أمية هو أول من يبدأ بالجهر فيما اعتزموه...
وأقبل الصباح، فغدا أولئك النفر إلى الكعبة، فطافوا مع بعضهم سبعاً، ثم وقف زهير بين الناس، يعلن الأمر الذي اتفقوا عليه قائلاً:
- يا أهل مكة!. اسمعوا وعُوا.. أما إنَّا لنأكلُ الطعام، ونلبسُ الثياب، وننعم بأسباب الدنيا وأطايبها.. وهنالك في الفلاة، بلا مأوى ولا طعام أو شراب، وبلا فراش وغطاء، بنو هاشم وبنو المطلب، هلكى.. لا يُباعُ، ولا يُبتاعُ منهم؟! أرَضيتم أن يكون أهل لكم في هذا المأزق الكَرِب، وأنتم عنهم غافلون، غير عابئين، ولا مهتمِّين؟! أتراكم قد نسيتم بأنَّ هاشماً كان يطعم الناس في سنوات الجدب والجفاف، ويحمي أهلَكم من الجوع والهلاك؟! حتى إذا قام أحدٌ من سليلته يدعو إلى ما يدعو، تضافرتم جميعكم عليه، وعلى ذويه ومريديه، تذيقونهم مرّ العذاب، وسوء الهوان في مقاطعة أردتموها قاتلة؟!. لا والله، لا أقعد حتى تُشَقَّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة!!
وعلا اللغط بين الناس، ودبَّ الشِّقاق.. وكان أبو جهل يراقب ما يجري بحذر، فلما وجد أنَّ الأمر بدأ يرتدي طابع الجدِّيَّة في الشقاق، صرخ في وجه زهير:
- خسئت وكذبتَ يا هذا، والله لا تُشَقُّ الصحيفة!..
وانبرى من بين الجموع زمعة بن الأسود يرد على أبي جهل:
- بل أنت الكاذب يا ابن هشام! والله ما رضينا كتابتَها حين أردتم ذلك..
وعلا صوت أبي البختري وهو يقول بدوره: لقد صدق زمعة، فنحن لا نرضى بما كُتِبَ في تلك الصحيفة، ولا نقرّ شيئاً قد فرضوه علينا قوةً وإكراهاً..
وقال المطعم: إن رفيقيَّ ما قالا إلاَّ حقاً.. وكذب من ادّعى غير ذلك.. وها أنا أبرأ إليك الَّلهُمَّ من تلك الصحيفة، وما كُتب فيها..
لقد تضافر أولئك الرجال على أبي جهل يسفِّهون رأيه، فحاول أن يشقَّ وحدة أرائهم التي طلعوا بها، ولكنه لم يُفلِح، إذ رأى جميع الناس عند الكعبة قد بُهتوا، وظلوا في أماكنهم صامتين، لا يدرون ماذا يقولون، فقال في نفسه:
«هذا أمر قد قُضِيَ بليل، وتشاوروا فيه بغير هذا المكان»...
وفي هذه الأثناء بالذات، كان قد وصل أبو طالب وبرفقته أخوه حمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب، وبعض شبان المسلمين. فبادر أبو طالب يسأل:
- أما تُخبرون يا قوم ما أنتم عليه مجتمعون؟
قال زهير: لم نعُد نرضى بصحيفةٍ ما كُتبت إلاَّ في غفلةٍ منا وطيش..
قال أبو طالب: يا سبحان الله، والله ما قدمتُ من الشعب إلاَّ وأنا أحمل خبرَ تلك الصحيفة إلى قريش، وسوف ترونَ من شأنها عجباً!..
قال أبو جهل: قل، فما خبرك يا شيخَ بني هاشم؟
قال أبو طالب: أرى أن يجتمع زعماء قريش كلهم هنا بجوار الكعبة حتى أبلِّغَهم بما بعثني به ابن أخي محمد بن عبد الله بأمر هذه الصحيفة..
وذاع الخبرُ في أرجاء مكة كلها، بأن أبا طالب قد نزل لأمرٍ هام، وهو يدعو للاجتماع به عند الكعبة.. فظنَّ البعض من قريش أن شيخ القبيلة قد جاء يحمل إليهم خبر الاستسلام والرضوخ لرأيهم، بينما أوجس آخرون خيفةً من مجيئه، لأنهم يعلمون مقدار صلابته، وتمسُّكِه برأيه وموقفه.. ومن أجل ذلك تعجّلوا جميعُهم يتدافعون نحو المسجد الحرام، وفي نفس كل منهم شتَّى الظنون. حتى إذا اجتمع الملأ من قريش، قامَ فيهم أبو طالب خطيباً، فقال:
- يا معشر قريش، لقد نزل جبرائيل الأمين على ابن أخي «محمد» وأعلمه بأمر الله تعالى في صحيفتكم.. وها إنّي قد جئتكم مع هؤلاء الفتيان لننظرَ فيما آلت إليه هذه الصحيفة، كما أخبرنا به النبي محمد، حتى إذا وصلنا وجدنا من رجالكم شجعاناً قد سبقونا إلى ما جئنا لأجله فبورك الرجال، وبورك سعيُهم في رفع الظلم عنّا، نحن الذين ما عَهِدْتمونا إلاَّ أنصاراً للمظلوم على الظالم، وأعواناً للحق على الباطل.. وإنها لجرأة اجترحها هؤلاء الفتية لعلَّها تردعكم، فترعوون عن باطلكم، وتعودون عن ضلالكم.. وأما ما جئناكم به نحن فهو خبر تلك الصحيفة التي جعلتموها سبباً للقطيعة، وأرادَها الله تعالى برهاناً آخر لصدق «محمد»، والتصديق بما يقول..
فقالوا: هاتِ ما عندك يا أبا طالب!.
فقال لهم:
- إن رسول الله «محمداً» يبلغكم بأنَّ الله ربَّه - تبارك وتعالى - قد أرسل على صحيفتكم الأرَضةَ «فأكلَتْ جميع ما فيها من جور وقطيعة رَحِمٍ وظلم إلاَّ اسمَ الله وحده. فإن كان كاذباً خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقاً رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا»[*] فماذا ترون في هذا يا معشر قريش؟..
لقد كانوا يتوقعون طلبَ الاستسلام، فإذا الأمر بخلاف ما يظنون.. ولكن ماذا عليهم لو فتحوا الصحيفة، والنتيجة مضمونة لصالحهم؟!.. إذ لا يمكن لأرضة أن تأكل كل ما في الصحيفة، ولا تترك إلا جزءاً يسيراً من رأسها، وهو الجزء الذي كُتِبَ عليه عبارة «باسمك اللهمَّ» التي كانوا يستهلّون بها مواثيقهم الهامَّة.. - إلاَّ أن تكون هذه الحشرة - التي لا تكاد تبين - تعقل، وتعبد الله، وتريد أن تنصر «محمداً» عليهم.. فيا للسخرية مما يتوهم أبو طالب وابن أخيه!.. إذن فلِمَ لا يرتضون فتْح الصحيفة وسرعان ما تنجلي الأمور؟..
وبمثل هذه الظنون وافقوا على تفحّص الصحيفة، فقالوا:
- قد أنصفت يا أبا طالب..
فدخل أحدهم إلى جوف الكعبة، وعلى مرأى من جميع الحاضرين وقف يشق اللفافة التي كانت تغلِّف الصحيفة.. ولكم كانت دهشة المشركين شديدة، حين وجدوها قد أُكِلَتْ برُمَّتها، إلاَّ فاتحتها بعبارة «باسمك اللهُمَّ».. فتناول أبو طالب هذا القسمَ اليسيرَ الباقيَ من الصحيفة، وراح يدور به على المجتمعين فرداً فرداً، ليروا بأم العين، صدق ما قاله لهم، وما بعثه به ابنُ أخيه رسول الله؛ ثمَّ وقف بعدها قِبالةَ أولئك الطغاة القساة، يعنِّفهم بقوله الراجح:
- أرأيتم يا معشر قريش كيف أن الله تعالى يُظهر أمْرَه، ويصدِّق نبيَّهُ بأصغر مخلوقاته؟ فها هي الأرضة تُنبىء بالحق المبين، وأنتم أصحاب الحجى والعقول ما زلتم في غيِّكم تعمهون. ألا وإنكم أوْلى بالظلم والقطيعة منا... والله ما كنا لنُقدم يوماً على مثل ما أقدمتم عليه، ولا أن نستسيغ هوانَكم بمثل ما رضيتم هواننا..
ونكَّسَ المشركون رؤوسهم، وهم يرون آيةً عظيمةً من آيات نبوّة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولكنهم كما أخبر الله - تعالى - عنهم: {وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ *} [القَمَر: 2] ، ولذلك كانت الصدمةُ للحظات فقط، ثم أفاق أحدهم - ممن لم يقدروا على لعق الحسرة التي أصابتهم - ليقول:
- إنما يأتوننا بالسحر والبهتان!..
فقال له أبو طالب:
- ويحك أيها المجدّف الكاذب! أتجرؤ على إنكار الحقيقة، وهذه آثار أسنان الأرضةِ[*] باديةٌ في ما تبقّى من الصحيفة؟ لقد خسئتَ في ادِّعائك الضالِّ، فاصْمُتْ ولا تعدْ إلى مثل هذا الإِفك، وإلاَّ قطعتُ أنفاسك بسيفي هذا.
وعلا الوجوم، وشاهت الوجوه من قريش..
... فقد توافقوا منذ لحظات على أن تكون الصحيفة هي البرهان الحسي، الذي يحسم كل جدل ويقطعه. والآن وقد حصحص الحق، وظهر ساطعاً مثل نور الشمس، فهل يمكن المضيُّ في المقاطعة؟!.. لم يعد ذلك ممكناً، وقد انتصرت عليهم الأرضة - من أضعف الحشرات خلْقاً - فتفرقوا يلوذون بجدران بيوتهم من خزي الذل والهوان، بينما راح الذين سَعَوا في نقض الصحيفة ينشرون خبر الأرضة في أنحاء مكة تشبثاً برأيهم، وحفاظاً على كرامتهم!..
أما أبو طالب فقد أوفد فتيان المسلمين، يُغِذّون[*] السير إلى الشِّعاب، ليزفُّوا إلى أهليهم خبرَ نقْض الصحيفة، وزوال الشدَّة عنهم بالعودة إلى ديارهم، مرفوعي الرؤوس.. أما هو فقد جلس يستند إلى ركن الكعبة، وفي قلبه شوق إلى هذا الجوار الطيب، الذي لم يستطع معه أن يمنع نفسه من التأثُّر، فجاشت قريحته ليقول في نقض الصحيفة قصيدةً طويلة، منها هذه الأبيات:
وقد كان في أمرِ الصحيفةِ عِبرَةٌ
مَتَى ما يُخَبَّرْ غائبُ القومِ يَعجَبِ
محا الله منها كُفرَهُمْ وعُقوقَهُمْ
وما نَقَمُوا مِنْ ناطقِ الحقِّ مُعربِ
فأصبَحَ ما قالُوا مِنَ الأمرِ باطلاً
ومَنْ يَخْتَلِقْ ما ليسَ بالحقِّ يكذِبِ
وانتهت المقاطعة، وعادت بيوت العز والكرم في مكة تفتح أبوابها على مصاريعها، فأتى أصحاب الأمس نادمين، آسفين، يبدون الأعذار لأسيادهم من بني هاشم وبني المطَّلب، إلا رؤوسَ الشرك فقد ازدادوا كفراً على كُفرهم وما نقموا من أهل الحقّ إلاَّ أنهم يحمون محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ويمنعونه.
وعاد المسلمون لمتابعة الدعوة بعزيمة أمضى، وبثبات أشدّ من ذي قبل. وكان لهم أن يُعذروا لو استكانوا فترة من الزمن، يستروحون فيها بعض الراحة لشدة ما عانوا خلال تلك السنوات الثلاث المتواصلة، أو لو تفرّغوا بعض الوقت في طلب الرزق للتعويض مما فاتهم.. ولكنهم دعاةٌ، ومسؤولون أمام الله - تعالى - وهم يتحمَّلون هذه المسؤولية، ويمشون على النهج الذي رسمه القرآن الكريم للرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ولهم، وذلك في قوله تعالى له:
{فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ *} [الزّخرُف: 43-44].
ولذلك فلا الراحة ولا الرزق، ولا مطالب الحياة الدنيا بأسرها، توازي عندهم كلمةً تقال لله، وفي سبيل الله - عزَّ وجلَّ ـ.
فما أسمى هذه الدعوة التي بها يحيون. وما أرفع هذا اللقب الذي به يشرفون؛ أما الدعوة فهي عقيدة الإسلام، وأما اللقب فهم أصحاب رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، والدعاة إلى الله - عزَّ وجلَّ - يحملون مشعلَ الإسلام الذي فيه الخلاص من موبقات الدنيا ومفاسدها، فهل يركنون إلى راحة، ولو كانوا متعبين، ونداء الحق ما زال مُلحّاً: أن هَلمّوا يا أهلَ الإيمان إلى العمل؟.
أبداً، لم يكن ممكناً أن يرتضوا مهادنةً لأنفسهم، والكفار من حولهم لا يزالون على عنادهم مكابرين، وفي النيل منهم ممعنين؟! إنهم مسلمون لله - جلَّت عظمته - وكفاهم بذلك عزَّةً وكرامةً: عزَّةً في النفوس تقوِّي هممهم وعزائمهم، وكرامةً في الحياة تزيد صلابتهم ومثابرتهم..
وكان في عودة المسلمين إلى سابق عهدهم، بعد ذلك الحصار اللئيم في الشعاب، ما ألَّف القلوب إليهم، وقرَّب دعوتَهم إلى النفوس أكثرَ من ذي قبل - وهذا من ثمرات المقاطعة كما قلنا - فازداد تفتُّحُ الأذهان على الإِسلام، وكثر عدد المسلمين، فاتّسع نطاق الدعوة حركةً، وعملاً، وأسلوباً، وطريقةً..
ولكن، وبمقدار ما كان لهذا النطاق أن يتسع ويمتدّ، بقدر ما كان الاصطدام مع قريش يحتدم ويشتد.. وقد اتخذ هذه المرة شكلاً جديداً من قِبَلِ المسلمين، الذين رأوا أن يجعلوه صراعاً حول الأفكار والمفاهيم التي جاء بها الإسلام، والتي من شأنها أن تنقُض كلَّ أفكار الوثنية ومعتقدات الشِّرك، وما ذلك إلاَّ لأن الدعوة الإِسلامية، تحمل بنفسها أسسَ الصراع الفكري والنفسي حول العقيدة الدينية قبل كل شيء، لتنطلق من ثَمَّ إلى معالجة شؤون الحياة والناس بروح إيجابية بناءةٍ، وفق الأحكام والسنن والمعايير التي تحملها آيات القرآن المبين.. ولذلك فإنها تقوم - كما صار معروفاً - على الدعوة إلى وحدانية الله وعبادته وحده لا شريك له، في حين أن عقيدة قريش تقوم على عبادة الأوثان والأصنام، وتتخذها زُلفى تقرِّبها إلى الله.. كما أن الدعوة تأخذ بزمام سفينة المجتمع لكي ترسوَ بها على قواعد حياتية جديدة، تعمل على اقتلاع النظام الفاسد القائم في المجتمع المكي، وهذا - ولا شك - يتناقض مع وجود قريش، ومكانتها الاجتماعية..
وكان عونَ المسلمين الأكبرَ في هذا الصراع المحتدم، القرآنُ الكريم، فهو يبيِّن - بصورة جليَّة - التعارضَ القائم، فَيُنْحي على الكفار باللائمة، ويَنعتهم بوضوح - بأنهم وما يؤمنون به من أفكار، وما يدينون به من معتقدات، أكوامٌ من الهشيم الذي مصيره إلى الزوال في نار الجحيم المحرقة، وذلك بقوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبيَاء: 98].
ثم يَشُنُّ عليهم هجوماً عاتياً في أنماط عيشهم، وما اعتادوا عليه من ربا، وفواحش، وعادات اجتماعية بالية، كي يجتثَّها من الجذور، ويقتلعَها من الأعماق، وذلك بقول الحق تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الرُّوم: 39]. ثم يبيِّن لهم خسران الذين يطفِّفون الكيل والميزان، ويتوعدهم بقوله العزيز: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ *الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ *وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ *} [المطفّفِين: 1-3] ذلك أنه كان من عاداتهم السيّئة عدمُ أداء الحقوق لأصحابها في معاملات البيع والشراء، سواء بين بائعي الجملة وزبائنهم، أو بين بائعي المفرَّق والمستهلكين، وهؤلاء الأخيرون هم غالبية الناس الذين تهمُّهم المبادلة الصحيحة في سوق العرض والطلب.. فكان أكثر الحيف يقع عليهم، لأن الباعة يستوفون حقوقَهم كاملة منهم، ولكنهم يبيعونهم مطففين، أي يسرقون بعضاً من حقوقهم خلسةً، من دون أن يشعر المستهلكون بما يُسرق منهم. وهو الشأن نفسُه اليوم مع غالبية الباعة والتجار الذين يعتبرون أن سرقة المستهلك، أو إنقاصَ حقه نوع من الحذلقة والمهارة يزيد في أرباحهم، من دون أن يدروا بأن هذه السرقة، التي يتوهمون أنها صغيرة، سوف تكون جمرةً من نار يُؤمرون بإمساكها بأيديهم فتحرقها، وتُكْوَى بها جُلُودُهم فتشويها، لتعيدهم بالتذكُّر إلى ما كانوا يفعلونه في الحياة الدنيا.. فجاء القرآن الكريم يضرب مثل تلك العلاقات الاقتصادية الفاسدة التي لا تصل فيها الحقوق كاملة إلى أصحابها بقوله تعالى: {وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعرَاف: 85]، تماماً كما جاء يفعل بالمعتقدات الوهمية البالية، بقوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبيَاء: 98]، وكما يفعل أيضاً بالعلاقات الاجتماعية القائمة على الاعتداد بالشرف والكرامة، بصورة خاطئة، كانت تدفعهم إلى قتل بناتهم ظلماً وعدواناً - وهنَّ في المهد - لم يرتكبنَ ذَنْباً أو يقترفنَ إثماً، فيسألهم باللغة التي يفهمون: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ *بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ *} [التّكوير: 8-9].
فهذه الآيات الكريمة وغيرها كانت تهدّم البنيان الذي تقوم عليه العلاقات في المجتمع المكِّي، وقد اعتمدها المسلمون سلاحاً يمدُّهم به القرآن الكريم، ليكون نهجُهم، في صراعهم الفكري، قائماً على الصراحة والوضوح. وهو النهج الذي اعتمده الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) منذ بادَأَ قريشاً بدعوته، يوم كان فرداً وحيداً، أعزلَ لا نصيرَ له ولا معين، ولا يملك عُدَّةً ولا سلاحاً، إلاَّ سلاحَ الإِيمان، ونصرة الله تعالى. بل ظهر هذا النهج في دعوته متحدياً، لا يتطرق إليه ضعف، ولا يعوقه عن احتمال التكليف الجسيم عائق. واستمرَّ في كفاحه على مثل هذا النهج من الدعوة، وهذا النمط من الكفاح، منذ أن عادَ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من الشِّعاب هو والصحابة من ورائه، مما جعل بعض الناس يُقبلون عليه، بعدما أخذ نورُ الإسلام يشعُّ وئيداً[*] بين قبائل العرب البعيدة عن مكة. وهكذا كان الرسول الأعظم يُعدُّ كلَّ السبلِ الفكرية للاتصال بالناس، ويهيّىء الدعاة الصالحين، والأرضية السويّة لانطلاق الإسلام من مرحلة التلقي والتعليم إلى مرحلة التصادم الفكري للتغيير المجتمعي..
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢