نبذة عن حياة الكاتب
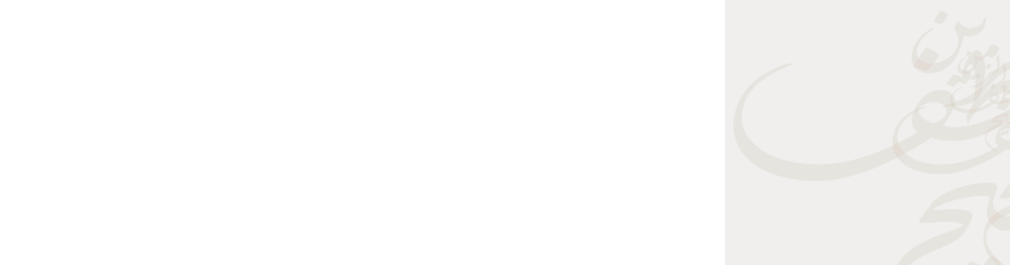
X
خَاتَمُ النَّبييِّن مُحَمَّد (ص) - الجزء الأول
البحث الثالث: عُروض قُريش وطلب المعجزات
عرض قريش المالَ والمُلْك على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)
وبمثل تلك الأوهام والظنون حزمت قريش أمرَها وعزمت على مقابلة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ومفاوضته على مقدار المال الذي يريده، وعلى المناصب التي يرغب في تقلُّدها.. ولكنْ من يذهب إليه من طغمة قريش التي تجتمع وتفكّر، وتدبِّر على هواها، وكيفما يحلو لها؟ إن أحداً من تلك الطغمة لا يجرؤ على الوقوف في مواجهة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) - وجهاً لوجه - حتى ينقل إليه ما يريدون. فقد كانوا يدركون ما للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من هيبة ووقار، وما يمتلك من سطوة عليهم بفعل نزاهة حياته، وخلقه العظيم، فإن جاءه أحد يفاتحه في الأمر فقد يردُّه خاسراً خاسئاً، فتفسد الخطة التي دبّروها، وتبقى الدعوة الإسلامية على حالها. وهكذا وبسبب الجبن الذي يسيطر عادة على ذوي المطالب الدنيئة، لم يجرؤ أحد من زعماء قريش أن يرضى بالذهاب إلى محمد بن عبد الله، فظلَّت اجتماعاتهم تتوالى، وعنوانها التصايح والتشاتم، لولا أن النضرَ بن الحارث أدرك هذا الوضع، واقترح أن يكون عتبة بن ربيعة سفيرهم إلى «محمد» لما له من حكمة ورأي لا يدانيه فيهما أحد من الحضور.. وارتفعت الأصوات في الاجتماع الذي كانوا يعقدونه مؤيدة النضر، مما فرض على عتبة أن ينزل عند رغبتهم، ويتحمَّل مشقة السفارة لمفاوضة «محمد» على الأمر الذي اعتزموه.
ودخل عتبة بن ربيعة على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) متردداً، ثم جلس والارتباك بادٍ عليه، إلى أن تجرَّأ أخيراً، وأفصح عما جاء لأجله، وهو يقول: «يا ابن أخي، إنك منّا حيث قد علمتَ من الشرف في العشيرة، والمكان في النسب. وإنك قد أتيتَ قومَك بأمرٍ عظيم فرَّقت به جماعتهم، وسفّهت به أحلامهم، وعِبت به آلهتهم ودينَهم، وكفّرت به مَن مضى مِن آبائهم، فاسمع منّي أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها»[*].
فقال الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «قل يا أبا الوليد، أسمع».
قال عتبة: «يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت من هذا الأمر مالاً، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سوَّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك. وإن كنت تُريدُ به مُلكاً ملَّكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيكَ رِئْياً[*] تراه ولا تستطيع ردَّه عن نفسك، طلبنا لك الطبَّ وبذلنا فيه أموالنا حتى نبْرئك منه».
ومرَّت لحظات حاسمة كان يتوقف عليها ليس مصير السفارة بين قريش والنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وحسب، بل ومصير الحق والباطل إلى أبد الدهور.. فلئن كانت العروض التي تريد قريش أن تُغدقها عليه كبيرة جداً - وقد لا يأنف إنسانٌ من قبولها - إلاَّ أن محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وهو مبعوث الحق قد رفضها بكل أناة وتؤدة، ودونما أية مجاملة أو تفكير، فما قاله كان القول الفصل، وهو لا يختار على الدعوة الإسلامية شيئاً. فما محمد إلاَّ رسول قد خلت من قبله الرسُل، وهو أمين على الرسالة التي يحمل، وكفؤ لها، وهو لن يدع أمرَها حتى يقضيَ الله - تعالى - أمراً كان مفعولاً.. ولذلك نجده مشفقاً على بني قومه من ظلم الشرك الذي يُغرقون به أنفسهم، فلا يخاطب عتبة إلا بالقول الحق، وهو يتلو عليه قول الله تعالى من سورة السجدة:
{الم *تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ *أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ *اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ *يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ *ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ *ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ *ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ *وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ *قُلْ يَتَوفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ *وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ *وَلَوْ شِئْنَا لآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَِمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ *} [السَّجدَة: 1-15].
وما إن انتهى رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من هذه التلاوة المباركة حتى خرَّ ساجداً على يديه وركبتيه، وهو يُثني على الله تعالى ويحمده. ثم قام من سجوده يسبّح بحمد ربه - عز وجلّ - ويشكره على أنعمه وفضائله على عباده، وهو في ذلك كلِّه يتناسق في القول والفعل مع القرآن، ومع فضلِ ربه (تبارك وتعالى)، الذي يعيش في ذاته، وفي كل جارحةٍ من جوارحه، فيحيا بذكر الله تعالى حامداً، شاكراً، عزيزاً، كريماً..
وكان عتبة بن ربيعة يستمع ويصغي، فيَعي.. حتى إذا أنصت إلى قوله تعالى: {وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *} [السَّجدَة: 14] إذا بالقشعريرة تتملكه، والرعدة تأخذ بمجامع كيانه، فيهتزُّ من الخوف والرهبة مثل الطائر المبلَّل.. ولم ينتشله من تلك الحالة التي سيطرت عليه إلاَّ تهدئة الرسول له، ليعود ويسأله عمَّا إذا كانتِ التلاوة واضحة المعاني والدلائل. فأومأ بالإيجاب، من دون أن ينبس ببنت شفة!... عندها تركه رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لنفسه كي يقرر ويختار بين الباطل الذي جاء يعرضه، وبين الحق الذي انتصب يقابله، وهو الحق من ربه الذي سوّاه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، هو ومن أوفدوه إليه، فلعلّهم يميّزون هذه العطايا العظيمة من خالقهم، فيعودون إلى أنفسهم ويقررون على ضوئها الموقفَ الصواب.
وأُرتجَ[*] على عتبة، فآثر البقاء على صمته، لأنه عاجز عما يجيب، وهو يشعر في قرارة نفسه بتفاهة ما جاء يعرض على «محمد» إزاء ما أسمعَهُ، وأبانَهُ له، ووعظَهُ به.
واستعجل عتبةُ خطاه وهو لا يدري ممّ يهرب: هل من هذا النبيِّ الذي لم يأتِ لا من قريبٍ ولا من بعيد على ذكر المال أو المُلك أو الجاه وتلك العروض السخيفة التي جاء بها إليه؟! أم أنه يهرب من الحق الذي جابهه به فأخرسه؟!. أم أنه يهرب من نفسه الأَمّارة بالسوء، التي أوكله إليها «محمد» فانتصبت تصدّهُ عن الحق، وتجعله - على الرغم من الخوف الذي اعتراها - لا يتناول يَدَيِ الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ويعلن إسلامه؟!.
إنه لا يدري فعلاً، ولكنه يستحث الخطى إلى جماعته التي تنتظره على أحرّ من الجمر، فقد يكون في وصوله إليهم ما يُزيح عن صدره هذا الهلعَ، الذي يكادُ يُرديه، ويذهب به إلى الموت.
وما إن دخل عليهم، وهو على تلك الحالة، حتى قالوا لبعضهم بعضاً: لقد عاد أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به... أما هو فقد ارتمى في مقعده خائر القوى، مشيراً ألاَّ يستعجلوه، لكي يتمكن من التقاط أنفاسه، قبل أن يخبرهم بما جرى معه... وإنْ هي إلاَّ لحظات، وهدأ الرجل، فانبرى يقول لهم:
- يا معشر قريش! لقد حمَّلتموني فوق ما أطيق. أما والله لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قطُّ.. يا معشر قريش! أطيعوني، واجعلوها لي.
وظنَّ الملأُ أن عتبة قد خرج على إجماعهم، فراحوا يرشقونه بنظرات حائرة، إلاَّ أنه قطع عليهم كل الظنون، بما قد تتهمه به عيونهم وهو يقول لهم:
- يا معشر قريش! خلوا بين هذا الرجل، وما هو فيه، واعتزلوه. فوالله ليكونَنَّ لقوله الذي سمعت نبأٌ عظيم. فإنْ تُصبْهُ العربُ فقد كُفِيتُموهُ بغيركم، وإنْ يظهرْ على العرب فملكُهُ مُلكُكُمْ، وعزُّهُ عزُّكُم، وكنتم أسعدَ الناس به.
لقد أراد عتبة بن ربيعة أن يكون نَصوحاً، إلاَّ أنهم جفلوا مما يقول، ورأوا فيه نوعاً من الهذيان استبدَّ به، فقالوا له:
- لقد سحرك يا أبا الوليد بلسانه!..
ولم يكن أمام عتبة إلاَّ أن يقول:
- والله ما هو بالسحر ولا بالكهانة. ولكنه رأيٌ رأيتُهُ فاصنعوا ما بدا لكم.
وتفرق المشركون وقد سُقط في أيديهم[*].. فهذا عتبة بن ربيعة، أحد كبراء قريش وسادتها لم يفشل في إقناع «محمد» وحسب، بل عاد إلى أترابه يحاول إقناعهم بعدم التعرض له، لأنه سيكون له نبأ فيه عِزّهُ وعزُّهم... فما هو أمر محمد بن عبد الله؟
هذا ما كان يشغل - دائماً - بالَ جماعة الكفر، وها هو يتأكَّد لهم من جديد.. فيذهب كل واحدٍ منهم إلى بيته مهموماً، ورفيقه القلق، لينزويَ في عزلةٍ محمومة من التأفف والتذمّر مما لاقاه في يومه، ومما قد يكون عليه في غده؟!..
وما كادت تلك الليلة تنقضي حتى عاد رؤساء الكفر للاجتماع على غَيِّهم من جديد، وقد رأوا أن يكون اجتماعهم عند الكعبة، حتى يلتقي جمعُهم بمحمدٍ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فبعثوا قائلين: إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك، فائتِ إليهم..
وكان أحبَّ شيءٍ على قلب النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يجتمع بأهل مكة، وزعماء العشائرِ - بخاصة - حتى يبيّن لهم خطَلَ الرأي الذي يركبون، ويدنيهم من الحق الذي عنه يبعدون. ولذا جاء ملبياً دعوتهم وفي نفسه أمل بكسر شوكة العداوة بينه وبينهم، إلاَّ أنه وجدهم - ويا للأسف - ما يزالون على الضلال، وعلى الموقف عينِه، وهو إغراؤه بالمال والسلطان بديلاً عن النبوّة. وقد انبروا يردِّدون على مسامعه نفس الكلام الذي سمعه من عتبة بن ربيعة البارحةَ تماماً، وكأنَّ ما نقله إليهم رجُلُهم عنه، وعن قرآنه، كان أبعد ما يكون عن تفكيرهم، ومطامعهم الفارغة في هذه الحياة الدنيا..
لقد جلسوا قبالتَهُ جميعُهم، ينمّقون ألفاظهم بمعسول الكلام حيناً، وبالوعيد المبطَّن حيناً، وهم لا يدركون أنَّ كل ما يقولون حجةٌ عليهم.. فقد كانت الشكاية منه وعليه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ،.. فيا لهم من عُتاةٍ ظالمين، ماكرين، يريدون أن يخادعوا رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بإظهار المحبة له، وتسييده عليهم، وما يخدعون إلاَّ أنفسهم.. ويحاولون أن يتملَّقوه بالملك والسلطان، أو بالشفاء مما أصابَهُ، أو بالتأسف على ضياع قريش ومكانتها، حتى إذا وجدوه على صدق ثباته، وأحقية دعوته، لا يجدون مفراً من الإشارة والتلميح له بالعداوة والبغضاء!..
أجل، لقد حاولوا بشتى أساليب الدهاء والمراوغة أن يثنوا «محمداً» عن أمره، وهو (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لهم بالمرصاد، لا تفوته كلمةٌ مما يقولون، ولا نيّة مما يبيّتون.. فلما أراد الردَّ عليهم كان أول ما بادر به دفْعَ التهمة الظالمة الغاشمة التي يحاولون إلصاقها به، وهي ما يعتريه من مسٍّ - لا سمح الله - فجاء جوابه بسيطاً، هادئاً، رصيناً، إذ لم يزد على أن قال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «ما بي ما تقولون!».
كان قولُهُ ينضح بالصدق الصراح، لأنه لا ينفي عنه تهمةً باطلةً وحسب، وبل ويَجْبَهُ ادعاءهم الجائر ويصمهم بأنهم كذبةٌ، ظالمون، مخادعون، بينما هو بالمقابل الصادق الأمين الذي يعرفونه حق المعرفة..
»ما بي ما تقولون».
هي كلمة قالها رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .. ولئن كانت هي الكلمة التي تخزيهم، وترفع الحيفَ الذي يريدون إنزاله به خداعاً ونفاقاً، إلا أنها في موازين الحق، الكلمةُ التي تثبت لهم، ولكل الناس، بأن محمداً هو لنبيُّ الله ورسولُهُ، ولا يمكن لنبي أو رسول، مبعوث من رب العالمين، إلاَّ أن يكون طاهراً، مطهَّراً من جميع الأدران، ومعصوماً من جميع العوارض التي تصيب بني البشر، وتجعلهم يخطئون، وبذلك لا يمكن أن يكون لدى «محمد» مسّ من الجنون.. إذن، فهو الكفر القبيح بعينه من هؤلاء المعاندين، المستكبرين والتعدي على قدسية الرسالة التي يحملها من لدن العليم الحكيم، فويلٌ لهم مما يظنون، وويلٌ لهم مما يُبيِّتون!..
هي كلمة قالها رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) «ما بي ما تقولون»!.. وهي وإن كانت في موقعها، وعلى أحقّيتها، إلاَّ أنها أيضاً الحجة البالغة التي يلقيها عليهم، وهي أن الله تبارك وتعالى يضع رسالته حيث يشاء، وقد اختار محمداً لمَا وصل إليه من صفات الكمال، ليكون رسولهُ الأمين المبين، فكيف يتهمونه بما لا يقبل عقل أو ضمير؟! بل كيف تطاوعهم قلوبهم على مثل ذلك الاتهام - الباطل - وهو يؤكد لهم أنه في دعوته لهم للدخول في الإسلام لا يريد إلاَّ وجهَ الله تبارك وتعالى، وحرصه على هديهم إلى هذا الدين القويم. وهو ينذرهم بقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا المُلك عليكم. ولكن الله بعثني - تعالى - إليكم رسولاً، وأنزل عليَّ كتاباً، وأمرني أن أكون بشيراً ونذيراً، فبلغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردُّوه عليَّ أصبرْ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»[*].
إن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يبلِّغ عن أمر ربه.. ولكن، هل بين تلك الجماعة من قريش - التي اجتمعت على الكيد له - من يريد أن يسمعَ، أو يدرك ما يبلّغ؟ لا! بل ووصلت بهم السخافة إلى أن يسفّوا إلى حدٍّ يثير الاستغراب!.. إذ على الرغم مما قاله لهم، ظلوا على الوتيرة نفسها يريدون مبادلة عروضهم بالنبوّة، بل ويلحّون في مفاوضته على أن يقايضوا بدين الله، دينَ الوثنية والجاهلية. ألا إنهم جاهلون حقاً!..
طلب قريش المعجزات الحسيّة [*]
لقد تعامت قريش عن الحق الذي يدعوها إليه النبيُّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وأصرَّ زعماؤها المشركون على عدم ترك دينهم ودين آبائهم - ومتى يا ترى كان الكفر أو الشِّركُ - في ميزان الحق - ديناً للعباد - إلاَّ عند مَن باعوا دينهم بدنياهم؟! فها هم أولئك المفسدون، ولمَّا لم يجدوا إلاَّ خيبةَ الأمل مما راودتهم به نفوسهم الشريرة - من إغواء سيد الخلق محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وصرفه عن دعوته - فقد عمدوا إلى المكيدة التي كانوا دبروها، والمؤامرة التي أحكموا فصولها بدقة متناهية، وهي في ظنهم الضربة القاضية التي لن تدعَ أي مجال له كي يفلت من أيديهم.
وأما تلك المؤامرة الدنيئة فكانت ترمي إلى إيقاعه في العجز، وإظهاره بالثوب البشري الذي لا يقدر على شيء مما يريدون. وذلك بأن يطالبوه الإتيان بمعجزات حسية تثبت أنه نبيٌّ مرسل وإلاَّ فلا شأن له في ما يدَّعيه، وبذلك يستحق ما يمنّون به أنفسهم، ويكون سبيلاً للخلاص منه إلى الأبد، لأن الناس سوف ترى، وتسمع بعجزه، فلا يعود أحد يكترث لأمره..
وكانت خطتهم في تنفيذ المؤامرة تقوم على توزيع الأدوار فيما بينهم، بحيث يسأله من يريد أن يسأل، ويطلب منه من يريد أن يطلب، ويهدد من يرغب أن يهدده، وكلهم على اتفاق حول ما يطرحون ويعلنون.. وقام أحدهم يصرخ بأعلى صوته:
- يا محمد! لقد أفسدت كل أمر بيننا وبينك، ولم يبق أمامنا إلا أن نقتلكَ، ونخلّصَ مكة والعرب من شرِّك.
وأجاب الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) محتسباً: حسبيَ الله ونعم الوكيل..
وانبرى رجلٌ منهم يُتقنُ المكر والخداع، منتهراً ذاك الرجلَ الذي يهدّدُهُ بالقتل، ثم توجَّه إلى المجتمعين بقوله:
- لا يا قوم! إن «محمداً» منا حيث تعلمون، ولا أحد منا يُضمر له شرّاً أو عداوة أو بغضاء، ولكننا نريد أن نُحاجَّهُ في أمره، فإن أصدقنا القولَ، وأقنعنا بهذا الأمر الذي يدعو إليه، اتّبعناه، وكان لنا فيه العزة والشرف.
وكانت تلك هي المقدمة للخبث الذي بيّتوه، وبعدها راحت تلك الفئة من شياطين قريش تتبارى في طلب المعجزات، فقال قائل:
- يا محمد! ليس أحدٌ أضيقَ بلداً منا، ولن نؤمن لك إلاَّ إذا سألت ربك أن يسيّر هذه الجبال من حولنا، ويبسط لنا في أرضنا، ويُجريَ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام، ويبدل لنا هذه الصحراء القاحلة من حولنا بجنات وقصور، وكنوز من ذهب وفضة.
وأردف آخر قائلاً:
- واسأل ربك يا محمد أن يحييَ لنا مَنْ مات من آبائنا، وليكن بينهم قصيّ بن كلاب، فإنه كان شيخَ صدق. فنسألهم عما تقول: أحق هو أم باطل؟ فإن بُعثوا وصدّقوك، صدقناك نحن وعرفنا منزلتك عند الله.
ورانت فترة من الصمت، والكل يتطلعون إلى ما يجيب به «محمد»... فما كان منه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلاَّ أن أظهرَ لهم حقيقةَ ما بعثَهُ ربُّهُ تعالى به، وطلب إليهم أن يقبلوه لخيرهم، وإلاَّ فالحكْم بينه وبينهم لله تعالى، وذلك بقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «ما بهذا بعثتُ إليكم.. إنما جئتكم من الله ربي بالهدى، ودين الحق، وقد بلَّغتكم ما بعثت به، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردُّوه عليَّ أصبرْ لأمر الله تعالى حتى يحكم بيني وبينكم».
فالرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وبالأمانة التي يحمل، يصبّر نفسه على ابتلائه بهم، ويترك لله مولاه أن يحكم بينه وبينهم.
عندها صرخ أحدهم ساخراً:
- نعلم أنك لن تأتي بما طلبه منك القوم.. وإنا معشرَ قريش لواثقون من عجزك!.. ولكن لِمَ لا تسألُ ربك أن يُنزل علينا العذاب من السماء كما تزعم، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً؟.
فيا ويلهم!. ماذا يطلبون؟
إنهم يطلبون أن ينزل عليهم العذابُ من السماء قِطعاً كبيرة متراكمة، أو أن ينزل الله - عزَّ وجلَّ - من عليائه ومعه الملائكة حتى يروهم أمامهم ويشاهدوهم بالعين المجرَّدة.
أجل هذا ما يطلبون!.. نستغفر الله - عزَّ وجلَّ - ونعوذُ به من هؤلاء الأشرار، فما أجرأهم قولاً على الله ورسوله؟! أتُرى هو الجهل الذي ران على عقولهم، أم هو الضلال الذي أعمى قلوبهم، فجعلهم على تلك الرعونة من الاستكبار والصلافة؟ ألا يدرون بأن العذاب واقع بالمشركين لا محالة، ولكنَّ تقديره يعود إلى الله العزيز القادر المقتدر، فهو - سبحانه - إن يشأ يُعذبْهم في هذه الحياة الدنيا، وإن يشأ يُعذبْهم في الآخرة؟!... فالأمر كله بيد الله عز وجلَّ، وقد أهلَكَ سبحانه وتعالى غيرهم كثيراً من الأمم الغابرة أمثال قوم نوحٍ وعادٍ وثمود ومدين ولوط.. إلاَّ أن حكمة الله تعالى البالغة قد قضتْ بأن يبعثَ محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) رحمةً للعالمين بقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ *} [الأنبيَاء: 107]، والتي يبيّنها لهم رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نفسه بقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «إنما أنا رحمة مهداة»[*]، فلولا حقدهم على «محمد» لكانوا أدركوا معنى تلك الرحمة وأن وجوده بينهم هو الذي يمنع عنهم العذاب المهلك المدمر.. أجل لو أدركوا ذلك لكانوا سعَوْا إليه طائعين، معتذرين، نادمين.. ولكن المكابرة، هي التي كانت تحول بينهم وبين الاهتداء إلى الحقيقة، فوقعوا في الغي والضلال، وفي التطاول على العزة الإِلهية..
وبتلك الجاهلية الحمقاء استمرت تلك الجماعة من قريش في مباراة التعجيز التي تخوضها ضد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فقام أحدهم يقول:
لماذا لا ينزل على «محمد» مَلَكٌ يشهد بنبوّته، ونحن ههنا قاعدون؟.
أجل، وبدون دراية بالعواقب يطلبون أن ينزل على الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ملك من السماء يدعو معه ويصدقه. ولكن سنة الله تعالى قد قضت بأن الملائكة حين ينزلون إلى الأرض على قوم كذبوا برسولهم، إنما ينزلون لتحقيق أمر الله تعالى فيهم بالهلاك الساحق، فهي إذن الجهالة الجهلاء من شياطين قريش، فوق ما تحمل من الحماقة والكفر..
وكأنْ لم يكْفِهم كلُّ ذلك الذي طلبوه، وكلُّ ما أبدوه من عنتٍ وجهالةٍ، فانتصب أحدهم ممعناً في السفاهة وهو يقول:
- يا «محمد»! ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري به وتربح؟ وبالأرض التي تجدب فترحل عنها إلى أرض مخصبة؟ ولم لا يكون لك بيت من زخرف فلا تلتمس بعد ذلك المعاش مثلنا؟. أَوَ لست تقول بأنك نبيٌّ، والأنبياء يجب أن تكون لهم منزلة تمنعهم من تعاطي الأعمال كما يفعل سائر الناس؟
وبماذا كان على الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يجيب غير أنه بشر، وأنه يسعى إلى كسب معاشه ومعاش عياله بعرق جبينه، وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلاَّ ما شاء الله تعالى.. فهذه سنّة الله في خلقه، والأنبياء هم خلْق الله، تسري عليهم السنن والنواميس الإلهية بلا فرق ولا تمييز. إنهم بشرٌ ومحمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) واحد منهم. وقد شاء ربُّ العالمين أن يجتبيه ويصطفيه لحمل رسالته الأخيرة إلى الناس، فبعثه بشيراً ونذيراً لقوم يؤمنون.. فهو إذن لا يعلم ما يبسط له ربُّه من الرزق وما يقْدر، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلاَّ الله - سبحانه وتعالى - ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولما مسَّه السوء بشيء.. وهو لا يملك أن يختار عاقبة فعله بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيراً أقدم، وإن رآها سوءاً أحجم، إنما هو يعمل، والعاقبة تجيء كما قدَّر له الله - تعالى - في غيبه المكنون.. وهذا كله نقيض ما يفكّر به أو يطلبه هؤلاء القرشيون. إنهم لا يدركون أن الرسول بشرٌ مثلهم، ومثل سائر الناس، غير أنه يتلقى أمْر ربه ليبلِّغه، فيكون بشيراً ونذيراً لقوم يؤمنون، وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يخرقَ السنن التي صنعها الله تعالى، إلا ما شاء الله أن يجعله معجزةً للناس، حتى يكون في خرق السنن - أي في تلك المعجزات - ما هو في صالح الدعوة التي يحمل، والرسالة التي يبلِّغ..
وما كاد الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يبيّن حقيقة بشريَّتِهِ، وأنه يعيش كما يعيش غيره من بني البشر، إلاَّ ما اختصّ بالرسالة التي نُدب لحملها، وبُعث لأجلها، حتى اشرأبت عنق رجل آخر من المشركين، وهو يقول له:
- يا «محمد»! لقد بلغنا أنه يُعلّمك هذا الذي تقوله لنا رجل من اليمامة يقال له الرحمن، وإنا لا نؤمن بالرحمن أبداً، وقد أعذرنا إليك، وإنا والله ما نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكَك أو تهلكَنا.
إنه افتراء جديد من المشركين على الله ورسوله، إذ كيف يتهمون الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأن ما يقوله لهم إنما يعلّمه إياه رجل من اليمامة، بينما آيات القرآن البيِّنات التي يتلوها عليهم تدحض بلفظها وبلاغتها كل ادعاء مثل ادعائهم.. ثم ما هذه السفاهة وهم يعلنون أنهم يكفرون بالرحمن.. ألا يعلمون أنه سبحانه هو الرحمن الرحيم، وقد وسعت رحمتُهُ كل شيء، ولولا هذه الرحمة الربانية التي تطالهم من جملة العباد لكان الويل قد حلَّ بهم منذ زمن بعيد وذهبوا إلى جهنم وبئس المصير؟! ولذلك كان جواب الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ناصعاً نقيّاً يبيّن حقيقة الرحمن، وأنه هو ربُّه لا إله إلا هو، وربُّ السماوات والأرض وما بينهنَّ، وأنه على ربه يتوكل في كل أمر وفي كل شأن، وأن إليه مآبه، ومرجعه في النهاية، مثل كل خلق الله..
وظنَّتْ تلك الجماعة من قريش أنه أرتجّ[*] على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .. وأنَّه لم يعد قادراً على أن يجيبهم بشيء، ولذلك راح يتذرع بأنه يتوكل على ربه، ويفوض أمره إليه، وذلك في اعتقادهم ليس إلاَّ هرباً من الردّ عليهم.. وبمثل هذا الوهم الكاذب، أخذتهم العزّة بالإثم، فقال بعضهم:
- إن كان محمد يعبد الرحمن ويدعونا لعبادته، فإن الملائكة بناتُ الله وهم أحقُّ بالعبادة، ولو شاء الرحمن ما عبدناهم..
وإن مثل هذا الضلال الذي ركب عقولهم فساروا عليه لا يحيدون عنه، يبيّنه القرآن الكريم بقول الله تعالى:
{وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ *وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ *أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ *بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ *وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ *قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ *} [الزّخرُف: 19-24].
ولم يكتف شياطين قريش بكل ذلك بل إنَّ من المعجزات والخوارق التي ألحوا عليها: أن يرقى في السماء!.. ولن يؤمنوا لرقيّه حتى يأتي بكتابٍ يقرأونه!.. ويبيّن القرآن الكريم هذا الطلب المعجز كما يبيّن موقف الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) منه، ومن كل ما طلبوه، وذلك بقوله تعالى: {أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِّيِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً *} [الإسرَاء: 93].
بل ويؤكد ربّ العزة والجلال أنه لو نزّل على رسوله كتاباً في قرطاس[*] ولمسوه بأيديهم لقالوا: هذا سحر مبين، كما ورد في التنزيل الحكيم قوله تعالى: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ *} [الأنعَام: 7]. فتصوّر ما يُبطنه أولئك الكفَرة الفجَرة، وكيف يكيدون للرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فهم يطلبون أن ينزِّل عليهم كتاباً مكتوباً على رقٍّ، ويكون فيه تصديقه على أنه نبيٌّ.. ولكن ولو نزَّل الله (تعالى) عليهم كتاباً فلمسوه بأيديهم (والملامسة فيها تأكيد وإثبات للشيء، وأبلغ من المعاينة والمشاهدة، وأنفى للشك) لما صدَّقوا، ولقالوا: إنَّ ما نلمس بأيدينا ونقرأ بأعيننا هو سحر {إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ *} [المَائدة: 110].
هكذا كانت حلبة الصراع التي أرادت قريش أن تصرفَ فيها «محمداً» (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن دعوته!.. ولكنها في الحقيقة كانت مواجهة بين الرسول الذي آمن بالله وملائكته وكتُبه ورسله، وبين الكفار والمشركين الذين لا يؤمنون إلا بالأصنام والأوثان. فقد أرادوا أن يعجزوا رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) حتى ينفوا عنه النبوّة والرسالة، ويتخلّصوا منه ومن دعوته، فاستعملوا كل أسلحة التعجيز وطلبوا الخوارق، إلاَّ أنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تصدّى لهم بالآيات القرآنية التي كان يتلوها عليهم فتصفع وجوههم، وتخرس ألسنتهم.. ولكن من غير أن يرعووا، أو يهتدوا إلى الحق المبين..
ولقد بدا واضحاً للرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، منذ الوهلة الأولى، أنه ما مِنْ أحد في تلك الجماعة يَنُمُّ قوله أو طلبه عن عقل أو رشد، أو عن فائدة تُرجى منهم، ولذلك قرر بعد جدال ونقاش طويلين أن يتركهم، وينصرف عنهم إلى حيث يدعوه الواجب المقدس في متابعة أمر الدعوة. لعلَّ الله تعالى يهدي على يديه من هو أحق بالهداية من أولئك القوم المشركين.. ولكنه ما إن قام يهمُّ بالذهاب حتى اعترضَهُ عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة المخزومي (وكان ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب) قائلاً له:
- أتدري يا محمد! لقد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم. ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول، ويصدقوك، ويتبعوك فلم تفعل. ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل. ثم سألوك أن تجعل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل. فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ سلّماً إلى السماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم يأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وأيمُ الله، لو فعلتَ ما ظننت أني أصدقك[*]!.
لقد كانت نيات هؤلاء القوم لا تخفى على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولكن أحدَ أبالستهم يُفصح عنها علناً، وبكل لؤم واستكبار. فما كانوا يطلبون المعجزات لكي يؤمنوا، ولكن لشيء واحد، وهو إحراج «محمد» وإظهار عجزه على الناس. وكفى بذلك الإبليس - عبد الله بن أبي أمية المخزومي - شرّاً أنه هو الذي انبرى من بين تلك الطغمة الباغية ليعلن عن نياتها الخبيثة التي كانت تبيّتها للإيقاع برسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ... فقد بدا واضحاً في كلامه أنه لو رأى الرسول بأم العين يصعد إلى السماء، ثم يأتي ومعه جمع من الملائكة يصدقونه بأمر نبوته ورسالته، فإنه لن يصدقه أبداً!.. ومثلُهُ - حتماً - كل تلك الجماعة التي سعت لإظهارِ عجزِ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ومعها من سار سيرتها، ودار في فلك شرْكها وجاهليتها... وإذا كانت تلك حال زعماء قريش المعتدين، فما على الرسول إلا البلاغ المبين.. وقد أبلغ وأنذر، وإنما هو ينذر من اتبع الذِّكر وخشي الرحمن بالغيب، وهؤلاء لا ينفع معهم ذِكر، ولا يخشون الرحمن، بل إنهم ليكفرون بالرحمن.. فقد تبين أنه كلَّما زادهم رسول الله تذكيراً، أمعنوا غلوّاً ومكابرة في طلب المعجزات والخوارق، ولو شاء الله - سبحانه وتعالى - لأتى بها، وأنزل بالمشركين من جرائها العذاب الأليم. ولكنه شاء - سبحانه وتعالى - أنْ يُمهل المعاندين لكي تتوضّح معالم الإسلام الجديد التي قوامها الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى، ولطفه بعباده، ورحمته بخلائقه، والإيمان بجميع النبيين والمرسلين الذين بُعثوا ليُخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن ثمَّ فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضلَّ فعليها.
أجل إن إيصال الإسلام إلى الناس، بمفاهيمه الجديدة هو أهمُّ وأبعدُ أثراً على مسار البشرية، من تأثيره على زمرةٍ من قريش ما تزال ترفض هذا الدين.. ولذلك كانت القناعة راسخة في نفس الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الزكية، بأنَّ تغيير زمان الكفر والشِّرك يحتاج إلى جهود مضنية، وصبر طويل على الأباطيل التي يقذفها أهل الباطل في وجه الدعاة للصلاح والفلاح.. وإذا كان كفار قريش قد حبكوا مكيدتهم في طلب المعجزات والخوارق[*]، فإنَّ الأمرَ لله تعالى، إذ إليه - سبحانه - يرجع التقدير في خرق النواميس، وإتيان المعجزات بحسب ما تقتضي حكمتُه السنيّة.. فالدعوات التي حملها الأنبياء والمرسلون فيما سبق تأيدت بالمعجزات والخوارق التي كانت تتوافق مع زمان كل نبي وأوضاع البيئة التي كان يعيش فيها، ولذلك مكّن الله العزيز الحكيم لنبيّه موسى (عليه السلام) أن يُعجز أساطين السحر الذي كان يسيطر في زمانه على العقول والنفوس، ويؤثر في الناس ومجرى حياتهم. وأذن للسيد المسيح عيسى ابن مريم (عليه السلام) أن يُحيي الموتى، ويشفي الأبرص والأكْمَهَ، بسبب ظهور الطب في أيامه ظهوراً عجيباً. كما أجاب دعوتَهُ وأنزل عليه مائدة من السماء لتثبيت الإيمان في نفوس تلامذته حتى يكون هذا الإيمان سلاحهم في حمل تعاليم الإنجيل بصدق وإخلاص.. وطمأَنَ - سبحانَه - قلب أبي الأنبياء إبراهيم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى أحقية البعث والنشور عندما أمره أن يذبح أربعةً من الطير، ويقطع أبدانها إلى أجزاء متفرقة، ثم يوزعها على الجبال من حوله، فلما فعلَ ودعاهنَّ إليه، عادت الطيور بأشكالها التامة حيّة تطير، وترفرف فوق رأس إبراهيم (عليه السلام) وبين يديه[*]. وأكَّدَ - عز وجلَّ - قدرتَهُ على إحياء الموتى، والبعث، - الذي ينكره المشركون - عندما مرَّ عزيرٌ على قرية خاويةٍ مدمَّرة - هي بيت المقدس - فقال: كيف يُحيي الله هذه بعد موتها؟ فأماته الله - تعالى - مائة عام ثم أحياه وقال له: كم لبثت؟ قال يوماً أو بعض يوم. قال: بل لبثت مائة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه (لم يتغيّر، ولم يفسد)، وانظر إلى حمارك ميتاً وعظامهُ نخرة، ثم انظر كيف نعيد تركيبها ونكسوها لحماً؟.. فلما قام الحمارُ ونهق، قال حينئذٍ عزيرٌ: أعلم أن الله على كل شيء قدير[*]..
فتلك المعجزات وما فيها من خرق للنواميس والسنن، قد جعلها الله العلي القدير لوقتها وزمانها، على الرغم من أنها كانت تحمل من المدلولات والعظات ما يبقى على الزمان. أما النبي محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقد جعل له الخبير العليم معجزة حسية في زمانه، وهي معجزة الإسراء والمعراج التي أثبتها القرآن الكريم، كما أثبت غيرها من معجزات الأنبياء والمرسلين - وقد تقدم ذكرها بإيجاز ـ. ولكن - بالإضافة إلى معجزة الإسراء والمعراج - فقد شاء رب العالمين أن يجعل للنبي محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) معجزة ثابتةً، دائمةً أبد الدهر، غير محصورةٍ بزمانه ومكانه، وغير مقصورة عليه وعلى أبناء عصره، بل تكون لكل زمان ومكان، وللناس، جميع الناس، بحيث تكون في متناول كل إنسان: يمكنه أن يلمسها بيديه، وينظر إليها بعينيه، ويقرأها بلسانه وشفتيه، ثم لتكون ذكرى وتذكِرةً لكل من ألقى السمع وهو شهيد.. وما هذه المعجزة الحسية الدائمة، إلاَّ القرآن الكريم، كتاب الله (تعالى) الذي هو في متناول أيدينا، وأيدي علماء أهل الأرض الذين يقتبسون منه العلم والمعرفة والهداية والذي هو في متناول كلِّ إنسانٍ يطلبه. نقول عن هذا القرآن إنه معجزة لأنه يتحدَّى الإنس والجنَّ جميعاً أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. وكان التحدي منذ نزل هذا القرآن على قلب محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وسيبقى قائماً إلى الأبد.
ومعجزة القرآن قد ظهرت لقريش، بل وللعرب جميعاً. وكان رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يتلو آيات هذا القرآن المبين على مسامع أهل الفصاحة والبلاغة، الذين نزل بلغتهم. وقد حاولوا بكل جهودهم أن يبدّلوا من آيات القرآن، أو يحرّفوا بعضاً من كلام الله تعالى، لكنهم وقعوا في اليأس والفشل، لأنهم قصَّروا عن ذلك وعجزوا عجزاً مطلقاً.. بل وتأكد لهم أنهم أمام المعجزة التي تقهر كيدهم، وتحبط تآمرهم، وما ذلك إلاَّ لأنها نزلت من الحق، وبالحق ومن أجل الحق.. فلما تبيّن لهم ذلك العجز ولم يستطيعوا الخوض في معارضة القرآن، ارتدّوا إلى طلب المعجزات الحسية فكان جواب محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن المعجزات الحسية التي نزلت على موسى (عليه السلام) (كالعصا وغيرها) وعلى عيسى (عليه السلام) (كإحياء الموتى وغيرها) إنما هي من عند الله، وما أنا إلا نذير مبين. وردّ اللّهُ سبحانه عليهم بقوله القاطع: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ *} [العَنكبوت: 51]. ويبقى القرآن الكريم هو المعجزة الحسيّة الدائمة التي يطّلع عليها الناس إلى يوم الدين.
بعثة قريش إلى أحبار اليهود
وظن كفار قريش أنهم قد أعجزوا النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فعلاً، لأنه لا يستطيع أن يأتيَ بشيء من المعجزات التي سألوها.. فذهبوا بعد نهارٍ طويل إلى بيوتهم ينامون قريري العين بهزيمة محمد بن عبد الله - كما غلب عليهم الوهم - ولكنها كانت بضعة أيام فقط، ووجدوا أن محمداً لم يرحل عن مكة، ولم ينزوِ في بيته - كما كانوا يتوقعون - بل استمرَّ على نهجه ودأبه، وأتباعُهُ من ورائه، في الدعوة إلى دين التوحيد، وتسفيه عبادة أهل الكفر والشِّرك.. وهذا ما أعادَ القلق إلى نفوس زعماء قريش الضالِّين، فراحوا يبحثون عما يصنعون!..
ولن يعدمَ مثلُ أولئك الأشرار وسيلةً أو حيلة لنصب مكائدهم، وإظهار حقدهم.. ولذلك أوفدت قريش اثنين من رؤوس أشرارها وهما: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، إلى أحبار اليهود في يثرب، لأنهم أهل كتاب، وقالت لهما: «سلاهم عن محمد، وصِفا لهم صفته، وأخبِراهم قوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم عِلم، ليس عندنا، من علم الأنبياء»[*].
والتقى مشركا قريش بأحبار اليهود في يثرب، وكان الجدال، الذي أعقبه خلوة تدارس فيها الأحبار الأمر حتى انتهوا إلى قرارهم، وهو أن تسأل قريش «محمداً» عن ثلاثٍ، فإن عرف خبرَها فهو نبيٌّ مرسل، وعندها على قريش أن تكتم الأمرَ عن الناس، وأن تتدبَّرَ حسم الموقف معه، لأنَّ في دعوته خطراً قد يستفحل، ويقوِّض كل ما لقريش من مكانة عند العرب!.
هكذا كانت الوصية المنكرة من أحبار اليهود إلى أهل الشرك والكفر.. وقد حملها النضرُ وعقبة، وراحا يغذّان السير على راحلتيهما إلى مكة، حتى إذا بلغا مشارفها، وجدا بانتظارهما جماعةً من رؤوس الحقد، وفي طليعتهم أبو سفيان، وأبو جهل، وأبو لهب وغيرهم، ممن هم من ألدِّ أعداء الدعوة الإسلامية، وأكثرهم بغضاً لنبيّ هذه الدعوة، إذ لم يطيقوا الصبر على البقاء في بيوتهم، فخرجوا بعد أن قدّروا مجيء رجُليهما، يجمعون بعضهم بعضاً لكي يلاقوهما، ويطمئنوا منهما على الأخبار من اليهود...
وانعقد نادي قريش، فور بلوغ خبر الوصول، والكل يتحرّق لمعرفة أنباء الفرج... فراح النضرُ وعقبةُ يستفيضان في الحديث عما جرى معهما في رحلتهما إلى يثرب، حتى وصلا إلى الغاية التي يريدها المجتمعون، فقالا:
لقد أوصانا أحبار اليهود أن تسألوا «محمداً» عن ثلاث لا رابعة لها:
- عن فتية في الدهر الغابر وكان أمرهم عجباً...
- وعن رجل طاف في مشارق الأرض ومغاربها...
- وعن سر الروح[*]...
وكأنما نزلت هذه الأخبار عليهم رَوْحاً وريحاناً، فقالوا:
- هي المعجزات من الكتاب الذي يستظهر به علينا محمد، إنا نظن أنه لن يقوى على معرفتها.. وإنَّ لنا معه، من بعدها لشأناً!..
وقرَّ رأيهم على دعوة «محمد» للاجتماع به عند الكعبة، وعلى الملأ من أهل مكة. فجاءهم، وسألوه أن يبين لهم أخبار الفتية، ورجل المشارق والمغارب، وأن يكشف لهم عن ماهيّة الروح؟ وتفكَّر بما طرحوه عليه، فاستمهل حتى الغداة، أو لبعض الوقت، لأنه لا يعلم من أخبار الماضي إلاَّ ما ينبّئُهُ به ربُّه العليم الخبير.
ولم يوافق ردُّه هواهم، فراحوا يتصايحون وهم يتهمونه بشتى الاتهامات الباطلة، حتى وقف أحدهم أخيراً وقال:
- أجيبوا الرجل إلى ما يريد، فإنه يبدو عاجزاً مهموماً. ولعلَّه يريد أن يسأل ربَّهُ عمَّا سألتموه، فلِمَ لا ندعُ له الفرصة التي لن تُجديَهُ نفعاً؟!.
وتركهم رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وذهب كعادته للصلاة، والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبيّن له من آياته العظمى ما يُجلي تلك المسائل التي طرحوها عليه، فيقرّ في الأذهان أن الله سبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب والشهادة، وأنه لم يكُ لمحمدٍ، ولا لأحدٍ من الخلائق أن يعلم إلاَّ ما يعلّمه إياه ربُّه، فما العلم أولاً وأخيراً إلاَّ من عند الله عز جل، وهو صاحب الشأن، إن شاء - سبحانه - أعلَم نبيَّهُ أو منَعَ عنه.
ومضت عدة ليالٍ، ولم يتنزَّل الوحيُ على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) . وكان رجالٌ من قريش يصادفونَهُ في طوافه، أو في طرقات مكة، فيعترضون طريقه، ويسألونه عمَّا طلب القوم منه، فكان لا يردُّ، بل يؤثر الانصراف عنهم.
ولما ظنَّ المشركون أن التعجيز قد أصابَ أهدافَهُ، وأن هذه جولتهم الأخيرة مع محمد بن عبد الله انصرفوا إلى الدِّعة، وإلى طلب الملذات في الحانات تحت الرايات، كعادتهم كلما ظنوا أن النصر حليفهم.
ويظهر الفارق هنا بين نبيٍّ يقضي لياليَهُ في طاعة الله ربِّه، وفي طلب الرحمة والهداية للناس، بعيداً عن همومه الشخصية، وعن أي غاية لنفسه.. وبين تلك الطبقة الباغية من قريش التي كانت تمضي لياليها في أوكار الحانات، تحتسي من كؤوس الخمر ما يذهب بعقولها، وتصيب من المتع الرخيصة ما يأتي على آخر ذرة من كرامتها..
حفلة ساهرة مع رؤوس الشِّرك
هؤلاء ثلاثة من شيوخ عشيرة قريش: أبو سفيان، وأبو جهل، وأبو لهب، يلتقون على إحياء ليلةٍ ساهرة، احتفالاً بالغلَبة على «محمد»، فيذهبون إلى حانة يهودي ماكرٍ - اعتادوا ارتيادها - لأنه يعرف كيف يؤمِّن لزبائنه الخمور والجواري، وكيف يوفر لهم اللذائذ والمتع، وكيف يتحايل عليهم ليقنص أموالهم، كدأب بني اليهود في كل زمان ومكان.
ودخل رجالات قريش الثلاثة، فأقبل عليهم صاحب الخيمة (ذات الراية الحمراء) يرحب بقدومهم، هاشّاً، باشّاً. ثم يصرخ بإحدى الجاريات:
- أسرعي يا ابنة اللعينة، وهيِّئي الطنافس لأسيادِ قريشٍ، ثم هاتي الكؤوس النظيفة، وأنا أتكفّل بالخمور المعتّقة التي تدير الرؤوس، وتلذها النفوس.
وتهيأت أسباب اللذة أمام تلك الزعامات القرشية، فمال اليهودي المتبذِّل على أذن أبي جهل وهو يُسِرُّ له:
- لك عندي يا سيدي جاريةٌ جديدةٌ، آيةٌ في الروعة والجمال..
قال أبو جهل: وأين هي يا ابن شلومة؟ أنرغب في الكلام أم في الجمال!.
قال اليهودي: اصبر قليلاً، وسترى..
ثم أقبل على الآخريْن، يمنّيهما بالغواني الجميلات مثل صاحبهما، وانصرف ليتدبَّر أموره، ثم يعود إليهم.. فما كان من أبي لهب إلاَّ أن ابتلَعَ جرعةً كبيرةً من خمرته، وهو يقول لصاحبيه:
- كأنّا بهذا اليهودي الخسيس لا يبقي لنا مالاً ولا شرفاً.
فنظر أبو سفيان إليه نظرة احتقار، ثم التفت إلى أبي جهلٍ، وقال ساخراً:
- أرأيت يا أبا الحكَم هذه الرجاحة في العقل عند أحدٍ مثل صاحبنا أبي لهب؟
ثم خاطب أبا لهب قائلاً:
- عجيب أمرك يا هذا، وما تبدي في هذه الساعة، أم نسيت أنك بين خمرة ابن شلومة وجواريهِ، فكيف خطر ببالك الحديث عن المال والشرف؟ هيّا ودَعْ كل أمْر إلاَّ اللذة والمدامة.
ويعقّب أبو جهل على رأي صاحبيْهِ فيقول:
- لا حاجة للإنكار يا أبا سفيان. فإن ما قاله أبو لهب هو عين الصواب.. وأنا أقسم باللات والعزّى أن هذا اليهودي لا يدفع لنا بجواريه إلاَّ ليَسلُبْنَ منّا الألباب، ويُفرِغْن ما في الجيوب. وإننا نعرف ذلك تماماً، ولكن نحن به راضون، وبحلاوته مسرورون.
ولم يجد أبو سفيان بداً من أن يتخلَّص من الهزيمة التي ألحقها به أبو جهل فقال:
يا صاحبيَّ! إنها لمتعةٌ وقد نشأنا عليها، وإنها للذَّة تسري في دمائنا، فما لنا عن طلبهما من محيص[*].
وظلَّ هؤلاء الثلاثة يعبّون الخمرة، والغانيات بين أيديهم حتى ساعة متأخرة من الليل.. وعلى الرغم من أنَّ أبا سفيان كان قد سكر حتى الثمالة، إلاَّ أنه رفع رأسه عن كتف غانيته، ثم تناول كأسَهُ بيده، وهو يقول متباهياً:
- أما إنكما لمعشر سوءٍ أيها الرجلان! لقد نسيتما أننا ما جئنا الليلة بالذات إلا لنحتفل بعودة الأمان إلى نفوسنا وديارنا، والاطمئنان إلى غدنا. والفضل في ذلك كان لأحبار اليهود الذين أمدّونا بالنصح لنتخلص من «محمد بن عبد الله»، فما رأيكما يا صاحبيَّ؟.
وكأنما ذكرُ «محمدٍ» أخرج أبا جهل من سكره، فانعكف[*] عن غانيته، ثم رفع كأسه وهو يقول:
- ما أطيب كلامك يا ابن عم! ولسوف تعلم العرب أننا نحن الأسياد في قريش، وأنَّه كان لنا الباع الأكبر في تأليب الناس على «محمد» والقضاء على دعوته!..
ثم التفت أبو جهل إلى نديمه الآخر وهو يقول له متهكماً:
- ولكن ما بال أبي لهب لم يرفع كأسه ويُبدِ سروره، أم تُراهُ حزيناً على ابن أخيه مما سيحلُّ به؟!
فما كان من أبي لهب وهو يسمع ذلك إلاَّ أن حمل كأسه، وشمخ بأنفه متغطرساً، ثم قال:
- ويْحكما من خبيثين! أتحسبانني أتخلى عن زعامة بني المطلب وفيَّ رمق من الحياة؟. أم نسيتما أنني أفنيت العمر وأنا أطلب هذه الزعامة وأعمل لأجلها؟!..
ولم يعقّب أبو لهب أكثر من ذلك لأنه لا يريد أن يهدرَ الوقت، فعادَ إلى مجونه، غير عابىء بما يدور حوله، بينما انكفأت نظرات صاحبيه عنه، وهما يتهامسان، ويسرّان لبعضهما بالقول:
- أحقاً يستأهل مثل هذا السكير الماجن زعامة بني عبد المطلب؟
ثلاثة.. ذوو عربدة، وفسق، وفجور.. لفَّهم الليل في حانة يهودي على الخمر والسكر، والانغماس في الرذيلة والموبقات، وهم يظنون - ظناً فقط - بأنهم ألحقوا وأمثالهم الهزيمة بالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وصرفوا الناس عن اتّباع دعوته، فتداعوا إلى سهرة المجون تلك، يحتفلون بانتصار موهوم، مكذوب!
ولكن هيهات لثلاثة سُكارى!..
بل هيهاتِ لأهل الشرك والكفر جميعاً أن يحققوا في نهاية المطاف المآرب التي يطمحون إليها في محاربة دين الله! إنهم لا يعلمون أن الله - سبحانه وتعالى - بالغٌ أمْرَه، مهما عمل أهل الأرض، ومهما رسموا من الخطط، أو وضعوا من الأدوات، أو عقدوا من التحالفات، أو سخّروا من العقول والأموال.. فعندما يكون المؤمنون مع ربهم - ولا يمكن للمؤمن إلاَّ أن يكون مع ربه - ويعزمون بالنية الصادقة والعمل المخلص على تحقيق أمر الله (تعالى)، فلا قوة في العالم تقف في وجههم، لأنهم من أجل الحق يعملون، ولا بد من أن ينتصر الحق، لأن سنَّة الله تعالى في خلقه أن يغلب الحقُّ الباطلَ، ولن تجد لِسنَّة الله تبديلاً، ولن تجد لسنّة الله تحويلاً.
وانقضت خمس عشرة ليلةً على نوم شياطين قريش، هانئين، مرتاحين.. بينما بات الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تلك الليالي ساهراً، ونفسُهُ معلّقةٌ بالملأ الأعلى يرجو الله ويستعينه - سبحانه وتعالى - أن يبيّن له ما سألوه، ويهديه سواء السبيل. وإن تقدير الباري عزَّ وجلَّ غيرُ تقدير خلائقه كلهم.. وها هو جبرائيل الأمين (عليه السلام) يتنزَّلُ - بعد تلك المدة - بوحي ربه ليلقِّن الرسول الكريم الآيات التي تردُّ على طلبات المشركين، ومَنْ هم وراءهم من أحبار اليهود.
تفسير المعجزات التي طلبوها
وما كادت شمس صباح ذلك اليوم تطلع، حتى كان الناس قد اجتمعوا إلى محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وهو على الصفا، ينادي: واصباحاه.
ووقفت جموعُ أهل مكة تستمع إلى رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وهو يحمد الله تعالى ويثني عليه، ويذكّر الناس بأنه لا يعلم الغيب، ولكنه وحيٌ يُوحى إليه ثم يتلوه عليهم بقوله تعالى:
{وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا *} [الكهف: 27].
لقد قدَّم الرسول الكريم بهذا التوجيه والإرشاد من قول ربه تعالى، لكي يؤكد للناس أنه لا يقول شيئاً من عنده، بل هو وحيٌ يوحى إليه من كتاب ربه الذي لا مبدِّل لكلماته.. ثم راح يُخبر الناسَ بما سألته قريش عنه...
قصة أهل الكهف
فقد سألته قريش عن فتية في الدهر. وفيهم قال الله عز وجل: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا *إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا *فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا *ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا *} [الكهف: 9-12].
وظل رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يتابع على مسامعهم تلاوة آياتِ ربه التي تقصُّ عليه نبأ أولئك الفتية (كما وردت في القرآن الكريم من الآية 9 إلى الآية 26 من سورة الكهف) إلى آخر تلك القصة وهو قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا *إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا *وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا *قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا *} [الكهف: 23-26].
وتدور هذه القصة من القصص القرآني حول بعض الفتية الأشداء الذين آمنوا بالله (تعالى)، إلهاً واحداً أحداً لا شريك له ولا ولد، بينما كان الوسط، الذي يعيشون فيه، كله كافراً مشركاً. فلما ظهر أمرهم، ولم يعد لديهم أي سبيل للالتقاء مع قومهم: لا في العقيدة، ولا في المشاركة بالحياة اليومية، لأن الاتجاهات مختلفة، والمفاهيم متضاربة، والعداوة لهم سافرة، والخوف على أنفسهم ودينهم من الحاكم بات يهددهم.. عندها آثروا الاختفاء فأوَوْا إلى كهفٍ في قريتهم، يختبئون فيه، ويدعون ربهم أن يرحمهم، ويهيّىء لهم من أمرهم رشَداً إلى ما يحفظ عليهم دينهم وإيمانهم..
وحلَّت عليهم الرحمة الإلهية السنيّة، فناموا في هدأة الإيمان، ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة وتسع سنينَ، يقلّبهم مقلّب الأحوال من جنب إلى جنب، حتى ليحسبهم الرائي أيقاظاً وهم رقود، أو ليحسبهم نياماً كالأيقاظ، وإلى جانبهم كلبهم قد بسط ذراعيه في فناء الكهف وكأنه يحرسهم، فلا يجرؤ أحد على الاقتراب منهم.. وكل ذلك بتدبير الله تعالى كي لا تهترىء أجسامهم في رقادهم، ولئلا يعبث بهم عابث من الناس أو الوحش أو الحشرات...
وفجأة تدبُّ فيهم الحياة من جديد، فيستيقظون، ويفركون أعينهم، تماماً كما يمكن أن يفعل أي واحد ينام ليلَهُ، ويفيق في صباحه، ولكنهم يحسُّون بأن نومهم كان طويلاً، فيسأل بعضهم بعضاً: كم لبثنا؟
- فقالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم.
ويشعرون بالجوع، فيبعثونَ أحدَهُم بالنقود التي كانوا يستعملونها في زمانهم لكي يذهب إلى المدينة ويأتيهم بالطعام، وهم يحذّرونه ألاَّ ينكشف أمره حتى لا يلحق به الكفار - والفتية يعتقدون أنهم دخلوا الكهف البارحة - فيعثروا عليهم ويقتلوهم، أو يعيدوهم في ملّتهم وعندئذٍ لا يفلحون أبداً.
ووجد الفتى أن المدينة قد تغيرت معالمها وأن أهلها مؤمنون، مثله ومثل رفاقه بالله الواحد الأحد، فلما سأل كيف دخل الإيمان إلى هذه المدينة علم أن الزمن قد دار، وأن بضع مئات من السنين قد تعاقبت، وأنه كان ورفاقه نياماً خلال تلك الحقبة الطويلة، وقد بعثهم الله العزيز الحكيم بعدها أيقاظاً صحاحاً، على نفس الهيئة التي كانوا عليها منذ دخولهم الكهف.
وهنا يعلن الفتى أمْره للناس، فيعرفون أنه ورفاقه هم الذين فروا بدينهم، في عهد أحد الملوك الظالمين، ولم يدرِ أحدٌ أين ذهبوا، بينما ظل الخلَف يتناقل قصتهم عن السلَف.
وهكذا بعثهم الله (تعالى)، وأعثر[*] عليهم الناسَ ليعلموا أن وعدَ الله - عزَّ وجل - بالبعث حق، إذ كما أنامَ سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية، ثم أبقاهم على حالهم طوال ثلاث مائة وتسع سنين، فهو قادر على أن يحيي الموتى عندما يبعثهم يوم القيامة، فيقومون من الأجداث ينسلون - وكلٌّ آتيه فرداً - على نفس الخلقة التي كان عليها في الحياة الدنيا..
وقد تنازع أهلُ تلك المدينة أمر الفتية بعد موتهم من جديد لمعرفة الشرع الذي كانوا يتعبدون عليه فيبنون لهم البنيان الذي يتوافق وشرعَهم، فقال بعضهم: نبني من حولهم البنيان الذي يسترهم، ربُّهُم أعلمُ بهم. ولكنَّ أصحابَ الرأي منهم قالوا: لنتخذنَّ عليهم مسجداً.
وتتعاقب الأجيالُ من جديد، وتبقى قصة الفتية عبرةً وعظةً قائمةً في النفوس. ولكنَّ الناس يختلفون في عددهم فيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم.. ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم. ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم. والحقيقة أن ذلك في علم الغيب. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعدَّتهم، وما يعلم عددهم من الناس إلاَّ قليل. ولكنَّ العبرة ليست في عدد أولئك الفتية، ولا في المدة التي لبثوها في كهفهم، بل العبرة في أمرين: الأول صدق الإيمان الذي جعل الفتية يلوذون بدينهم فراراً وهم يتوكلون على ربهم في أمرهم. والثاني سنّة الله تعالى في الخلق عندما قدَّر الموتَ والبعث والحساب، فيوقن الذين ينكرون البعث أنَّهُ حقٌّ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث مَن في القبور.. وهنا التذكير المفيد: فهل يوقن كل من يقف على قصة هؤلاء الفتية الصادقة بأمر البعث والنشور؟!..
وتبقى قصة أهل الكهف، بمدلولاتها الإيمانية، خالدة خلود القرآن الذي حفظها كما تنزَّل بها الوحيُ من الله العلي الكبير على قلب محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) . وقد تلاها رسول الله آياتٍ بيّنات على مسامع أهل مكة يومئذٍ لعلَّهم يهتدون، كما يتلوها اليوم قارىء القرآن على مسامع الناس أجمعين لعلَّهم أيضاً يؤمنون!
قصة ذي القرنين
وقد سألوا الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن الرجل الذي طاف في مشارق الأرض ومغاربها. فعاد بعد قصة أهل الكهف، يتلو عليهم - من ذكر ذلك الرجل، الذي كانَ داعيةً إلى الله، وعقيدة التوحيد - قرآناً مبيناً بقول الله تعالى:
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا *إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا *فَأَتْبَعَ سَبَبًا *حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا ياذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً *قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا *وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا *} [الكهف: 83-88] [*].
هذا ما كان من ذي القرنين (كما يسميه القرآن الكريم) مع أولئك القوم الذين وجدهم يعيشون في بلادٍ تغرب عندها الشمس، مما يعني أنه بلغ البحر من ناحية الغرب حيث تختفي الشمس عند المغيب، فأوحى له ربُّهُ إمَّا إنْ يعذّبَ، وإما أن يعامل بالحسنى، فأمَّا من رفض دعوته إلى الإيمان والتوحيد، فقد نالَ ما يستحق من العذاب على كفره، وأما من آمن وعمل صالحاً، فقد عامله بالحسنى، وأرشدَهُ إلى السبل اليسيرة التي يحفظ بها إيمانه وحياته.. وبعد أن انتهى من الأوضاع عند أولئك القوم تركهم وتابع نحو المشرق فوجد قوماً غيرهم يعيشون في سراديب[*] من الأرض، لأنَّ الله تعالى لم يجعل لهم من دون الشمس ستراً (بناءً، أو ظلالاً تحميهم من حرّها)، فتركهم وتابع سيرَهُ حتى بلغ مكاناً بين سدّين، ومن ورائهما قوم لا يكادون يفقهون القول وقد حاق بهم العذاب من قوم يقال لهم يأجوج ومأجوج كانوا يأتونهم طغاة ظالمين، فيفسدون عليهم العيش، وينكّدون عليهم الحياة.. وفي أخبار ذي القرنين في مسيره نحو مطلع الشمس، قال الله تعالى:
{ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا *حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا *كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا *ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا *حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً *قَالُوا ياذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا *قَالَ مَا مَكَّنْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا *آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا *فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا *قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا *} [الكهف: 89-98].
هذا ما أبلغه رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لقريش، ولأهل مكة عن الرجل الذي بلغ من الأرض ناحيتي المغرب والمشرق..
وقد تداولت التفسيرات هذه القصة بتوسع، ومفادها:
أن أحد ملوك حِمير (الذين كانت أسماؤهم تبدأ بـ«ذي» مثل: ذي نؤاس، ذي يزن) وكان اسمه أبو بكر بن أفريقش، قد سار من بلاده اليمن بجيوشه إلى ساحل البحر المتوسط، فمرَّ بتونس، ومراكش وغيرهما من البلدان المجاورة، وبنى مدينة أفريقية فسميت القارة كلها باسم تلك المدينة المأخوذة من اسمه أفريقش.. وأما لقبه في القرآن الكريم بذي القرنين فلإثبات أنه من ملوك حمير، وأنه بلغ قرنَيِ الشمس، أي ناحيتي المغرب والمشرق في إحدى المناطق الواقعة في بلاد الشرق.
وعلى ذلك فإن ذا القرنين اليمني ليس هو الإسكندر المقدوني، أحد القادة الإغريق المعروف في التاريخ، والذي كان يلقب أيضاً بذي القرنين لاتساع فتوحاته في المشارق والمغارب. فالمقدوني كان على الوثنية، بينما ذو القرنين اليمني كان رجلاً مؤمناً صالحاً، وقد مكّن الله تعالى له في الأرض، فقام بفتوحات كبيرة بلغت إحداها المغرب، والأخرى المشرق، والثالثة بلاد السدّين.
وتفصيل ذلك أن أول فتوحاته قد بلغ مكاناً رأى الشمس تغرب فيه، وقد يكون ذلك المكان على شاطىء البحر المتوسط، أو شاطىء المحيط الأطلسي - أو عند مصب أحد الأنهار الكبيرة - حيث تكثر الأعشاب ويكثر الطين اللزج الذي هو الحمأ، وحيث تكثر البرك وكأنها عيون ماء.. فرأى الشمس تغرب هناك، «وجدها تغرب في عين حمئة».. وقد وجد في تلك الأمكنة قوماً منهم الكافرون، ومنهم المؤمنون، فأولاه الله - سبحانه وتعالى - سلطةً عليهم، ليحكم بينهم بما أنزل الله، وهو العدل السوي: بأن يعذِّب الظالم الآثم، والكافر على فعالِهِ السيئة، وذلك في دنياه هذه، قبل أن يُردَّ إلى ربه فيعذبه عذاباً شديداً نكراً.. وأما المؤمن الذي يعمل صالحاً فله في الدنيا جزاء الحسنى والمعاملة الطيبة، والتكريم، والتقدير الذي يستحق على إيمانه وعمله الصالح، وأما في الآخرة فستكون حالته أحسن بكثير لأن العناية الإلهية سوف تحيطه باليسر في آخرته، فينال جزاءً أوفى، رضواناً من ربه - تبارك وتعالى - وفوزاً بجنات النعيم.
وسارَ ذو القرنين من تلك الناحية في الغرب نحو المشرق، ووصل إلى أرض مكشوفة، لا تحجبها عن الشمس مرتفعات ولا أشجار، مما ينطبق على وصف الصحارى أو السهول الواسعة غير المزروعة، وغير المشجرة.. وقد تعامل مع أولئك القوم بما يتناسب وأوضاعهم الفكرية والحياتية، إلاَّ أنه هداهم إلى شرع الله تعالى وعدْله - شأنه في كل أرض كان يحلُّ بها - كي يغيِّروا نمط عيشهم، وتستقيم أمورهم..
ثم تابع فتوحاته حتى بلغ مكان قوم عند حاجزين طبيعيين أو تقاطعٍ بين سدّين، فوجدهم متخلفين لا يكادون يفقهون شيئاً من القول إلاَّ ببطء فعرضوا عليه، في مقابل خرْج من المال يؤدّونَهُ له، أن يخلِّصهم من ظلم يأجوج ومأجوج القوم المفسدين الذين يغيرون عليهم من الفرجة بين السدّين فيعيثون فساداً في أرضهم، من دون أن تكون لديهم قدرةٌ على صدّهم، أو دفعهم عما يفعلون بهم.
ولم تكن عند ذي القرنين أطماعٌ في جمع المال، بل كان يسعى في الأرض لاقتلاع الكفر والفساد، وإقامة الحكم الصالح، فلم يقبل من أولئك القوم الخرْج الذي عرضوه عليه، بل طمأنهم إلى دفع الشرّ عنهم بما مكّنه ربُّهُ، وهو خيرٌ - بإذن الله - على أن تكون لديهم الجلادة على العمل المضني الشاق - وغايته من ذلك أن يغيّر ما في نفوسهم من تخاذل وتكاسل - وذلك بأن يعينوه على صنع قطع الحديد، ونقلها ليراكمها فوق بعضها بعضاً، ويسد بها الممرَّ الذي يَعبُرُ منه الغازون.
وبدأ العمل، واشتدت السواعد بعد لينها، وقويت النفوس بعد ضعفها، فاستطاع ذو القرنين - بإذن الله - أن يجمّع الحديد ويراكمه فوق بعضه بعضاً إلى أن ارتفع إلى موازاة قمتي الجبلين، حتى صارا، بمثابة صدَفتين تطبقان على الحديد بينهما. ثم أشعل ناراً حامية شديدة كي تلين الحديد وتشده إلى بعضه. ثم أمر بالنحاس فأذابَهُ وصبَّهُ فوق الحديد المحمّى ليسدَّ كل فراغ بينه، ويجعله متراصّاً متماسكاً وكأنه جزء لا يتجزأ من ذيْنك الجبلين، فلا يعود باستطاعة قوم يأجوج ومأجوج اختراقه، ولا الصعود والهبوط منه إلى الناحية الأخرى.
ونظر ذو القرنين إلى هذا الردم من الحديد الذي أقامه - وهو عمل رائع حقاً - فلم تأخذه العزة بنفسه، بل ردَّ الأمر إلى ربِّه العلي القدير، فقال: «هذا رحمة من ربي».
ثم أردف: فإذا جاء وعد ربي، وقامت القيامة فإنها لا تذر جبالاً، ولا حواجز، ولا سدوداً، ولا بنياناً، ولا يبقى شيء على هذه الأرض، التي تغدو عارية منبسطة. وإنَّ وعد ربي حقٌّ بحلول ذلك الانقلاب الكوني الذي يجعل كل شيء دكّاء[*].. وهو ما أورده القرآن الكريم على لسان ذي القرنين، بقوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا *} [الكهف: 98].
هكذا وبالقرآن الكريم الذي يتنزَّلُ وحياً من رب العرش العظيم، كان رسول الإسلام يبيّن للناس على الصفا - بالقرب من الكعبة المشرَّفة - ما كان من خبر أصحاب الكهف، وخبر ذي القرنين.
وكانت الأسئلة تنهال عليه، إما بدافع التعجيز، وإما بدافع الفهم ومعرفة معاني الآيات التي يتلو، والنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لا يكلُّ، ولا يتعب في توضيح كل ما يسألون عنه، والردّ على كل ما يبدونه، حتى حان موعد المسألة الثالثة التي طرحتها عليه قريش..
ماهية الروح
وكانت قريش قد سألت النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : ما هي الروح؟ فجاءتها الإجابة آيةً مبينة يتلوها رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على مسامعهم بقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً *} [الإسرَاء: 85].
وكانوا يفقهون لغة القرآن لأنه نزل بلسان عربي فصيح، فما استطاعوا أن يتهموا النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بتقصير، أو عدم تبيان لأمر الروح.. فقول الله - جلّ وعلا - في ماهية الروح واضح، ولا يحتمل جدالاً ولا تأويلاً.. إنها من أمْر الله، وقد أغلق - سبحانه - علْمها على كلِّ عباده، فلا شأن لهم بالسؤال عنها، ولا شأن لهم بعلم سرِّها.. إذ العلم الذي يُؤتونَهُ يبقى قليلاً جداً، وجزئياً من علم الله الواسع الكبير. ولذلك تبقى الروح وكثيرٌ غيرها - مما لا يعلمُهُ إلاَّ الله سبحانه وتعالى وحده - أسراراً لا قبلَ للعقل البشري بإدراكها، أو الوقوف عليها. وهذا ما يجعل من هذه الآية معجزةً تضاف إلى معجزات القرآن التي تضع الإنسان في مواجهة عدد من الآيات التي يوردها هذا الكتاب المجيد ليستدل - الإنسان - على ضعفه، وقلة حيلته، فلا يضل عن الإيمان بالله تعالى، ولا يستكبر عن طاعة ربه، والامتثال لأوامره ونواهيه...
ولمَّا لم يعد أمام القوم من سبيل لمناقشة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تفرقوا في كل ناحيةٍ لا يلوون على شيء...
أما رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فنزل إلى الكعبة الشريفة يطوف، ويصلّي، وهو يحمد ربهُ تعالى، ويشكره على ما أظهَرَ له، وأعانهُ عليه. ثم يذهب إلى بيته ليرتاح من تعب ذلك اليوم، ويستعدَّ لأيام أثقل عبئاً، وأشدَّ وطأة.
وتفرَّق زعماء قريش بعدما أُجيبوا عما سألوا، فهل يرعوون؟!..
لقد كان خليقاً بهم أن يؤمنوا، ويصدقوا محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعدما سمعوه يخبرهم عن أنباء الماضي السحيق، التي ما كان له أن يعرفها لو لم يتنزَّل عليه خبرها قرآناً كريماً بلسان عربي فصيح. ولقد كان جديراً بهم أن يتفكروا بذلك، ويدركوا أن ما أبانَهُ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يكن من عنده، وليس بمقدوره أن يعلمه إلاَّ أن يكون وحياً من ربه - تبارك وتعالى - ولكن هل فطنوا إلى شيءٍ من ذلك؟! أم أنهم فطنوا، ووعوا تلك الأخبار التي تُعتبر بذاتها معجزةً، ولاسيما ما تلاه من قرآنٍ عن الروح، الذي ينبىء ليس بعجزهم وحدهم بل وعجز الثقلين عن معرفة ماهية الروح؟! لقد استمعوا.. وربما فقهوا أو لم يفقهوا.. فانصرفوا يلوذون بالخسران والهزيمة بعدما أمَّلوا الربح والنصر..
أجل! لم يؤمنوا لا بالتبليغ، ولا بالإنذار، فصدق فيهم قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ *} [البَقَرَة: 6] وقوله عز وجل: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا} [الأنعَام: 25][*]، فقد كتبوا على أنفسهم أن يبقوا منغمسين في حمأة الضلال، فويل لهم مما صنعت أيديهم، وويلٌ لهم مما ظلموا به أنفسهم!..
الاستماع إلى قراءة القرآن
ولكن على الرغم من إعراضهم عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقد بقي من تأثير ذلك اليوم بعضُ الشيء في النفوس. فقد أيقن بعضٌ من كهّان المكر أنَّ ما تلاه «محمد» على مسامعهم لم يكن سحراً، ولا كهانة، ولا رجماً بالغيب.. بل كان - حقاً - قولاً متناسقاً في جرْسه ووقعه، متآلفاً في معانيه وعظاته، بما يدلُّ على أنه قولٌ عُلويٌّ، وليس من قول البشر.. إذن فقد أمكن لهؤلاء أن يتذوقوا حلاوةً في التلاوة لم يعرفوها من قبلُ، وهي التي جعلت في نفوسهم ميلاً للاستماع إلى القرآن، هذا الكتاب الذي تتمنطق آياته الكريمة بقوة المبنى والمعنى، وبصدق الأدلة والبيّناتِ التي تلقيها حجةً على الناس جميعاً، وليس على نفرٍ من قريش وحدهم.. فإذا كفروا من بعدُ فيكون كفرهم - مع البيّنة، وإقامة الحجة وإظهار الدليل - كفرَ عنادٍ، وكفرَ نفاقٍ.. المهم أن التأثيرَ في النفوس قد حصل، وهذا ما دفع بأولئك البعض من قريش لأن يتحيّنوا الفرص للاستماع من جديد إلى تلاوة الآيات القرآنية.
ففي ليلة ظلماء غطى سوادها مكة، وبدون علم من الأتراب الآخرين، أو من أحدٍ غيرهم خرج وحده كلٌّ من: أبي سفيان بن حرب، وأبي جهل عمرو بن هشام، والأخنس بن شريق إلى جوار بيت «محمد» ليختبىء، متخفّياً، ويجلس منصتاً.
وكان النبيُّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقوم آناء الليل على الصلاة والتهجد وعلى قراءة القرآن، فجاء أولئك النفر يستمعون، غير متنبِّهين للوقت وهو يمرُّ سريعاً حتى بانت طلائع الفجر، فهبَّ كل واحد يريد العودة إلى بيته لئلا يُكتشف أمره، ويُفتضح سرُّهُ.
وكم كانت دهشتهم كبيرة وهم يتلاقون مع بعضهم قرب بيت «محمد»، فوقفوا واجمين وقد عقد الخجل ألسنتهم، فلم يبادل أحدٌ أحداً بتحية، أو بأي كلمة، حتى تجرّأ أبو سفيان وقال:
- ويحنا من مغفَّلين، فما لنا ولهذا الوقوف المخزي؟ ألا ترون أن الناس بدأوا ينتبهون من رقادهم، وقد يتساءلون عن وجودنا في هذا المكان، وعن الذي جمعنا في الفجر عند بيت محمد بن عبد الله؟
قال عمرو بن هشام: وما أتى بك إلى هذه الناحية يا أبا سفيان؟
فقال له: إنه الشيء نفسه الذي جعلك وصاحبَك ههنا.
وقطع عليهما الأخنس الجدل قبل أن يستفحل، فقال: لا نلومَنَّ أنفسنا بما فعلنا، ولكن لنتعاهد على ألاَّ نعود إلى مثلها مرة أخرى.. وطمأن كلٌّ منهم الآخر ألاَّ يعود للاستماع إلى «محمد» مهما كانت ميوله ودوافعه. ثم انصرفوا عن بعضهم مستعجلين.
ولكن هيهاتِ لأي منهم أن تسكن نبضات قلبه وهي تحنّ إلى الذكر الحكيم. فلو تُركت النفوس وفطرتَها لانقادت إلى خالقها طائعة. ولكنّ الإنسان، هو الذي ينقضُ الفطرة التي فطره الله عليها، فيدسُّ في نفسه الشرَّ، ويترك للشيطان أن يملأها بالوسوسة والغواية.. ولذلك ينبهنا القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة عندما يعبِّر عنها بظلم النفس، أي أن الإنسانَ هو الذي يظلم نفسه بالشرك والكفر، فيجعلها موضعَ الحساب وتلقّي اللوم على ما حملت، وتوطَّن فيها، وذلك عندما يطغى عليه الشيطان فيحوّله عن فطرته السليمة إلى عبدٍ له يأتمر بغوايته وينقاد لإضلاله.
لقد تعاهَدَ أولئك الثلاثة في فجر ذلك اليوم، على الابتعاد، عن سماع القرآن.. ولكن ما إن جَنَّ الليل حتى هبَّ كل واحد من فراشه، وراح إلى المقعد الذي اقتعده البارحة.. وتلاقوا من جديد، ودار ما دار بينهم، ثم ولَّوا وقد تعاهدوا على عدم الرجوع إلى ما كانوا فيه. إلاَّ أن الفجر الثالث جمعهم من جديد، وفيه قدّروا مدى الخطأ الذي يرتكبون إن ظلوا على تلك الحال، التي من شأنها أن تجعل قريشاً تخزيهم، وترذلهم، لأنها سوف ترى فيهم حماقة أخرجتهم على وحدة الكلمة وثبات الموقف. ولذلك أقسمَ أبو سفيان والأخنس باللات والعزَّى على ضبط النفس، وعدم خداع بني قومهم.. إلاَّ أن أبا جهل أبى أن يستوثق من أَيمانهم إلا عند هبل، كبير آلهة قريش. فتوجهوا من فورهم إلى الكعبة - أعزها الله - وعلى قدمي هبل انحنوا يمرّغون جباههم، وهم يحلفون بألاَّ يعودوا للاستماع إلى القرآن، بل وأن يلغوا فيه، إلى أن يتم لهم دحرُ «محمد» والنصرُ عليه.. وقد بيّن الله تعالى موقفهم ذاك بقوله العزيز:
{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ *} [فُصّلَت: 26].
لقد جفّت قلوب أولئك النفر من قريش - ومن هم على شاكلتهم - من نداوة الإيمان، وغابت من وجوههم مسحة الهداية، فراحوا يحاربون القرآن، ويتقوّلون فيه أقاويل شتى، كانت كلها لغواً بلغوٍ.. إلاَّ أنهم لم يستطيعوا مع ذلك، أن يسكتوا الصوت الصارخ في أعماقهم، وهو يقرّعهم على التمادي في الغي والضلال، فكان لا يجتمع أحدٌ مع غيره من جِلْدته، إلاَّ ويكون الحديث عن القرآن وحلاوة سماعِهِ. حتى أن الأخنس لم يتورع مرةً عن مصارحة أبي جهل بحقيقة مشاعره، فيقول له:
- يا أبا الحكم! هلا أخبرتني، ولكن بصدق؟
- قال أبو جهل: وبماذا تتهمني يا أبا ثعلبة؟
- لا، وحق اللات والعزى ما هو باتهام، وإنما هي الرغبة في معرفة ما ترى في القرآن الذي يتلوه «محمد»!..
قال أبو جهل: أما إنك خبيث وماكر يا أبا ثعلبة.. فأيّاً يكن الشيء الذي في نفسك، لا أخفي عليك أنني كنت أستمع إلى «محمد» مأخوذاً. ولكن ما يحيّرني أنني قد فهمت أشياء، وغابت عني أشياء، وإنَّ نفسي لتوّاقة لأن أجلس إلى هذا الرجل فيبيّن لي ما عمِيَ عليَّ من معاني قرآنه.
قال الأخنس (والغصَّةُ تكاد تخنقه وهو يبتلع ريقه):
- وإنّي والله مثلك يا أبا الحكَم، ففي القرآن معانٍ صعبٌ علينا إدراكها، إن لم نعرف أسباب نزولها وأحكامها، وما تحمل من البراهين والعظات..
وبعد بضعة أيام التقى الأخنس بن شريق بصاحبه الآخر أبي سفيان بن حرب، ودار بينهما الحديث نفسُهُ عن فصاحة لغة القرآن وبلاغته، وحلاوة سماعه، ولكنَّ أبا سفيان لم يكن همُّهُ قرآن «محمدٍ» بقدر ما كان همُّهُ حقده عليه وعلى دعوته، لأن العداوة المتأصّلة في نفوس بني أميّة ضد بني هاشم إنما هي على الرئاسة في قريشٍ. فأجاب صاحبه قائلاً:
»لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا.. حتى إذا تحاذينا الركب وكنا كَفَرسَيْ رهانٍ، قالوا: منا نبيٌّ يأتيه الوحيُ من السماء، فهل ندرك مثل هذه المرتبة؟ واللات والعزى لا نؤمن به أبداً، ولا نصدقه».
القرآن عنصر الدعوة الأساسي
يتبيّن مما قاله أبو سفيان بن حرب أن الدوافع وراء عداوة المشركين لمحمد ودعوته عديدة ومتنوعة - كما أشرنا مراراً - وهي التي جعلتهم يبتعدون عن القرآن، ولا ينتفعون بآياته التي تزكّي النفس بالتهذيب والاعتزاز، وتصقل العقول بالوعي والانفتاح. إذن فلا القرآن وما يحمل من عظات للبشر، وتعاليمَ تسمو بالإنسان إلى معارج الإيمان والرقي والتقدم، ولا فصاحة مبناه، وروعة بلاغته وبيانه.. لا شيء من ذلك كله كان ليفتح عقولهم وقلوبهم لهذه الدعوة التي يحتضنها بين دفتيه، والتي من شأنها أن تنقلهم من الجاهلية والبداوة إلى العلم والحضارة.
وعلى خلاف ذلك تماماً كان حال المسلمين.. فقد كانوا يعايشون القرآن، وينعمون بنفحاته الطيبة، ويتفيأون في ظلال أحكامه وتعاليمه المجيدة.. يَحْيوْنَ بالاستماع إلى تلاوته وقراءته، وفي التفكّر بجلال قدره وقيمته، وينهجون على شرعه قولاً صادقاً، وسلوكاً قويماً، وعدلاً سوياً، فيرتقون به إلى أعلى درجات الإنسانية: في صلابة العقيدة، وأحقية القول والفعل، وفي صدق النيّات والإخلاص لربهم، وهداية عباده.
وهذا هو الفارق الكبير بين المسلمين والمشركين، وإن كانوا من البيئة ذاتها، والمجتمع نفسه، ويتشاطرون وإياهم أسباب الحياة ومقومات الوجود نفسها. ولكن أين أهل الكفر من أهل الإيمان، ولكلٍّ عقيدةٌ ووجهةُ نظر مختلفةٌ عن الحياة والإنسان والكون؟ فكان محتوماً أن يوجد التضارب في الأفكار، والتضادّ في الاتجاهات، والتفاوت في المسارات.
وكان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يعزّز هذه الحقائق التي تميّز المسلمين عن المشركين، والتي يعود الفضل فيها للقرآن الكريم. لقد أراد منذ البدء أن يكون تعاطيهم مع المشركين من خلال هذا القرآن، ولكنَّهم أبوْا النصح، وتمنّعوا عن الاهتداء.. إلاَّ أن ذلك لم يَفُتَّ في عضد رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وفي استقامته على نفس المنهج الرباني الذي يمكن أن يربيهم عليه، لو استقاموا على الشريعة!. فما رصدوا له موقفاً كي يثنوه عن عزمه، وما طرحوا قضية أو مسألة كي يحاجّوه ويجادلوه إلاَّ وجعل القرآنَ بينه وبينهم. فالقرآن يدور على لسانه كما ينبع من قلبه، وأحبّ شيء إليه أن يستفيض في إسماعهم قول الله الحق تذكرةً في خلدهم، أو على ألسنتهم. فقد كان (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يدرك ما للقرآن الكريم من أثر عظيم في النفوس، ويسعى لأن تكون حياة المسلمين، بمعايشتهم القرآن، مثالاً يُحتذى به من أبناء مكة، مما قد يجذبهم للانقياد إلى الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها، فيقبلون على الإسلام بفضل القرآن... ولذلك رأى الرسول الأعظم أن يتّبع أسلوباً جديداً في إيصال القرآن إلى مسامع أهل مكة عبر الأثير[*] الذي ينقل الأصوات، فيتلقّاه الناسُ في البيوت والمجالس، والطرقات بصورة تلقائية، وبدون أي استعداد نفسيٍّ مسبقٍ - ينطوي على خلفية العداوة لهذا القرآن - وعلى أن يتم ذلك جهراً عدة مراتٍ في اليوم - إن أمكن ـ. فلما عرض الأمر على الصحابة، في دارة ندواتهم وحلقاتهم، هلَّلَ الحاضرون وكبَّروا، لأنَّ في مثل هذا الجهر بالقرآن إعلاناً للناس أن المسلمين يريدون الحق، ويعملون للحق، والحق - في كل حال - واحد لا يقبل التجزئة لا في أسسه وقواعده، ولا في أهدافه ومقاصده.
وأبدى كل من الصحابة كامل الاستعداد لقراءة القرآن جهراً وعلانية على ملأ قريش، وعلى أهل مكة في وضح النهار، حيث يحظى القارىء بهذا الشرف الرفيع. وأبى عبد الله بن مسعود إلاَّ أن يكون هو البادىء، ولينال المكرمة الربانية التي يعدهم بها الرسول العظيم، وليس ذلك بسبب أنانيةِ عبد الله وأثرتِه، بل طمعاً في نيل رضوان الله تعالى، وخوفاً على هؤلاء الإخوة من أذى قريش..
ولم يوافق إخوته المسلمون على أن يُعرِّض عبد الله حياتَهُ للخطر، فإنَّ فيهم من له عشيرةٌ تحميه وتمنعه من القوم. فإن قام قرشيٌّ يجاهر بالقرآن، فقد لا يتعرَّض لما قد يتعرض له عبد الله.
وتأثَّر عبد الله بن مسعود بهذا الموقف، فدمعت عيناه، لأنه أراد أن يبعد عن الدعوة حرباً قبلية قد تتذرع بها قريش أو غيرها من قبائل مكة، ولا همَّ بعدها ما يناله من الأذى والاعتداء حتى ولو كان القتل في سبيل الله، فوافق النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ودعا له بالتوفيق.
وهنالك على مقربةٍ من الكعبة الشريفة، ارتقى عبد الله بن مسعود مرتفَعاً من الأرض وراح يقرأ بأعلى صوته، سورة الرحمن، بالقول الحق المبين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *} {الرَّحْمَانُ *عَلَّمَ الْقُرْآنَ *خَلَقَ الإِنْسَانَ *عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ *وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ *وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ *أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ *وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ *وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ *فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ *وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ *فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *} [الرَّحمن: 1-13].
كان صوت عبد الله بن مسعود[*] يتهادى، ويمتد في سماء مكة، فيسمعه شيخها ووليدها، مما جعلهم يهتاجون لمعرفة من هو هذا القارىء الذي يتحدى مشاعرهم، ويخرج على طاعتهم. وكان أكثرهم دهشة عقبة بن أبي معيط الذي وقع عليه الخبر كالصاعقة، إذ ما كاد يسمع باسم ابن مسعود حتى امتقع لونه، وشحب وجهه، لأنه ما كان ليدور في خلده يوماً، أن يكون خادمُهُ وراعي غنمه - وهو ما عليه من قِصَر القامة، ونحالة الجسم، ودقة العظم - الإنسان الذي يتحدّاه، غير آبهٍ بولايته عليه، أو بما لَهُ من مكانةٍ بين القوم، وبما عنده من المال. لقد أحسَّ بأن هذا الراعي قد أخزاه، فاندفع يريد قتله، ومثله كثيرون كانوا قد خرجوا في طلب ابن مسعود لما أنالَهُمْ من المهانة، بحسب تفكيرهم القاصر!..
وتلاقت جماعات الحقد في الطريق، فانهالوا على عقبة بن أبي معيط بالسخرية، فسكت لأنّ ما بيده حيلة، على ما يجري، حتى وصلوا إلى عبد الله، فانقضّوا عليه يشبعونه شتماً وإهانةً ويوجعونه ضرباً ولكماً، وهو لا ينثني عن ترداد ذكر الله - عزَّ وجلَّ - والاستمرار في قوله تعالى {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *} [الرَّحمن: 13].
وأخيراً وقع عبد الله مغشياً عليه، فتناول عقبة بن أبي معيط حجراً كبيراً ليهوي به على رأسه، لولا أن أمسكَهُ أميةُ بن خلَف قائلاً:
- ويحك يا رجل! أتريد أن تدنِّس يديك بقتل راعٍ للغنم نتنِ الرائحة. دعْ عنك الأمر إنه ميت لا محالة!.
وذهب الكفار وفي ظنهم أنه فعلاً قد مات، أو على وشك الموت.. فجاء فتيان من المسلمين يحملون أخاهم الشجاعَ، الصابر، إلى دار الأرقم، حيث كان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ما يزال بانتظاره مع الصحابة..
وسارعوا في إسعاف الجريح، والدم ينزف من فمه وأنفه، وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما كنا نخشاه على أخينا عبد الله.
ولمَّا أفاق واستعادَ وعيَهُ، كانت أولُ بادرةٍ بحثَهُ بناظريه عن رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فرآهُ فوق رأسه تعلو ثغرَهُ رحمةٌ ومؤاساة، فأحسَّ بقواه تعود إليه، فنهض وهو يقول:
- والله يا رسول الله ما رأيتُ أعداءَ الله أهونَ عليَّ منهم اليوم. ولو أجزتني لآتِينَّهم غداً بمثلها.
ويتلقى عبد الله من إخوانه التهانيَ التي تعبّر عن مشاعرهم الصادقة، إلاَّ أن أكثرها بركةً كانت من رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وقد اعتبرها عبد الله وساماً يرفع من قدره على مدى الحياة، عندما أثنى (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على فعله الجريء بما يرضي الله - عز وجل - بقوله له: «حسبُكَ.. وقد أسمعتهم ما يكرهون».
ولم يكن اختيار الرسول الحكيم لابن مسعود، لكي يجهر بالقرآن على الملأ من قريش، إلاَّ عن حكمة وتقدير، ويتجلّى هذا الاختيار بجوانب عديدة أبرزها:
- أن يثبت للمشركين أن القرآن هو زاد المسلمين وسلاحهم، يجعل ضعيفهم قوياً، ويزيد قويَّهم قوة، ولذلك كان اختياره لابن مسعود بالذات لأنه في نظر أعداء الدعوة من الأضعفين في المسلمين (على ما كان الكفار يصنّفونهم).
- أن يجعل المشركين يقتنعون أخيراً بأنه لا مكانة في الإسلام لعصبية أو قبلية، أو تمايز طبقي، بل إن بناء الشخصية الإسلامية يقوم على التقوى والعمل الصالح، ولذلك فلا فرقَ بين أن يجهر بالقرآن عبد الله بن مسعود أو أي مسلم آخر أمثال علي بن أبي طالب، أو عثمان بن عفان، أو عبدالله بن عبد الأسد (أبي سلمة) أو أبي عبيدة بن الجراح أو غيرهم.
- أن يوقن المشركون بأن القرآن هو كتاب المسلمين، الذي يجسد، في نفوسهم، وفي أعمالهم، الروح الإسلامية التي تميزهم عن سائر الناس، فكان حريّاً أن يجهروا به تعبيراً عن تلك الشخصية الإسلامية المميزة.
- ثم إن هذا القرآن هو المعجزة الذي تحدَّى بها ربُّ العزة والجلال الثقلين، فلمَ لا ينصبُّ هذا التحدي على رؤوس مشركي مكة فيوقنون أنه بالقرآن، وبالقرآن وحده يبرز الإيمان ليتحدى الكفر، والحقُّ ليتحدى الباطل..
أجل، هذه بعض الجوانب التي شاءَ الرسولُ الأعظم أن يُفهمها لقريش من الجهر بالقرآن... بل وليعلم زعامة الكفر بأن الكلّ في الإسلام - ولا فرق في ذلك بين راعي الغنم ونبيل القوم - جندٌ لله سبحانه وتعالى، ولكل جندي من جنود الله من القوة الذاتية ما يؤهله للتضحية في سبيل الله بكل غالٍ ونفيس، حتى الشهادة.. ومن هنا كان ذلك البون الشاسع بين المسلمين الأوائل الذين كانوا على النهج القويم عينِهِ من الإيمان والاستقامة، وبين طغاة قريش وما تحبل به نفوسهم من غطرسة جوفاء، وصلافة رعناء، وما تمتلىء به قلوبهم من قساوة، حتى أنها قد تكون أشدَّ قسوةً من الحجارة!.
فهل تدرك قريش كل ذلك؟! كلا إنها لا تعي شيئاً من هذا القبيل - على الأرجح - لأن الجاهلية كانت تقودُ حياتها، فسيطرت على أفكارها، ومعتقداتها وتصوراتها حتى أعمت البصائر وأصمّت الآذان.. فماذا فَعلَ عبد الله بن مسعود غير أنه كان يتلو سورة الرحمن من القرآن المجيد التي تبيّن للناس وللجانّ آلاء[*] الرحمن، وتدعوهم للنظر بهذه الآلاء؟ ثم أليست سورة الرحمن ترشد إلى رحمة الله، الرحمن الرحيم، وقد وسعت رحمته كل شيء؟.. فأي خطأ ارتكبه قارىء القرآن؟ إلاَّ أن يردّد قول الله العلي القدير حتى تشيع في أجواء مكة نفحات الإيمان، وتُسدَلَ عليها أستار الرحمة، وفي ذلك خير لهم أجمعين؟! فهل جزاؤه يكون ذلك الأذى الذي أقدمت عليه قريش؟ تبّاً للكفر ما أقساه، وللضلال ما أشنعه، وتعساً لهؤلاء القوم الذين ضاعوا بين عبادة الأوثان، وسفاهة الأحلام!.
ولم تمرَّ حادثة ابن مسعود بلا أثر... فقد رأى فيها القرشيون ذريعةً جديدة للتملّق إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) واستمالته، ولذلك جاءه نفر من الأغنياء والمستكبرين يعرضون عليه أن يطرد الفقراءَ من أتباعه أمثال: عبد الله بن مسعود، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وعمار بن ياسر، وخباب بن الأرت، وغيرهم من الموالي والمستضعَفين، في مقابل أن يدخل زعماء قريش في الإسلام، أو على الأقل أن يجعل لهؤلاء الزعماء مجلساً غيرَ مجلس مواليهم وعبيدهم، لأنهم يأنفون من وجودهم قبالتهم، أو بجانبهم، ولا يرضون إلاّ أن يتميّزوا عنهم!...
أجل، هذا ما جاؤوا يعرضونه على رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وهو إثبات قاعدة التمايز الطبقي، أي بما يتناقض مع قاعدة من قواعد الإسلام الثابتة، وهي أنه لا فضل لغنيٍّ أو فقيرٍ، أو قوي، أو ضعيف، إلاَّ بالتقوى.. فما أغباهم! إنهم - إلى الآن - لم يدركوا أن تلك المظاهر التي يتمسكون بها لا تعبّر إلاَّ عن قيمٍ زائفةٍ أو زائلة.. وأن التفاضل بين الناس يكون بمدى الإخلاص لله تعالى وطاعته، وفي تقوى الإنسان، والعمل على تزكية نفسه وحسن التعامل مع الآخرين، وخدمة الجنس البشري، وفيما عدا هذه القيم الإنسانية وأمثالها التي ينادي بها الإسلام، فهو الهوى والسفَه والبطلان! ولذلك ردَّهم الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) خاسرين، خاسئين. وتنزَّل قول الحق الذي يدحض افتراء المستكبرين بقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاَءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ *} [الأنعَام: 53].
لقد كانت المفارقة في الأفكار والتوجهات واضحة وضوح الشمس في وسط النهار. فالمسلمون ضعيفهم وقويهم، فقيرهم وغنيهم - إلى آخر مثل هذه المفردات في القاموس البشري - هم أهل الله - عزَّ وجلَّ - وجنده، ما داموا على هُدىً من ربهم، مخلصين له الدين ولو كره المشركون.. أما هؤلاء المشركون فهم - في الحقيقة - أعداء الله لأنهم أعرضوا عن دينه القويم، ورفضوا دعوة رسوله الكريم، وذلك من أجل تعلقهم بأهداب الدنيا، واتخاذ كل ما يمتُّ إلى وجودهم بصلة، بمثابة سلعة للمتاجرة. ولو أنهم دخلوا في الدين الجديد لجعلوه سلعةً إضافية في سوق الدعوات، يبيعون منها ويشترون بما يتوافق مع استغلالهم للآخرين، ومع رغباتهم وشهواتهم. ولذلك فقد لفظهم الإسلام بتدبير العزيز الحكيم، لأن مشيئة الله الحق لا تجعل الخبيث يستوي والطيب، والخير يتساوى والشرّ، والنور يتماثل والظلام.
عروض جديدة من قريش على أبي طالب
وإزاء الواقع الذي تشهده قريش في مواصلة العمل للدعوة الإسلامية، والسعي إلى نشرها، رأت أن تلجأ إلى الأسلوب الذي جرّبته مع «محمد» من قبل ولم يُفلح، وهو التأثير، هذه المرة، على عمّه أبي طالب. فهم يرون بأنه الشيخ الحكيم، وأمْر بني قومه يعنيه أكثر مما يعنيهم، لأن لهم عليه حق رعاية مصالحهم وشؤونهم، مثلَ ما له عليهم حق الطاعة. وهو وإن أظهر الحماية لابن أخيه، إلاَّ أنه لا يهون عليه أن يتفرق الشمل، ويتضعضع الكيان!. ولذلك مشى إليه معظم رؤوس الشِّرْك، ومنهم عتبة وشيْبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، وأبو سفيان (صخر بن حرب بن أمية) وأبو البختري (العاص بن هشام) والأسود بن عبد المطلب بن أسد، وأبو جهل (عمرو بن هشام) والوليد بن المغيرة، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر، والعاص بن وائل السهمي، والمطعم بن عدي بن نوفل وغيرهم من ذوي النفوذ والمال في قريش.
وجاء هؤلاء في حشدٍ كبير إلى مجلس أبي طالب، ودخلوا عليه يعرضون شكواهم من ابن أخيه «محمد» قائلين:
- يا أبا طالب! إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا. ولقد عرضنا على ابن أخيك مالاً إن كان يريد المال، وجاهاً إن كان يسعى وراء الجاه، وملكاً علينا إذا كانت غايته الملك. وإننا والله ما زلنا عند عروضنا. وقد جئناك حتى تتدبَّر الأمر، وترفع هذه الظلامة عن آلهتنا، فلا يعيبها «محمدٌ» علينا، ولا يفرّق شملنا!..
لقد مشوا إليه، وهم يتوهمون أنهم سيثيرون فيه النخوة والحميّة على وحدة الكلمة، وعدم تفرقة الصف، وأنهم سوف يجعلونه يغيِّر رأيه، ويعيد النظر في مواقفه من ابن أخيه. أمّا ما يُبطنون من الحقد على «محمد» ودعوته، فهذا ما تخفي صدورهم، ولن يمكن لأبي طالب أن يعلمهُ!..
وعلى عكس ما كانوا يظنون، فإن نيّاتهم لم تكن لتخفى على شيخ البطحاء، ورجل الحكمة والموقف.. صحيح أنهم يبدون أمامَهُ نوعاً من الذلة والانكسار. وهم يسألونه أموراً عامة، ويعتبرون المسّ بها أمراً مُنكراً ومكروهاً، لأن حياتهم كلها تقوم عليها، إلاَّ أنهم - كما كان يقول أبو طالب في نفسه - من أشد الناس مكراً وخداعاً.. ولذلك رأى الرجل الحكيم أن الموقف دقيق وحسّاس، وأنه لا يجوز أن يصدهم بالشدة، كما لا يستطيع، ولا يقبل أبداً، أن يجاريهم في العداوة لابن أخيه، خصوصاً أنه على يقين بأن خصومتهم لرسول الله هي محض افتراء وتَجَنٍّ على الحق. من أجل ذلك آثر أبو طالب أن يقول لهم قولاً رقيقاً، وأن يردّهم رداً جميلاً، حتى عميت عليهم حقيقة الموقف، فخرجوا من بيته وهم يُسائلون بعضهم بعضاً: هل إن أبا طالب معنا وضد ابن أخيه، أم أنه ضدنا وهو على دين ابن أخيه؟!.
لقد تركوا أبا طالب وهم حيارى، لا يعرفون حقاً اتجاهاته وميولَه. ولكنَّ الشيء الوحيد الذي تأكد لهم، بعد هذا اللقاء، هو بقاء الرجل على حماية «محمد»، وإصراره على منعه من كل مكروه.. وهذا - في رأيهم - ما يزيد الأمور تعقيداً، ويجعل الحالة أكثر سوءاً.
أما من جهته، فقد ذهب أبو طالب إلى ابن أخيه، يباحثه في أمر القوم، وما يبدون من شكاية على أحوالهم، وما يعرضون عليه، مجدداً، من المال، والجاه، والسلطان، مقابل أن يتخلَّى عن دعوته، ويعيد لقريش وحدتَها، وسالِفَ عهدها من الاستقرار والأمان..
واستمع رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى قول عمّه. وتفكَّر في هذا الضلال الذي يُصرُّ عليه أولئك القوم، على الرغم ممّا بشَّرهم به من عزٍّ في الدنيا، وفوزٍ من الله تعالى في الآخرة إن هُمُ استجابوا لنداء الإيمان الذي يدعوهم إليه.. ولكن! ماذا بعد بيده إن هُمُ استحبوا الكفر على الإيمان، وأمعنوا في الغي والاستكبار؟.
ولذلك، وبأنفة النبي، وعزة الرسول، نظر محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى عمه أبي طالب نظرة الواثق المطمئن، وقال له:
»يا عمُّ، والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركتُه، حتى يُظهره الله، أو أهلك دونه»[*].
ذلك هو عزم رسول مبين!..
وتلك هي وقفة تاريخ مجيد!.
وكلاهما: العزم الرسولي، والوقفة التاريخية، ما كانا ليصدرا إلاَّ عن رسول الإسلام محمد بن عبد الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولاسيما في ظل تلك الظروف، وفي وسط تلك البيئة، التي كان يعيش فيها الرسول الأعظم.
إنه محمد المبعوث من ربِّ العزة والجلال لينفذ على التاريخ بآفاق الإيمان الرحبة، وليقدم للإنسانية معاني جديدة لم تعرفها عهود البشرية من قبل، إلاَّ في حدود تلك المعاني التي سبق بها النبيون والمرسَلون.. وهي، هي نفسها الآفاق، والمعاني، بل والقيم، والمثل، والأفكار التي تقوم على المنهج الرباني، وعلى الهدي الإلهي لبني الإنسان، منذ آدم (عليه السلام) وحتى آخر بشري على هذه الأرض.. لأنها تتناول حياة الإنسان في تركيب خلقه، وفي قوله، وفي عمله، وفي كل ما يتعلق بوجوده على هذه الأرض، بل وفي انسجامه مع الكون في انتظامه، حتى تكون له الطريق التي يعبر بها إلى الحياة الآخرة، وإلى ما ينتظره من حُسن المآب، وعظيم الجزاء.
إذن، فالإسلام يتوخَّى أولاً، وقبل كل شيء، الأخذ بيد الإنسان حتى ينتشله من كل ما يعيق فطرته السليمة، وتفتّح مداركه، وصحوة ضميره، وتطلّعه إلى عمارة الأرض، وإقامة العلاقات الصحيحة مع غيره في الأخوّة الإنسانية. ومتى أمكن لهذا المنهج أن يسود على مناهج الأرض، صار بمقدور الإنسان أن يطمئنَّ إلى رضوان الله - تبارك وتعالى - وأن يُعدَّ العدّة للحياة الأبدية..
ولذلك كان محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) حامل الرسالة الخاتمة التي توافق العقل البشري في آخر مراحل النضوج الفكري.
ولذلك كان محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) صانع التاريخ الإنساني الأكمل في تناوُله لحقيقة الإنسان وقيمة خلْقه.
ولذلك كان حريّاً بهذا المبعوث، وهذا الإنسان، أن يزدري تلك العروض التي تقدمها قريش، والتي تحسبُها هي على أساس ميزان الأرباح والخسائر، بينما لا شيء في حسبانه هو إلا السيرُ على هدى الله تعالى، والامتثال لأوامره ونواهيهِ. وحسبه أنه يتوكل على ربه في كل شأن، وعلى الله فليتوكل المتوكلون..
وعلى هذه الاعتبارات قال محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كلمته لعمّه أبي طالب.. وهي الكلمة التي أقسَمَ فيها بالله تعالى - وخصَّ الشمس باليمين لأنها الآية المبصرة، التي يتجلّى فيها النهار، وخصَّ القمر بالشمال لأنها الآية الممحوَّة التي يطغى عليها ظلام الليل - ليؤكد بهذا القسم الجليل إدراكه لحقائق هذا الكون الواسع الذي خلقه الله تعالى، وهو الخالق العظيم، والصانع المجيد، وليثبت أيضاً في روع الناس أنه يؤمن بحقيقة وجود الله تعالى، وأنه يدعو إلى عقيدة التوحيد التي وحدها كفيلة إن استقرت في القلوب، وفي العقول، أن تُقيل البشريةَ من عثراتها، وتوقظها من غفلتها وجهالتها، لتحملها من ثَمَّ إلى بَرِّ الإِيمان والأمان.
ولذلك اهتزَّ كيان أبي طالب، الشيخِ الوقور الجسور، لسماع كلام ابن أخيه وهو يرفض كلَّ متاع الدنيا ومغرياتها.. وأيقن أن معرفته السابقة به، لا تعدو كونها معرفةً جزئية، لم تلامس مزايا «محمد» الشخصية، وصفاته الذاتية، بل وإنَّ معايشته لابن أخيه - على شدة عمقها - بمثابة نقطةٍ في بحاره المليئة بالحق، والخير، والإيمان... فكان حقاً على كيانه أن يهتزَّ وأن تمتلكه القشعريرة في تلك اللحظات، التي ما أفاق من تأثيرها، إلاَّ ورأى نفسه قد اندفع يحتضن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى صدره، وهو يقول له:
»امضِ يا ابن أخي على أمْرك، فقل ما أحببت، فوالله لا أُسْلِمُكَ لشيءٍ أبداً»[*].
وخرج أبو طالب من عند ابن أخيه، والإيمان بدين الله تعالى، وبتصديق محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يملأ عقله وقلبه وكلَّ كيانه، فيعبِّر عن ذلك قائلاً:
واللّهِ لن يَصِلُوا إليكَ بِجَمْعِهِمْ
حتَّى أُوسَّدَ[*] في التُرابِ دَفينَا
فاذهبْ لأمرِكَ ما عليكَ غَضَاضَةٌ
أَبْشِرْ وقَرَّ بِذاكَ مِنْكَ عُيونَا
وَدعَوْتَني وعَلِمْتُ أَنَّكَ ناصِحي
فَلَقَدْ صَدَقْتَ وكُنْتَ قَبلُ أمينَا
وعَرَضْتَ دِيناً قد عرفْتُ بأنَّهُ
مِنْ خيرِ أَديانِ البَرِيَّةِ دِينَا [*]
فيا لإيمان أبي طالب الدفين في قلبه، يُعْلِنُهُ في هذه الساعة، ويدوِّنه على صفحات التاريخ عنواناً، ودليلاً على صدق دينٍ هو «من خير أديان البريّةِ دينا».
لقد عاهدَ أبو طالب رسولَ الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يحميه، ويذود عنه حتى يُوسَّد في التراب، ويُدفن تحت الثرى، وأنه سيظل على هذا العهد الثابت القاطع ولو تألبت عليه قوى البغي والشر كلُّها..
أما رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقد مضى على ما هو عليه في الدعوة إلى دين الله تعالى، بعد أن رفض كل عروض قريش المادية الزائلة، لا يبالي بالحماقات التي يتقوّلونها عليه، ولا بالعقبات التي يضعونها في طريقه.. ثمَّ شرى[*] الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذِكْر رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بينها، فتذامروا[*] فيه، وتواصوا بالكيد له.. ولكنهم لم يجدوا، بعد جولات من السفه عليه وعلى أتباعه، وبعد مداولات ومشاورات طويلة، إلاَّ العودة إلى أبي طالب من جديد، على أن يحملوا معهم هذه المرة ما يُغري شيخَهم، فيترك نصرة ابن أخيه.. فذهبوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة وكان أنهدَ فتى في قريش وأكثرَهم جمالاً، وأنطقَهم شعراً.. ودخلوا على أبي طالب، وقالوا له:
»يا أبا طالب! إنَّ هذا الفتى، أنهدُ فتى في قريش وأجمل، فَخُذْه، فلك عقلُهُ ونصْرُهُ، واتخذه وَلداً فهو لك، وأسلمْ إلينا ابن أخيك، هذا الذي خالف دينك، ودين آبائك، وفرَّق جماعة قومك، وسفَّهَ أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل»[*].
وعقلت[*] الدهشةُ لسانَ أبي طالب - إلى حين - وهو يسمع ما يعرضون عليه، فغاص في تفكيره وهو يسائل نفسه:
ما هذه الجهالة الجهلاء التي حلَّت برؤوس هؤلاء القوم؟! وأية حِطَّةٍ ومهانةٍ ملأت نفوسهم حتى بلغ بهم الصلَف إلى هذا الحدِّ الذي لا يقبله عاقل في الوجود؟! ثم من يظنون أبا طالب حتى جاؤوا يقايضونَه على محبته لابن أخيه بمحبة فتى غريب عنه؟! أو حتى يقايضوا بين يديه نبياً من الأنبياء ذوي العزم بشاعرٍ يهيم في كل واد؟! فأية مساومة رعناء، وأية مبادلة خاسرة جاء بها هؤلاء القوم؟! بل وهل يمكن مقايضة النبوّة التي هي تكليف من رب العرش العظيم لعبده ورسوله محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأي شيء مهما علا في المقام أو غلا في القيمة؟ فلِلّه درّهم، هؤلاء البغاة ما أجرأهم على الله ورسوله، وما أشدَّ ظلمهم على العقل والفطرةِ والدين!..
وبعد طول تفكيرٍ وتعجبٍ، رفع أبو طالب رأسه من إطراقه، والإِنكارُ بادٍ على قسمات وجهه، ليقول لهم:
»والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبداً»[*].
لقد ردَّهم شيخ الحكمة والرأي لا بغضب وانفعال، ولكن بمنطق غلب على كل منطقهم.
وخرجت تلك الجماعة، وظلَّ المطعم بن عدي (ابن نوفل بن عبد مناف بن قُصي) في مقعده، فقال لأبي طالب:
- لقد أنصفك قومك يا عم، وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً!
فقال له أبو طالب بحنقٍ وغضبٍ: إخرس أيها الوقح، قد ثكلتْك أمُّك. والله ما أنصفوني. ولكنك أنت قد شططت وزللت، وقد أجمعت على خذلاني، ومظاهرة القوم عليَّ. فاغرب عن وجهي - يا قبحك الله - واصنع ما بدا لك[*].
وشِعْرُ أبي طالب يملأ كُتبَ السيرة وهو يعرِّض بالمطعم بن عدي، وبمن خذله من بني عبد مناف، وبمن عاداه من عشائر قريش، على منْعِهِ رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وحمايتِهِ ومن ذلك قوله[*]:
ألا قُل لِعَمْرٍو والوليدِ ومطعمٍ
أَلا ليتَ حَظّي من حِياطَتِكُمْ بَكْرُ
أَخُصُّ خصوصاً عبدَ شمسٍ ونوفلاً
هما نَبَذانا مثلَ ما يُنبَذُ الجَمْرُ
هما أَغمزا[*] للقوم في أخويْهما
فقد أصبحا منهم أكفُّهُما صِفْرُ
هُما أَشْرَكا في المَجدِ مَنْ لا أَباً لَهُ
من الناسِ إلاّ أن يُرَسَّ[*] لَهُ ذكْرُ
وتَيْمٌ ومخزومٌ وزهرةُ منهُمُ
وكانوا لنا مولى إذا بُغي النَصْرُ
فوالله لا تنفكُّ منا عداوةٌ
وما منهُمُ ما كان من نَسْلِنا شَفْرُ[*]
فقد سُفِهَتْ أحلامُهُمْ وعُقولُهُمْ
وكانوا كَجَفْرٍ بِئْسَ ما صَنَعَتْ جَفْرُ[*]
لقد تمنّى أبو طالب أن يكونُ حظه منهم على قدر بكرٍ من الإبل لأنه أنفعُ من حياطتهم له.
ثم وصف تلك العداوة والبغضاء التي تتحكم في نفوس بطون قريشٍ كلها حسداً من بني هاشم، وبني المطلب، والتي لن تذهب ما بقي شَفرٌ (أحدٌ) من نسلهم.. ثم انطلق يسفه أحلامهم وعقولهم، لما أوصلهم إليه سوء التفكير...
... لقد أثقل محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في دعوته على قريش حتى أغرقها بالهموم، فراحت تبذل الجهود تلو الجهود، والمحاولات إثر المحاولات حتى تتخلّصَ من الورطة الشديدة التي هي فيها، فلم تفلح، فصار لا يستكين لها بال، ولا يهدأ لها أوار[*] وهي تُمنى بهزائم حقدها وضلالها. وكان أكثر ما يحيّرها موقف أبي طالب الذي يسدُّ عليها المنافذ كلما مشت إليه لتكلمه بشأن ابن أخيه. فماذا تصنَعُ، وهي ترى أن الكيل قد طفح مع هذا الشيخ، إلاَّ أن تأتيَ إليه من جديد، ولكن لتُظهر هذه المرة الغضب والشدة علَّ في هذا الأسلوب ما قد ينفع!..
ومن جديدٍ، جاء أولئك الظالمون أنفسهم لأبي طالب قائلين:
يا أبا طالب! إنَّ لك سنّاً وشرفاً ومنزلةً فينا. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تَنْهَهُ، وإنَّا والله لن نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وعيبِ آلهتنا، حتى تكفَّهُ عنا، أو ننازله وإياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين»[*].
إذن فقد أعلنوها حرباً سافرةً عليه وعلى ابن أخيه..
ولكن ما ظن هؤلاء القوم بالرجل؟
هل يعتقدون أن تهديدهم يخيفه، وهم يعرفون أنه شيخ البطحاء؟
وهل وعيدهم يثنيه عن نصرة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وهو على يقين بأنه يحمل دعوة الحق؟ إنه لن يتخلَّى عن هذا الرسول، وعن حمايته والذود عنه مهما كلفه الثمن غالياً.. لقد أخطأ عتاةُ قريش التقدير، وليفعلوا ما بدا لهم، فإنه ماضٍ على موقفه، مثلما أنَّ ابن أخيه ماض في دعوته. ولذلك جاءهم جواب أبي طالب صارماً بما يخذلهم وكأنّي به يقول لهم:
- قاتلكم الله من قوم قساة ظالمين. عرضتم عليَّ الشكاية وعرضتم عليَّ المساومة، وكانت عروضاً قبيحةً ما كنت لأستسيغ سماعها، أو لأقبل بمناقشتها لولا مصلحة القوم. وها أنتم قد أتيتم تهددونني بالقتال وتريدون إشعال نار الفتنة في قريشٍ. فلا والله لا أُعينكم على هذا أبداً، ولن أتوانى عن إخماد الفتنة التي بدأت تذرّ بقرْنها في العشائر، وأن أُهلك كلَّ من تُسوّل له نفسُه نشْر الكراهية في صفوف القوم، فاصنعوا ما بدا لكم.
لقد كان الموقف حرجاً ودقيقاً وخطيراً. ولكن أبا طالب عرف كيف يتخلص منه، إنما بثمنٍ غال بذله من قلبه ومن نفسه..
ولقد أحسَّ الشيخ بالعبء الكبير الذي يثقل كاهله.. ولذا نراه، بعد خروج القوم، يحمل همومَهُ على كتفيه، ويذهب بحثاً عن ابن أخيه، فعسى أن يجد لديه ما يُبعد الخطرَ الذي بدأت قريش تلوِّح به، ويوقف النزاع الذي تسعى إليه!..
ولقي أبو طالب النبيَّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في داره، فأخبره بما جاء به القوم من تهديد ووعيد، وما تبدي قريش من صلابة في مواقفها، وعنتٍ في آرائها التي قد تجرُّ إلى ما لا تُحمد عقباه، حتى وصل معه إلى أن يسأله الرأفة بحالِهِ وبِهِ، وهو يقول له:
«فأبقِ عليَّ وعلى نفسك يا ابن أخي، ولا تحمِّلني من الأمر ما لا أطيق»[*]!..
لقد أثَّر كلام الشيخ في النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فأطرق مفكراً، يقلّب الأمور على مختلف وجوهها:
فهؤلاء المشركون ذوو بأس وشدة، وهم لن يتورعوا عن إشعال الفتنة بين قريش، وإشهار القتال عليه وعلى أصحابه.. وبالمقابل فإن المسلمين ما زالوا قلائل، ضعافاً، ولن يستطيعوا مواجهة بطونِ قريش كلها في الحرب التي تعلنها..
ثم إن ربه (تعالى) لم يأذن له بعدُ بالقتال، لكي يُشهر في وجوههم السلاح نفسه الذي يحاولون الاعتداد به..
تلك الصورةُ بدت واضحةً للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بسواد ظلالها.. ولكن أيّاً تكن العواقب فإنه لن تكون مهادنةٌ مع قريش في الجهر بالحق، والعمل لأجل دين الله عز وجل..
إنما بقي أمر عمِّه!.. هذا الشيخ الذي تتراكم الهموم على كاهله، لما يُلاقي من عنتٍ بسبب وقوفه إلى جانبه، وحمايته له.. أجل! إن عمَّه بات ينوء تحت أعباء العنت القرشي، والاستكبار الجاهلي، وهو يدفع ثمن ذلك من نفسه وأعصابه، فماذا يقدر أن يصنع له في ظلِّ هذه الظروف الحرجة، المَقيتة؟ لا شيء، إلاّ أن يطيّب خاطره، ويكله إلى ربِّه، ثم ليتحمل هذا العم الصبور ما يمكن أن يتحمل من صلافة قبيلته، بل ومن جهل الناس، فإنها الضريبة التي يدفعها الرجال العظام - دائماً - في سبيل الحق الذي به يؤمنون.. ولذلك كان صريحاً مع عمّه، وأبدى له كلَّ ما يجول بخاطره، وأنه لن يهادن في محاربة الكفر والضلال، ولن يخلي الساحة لقريش أبداً. بل سيمضي في مسيرته إلى ما شاء الله ربُّه، وقدَّر له.
ولكن ماذا على أبي طالب أن يفعل، وهو يدرك أن تهديد قريش لا يمكن أن يُحمل إلاَّ على محمل الجد والتحدي؟. وهل عليه، حيالَ هذا الواقع الأليم، الذي أوصَلَهُ إليه استكبار بني قومه، إلاَّ التحرك السريع؟.
لقد حَزَب[*] الأمر - هذه المرة - أبا طالب، فما وجَدَ أمامه إلاَّ اللجوء إلى العشيرة، فهي في النهاية الملاذُ الأخير في بيئةٍ قاسيةٍ، جاهلةٍ، همُّها الأوحد أن تنال حظوتها من الدنيا، ثم يأتي بعد ذلك كل شيء، متراخياً في الزمن، متفاوتاً في المقاصد...
وبَعَثَ أبو طالب مَنْ يطوفُ على عشيرته الأقربين من بني هاشم والمطلب، يدعوهم للاجتماع، فجاؤوه في الغداة ملبّين، ولم يتخلف منهم إلا نفر قليل، وفيهم المسلمون والمشركون، لأنهم جميعاً على حد سواء في تقديرهم لشيخهم، وكبير الشرف فيهم. ووقف أبو طالب يُعلن على ملئهم عزمَ قريشٍ على قتاله، وقتال محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ويبيّن لهم الأخطار التي قد تترتب على ذلك، وأنه ما دعاهم إليه إلاّ ليقرروا بأنفسهم ماذا يفعلون.. وظلّ أبو طالب يبيّن لهم ما آلت إليه الأحوال حتى قال لهم:
- فوالله، يا أهلي وعشيرتي، ما جاء محمدٌ إلا بالحق من ربِّه. وقد قالَ بالأمس قول الفصل بألاَّ يترك أمر ربِّهِ تعالى أو يهلك دونه، فما تقولون به، وهل تمنعونَهُ من قريشٍ، وتذودون عنه بما لِيَ ولَهُ عليكم من حق؟!
فأجابوه برأي واحد قاطعٍ: والله يا شيخ البطحاء لا نعملُ إلاَّ بما قطعت.. ولسوف ترانا عدوّاً لمن عاداه، وحرباً على من حاربَهُ، نذبُّ عنه بالأفئدة والنفوس قبل المال والسلاح، ونحميه ونمنعُهُ قبل الولد والعيال..
لقد لبّى بنو هاشم، وبنو المطلب - الذين حضروا - نداءَ شيخهم أبي طالب، وعاهدوه على الوفاء له وللنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، إلاَّ واحداً أبى إلاَّ الخروجَ على إجماع العشيرة، وأعلنَ بُغضَهُ وعداوتَه لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) . وما كان هذا الخارجُ إلا أبا لهب - طبعاً - على الرغم من أنه العمُّ القوي الذي كان يمكن أن يعضد دعوة ابن أخيه رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، والأخُ الذي كان يمكن أن يستقوي به أخوه أبو طالب في ندائه لعشيرته الأقربين.. ولكنه - ويا للعار - كان منذ البدء، ألدَّ الأعداء، فلم يكن غريباً منه أن يقف ضد رأيهم جميعاً، ضارباً بأواصر القربى عرْض الحائط، ومُمعناً في ظلمه لنفسه، إذ ما كاد يرى تلك الاستجابةَ المشرّفةَ من ذويه، حتى هبَّ مغاضِباً، وخرج شاتماً كلَّ من تسوّل له نفسه نصرة «محمد»، أو الوقوف بجانبه!..
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢