نبذة عن حياة الكاتب
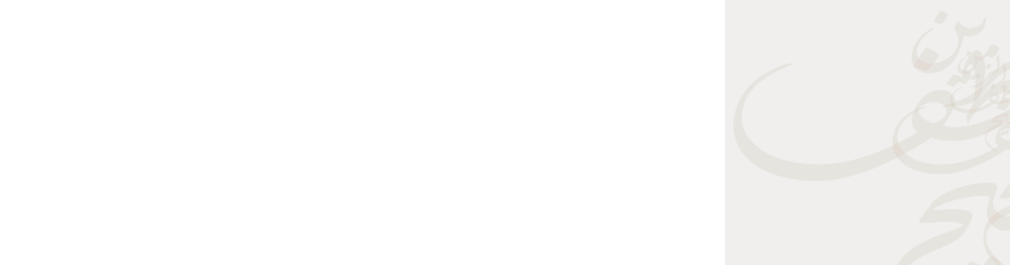
X
خَاتَمُ النَّبييِّن مُحَمَّد (ص) - الجزء الأول
ظهُور الإسلام في مكّة - البحث الأول: بعْث محمد (ص) بالنُّبُوة والرّسالة
مراتب الوحي
قسَّم بعض الفقهاء مراتب الوحي إلى سبع، وإن كانت كل مرتبة قد تتداخل مع الأخرى، بحيث لا يمكن الفصل التام بين بعضها بعضاً..
المرتبة الأولى: الرؤيا الصادقة
والرؤيا تكون في النوم. ولكنها تحدُث وتقع صادقة في اليقظة، ويراها صاحبها في الواقع تماماً كما رآها في المنام.. وأول ما نزَلَ الوحي على النبيِّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان بالرؤيا الصادقة، وذلك عندما رأى روح القدس جبريل (عليه السلام) عياناً، وهو يدعوه للقراءة:
{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ *} [العَلق: 1]..
والرؤيا الصادقة قد توجب أحياناً التكليف، مثل الذي أراه الله سبحانه للخليل إبراهيم (عليه السلام) في قصة الذبح والفداء..
المرتبة الثانية: النفث في الرُّوع[*]
كان الوحيُ يأتي الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بما كان يُلقيه جبرائيلُ (عليه السلام) في روعه وقلبه. بدليل قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «إنَّ روح القدس نفثَ في روْعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتَّقوا الله وأجملوا في الطلب»[*].
وفي هذه المرتبة كان التكليف من الله سبحانه لروح القدس جبرائيل (عليه السلام) أن يلقي في نفس محمد وفي قلبه وعقله ما يريد أن يوحي به لرسوله الكريم. فيكون جبرائيل الوسيطَ لإِلهام «محمد» بأمرٍ من الله عزَّ وجلَّ.
المرتبة الثالثة: المخاطبة وجاهة
والمخاطبةُ هنا هي مخاطبة الملك جبرائيل للرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وجاهة حين كان يتمثل له رجلاً. فيظهر أمين الوحي جبريل (عليه السلام) على النبي محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بصورة رجل بهي الطلعة، يجلس إليه ويلقِّنه ما أُنزل به من الوحي، فيعيه بقلبه وعقله.
والمعروف عنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنه قال: كان جبرائيل (عليه السلام) يأتيني بصورة دحية الكلبي (وهو رجل جميل كانت صورته محبَّبة إليه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ).
المرتبة الرابعة: الاتحاد في الروح
لقد كان جبرائيل (عليه السلام) - وهو الروح الأمين - يختلط بالنبي ويمازج نفسه، فيتّحدان مع بعضهما.. ثم ينقل الملكُ الوحيَ مخاطباً به نفس محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فتأتي المخاطبة قوية شديدة الوقع، ذات تأثير عجيب، بحيث تجعل النبيَّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لشدَّتها يتصبَّب عرقاً، ولو في البرد القارس، فيثقل جسمه، حتى ليكاد أن يرضّ عظم اليد أو الفخذ إذا توكّأ عليها وهو على تلك الحالة..
المرتبة الخامسة: نزول جبرائيل على صورته الحقيقية
كان جبرائيل (عليه السلام) ينزل بالوحي في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. فيبلغ الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ما شاء أن يوحيَه الله تعالى إليه.. كما جاء في سورة النجم، مصداقاً لقوله تعالى:
{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى *مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى *وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى *} [النّجْم: 1-5].
المرتبة السادسة: التلقّي المباشر
في هذه المرتبة حصل الوحي مباشرة من الله تعالى، ليلة العروج برسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) . إذ كان التلقِّي عن الله تعالى، من دون أي وسيط، كما في تكليمه موسى (عليه السلام) وفقاً لقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا *} [النِّسَاء: 164]...
المرتبة السابعة: الوحي من وراء حجاب
في هذه المرتبة كان الله تعالى يكلِّم رسوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من وراء حجاب، وبصورةٍ مباشرة أيضاً، وبدون وسيط. وقد حدث ذلك للرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ليلة الإِسراء والمعراج - كما سنرى - وهذه المرتبة كان قد اختُصَّ بها من قَبلُ موسى (عليه السلام) كليمُ الله، وقد تأيدت بنصِّ القرآن الكريم..
وفي الحقيقة إن هذا التقسيم لمراتب الوحي لا يتعدَّى كونه نوعاً من التوضيح الذي يقرِّب للأذهان الطرق التي كان يتلقى فيها محمد بن عبد الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) رسالة الإِسلام من الله تعالى إلى الناس كافة. وهي لا تعدو كونها مراتبَ روحية حتى ولو رأى الرسولُ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) جبرائيل (عليه السلام) على حقيقته وعلى الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، لأن جبرائيل نفسه مخلوق روحاني. ولا يمكن للإِنسان العاديِّ أن يدرك هذه المراتب باعتبارها جوهراً روحيّاً، بل يمكن له تصورها فقط، كما لا يمكن لإِنسانٍ أن يعرفها إلاَّ إذا عايشها، أمثالُ المصطَفَين الأخيار من رُسُل الله - جلّ وعلا ـ.
وما دامت تلك المراتب ذات جوهر روحي، فإنها تكون متداخلة بعضها ببعض، كما في المرتبتين السادسة والسابعة، أو في المرتبتين الثالثة والخامسة. والتي لخَّصها القرآن الكريم بقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ *} [الشّورى: 51].
نزول الوحي
كان محمد قد بلغ الأربعين سنة.. وقد ذهب منذ أن أطلَّ شهر رمضان، كعادته إلى غار حراء للتعبد والتحنّث. وقضى الشهر حتى كاد يبلغ أواخره. وفيما هو نائم في غاره ليلة السابع والعشرين منه[*] إذا به يرى في المنام مَلَكاً يقول له:
إقرأ!
قال محمد: وما أقرأ وأنا لست بقارىء؟!
قال الملك: اقرأ هذا القرآن الذي أتنزل به إليك من ربك الأكرم، بقول الله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ *خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ *اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكَرَمُ *الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ *عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ *} [العَلق: 1-5].
وتلاها محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وقد نقشت في قلبه.. فانصرف عنه الملك.
وكانت هي بداية الوحي، وبعث محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نبيّاً، ورسولاً من رب العالمين إلى الناس أجمعين.. وقد تلقى محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الوحي عن ربه بنفس صافية، وقلب مطمئن. فمِن قبْل كان ربُّه تعالى يرصده، ويربيه التربية الصالحة، ويُعدّه الإعداد التام بحيث يستطيع أن يكون في مستوى الحدث العظيم الذي ينتظره. وبسبب هذا الإعداد الإلهي كان الوحي، وكان التلقي.
أجل كان التلقي باطمئنانٍ كامل «لأن الله - تعالى - إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار فكان الذي يأتيه من قبل الله - جلَّ وعلا - مثل الذي يراه بعينه»[*]. ثم إن ما يزيد في اطمئنان محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) اليقين الثابت الذي زرعه الله تعالى في قلبه وهو: «أن الله - تبارك وتعالى - لا يوحي إلى رسوله إلاَّ بالبراهين النيرة، والآيات البينة، الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هو من عند الله تعالى، فلا يحتاج إلى شيء سواها»[*].
وقد تنزَّل الملكُ بالآيات المبينة التي تهدي محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لقراءة القرآن باسم ربه تعالى الذي خلق الإنسان وعلَّمه ما لم يعلم، كما في هذا التعليم الرباني الذي كان به ابتداء الوحي على النبيّ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .
وإذا كان أمر النبوة عظيماً، وعبئها ثقيلاً، والجبلة البشرية ضعيفة، فإن محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قد أفاق من نومه وفي نفسه ثقل العبء العظيم، وخصوصاً أنه لا يرى أمامه الملك الذي استقرأه، ولا أحداً غيره.. أفاق وخرج من الغار فإذا المكان كله، كما يعهده من الصفاء، والسكون، والصمت الرهيب. ولمّا لم يجد أحداً نزل يريد العودة إلى مكة. حتى إذا صار وسط الجبل إذا بصوت كأنه قصف الرعد، يشق عنان السماء وهو يستوقفه ويقول له: «يا محمد! أنت رسول الله، وأنا جبريل»[*].
فأي ملك هذا الذي يسمعه ويراه؟ إنه على صورة قد سدَّ بها الخافقين[*]، فلا ينظر في أية ناحية في الآفاق الشاسعة من السماء إلاَّ ويراه فيها.. بل إنه يتطلع إليه فإذا هي الصورة نفسها المحببة إليه، التي رآها في المنام عندما أمَرَه أن يقرأ باسم ربه الخالق الكريم، العظيم. وثبت في مكانه لا يتقدم، ولا يتأخر، وجبرائيل الملك على حاله في آفاق السماء حتى انصرف عنه.. وغرق محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، وهو في وقوفه، في بحار التفكير.. ولكنه قلَّب الأمر على مختلف وجوهه فكان لا يأتيه إلاَّ الجواب القاطع: إنه الحق.. إنه الوحي من الله تعالى يتنزل به جبرائيل الأمين، فلا يتلقاه في رؤياه الصادقة في المنام وحسب، بل وجهراً، وفي اليقظة.. وإنه الوحي الذي يحمل التبليغ بالنبوة والرسالة.. فهو إذن العهد إليه من الله تعالى ببعثه نبياً ورسولاً..
ومثل هذا العهد من شأنه أن يثير في المعهود إليه كوامن الخوف من العبء الثقيل الذي تدركه نفسه فور تلقيه التبليغ. وقد يزيد في هذه المخاوف - بعض الشيء - صورة الملك الذي يحمل الوحي، وهو يتمثل أمامه بصورة بشري يسدُّ آفاق السماء، مما لا يترك مجالاً للنفس - حتى ولو كانت نفس محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) - إلاَّ أن تستشعر حقاً ببعض الخوف من هول ما ترى. ومن قبل فقد خاف موسى (عليه السلام) عندما أمره ربه تعالى أن يلقي عصاه، فلما ألقاها ورآها حيةً تسعى أوجس خيفة منها، فقال له ربه تعالى: {خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُوْلَى *} [طه: 21]!
فالخوف هو من كوامن الضعف البشري، لأنه مظهر من مظاهر غريزة حب البقاء، ولا يخاف عادة إلاَّ من يدرك النتائج والعواقب التي تترتب على أمر معين، فكيف إذا كان الأمر عظيماً، من الرب العظيم؟.
ولكنَّ تلك المخاوف التي أحسَّها محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في تلك اللحظات، سرعان ما قابلها في نفسه شعور بالاطمئنان إلى ربه، وشعور بالرضى من الخالق الكريم وهو يحمّله العهد الذي لا ينتدب إليه إلاَّ أنبياءه ورسله المخلصين. ومثل هذه المشاعر السامية من شأنها أن تريح النفس من أعباء الخوف، ومن أية أعباء أخرى، مهما كان ثقلها عظيماً.
ومشى محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في طريق العودة إلى مكة والوحيُ يلفُّ كيانَهُ. ودخل على أهلِهِ مسروراً، مؤمناً، ولكنه متعب الجسم، منهوك القوى، لا يرغب في تلك الساعة بشيء أكثر من الركون إلى الراحة، والنوم في سباتٍ عميق، فطلب إلى زوجِهِ خديجة الطاهرة أن تهيّىء له فراشه، وتغطّيه جيداً وهو يقول لها: «زمّلوني، زمّلوني».
وأسرعت زوجُهُ الفاضلة تلبّي أمرَهُ. ثم جلست إليه، كعادتها بعد رجوعه من عبادته تسألُهُ عن حاله، فأخبرها بنزول الوحي عليه، وبعثه من الله تعالى نبياً ورسولاً، وكيف أتاه جبريل الأمين في المنام أولاً، وكيف رآه جهرة وعلى تلك الصورة العظيمة التي تسد ما بين الأرض والسماء، وما نقل إليه عن ربه تبارك وتعالى من آيات كريمة، ومن تبليغ بأنه رسول الله.
وشعرت خديجة بنفس الاطمئنان الوجداني الذي كان يملأ كيان زوجها. لقد أنصتت إليه بكل جوارحها، فما زادها الأمر إلاَّ إيماناً وتصديقاً، فرنت إليه بنظرة ملؤها الحب والثقة، وهي تقول: «أبشر يا ابن عمّ، واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبيَّ هذه الأمة! والله لا يُخزيك الله تعالى أبداً. إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحملُ الكلَّ، وتُقري الضيف، وتُعين على نوائب الدهر».
وما لبث محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعد أن أفضى لزوجه بمكنون صدره أن أخلد للنوم مرتاحاً.
ولكن أية راحةٍ بعد اليوم؟ فلئن نامَ في هذه الساعة - كما يدفعنا إليه استباق الأحداث - فإن يقظة الحياة الحرَّة الكريمة كلها متعلقِّة به، وآمالها معقودة عليه، فإنه رسول الله إلى الناس كافة، مسترشدين بالتنزيل الإلهي بأن الله تعالى قد أرسل محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) {بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ *} [التّوبَة: 33]، وأنه تعالى أرسله بشيراً ونذيراً للناس كافة بقوله العزيز: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ *} [سَبَإ: 28].
وما الهدى ودين الحق إلاَّ هذا الوحي الذي بدأت بشائره منذ يوم بعث محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ليتلقاه قرآناً عربياً جامعاً لحقائق الوجود كلها، وفرقاناً بين الحق والباطل لقوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا *} [الفُرقان: 1]، أجل لينذر به العالمين حتى يعرفوا الحق ويتبعوه، ويعرفوا الباطل ويزهقوه..
فما محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) - منذ هذا اليوم المبارك - إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل. وليس أحدٌ أكفأ منه للنبوة والرسالة، فكيف إذا كان خاتم النبيين، وحامل آخر الرسالات السماوية إلى أهل الأرض - كل الأرض - كما ظهرت حقيقته (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فيما بعد؟ أجل، ليس أحدٌ أكفأ منه لذلك كله، وتاريخ حياته صفحات ناصعة مجيدة تفيض بالمآثر والعظائم التي كرَّست قدرة الإنسان وقيمته في ذاته، ومكرمته عند ربه، وعلى أساس الاعتبار الوحيد: الإيمان والتقوى مصداقاً لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحُجرَات: 13].
فحياة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هي حياة الإنسان الذي أكرمه ربُّهُ، ومنَّ عليه بالمحبة، والرعاية والإعداد. وإننا نختار، للدلالة والتبيان فقط، ثلاثاً من الصفات التي منَّ بها الله تعالى على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في حياته، وهي كفيلة بذاتها، أن تشدَّ كل ذي بصيرة ومنصفٍ إلى التأمل وإدراك ما أرادَ الله تعالى من خلْقِ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وهديه: فقد وجَدَهُ ربُّه - تبارك وتعالى - يتيماً فآواه، ووجده ضالاًّ فهداهُ، ووجده عائلاً فأغناه.
إذن، فالمنّة الأولى كانت من الله تبارك وتعالى عندما كان يتيماً فآواه.. فقد رأينا من قبلُ، أن الله تعالى توفَّى أباه وهو ما يزال جنيناً في رَحِمِ أمه، ثم ماتت هذه الأم وهو في السادسة من عمره، ولكنَّ ربَّه - عز وجلَّ - وهو يصنَع له مصيره، قد هيأ له القلوب الكبيرة التي تحبه، والأحضان الدافئة التي تحتضنه، والنفوس الكريمة التي تربيه وترعاه، فلا يكون طفلاً مشرداً، هائماً على وجهه، يقف على الأعتاب متلمساً من يعطيه ما يسدّ به رمق جوعه، أو يكسو عُريه، فينشأ عاجزاً عن تدبّر نفسه، فاقد الأمل والرجاء في حياة كريمة.. فظروف الحياة إجمالاً قاسية على اليتيم، ولولا المشاعر الإنسانية التي عرفت حقيقة اليتم وفداحة أضراره على اليتيم لما كانت تلك المؤسسات الإنسانية التي آلت على نفسها رعاية اليتامى، لكي تؤهلهم للحياة.. ولعلَّهُ بفضل مثل هذه الرعاية، برز في تاريخ البشرية أفذاذ كبار كانوا يتامى، في الصغر، وأعطوا الحياة الإنسانية ما لم يعطها غيرهم في الكبر..
ولو عدنا إلى البيئة التي عاش فيها محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لوجدناها قاسيةً، جافةً من المشاعر التي تحنو على اليتيم وترعاه. فالاعتبار الأول في تلك البيئة كان للقوة والسيف، وللقبلية والعشائرية، يحكمها الصراع على البقاء، والأنانية الحادّة، بعيداً عن اعتبارات الرأفة باليتيم والشريد، والحدب على الفقير والمسكين، إلاَّ من بعض القلوب العطوفة، والنفوس الخيرة.
ولكنَّ محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يعرف ذلَّ اليتم، ولا قهر البيئة، وذلك بفضل جده عبد المطلب، ومن بعده عمه أبي طالب. وقد عاش في كنَف كل منهما عزيزاً مكرَّماً، وأحبَّه كل منهما حبَّ الأب لابنه، بل وكانت له مكانة تميّزه حتى عن أبنائهما إن في الحب، أو في المعاملة، أو في الرعاية.. وهذا هو فضل الله تعالى على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عندما هيّأ له تلك القلوب الرؤوفة الرحومة التي تصونه، وترفع من شأنه، فتبعد عنه أي شعور باليتم.
فصدق الله تعالى بقوله الكريم: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى *} [الضّحى: 6].
والمنة الثانية[*] من الله - عز وجل - على «محمد» عندما وجده عائلاً فأغناه، فقد هيّأ له كافة الأسباب التي حوَّلت فقره إلى غنى.
لقد كان «محمد» فقيراً حقاً، إذ توفي أبوه ولم يخلّف له من المال إلاَّ ناقة، وجارية (هي أم أيمن الحبشية). ولم تُتَحْ له الظروف المناسبة لكسب المال الوفير والغنى، لأن مزاولته للتجارة كانت في حدود ضيقة داخل مكة، فظل في صباه وشبابه فقيراً على الرغم من سعيه الدائب إلى العمل والكدح. ويقيّض الله تعالى له الأسباب التي تبدّل فقرهُ إلى غنًى من خلال تعاطي تجارة زوجه، وإدارة أموالها.
وهنا تكمن الرعاية الإلهية، فقد شاء سبحانه وتعالى أن يربي «محمداً» ويعلّمه معاني الفقر، ثم ينقله إلى حالة الغنى في الوقت المقدّر له لئلا يبقى مشغولاً بهموم الحياة المادية التي تواجهه، كما تواجه كل إنسان غيره، فتصرفه عن التأمل والتفكير، وتحول بينه وبين الاستعداد للأمور الجسام التي ستكون مدار اهتماماته وانشغالاته في مقبل أيامه.
إنها الحياة وأعباؤها المادية.. ولو التفت كل منّا إلى واقع حياته، ووجد نفسه لا يملك شيئاً مما يدفع عنه غائلة الجوع والفقر والمرض، فكيف يجد الحياة من حوله؟ كثيرون عاشوا هذه التجربة، فانحرف منهم من انحرف، وشذَّ من شذَّ، حتى بات عالة على المجتمع.. ولكن بالمقابل فإنَّ هناك من تحلّى بالصبر على شظف العيش ومرارة الحرمان، وتمكنوا من أن يشقوا طريقهم لبلوغ النجاح رغم كل الصعوبات والعثرات.. وهؤلاء هم العصاميون حقاً الذين توكلوا على الله تعالى أولاً، ثم انبروا إلى الكفاح والكدح في الحياة فكانت رعاية الله تعالى لهم، لأنه تبارك وتعالى مع العبد، ما دام العبد مع ربه، ومع نفسه التي يوجهها لصالح الأعمال.. فبرز هؤلاء العصاميون أفذاذاً في المجتمعات التي عاشوا فيها.
وإن في مسار حياة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كلها ما يبيّن لنا أنه كان بذاته وبصفاته الشخصية عصامياً فوق العصاميين، وفذاً فوق الأفذاذ. ومن أجل هذه المزايا الذاتية كان إعداده (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في علم الله تعالى السابق، على النحو الذي لا يجعل الفقر يرهقُهُ، ويشغله عن الأمور العظام، إذ وجَدَه عائلاً، شديد الفقر، فأفاض عليه من نعمائه، ومنَّ عليه بجوده وكرمه فأغناه بالمال الوفير، والرزق الكريم. فسبحان الله الذي أجزل العطاء لمحمد بن عبد الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، ونقله من العول إلى الغنى كما يثبته قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى *} [الضّحى: 8].
وأما المنة الثالثة على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فهي أن الله - عز وجل - قد وجده ضالاًّ فهداه.. وهذه أهم المنن على الإطلاق في حياته الشريفة، لأن فيها الهدى إلى دين الله الحق، وإلى الصراط المستقيم.
فقد نشأ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في بيئةٍ جاهليةٍ اختلطت فيها المعتقدات والعادات والأعراف ببعضها حتى شكلت تلك الذهنية الخاصة للعربي في صحرائه.. ولشد ما كان يؤلمه ضلال قريش والعرب جميعاً، ولشدَّ ما كان يأخذه العجب من هذا الاضطراب في المفاهيم، وهذا الاختلاف في التصورات بين اليهود والنصارى.. كل ذلك قادَه في تفكيره وتأمله، ومن خلال انقطاعه عن الناس وانصرافه إلى خلواته، إلى البحث عن المنهج السوي الذي يجب أن تكون عليه حياة الناس، بدلاً من الضلال والفرقة والجاهلية التي كانوا عليها..
وما يمكن التأكيد عليه «هو أنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان مؤمناً، موحداً، يعبد الله، ويلتزم بما ثبت له أنه شرع الله تعالى مما هو من دين الحنيفية شريعة إبراهيم (عليه السلام)، وبما يؤدي إليه عقله الفطري السليم، وأنه كان مؤيداً ومسدداً، وأنه كان أفضل الخلق وأكملهم خَلْقاً، وخلُقاً وعقلاً»[*]، ويؤيد هذا الاتجاه، باهتداء محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى دين الحنيفية قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النِّسَاء: 125]. وقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [آل عِمرَان: 95].
وإنه لمن الثابت في السيرة النبوية الشريفة أن سيدنا محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يتعبَّد قطّ للأصنام، بل على العكس فقد عافت نفسه العبادة الوثنية التي يمارسها أبناء قومه، ونفر طبعه من عاداتهم الجاهلية وهم يقدسون الأوثان والتماثيل.. ومن أجل ذلك كان الله تعالى يُعِدُّهُ منذ صغره وهو يودع فيه نفساً صافية، وعقلاً سليماً، وفطرة سوية، ويزيّنه بالفضائل التي كانت تجتمع فيه على النحو الأكمل والأفضل. ومن أجل ذلك أيضاً كان توجُّهه إلى التحنث والتعبّد في غار حراء، وفي أفضل الشهور، وأفضل الأيام عند الله تعالى.. وإذا كان لجهد محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الشخصي في ذلك كله اعتبارُهُ وقيمته، إلاَّ أن تسديد الله تعالى له كان الأقوى والأجدى. وها هي النعمة الفيَّاضة تتنزل عليه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وتقوده إلى الحق، وإلى الصراط المستقيم، فلا تبقى نفسُهُ حائرة بين شرع إبراهيم، أو موسى أو عيسى (عليه السلام)، وهي الحيرة التي كانت تقربه من الاهتداء إلى الدين الأكمل، والشرع الأحسن.
نعم لا جدال بأن نفسَ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كانت تتقلَّب بين كثير من الاعتبارات والقيم والمثل السامية الرفيعة، ولكن الأصالة الكامنة في أعماق نفسه كانت تتوق إلى ما هو أعظم شأناً، وأعلى درجة، وأكمل معنى، إلى الدين الذي ارتضاه الله - تعالى - لعباده، وإلى الشرعة والمنهاج اللذين تقوم عليهما حياة الناس.. ولذلك فقد كان هدى الله - عز وجل - لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في نهاية المطاف، وعلى النحو الذي شاءه سبحانَه وتعالى وقدَّره له، وهو ما عناه قوله عز وجل: {وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى *} [الضّحى: 7].
يا محمد! أنت رسولُ الله، وأنا جبريل.
هذه هي الكلمات الوجيزة والمعبّرة التي خاطب بها الملك جبرائيل (عليه السلام) محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وجهاً لوجه، وبيقظة تامة، لا بالرؤيا في المنام. وكان القصد منها أن يثبتَ في عقله، ويُقرَّ في نفسه أنه هو من اختاره الله تعالى، ربُّ الكون كله، من دون الخلق جميعاً، ليحمل الأمانة الكبرى التي يكلفه بها، فتكون دعوتُه هدىً للناس، ورحمةً للعالمين..
وقد رأينا أنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعدما أتاه الوحي ذهب إلى أهله مسروراً، مستبشراً مطمئناً، إلاَّ أن قَطْع مسافة حوالي ثلاثةِ أميالٍ في مسالك وعرة، وهولَ الرؤية لأول مرة للملك جبرائيل (عليه السلام) قد أتعبَاهُ، فطلب أن يدثروه لينام..
ولكن السيدة خديجة لم تهدأ، ولم تسكن، بل ظلت تدور من حول زوجها - بعد هدأته في فراشه - في جذلٍ[*] لم تذق طعمه من قبل، وقد أيقنت أن زوجها هو نبي الله، ورسوله. ولكن أليس هذا الأمر حدثاً عظيماً، في بيتها الزوجي؟ وهل يمكنها أن تبقى ساكنةً من دون أن تعرضَ هذا النبأ العظيم على إنسانٍ عالم، يستطيع أن يحيطها بأخبار النبوّة، وما يترتب عليها من الأعباء الثقيلة، خصوصاً أن زوجها قد بُعث للقضاء على عبادة الأوثان، والدعوة للدخول في دين الله الجديد؟ وهل يمكن أن تقبل قريش بهذه الدعوة وفيها رجال يغلب على طباعهم الحسد والصلافة معاً، ولا يقبلون بأن يكون محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، أو غيره أعلى منهم مكانة، وأسمى مقاماً، وأعزَّ شأناً؟!..
ورأت الزوجة الوفية أن تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فهو على النصرانية، وقد بلغ سن الكهولة ونضوج الفكر، وعنده من علم الكتاب ما ليس عند غيره من قريش... فلعلَّ ورقة يوجهها إلى ما يجب عليها أن تعمل تجاه زوجها، وما يتناسب مع جو النبوة، بجلالها وقدرها.
وانطلقت السيدة المخلصة إلى حيث يقيم ابن عمها ورقة، وأخبرته بالوحي الذي أنزل على زوجها محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ..
وتفكَّر ورقة بن نوفل بما أخبرته به السيدة خديجة.... ولكي يتأكد من صفات النبي الذي أطلَّ زمانه، قام إلى بطون الكتب يبحث فيها عن هذا النبأ العظيم الذي كانت بشاراته معروفة لدى أهل العلم.. وبعد البحث المضني - وبخاصة لمن هو في مثل سنه - جلس يلتقط أنفاسه، ثم توجّهَ إلى خديجة قائلاً: «والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني بما أخبرتِني يا خديجة فقد جاء الناموس[*] الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبيُّ هذه الأمة، فقولي له: فليثبت»[*].
لقد كان ورقة بن نوفل وهو على دين النصرانية، على اطلاع واسع بالديانة التوراتية لأنه - كما قيل - قد نقل كثيراً عن التوراة إلى اللغة العربية وهو يعلم ما في التوراة والإنجيل من خبر النبي الأمي العربي: وقد وعى صفات هذا النبي، بل وعرف اسمه بالذات. وكلّ ذلك لا ينطبق إلا على محمد بن عبد الله، ولذلك قال لزوجه خديجة أنه «نبي هذه الأمة»..
أي - والله - لقد قال ورقة قول الحق، ولكنه لم يدرك الحقيقة كلها.. فالله تبارك وتعالى لم يبعث محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نبياً ورسولاً لأمةٍ، ولا لشعبٍ معيّن بالذات، بل بعثه وأرسله لجميع الشعوب، ولجميع الأمم في مشارق الأرض ومغاربها، للناس كافة، وليس لأمة واحدة كما قال العالم ورقة بن نوفل. وهذا ما صححه له التاريخ، ولغيره من أهل الكتاب من الباحثين والعلماء والفقهاء. فقد ثبت، وما يزال الحق ثابتاً وقائماً، بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله للناس كافة. وشهد الله من عليائه، وشهدت ملائكته، وشهد المؤمنون الصادقون هذه الحقيقة الناصعة وهي أن محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ما كان إلاَّ بشيراً ونذيراً للعالمين...
ولم يكن ذهاب خديجة بسبب القلق على زوجها، كما قالت به روايات كثيرة.. فهي لم يخامر قلبها الشكّ يوماً بما يقوله محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لأنها على يقين بأنه لا يقول إلا الصدق، ولا ينطق إلا بالحق..
وقد أشرنا إلى بعض دوافع السيدة خديجة في ذهابها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وأولها كان حرصها على عدم التقصير بحق زوجها، وخوفها عليه من قريش. بل لعلَّ هذا الخوف كان وراء هواجسها كلها، لأن الدعوة التي سوف يحملها زوجها ستثير حفيظة المشركين، وتؤلِّبهم على عداوته، مما قد يجعل حياته في خطر. وهذا وحده يفرض عليها - هي بالذات - أن تكون مستعدة لاتخاذ الحيطة والحذر حتى تذبَّ[*] عن النبي، وتدفع عن الرسول الأذى... إنها خديجة، وهي تريد أن تكون على مستوى الأحداث التي ترافق النبأ العظيم، فلجأت إلى ابن عمها علّه ينير لها الطريق في مواجهة كافة الاحتمالات التي قد تقع.. ولكن ورقة بن نوفل اقتصر همُّه على شيء واحد، وهو التأكيد لزوجة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأنه نبي هذه الأمة، وأن عليه أن يثبت في مواجهة الصعاب الكبيرة التي سوف تعترضه في حمل دعوته..
وعادت السيدة خديجة إلى بيتها، فرأت زوجها ما زال في نومه مطمئناً.. فآثرت الركون والسكون، ونفسها تمتلىء اعتزازاً، وهي تنظر إلى هذا الزوج الذي حباه الله تعالى بأعظم النِّعم، وأجلِّها على الإطلاق.
وطلع اليوم التالي على مبعث رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فرأى أنه ما زال بحاجة إلى النوم والراحة. وإنَّ من حقه أن يأخذ قسطه الوافي من النوم، وقد أمضى ليالي رمضان الطوال في غار حراء ساهراً متعبداً. وإنَّ من حق بدنه عليه أن يذوق طعم الراحة بعد تعب تلك الليالي، ومن ثقل أهم حدث يواجهه في حياته..
وجلست زوجه الطاهرة تتأمله وترقبه بلهفة، وهو يتدثر بغطائه. لكنها تراه الآن قد ثقل تنفسه، والعرق يبلل جبينَه، ثم رأته يفتح عينيه وهو مصغٍ منجذب لا يتطلّع إلاَّ إلى فوق، وكأنه في عالم غير هذا العالم الأرضيّ، وفي دنيا غير هذه الحياة الدنيا.
وأحسَّت وهي تنظر إليه على هذه الحالة كأن قوةً خفية تشل حركتها، وتعقدُ لسانَها، فتظل ثابتة حيث هي بلا حراك.. تدرك وتعي أن أمراً عظيماً يستغرق كل كيانِ زوجها، ولكنها لا تعرف ما هو هذا الأمر، ولا تقدر على فعل شيء حياله، أو القيام بأي شيء يمكنُها معه استيعاب ما يجري.
نفحاتٌ من الإعداد الإلهي لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)
وأخيراً يرتاح النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فينظر إليها بابتسامة هانئة راضية، فتشعر أنها تحلَّلت من القيود التي كانت تكبِّل حركتها، فتُقبل عليه قلقةً، خائفة، ولكنهُ يطمئنها أنه بخير، وأن عبء الوحي وهو يتنزل عليه ثقيل، إذ أتاه جبرائيل الأمين (عليه السلام) بالأمر الجلل، وهو قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ *قُمْ فَأَنْذِرْ *وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ *وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ *} [المدَّثِّر: 1-7].
وتستمع السيدة خديجة إلى التلاوة المباركة، فيصرخ بها دافع الإيمان، وقد ملأ قلبها وعقلها، فتنطق بشهادة الحق وهي تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله».
إنها الطاهرة الصدوقة. وقد تجلّى صدقها المتأصِّل في أعماقها، منذ أن واكبت سيدنا محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في حياته. أما الآن فيتجلَّى أيضاً إيمانها النابع من أعماق نفسها الصافية، وفطرتها السليمة، فتعلن هذا الإيمان بالشهادة الحقة، التي تعني حقاً وصدقاً: التصديق بأن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وبأن محمداً عبده ورسوله، وحاملُ أمانته إلى خلقه وعباده.
وكان على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يصدع لأمر ربه تعالى: «قم فأنذر»..
أجل، قُمْ يا محمد لتبدأ النذير العام للبشرية، ولتباشر دعوة الناس بألاّ يعبدوا إلا الله الذي لا إله إلا هو إلهاً واحداً في السماوات والأرض، وأن يطيعوه ويقدّسوه لأنه هو - جلّ وعلا - خالقهم، ومالك أمورهم، فلا شرك في عبادته، ولا عذر في معصيته، وإلاَّ.. فإن الحساب في الآخرة لآتٍ، وويل لمن كفر، أو أشرك بربه، أو عصاه، فإن عذاب السعير بانتظاره.
ثم على قدر هذا العبء الكبير، كان التوجيه الرباني:
{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *} [المدَّثِّر: 3].
وحده سبحانه الكبير المتعال، وكل شيء ما خلا الله تعالى صغير وباطل.. فعلى الرسول مهما لاقى في دعوته من القوى المعادية ومن الصعاب والعقبات أن يستصغرها، وهو يستحضر هذا الشعور بأن ربَّهُ هو الكبير، وأنه مهما كبرت العظائم فالله أكبر. إذن فالأمر فوق التصوّر البشري المحدود، لأنه يتناول خلق السماوات والأرض، ويجعل كلَّ ما فيها في قبضة الله تعالى الكبير، يتصرف بها كيفما يشاء، وعلى النحو الذي يشاء.. ولذلك يوجِّه سبحانه وتعالى رسولهُ إلى هذه الحقيقة، ويزوِّده بهذه القوة، التي يواجِهُ بها الناسَ في دعوته، بل وفي كل أمرٍ يُقْدِمُ عليه، فيجعل شعاره في رسالته الشعار إيّاه الذي يقوم عليه الوجود كله وهو: الله أكبر، ولا إله إلا الله..
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *} [المدَّثِّر: 4].
والطهارة لا تعني فقط طهارة الثياب والبدن مع أهمية ذلك في المناعة (الوقاية) من الأمراض التي ثبت أن سبب معظم الأمراض كالحمى والإنفلونزا والطاعون، كما في {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *} [المدَّثِّر: 4] طهارة للقلب واللسان والعقيدة.. إنها الطهارة الكاملة التي تتناسب مع التلقّي من الملأ الأعلى.. فالرسولُ هو الداعية إلى البشرية كي تتخلص من تلوث عقيدة الكفر والشرك، ومن الشوائب والأدران التي تدنس حياتها. والطهارة الكاملة في نفس الداعي، وفي بدنه، بل وحتى في ثيابه ضرورية كي تبعد الملوَّثين عن تلوثهم، والمدنّسين عن دنسهم.
ولذلك كان التلقي مقروناً منذ بدء الوحي بأداء فريضة الصلاة التي تستوجب الطهارة.. إذ لما نزل التكليف بأن ينذر الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الناسَ، كانت الدعوة إلى دين الله تعالى، مصحوبة بالعبادة، فلا دين من غير عبادة، ولا عبادة من غير صلاة.. فكان فرض الصلاة، وكان فرض الطهور أي الوضوء[*]. وهو التكامل التعبديّ الذي يشتمل عليه قول الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *} [المدَّثِّر: 4] وقد فرضت الصلاة ركعتين في أول البعثة المحمدية. وكانت تقام مرتين في الصباح وفي المساء، وذلك بدليل قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ *} [غَافر: 55].
أما الصلوات الخمس فقد فرضت بعد الإسراء، فصارت أربع ركعات في صلوات: الظهر والعصر والعشاء، وثلاث ركعات في صلاة المغرب، وظلت ركعتين في صلاة الصبح، على نحو ما هو ثابت ومعول به عند المسلمين، وهم يؤدون صلواتهم وفقاً للسنة النبوية الشريفة، وما أمر به عندما قال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «صلوا كما رأيتموني أصلّي».
ومنذ ذلك الحين بدأ رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالصلاة مع أهله، أي منذ ذلك اليوم الذي تنزَّل عليه الوحي ودعاه ربُّهُ تعالى إلى نفض دثاره، والقيام لينذر الناس بأن يتركوا الوثنية والكفر وأن يعبدوا الله سبحانه وحده، بلا أنداد، ولا شركاء.
{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *} [المدَّثِّر: 5].
والرجز معناه الشرك..
ويقال في اللغة: هجَرَه يهجره هَجْراً وهجراناً: ضد وصَلَهُ[*].
فيكون معنى التوجيه الإلهي أن على رسول الله محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يقاتل الشرك، ويصرمَهُ من حياة الناس بحيث تتقطع أوصاله في النفوس... والرجز والقذارة والإيمان والنظافة ضدان متناقضان، ولا يمكن للإنسان إلاَّ أن يسلك طريق أحدهما دون الآخر، فلا تلاقي بينهما، ولا تقارب.. والأساس في دعوة التوحيد: محاربة الشرك والقضاء عليه، فلا يبقى له أثر لا في القلوب، ولا في العقول، ولا يكون بعد ذلك للبشرية، أن تحتجَّ بأي شيء على الله سبحانه وتعالى، فقد بعث لها رسولهُ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالهدى ودين الحق، وما عليها إلاَّ أن تهجر جميع معتقداتها السابقة، وتتَّبع دعوة هذا النبي الرسول بقطع كل صلة لها مع الشرك وتركه إلى الأبد. وهذا معنى قوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *} [المدَّثِّر: 5] أي حارب الشرك واقطع وجوده، حتى يثبت دين التوحيد.
أما هو (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقد حفظه الله تعالى من رجس الوثنية، فلم يثبت على الإطلاق أنه انحنى لصنم، أو أقام شعيرة عند وثنٍ. وإن سيرة حياته الشريفة كلها تنبىء بذلك، ويؤكدها قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم، ولم يدنسني بدنس الجاهلية»[*].
{وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ *} [المدَّثِّر: 6].
أي لا تعطِ عطيّةً تلتمس بها أكثر منها وأفضل، لأن الكريم يستقلّ دائماً ما يعطي وإن كان كثيراً. والسرّ في ما ينهى الله تعالى رسولهُ عنه هنا هو أن يكون العطاءُ خالياً من انتظار العوض تعففاً وكمالاً، فهو سبحانه وتعالى قد أمر عباده بثلاثة: العمل {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التّوبَة: 105] والسعي {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [المُلك: 15] والدعاء {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غَافر: 60] أما القبول فهو من شأنه سبحانه وتعالى، وعطاء الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من صلب العمل والسعي والدعاء.. لأن الدعوة هي في الأصل عطاءٌ من الله - تعالى - المعطي، فيجب أن تتناسب معها حياة الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأن تقوم على العطاء، وبلا منّةٍ، ولذا كان التلازم بين العطاءين مؤدياً إلى الكمال في الرسالة.
{وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ *} [المدَّثِّر: 7].
وهو الصبر الذي يوجه الله - تعالى - رسولهُ إليه عند كل تكليف من تكاليف هذه الدعوة الشاملة.. فأمام حاملها معركة شاقة، متعددة الجوانب والاتجاهات، ويكفي منها المعركة مع شهوات النفوس، وأهواء القلوب، والأطماع والنوازع المادية التي تغري الناس وتفتنهم. ثم هنالك المعركة مع الأعداء الذين سيقفون بوجه هذه الدعوة ومحاربتها بلا هوادة.. وكل ذلك يتطلب الزاد الضروريَّ وهو الصبر على المواجهة، والصبر على البلاء، والصبر على الاحتمال..
فالتكليف منذ البدء شاق، وصعب جداً لأنه سوف يتناول معالجة الناس من داخل نفوسهم، كما سوف يعالج أمور حياتهم من الخارج، وهذا في جوهر التكليف بالرسالة الخاتمة لتبيان كل شيء، ومن ثَمَّ لمواجهة كل شيء ومعالجته.
دعوة ذوي القربى
هكذا كان التوجيه الرباني للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : اليقين بأنه - سبحانه - الكبير المتعال، والطهارة، وقطع دابر الرجز، والعطاء بلا منة ولا استكثار، والصبر والاحتمال... ويبقى المباشرة بالإنذار..وهكذا تلقاه النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الذي كان عليه أن يبدأه، ويباشره في أول النذير العام للبشرية. ولئن كان عليه أن يُعِدَّ العدة لكي يبدأ الدعوة بين الناس، إلاَّ أن أهل بيته أوْلى بالإسلام، والإسلام أوْلى بهم. فقد أسلمت زوجه خديجة (رضي اللّه عنها) بقناعتها وعفويتها الصادقة، فكان لهؤلاء الذين يعيشون في كنفه، والذين لهم مكانة خاصة في نفسه، حقهم بأن يكونوا قبل كل الناس السبّاقين إلى فضل الله تعالى، والإيمان به، وعبادته. وما على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلاَّ أن يباشر دعوته في مهبط الوحي، في داخل البيت النبوي، قبل أن ينصرف إلى مبادأة الآخرين بطرح الدعوة عليهم..
إسلام علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)
وكان علي يعيش - كما تقدم - في كنف محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، منذ أن كفله وهو صغير، فقام هو وزوجته خديجة على تربيته التربية الحكيمة الرشيدة، فنشأ في تلك البيئة الصالحة التي يتزوّد منها بمكارم الأخلاق، وفضائل العادات وصالح الأعمال. وكان عليٌّ بذاته قد حباه الله تعالى ذهناً متوقداً، وذكاء متوهجاً، وصفاءً في النفس ومتانةً في العود. هذا فضلاً عن المكرمة التي تكرَّم الله تعالى بها عليه، عندما قاد سبحانه خطوات أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف (وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي) إلى البيت الحرام فولدته في جوف الكعبة، يوم الجمعة في الثالث عشر من شهر رجب، وقبل بعث محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعشر سنوات.. وهذا ما جعل له تلك المكانة المميزة في نفس ابن عمه محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وفي نفس أهل مكة جميعاً، لما كان للكعبة من قدسية عند العرب.
وفوق تلك النِّعم التي أفاضها الله تعالى على علي بن أبي طالب، كان فضله تعالى أعظم عندما منَّ عليه بالإسلام في مهبط الوحي بالذات.. فقد أجلسه رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى جانبه وأخذ يخبره بما بعثَهُ الله تعالى به من الدين الحق، وهو يتلو عليه من الآيات البيّنات التي يتنزَّل بها جبرائيل الأمين، مما جعل قلب علي يطمئن بالإيمان، فيصدِّق الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ويؤمن به، فينطق بشهادة الحق: «أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله».
وطابت نفس النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بإيمان هذا الصبي، ابن العاشرة، كما طابت نفسه من قبله بإسلام زوجته الوفية، فعمد إلى تزويدهما بالتعاليم الإسلامية، المتعلقة بأحكام الصلاة، وطريقة الوضوء والطهارة، فصارا يصليان معه في البيت الصلاة المفروضة، وكانت ما تزال ركعتين في الصباح وركعتين في المساء - كما تقدم بيانه ـ.
وشاء النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ألاَّ يكون إسلام علي في غفلةٍ عن أبيه، لاسيما أنه عمّهُ، وكفيله في صغره، وحبيبه، وسيد الأبطح، فطلب إليه أن يذهب ويخبر والده أبا طالب بالأمر. فوقف علي أمام الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وأجابه بما لم يخطر على بال أحد أن يجيب به صبيٌّ في مثل سنه، وقال: «لقد خلقني الله يا رسول الله من غير أن يشاور أبا طالب، فما حاجتي أنا إلى مشاورته لأعبد الله ربي. وإن هذا الدين الذي تدعوني إليه هو دينُهُ الذي ارتضاه لنا نحن عبادهُ، فعليَّ أن أتّبع دين الله من غير أن أشاور أحداً من الناس»!.
ألا إنها نعمة الرضى التي أنعم بها تعالى على عباده الصالحين. وقد أفاض سبحانه من عليائه على نفس عليٍّ ما جعل قلبَهُ الفتيّ يعمر بالإيمان حتى يكون «أول ذكر من الناس آمن برسول الله وصلَّى معه، وصدق بما جاءه من الله تعالى وهو يومئذٍ ابنُ عشر سنين»[*].
إسلام زيد بن حارثة
وكان زيد بن حارثة يعيش هو الآخر في بيت محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قبل البعثة. وكان قدره أن يخطفه فرسان من بني القين بن جسر، وهو ابن ثمانية أعوام، ويبيعوه رقيقاً، كما كان يجري في أيام الجاهلية، إلى أن انتهى أمره إلى سوقٍ للنِخاسة في الشام. فاشتراه حكيم بن حزام مع عبيدٍ آخرين، وحملهم معه إلى مكة. فباعه من السيدة خديجة بنت خويلد فلما تزوجت وهبته لزوجها.. وبخلقه المحمدي لم يبقِ عليه رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مولى، بل أعتقه وتبنّاه، فصار يدعى زيد بن محمد..
وكان أبوه حارثة بن شرحبيل الكلبي لا ينفك عن البحث حتى يعرف خبرَ ولدِهِ، فلمّا أُخبِرَ به وعرف بوجوده، جاءَ وعمّهُ كعبٌ بيت «محمد» فدخلا عليه، فقالا: «يا ابن عبد المطلب (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يا ابن سيد قومه! أنتم أهل حرم الله، تفكّون العاني[*] وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا عندك، فامنن علينا به، وأحسن في فدائه». قال: ما ذاك؟ قالوا: زيدٌ ولدنا... وما كان لمحمدٍ أن يتوانى فدعا إليه زيداً، وخيَّره بين البقاء أو الرحيل مع أبيه، ولكنَّ زيداً رفض أن يترك هذا الإنسان الذي أكرمه، وآثر أن يبقى في الكنف الطاهر الذي لم يُشْعِره بالعبودية وذلِّها منذ أن دخله وعاش بين ظهراني أهله، ولذلك قال من فوره: «ما أنا بالذي يختار عليك أحداً، أنت مني بمكانة الأب والعم»..
واستغرب حارثة موقف ابنه، فقال له: زيد يا بنيّ! أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك وأهلِكَ؟!
فأجهش زيد بالبكاء، وقال لأبيه: ومن قال إني عبدٌ في هذا البيت؟ والله ما جعلني «محمدٌ» عبداً، بل كنت عزيزاً، موفورَ الكرامة عنده وعند أهله الطيبين الطاهرين، بل ولقد دعاني إليه، فصرت ابناً له، فكيف يتفق ذلك وما تتهمني به من العبودية عنده، فوالله ما أنا بالذي يفارقه أبداً.
ولم يجد حارثة بن شرحبيل وسيلة ليقنع ابنَهُ زيداً بالعدول عن رأيه، فتركه، وانصرف عنه وهو يدعو له بالخير والبركة، فلما رأى النبيُّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ذلك أخرجه إلى الحجر ونادى في الناس: اعلموا بأن زيداً ابني، يرثني وأرثُهُ، فدعي زيد بن محمد، حتى نزل الحكم الإلهي في التبنّي.. وهكذا تابع زيدٌ حياته النبيلة، ورأى آثار النبوّة تسطع في البيت المحمدي، الذي أحسن مثواه وتنشئته، فأقبل على دين الله عندما دعاه الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى الإسلام، راغباً، مختاراً سعيداً، ليعيش في ظلال الوحي مؤمناً، صادقاً، يصلّي، ويتعبّد لله العزيز الحكيم وظلَّ على هذا التبنّي حتى نزلت الآيات القرآنية التي تمنع التبني في الإسلام، - وذلك في المدينة المنورة - بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزَاب: 5]. عندها ومنذ أن تنزَّل هذا الأمرُ من الله تعالى، لم يعد زيد ابناً لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، بل عاد يُدعى باسم أبيه.. زيد بن حارثة.
وقد شَرُفَ زيد بإسلامه وإيمانه، أكثر من تشرّفِهِ بنسبه العربي الأصلي، كما لم يَعُد الرقّ يشوّهُهُ منذ أن أعتقَهُ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ورعاه في بيته، وقد زوَّجَهُ رسول الله حاضنتَهُ أمَّ أيمن فولدت له أسامة، وكان يكنَّى به - وبعدها زوّجه من زينب بنت جحش - ولسوف يأتي - إن شاء الله - البحث في حكم التبنّي، وزواج زيدٍ من زينب.
إسلام أم أيمن
وكان لا بد أن يتوالى إيمان أهل البيت النبوي الواحد تلو الآخر.
فهذه أم أيمن التي كانت جارية حبشية من قبْل، قد منَّ الله تعالى عليها برحمته، فجعلها ترافق محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) منذ أول يوم أطلَّ فيه على هذه الحياة - باستثناء مرحلة رضاعه في ديار بني سعد - وتظل إلى جانبه أينما حلّ.. فكانت تنتقل معه من كنفٍ إلى كنفٍ حتى تزوج السيدة خديجة (رضي اللّه عنها) وجاء (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأم أيمن معه إلى بيته الجديد، لتكون إنسانةً حرَّة، شريفة، بعد أن نفض عنها غبار العبودية، وأكرمها بجواره حتى صارت عنده بمثابة الأم.
وقد آمنت هذه الإنسانة الوفية برسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وصدَّقته منذ أن صدع بالرسالة، فكانت من خيرة النساء الأوائل اللواتي دخلن في الإسلام، بل وكانت أول امرأة بعد السيدة خديجة آمنت وشهدت شهادة الحق. وقد عاشت في كنف النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تتأدَّب بآداب الإسلام، وتتلّقى معانيه الحقّة الخيّرة على يديه الشريفتين.
إسلام بنات محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)
ويتتابع الفيض الإلهي على بيت رسوله محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .. فتأتي بناته زينب ورقية وأم كلثوم لزيارة الأهل، ويكون اللقاء الميمون بين الأبوين وبناتهما، فتتلقى كل واحدة الدعوة من أبيها للدخول في دين الله، فتقبل على الإسلام، وتشهد بشهادة التوحيد، وهي راضية فخورة بهذا الأب العظيم الذي منَّ الله تعالى عليه بالنبوّة والرسالة، وبهذه الأم التي تفضَّل عليها خالقها وبارئها لتكون أول الناس إسلاماً وإيماناً.. ويغمرُ البِشْرُ وجه النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ويأنس بإيمان بناته، فيطلب إلى زوجه أن تعلِّمهنّ الصلاة والوضوء، فتسارع الأم إلى تلقين بناتها الآيات التي تتلى في الصلاة، والأصول الواجبة التي يقوم بها المسلم في طهارته ووضوئه، حتى أُشبعت نفوس هؤلاء البنات بالإيمان الصادق. فارتاح الجميع، وجلسْنَ حول النبي (عليه السلام) يشكرْنَ الله تعالى على نعمته الجزيلة، وفضله السنيّ. وقد خيمت السعادة على أجواء هذا البيت الشريف، الذي يستظل بظل الله تعالى، ويتفيّأ بوارف رحمته، وجلال عظمته وقدسيته.
وهكذا كانت بنات محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يترددن على بيت أهلهنَّ للتزود بمفاهيم الإسلام، وفي كل مرة يحل فيها موعد ذهابهن، توصي الأم الرؤوم ابنتيها رقية وأم كلثوم أن تكتما إسلامهما عن زوجيهما عتبة (زوج رقية) وعتيبة (زوج أم كلثوم) ابنيْ عمهما أبي لهب، وأن تنتظرا أمرَ الله تعالى حتى يجد لهما مخرجاً.. أما قلق الأم فمردُّه الخوف من عائلة أبي لهب جميعاً - وليس من ابنيه فقط - التي لن تقبل بإسلامهما، وقد تعمد تلك العائلة إلى أذيتهما، والنيل من كرامتهما.. أما ابنتها زينب فلا خوف من زوجها العاص بن الربيع، فهو ابن أختها هالة بنت خويلد، وأمه تحبها حباً شديداً، فلا يمكن أن تدع له المجال لكي يؤذي ابنة أختها، أو أن يلومها على عملٍ ارتضاه لها أبواها. ومع ذلك كله فقد آثرت السيدة خديجة أن تبقي ابنتها زينبُ إسلامها سراً، حتى يُعلن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) دعوته للناس.
وبعد أن اطمأن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى إسلام أهل بيته، كان عليه أن يباشر دعوته بين الناس للدخول في الإسلام. وليس أفضل من رحاب الكعبة لهذا الأمر الخطير، فلعلَّ ما للبيت الحرام من قدسية في النفوس، يساعده على تصديق الناس له والإيمان بما يدعو إليه.. لذلك صار النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقضي معظم أوقاته بجوار الكعبة للاجتماع إلى الناس - كعادته التي ألفوه عليها - والاستماع إلى همومهم وتشكّيهم من الأوضاع التي يعيشونها، لأن الغالبية كانوا يشتكون من قساوة الظروف، وشظف العيش في تلك البيئة الظالمة..
والتقى النبيُّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عند الكعبة - أعزَّها الله - ورقة بن نوفل، وكان قد صار شيخاً هرماً، ضعيفاً، فجلس يتحدث إليه بما بعثهُ الله تعالى به من الدين القيم، دين التوحيد والتعبّد لله الواحد الأحد، الذي لا شريك له ولا ولد.. وكان ورقة يصغي للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بلهفةٍ، ثم ما كان منه إلاَّ أن أمسك برأسه الشريف يقبّله، وهو يقول له: «والذي نفس ورقة بيده إنك لنبي هذه الأمة، لقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى. ولتُكذَّبَنَّ، ولتُؤذَيَنَّ ولتُخْرَجَنَّ، ولتُقَاتَلَنَّ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنَّ الله نصراً يعلمه».
ولم يكن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يترك جوار الكعبة، إلاَّ في الأوقات التي يذهب فيها إلى شعاب مكة، حيث كان يقضي كل يوم فترةً يخصِّصُها للصلاة والدعاء إلى ربه تعالى أن يعينه على تبليغ الدعوة والقيام بحق الرسالة.. وكان في ترداده إلى الكعبة الشريفة يتحيّن الفرصة التي يُتاح له فيها أن يفاتِحَ الناس بما بعثَهُ الله تعالى به. حتى حانت الفرصة وذلك عندما رأى النقاش محتدماً بين نفرٍ من قريش، وهم يحلفون باللات والعزى على عادة القوم يومئذٍ، فما كان منه إلاَّ أن تقدم ينحي باللائمة عليهم، وينهاهم عن الحلف بأصنام جامدة لا تنفع ولا تضر، ويبيّن لهم أن الحلف الحقَّ إنما يكون بالله العلي العظيم الذي تقوم له السماوات والأرض، والذي - سبحانه - وحده الإله الحق، وما دونه الكفر والباطل.
وكانت الصدمة شديدة على عقول أولئك النفر. صحيح أنهم لم يَرَوْا «محمداً» يعبد الأصنام من قبل، أما أن يعترض، ويمنع عليهم الحلَفَ بمعبوداتهم، فهذا طعن ليس بدينهم، بل وبدين الآباء والأجداد، وفي ذلك ما فيه من العجب منه!.. بل وكان أشدّ وأقوى ما أخذهم من العجب أنهم لم يعيبوا على «محمد» شيئاً من قبل في حياته قطُّ، فهو الصادق الأمين بين الناس، وهو المثال في القول والعمل بين القوم، فما باله اليومَ يدعوهم إلى ترك آلهتهم وعبادة الله وحده؟!.. إنه لأمر محيّر فعلاً، ولا يدرون له تفسيراً.. ومع ذلك فإن أحداً لم يجرؤ على تكذيبه، أو الردّ عليه، بل آثروا الانسحاب وتركوه وحده دونما أدنى جدال أو نقاش.
أما النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فلم يستغرب هذا الإعراض عنه، فقد كان يعلم أن الجاهلية قد جعلت قلوب الناس قاسية غليظة، وأن عبيد الوثنية، هؤلاء وغيرهم، قد ألفوا ما كان يعبد آباؤهم، فصار من العسير أن يتخلوا عن معتقداتهم البالية، الخرقاء.. فكانوا هم ومَنْ وقف موقفهم، وتصدَّى لمحاربة الدعوة فيما بعد، ممن صدق فيهم قول الله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ *} [الزّخرُف: 23].
وكانت تلك الحادثة أولَ خطوةٍ على هذا الدرب الطويل الذي سوف يسير عليه لنبيُّ الإسلام، والذي سوف يُلاقي في سلوكه كلّ عَنَتٍ وجهالة من الناس. فقد قام بعد تلك المحاولة الأولى بمحاولات عديدة مماثلة، إلاَّ أنه لم يلقَ خلالها إلا الإعراض نفسه، والنفور عينه، دونما استجابة من أحد، أو اهتمام بما يبديه ويصرِّح به.. وهذا ما أثار في نفسه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الألم والحزن، وجعله يهفو إلى لقاء الروح الأمين جبرائيل (عليه السلام)، لعلَّ في لقائه ما يؤنس قلبَهُ، ويفتح أمامَهُ السبلَ التي من شأنها أن تزيح الغشاوة عن عقول هؤلاء القوم، وتمزّق الغُلُفَ عن قلوبهم.
ولكن الوحيَ تأخَّر عليه، وهذا ما زاد في غمه وقلقه.. فرأى أن خيرَ ما يُعينُهُ على تأخر الوحي قد يكون في الذهاب إلى جبل النور، فهناك وفي داخل الغار يجد الأنس لقلبه، والطمأنينة لنفسه، لأنه المكان المبارك الذي اعتادَ فيه الاتصال بربه (تعالى) في تعبّده وتحنُّثه قبل بعثه، وهو المكان نفسه الذي رأى فيه جبرائيل (عليه السلام) لأول مرة، فصار منذ ذلك الحين يشتاق إليه، ويحنُّ إلى لقائه.. ولو كان الأمر بيده لاستعجله، واستكثر مما يأتي به من آيات الله البيِّنات.
وبمثل هذا التوجه كان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يصعد إلى جبل النور، ويدخل غار حراء متعبداً، داعياً منيباً، عسى أن يعاوده الوحي.. وكانت المرارة تزيد في نفسه يوماً بعد يوم، إذ إنه فوق تأخّر الوحي كان المشركون قد بدأوا يتقوَّلون عليه أقاويل شتى، وكلها كذب وافتراء، ولا تنمُّ إلاَّ عن الاستهزاء والسخرية منه. فقد اتهموه في بادىء الأمر بأن عوارض تصيبه من الجنون، ثم لمّا تأخر الوحيُ عنه، صاروا يقولون: «أرأيتم محمد بن عبد الله.. لقد تركه ربه وقلاه»!. أجل لقد اتخذوا من قول محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأنه نبيّ ورسولٌ من عند الله الواحد، مادةً للهزء به، فراحت أَلسنة السوء تلوك سمعته وتحاول النيل منه. وقد انقلبت صورته بين ليلة وضحاها من محمد الصادق الأمين إلى رجل عادي لا يستأهل الجلوس معه، والتحدث إليه.. فكانت تلك الفترة حرجة جداً عليه، وزادت في ضيقه. ولكنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم ييأس، ولم يقنط من رحمة الله تعالى، بل ظل على عهده مع ربه، قائماً على عبادته، والدعاء إليه عزّ وجلّ، حتى مرت خمسة عشر يوماً فإذا الهموم تنزاح عن نفسه، ويأتيه الفرج الذي ينتظره عندما عاوده الوحي الذي يحمل إليه الأدلة والبراهين على حب الله تعالى له وذلك بقوله المجيد:
{وَالضُّحَى *وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى *مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى *وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى *وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى *أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى *وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى *وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى *فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ *وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ *وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ *} [الضّحى: 1-11].
فما أعظم هذه الألطاف الإلهية وهي تتنزل على قلب سيدنا محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وكلها إيناس وطمأنة لقلبه. فالله سبحانه وتعالى يُقسم بأنه لم ينسَ رسولهُ محمداً، ولم يتركه، أو يتخلَّ عنه.. وقَسَمُهُ - عز وجلَّ - كان توكيداً بينه هو - سبحانه - وبين عبده محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على مقدار الصلة الجليلة التي تربط محمداً بربِّه، وهي صلة العبودية القائمة على الصفاء، والصدق واليقين الحق، ولذلك كان قسمُ المولى سبحانه وتعالى بأصفى طرفين من النهار والليل وأشفّهما:
بالضُحى حين ينتشر النور وتنبعث حركة الحياة على أحد طرفي الكرة الأرضية، وما في هذه الحركة من نفع وخير للعباد، وبالليل الساجي الذي يرقّ ويصفو، ويغطي على الطرف الآخر من المعمورة بالهدوء والسكون، فيرتاح العبادُ من المعاناة التي ترهقهم طوال بياض النهار وضوئه.
أجل، بهذين الوقتين الرائقين الموحيين يُقسم الله - عز وجل - بأن ربَّك يا محمد ما تركك، وما جفاك، فأنت عبده المخلص، وهو يرعاك، ويكفلك ويحبك.. ومهما كانت النِّعم التي تفضل عليك بها في هذه الحياة الأولى، فإنَّ ما سوف يجزيك به من الأجر والثواب والمكرمة لأكثرُ وأعظمُ في الآخرة. ولا شك في أن الآخرة خير لك من الأولى، إنما سوف تكون راضياً مرضياً في الحالين، فاطمئن إلى رضى ربك تعالى، وحبه لك.
أما ما يتقوَّلُهُ المشركون فهو مجرد ترّهات وسفاهات، لن تحطَّ من دينك وكرامتك شيئاً، فأنت حبيبُ ربك المصطفى، ونبيّهُ المجتبى. وإنّ في حياتك كلها من الأدلة والشواهد ما يثبت حبَّ الله تعالى ورعايته لك: ألم يجدك يتيماً فآواك في القلب المحبِّ، والكنف الكريم؟ ووجدك حائراً في البحث عن الدين الحق وشرعته فهداك إليه؟ ووجدك فقيراً محتاجاً إلى معونة ربك فأغناك؟
فهل بعدُ أجلُّ وأعظم من هذه الفضائل الربانية وهي تتنزل وحياً كريماً على قلب رسول الله؟!..
وبهذه المناسبة الكريمة التي يذكّره فيها ربُّهُ تعالى بتلك النعم التي أنعمها عليه، يوجِّهه إلى ما في البيئة الجاهلية من آفات مجتمعية لا ترعى حقاً لضعيف، ولا تقيم وزناً لسائل أو محتاج، ولا تأبه للمشاعر الإنسانية التي يجب أن تغني البشر بالرحمة والإحسان والشفقة..
إنها بيئة ظالمة تقهر اليتيم، وتحتقر السائل. ولكن هذا الوحيَ الإِلهي الذي يتنزَّل على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو بخلاف ذلك تماماً. لأنه يهدف إلى وخز الضمير البشري الذي لا يأبه للضعفاء، وإلى إقامة موازين الحق والعدل التي تمنع الجورَ والظلمَ والحرمان، وتعطي كل ذي حقِّ حقه، ليعيش كل إنسان بكرامته وهدايته.
فالحمد لله الذي يجمع بوحيه إلى نبيِّه بين الإيناس والتوجيه ليكون زادُ هذا النبي قوياً في مواجهة الظالمين..
ويعود (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى بيته مشرق الوجه، فتهبّ زوجته الطاهرة وتتلقاه بالبِشْر والحبور، ثم تجلس إليه وتستمع إلى خبر الوحي وقد عاوده بآي الذكر الحكيم بـ«سورة الضحى» التي تنزّل بها الروح الأمين من لدن الرحمن الرحيم، وما تحمل آياتها من الدلائل على أن ربَّ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ما تركه، وما قلاه، كما تتوهم تلك القلة من المشركين.. بل إن الرعاية الإلهية ما تزال تكتنفه في شؤون النبوة والرسالة، كما تكرَّمت عليه من قبل في شتى جوانب حياته.
أجل عادَ الوحيُ، وأذهب عن نفس النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) القلق والحزن، فصار بمقدوره أن يلقى الناس بدعوته العتيدة، لأنه لم يكن، حتى ذلك الحين، قد آمن به غير تلك الجماعة الأولى في الإسلام من أهل بيته، دون أن تتعدَّى زوجَه، وبناته، وابنَ عمه علي بن أبي طالب، وعتيقه زيد بن حارثة، ومربِّيته أم أيمن.
فأما زوجُهُ الطاهرة التي حباها الله تعالى بالنفس الزكية فقد كانت له سكناً، آمنت به وصدَّقته، وأقامت له بيتاً من الأمن، والسلام، فأثابها ربُّها على حسن صنيعها بما اختُصت به دون سائر نساء النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الأخريات، وهي الرحمة التي تقرُّ بها عينُها في جنة الخلد، عندما أمَرَ سبحانه وتعالى نبيَّهُ، وعلى لسان جبرائيل الأمين، بأن يُعلِم خديجة (رضي اللّه عنها) أن الله تعالى يُقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب[*] لا صَخَبَ فيه ولا نَصب[*].
وردَّت المؤمنةُ الصادقةُ التحية لخالقها وبارئها، عندما أقرأها زوجُها سلامَ الله - عز وجلّ - بقولها: «الله السلام، ومنه السلامُ، وعلى جبرائيل السلام»[*].
وأما عليٌّ، الفتى الأشمّ، فقد لازَمَ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في كل مكانٍ يذهب إليه، لأنه أحبُّ الناس إلى قلبه، وأقربُهم إلى نفسه، فكان لا يفارقه أبداً: فإن ذهب إلى ندوات قريش كان معه، وإذا طاف حول الكعبة الشريفة طاف بجانبه، وإن قَصَدَ إلى الشعاب للصلاة كان برفقته، يصلي ويتعبَّد معه حتى صار له بمثابة الظل، يدور في فلك النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كيفما دار، لا تهمه الدنيا ومَن فيها، ما دام ابن عمه، هذا النبي الكريم، محباً له وراضياً عنه.
ولم يكن ليخفى على أبي طالب ما يدور في بيت ابن أخيه محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وملازمةُ ابنهِ عليٍّ له، أو ما يتحدث به الناسُ عن «ادعائه» النبوّة، وحمل رسالة الإسلام.. فآثر الترقب، والحذرَ حتى تتبيّن له مواقف زعماء قريش، وقادة مكة من تلك الأمور التي يدور اللغط حولها، وذلك قبل أن يفاتح بها ابن أخيه، ويقف منه على جلية الأمر.. ولكن الأيام تمرُّ بسرعة، وليس في أجواء قريش إلا الأقاويل وكثرة الكلام؛ ولذا عزم أبو طالب أن يلحق بابن أخيه إلى شعاب مكة، حيث يعرف أنه يذهب إلى هناك كل يوم، ليقضي بعض الوقت بعيداً عن عيون الناس...
حقيقة إسلام أبي طالب
وتوجَّهَ أبو طالب فعلاً إلى الشعاب، وبرفقته ولدُه جعفر، وراح يبحث بين ثناياها حتى اهتدى إلى محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وهو في حالة من الإشراق والانجذاب لا يلتفت معها إلى جانبيه ولا إلى ورائه، بل يركع ويسجد، ثم يقوم متوجهاً بناظريه إلى السماء، حتى لكأن روحَهُ معلقةٌ بالملأ الأعلى.. وكان إلى جانبه ولدهُ عليٌّ يقوم بما يقوم به محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تماماً، مما جعل أبا طالب يؤخذ بهذا المشهد، فيلتفت إلى ابنه جعفر ويقول له: أي بنيَّ، تقدم وصِلْ جناحَ ابن عمك[*].. أي تقدم وصلِّ عن شمالِ ابن عمك، كما يصلي أخوك عليٌّ عن يمينه..
وظلَّ أبو طالب واقفاً في مكانه لا يتحرك حتى فرغ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من صلاته، فأسرع إليه يحتضنه، ويعانقه طويلاً، ثم يعانق ولده عليّاً، وهو يدعو لهما بالخير والبركة. وأقبل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على هذا العم الحبيب، بوجهه المشرق الوضّاء، ونفسه الزكية الصافية، يسأله عن أحواله وعن عياله، ويُبدي عذره للانشغال عنه، ولاسيما في هذه الفترة الأخيرة، بالأمر الجلل الذي ندبَهُ الله تعالى إليه وهو حمل رسالة الإسلام، والدعوة إلى الله الواحد الأحد.
وسأله أبو طالب: وما الإسلام يا ابن أخي؟ فنحن، كما تعلم، «على الحنيفية دين إبراهيم (عليه السلام)»[*].
قال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «إن الدين عند الله الإسلام» فهو دين الله، ودين ملائكته ورسُله، ودين أبينا إبراهيم (عليه السلام) قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *} [النّحل: 123]. وقال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *} [الأنعَام: 161].
فالوحي الإلهي إلى النبي محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان يدعوه إلى اتباع ملة إبراهيم (عليه السلام) حنيفاً. وما ملة إبراهيم إلا هذا الدين الإسلامي الذي يدعو إليه هذا النبي الذي هو من نسل إبراهيم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وإنه الدين نفسه الذي لا حرج فيه والذي يقوم على تسليم العبد وجهه لله تعالى، وهو محسن، أي صادق الإيمان..
بهذه المعاني التي يكتنزها قلب رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان يتحدث إلى عمه أبي طالب ويقصُّ عليه خبر بعثته، وما يحمل من رسالة الهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم.
ولم يستغرب أبو طالب النبأ العظيم. فمن قبل عرف أنه سيكون لابن أخيه شأن عظيم، وها هو النبأُ يتأكد والشأنُ العظيم يظهر عندما بعث الله تعالى محمداً نبياً للهدى، ورسولاً للناس كافة.
ولم يكن جديداً على أبي طالب أن يدعو ابنُ أخيه محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى ملة إبراهيم (عليه السلام)، فأبوه عبد المطلب كان يتعبّد على شرع إبراهيم (عليه السلام) ويدعو أبناءه - وفيهم أبو طالب نفسه - إلى عبادة الله العلي العظيم، واتباع ملة إبراهيم، وهو ما حفظه عبد المطلب بدوره عن آبائه[*]، واتّبعه في حياته، والدليل على ذلك قول النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، حتى أخرجني في عالمكم، ولم يدنسني بدنس الجاهلية»[*].
وإن أبا طالب ليؤمن تمام الإيمان بصدق محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وبأحقيّة دعوته في محاربة الكفر والقضاء على الوثنية والشرك.
وإن أبا طالب ليحسُّ بهوان الأصنام التي تعكف قريش والعرب على عبادتها. وإنه ليوازن بين الأمور بمقياس صاحب العقل الحصيف، شأنه في ذلك شأن كل سيد في هذه الأسرة الشريفة من الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فلا يجد أي مجالٍ للموازنة أو المقارنة: ها هنا الإسلام والحق، وهناك الكفر والباطل.
ولكن آهٍ من قريش! فقد خبر أبو طالب عقليتها الجاهلة، وصلافتها وغرورها واستعلاءها.. فهل يعقل أن يقبل زعماؤها - وكل واحد منهم طاغية، متكبر وجاهل - أن يتنازلوا عن مكانتهم، ويسلموا قيادتهم لدعوة ابن أخيه؟ أم أنهم، وهو الأرجح، سيقفون له ولدعوته بالمرصاد، يحاربونه بلا هوادة، ويمنعونه بلا تبصُّر، لئلا يكون في نجاح دعوته القضاءُ على امتيازاتهم، وأفولُ سيادتهم في أقوامهم؟.. أبداً لن ترضى قريش بذلك، بل وستؤلّب العرب على ابن أخيه. وإذن فهو لن يقف مكتوف الأيدي، فإما التصدّي لقريش وحلفائها وفي ذلك ما فيه من حرب أهلية قد لا تترك ولا تذر، وإما أن يهادن قريشاً فلا يُعلن إسلامَهُ على ملئها، وبذلك يكون أقدرَ على الإمساك بزمام الأمور، ومناصرة الدعوة برويّة وتعقّل هما من أشد الضرورات لها في هذه المرحلة بالذات..
وبعد هذا التأمل الطويل، والتفكر في الأمور من جميع جوانبها، قال أبو طالب للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «إي والله يا ابن أخي، ما أحب إلى قلبي من دينك، فامض لأمرك على بركة الله.. ووالله لا يخلص إليك من الناس شيء تكرهه وأنا على قيد الحياة».. ثم يلتفت أبو طالب إلى ولده عليّ ويقول له: «وأما أنت يا بُني فما أراك إلا آمنت بدين ابن عمك؟» قال علي: إي نعم يا أبت! آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به، وصلّيت معه لله واتّبعته... فقال له أبوه: «أما إنه لم يدعُكَ إلا إلى خيرٍ فالزمه»[*].
لقد رأى أبو طالب ألاّ يجهر بإسلامه من أجل مصلحة نبي الله، ومن أجل دين الله.. ولكنه أخذ العهد على نفسه وهو يقسم بالله العلي الكبير أن يناصب العداء كلّ من يقف في وجه الدعوة إلى هذا الدين، وأن يدفع عن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كل مكروه ما دام فيه عرق ينبض بالحياة.
وقد يتراءى للبعض أن موقف أبي طالب لم يكن فيه الوضوحُ الكافي، فهو كما ذهبَ إليه أكثرية كتّاب السيرة، وأخذه عنهم المستشرقون، لم يعلن إسلامه ويشهره على الملأ، ولكن بالمقابل لم يثبت أبداً أنه عارض محمداً ودعوته، بل وكيف يمكن أن يرفض الدعوة إلى الدين القيّم الذي جاء يقتلع الشِّرك من جذوره، ويبدد كل ما يتصل به، وهو على الحنيفية - كما أوضحناه سابقاً - ولنا الحق أن نتساءل:
فهل حبه الكبير لابن أخيه، ودافع عصبية القرابة والقبلية هما وراء عدم وضوحه؟ أم أنه آمن ولكن أراد أن يكتم إيمانه حتى يبقى مسيطراً على الوضع، وقادراً على مساعدة رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بكل ما أوتي من قوة؟ أم أنه أراد ألاَّ يشهرَ إسلامَهُ حتى لا يقف في الصف المعادي لقريش حتماً، فيكون خصماً لها، وتكون قريش خصماً له، وفي ذلك ما يفقده الحجة تجاه القوم، بل ويفقده عنصر الحماية الذي يفرضه سير الدعوة؟...
ولا نعتقد أنه كان للعصبية والقرابة والقبلية أي تأثير على أبي طالب، فإن كان أبو طالب عمَّ «محمد»، فإنَّ أبا لهب - عبد العزى بن عبد المطلب - هو أيضاً عمُّ «محمد»، - وسوف نرى بأنه سيكون أكثرَ الناس عداوةً للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وأشدَّهم حرباً على دعوته ـ. فيبقى أن حكمة الله البالغة هي التي ألهمت أبا طالب المؤمِنَ أن يشدّ عزم الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على المضي في دينه، وأن يعطيه العهد على أن يمنعه من أي شيء يكرهه؛ وهي حكمة الله - تعالى - عينها التي جعلت أبا طالب مؤمناً بحقيقة وجود الله من قبل بعث محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فكان دفاعه عن الإسلام وحامله موقفاً ثابتاً لا شأن له بالعصبية، ولا حساب له في ميزان القبلية، وخصوصاً عند إنسان مثل أبي طالب الذي شرف بالحسب الرفيع، والمكانة العالية في العقل والخلق والعمل، فلا يمكنه أي يمالىء على الحق، أو يداهن من أجل عصبية القرابة.
وكذلك الحال بالنسبة للأهواء الشخصية، لأن حُب أبي طالب لابن أخيه «محمد» لا يمكن أن يحجب عنه - مهما بلغ - رؤية بصيرته النافذة، ورجاحة عقله المعهودة، وحكمته الرشيدة.. ثم إن أقارب «محمد» كانوا يحبونه حباً شديداً. فالعلاقة كانت وطيدة بينه وبين عمه أبي لهب مثلاً، وقد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم لولدَيْ هذا العم، بل وكان أبو لهب ذاته يكنُّ له قبل البعثة الحبَّ والحنان، وقد قيل إنه أعتق جاريته التي بشّرته بولادة «محمد». وكان دائماً يفاخر به في أندية قريش ومجالسها، ويتحدّث بما يتحلى به من الصفات التي تميزه عن غيره. ومع ذلك فقد وقف موقفاً عدائياً منه بعد بعثه بالنبوّة..
إذن فلا العصبية، ولا المشاعر الشخصية هي التي جعلت كلًّا من ذيْنكَ العمَّين يقف من ابن أخيه موقفاً مغايراً تماماً للآخر!..
فقد بدا واضحاً فيما بعد:
أن موقف أبي طالب كان العضد[*] للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وقد منعه من أعدائه.
وأن موقف أبي لهب كان الأشد والأدهى في العداوة للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ودعوته، بل وكان هذا الكافر بمثابة الحية الرقطاء التي تنفث السموم، أو الوحش الكاسر الذي يريد أن يلتهم فريسته.
على أن موقف كل منهما كانت وراءه المعتقدات، والدوافع النفسية.. فأما أبو طالب فكان على ملة أبيه عبد المطلب، وهي ملة إبراهيم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كما رأينا. ثم إن مزاياه الشخصية، وصفاته الذاتية هي التي أهّلته لأن يكون شيخ الأبطح، وسيداً في قريش، بل وفي العرب.. وأما أبو لهب فكان كافراً، مشركاً بالله تعالى، ولم يتأثر بمعتقدات أبيه عبد المطلب على الإطلاق. وكان همُّه معاقرة الخمرة، والإسرافَ في اللذائذ، يتهتّك في متعه فلا يرعى حرمة ولا يألو ذمة.. هذا فضلاً عن مطامعه في الكسب، وطموحاته في الرياسة على بني هاشم وفي النفوذ على مكة..
إذن فالاختلاف بين عمَّيْ محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان في المبدأ، وليس في الموقف فقط.
فلا يمكن لمؤمن بالله تعالى، وعلى شرع أنبيائه أن يحارب ديناً هو لله تعالى أو أن يقف ضده، وسواء أكان الداعي لهذا الدين قريباً له أم غريباً عنه.
ولا يمكن لمشرك بالله تعالى، وكافر بدينه، أن يقبل الدعوة إلى الإيمان الحق، أو أن يناصر الداعي، حتى ولو كان أقرب الناس إليه..
فالمبدأ هو الجوهر والأساس في حياة الناس، إما أن يجمع أو أن يفرِّق، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجمع المبدأ الإسلامي بين مؤمن وكافر، أو بين حق وباطل، أو بين نور وظلام.. ولذلك كان الاختلاف في المبدأ بين أبي طالب المؤمن، وبين أبي لهب الكافر. وكان الموقف المناصر للإسلام من الأول، والموقف العدائي لهذا الدين من الثاني.. وحيال تلك الحقائق معاذ الله أن يُتَّهم أبو طالب بأن موقفه كان متردداً أو متأرجحاً بين الإيمان والشرك، لأنه لا يمكن لأحدٍ في الدنيا أن يدّعي بأنه لم يكن عوناً لابن أخيه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الداعي إلى الإسلام، كما لا يمكن لأحد أن يُنكر بأنه كان حرباً على الكفار والمشركين، حتى ولو كانوا أبناء عشيرته الأقربين.
وهذا ما يُثبت أن أبا طالب كان في الحقيقة والواقع من الذين آمنوا برسالة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ... ودلالات إيمانه كثيرة:
- فهو قد عرف من أبيه عبد المطلب أنه سيكون لابن أخيه «محمد» (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) شأن عظيم، إذ كان أبوه يصرِّح بذلك ويعلنه على قريش في كل مناسبة.. وهذا الشأن قد حدَّثهُ عنه أيضاً الراهب بحيرا عندما كان محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) برفقته إلى الشام وهو ابن الثانية عشرة. ولقد ظهر لأبي طالب فعلاً هذا الشأن العظيم عندما أخبره محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن الله سبحانه وتعالى بعثه نبياً ورسولاً، لأن «محمداً»، هو الصادق الأمين، فإن قال أو أخبر صدق، كما تدلُّ عليه سيرته قبل البعثة وبعدها.
- وهو قد عاهَدَ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يمنع عنه كل كريهةٍ، وفي هذا حماية للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ولدعوته، ونصرة للإسلام الذي يحمله هذا النبي الكريم.
- وهو قد ثبَّت ابنَهُ علياً على دين الإسلام، وأمره بملازمة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والبقاء بجانبه.
- وهو الذي أمَرَ ابنَهُ جعفراً أن يصلّي إلى جانب النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، كما يصلي أخوه عليٌّ بجانبه..
- وهو الذي نزحَ إلى الشِّعب، وارتضى العيش جوعاً ومرارةً طوال ثلاث سنوات، عندما هجّرت قريش بني عبد المطلب وبني هاشم إلى البراري المقفرة لسبب واحد وهو أنهم أهل النبي محمد وعشيرته (وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله).
- وهو الذي أمر ابنه علياً أن ينام محل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في الشعب إبَّان المقاطعة خوفاً عليه من الغدر.
- وهو الذي رفض عروض قريش السخية كي يقنع ابن أخيه محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالعدول عن دعوته (كما سنرى).
وهذه الحقائق الثابتة في بطون كتب السيرة النبوية الشريفة، تكفي لتؤكد وتثبت إيمان أبي طالب[*] الذي نصرَ رسولَ الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) باليد واللسان، ونظم فيه، وفي دينه من مدائح الشعر ما ملأ بطون الدواوين.. ولو لم تكن هذه هي الحقيقة، لما كانت حكمة الله البالغة قد جعلت رسولهُ محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يطمئن إلى عمه أبي طالب، ويتّخذه بمثابة الركن الركين الذي يلجأ إليه، بعد ربِّه - عزّ وجلّ - كلما حزَبتْه الشدائد من عنت قريش واستكبارها..
بدء دخول الصحابة الكرام في الإسلام
لقد بدأت الألسن تتحدث عن الدعوة داخل مكة، وأمرُ الله تعالى بإنذار الناس قد نزل، وما على الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلاَّ أن يُلبي نداءَ الواجب المقدس ويباشر الدعوة ولو في نطاق مجاله. فرأى (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يبدأ برجال يثق بهم، ويكونون على قدر من الأصالة، والتفكير، والمقدرة على تحمُّل المسؤولية.. ولعلَّ الأوْلى أن يكونوا من الأصدقاء - كما يندبنا إليه العقل، ويحثنا عليه الشعور - لأنهم أولُ من نختار لنطرح عليهم أمورنا وقضايانا، وبخاصة الهامة منها..
إسلام أبي بكر (رضي اللّه عنه)[*]
وبهذا التوجّه ذهب النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى أبي بكر الصديق بن أبي قحافة الرجل الذي ألِفَهُ، وربطته به المودة منذ أن زاول التجارة في مكة. فقد كان أبو بكر ممن يتّجرون بالثياب وقد نجح في مزاولة هذه المهنة حتى عُدَّ من أغنياء قريش. وإن صفاته الطيبة هي التي قرَّبتهُ من «محمد» حينئذٍ، لما وجَدَ فيه من دماثة الخلق، ورقة الطبع، وحسن الحديث، وصدق القول، ولطف المعشر.. فنشأت بينهما تلك الصداقة الحميمة، وزادت متانة عندما شهدا معاً حلف الفضول. هذا بالإضافة إلى أنه كانت لأبي بكر مكانة اجتماعية مرموقة بين أبناء قومه، فقد كان أنسبَ قريش لقريش، وأعلم قريش بأنساب العرب، ملمّاً بآدابها وأشعارها خير إلمام.. فإذا أخذنا بعين الاعتبار تقارب السن بين محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وأبي بكر الذي لم يكن يصغره بأكثر من سنتين وبضعة شهور، لتبيّن لنا أن هنالك عوامل كثيرة قد ألّفت بين الرجلين، ولا سيما حسن الخلق، فكان أمراً طبيعياً أن تجمع بينهما الصداقة والمودة، وأن يكون أبو بكر أول من يخطر على بال النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يذهب إليه، ويعرض عليه دعوته..
وهبَّ أبو بكر يَلقى صديقه بالترحاب والمكرمة، ويجلسه في صدر البيت - كعادته - وهو يحفّه بالبشر واللطف.. وكان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يعلم بأن أمرَه غيرُ خافٍ على صديقه.. فراح يخبرُهُ بما أُوحيَ إليه من ربه تعالى، وبعثه رسولاً للدعوة إلى دين التوحيد، والقضاء على معتقدات الوثنية والجاهلية.
وكان أبو بكر يستمع إليه بآذان صاغية، ويتذوق طعم آي الذكر الحكيم الذي يتلوه عليه النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قرآناً عربياً مبيناً. ولم يتردّد عندما دعاه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى الإسلام، وعرف الحق، بالاستجابة لنداء الإيمان، فنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
وليس من غرابة في هذه التلبية، وهذه الاستجابة الفورية من رجل مثل أبي بكر (رضي اللّه عنه) ، فقد كان يعرف صديقه محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) حق المعرفة بمزاياه النفسية، وفضائله الخلقية، وقدراته الذاتية التي تؤهله لأن يكون رسول الله. كما كان أبو بكر - بدوره - يحمل بين جنبيه نفساً صافيةً، قادرة على معرفة الحق واستيعابه، ولذا نراه يُقبل على دعوة الإيمان، بصدقه وإخلاصه، رافضاً كل عبادة للأصنام، كارهاً كل الوثنية وأشكالها.
وطابت نفس النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بإسلام صديقه. وها هما بعد أن كانا رفيقي الشباب، صارا أخوين في الإسلام لا ينفك أحدهما عن لقاء الآخر، والاجتماع على الإسلام وتعاليمه السمحاء، وآفاقه الواسعة، ومراميه البعيدة في حياة الناس؛ وفي أحد اللقاءات، وفيما كان أبو بكر (رضي اللّه عنه) مأخوذاً بحديث النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، إذ يقول له: يا «عبد الله»... فقال: أبو بكر: يا رسول الله، إن أمي سلمى بنت صخر بن عامر أسمتني «عبد الكعبة» وفاءً لنذر كانت قد قطعته على نفسها، لأول طفل تلده. وإنه والحق اسمٌ فيه دلالة من الجاهلية، ولا يأتلف مع إسلامنا القويم، وإنه من رضى الله (تعالى) أن تمنَّ عليَّ باسم: عبد الله، فجزاك الله خيراً يا رسول الله..
وبهذه الروح الطيبة وبتوجيه من النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أخذ أبو بكر على عاتقه أن يفتش بين الأهل والأصحاب عمّن عنده الاستعداد لقبول الدعوة، وقد أوصاه بأن يحتذي حذوه، ويقتدي بأسلوبه في جدال الناس بالتي هي أحسن، لأن ما سوف يلقيه على مسامعهم ليس بالأمر اليسير قبولُه، ومن شأنه أن يحرك لدى كل إنسانٍ انقلاباً نفسياً في تبديل عقيدته الدينية، واتباع عقيدة جديدة تخالف عقيدته السابقة من جميع جوانبها..
إسلام سعد بن أبي وقاص
وكان أولَ سعي لأبي بكر (رضي اللّه عنه) دخولُهُ دكان سعد بن أبي وقاص، الذي يعمل في صنعة برْي النبال، وقد حملَ معه بعضاً منها للقنص، لكي يبيعها منه.
ودار الحديث بين الرجلين وتشعَّب، إلى أن قال أبو بكر (رضي اللّه عنه) :
- اسمع جيداً يا سعد ما أقولُهُ لك.. أرأيت إلى هذه الأصنام والأوثان التي تعبدها العرب، وهي جوفاء، صمّاء بكماء لا تنفع ولا تضر؟ وهل قال أحدٌ يوماً بأن شجرةً أو صخرةً أو قطعةً من خشب ذات عقل وقلب مثل الإنسان؟ إذن أليست عبادتها ضرباً من الخرافات والأساطير؟ بل وإيهام للعقل والذهاب بمحجته؟!
قال سعد: ولكن العرب تعبدها لتقرِّبها زلفى إلى الله!..
قال أبو بكر (رضي اللّه عنه) : وهذا هو الشِّرك بعينه، لأنهم يجعلون مثل هذه المعبودات الحقيرة شركاء لله!..
قال سعد: وما العبادة الحق؟
قال أبو بكر (رضي اللّه عنه) : إنها عبادة الله تعالى، الواحد الأحد. والدين القيِّم الذي يدعو لعبادة الله وحده، هو الإسلام، وقد بعث الله - عز وجل - بهذا الدين محمد بن عبد الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نبياً ورسولاً للناس كافة.
قال سعد: وهل «محمد» حقاً رسول الله؟
قال أبو بكر (رضي اللّه عنه) : أي والله يا سعد، وقد آمنت به، وصدقته، فهلمَّ بنا إليه.
وتوجه الرجلان إلى شعب أجياد حيث كان رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يصلّي مع ابن عمه علي بن أبي طالب. فلمّا فرغا من صلاتهما أقبل الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على سعد بن أبي وقاص يعرّفه بالإسلام ويبيّن له حقائقه وتعاليمه حتى شهد سعدٌ بشهادة الحق، وصار من المسلمين. وعادَ سعدٌ من شعب أجياد إنساناً جديداً يحس وكأن الدنيا لا تكاد تسعه من شدة سروره وارتياح قلبه.
إسلام عثمان بن عفان (رضي اللّه عنه)
وبينما هو في الطريق وقد صار قريباً من دكانه التقى عثمان بن عفان، فبادره هذا بالقول:
- ما هذا البِشْرُ على وجهك يا سعد؟ فقد وجدت الدكانَ مغلقاً..
قال سعد: والله كان مقصداً مباركاً مع أبي بكر بن أبي قحافة إلى صديق حميم..
وتطلّع إليه عثمان محدِّقاً ثم قال: ومن هو هذا الصديق يا تُرى؟ إلاَّ أن تكون مودة أبي بكر لمحمد بن عبد الله هي التي قادتكما إليه، خاصة وأن الناس تتحدث عن لقائهما كثيراً هذه الأيام؟!.
ولم يجب سعد بل انصرف عنه وهو يقول في نفسه: ليتك يا عثمان، تؤمن بأن محمداً رسولُ الله..
وذهب عثمان إلى بيته ليجد خالته سعدى بنت كريز قد جاءت لزيارة أمه أروى بنت أم حكيم بنت عبد المطلب (وأم حكيم هذه توأمة عبد الله بن عبد المطلب - والد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ).
ولاحظ عثمان مدى انهماك خالته بحديثها، فسألها عما يشغل بالها، فقالت له:
- أما والله إنه لخبر مثير يا ابن أختي، فلقد جئت تواً من بيت أبي طالب، وقد سمعته يقول بأن ابن أخيه «محمداً» قد نزل عليه الوحي من السماء، وبعثه الله نبياً ورسولاً..
قالت أروى: أسمعتَ بهذا يا بُني؟ والله لو كان ما يقال حقاً عن بعث نبيٍّ آخر الزمان، فلن يكون هناك نبيٌّ غير محمد بن عبد الله، فما عرفناه إلا الصادق الأمين.
قال عثمان: إن خبره يشيع في أرجاء مكة كلها، وما سمعت أن أحداً من سادة قريش قد تابعَهُ ودخل في دينه.
قالت خالته سعدى: بل سمعت بأن أبا بكر عتيق بن أبي قحافة قد تابعَهُ على دينه..
وكأنَّ هذا الحديث، والتأكيد عليه، كان سبباً في أرَقِ عثمان، فبات يتقلب على فراشه، في تلك الليلة، وهو يفكر بما يدور في مكة، وهو الذي اعتاد ألاَّ يفوته شأن من شؤون القوم، إلاَّ ويكون أول السباقين إلى معرفته والإحاطة به..
وطلع الصباح وهمَّ بالخروج، فإذا بأبي بكر (رضي اللّه عنه) يفاجئه بالطرق على الباب، وقد جاء لزيارته في مثل تلك الساعة المبكرة، فبدا عليه بعض القلق، ولكنَّ أبا بكر (رضي اللّه عنه) هدَّأ خاطره، وقال بأنها زيارة وديّة، وقد جاء ليطمئن إليه وإلى أهله، وللبحث بأمر قد يهمُّهُ ويهمُّ قريشاً كلها.
وجلس أبو بكر (رضي اللّه عنه) يتحدث عن بعث محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وعن رسالة الإسلام التي يحملها هدىً للناس جميعاً، وليس للعرب وحدهم. وإنه لشرف عظيم للقرشيين أن يكون هذا الرسول منهم، ويعيش بين ظهرانيهم. وإن عليهم أن يهبّوا معه لحمل الدين الجديد، ونشره في شبه الجزيرة كلها.
وبعد أن أفاض أبو بكر (رضي اللّه عنه) بما عنده، قال لعثمان: ويحك يا رجل، والله إنك لتدرك عظائم الأمور، وتميز الحق من الباطل، فهل ترضى ببقائنا على عبادة جوامد يقلِّبها الإنسان كيف يشاء ومتى يشاء، وتغشاها الطيور والحشرات والحيوانات بقذارتها؟ أم أن عبادة الله (تعالى) وحدها هي التي ترفع الإنسان وتكرِّمه في عبوديته لرب العالمين، وخالق السماوات والأرض؟!
قال عثمان: لا والله لا يجوز لعاقل يسمع ويبصر أن يتخذ من تلك الأصنام آلهة يعبدها من دون الله.
قال أبو بكر: وهو الحق الذي جاء به محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وهو يدعو إلى دين الله العلي الأعلى، وترْك الوثنية والشِّرك.
قال عثمان: فما بال القوم لا يُقبلون على دعوة «محمد»؟
قال أبو بكر: إنها بداية العهد بالإسلام، فلمَ لا يكون لك الفضل في السبق لاعتناق هذا الدين؟
واقتنع عثمان بما يبديه صاحبه، فانطلقا إلى رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ليلقاهما ببشره وأنسه المعهودين، ثم يدني إليه عثمان، ويبيّن له حقيقة الرسالة التي ندبَهُ الله تعالى إلى حملها، والدعوة لإيصالها إلى الناس.. وظل معه يحدِّثه عن دين التوحيد حتى أشبع نفسه أمناً وإيماناً، فدعاه للإسلام وهو يقول له: يا عثمان أجب الله تعالى إلى جنته.
وتملكت كلمات رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قلْب عثمان، فأسلم وشهد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فكان عثمان بن عفان أولَ واحد من بني عبد شمس أسلم وجهه لله تعالى، وصدَّق محمداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وآمن به.
إسلام الزبير بن العوام
وذات يوم، وبينما كان الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في شعاب بني هاشم، أطلَّ عليه الزبير بن العوام، ابن عمّته صفية بنت عبد المطلب، فقام يلقاه مرحباً، ويسأله عمَّا جاء به، فقال الزبير: إنَّ عمته خديجة بنت خويلد هي التي ألحَّت عليه بالمجيء، بل وهي التي دلَّته على مكانه وأصرَّتْ أن يأتيه ويلتقيه. فأخذ الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بيد ابن عمته، وأجلسه بقربه، في ظل صخرة كبيرة مبدياً له أن عمته ما أرادت به إلاَّ خيراً، ولا سبيل إلى خيرٍ ولا فلاح إن لم يهتد الإنسان إلى عبادة الله الحق، كما تدلُّ عليه الآيات القرآنية المبينة بقوله تعالى: £ $ ! "{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *} {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى *الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى *وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى *وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى *فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى *سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى *إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى *وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى *فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى *سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى *وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى *الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى *ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى *بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا *وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى *إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى *صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى *} [الأعلى: 1-19]. وعقَّب الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعد التلاوة فوراً بقوله: «سبحان ربي الأعلى وبحمده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له».
ورغب الزبير أن يستوضح عن معاني باقي الآيات التي قرئت عليه، فانبرى (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يشرح له ما تحمل آيات «سورة الأعلى» من المعاني الجليلة، والعظات البليغة التي توجب على كل مخلوق أن يقدِّس، ويجلَّ، ويسبِّح اسم الله تعالى، لأنه ربُّهُ وخالقُهُ، الذي خلق كل شيء فسوّاه، فأكمل خلقَهُ في صورته وجوهره بحيث لا يمكن أن يكون لأيّ مخلوق في الأرض - وليس الإنسان فقط - جبلّةٌ أكملُ مما صوَّره الله تعالى عليها، لأنه بلغ به غاية الكمال الذي يناسبه. ثم إنه الخالق الكريم الذي قدّر لكل مخلوق غرائزه وحاجاته العضوية، فهداه إلى ما خلقه لأجله، وألهمه غاية وجوده، وقدّر له ما يصلحه مدة بقائه، ودلَّهُ على عُرى وضوابط صلاحه..
وظل الرسول الكريم عاكفاً على شرح الآيات الأخرى وما تمتلىء به من المعاني السامية التي تفرق بين الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى فيكثر من ذكر ربه تعالى، ويعبده، فينال الفلاح، وبين الإنسان الذي يبعد عن عبادة الله - العلي العظيم - وينسى ذكر ربه، فيكون مصيره النار الكبرى التي يخلد فيها مُهاناً... إلى غيرها من المعاني العظيمة الدالّة، التي إن مكّن الله تعالى أيَّ إنسان من فهم حقائقها، فلا يكون له أيُّ خيار إلاَّ أن يتّقي الله ربَّه، ويؤمن به إيماناً قوياً ثابتاً، كما حصل للزبير إذ خشع بين يدي رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لربه الأعلى، فشهد شهادة الإسلام.
وكان وقت الظهيرة قد حلَّ، فقام الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يعلّم الزبير الوضوء والصلاة، فيصلّي معه هو وعليّ (كرَّم الله وجهه) ثم ينزلون إلى مكة، فيذهب الزبير إلى أمه - عمة رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) - فيخبرها بإسلامه وإيمانه وهو يمتلىء فرحاً وحبوراً.
وعلى هذا النحو كان الدخول في الإسلام يجري، وكانت الدعوة إلى دين الله تعالى تصل إلى الناس في الإطار الفردي الضيق، من خلال الاتصال الشخصي الذي كان يقوم به الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، أو أحد هؤلاء المسلمين القلائل الذين حملوا دعوة نبيِّهم.. أو ربما من خلال حديث قد يسمعه أحد الناس فيدفعه حب الاستطلاع أو الاستعداد الكامن في نفسه لمعرفة الدين الجديد، فيهديه ربُّهُ ويدخل في الإسلام على يدي رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .
ثلة أخرى من الأولين
وبمثل هذه الخطوات الوئيدة والمحسوبة، ووفق الأسلوب الذي اعتمده رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كانت الدعوة تسري في مكة رويداً رويداً، إذ رأى (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عدم توسيع دائرة الاتصال بالناس دفعة واحدة، أو بصورة سريعة حتى لا تحصل مفاجآت غير متوقعة، وهي حتماً ليست في صالح الدعوة، فتتعثر خطواتها، ويتوقف سيرها.. ويذكر في هذا المجال فضل أبي بكر (رضي اللّه عنه) الذي كان يواصل جهودَه، ويأخذ بيد عدد من أبناء مكة، فيجمعهم إلى رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الذي يبين لهم حقيقة بعثه والدين الذي جاء به، فيهديهم الله - تبارك وتعالى - على يدي رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ويدخلون في الإسلام..
وتتابع دخول الذين استجابوا لنداء الإيمان، في دين التوحيد، فكان أبرزهم: عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد - وهو زوج أم سلمة التي تزوجها النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعد موته - والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان وقدامة وعبد الله والسائب أبناء مظعون بن حبيب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وخباب بن الأرت، وعمير بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، ومسعود بن القاري، وسليط بن عمرو وأخوه حاطب بن عمرو، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وامرأته أسماء بنت سلامة، وخنيس بن حذافة بن قيس، وأبناء الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب: حاطب وامرأته فاطمة بنت المجلَّل، وحطّاب وامرأته فُكَيهة بنت يسار ومَعْمر، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف، وامرأته رملة بنت أبي عوف، وعامر بن فهيرة، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية وامرأته أمينة بنت خلف، وخالد وعامر وعاقل وإياس أبناء: البُكير بن عبد ياليل (حلفاء بني عدي بن كعب)، وصهيب بن سنان.
لقد كان الحق والهدى هما الجامعَ لهذه القافلة من الأخيار، فالتقت على حب الله ورسوله، ودخلت في الإسلام طائعة مختارة، تحاذر إثارة عداوة قريش في خروجها على وثنيتها وصنميتها، وتأبى مخالطة زعمائها، الذين أخذ الحقد والضغينة يستبدّان بهم على محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، بعد أن أخذَ خبر بعثه يذيع، لاسيما أنَّهُ من بني هاشم الذين ينافسونهم الزعامة والقيادة والفضل.
ولئن بدا - في ظاهر الحال - أن عدد المسلمين قد تجاوز بضع عشرات من مختلف الطبقات الاجتماعية في مكة، فإن ذلك لم يَعْنِ شيئاً لقريش، بل رأت فيه مجرد طفرة من أفراد قلائل جذبتهم الأحاديث البراقة عن دين جديد، فانقادوا إلى هوى في نفوسهم، سوف لا يلبث إلا قليلاً ويزول عنهم هذا العارض من حب الاستطلاع.. ولذلك كانت اللامبالاة من قريش، ومن الناس، هي عنوان تلك الفترة في مكة، دونما اهتمام أو اكتراث، لا بدعوة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ولا بالذين اعتنقوا هذه الدعوة!.. إلاَّ من بعض أولئك الذين فرضت عليهم قرابتهم من الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، أو ألحَّت عليهم الفطرة السليمة في نفوسهم، أن يستشعروا بأهمية الأمر الذي يدعو إليه، فيتخذوا الموقف الذي يناسبهم، ويروا فيه الصواب والحق.. ومن هؤلاء كان العباس بن عبد المطلب، عم النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الذي كانت أمواله وديونه وتجارته تشغله، فترك الأمور تسير على عواهنها حتى أيقظه من مطامع الدنيا، وفتحَ عيونَه على الحقيقة، صديقٌ له يدعى عفيف الكندي. فبينما كانا يجلسان بجوار الكعبة، إذ استرعى انتباه الكندي رجلٌ قد وقف على بئر زمزم وهو يتوضأ من مائها بطريقة لم يألفها عند أحدٍ من قبل، وإلى جانب الرجل فتى ناهد يفعل فعله، وامرأة وقفت بخمارها تنتظرهما.. فلما فرغا من هذا الغسل، وقف الرجل وفتاه إلى يمينه، ومن ورائهما المرأة التي يسترها ثوبها الجميل عند مقام إبراهيم، ووجوههم إلى الكعبة وراحوا يركعون ويسجدون، ثم يقفون ويعاودون الركوع والسجود، مما جعلَ هذا المشهد يروق للكندي، فيسأل العباس أن يخبره عما يرى وعمَّا لم يألفه عند أحدٍ في حياته؟!
فقال العباس: أما الرجل فهو ابن أخي محمد بن عبد الله، والفتى هو علي بن أبي طالب ابن أخي أيضاً، وأبوه - كما تعلم - شيخ مكة والأبطح، والمرأة هي زوج محمد، السيدة في نساء قريش خديجة بنت خويلد.. وإن ابن أخي ليقول: بأنَّ الله بعثه نبياً ورسولاً بدين الإسلام، ومن شعائر هذا الدين طهارة الوضوء، والصلاة كما تراهم يفعلون.
قال الكندي: ولكنني لا أرى أمامهم صنماً أو وثناً!.
قال العباس: إن دين «محمد» يعيب على الناس عبادة الأصنام والأوثان، ويعدّها كفراً وشركاً بالله.
قال الكندي: عجيب أمر «محمد»! أَوَ يترك دين الآباء والأجداد، وها هي الآلهة التي يعبدون تملأ الكعبة، ومكة، بل وكل قبائل العرب عندها آلهة!..
قال العباس: إنه لا يعبد إلاَّ الله وحدَه لا شريك له، هو ومن اتبعه على دينه.
وكأنَّ هذا الحديث كان بمثابة وخزةِ ضميرٍ للعباس، فراح يقول في نفسه: ما أراني والله إلاَّ راضياً عن هذا الدين الذي يدعو إليه «محمد».. فقد آمنت به زوجتي أم الفضل. وإنها لتُصلّي وتعبد الله في بيتي، وعلى مرأى عيني، وما طاوعتني نفسي يوماً أن أنهاها عن صلاتها، بل كنت، والله، آنسُ لمرآها، وأنجذب إليها، كما انجذب الكندي إلى رؤية هؤلاء المصلّين على بئر زمزم.. وأم الفضل نفسها لم تُخفِ إسلامها عني، بل وتتردد إلى أسماء بنت أبي بكر، وأسماء تتردد إليها، فتمضيان الساعات في ذكر الله، وفي الدعاء لمحمد بالخير، والعون من ربه.. لا، لن أبقى بعد اليوم متنكراً لذاتي، وكأن شيئاً لا يعنيني إلاَّ الانشغال بالأموال والتجارة.. أجل، إن زوجتي أم الفضل هي على الحق باتباعها هذا الدين الذي يتغلغل في نفوس معتنقيه، ليصيرَ أوْلى من الزوج والولد، بل وأوْلى من كل شيء في حياة المسلم.. ولم يفق العباس من تفكيره إلاَّ على صوت صديقه الكندي، وهو يسأله عن شروده، فقام العباس يدعوه إلى تناول الغداء في بيته، وهو يقول له:
- هيا بنا يا صديقي إلى مائدة أم الفضل، فقد أثابني الساعةَ مرأى ابن أخي محمد إلى رشدي، وكأنما دينهُ قد أيقظ الحبَّ في قلبي إلى أم الفضل، هذه الزوجة المؤمنة، التي أحيت بيتي بالطهارة، وأنا غافل عن صنيعها الجميل..
وعلى خلاف العباس الذي كانت أمواله الشغل الشاغل له، فلم يكترث لإسلام زوجه بل تركها تحيا بإيمانها الكبير وحدها.. أجل وبخلافه، كان جاره سعيد بن زيد بن نفيل، ومعه امرأته أم جميل فاطمة بنت الخطاب بن نفيل يعيشان معاً في فيء الدين الجديد، بعد أن ألقى الإسلام بظلاله ونعمائه على هذا البيت المؤمن.. ولم يكن إسلامهما إلا حديث عهد، إذ بعد أن دخل هذا الدين بيوت مكة كلها - وذلك بالحديث عنه سواء عن قصد ومتابعة، أو عن غفلةٍ وكراهة - جاءت فاطمة يوماً، إلى زوجها، وقالت له:
- أتدري يا ابن عمي، إنني ومنذ مدة لا يستحوذ على نفسي إلاَّ ما علمت من هذا الدين الجديد الذي يدعو إليه «محمد»، ولم تكن لديّ جرأة على مكاشفة أحد بما يدور في خلدي، فأخفيت الأمر حتى عنك أنت. فهل تعذرني يا ابن عمي وتنصحني؟!
قال سعيد: ولمَ الملامة يا عزيزتي.. ألا يقول محمد بأنه رسول الله، فإن كان صادقاً فهو - والله - الخيرُ له ولقريش.
قالت فاطمة: لو قال أحَدٌ غيرُهُ بأنه نبيٌّ لما صدَّقت إلا بالبرهان، أما وأنه محمّد الصادق الأمين، فلا مناص من تصديقه.
قال سعيد: أَوَ تدرين أيتها الزوجة الحبيبة بأنَّ أبي قد أودعني وصيَّة لن أنساها، وربما حان وقتها الآن؟! فقد كنت برفقته في جوار الكعبة، وقد جلس إلى ورقة بن نوفل يتحدثان عن نبيٍّ يبعثه الله آخر الزمان، وقد أوصاني يومها بقوله: لئن أظهر الله خاتم أنبيائه، وكتب لك أن تلقاه أو تسمع به يا بنيَّ، فاتّبعه، والزمه، وآمِن به، وأقرئْهُ عنيَ السلام!..
ونظرت المرأة إلى زوجها بدهشةٍ، وهي تعاتبه على إخفاء تلك الوصية عنها، فأخذ سعيد يبرّر موقفه وهو يقول: وهل كنت أظنُّ يوماً بأن نبي آخر الزمان سيكون بين ظهرانينا؟
قالت زوجه: إذن فأنت تصدِّق محمداً بأنه لنبيُّ الله؟!
قال سعيد: ولكنني لم أجتمع إليه، ولم أسمع منه بعد.. فما رأيكِ إن انطلقنا إليه الآن، فعسى أن نجد ما يطمئن نفوسنا، فنؤمن به، ونكون من المهتدين؟
وبالفعل، قصد الزوجان - وقد تاقت نفساهما إلى الحق - بيت النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) واجتمعا إليه، ثم دخلا في الإسلام راضيين مختارين، فأبلغ سعيدٌ سلامَ أبيه للنبي، فشكره (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وحَمَد وفاءه لأبيه المتوفَّى. ومنذ ذلك اليوم والبركة تحف بيت سعيد بن زيد بن نفيل الذي أسعَدَهُ الله تعالى بالإسلام..
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢