نبذة عن حياة الكاتب
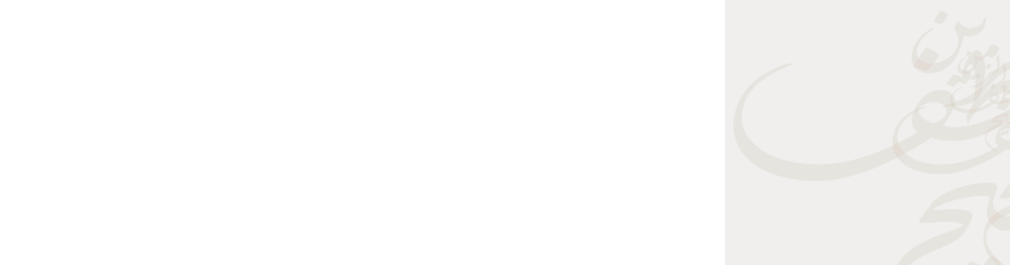
X
الفصْل السَادِسْ - الأدلّة الشَرعيّة
الأدلَّة الشرْعيَّة
البحث الأول: معنى الدليل الشرعي
الدليل لغة بمعنى الدالّ: وقد يطلق تعبير الدليل على ما فيه أو ما يهدي إلى شيءٍ حسِّيٍّ أو معنويٍّ، كما يُطلق على ما يستدلّ به وهو ما فيه دلالةٌ وإرشادٌ، وهذا هو المسمى دليلًا في تعريف الفقهاء. أما علماء الأصول فقد عرَّفوا الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، أو ما يُـتخذ حجةً على أن المبحوث عنه حكمٌ شرعي.
وكل دليل شرعي إما أن يدل على الحكم دلالة قطعية أو ظنية. فالدلالة القطعية كالقرآن والحديث المتواتر، وكل ما هو قطعي الدلالة لا اتكال في اعتباره أو الأخذ به. أما الدلالة الظنية فما كان أصلها قطعيًّا كالقرآن والحديث المتواتر فهي معتبرة أيضًا للأخذ بها، وأما ما كان أصلها ظنيًّا كخبر الآحاد، فلا يصح القبول به بصورة مطلقة، بل يجب التثبت منه.
والأدلة الشرعية نوعان:
ـــــــ أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض أي إلى النص المحض من حيث الألفاظ وما يدل عليه منطوقها ومفهومها، والنقل المحض هو الكتاب والسنّة والإجماع، وهذا يحتاج إلى الفهم والنظر.
ـــــــ وثانيهما ما يرجع إلى الرأي المحض أي إلى معقول النص الذي هو العلَّة الشرعية. والرأي يحتاج إلى العلة الشرعية التي دل عليها النص الشرعي والدليل الشرعي، ولكي يُعدّ حجةً فلا بد من أن يقوم الدليل القطعي على حجيته.
البحث الثاني: قوة الدليل الشرعي
الدليل الشرعي هو الحجة على أن الحكم الذي دلَّ عليه هو حكمٌ شرعي. لذا فإن اعتبار الحكم شرعيًّا يتوقف على شرعية دليله، فإذا ورد على الحادثة دليل صالح يدلُّ على أن حكمها كذا، عُدّ هذا الحكم شرعيًّا لتلك الحادثة بناء على اعتبار دليله الشرعي... وإذا ورد على الحادثة دليلان صالحان أحدهما يدلُّ على حكم معيّن كالحرمة مثلًا، والثاني يدل على حكم آخر خلافه كالإباحة مثلًا، فيجب حينئذٍ ترجيح أحد الدليلين على الآخر حتى يتسنَّى أخذ أحد الحكمين وهو الذي يكون دليله أقوى من الدليل الآخر.
وعندما يتعارض دليلان فلا يصحّ اللجوء إلى ترجيح أحدهما على الآخر إلَّا في حالة عدم إمكان العمل بكليهما معًا، فإن أمكن العمل بهما فهو أولى، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إذ الأصل دائمًا في الدليل الإعمال لا الإهمال.
غير أن العمل بالدليلين لا يصح أن يكون بمحاولات تحميل النص ما لم يحمل، بل بمدلول النص، كما قوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد». فهذا النص يفيد على أن الصلاة يجب أن تكون في المسجد. لكنه ثبت عن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، تقريره للصلاة في غير المسجد، فتوافر لدينا دليلان متعارضان فكيف يمكن إعمال هذين الدليلين أو الجمع بينهما؟
هنا نرجع إلى الصلاة على أنها فرضٌ واجب الأداء. ويمكن أداؤها إما في المسجد، ولا سيما في شعيرة الجمعة، وأداؤها في المسجد يعني الكمال أي اكتمال وجوبها الشرعي واكتمال القيام بها في بيت خصص لعبادة الله تعالى... كما يمكن أداؤها في البيت أيضًا، لأنه لا شيء يمنع، في غير الجمعة، الصلاة في البيت، لأنَّ بيتًا لا يذكر فيه اسم الله تعالى، ولا يُعبد فيه الله الواحد الأحد، هو مأوى للشيطان. فدلَّ بها تقرير الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، على صحة الصلاة في غير المسجد، وعلى كمالها في المسجد.
وعندما لا يمكن العمل بالدليلين معًا في حال تعارضهما، أي عندما لا يمكن التوفيق أو الجمع بينهما، وكانا دليلين متساويين في القوة والعموم، فإن المتأخر منهما يُعدّ ناسخًا للمتقدم، ويعمل بهذا المتأخر، سواء كانا قطعيين أو ظنيين، وسواء كانا من الكتاب أو السنّة.
أما في حال عدم معرفة المتأخر منهما فلا بد من أن يكونا دليلين ظنيين (لأن الأدلة القطعية لا تعارض بينها) وهنا وجب اللجوء إلى الترجيح فيعمل بالدليل الأقوى.
وقوة الدليل تكون من حيث ترتيب الأدلة، ومن حيث درجة الاستدلال في كل نوع من أنواع الأدلة الظنية.
ـــــــ أما من حيث ترتيب الأدلة فإن الكتاب أقوى من السنّة ولو كانت متواترة. والسنّة المتواترة أقوى من الإجماع. والإجماع المنقول بالتواتر أقوى من خبر الآحاد. وخبر الآحاد أقوى من القياس إذا كانت علته مأخوذة دلالةً أو استنباطًا أو قياسًا. أما إذا أخذت علته صراحة فتعامل معاملة النص الذي دلَّ عليها صراحة وتأخذ حكمه من حيث قوة الدليل: فإن كان قرآنًا كان حكمُها حكمَ القرآن. وإن كان سنّة كان حكمها حكم السنّة. وإن دلَّ عليها الإجماع فتَأخذ حكمَ الإجماع.
أما من حيث درجة الاستدلال في كل نوع من أنواع الأدلة الظنية، فإنه يعمل بالسنّة والعقل. ولكل واحدٍ من هذين الدليلين اعتبارات في الترجيح لمعرفة الدليل الأقوى.
وقوة الدليل بالنسبة إلى السنّة تكون من حيث قوة السند، أو من حيث قوة المتن أو من حيث قوة المدلول.
ـــــــ أما ترجيح السند فيبنى على مراقبة الأمور التالية:
1 ـــــــ يرجح الراوي المباشر على الراوي غير المباشر.
2 ـــــــ يرجح الخبر المتواتر على خبر الآحاد.
3 ـــــــ يرجح خبر الراوي البالغ على الراوي قبل البلوغ.
4 ـــــــ يرجح الخبر المحكي بلفظ الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، على الخبر المروي بغيره.
5 ـــــــ يرجح الخبر الذي يدل لفظه على الحقيقة، على الخبر الذي يدل لفظه على مجاز.
6 ـــــــ يرجح الخبر الذي يدل على الحقيقة الشرعية على الخبر الذي يدل على الحقيقة اللغوية.
وأما قوة الخبر من حيث المتن فتكون في أمور:
1 ـــــــ أن يكون أحد الخبرين مفيدًا للتخفيف، والآخر مفيدًا للتشديد، فيرجح الخبر الذي يفيد التخفيف لأن الله تعالى يقول: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة: 185]، ولقوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الدين يسر».
2 ـــــــ أن يكون أحد الخبرين مفيدًا للتحريم، والآخر للإباحة، فيرجح الخبر الدال على التحريم، لقوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلبَ الحرامُ الحلالَ»، وقوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك».
3 ـــــــ أن يكون أحد الخبرين مفيدًا للتحريم والآخر مفيدًا للوجوب، فيرجح الخبر الدال على التحريم، لأن الغالب في التحريم أن يكون لدفع مفسدة، والغالب في الوجوب أن يكون لجلب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
4 ـــــــ أن يكون أحد الخبرين مفيدًا للوجوب، والآخر مفيدًا للإباحة، فيرجح الخبر الدال على الوجوب، لأن الوجوب يقتضي تركه الإثم، والإباحة لا يقتضي تركها شيئًا. هذه هي خلاصة المرجحات، ومنها يمكن أن يعرف الدليل الأقوى حتى يرجَّح به الحكم الشرعي. والأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام الشرعية، والتي اتفق جمهورُ المسلمين على الاستدلال بها، ترجع إلى أربعة: القرآن والسنّة والإجماع والعقل (القياس). كما جرى الاتفاق على ترتيبها في الاستدلال على هذا النحو، بحيث إذا عرضت واقعة نظر أولًا في القرآن، فإن وُجد فيه حكمُها، عُمل به، وإلَّا وجب النظرُ في السنّة فإن وُجد حكمُها فيها عُمل به، وإن لم يوجد فيها حكمُها نُظر في الإجماع، فإن وجد كان به، وإلَّا اجتهد في إيجاد حكم لها عن طريق العقل على ما ورد النصُّ بحكمه.
وأما البرهان على الاستدلال بالأدلة الأربعة ففي قوله تعالى في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء: 59] فالأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول أمرٌ باتِّباع القرآن والسنّة، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمرٌ باتِّباع ما اتفق عليه المجتهدون من الأحكام لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين. والأمر بردّ المتنازع فيه من الأشياء إلى الله ورسوله أمرٌ باتِّباع طريق العقل حيث لا نص ولا إجماع.
وهنالك أدلة أخرى، غير هذه الأدلة الأربعة، لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر الاستدلال بها، وأشهر هذه الأدلة المختلف الاستدلال بها ستة وهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا.
وهكذا تكون الأدلة الشرعية عشرة: أربعة متفق من جمهور المسلمين على الاستدلال بها، وستة مختلف في الاستدلال بها.
والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ ما أتى به الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، فقط: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [سورة الحشر: 7]. وما أتى به رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، هو الكتاب والسنّة. وعلى هذا فلا يمكننا أن نساوي بين الكتاب والإجماع، أو بين السنّة والعقل، لأن الإجماع والعقل ليسا بدليلين كالكتاب والسنّة بل هما يكشفان عن دليل من الكتاب والسنّة. وهذا ما يؤكده العلامة الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه «الفتاوى الواضحة» بقوله: «ونرى من الضروري أن نشير أخيرًا بصورة موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي كما ذكرنا في مستهل الحديث عبارة عن الكتاب الكريم والسنّة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم. أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغًا شرعيًّا للاعتماد عليها.
وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، لكننا لم نجد حكمًا واحدًا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي هو ثابت في الوقت عينه بكتاب أو سنّة.
وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرًا إلى جانب الكتاب والسنّة بل لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات.
وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنّة، ونبتهل إلى الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهما ومن استمسك بهما {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة البقرة: 256].
وإن كنا نؤمن إيمانًا جازمًا بأن الكتاب والسنّة هما المصدران الرئيسيان للتشريع الإسلامي، إلَّا إننا سوف نبحث في الأدلة الأربعة المتفق عليها من جمهور المسلمين، لكي يكون السبيل واضحًا أمام القارئ الكريم للاستنارة والاستزادة في العلم والمعرفة».
ونحن نرى أيضًا أن الكتاب والسنّة يغنيان عن جميع الأدلة التي اعتمدها المجتهدون، وفي الوقت عينه يتوحد المسلمون حول مفهوم واحد للحكم الشرعي المستنبط من كتاب الله وسنّة رسوله. وهذا ما حث عليه أمير المؤمنين علي، عليه السلام، في كتاب نهج البلاغة بقوله: ترد على أحدهم القضيةُ في حكم من الأحكام فيحكُمُ فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكمُ فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاةُ بذلك عند الإمام الذي استَقْضاهُم، فيصوِّبُ آراءَهمْ جميعًا. وإلهُهُمْ واحِدٌ ونَبيُّهُمْ واحدٌ! وكِتَابُهُمْ واحدٌ! أفأمرهُم الله ـــــــ سبحانه ـــــــ بالاختلاف فأَطاعوهُ، أم نهاهُمْ عنهُ فعصَوْهُ! أمْ أنزلَ الله سبحانهُ دِينًا ناقصًا فاستعانَ بهمْ على إتمامِهِ! أم كانوا شُركاء له، فلهُمْ أن يقولوا، وعليهِ أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانهُ دِينًا تامًّا فقصَّرَ الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، عن تبليغهِ وأدائهِ، والله سبحانه يقول: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شَيْءٍ} [سورة الأنعام: 38] وفيه تبيانٌ لِكُلِّ شيءٍ، وذكَرَ أنَّ الكتابَ يصدِّقُ بعضُهُ بَعْضًا، وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانهُ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [سورة النساء: 82].
الدليل الأول: القرآن
القرآن هو الكتاب المنزل بلفظ عربي معجز، وحيًا تلقّاه الرسول محمد، صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كلام الله تعالى، نزل به الروح الأمين جبريل، عليه السلام، بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة لمحمد، صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه رسول الله، وليكون مرجعًا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته. وهو المدوَّن بين دفتَي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا نقلًا متواترًا ـــــــ لأن نقل الآحاد ليس من القرآن ـــــــ محفوظًا من أي تغيير أو تبديل، مصداقًا لقول الله تعالى فيه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر: 9].
والذي يجب لفت النظر إليه أن القرآن قد نقل بالمشاهدة عن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، عن الوحي حين نزوله به، وسجل كتابه إلى جانب حفظه.
فالصحابة، رضوان الله عليهم، لم يَروُوا القرآن الكريم رواية عن رسول الله، بل نقلوه نقلًا. أي نقلوا ما نزل به الوحيُ نفسه، وما أمر الرسولُ، صلى الله عليه وآله وسلم، بكتابته. وبهذا يقال إن الصحابة قد نقلوا القرآن الكريم نقلًا بخلاف الحديث فإنه روي عن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، رواية ولم يسجل، أي يكتب، حين قوله أو روايته، بل جرى تدوينه وكتابته في عهد تابعي التابعين. قال ابن حزم في القرآن: «ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إلينا، والذي ألزمنا الإقرار به، والعمل بما فيه، وصحَّ بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه، أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف، المشهور في الآفاق كلها: وجب الانقياد إلى ما فيه، فكان هو الأصل المرجوع إليه، لأننا وجدنا فيه: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [سورة الأنعام: 38] فما في القرآن من أمر ونهي فواجب الوقوف عنده».
فمن خواص القرآن إذًا أن ألفاظه ومعانيه من عند الله تعالى. وأن ألفاظه العربية هي عينُها التي أنزلها ربُ العالمين على قلب رسوله الكريم بوساطة الروح الأمين جبريل، عليه السلام، والرسول ما كان إلَّا مبلِّغًا آياته وتاليًا لها.
ويبنى على هذا ما يلي:
1 ـــــــ إن ما ألهم به الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزَّل عليه تنزيلًا، بل عبَّر عنه بألفاظ من عنده، إنما هو من أحاديثه، صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يُعدُّ من القرآن، ولا تثبت له أحكام القرآن. وكذلك الأحاديث القدسية التي قالها الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يرويه عن ربِّه لا تُعَدُّ من القرآن، فلا تكون في مرتبته في الحجية، ولا يُتعبد بتلاوتها مثل التعبُّد بآيات الكتاب المبين.
2 ـــــــ إن تفسير آية أو سورة بألفاظ عربية، دالة ما دلت عليه ألفاظه، لا يُعد قرآنًا مهما كانت تلك الألفاظ مطابقة أو مرادفة لألفاظ القرآن ودلالاتها. فالقرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله تعالى، وهي كلام الله عزّ وجل.
3 ـــــــ إن ترجمة القرآن بلغة أجنبية غير عربية لا تُعد قرآنًا، مهما روعي من دقة الترجمة وتمام مطابقتها للمترجَم في دلالته. وترجمة القرآن ممن يوثق بدينه وعلمه وأمانته تبقى بيانًا لما دلّ عليه القرآن، ولكن لا تُعدّ قرآنًا، ولا تثبت لها أحكامه، ألفاظ هذه الترجمة وعباراتها ليست ألفاظ القرآن وعباراته، ولا تصح الصلاة بصيغة الترجمة، ولا يُتعبد بتلاوتها.
4 ـــــــ إن القرآن حجة على الناس؛ وأحكامه واجبة التطبيق والاتِّباع، وما ذلك إلَّا لأنه من عند الله تعالى، والبرهان أنه من عنده سبحانه فهو إعجازه للناس على أن يأتوا بمثله.
5 ـــــــ إن القرآن معجز حقًّا للناس. لأن معنى الإعجاز في اللغة العربية عندما ينسب العجز إلى الغير ويثبت فعلًا هذا العجز، ولا يتحقق الإعجاز، أي إثبات العجز للغير إلا إذا توافرت أمور ثلاثة:
الأول: التحدي أي طلب المباراة والمنازلة والعارضة.
والثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة والمعارضة.
والثالث: أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة.
والقرآن الكريم توافرت فيه شروط الإعجاز الثلاثة. توافر فيه التحدي به. ووجد المقتضي لمن تحدوا به أن يعارضوه. وانتفى المانع لهم، ومع هذا لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله.
أما التحدي فهو أن محمدًا، صلى الله عليه وآله وسلم، قد بلَّغ للناس أنه رسول الله، وأن برهانه على رسالته هذا القرآن الذي ينزل عليه وحيًا من عند الله تعالى ويتلوه عليهم، فلما أنكروا جاحدين تحداهم على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، حتى وصل التحدي إلى أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، وأقسم لهم إنهم لا يأتون بمثله، ولن يفعلوا، ولن يأتوا بمثله، حتى ولو اجتمع الناس كلهم، وجاؤوا بالجن ليكونوا ظهيرًا لهم على أن يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا، ولن يستطيعوا ذلك. وهذا برهان التحدي والإعجاز، وهو برهانٌ حسِّيٌّ دائمٌ، لا ينفكُّ قائمًا منذ نزول القرآن وحتى قيام الساعة، وسيظل قائمًا حتى يزول العالم وتقوم القيامة. قال الله تعالى في سورة القصص: {قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ}[سورة القصص: 49 ـــــــ 50]. وقال تعالى في سورة الإسراء: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [سورة الإسراء: 88]. وقال تعالى في سورة هود: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [سورة يونس: 38]. وقال تعالى في سورة البقرة: {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [سورة البقرة: 23 ـــــــ 24]. وقال عز وجل في سورة الطور: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ} [سورة الطور: 33 ـــــــ 34].
إذًا فهذا قرآن بين أيدي الناس جميعًا، كتاب يتحدَّى الإنس والجان على أن يأتوا بمثله كله، أو بمثل جزء يسير منه، أو آيةٍ واحدة من مثله، أو يقولوا حديثًا مثله... وليتجنَّد أهل العلم واللغة والفلسفة والبيان والمنطق وسائر أهل المعارف والثقافات، وليأتوا بمناصرين ومساعدين ومعاونين... وليشحذوا عقولهم، ويسخّروا آلاتهم، ولتكن لهم كل ما يملكون من خزائن الأرض وكنوزها من علوم ومعرفة... ليكن لهم ذلك كله على أن يأتوا بسورة من مثله... فإنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا... وهذا هو تحديّ القرآن، وهذا هو إعجاز القرآن، وهذا إذًا كتاب الإسلام فليتَّقِ عبادُ الله ربَّهم الذي خلقهم، وليؤمنوا بدين الإسلام وقرآنه.
ـــــــ أما وجود المقتضي أو الأسباب والدوافع للمباراة والمعارضة عند من تحداهم فلا يحتاج إلى بيان. فهذا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لهم إنه رسول الله للناس كافة، وإنه جاءهم بدين الإسلام يبطل ديانة الوثنية ويبطل الكفر والإلحاد، بل يبطل ما وجدوا عليه آباءهم. وقد سخر من آلهتهم الموهومة، وسفَّه عقولهم التي تمجِّد أوثانًا وأصنامًا لا تنفع ولا تضر... فهل أعظم شيئًا عندهم من ذلك؟ وما كان أحوجهم إلى أن يدحضوا حجج محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه رسول الله، وبأن يبطلوا ما يواجههم به من آيات قرآنية، لكي يدافعوا عن دينهم، ويحافظوا على عقيدتهم، ولكي يبقى لهم على الأقل إيمانهم الذي يسيّرهم في الحياة... لكنهم لم يفعلوا، وما قدروا على أن يفعلوا، لأن جميع جهودهم باءت بالفشل، وجميع محاولاتهم نالها الخسران المبين.
ـــــــ وأما انتفاء ما يمنعهم من معارضته، فلأن القرآن بلسان عربي، وألفاظه من لغة العرب، وعباراته على أسلوب العرب، وهم أهل البيان، وفيهم ملوك الفصاحة، وقادة البلاغة، وحياتهم مليئة بالشعراء والخطباء والفصحاء في مختلف فنون القول. هذا من الناحية اللفظية.
وأما من الناحية المعنوية فقد دلت آثارهم من شعر وخطب وحكم ومناظرات بأنهم كانوا ناضجي العقول، ذوي بصر بالأمور، وخبرة بالتجارب، وفضلًا عن ذلك فقد دعاهم القرآن الكريم، ودعاهم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يستعينوا بمن شاؤوا ليستكملوا ما ينقصهم، ويتموا عدتهم، وفيهم الكهان وأهل الكتاب. وأما من الناحية الزمنية، فالقرآن لم ينزل جملة واحدة لكي يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة، بل نزل مفرقًا خلال ثلاث وعشرين سنة، بين كل تنزيل وآخر زمان فيه متسع للمعارضة والإتيان بما يقدرون عليه، هذا لو كان في مقدروهم، لكنه لم يكن... ذلك أن التجاءهم إلى قتال محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه، ومحاربة الإسلام، بدل المعارضة في الفكر والقول، كل ذلك اعتراف منهم بعجزهم عن معارضة القرآن، وتسليم منهم أن هذا القرآن فوق مستوى البشر. بل لقد حاول العرب معارضة القرآن بعد نزول سورة الكوثر فراحوا يشحذون زناد أفكارهم، وبارع أقوالهم، فجاء إخفاقهم يدل على سخف معارضتهم لهذه السورة حيث يقولون: (إنا أعطيناك العقعق، فصل لربك وازعق، إن شانئك هو العجل الأبلق).
ولقد اتفق العلماء على أن القرآن لم يعجز الناس عن أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة معيَّنة، بل أعجزهم من نواحٍ متعددة: لفظيةٍ ومعنويةٍ وروحيةٍ وزمنيةٍ، تساندت وتجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه. واتفقت كلمتهم أيضًا على أن العقول لم تصل حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز كلها وحصرها في وجوه معدودةُ. وأنه كلما زاد التدبر في آيات القرآن، وكشف البحث العلمي عن أسرار الكون وقوانينه، وأظهر مرور السنين وتعاقبها عجائبَ الكائنات الحية وغير الحية... تجلَّت نواحٍ من نواحي إعجاز القرآن، وقام البرهان الساطع والدليل القاطع على أنه من عند الله العليم الحكيم.
6 ـــــــ إن في القرآن الكريم آيات محكمة وأخرى متشابهة. قال الله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [سورة آل عمران: 7] كما بيَّنا سابقًا.
7 ـــــــ وأخيرًا إن ما نجد من حروف المعجم في أوائل السور فإن لها معنًى لأنها أسماء للسور ومعرفة لها، وقد جعل الله تعالى علمها في الغيب، مما لا يمكن تأويله أو كشفه إلَّا أن يشاء الله، حتى يبقى للقرآن أسراره العجيبة التي شاء منزله أن تكون كذلك لحكمة لا تزال بعيدة من إدراكنا.
الدليل الثاني: السنة النبوية
أولًا: معنى السنّة وأنواعها:
السنّة في الفقه الطريقة. يقال: سنَّ الله سنّة أي بيّن طريقًا قويمًا، كما في قوله سبحانه: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ} [سورة الأحزاب: 62].
والسنّة هي السيرة، حسنة كانت أم سيئة. وكل من ابتدأ أمرًا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنَّه. قال، صلى الله عليه وآله وسلم: «من سنَّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنَّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».
وأما في الاصطلاح الشرعي فإنما يراد بالسنّة أمران:
الأول: تطلق السنّة على ما قابل الفرض، فيكون معناها النافلة المنقولة عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، كالنوافل في الصلوات.
والثاني: تطلق السنّة على ما قابل القرآن الكريم، فهي ما صدر عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من قول أو فعل أو تقرير. لذلك تقسم السنّة عند الأصوليين ثلاثة أنواع:
1 ـــــــ السنّة القولية: وهي الأحاديث التي صدرت عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وفقًا لمقتضيات الأحوال، وذلك مثل قوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وقوله «في السائمة زكاة». وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته». وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وقوله: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»...
2 ـــــــ السنّة الفعلية: وهي ما صدر عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، من أفعال ليست من جبلته البشرية كأدائه الصلاة بهيئاتها وأركانها، والوضوء، وأداء مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد مع يمين المدعي ونحو ذلك...
3 ـــــــ السنّة التقريرية: وهي ما أقره الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، مما صدر عن الصحابة بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فسكوته أو موافقته إثبات فصار سنّةً نبوية. ومن قبيل ذلك ما روي أن صحابيين خرجا في سفر، فلما حان وقت الصلاة ولم يجدا ماءً، تيمما وصلَّيا، وبعد متابعتهما السير وجدا ماءً، وكان وقت الصلاة لا يزال قائمًا، فتوضأ أحدهما وأعادَ الصلاة، ولم يتوضأ الآخر ولم يُعد الصلاة؛ فلما رجعا أخبرا رسولَ الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بما حدث، فقال لمن أعادَ الوضوء والصلاة: لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يُعِدْ: أصبت السنّة وأجزأتك صلاتك. فكان ذلك إقرارًا من الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، لفعل كل واحد منهما.
قال ابن حزم في السنّة: «لما كان القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، فقد تضمَّن وجوب طاعة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فيما أمرنا به، إذ يقول الله تعالى واصفًا رسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [سورة النجم: 3 ـــــــ 4]. ومن ذلك يتبين لنا أن الوحي من الله عز وجل إلى رسوله الكريم على قسمين: أحدهما وحيٌ متلوٌّ، مؤلف تأليفًا معجزًا في النظم ـــــــ وهو القرآن ـــــــ. والثاني وحيٌ مرويٌ، منقولٌ، غير مؤلف ولا معجز في النظم، ولا متلو لكنه مقروء ـــــــ وهو الخبر الوارد عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم ـــــــ وهو الذي يبيّن عن الله عز وجل مرادَه منا، لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [سورة النحل: 44].
ثانيًا ـــــــ أقسام السنّة من حيث ورودها والاستدلال بها:
تقسم السنّة باعتبار طريق وصولها إلينا إلى الأقسام التالية:
1 ـــــــ السنّة المتواترة: وهي التي تفيد العلم واليقين. إذ لا بد من أن يثبت من أن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قد فعل هذا الفعل أو قال هذا الحديث. فإذا ثبتت السنّة صحَّ الاستدلال بها على الأحكام الشرعية وعلى العقائد، وكانت حجة على أن هذا الثابت بالسنّة حكم شرعي أو عقيدة من العقائد. وثبوت السنّة هنا يجب أن يكون ثبوتًا قطعيًّا كأن يرويها جمع من تابعي التابعين (أي لا يقل عن خمسة) عن جمع من التابعين عن جمع من الصحابة عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، شرط أن يكون كل جمع متكوّنًا من عدد كاف، بحيث يؤمن عدم تواطؤهم على الكذب. وهذه هي السنّة المتواترة أو الخبر المتواتر.
2 ـــــــ سنّة الآحاد: وهي التي تفيد الظن ولا تفيد اليقين فيكون ثبوتها ثبوتًا ظنيًّا، كأن يرويها واحد أو آحاد متفرقون من التابعين لا يبلغ حدَّ التواتر، ثم رواها عن هذا العدد تابعو التابعين عن واحد أو آحاد من التابعين، عن واحد أو آحاد من الصحابة، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي سنّة الآحاد أو خبر الآحاد.
لذلك كانت السنّة من حيث الاستدلال قسمين اثنين: هما الخبر المتواتر وخبر الآحاد.
أما الخبر المشهور (أو السنّة المشهورة التي تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين) وهو الذي يروى بطريق الآحاد عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يشتهر في عصر التابعين، أو تابعي التابعين، فإنه من خبر الآحاد أو من سنّة الآحاد، وليس قسمًا ثالثًا. لأن السنّة إما تكون متواترة، وإما آحاد، ولا ثالث لها. وخبر الآحاد إذا كان صحيحًا أو حسنًا يُعدّ حجة في الأحكام الشرعية كلها، ويجب العمل به سواءٌ أكانت أحكام عبادات أو معاملات أو عقوبات. والاستدلال به هو الحق، فإن الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحاديث في إثبات الأحكام الشرعية هو الثابت. والمثال على ذلك أن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قضى بشهادة شاهدٍ واحد ويمين صاحب الحق. وقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع. وهذا كله خبر آحاد. والقضاء إلزام بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب، ما دامت الشبهات التي تجعل الخبر مظنة الكذب قد اتبعت وغير ثابتة. وهذا الإلزام ليس إلا عملًا بخبر الآحاد.
والثابت عن الصحابة فيما اشتهر بينهم واستفاض عنهم، أنهم كانوا يأخذون بخبر الآحاد إذا وثقوا بالراوي. وعلى ذلك يكون خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية.
هذا من حيث ورود السنّة.
أما من حيث دلالتها على الأحكام فتارة تكون هذه الدلالة قطعية وذلك في الألفاظ التي تحتمل تأويلًا، مثل قول الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم: «في خمس من الإبل شاة» فلفظ «خمس» قطعي الدلالة لأنه لا يحتمل إلَّا معنًى واحدًا. وطورًا تكون السنّة ظنية الدلالة إذا كانت محتملة التأويل، مثل قوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا نكاح إلَّا بولي». والسنّة دليل شرعي كالقرآن، وهي وحي من الله تعالى. والاقتصار على القرآن وترك السنّة كفرٌ صُراحٌ، وهو رأي الخارجين على الإسلام.
أما أنَّ السنّة وحيٌ من الله تعالى فهو صريح في القرآن الكريم، بقوله تعالى: {إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [سورة الأحقاف: 9]. وقوله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [سورة النجم: 3 ـــــــ 4].
وأما أن السنّة واجبة الاتباع كالقرآن الكريم فهو صريح في القرآن أيضًا، بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [سورة الحشر: 7].
لذلك فإن السنّة الشريفة من قول أو فعل أو تقرير هي واجبة الاتباع كالقرآن الكريم.
3 ـــــــ الأحكام الواردة في السنّة: السنّة إمَّا أن تكون مبيِّنةً ومفسِّرةً وشارحةً للقرآن، وإمَّا أن تكون تشريعًا جديدًا مثل قول الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} [سورة النساء: 59]. والردُّ إلى الله تعالى يكون بالردِّ إلى القرآن الكريم. وأما الردُّ إلى الرسول فيكون في حياته بالرجوع إليه، وبعد مماته إلى ما صدر عنه أي إلى سنّته. والتنازع هنا هو لفظ مطلق، سواء أكان في فهم القرآن أو في استنباط الأحكام أو في التخاصم. والردُّ إلى السنّة مطلق سنّة، سواء أكانت قولًا أو فعلًا، وسواء أكانت تفسيرًا أو شرحًا أو كانت تشريعًا جديدًا. لذا يجب الأخذ بالقرآن وبالسنّة لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بكتابه العزيز: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} والرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قد أتى بالكتاب والسنّة فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئًا أتى به، ونتخلى عن شيء.
وفيما يتعلق بالأحكام فقد غصت السنّة النبوية الشريفة بالأحكام التشريعية مع تباين أنواعها واختلاف أشكالها، ومع ذلك فهي لا بد من أن تكون مندرجة تحت واحد من الأمور التالية:
1 ـــــــ السنّة المؤكدة لما في القرآن:
هذه السنّة كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها قوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» فهذا الحديث يؤكد ما جاء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [سورة النساء: 29]. ومنها قوله، صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقوا الله في النساء فإنهن عون عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فهذا الحديث يؤكد ما جاء في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: 19].
والسنّة المبينة لكتاب الله قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [سورة النحل: 44]، فتكون بذلك مُفَصِّلة لمجمله، مُخَصِّصة لعمومه، مُقَيِّدة لمطلقه، أو مُلحقة فرعًا بأصل، أو جاءت بتشريعاتٍ لم يُنَص عليها في القرآن الكريم. وهذا بيان مجمل لكل نوع من هذه السنن:
أولًا: السنّة المفصلة لمجمل القرآن:
والمجملُ هو اللفظُ الذي لم تتضحْ دلالته، فقد ورد في القرآن الكريم وجوب الصلاة والزكاة والحج بشكلٍ مجمل من دون بيان لكيفياتها، فجاءت السنّة فبيَّنت أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وكل ما يتعلقُ بها، وذكرت السنّة في أي حال تدفع الزكاة والأشياء التي تجبُ فيها والمقدار الذي تفرض عليه كما أنها بيَّنت مناسكَ الحج وقول الرسول الكريم واضح وصَريح «خذوا عني مناسككم» وكذلك الجهاد، جاءت السنّة وبيَّنت كيفية السير فيه وما يسبقه ويتبعه وما يترتب عليه من علاقات.
ثانيًا: السنّة المخصصة لعامِّ القرآن الكريم:
والعامُّ: هو اللفظُ الذي يستغرقُ جميعَ ما يصلحُ له بلفظ واحد، مثل الرجال والنساء، الأولاد، المؤمنون المسلمون، المشركون إلى آخره. فقد ورد في القرآن الكريم عموميات وجاءت السنّة وخصصتها فمثلًا قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: 11]، فهذه الآية عامة في توريث الأبناء من الآباء، فجاءت السنّة وخصصت العام وجعلته لغير المرتدين عن الدين الإسلامي ولغير القاتلين آباءهم لقول رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «قاتل أبيه لا يرث، مفارق الجماعة لا يرث».
وقال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالْزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور: 2] فهذا عام شامل لكل من يزني محصنًا أو غير محصن فجاءت السنّة وخصصت ذلك بغير المحصن وأوجبت رجم المحصن.
ثالثًا: السنّة المقيدة لمطلق القرآن:
والمطلق: هو اللفظُ الدالُّ على مدلولٍ شائع في جنسه، فقد وردَ في القرآن الكريم آيات مطلقة وجاءت السنّة وقيَّدت هذا المطلقَ بقيدٍ معيَّنٍ مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [سورة المائدة: 38] فإنها مطلقة في كل سرقة فجاءت السنّة وقيَّدت مقدار السرقة بربع دينار ذهبًا فصاعدًا، وقيدت قطع اليد من مكان معيَّن.
رابعًا: السنّة الملحقة لفرع من فروع الأحكام ورد فيها بأصل موجود له في القرآن:
فقد ورد في القرآن الكريم تحريم الجمع بين الأختَين قال تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء: 23] ولم يذكر القرآن الكريم حرمة جمع نكاح المرأة مع عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها أو ابنة أختها فجاءت السنّة وبيَّنت ذلك قال، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنةِ أختها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» فأُلحِقَ ذلك كله بتحريم الجمع بين الأختَين.
وكذلك في تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23]. فجاءت السنّة وألحقت بهذا الأصل سائر القرابات من الرضاعة اللاتي يحرمن من النسب، كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت إلخ. قال الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله حَرَّمَ من الرضاعِ ما حرَّم من النسب».
خامسًا: السنّة جاءت بتشريعات جديدة ليس لها أصل في القرآن الكريم:
مثل جعل مرافق الجماعة والنفط ومعادن الذهب والحديد والفضة والنحاس، وغيرها من المعادن، والأنهار والبحار والمراعي والأحراش من الملكية العامة. ولقد قال، عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «الناسُ شركاءُ في ثلاث في الماءِ والكلأ والنار» وقال: «مِنًى مَنَاخُ من سبق».
ومن ذلك أخذُ الأرض ممن يُعَطِّلهَا ثلاثَ سنوات متوالية لقوله، عليه الصلاة والسلام: «وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين».
ثالثًا ـــــــ أفعال الرسول:
أفعال الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة أقسام:
أحدهما: الأفعال الجِبِلِّة، أي الأفعال التي من جِبِلة الإنسان وطبيعته أن يقوم بها وذلك كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه، فهذه لا نزاع في كون الفعل على الإباحة بالنسبة إليه، صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أمته.
الثاني: الأفعال التي ثبت كونها من خواصه لا يشاركه فيها أحد، وذلك كاختصاصه، صلى الله عليه وآله وسلم، بوجوب الضحى والوتر والتهجُّد بالليل، أو تعدد الزوجات إلى ما فوق الأربع ونحو ذلك مما ثبت أنه خاص بالرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا نزاع في أنه لا يجوز الاقتداء فيها بالنبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك مما اختص به هو وحدَه، صلى الله عليه وآله وسلم.
الثالث: ما ليس من الأفعال الجِبلية وليس مما اختص به، صلى الله عليه وآله وسلم. أي سائر الأفعال، وهذه لا نزاع في أننا مأمورون بالاقتداء فيها به، صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نزاع في أنها دليل شرعي كأقواله وسكوته، فيجب العمل به لأنه فعل، لقوله تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} {سورة الأحزاب: 21] ولقوله تعالى: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [سورة يونس: 15] وقوله تعالى: {إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي} [سورة الأعراف: 203]. وهذا صريح وظاهر في العموم فيشمل كل ما يقوم به الرسول من أعمال كما يشمل الأقوال ويشمل السكوت.
لذلك كان اتباع الرسول في جميع أفعاله التي صدرت عنه مما ليس مختصًّا به ومما ليس من الأفعال الجِبلية واجبًا على كل مسلم لأنه، صلى الله عليه وآله وسلم، لا يَتَّبعُ إلَّا ما يُوحى إليه.
غير أن وجوب اتِّباع الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعني وجوب القيام بالفعل الذي فعله بل يعني وجوب الاتِّباع بحسب الفعل فإن كان الفعل مما يجب، كان القيام به واجبًا، وإن كان القيام به مما يُندب إليه، كان القيام به مندوبًا، وإن كان الفعل مباحًا، كان القيام به مباحًا. فالاتِّباع واجب بحسبما جاء به، وهو مثل اتِّباع أوامر الرسول؛ فالله تعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة النور: 63] فدلَّ ذلك على وجوب طاعة الرسول فيما يأمر به وعلى وجوب القيام به بحسبما أمر. وكذلك أفعاله، صلى الله عليه وآله وسلم، يجب اتِّباعها ولكن القيام بها بحسبما جاءت به الأفعال. أما متى يدلّ الفعل على الوجوب ومتى يدل على النَّدب ومتى يدل على الإباحة، فإن في ذلك تفصيلًا، إذ يُنظر في الفعل فإن كان قد اقترن به دليل يدل على أنه بيان خطاب سابق فإنه يكون بيانًا لنا، وذلك كأن يقول الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قولًا صريحًا بأن هذا بيان لكذا، كقوله: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» وكقوله: «خُذوا عنِّي مناسِكَكُمْ» أو كأن تكون قرائن الأحوال تدل على ذلك، وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل، أو عام أريد به المخصوص، أو مطلق أريد به التقييد، ولم يبيِّنه قبل الحاجة إليه، ثم فعل عند الحاجة فعلًا صالحًا للبيان، فإنه يكون بيانًا.
فهذه الأفعال التي هي بيان لنا، أي بيان لخطاب سابق من آية أو حديث تأخذ حكم المبيَّن.
وأما ما لم يقترن بالفعل، وبما يدل على أنه للبيان لا نفيًا ولا إثباتًا، أي لم يقترن بالفِعْل دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق، فإن كونه فرضًا أو مندوبًا أو مباحًا يحتاج إلى قرينة، إذ يكون حينئذٍ مثل طلب الفعل.فإنه لمجرد الطلب يحتاج إلى قرينة تعيِّن كونه طلب فعل جازم أو طلب فعل غير جازم أو تخييرًا، وكذلك الفعل الذي لم يقترن به ما يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق يحتاج إلى قرينة تعيِّن كون القيام به واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا. وبحسب هذه القرينة يكون حكم القيام به.
غير أنه من استقراء الأفعال التي لم يقترن بها ما يدل على أنه قصد بالفعل بيان خطاب سابق يتبيَّن أنها نوعان: أحدهما ما يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، والثاني ما لا يظهر فيه قصد القربة.
فأما الفِعْلُ الذي يظهر فيه قصد القربة فإن القيام به مندوب، وذلك أن كونه ما يُتقرب به إلى الله قرينة على ترجيح الفعل على الترك، وكونُها قرينة ترجيح ظنية لا قرينة ترجيح قطعية دليلٌ على الطلب غير الجازم، ومن هنا كان مندوبًا وليس واجبًا. فالقرينة هي التي عينت كونه طلب فعل غير جازم، أي عينت كونه مندوبًا.
وأما الفعل الذي لم يظهر فيه قصد القربة فإن القيام به مباح. وذلك أن كون الرسول فعله يدل على الطلب، وكونه ليس مما يتقرب به إلى الله لا يدل على الترجيح بل يُفهم منه عدم ترجيح الفعل على الترك، فإذا قرن هذا مع دلالة الطلب كان الطلب طلب تخيير، أي كان مخيرًا بين فعله وتركه وذلك هو المباح.
وهناك من يقول إن القيام بالفعل الذي فعله الرسول واجب ويستدلون على ذلك بالكتاب والسنَّة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقوله تعالى: {فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ} [سورة الأعراف: 158] فقد أمر الله بمتابعته، ومتابعته امتثالُ القول والإتيان بمثل فعله، والأمر للوجوب فيجب القيام بالفعل. وقال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ} [سورة آل عمران: 31] فإنه يدل على أن محبة الله مستلزمة للمتابعة ومحبة الله تعالى واجبة إجماعًا، ولازم الواجب واجب، فتكون المتابعة واجبة. وأيضًا قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [سورة النور: 63] فحذَّر من مخالفة أمره، والتحذير دليل الوجوب، والأمر يُطلق على الفعل كما يطلق على القول.
وأيضًا قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [سورة الأحزاب: 21]. فإن منطوقه أن الأُسوة لمن كان يؤمن، فربطها بالإيمان. أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله في رسول الله أُسوة حسنة، ومعناه أنه من لم يتأسَّ به لا يكون مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر، وهذا قرينة على الطلب الجازم وهو دليل الوجوب. وأيضًا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} [سورة النساء: 59] أَمْرٌ بطاعة الرسول، والأمر للوجوب، ومن أتى بمثل فعل الغير على قصد إعظامه فهو مطيع له، فيكون القيام بالفعل واجبًا. فجعل فعله تشريعًا واجب الاتِّباع، وهذا يدل على أن فعله واجب الاتِّباع.
وأما السنّة فما روي عنه أنه لما سألته أم سلمة عن بَلِّ الشَّعر في الاغتسال قال: «أما أنا فيكفيني أن أحثوَ على رأسي ثلاث حَثْيات من ماء» وكان ذلك جوابًا لها.
والجواب عن هذه الأدلة كلّها ينحصر في نقطة واحدة هي أن هناك فرقًا بين الاِّتباع والقيام بالعمل، أي هناك فرق بين اتِّباع الرسول والقيام بما فعله الرسول. فاتباع الرسول واجب ولا كلام ولا خلاف في ذلك، لكن القيام بالفعل الذي يجب اتِّباع الرسول به فهو يختلف باختلاف الفعل، فإذا كان الفعْلُ مباحًا فإن الاتباع فيه اتِّباعٌ في المباح، أي أن يخيَّر الإنسان بين فعله وتركه، ففي هذه الحالة هذا هو الاتِّباع، فإذا أوجب على نفسه فعله وجعله واجبًا لا يكون متبِعًا للرسول بل يكون مخالفًا له، إذ إن الاتِّباع إنما يكون بالقيام به بحسبما جاء به الفعل، فإن جاء به واجبًا كان القيام به واجبًا، وإن جاء به مندوبًا كان به مندوبًا، ولا يأثم إن تركه، وإن جاء به مباحًا كان القيام به مباحًا فيتَّبعه بالفعل بحسبما جاء به الفعل، وإن خالف ذلك كان غير متَّبع. والأدلة السابقة كلها أدلة على الاتِّباع لا على القيام بالفعل، لذلك لا تصلح دليلًا على أن القيام بالفعل الذي فعله الرسول واجب، فيسقط الاستدلال بها على الوجوب. وهذا نظير الأمر، فإن الأمر ليس للوجوب، فليس كل ما أمر الله به واجبًا، بل يختلف باختلاف القرائن. فقد يكون ما أمر به واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مباحًا، والواجب في الأمر إنما هو طاعة الأمر. وطاعة الأمر إنما تكون بحسبما أمر به، فإن أمر به على سبيل الإباحة كان القيام به مباحًا، وإن أمر به على سبيل الواجب كان القيام به واجبًا، وكذلك اتِّباع الرسول في أفعاله إنما يكون بحسبما جاء به الفعل.
وهناك من يقول إن القيام بالفعل الذي فعله الرسول مندوب، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب: 21] فإن وصف الأسوة بالحسنة يدل على الرجحان والوجوب منتفٍ لكونه خلاف الأصل، وبقوله: {لَكُمْ} ولم يقل عليكم فتعيَّن النَّدب.
والجواب عن ذلك أن المراد بالتأسِّي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه هو، صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه لو صلَّى وصلَّينا متنفلين أو بالعكس فإن ذلك لا يكون تأسِّيًا به. فالتأسي هو القيام بالفعل على ما قام به هو، صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واجب وليس بمندوب، وقوله {حَسَنَةٌ} وصف للأسوة أي تأسٍّ حسن وليس هو دليل النَّدب. والتأسي واجب وتدل الآية على أنه واجب بدليل قوله: {لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [سورة الأحزاب: 21]، فقد قال: {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ} فهو قرينة تدل على وجوب التأسي. غير أن التأسي هنا لا يُفهم منه وجوب القيام بالفعل بل وجوب الاتِّباع، وبما أن ما فعله لم يثبت كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا إلا بالقرينة، فإن القيام به لا يكون واجبًا إلا إذا ثبت بالقرينة أنه واجب، وعليه فإن الآية تدل على الاتِّباع ولا تدل على القيام بالفعل فلا دلالة فيها على أن القيام بالفعل مندوب.
وهناك من يقول إن القيام بالفعل الذي فعله الرسول مباح وليس بواجب ولا مندوب، وقد استدلوا على ذلك بأن فعله لا يكون حرامًا ولا مكروهًا لأن الأصل عدمه، ولأن الظاهر خلافه، فإن وقوع ذلك أي المحرم والمكروه من آحاد عدول المسلمين نادر فكيف من أشرف المسلمين؟ وحينئذٍ فإما أن يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا والأصل عدم الوجوب والنَّدب، لأن رفع الحرج عن الفعل أو الترك ثابت، وزيادة الوجوب أو الندب لا تثبت إلَّا بدليل ولم يتحقق، فتبقى الإباحة. والجواب عن ذلك أن فعل الرسول المجرد، لما لم يظهر فيه وجوبٌ أو ندبٌ فهو مباح وهو ليس مما يطلب الاقتداء به، وكون الرسول فعله معناه أنه طلب فعله فيكون الطلب طلب تخيير، وذلك هو المباح. وأما ما عداه فإن القرينة عيَّنت كونه واجبًا أو مندوبًا، وعليه فإن حصر أفعال الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم بأنها إنما تدل على الوجوب أو النَّدب أو الإِباحة ولا تدل على الحرام ولا على المكروه صحيح، لكنَّ حَصْرَها في الإِباحة هو الغلط، لأن القرائن هي دليل الوجوب أو الندب وقد تحققت فيما ظهر فيه قصدُ التقرب به إلى الله تعالى، لذلك كان مندوبًا، ولو تحققت قرينة تدل على الوجوب لكان واجبًا. ومن هذا كله يتبيَّن أن أفعال الرسول لا تدل على الوجوب ولا على الندب ولا على الإباحة، ولا على مجرد طلب الفعل إلا بالقرينة التي تعيِّن كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا. وهذا في الأفعال التي لم تأت بيانًا لخطاب سابق. وأما الأفعال التي جاءت بيانًا لخطاب سابق فإنها تتبع المبيَّن في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
والأفعال التي فعلها رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن بيانًا لخطاب سابق ولا قام الدليل على أنها من خواصه. وعُلمت لنا صفتُه من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما بنصِّه، صلى الله عليه وآله وسلم، على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة، أي بقرينة من القرائن. فإن التأسي به واجب، أي إن اتِّباعه في هذا الفعل فرض، والدليل على ذلك النص وإجماع الصحابة. أما النص فقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [سورة الأحزاب: 37] ولولا أنه متأسًّى به في فعله ومتبعٌ لما كان للآية معنى.
وأيضًا قوله تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ} [سورة آل عمران: 31] ووجه الاستدلال به أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة، فلو لم تكن المتابعة له لازمة لزم من عدمه عدم المحبة الواجبة وذلك حرام بالإجماع. أي إن اتِّباع الرسول شرط في ثبوت محبة الله فإذا لم يحصل الشرط وهو الاتِّباع لم يحصل المشروط وهو محبة الله، وبما أن محبة الله فرض فإن اتِّباعه يكون فرضًا. وأيضًا قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [سورة الأحزاب: 21] ووجه الاحتجاج به أنه جعل التأسِّي بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم من لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر.
ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم، وهو الرجاء لله واليوم الآخر وذلك كفر. فكان ذلك قرينة دالة على وجوب التأسي.
أما إجماع الصحابة فهو أن الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله في وقائع لا تحصى. فهذه الأدلة كلها كافية للدلالة على وجوب التأسي، ولهذا فإن التأسي في الفعل هو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله. فكلمة: مثل فعله قيد، لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل، وكلمة على وجهه قيد ثان، فإن معناه المشاركة في غرض ذلك الفعل ونيَّته لأنه لا تأسي مع اختلاف الفعلين في كون أحدهما واجبًا والآخر ليس بواجب وإن اتحدت الصورة. وكلمة من أجل فعله قيد ثالث، لأنه لو اتفق فعل شخصين في الصورة والصفة ولم يكن أحدهما من أجل الآخر كاتِّفاق جماعة في صلاة الظهر مثلًا، أو صوم رمضان اتِّباعًا لأمر الله تعالى، فإنه لا يقال يتأسى بعضهم ببعض. وعلى هذا لو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في المتابعة والتأسي، وسواء تكرر أو لم يتكرر إلا أن يدل الدليل على اختصاص العبادة بذلك المكان أو الزمان كاختصاص الحج بعرفات، واختصاص الصلاة بأوقاتها واختصاص صوم رمضان. هذا هو التأسي. ومن هنا لو أن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، فعل فعلًا على أنه مندوب وفعلناه نحن على أنه واجب لم يكن فعلنا تأسيًا بل كان مخالفة لأمر الرسول فكان حرامًا، فالتأسي هو أن نفعل مثل فعله، على وجهه، من أجل فعله. فلا بد من تحقق هذه القيود الثلاثة في الفعل حتى يكون تأسيًا.
الطرائق التي تعرف بها جهة فعل الرسول
لما ثبت وجوب التأسي به، صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شرط التأسي أن يفعل مثل فعله، كان العلم بجهة فعله، صلى الله عليه وآله وسلم، شرطًا من شروط المتابعة. لهذا كان لا بد من معرفة الطرق التي تُعلم بها جهة فعله حتى يُقام بالعمل على الوجه الذي قام به الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا.
أما بالنسبة إلى فعله الذي ليس ببيان لخطاب سابق فظاهر أن طريقة معرفة جهة الفعل هي معرفة الفعل نفسه، فإن كان مما يُتقرب به كانت الجهة ندبًا، فكان مندوبًا، وإن لم يكن مما يتقرب به كانت الجهة إباحة، فكان مباحًا. وأما بالنسبة إلى فعله الذي هو بيان لخطاب سابق فإن فعله منحصر في الوجوب والندب والإباحة، فالطرائق التي تُعلم بها جهة الفعل أربع: إحداها الطريقة التي تعم الثلاثة، والثانية الطريقة التي يُعلم بها الواجب، والثالثة الطريقة التي يعلم بها المندوب والرابعة الطريقة التي يُعلم بها المباح. أما الطريقة التي تعم الثلاثة فهي أربعة أشياء.
أحدها: التنصيص، بأن ينص النبيُّ، صلى الله عليه وآله وسلم، على وجوب الفعل والنَّدب والإباحة، بأن يقول هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح.
ثانيها: التسوية وذلك بتسويته ذلك الفعل بفعلٍ عُلمت جهته، أي أن يفعل فعلًا ثم يقول هذا الفعل الفلاني وذلك الفعل عُلمت جهته.
كما إذا قال: هذا الفعل مساوٍ للفعل الفلاني وهو معلوم الجهة فإنه يدل على جهة الفعل أيَّ جهة كانت.
ثالثها: أن يُعلم بطريقة من الطرائق أن ذلك الفعل امتثال لآية دلت على أحد الأحكام الثلاثة بالتعيين، مثلًا: إذا عُلم أن الفعل الفلاني امتثال لآية دلت على الوجوب، فإذا سوَّى بينه وبين فعل آخر علم أن ذلك الفعل أيضًا واجب، وكذا القول في النَّدب والإباحة.
رابعها:أن يُعلم، أن ذلك الفعل بيان لآية مجملة دلت على أحد الأحكام، حتى إذا دلت الآية على إباحة شيء مثلًا وذلك الشيء مجمل وبيَّنه بفعله، فإن ذلك الفعل يكون مباحًا لأن البيان كالمبيَّن، مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} مع إتيانه به قائلًا: {صَلُّوا كَما رأَيْتَموني أُصَلِّي}. ومثل مناسك الحج إلخ...
وأما الطريقة الخاصة بالواجب فهي ثلاثة أشياء:
الأول: الأمارات الدالة على كون الشيء واجبًا كالآذان والإقامة في الصلاة فإنهما أمارتان لوجوب الصلاة.
الثاني: أن يكون الإتيان بالفعل تحقيقًا لما نُذر، إذ فِعْلُ المنذور واجبٌ، كما إذا قال: عليَّ صوم الغد إذا هُزم العدوّ، فصيام الغد بعد الهزيمة واجب.
الثالث: أن يكون الفعل ممنوعًا لو لم يكن واجبًا كالركوعات الزائدة في صلاة الخسوف، وذلك لأن زيادة ركن فعلي عمدًا يبطل الصلاة، فإذا لم تكن تلك الركوعات واجبة غدت ممنوعة. فالركوع الثاني في صلاة الخسوف الذي كان يقوم به الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه فَرْض. ولا يقال يجوز أن تكون شرعية الركوع الثاني من قبيل النَّدب والإباحة في هذه الصلاة خاصة، فتكراره يدل على أنه واجب إذ هو تكرار لواجب كما في السجدة الثانية. وأما سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة وغيرها فإنه ليس تكرارًا وقد دل الدليل القولي إلى جانب الفعل على أنه مندوب فكان ذلك دليلًا على النَّدب. وأما رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد فإنه ليس زيادة ركن عملًا، ثم إنَّ رفع اليدين حركة لا تبطل الصلاة. فيكون الفعل الذي يدل على الوجوب هو فعل لو لم يكن واجبًا لكان ممنوعًا، أي لو لم يكن فرضًا لكان منهيًّا عنه.
وأما الطريقة الخاصة بالنَّدب فهي شيئان:
أولهما: أن يكون الفعل مأتيًّا به على قصد القربة مجردًا عن زائد على أصل القربة. أي تجرد عن أمارة تدل على خصوص الوجوب أو الإباحة، فإنه يدل على أنه مندوب، لأن الأصل عدم الوجوب، ولأن كونه للقربة ينفي الإباحة، فيتعيَّن النَّدب.
ثانيهما: أن يكون الفعل قضاء لمندوب، فإنه يكون مندوبًا أيضًا إذ القضاء يماثل الأداء. ولا يقال إن من نام جميع الوقت فإن الأداء عليه غير واجب مع وجوب القضاء، ولا يقال ذلك لأن الأداء في مثل هذه الحالة واجب عليه بمعنى انعقاد سبب وجوبه في حقه.
وأما الطريقة الخاصة بالإباحة فهي شيئان:
أحدهما: أن يداوم الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، على فعل ثم يتركه من غير نسخ، فإن تركه لما داوم عليه تركًا تامًّا يدل على طلب التخيير وهو المباح فيكون دليل الإباحة.
ثانيهما: أن يفعل فعلًا ليس عليه أمارة على شيء، وبما أنه لا يفعل محرَّمًا ولا مكروهًا، والأصل عدم الوجوب والنَّدب، فيكون مباحًا.
أمَّا سكوته، صلى الله عليه وآله وسلم، أي تقريره، فهو من السنَّة، كقوله وكفعله سواء بسواء. فإذا فعل واحد بين يدّي النبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، فعلًا، أو في عصره، وهو عالم به، قادر على إنكاره فسكت عنه وأقرّه عليه من غير نكير عليه يُنظر، فإن سكوته عن فاعله وإقراره له عليه يدل على جواز ذلك الفعل ورفع الحرج عنه. لأنه لو لم يكن فعله جائزًا لأنكر عليه، لأن الرسول لا يسكت على منكر. لذلك كان سكوته، صلى الله عليه وآله وسلم، دليل الجواز. وأما إن كان النبيُّ قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل وعرف تحريمُه فإنه لا يُتصور سكوت الرسول عن ذلك الشخص، لأنه إقرار على منكر وهو محال على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سكوت الرسول عن أهل الذِّمة وهم يختلفون إلى كنائسهم فإنه لا يدل على الإقرار على فعلهم، بل يدل على ترك أهل الذمة وما يعبدون، وليس دليلًا على جواز الذهاب إلى الكنيسة. فالسكوت الذي يُعدّ من السنَّة يُشترط فيه ألّا يكون قد سبق نهي عنه، وأن يعلمه الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يُفعل بين يديه، أو يُفعل في عصره وبعلمه. وأن يكون الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قادرًا على إنكاره، وما عدا ذلك لا يُعدّ من السنَّة. والمراد بإنكاره هو زجرُ فاعلِه وليس عدم ميل الرسول إليه.
أمَّا التعارض بين أفعال الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يُتصور، لأن التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما صاحبه، وهذا التعارض بين فعلَين من أفعال الرسول بحيث يكون أحدهما ناسخًا للآخر أو مخصصًا له لا يُتصور وقوعه بين أفعاله، صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه إن لم تتناقض أحكامها فلا تعارض، وإن تناقضت فكذلك أيضًا، لأنه لا يجوز أن يكون الفعل في وقت واجبًا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه، من غير أن يكون مبطلًا لحكم الأول، لأنه لا عموم للأفعال بخلاف الأقوال. نعم إذا كان مع الفعل الأول قول مقتضٍ لوجوب تكراره فإن الفعل الثاني قد يكون ناسخًا أو مخصصًا لذلك القول لا للفِعْل، فلا يُتصور التعارض بين الفعلَين أصلًا. أما سبب عدم تصور التعارض فذلك لأن الفعلَين المتعارضين إما من قبيل المتماثلين كفعل صلاة الظهر مثلًا في وقتَين متماثلين أو في وقتين مختلفَين.
أما الفعلان المتماثلان فظاهر فيهما عدم التعارض وذلك كصلاة الظهر في وقتَين. وأما الفعلان المختلفان فإن كانا من الجائز اجتماعهما كالصلاة والصوم فكذلك ظاهر عدم التعارض، وإن كانا مما لا يُتصور اجتماعهما وكانت لا تتناقض أحكامهما كصلاة الظهر والعصر مثلًا فإنه أيضًا لا تعارض بينهما لإمكان الجمع، فيمكن الجمع بين الصلاة والصوم ويمكن الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر. وإن كانا مما لا يُتصور اجتماعهما وكانت تتناقض أحكامهما كالصوم في يوم معيَّن والإفطار في يوم آخر، فكذلك لا تعارض بينهما لاجتماع الوجوب في وقت والجواز في وقت آخر، أي يمكن أن يكون الفعل في وقت واجبًا أو مندوبًا أو جائزًا، وفي وقت آخر بخلافه، ولا يكون أحدهما رافعًا ولا مُبطلًا لحكم الآخر، إذ لا عموم للفعلَين ولا لأحدهما.
وكذلك التعارض بين فعل النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله فإنه لا يقع إلا في حالة واحدة وهي النسخ، وما عدا هذه الحالة فلا تعارض بين قوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله مطلقًا. والتعارض له ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون القول متقدمًا. وهو أن النبيَّ، صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فعل فعلًا ولم يكن هناك دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يكون ناسخًا للقول المتقدم عليه المخالف له، سواء أكان ذلك القول عامًّا كما إذا قال صوم يوم كذا واجب علينا ثم أفطر ذلك اليوم وقام الدليل على اتِّباعه كما فرضنا، أم كان خاصًّا به بدليل دل على ذلك أو خاصًّا بنا بدليل دل على ذلك. يعني أن فعله، صلى الله عليه وآله وسلم، الثابت التكرر، الواجب التأسي به، إذا تأخر عن القول خاصًّا به، أو خاصًا بنا، أو عامًّا له ولنا، نسخ القول في حقه أو في حقنا أو في حقه وحقنا. أما الفعل الخاص به فظاهر فيه النسخ، وأما الخاص بنا فلوجوب الاتِّباع. وأما العام له ولنا فلوجوب الاتباع كذلك.
ثانيها: أن يكون القول متأخرًا عن الفعل المذكور وهو الذي دل الدليل على أنه يجب علينا اتِّباعه فيه لأنه لا يوجد دليل على أنه خاص به، وهذا يُنظر فيه، فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرار الفعل فلا تعارض بينه وبين القول المتأخر أصلًا، لأن الفعل وقع لمرة واحدة وانتهى ولم يطلب تكراره فأصبح معدومًا، فلا يكون القول معارضًا له لأن التكرار غير مطلوب. وإن دل الدليل على وجوب تكراره عليه وعلى أمته فالقول المتأخر قد يكون عامًّا أي متناوِلًا له، صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمته، وقد يكون خاصًّا به، وقد يكون خاصًّا بنا.
فإن كان عامًّا فإنه يكون ناسخًا للفعل المتقدِّم، كما إذا صام يوم عاشوراء مثلًا، وأقام الدليل على وجوب تكراره وعلى تكليفنا به ثم قال ليس واجبًا علينا صيامه. هذا إن كان عامًّا. وأما إن اختص القول المتأخر بالنبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، فإن القول المتأخِّر ينسخ الفعل المتقدِّم في حقه، صلى الله عليه وآله وسلم، لا في حقنا. وإن اختص القول المتأخر بنا أي بالأمة كما إذا قال لا ينبغي لكم أن تصوموا فلا تعارض فيه بالنسبة إلى النبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، فيستمر تكليفه به، وأما في حقنا فإنه يدل على عدم التكليف بذلك الفعل، ثم إن ورد قبل صدور الفعل منا كان مخصصًا، أي مبيِّنًا لعدم الوجوب، أي كنا مستثنين من الفعل. وإن ورد بعد صدور الفعل منا فلا يمكن حمله على التخصيص لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيكون ناسخًا لفعله المتقدم.
ثالثها: أن يكون المتأخِّر من القول والفعل مجهولًا. أي لم يعلم أن المتقدِّم هو الفعل أو القول. وفي هذه الحال ينظر: فإن أمكن الجمع بينهما يرتفع التعارض، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يؤخذ بالقول فيما كان مختصًّا بنا، أو عامًّا له ولنا، دون ما كان مختصًّا به، فيقدم القول ويؤخذ به ويترك الفعل، وذلك لكون القول مستقلًا بالدلالة موضوعًا لها بخلاف الفعل فإنه لم يوضع للدلالة وإن دل فإنما يدل بوساطة القول.
على أنّ القول أعم دلالة لشموله المعدوم والموجود، المعقول والمحسوس بخلاف الفعل لاختصاصه بالموجود المحسوس.
التعارض بين أقوال الرسول
لا يقع التعارض بين قولَين من أقوال الرسول إلا في حالة واحدة وهي النسخ وما عداها فإنه يكون إما من باب التعادل والتراجيح وإما أنه يمكن التوفيق بينهما.
أما النسخ فسيأتي الكلام عليه في بحث النسخ، وأما التعادل والتراجيح فإن الكلام عليه في باب التعادل والتراجيح للأدلة، وأما التوفيق بين القولَين المتعارضين فإنه يكون بالتدقيق في كل قول منهما لبيان ظروفه وأحواله فيزهر حينئذٍ عدم التعارض، وذلك أن أحوال العمران مختلف بعضها عن بعض، فلا يقاس شيء من أحوالها على الآخر لمجرد الاشتباه، إذ يجوز أن يحصل الاشتباه في أمر ويكون الاختلاف واقعًا في أمور متعددة. لذلك يجب استبعاد التعميم والتجريد في التشريع والسياسة، لأن التشريع هو علاج أفعال العباد ببيان حكمها. والسياسة رعاية شؤون الناس في مصالحهم التي تقوم عليها أفعالهم. وكل منهما متعلق بالحياة وظروفها وأحوالها وهي متعددة ومتخالفة ومتباينة لكنها كثيرًا ما تكون متشابهة فيخشى ألّا يرى فيها هذا التباين أو الاختلاف أو التعدد، فيجر ذلك إلى التعميم أي إعطاء الحكم إلى كل ما هو من جنسها ويجر أيضًا إلى التجريد أي تجريد كل فعل أو كل شأن من الظروف والأحوال المتعلقة به، وهنا يقع الخطأ ومن جراء ذلك يظهر التعارض بين علاجَين لفعل واحد أو شأن واحد، أي يظهر للرائي أن القولين متعارضان، ومن هنا جاء ظن التعارض بين بعض أقوال الرسول مع بعضها الآخر، ولكن عند استبعاد التعميم وجعل كل علاج لما جاء به من حادثة، واستبعاد التجريد أي تجريد الواقعة من ظروفها، فيلاحظ من ربط العلاج بالحادثة نفسها وربط الحادثة بظروفها أن هناك فرقًا بين الحادثتَين ويتبيَّن أن لا تعارض بين الحديثَين لاختلاف ظروف كل منهما وأحواله، أو لارتباط أحدهما بالآخر في جعلهما معًا أساس النظرة للعلاج، وأساس النظرة للحادثة، وليس كل واحد منهما منفردًا عن الآخر. وهذا ما يجب على الفقيه وعلى السياسي أن يقوم به بإفراد كل حادثة عن الأخرى حتى يتبيَّن له بدقة الفارق بينها فيصل إلى أن معالجتها مختلفة ويصل إلى ما هو أقرب إلى الحق والصواب في علاج الحوادث وفي فهم التشريع أو السياسة. وبالنسبة إلى التشريع فإن النصوص التشريعية هي حكم الحوادث والوقائع فمن طبيعتها أن تكون مختلفة ومن طبيعتها أن يظهر بينها كأنها متعارضة، لدقة الاختلاف بينها،ولحتمية وجود التشابه مع هذا الاختلاف.
فيجب على الفقيه أن يدقق في النصوص التشريعية قبل أن يصدر حكمه عليها لأنها ليست تعابير أدبية تدل على معانٍ فقط، بل هي علاج لوقائع لا بد من أن يقرن معانيها التي في ذهنه بالوقائع التي يقع عليها حسه، بحيث يضع أصبعه على الواقع حتى يتأتى له فهم التشريع وإدراك الواقع الذي يعالجه، فيدرك حينئذٍ الفروق الدقيقة بين مدلولات النصوص، ويدرك خطر التعميم وخطر التجريد. وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر إلى الأحاديث النبوية فيدرك حينئذٍ عدم التعارض.
والناظر في الأحاديث النبوية التي يظهر فيها أنها متعارضة يجد أن التوفيق يمكن بينها جميعًا عند التدقيق. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك مثلًا أحاديث يأمر الرسول فيها بأشياء وتعارضها أحاديث أخرى يرفض الرسول قبول هذه الأشياء التي أمر بها، فيظهر حينئذٍ أن بينها تعارضًا، لكن الحقيقة أن لا تعارض بينها. فإن أمر الرسول هو طلب فعل، فهو لا يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة إلا بقرينة، فكونه يأتي بعد هذا الأمر بما يدل على أنه لا يفعله، كان ذلك قرينة على أن الأمر بما يدل على أنه لا يفعله، كان ذلك قرينة على أن الأمر للإباحة، فلا يكون رفضه لقبول الأشياء التي أمر بها مناقضًا لأمره بها بل يكون قرينة على أن أمره للإباحة وليس للوجوب ولا للندب. ومن ذلك ما روي عن قيس بن سعد، قال: «زارنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في منزلنا فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران، فاشتمل بها» فإن هذا الحديث يدل على جواز التنشيف من الغسل ومثله الوضوء، وهذا يعارض ما روي عن أنس: «إن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء» لأنه يدل على أن الرسول لم يفعل التنشيف على الكراهة بدليل أنه حصل منه التنشيف، لكن ذلك إنما يحمل على الكراهة لو كان الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن الشيء وأمر به فإنه يحمل النهي على الكراهة ولكن هنا فعل الشيء مرة ولم يفعله مرة أخرى فلا تعارض بين الفعلَين، ولو فرض أن هناك تعارضًا فيحمل على الإباحة، لأن عدم فعل الرسول لشيء لا يدل على النهي، لأنه كثيرًا ما كان يعرض عن فعل بعض المباحات.
ومن ذلك ما روي عن عياض بن حمار أنه أهدى النبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، هدية فقال النبيُّ، صلى الله عليه وآله وسلم: «أسلمت؟ قال: لا، قال: إني نهيت عن زبد المشركين» ورُوي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: «إن عامر بن مالك ملاعب الأسنة قدم على رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مشرك فأهدى إليه فقال: إني لا أقبل هدية مشرك» فهذان الحديثان يعارضان ما ثبت عن النبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قبل الهدية وأمر بقبولها. وعن علي، عليه السلام، قال: «أهدى كسرى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل منه، وأهداه قيصر فقبل، وأهدته الملوك فقبل منها». وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: «قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت السيدة عائشة النبيَّ، صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [سورة الممتحنة: 8 ـــــــ 9]. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. فيظهر التعارض بين قبول الرسول الهدية من المشرك ورفضه الهدية من المشرك. والجمع بينهما أن رفضه هدية من المشرك قرينة على أن قبول الهدية مباح وليس واجبًا ولا مندوبًا، لأن الرسول كان يرفض كثيرًا من المباحات. وعليه فإنه إذا ورد حديث يدل على امتناع الرسول عن فعل شيء وتصريحه بأنه لا يفعله فليس نهيًا ولا يفيد النهي، فلا يعارض فعل الرسول لذلك الشيء في وقت آخر ولا يعارض أمره بذلك الشيء. وكل ما في الأمر يكون قرينة على أن ذلك الشيء الذي فعله الرسول أو أمر به مباح وليس بواجب ولا مندوب، والرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، قد تجنب كثيرًا من المباحات. ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينها أحاديث ينهى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فيها عن شيء ويأمر به، فمن ذلك التداوي بالنجس وبالمحرمات، فقد وردت أحاديث تنهى عن التداوي بالنجس وعن التداوي بالمحرمات، فعن وائل بن حجر «أن طارقًا بن سويد الجعفي سأل النبيَّ، صلى الله عليه وآله وسلم، عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء». وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوَوا ولا تتداوَوا بمحرَّم».
فهذان الحديثان يعارضان ما ورد من أحاديث يأمر فيها الرسول بالتداوي بالنجس وبالمحرم، عن قتادة عن أنس «أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا على النبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها» الحديث. وعن أنس أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، رخَّص فيها لعبد الرحمن بن عوف والزبير في «لُبس الحرير لِحِكَّةٍ كانت بهما». ورواه الترمذي بلفظ «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوَا إلى النبيِّ، صلى الله عليه وآله وسلم، القمل فرخص لهما في قُمُص الحرير في غزاة لهما» فهذان الحديثان يجيزان التداوي بالنجس والمحرم، فالحديث الأول يجيز التداوي بشرب البول وهو نجس، والحديث الثاني يجيز التداوي بلبس الحرير وهو حرام، والأحاديث التي قبلهما تحرم التداوي بالمحرم والنجس، وهنا يقع التعارض. والجمع بين هذه الأحاديث هو أن يحمل النهي عن التداوي بالنجس والمحرم على الكراهة لأن النهي طلب ترك ويحتاج إلى قرينة تدل أنه طلب جازم أو غير جازم، فكون الرسول يجيز التداوي بالنجس والمحرم في الوقت الذي ينهَى عن التداوي بهما قرينة على أن نهيه عن التداوي بهما ليس نهيًا جازمًا فيكون مكروهًا.
ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينها وبين الأحاديث التي يتحد موضوعها، ولكن تختلف أحوالها، ما روي عن حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: «أتيت النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي ولم نُسْلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا، فقال إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلَمْنا وشهدنا معه» وعن أنس قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تستضيئوا بنار المشركين» وعن أبي حميد الساعدي قال: «خَرَجَ رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: من هؤلاء؟ قالوا بني قينقاع رهط عبد الله بن سلام، قال: أو لم تُسلموا؟ قالوا: لا، فأمرهم أن يرجعوا وقال: إنا لا نستعين بالمشركين، فأسلِموا». فهذه الأحاديث تعارض الأحاديث التي وردت في جواز الاستعانة بالمشركين. عن ذي مخبر قال: «سمعت رسول الله صلى الله، عليه وآله وسلم، يقول: ستصالحون الروم صلحًا تغزون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم».
وعن الزهري أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، استعان بناسٍ من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم، فهذه الأحاديث تدل على جواز الاستعانة بالمشركين، والأحاديث السابقة تدل على عدم جواز الاستعانة بالمشركين، فيبدو أنها أحاديث متعارضة. والجمع بينهما هو أن حديث أبي حميد الساعدي قد قال فيه: «إنا لا نستعين بمشرك» فهو عام وله وللأمة ولذلك يفيد النهي، لكن موضوعه كان كتيبة تقاتل تحت رايتها وليس شخصًا، فيكون النهي عن الاستعانة بجيش يقاتل تحت رايته، والأحاديث التي استعان فيها الرسول قد استعان بأفراد، فيكون الحديثان قد اختلفت فيهما الحال، فالنهي عن الاستعانة إنما هو عن الاستعانة بالجيش يقاتل تحت راية نفسه، والجواز إنما هو للاستعانة بالأفراد. وأما حديث أنس، فإن النار كناية عن الكيان، فالقبيلة توقد لها نارًا إشارة لإعلانها الحرب والاستضاءة بنارها الدخول تحت كيانها فهذا هو المنهي عنه. وحديث الروم يعني أنهم دفعوا لنا الجزية ودخلوا تحت حمايتنا، لأن الصلح يقتضي ذلك فيكونون قد قاتلوا تحت رايتنا، وعليه لا تعارض بين هذه الأحاديث، لأن النهي عن الاستعانة بالمشرك في حالة أن يستعان به بصفته جيشًا وتحت رايته، وجواز الاستعانة بالمشرك إنما هو في حالة كونه فردًا أو جيشًا تحت راية الإسلام. ومن الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة ولكن يمكن التوفيق بينها الأحاديث التي ينهَى الرسول فيها عن أمر نهيًا عامًّا، ولا ينهى عنه نهيًا عامًّا في حال معينة، فتكون الحال المعينة بمقام الاستثناء، أي يكون نقيض الحال التي أباحها علة للنهي.
ومن ذلك ما روي عن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» فهذا الحديث يعارض ما ثبت عنه، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أباح للأفراد ملك عيون الماء ملكية فردية لهم في الطائف والمدينة.
ولكن يمكن الجمع بينهما بأن المياه التي أباح الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، ملكيتها للأفراد لم تكن للجماعة حاجة فيها، فكانت فضلة عما يحتاج الجماعة بدليل أن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول في حديث آخر: «ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه» فمعناه أن الماء الذي يملك ملكية فردية هو الماء الذي ليس للجماعة فيه حاجة فيكون نقيضه وهو الماء الذي للجماعة حاجة فيه والذي يكون الناس شركاء فيه، فتكون هذه هي على كون الناس شركاء فيه، وعليه فلا تعارض بين الحديثين.
وهكذا جميع الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة فإنه عند التدقيق فيها يتبين أنها غير متعارضة للاختلاف الموجود بينها، ومن هذا يتبين أن لا تعارض بين أقوال الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حالة واحدة هي حالة النسخ.
الدليل الثالث: الإجماع
الإجماع في اللغة يعني أحد أمرين:
الأول ـــــــ العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه يقال: أجمع المرء على كذا إذا عزم عليه. قال الله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [سورة يونس: 71] أي اعزموا. وقال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل» أي لمن لا يعزم عليه وينويه من الليل. أي عليه أن يعزم عليه من الليل. وعلى هذا فإن إطلاق لفظ «الإجماع» من الفرد معناه عزمه ولا يتصور له معنًى غيره.
الثاني ــــــ الاتفاق، ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، فاتفاق كل جماعة على أمر من الأمور، دينيًّا ودنيويًّا يسمى إجماعًا.
وأما الإجماع في اصطلاح الأصوليين فهو «الاتفاق بين المسلمين بعد وفاة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي».
وقد اختلف فيمن يكون إجماعهم دليلًا شرعيًّا:
فمنهم من قال: إجماع أمة محمد، صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنهم من قال: إجماع أهل بيت النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دار في فلكهم والمقصود بأهل البيت الأئمة الاثنا عشر وهم: علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، والحسين بن علي، وعلي بن الحسين، ومحمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، حسن العسكري، محمد بن الحسن المهدي المنتظر (سلام الله عليهم جميعًا).
ومنهم من قال: إجماع العلماء على حكم من الأحكام الشرعية.
ومنهم من قال: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم.
ومنهم من قال: إجماع أهل المدينة.
حجية الإجماع:
لكنهم اتفقوا على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به.
وكيفما كان الأمر فالإجماع الذي هو حجة، هو خصوص الإجماع الكاشف عن وجود دليل معتبر، لأن العبرة بذلك الدليل لا به. وليس للإجماع موضوعية بحيث يكون حجة ودليلًا في نفسه مقابل الكتاب والسنّة كما يستشف من مؤلفات بعضهم.
ومن هنا إذا كان الإجماع قد قام على حكم، على خلاف القاعدة أو الدليل، فالذي يعول عليه هو الدليل. فلو قام على حكم تقتضيه القاعدة أو الدليل الذي بين أيدينا، واحتمل استنادَ المجمعين في ذلك إلى القاعدة أو الدليل سقط الإجماع عن الحجة وصار التعويل على الدليل. وبعبارة مختصرة الإجماع الذي هو حجة هو الذي يعلم ولا يحتمل مدركه، ومع معرفة المدرك كان التعويل عليه لا على الإجماع. إذًا فالإجماع ليس دليلًا شرعيًّا بحد ذاته، بل هو يكشف عن دليل من السنّة، أي إن سكوت الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، عن فعل أو قول وأصبح الفعل أو القول شائعًا إثر ذاك، فتعاطاه الصحابة (رضي الله عنهم) وأجمعوا عليه، فأتى المسلمون من بعد يعملون بهذا الإجماع من غير أن يكون الدليل واضحًا، وإلا لو وضح الدليل لسقط حكم الإجماع. وكما يكون الإجماع على حكم واقعة معينة، فإنه يكون على تأويل نصٍ أو تفسيره، أو على تعليل حكم النص وبيان الوصف المنوط به.
الدليل الرابع: القياس أو العقل
القياس في اللغة معناه التقدير للشيء بما يقابله. يقال: قياس الأرض بالمتر، وقست الثوب بالذراع، أي قدَّرته...
ويطلق القياس على التسوية لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما. لذا كان القياس يستدعي أمرَين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة، فيقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان. والقياس في اصطلاح الأصوليين هو إلحاق أمر بآخر أو إلحاق واقعة بأخرى في الحكم الشرعي لاتِّحاد العلَّة بينهما، أي لاتِّحادهما في الباعث على الحكم في كل منهما.
فإن دلَّ نَصٌّ على حكم في أمر، عُرِفَتْ علَّة هذا الحكم، بالطرق التي تُعرف بها علل الأحكام، ثم وُجدت واقعة أخرى تحقق فيها علَّة الحكم المعروفة، فإن هذه الواقعة الأخرى تساوي واقعة النَّص أو تُسَوّى بها في الحكم، أي يُطبَّق عليها الحكم نفسه، بالاستناد إلى تساويهما في العلَّة.
وتعاريف القياس كلها تقتضي وجود مشبَّه ومشبه به «وجه شبه» أي تقتضي مقيسًا ومقيسًا عليه ووجه قياس. والذي يجعل القياس موجودًا هو اشتراك المقيس والمقيس عليه في أمر واحد، أي وجود جامع بينهما، وهذا الأمر الواحد الجامع بين المقيس والمقيس عليه هو الباعث على الحكم أي العلَّة الواحدة.
وما يقتضي توضيحه هو أن القياس لا يكون إلّا بالعقل؛ لأن العقل هو الوحيد الذي يفهم النص الشرعي ويقيس عليه. فالقياس، كما اتفق عليه العلماء، هو دليل شرعي، لكنه من الأدلة التي ذلَّ عليها الكتاب والسنّة؛ وما يجري القياس به هو العقل طبعًا، لأنَّ العقل وحده هو القادر على أن يقيس على العلة الشرعية، وهذا هو القياس المقبول، أمَّا القياس على هوى النفس، فهو قياس باطل ولا أثر له في الأحكام الشرعية.
ونؤكد على القول بأن الذي يجري القياس بوساطته هو العقل، لأن العقل يبذل قصارى جهده لفهم النص كي يستنبط منه العلة الشرعية، وبعد التحقق والتيقُّن بأن ما استنبطه هو علة شرعية يبدأ القياس عليها. ومن هنا نرى أن الذين قالوا بالقياس إنما يكونون قد قصدوا في الحقيقة العقل لأنه هو الذي يقيس، ولأن القياس لا يكون إلا بوساطته، والذين قالوا بالعقل يكونون قد قصدوا القياس على العلة بوساطة العقل، فليس ثمة خلاف بين هؤلاء وأولئك. وإذا ما رأى بعضهم وجود اختلاف فمردّ ذلك مع الأسف، إلى أنه في العصر الهابط الذي نعيش، هنالك كثيرون من العلماء الذين لا يدركون حقيقة معنى العقل ومكنوناته ومقوماته، فكان لزامًا توضيح هذا الأمر حتى لا تلتبس على الناس المفاهيم الصحيحة.
فالعقل، والفكر، والإدراك. تعابير ثلاثة بمعنى واحد، لذلك يمكن القول بأن العقل هو الطاقة أو القدرة التي ينبثق منها فكر أو إدراك لإصدار الحكم على شيء. ولا يمكن أن ينبثق مثل هذا الفكر أو الإدراك طبعًا إلَّا من إنسان عاقل أي صاحب تفكير وإدراك، وإصدار الحكم على الشيء لا يكون أيضًا إلَّا بناء على ما تحصّله الحواس الخمس من أحاسيس بوقائع معينة تتكون بنتيجتها القدرة على إعطاء الحكم على الشيء... فالحواس الخمس (البصر والسمع واللمس والشم والذوق) تقع على الأشياء الموجودة في الواقع، وهي التي تنقل إلى الدماغ ما وقعت عليه، والدماغ بدوره ينطوي على قدرة ربط المعلومات وعلى قابلية التمييز، وهذه القدرة على الربط والتمييز هي خاصية للإنسان وحده، وهذه الخاصية هي بحقيقتها العقل الذي خصَّ الله تعالى به الإنسان على سائر الكائنات الأرضية. ووجود هذا العقل في الإنسان هو الذي جعله مناط التكليف في الدنيا، وكتب عليه الحساب وبنتيجته الثواب أو العقاب في الآخرة.
فالعقل هو الذي ينتج الأفكار التي تعبّر عن وقائع الحياة وموجوداتها، وهو الذي يمكّن من إصدار الأحكام على تلك الوقائع والموجودات أي التمييز في ما بينها، وإعطاء حكم خاص بكل منها.
وعوامل العقل أو التفكير أربعة:
ـــــــ عاملان يدخلان في تكوين الإنسان وهما: الحواس الخمس (وهي مراكز تلقّي المعلومات) والدماغ (وهو مركز التمييز).
ـــــــ وعاملان يخرجان عن تكوين الإنسان وهما: حقيقة الواقع، واسمه.
وتنطلق العملية الفكرية من اجتماع هذه العوامل الأربعة. وتكون نقطة الانطلاق دائمًا من الواقع المحسوس، فإذا نقلنا معلومات صحيحة عن هذا الواقع كان الحكم عليه صحيحًا، وإذا نقلنا عنه معلومات خاطئة كان الحكم عليه خاطئًا.
من هنا كان العقل هو الذي يجري بوساطته القياس لتطبيق حكم شرعي يعود لأمر معين على أمر آخر إذا اتحدت العلة الشرعية بين الأمرين.
وبناء عليه فلا يدخل في القياس قياس حكمٍ على حكم للتماثل بينهُما. فالقياسُ المعتبَرُ هو الذي يرجعُ إلى النصِّ نفسِه لا غير. والمرادُ بالقياسِ القياسُ الشرعيّ لا القياسُ العقليّ، أي القياسُ الذي وجدَتْ فيهِ أمارةٌ من الشرعِ تدلّ على اعتبارِهِ، أي وجدتْ فيهِ علّةٌ شرعيّةٌ ورد بها نصّ شرعيّ معيّنٌ.
وأمّا القياسُ العقليّ الذي يفهَمهُ العقْلُ منْ مجموعِ الشرعِ، من دونِ أنْ يكونَ هناكَ نصّ معيّنٌ يدلّ عليهِ، أو الذي يفهَمهُ منْ قياسِ حكمٍ على حكمٍ لمجرّدِ التماثُلِ عقلًا، من دونِ أنْ يكونَ هناكَ باعثٌ على حكمٍ وردَ بهِ الشرعُ. فإنّ ذلكَ كلّهُ لا يجوزُ بَوجْهٍ منَ الوجوهِ.
أمّا ما قالوهُ في أحكامِ الغَصْبِ من أنّ على الغاصِبِ رَدّ عينِ المغصوبِ ما دامَ قائمًا، وَردّ مثله أو قيمتِهِ إذا تلف، فيقاسُ على تَلَفِ المغصوب تغييرُ عينهِ تغييرًا يجعلُهُ شيئًا آخرَ غيرَ الأوّلِ، كطحْنِ الحنطةِ المغصوبةِ، أو صنْعِ قطعةِ الفولاذِ سيْفًا أو ما شاكلَ ذلكَ، لأنّهُ يُشْبِهُ التلف في زوالِ العين الأولى، فهذَا ليسَ منْ قياسِ الحكمِ بل هو من قياسِ العلّةِ. فالتلَفُ عِلّةُ الرّدّ فيُقاسُ على هذهِ العلّةِ كلّ ما تحقّقَ فيها ممّا يجعلُها عِلّةً، والذي جَعَلَهَا عِلّةً زوالُ عيْنها، فكلّ ما تزولُ بهِ العينُ يُعدّ عِلّةً قياسًا على التلفِ، لذلكَ كانَ تغييرُ العَينِ عِلّةً كالتلفِ إذا زالتْ بهِ العينُ عما كانتْ عليهِ، فحكمُ الغصْبِ ردّ العينِ المغصوبةِ عملًا بعمومِ قولِ رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤَدّيه» فإنّهُ دليلٌ على أنّهُ يجبُ على الإنسانِ ردّ ما أخذتْهُ يدهُ من مالِ غيرِهِ كونه عينًا أو إجارةً أو غصبًا. ولكنْ إذا تلفت العينُ المغصوبةُ فعلى الغاصبِ رَدّ مثلِها أو قيمتها لما رُويَ عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَسرَ شيئًا فهوَ لهُ وعليهِ مثلهُ»، فهذا دليلٌ على حكمِ المتلفِ منه تلَف عينِ المغصوبةِ، والتلَفُ علّةٌ لردِّ القيمةِ أو المثلِ فيكونُ دليلًا على العِلَّةِ، ومن هنا لا يأتي قياسٌ على حُكْمٍ لمجردِ التشابه بينَ الوظيفتينِ بلْ لا بدَّ منْ أن تكونَ هناكَ علّةٌ دَلّ عليها الدليلُ الشرعيّ:
هذا هو القياسُ الشرعيّ الذي يُعدُّ دليلًا شرعيًّا.
والقياس من الأمور الدقيقة جدًّا، وينبغي أن يعلم أن هذا القياس إنما هو لذوي العقول التي تفهم النصوص والأحكام والحوادث، وليس هو لكل واحد من الناس يقوم به بحسبما يهوى ووفق ما يشتهي، بل لا بد من أن يكون لمن آتاهم الله بصيرة وفهمًا وإلا كان وسيلة من وسائل الهدم والبعد من حقيقة حكم الله تعالى.
والقياس إنما هو إلحاق فرع بأصل. لذلك لا يعني القياس العموم في عبارة النص العام ولا يُعدّ من القياس، لأن النص العام يشمل جميع الأفراد الداخلة في مفهومه فقط. فقوله تعالى: {وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة النساء: 25] لفظ عام يشمل إجارة المرضع والعامل والدار والسيارة وغير ذلك، ولا يقال قيست إجارة العامل على إجارة المرضع أو قيست إجارة السيارة على إجارة العامل بل هي داخلة تحته وفرد من أفراده. وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [سورة المائدة: 3] لفظ عام يشمل جميع أنواع الميتة سواء أكانت معبأة في علب أم لا، فلا يقال إن تحريم لحم العلب الذي لم يذبح حيوانُه ذبحًا شرعيًّا قياس على لحم الميتة، بل لحم العلب هذه لحم ميتة فهو داخل تحت الميتة وفرد من أفرادها. أما القياس فإنه يجعل النصوص شاملة لما يدخل في معقولها من أنواع الحوادث وأفرادها بطريق الإلحاق للاشتراك في العلة، فمثلًا ثبت في أحكام الشريعة أن الأجير يجبر على القيام بما استؤجر عليه لأن الإجارة من العقود الجائزة، لكن الوكيل إذا وكل بأجرة فحينئذٍ يقاس على الأجير، لأن الوكيل بأجرة كالأجير بأجرة لوجود الأجرة لكل منهما، وعُدّ الوكيل في حالة أخذه أجرة مجبرًا على القيام بما وكل به لأنه بتقاضيه الأجرة أصبح كالأجير، لأن الأجرة هي الباعث على حكم الإلزام في الإجارة فكذلك تكون الوكالة الباعث على حكم الإلزام.
وهذا ما يكون ما لو كان وكيلًا من غير أجر فلا يجبر ولا يقاس على الأجير لعدم وجود الأجرة الموجودة في الأجير، ولهذا فإن القياس لا يعني العموم، بل يعني جعل النص يشمل أنواعًا أخرى أو أفرادًا أخرى من الحوادث لا بلفظه بل بطرائق الإلحاق لاشتراكها مع ما جاء فيه في العلة. ومن ذلك يتبين أن وجود أركان القياس أمر حتمي ليتأتى القياس، فإذا انتفى ركن واحد منها لا يصح القياس، لذلك لا بد من معرفة أركان القياس التالية:
ـــــــ الفرعُ الذي يُرادُ قياسُهُ.
ـــــــ الأصْلُ الذي يُرادُ القياسُ عليهِ.
ـــــــ الحكم الشرعيُّ الخاصّ بالأصلِ.
ـــــــ العِلّةُ الجامعةُ بينَ الأصلِ والفرْعِ.
ومثالُه تحريمِ الإجارَةِ عندَ أذانِ الجمعَةِ قياسًا على تحريمِ البَيْعِ عنْدَ أذانِ الجمعةِ، لوجودِ العلّةِ وهي الإلهاءُ عن صلاةِ الجمعَةِ، فالفرعُ هنا الإجارَةُ، والأصلُ البَيْعُ.
والحُكْمُ الشرعيّ الخاصّ بالأصلِ التحريمُ الموجودُ في البيْعِ عندَ أذانِ الجمعةِ والعِلّةُ هيَ الإلهاءُ عنْ صلاةِ الجمعةِ.
وليسَ حكمُ الفرْعِ منْ أركانِ القياسِ إذ الحكمُ في الفرع متوقف على صحّةِ القياسِ فلو كانَ ركنًا منهُ لتوقّفَ على نفسهِ وهو محالٌ.
وعلى هذا فشروطُ القياسِ لا تخرجُ عن شروطِ هذهِ الأركانِ فمِنْها ما يعودُ إلى الفرْعِ، ومنها ما يعودُ إلى الأصلِ، ومنها ما يعودُ إلى حُكْمِ الأصلِ، ومنها ما يعودُ إلى العِلّةِ.
الفرع وشرُوطه:
الفَرْعُ هو نَفْسُ المــُــــتَنَازَعِ فيهِ، وهو مَقيسٌ، ويتطلب خمْسَة شروطٍ:
1 ـــــــ أنْ يكونَ خاليًا منْ مُعارِضٍ راجحٍ يقتضي نَقيضَ ما اقتضتّهُ عِلّةُ القِياسِ.
2 ـــــــ أنْ تكونَ العِلّةُ الموجودةُ فيهِ مُشاركةً لِعِلّةِ الأصلِ. إمّا في عينِها وإمّا في جنسِها.
3 ـــــــ أنْ يكونَ الحكْمُ في الفرْعِ مماثلًا لحُكْمِ الأصْلِ في عينِه، كوجوبِ القصاصِ في النّفْسِ.
4 ـــــــ ألّا يكونَ حُكْمُ الفرْعِ منصوصًا عليه.
5 ـــــــ ألّا يكونَ حُكْمُ الفَرْعِ مُتقدّمًا على حُكْمِ الأصلِ.
الأصل وشروطه:
الأصلُ ما بُني عليهِ غيرُهُ، أي ما عُرِفَ بنفسِهِ، منْ غيرِ افتقارٍ إلى غيرِهِ وهو مقيسٌ عليهِ، وشَرْطهُ ثبوتُ الحكْمِ فيهِ، لأنّ إثباتَ مثلِ حُكْمِ الأصلِ في الفرْعِ فَرْعٌ عن ثبوتِه فيهِ، لذلكَ يُشتَرَطُ في الأصلِ. ثبوتُ الحكمِ فيهِ.
شرُوط حُكمِ الأصل:
يُشترَطُ في حُكْمِ الأصلِ خمْسَةُ شرُوطٍ:
1 ـــــــ أنْ يكونَ حُكْمًا شرْعيًّا تابعًا بدليلٍ منَ الكتابِ، أو السنّةِ أو الإِجماعِ.
2 ـــــــ ألّا يكونَ الدليلُ الدالّ على حُكْمِ الأصلِ مُتناولًا للفرع.
3 ـــــــ ألّا يكونَ الدّليلُ الدّالّ على إثباتِ حُكْمِ الأصلِ دالًّا على إثباتِ حُكْمِ الفَرْعِ، وإلّا فلنْ يكونَ أحدهُما أصلًا للآخَرِ ولا يكونَ أحدُهُما أوْلى منْ أخيهِ.
4 ـــــــ أن يكون حكمُ الأصل مُعلَّلًا بعلة معينة غير مُبهمةٍ.
5 ـــــــ أن يكون حكم الأصل غير متأخرٍ عن حكم الفرع.
العِلَّة
العلَّة هي الشيء الذي من أجله وجد الحكم، أو بعبارة أخرى هي الأمر الباعث على الحكم، أي الباعث على التشريع لا على القيام بالحكم وإيجاده، ومن هنا كان لا بد من أن تكون وصفًا مناسبًا أي وصفًا مفهمًا، بمعنى أنه لا بد من أن يكون الوصف مشتملًا على معنى صالح لأن يكون مقصودًا للشارع من تشريع الحكم. فلو كانت العلة وصفًا طرديًّا، أي غير مشتمل على معنى صالح لأن يكون مقصود الشارع من تشريع الحكم بل كان إمارة مجردة، فالتعليل به ممتنع لأنه حينئذٍ يكون إمارة على الحكم أي علامة عليه، فلا فائدة منه سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه، لذلك كان من الخطأ تعريف العلة بأنها المعرفة للحكم، لأن هذا يعني أنها أمارة مجردة، مع أن واقعها يبيِّن أنها ليست أمارة بل هي الباعث على التشريع، وعليه وإن كانت العلة دليل الحكم، لكن هناك فرقًا بينها وبين الخطاب في كونه دليلًا.
فالخطاب دليل على الحكم وهو علامة عليه ومعرِّف له، والعلة كذلك أيضًا، لكن العلة إلى جانب ذلك هي الأمر الباعث على الحكم، فهي الأمر الذي من أجله شُرِّع الحكم، ففيها إلى جانب التعريف العلِّية، أي الدلالة على الشيء الذي من أجله صار شرع الحكم، معقول النص. فالنص إن لم يشتمل على علة كان له منطوق، وكان له مفهوم، وليس له معقول، فلا يلحق به غيره مطلقًا، لكنه إن كان مشتملًا على علة بأن اقترن الحكم فيه بوصف مفهم، فيكون له منطوق ويكون له مفهوم ويكون له معقول، فيلحق به غيره، فوجود العلة جعل النص يشمل أنواعًا أخرى من الحوادث لا بمنطوقه ولا بمفهومه بل بطريق الإلحاق لاشتراكها مع ما جاء فيه من العلة.
ففي العلة إذًا شيء جديد زيادة على الدلالة على الحكم وهو الأمر الباعث على تشريع الحكم...
فتعريفها، بأنها المعرّفة للحكم، غير سديد، لأنه قاصر عن الدلالة على ماهيتها. ولهذا تعرف بأنها الباعث على الحكم، فيفهم منه أنها المعرِّفة له كذلك.
ثم إن العلة قد تأتي في دليل الحكم، فيكون الحكم قد دل عليه الخطاب ودلت عليه العلة التي تضمنها الخطاب، كقوله تعالى: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [سورة الحشر: 7].
ثم قال: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [سورة الحشر: 8] الآية. فالآية دلَّت على الحكم وهو أعطاء الفيء للفقراء المهاجرين. لذلك أعطى الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الفيء الذي نزلت في حقه الآية ـــــــ وهو ما غنم المسلمون من بني النضير للمهاجرين فقط، ولم يُعط سوى رجلين من الأنصار تحقق بهما الفقر، وكذلك العلة التي جاءت في قوله: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ} أي كي لا يبقى متداولًا بين أيدي الأغنياء بل ينتقل إلى غيرهم، دلت على الحكم، وكانت هي الباعث على تشريعه.
وقد روي عنه، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سئل عن جواز بيع الرُّطب بالتمر فقال: أينقص الرُّطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فقال: فلا، إذًا.
فالحديث دل على الحكم وهو عدم جواز بيع الرُّطب بالتمر، وكذلك العلة التي جاءت في الحديث، وهي كون الرُّطب ينقص إذا يبس، دلت على الحكم وكانت هي الباعث على تشريعه ففي هذين المثالَين جاءت العلة في دليل الحكم.
وقد يأتي الدليل دالًّا على العلة وكان المقصود دلالته عليها، فتكون العلة قد دلت على الحكم وكانت الباعث على تشريعه، فحكم الغصب ردُّ العين المغصوبة عملًا بعموم قول رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديَه» فإنه دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غصب حتى يرده إلى مالكه. ولكن إذا تلفت العين المغصوبة فإن على الغاصب رد مثلها أو قيمتها لما روي عن أنس أنه قال: أهديت بعض أزواج النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، طعامًا في قصعة، فضربت السيدة عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: «طعام بطعام وإناء بإناء» وفي رواية ابن أبي حاتم قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله» فهذا دليل على حكم المتلف ومنه تلف العين المغصوبة، والتلف علّة لرد القيمة أو المثل، فيكون دليلًا على العلة.
وحكم مال الفرد أيضًا فإنه محترم ولا يؤخذ من الشخص إلا بطيب نفسه عملًا بعموم قول رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» ولكن إذا كان منعه يؤدي إلى ضرر يؤخذ جبرًا عنه فقد روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار، وللرجلِ أن يضع خشبه في حائط داره». فالحديث يدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع، مع أن الجدار ملك للشخص فله أن يمنع جاره، غير أن منع جاره من غرز خشبه يضره، فإزالةً للضرر أُجبر على أن يسمح لجاره، فالعلة هي الضرر، فهذا دليل على منع الضرر، والضرر علة لإجبار المالك على التنازل عن ملكه، فيكون دليلًا على العلة. فالتلف في المثال الأول والضرر في المثال الثاني كل منهما علة شرعية، وقد جاء الدليل شاهدًا على كل منهما. وعلى ذلك فإنه ليس شرطًا أن يكون دليل العلة هو دليل الحكم بل قد يكون دليلها الحكم وقد يكون المقصود في دليلها الدلالة عليها. ومعرفة العلة غير متوقفة على الحكم لكونها ثابتة بالنص فلا تتوقف على الحكم لكنها متوقفة على وجود الدليل. فالحكم وحده ـــــــ ولو جاء دليل يدل عليه ـــــــ لا يدل على العلة لأنها غير الحكم، ولأنه لا يصلح دليلًا عليها. ومن هنا لا يأتي قياس حكم على حكم لمجرد التشابه بين الوظيفتين، بل لا بد من أن تكون هناك علة قد دل عليها الدليل الشرعي.
وعليه فإن الحكم والعلة شيئان مختلفان، وكل منهما يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنّة أو إجماع يدل عليه... فدلالة الدليل على الحكم لا تكفي للدلالة على وجود العلة، بل لا بد من أن يكون هناك دليل يدل عليها، سواء في دليل الحكم نفسه بنص خاص بالدلالة عليها، أو في دليل مقصود به الدلالة على العلة. لكن العلة نفسها تكون دليلًا على الحكم، ولا يحتاج إلى دليل آخر، لأنها هي نفسها دليل، إذ إنها معقول النص، فهي كمنطوق النص وكمفهومه. ومن هنا كان تعريفها ـــــــ بأنها الباعث على الحكم ـــــــ من أدق التعاريف لها.
ولما كان تعريف العلّة بأنها الشيء الذي من أجله وُجد الحكم يُوجِدُ اشتباهًا بينها وبين السبب، ويُوجِدُ اشتباهًا بينها وبين المناط، لذلك كان لا بد من بيان الفرق بين العلة والسبب والفرق بين العلة والمناط.
الفرق بين العلة والسبب:
السبب هو ما يلزم من وجوده وجود، ومن عدمه العدم، ولم يكن هو الباعث على تشريع الحكم، فالسبب متعلق بوجود الحكم في الواقع وليس متعلقًا بتشريع الحكم لمعالجة الواقع، كمشاهدة هلال شهر رمضان الذي هو سبب لوجوب الصوم على من شاهده. فالسبب دل على وجود الوجوب لا على الباعث على الوجوب أي لا على سبب الوجوب، ووجود الوجوب غير سبب الوجوب. وهذا بخلاف العلة فإنها الشيء الذي من أجله وُجد الحكم أي شُرع، أي هي الباعث على تشريع الحكم، فهي متعلقة بتشريع الحكم لا بوجوده بالفعل، فهي سبب لوجوب الحكم وليست سببًا لوجوده. والسبب يأتي قبل وجود الحكم، فإذا وجد أصبح وجود الحكم الواجب المشرَّع واجبًا. وقبل أن يوجد السبب يكون الحكم المشرَّع واجبًا على المكلف.
لكن وجود هذا الوجوب يتوقف على وجود السبب، بخلاف العلة فإنها تصاحب تشريع الحكم إذ هي الباعث على شرع الحكم.
فمثلُ رؤية هلال شهر رمضان الذي أوردناه سابقًا، يُظهر السبب لوجود وجوب الصوم، فهي سابقة على الصوم، بخلاف شلالات المياه العامة التي تولد الكهرباء مثلًا، فإنها علة لجعل الكهرباء ملكية عامة، فهي مصاحبة لتشريع الحكم، وكون الشلالات ملكية عامة مصاحب لحكم الكهرباء المتولدة منها، هو الباعث على الحكم. وأيضًا فإن السبب خاص بما كان سببًا له ولا يتعداه إلى غيره فلا يقاس عليه، وهذا بخلاف العلة فإنها ليست خاصة بالحكم الذي شرع لأجلها بل تتعداه إلى غيره ويقاس عليه ويقاس عليها. فمثلًا حلول وقت صلاة المغرب سبب لجواز أداء صلاة المغرب وليس سببًا لوجوبها وهو لا يصلح سببًا لغير صلاة المغرب فلا يقاس عليه. لكن كون الإلهاء عن الصلاة علة لتشريع حكم تحريم البيع عند أذان الجمعة كما دل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة: 9]. ليس خاصًا بالبيع بل متى تحققت في غير البيع تعدى الحكم لهذا الغير فبوساطتها يقاس على الحكم فتحرم الإجارة والسباحة والكتابة وغيرها عند آذان الجمعة.
فالعلة هي الباعث على تشريع الحكم والسبب هو الباعث على إيجاد الحكم بالفعل أي على القيام به.
وعلى هذا فقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [سورة الإسراء: 78] ليس علة بل هو سبب، إذ دلوك الشمس سبب لإقامة الصلاة وليس علة.
وما روي عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلّي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ليس علة بل هو سبب، إذ غروب الشمس وتواريها بالحجاب سبب لإقامة صلاة المغرب وليس علة لها. فهذا كله وأمثاله من قبيل الأسباب وليس من قبيل العلل لأن كلًّا من دلوك الشمس وغروبها سبب لوجود الحكم بالفعل وليس سببًا لوجوبه، أي هي سبب لإيجاده من المكلف المعيَّن وليست سببًا لتشريعه. ومن هنا يتبين أن ما ورد في العبادات من كونها أسبابًا وليست عللًا يجعل العبادات توقيفية لا تعلل ولا يقاس عليها. لأن السبب خاص بما كان سببًا له، وهو القيام بالحكم وليس تشريعه.
الفرق بين العلة والمناط:
العلة هي الشيء الذي من أجله وُجد الحكم أو بعبارة أخرى هي الأمر الباعث على الحكم، أي هي الشيء الدال على مقصود الشارع من الحكم، وهذه لا بد لها من دليل شرعي يدل عليها حتى يفهم أنها هي مقصود الشارع من الحكم. أما المناط فهو ما أناط الشارع الحكم به وعلّقه عليه، أي هو المسألة التي ينطبق عليها الحكم وليس دليله ولا علته.
والمناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعليق والإلصاق، قال حبيب الطائي:
بلادٌ بها نِيطتْ عليَّ تمائمي وأولُ أرض مسَّ جِلْدي ترابُها
أي عُلِّقت عليَّ الحُروز بها، وهذا المعنى اللغوي هو المقصود من كلمة المناط بالنسبة إلى الحكم، إذ لم يرد لها معنى شرعي غيره فيكون معناها اللغوي هو الذي يجب أن تفسر به وأن يكون هو المقصود.
وعلى هذا فإن كلمة المناط يراد منها الشيء المتعلق به الحكم.
ومعنى نيط به: أي ارتبط الحكم به وتعلَّق. وبناء على ذلك فإن تحقيق المناط هو النظر في واقع الشيء الذي جاء الحكم لأجله لمعرفة حقيقته، أي إن الحكم الذي جاء قد عُرف دليله وعُرفت علته، ولكن هل ينطبق على هذا الشيء بذاته أم لا؟
فالنظر في انطباق الحكم المعروف دليله وعلته على فرد من الأفراد هو تحقيق المناط، فمناط الحكم هو الناحية غير النقلية في الحكم الشرعي.
فالمناط ـــــــ إذن ـــــــ هو ما سوى النقليات والمراد به الواقع الذي يطبَّق عليه الحكم الشرعي. فإذا قلت: الخمر حرام، فإن الحكم الشرعي هو حرمة الخمر. أمَّا تحقيق كون الشراب المعيَّن خمرًا أو ليس بخمر ليتأتى الحكم عليه بأنه حرام أو ليس بحرام فهو تحقيق المناط. ولا بد من النظر في كون الشراب خمرًا أو غير خمر حتى يقال عنه إنه حرام. وهذا النظر في حقيقة الشراب هل هو خمر أم لا، هو تحقيق المناط، وإذا قلت: الماء الذي يجوز منه الوضوء هو الماء المطلق، فإن الحكم الشرعي هو كون الماء المطلق هو الذي يجوز منه الوضوء.
فتحقيق كون الماء مطلقًا أو غير مطلق ليتأتى الحكم عليه بأنه يجوز منه الوضوء أو لا يجوز، هو تحقيق المناط، فلا بد من النظر في كون الماء مطلقًا أو غير مطلق حتى يقال إنه يجوز الوضوء منه أو لا يجوز، وهذا النظر في حقيقة الماء هو تحقيق المناط.
وإذا قلت: إن المـُــحدِث يجب عليه الوضوء للصلاة، فإن الحكم الشرعي هو كون المحدث يجب عليه الوضوء للصلاة، فتحقيق كون الشخص مُحْدِثًا أو ليس بمُحدِث هو تحقيق المناط، وهكذا. فتحقيق المناط في هذه الأمثلة هو تحقيق كون الشراب المعيَّن خمرًا أو ليس بخمر، وتحقيق كون الماء مطلقًا أو غير مطلق، وتحقيق كون الشخص مُحْدِثًا أو ليس بمُحدِث.
فالمناط فيها هو الشراب والماء والشخص، وتحقيق المناط هو الوقوف على حقيقة هذه الأشياء من حيث كون الحكم الشرعي المتعلق بها ينطبق عليها أم لا. فتحقيق المناط ـــــــ كما أصبح واضحًا ـــــــ هو النظر في معرفة وجود الحكم الشرعي في آحاد الصور بعد معرفته من الدليل الشرعي أو من العلة الشرعية. فجهة القبلة هي مناط وجوب استقبالها، ووجوب استقبالها هو الحكم الشرعي، وهو معروف من قبل قد دل عليه قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [سورة البقرة: 150] وكون هذه الجهة هي جهة القبلة هو المناط، فتحقيق هذا في حالة الاشتباه هو تحقيق المناط، فتحقيق المناط هو تحقيق الشيء الذي هو محل الحكم.
وعليه فإن المناط غير العلة، وتحقيق المناط غير العلة، لأن تحقيق المناط هو النظر في حقيقة الشيء الذي يراد تطبيق الحكم عليه كالنظر في الشراب هل هو خمر أم لا؟ والنظر في الماء هل هو مطلق أم لا؟ والنظر في الشخص هل هو مُحْدِث أم لا؟ والنظر في الجهة هل هي القبلة أم لا؟ وهكذا. أما تحقيق العلة فهو النظر في الباعث على الحكم كالنظر في قوله، صلى الله عليه وآله وسلم: أينقص الرُّطب إذا يبس؟ حين سئل عن بيع الرُّطب بالتمر، وقال: فلا، إذن، هل يفيد العلية أم لا؟ وكالنظر في قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [سورة الحشر: 7]. هل يفيد العلية أم لا؟ وكالنظر في قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة: 9] مع قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [سورة الجمعة: 10]. هل يستنبط منها علة أم لا؟ وكالنظر في قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [سورة التوبة: 60] هل يدل على علة أم لا؟ وهكذا... فتحقيق المناط يرجع إلى العلم بما لا يُعرف ذلك الشيء إلا به، فهو يرجع إلى غير النقليات، إلى العلوم والفنون والمعارف التي تعرف ذلك الشيء، فبوساطة المراصد والحساب نحدد المواقيت، وبوساطة البوصلة نحدد وجهة القبلة، لذلك لا يُشترط فيمن يحقق المناط أن يكون مجتهدًا. وهذا هو الفرق بين العلة والمناط، وبالتالي الفرق بين تحقيق العلة وتحقيق المناط.
وحين يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر ذلك إلى مجتهد مستوفٍ شروط الاجتهاد الشرعية حتى يعلم منه تحقيق المناط أي حتى يحقق المناط بمعنى أنه لا يفتقر إلى معرفة بالأدلة الشرعية ولا إلى معرفة بالعربية، لأن المقصود من هذا الاجتهاد هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، أي بالشيء الذي يراد تطبيق الحكم الشرعي عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يُعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قُصدت المعرفة به، فلا بد من أن يكون ذلك الشخص عالمـــًا بهذه المعارف التي تتعلق بذلك الشيء ليعطيَ الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضي، سواء أكان ذلك الشخص هو المجتهد أم كان شخصًا آخر غيره يرجع إليه المجتهد لمعرفة الشيء، أم كان كتابًا شرح ذلك الشيء. فتحقيق المناط لا يشترط فيه ما يشترط في الاجتهاد من علم بالأمور الشرعية وعلم بالعربية، بل يكفي فيه أن يعرف الموضوع المراد تطبيق الحكم عليه ولو كان جاهلًا كل الجهل في سواه كالمحدِّث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها وصحيحها من سقيمها وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به، فهذا يُعدّ علمه فيما هو متعلق بالحديث، سواء أكان عالمـــًا بأمور الشريعة أم لا، وعارفًا بالعربية أم لا. ومثلُه الطبيب في العلم بالأدواء والأمراض، والصانع في معرفة عيوب الصناعات، وعُرفاء الأسواق في معرفة قِيَمِ السِّلع ومداخل العيوب فيها، وعالم اللغة في معرفة اللفظة ومعناها، والمخترع للآلات والعالم في الذرة،والخبير في علوم الفضاء ونحو كل هذا وما أشبهه مما يُعرف بوساطته مناط الحكم الشرعي ولا يشترط فيه أن يكون مجتهدًا حتى ولا أن يكون مسلمًا، لأن المقصود من تحقيق المناط هو الوقوف على حقيقة الشيء، وهذا لا دخل له بالاجتهاد ولا بالمعارف الشرعية ولا باللسان العربي، بل القصد منه محصور بأمر معيَّن وهو معرفة الشيء.
وتحقيق مناط الحكم أي الشيء المراد تطبيق الحكم عليه أمر لا بد منه قبل معرفة الحكم، ولا يمكن معرفة الحكم إلا بعد تحقيق مناطه، فإن كُلَّ دليل شرعي مبني على مقدمتين: إحداهما راجعة إلى تحقيق المناط، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. فالأولى عقلية بحتة أي تثبت بالفكر والتدبر وهي ما سوى النقلية، والثانية نقلية أي تثبت بفهم النص الشرعي الذي صح نقله وهو الكتاب والسنّة والإجماع.
فعلى المجتهد أولًا أن يتفهم حقيقة الحادثة أو الواقعة أو الشيء الذي يريد بيان الحكم الشرعي بشأنه. وبعد أن يقف عليه ينتقل لفهم النقليات، أي لفهم النص الشرعي المراد استنباط الحكم منه لتلك الحادثة أو الواقعة أو الشيء، أو لفهم الحكم الشرعي المراد تطبيقه على تلك الحادثة أو الواقعة أو الشيء، أو لفهم الحكم الشرعي المراد تطبيقه على تلك الحادثة أو الواقعة أو الشيء. أي لا بد من أن يلاحظ حين استنباط الأحكام وحين تبنِّيها فهم الواقع والفقه فيه ثم فهم الواجب في معالجة هذا الواقع من الدليل الشرعي وهو فهم حكم الله الذي حكم به في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وبعبارة أخرى أن يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله تعالى.
الخلاصة:
ممَّا تقدَّم نجد أن هنالك دليلَين لاستنباط الأحكام الشرعية وهما الكتاب والسنّة، ودليلَين آخرين يدل عليهما الكتاب والسنّة وهما: الإجماع والقياس أو العقل. أمَّا الإجماع فليس بدليل شرعيّ بحد ذاته بل هو يكشف عن دليل من الكتاب والسنّة؛ والقياس يتم بوساطة العقل أي عندما يقيس العقل على العلة الشرعية بعد فهم العلة من الدليل الشرعي.
وأما ما عدّه كثيرون من الأدلة الشرعية، غير الدليلَين الأصليَّين: الكتاب والسنّة، والدليلَين الآخرَين اللَّذين دلَّ عليهما الكتاب والسنّة أي الإجماع والقياس... وما هو خلاف هذه الأدلة لا يمكن الاعتماد عليها؛ وقد اختلف العلماء في ما بينهم على صحتها.
ومن المفيد أن نعود فنكرر ما قاله العلامة محمد باقر الصدر في كتابه «الفتاوى الواضحة»: حيث يذكر المصادر الشرعية التي اعتمدها فيقول: «ونرى من الضروري أن نشير أخيرًا بصورة موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي الكتاب الكريم والسنّة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورِّعين في النقل مهما كان مذهبهم. أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغًا شرعيًّا للاعتماد عليها.
وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدِّثون في أنه: هل يسوغ به العمل أو لا؟ فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به لكننا لم نجد حكمًا واحدًا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي هو ثابت في الوقت عينه بكتاب أو سنّة.
وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرًا إلى جانب الكتاب والسنّة وإنما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات».
وهكذا نحن نجزم بالقول بعد التحقيق والتدقيق أن المصدرَين الوحيدين للتشريع هما الكتاب والسنّة، ونبتهل إلى الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهما لأنه من تمسك بهما فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وعلينا ألّا ننسى أنَّ هذا القول قد صدرَ عن مفكر كبير، وعالم جدير بكل تقدير في القرن العشرين، كان همّهُ الأول والأخير جمع كلمة المسلمين على أساس من الكتاب والسنّة. ولا يسعنا إلا أن نقف وقفة مدقق في هذه الأدلة التي تجاوزت الكتاب والسنّة وما دل عليهما الكتاب والسنّة ونقول أمام الله العظيم ورسوله الحكيم نحن ملتزمون بقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [سورة الحشر: 7] والرسول الكريم أتانا بالكتاب وبالسنّة.
إذن، علينا أن نعود إلى ما اصطلح عليه الكتاب والسنّة لأنه هو المصطلح الذي لا يجوز الخلاف عليه، وأما المصطلحات التي قدمناها نحن لبني البشر هي التي قام عليها الخلاف، فعلينا إذًا الابتعاد عن كل مصطلح سبب لنا التفرقة وأبعدنا عن توحيد الرأي تجاه أمورنا المصيرية.
واحذروا أيها المسلمون من المصطلحات الكثيرة التي وضعناها، لأن معظمها يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، وهي سبب بلاءنا، وعودوا إلى ما اصطلح عليه القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة يكتب لكم النجاح والفلاح بإذن الله تعالى.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢