نبذة عن حياة الكاتب
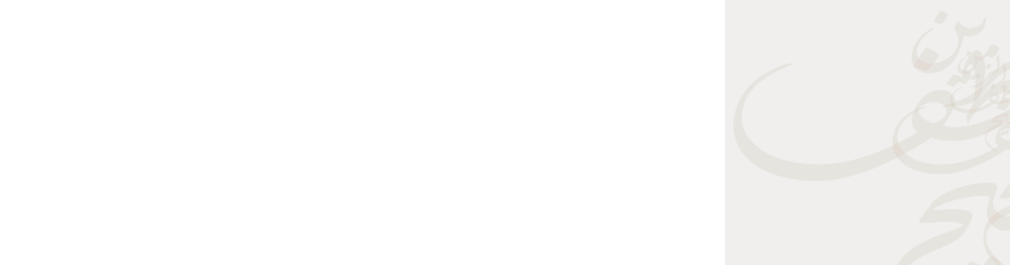
X
خَاتَمُ النَّبييِّن مُحَمَّد (ص) - الجزء الثاني
البحث الأول: بناءُ المُجتمع الإسلاَمي
بناء مسجد المدينة:
أقام رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في منزل أبي أيوب (الأنصاري)، وكان أول ما عمد إليه العمل على الإعلان عن نهج الإِسلام في البناء والتوحيد. ولذلك دعا إليه معاذَ بن عفراء ونَقَدَهُ ثمن الأرض التي بركت فيها الناقة، بعد أن حاول الرجل إقناع رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأن يقبلها هبةً، وسيكفي الغلامين بدلاً عنه، ولكنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يرضَ إلاَّ بشراء المربد ودفع ثمنه من ماله الخاص، فلما اطمأن رسول الإسلام إلى امتلاك المسلمين مكاناً عاماً في تلك الناحية من المدينة، دعاهم لإقامة مسجد لعبادة الله تعالى، وكان (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أول من ضرب معوله لحفر الأساس، فاندفع المسلمون من ورائه إلى العمل الجماعي، وملؤهم القوة والحماسة..
ولم يكن بناء المسجد يتطلب جهوداً مضنية وشاقة، لأن كل ما يحتاج له قليل من الحجارة ينقلونها من منطقة الحرّة لردم الأساس ورصفه، ثم إقامة الحيطان من اللَّبِن الذي يتشكَّل من الطين المعجون بالماء والتراب.
وقد تبدَّت الحماسة في إقبال المسلمين على هذا العمل المشترك، مثل شعلة الإيمان في نفوسهم، فاندفعوا إليه بهمة وإخلاص كما يستشفُّ من شكاية عمار بن ياسر إلى رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو يقول له: يا رسول اللّه، قتلوني، يحمّلون عليَّ ما لا أطيقُ!. فيقول له رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «ويح ابن سميّة! ليسوا بالذين يقتلونك. إنما تقتلك الفئة الباغيةُ[*]. وكان يزيدُ في نشاط الرجال وحماستهم رؤيةُ سيِّدهم ونبيِّهم وقد أبى إلا أن يكون واحداً منهم، يعمل بيديه الشريفتين، ويحمل اللبن على صدره وكتفيه، كما كان يفعل منذ أيام معدودات عندما أمر بتأسيس مسجد قباء، وكما يفعل الآن مع هؤلاء العاملين على بناء المسجد في المدينة، بلا تمييز بينه وبين أحد منهم، لأن كلَّ واحدٍ في الإسلام مدعوٌّ للعمل إنْ في الحقل الخاص لنفسه، أو في ميدان العمل العام، وعلى الكل واجب العطاء والبذل..
وحان وقت الظهيرة، واشتدَّ لظى الهاجرة، فبدا نوع من الفتور في همة الرجال. وقد ظهر عليهم ذلك من خفوت الأهازيج والأناشيد. فأمر عندها رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأخذ قسط من الراحة، ليقيلوا ويطعموا ويستروحوا ثم ليهبوا إلى متابعة العمل وقد زال عنهم كل كدٍّ أو تعب.. إنه الإِخلاص لصاحب الرسالة، وما كان بناء هذا المسجد إلاَّ عملاً مادياً بسيطاً من الأعمال التي يجب أن تقوم بها الرسالة لتأسيس الدولة الإِسلامية.. بل وإنه قبل كل شيء، العمل المبنيُّ على الإِيمان بالله تعالى، وفي سبيل مرضاته وثوابه.. فالكل يشارك، والكل يريد أن يأخذ حظه من الثواب، والرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) واحد من هؤلاء العاملين، يريد حظاً من ثواب الله الوفير.. فقد رآه أحدُهم وقد عَلته غَبَرَةٌ كثيرة، وفوق كتفه حَمْلُهُ من اللَّبِن، فأوجف إذ ظنَّ الأمر مهولاً، فتقدم من الرسول الكريم، يرجوه أن يجلسَ ويرتاح ويُشرفَ عليهم، ويعطيهم الأوامر، وهم يكفونه أمر المشاركة في الشغل، قائلاً له:
ـ أعطنيها يا رسولَ الله، واهدأ بجوارنا آمراً مُطاعاً..
ويدهش الصحابيُّ، ويُعقل لسانُه عن الكلام، وهو يسمع رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، يقول له:
»اذهب فخذ غيرها، فلستَ بأفقرَ إلى الله منِّي».
ويتفكّر هذا الصحابي: سبحان الله.. إنه رسول اللّه، وصاحب المكرمات عند باعثه، فكيف يكون فقيراً إلى الله؟.
ذلك هو الإِسلام: عدالةٌ ومساواة في كل شيء. إلاَّ أن الفضل لمن يعطي أكثر، فكيف إذا كان العمل والعطاء من أجل الجماعة، وخدمةً للمصلحة العامة، فيكون عندها الأجر والثواب أكبر.. والرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كغيره من المسلمين، لا يطلب إلاَّ ثوابَ ربه جلَّ وعلا، فحملُ الدعوة مكرمةٌ من الله وثواب، والدأبُ على إيصالها للناس رحمةٌ من الله وغفران، والتعبُ في سبيل إيصالها تعزيزٌ من الله وإكرام، والرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليس مدعواً للعمل في هذا النهج وحدَه، بل هو فريضة على كلِّ مسلم يعمل - ومن واجبه أن يعمل - في سبيل الله عزَّ وجلَّ، فينال أجر الآخرة، كما تعبّر عن ذلك أرجوزة المسلمين وهم يبنون المسجد:
اللهم إنَّ الأجرَ أجرُ الآخرة
فارحم الانصار والمهاجرة
أما عن اندفاعهم، وهم يرون نبيَّهم يعمل مثلهم، فيتغنَّون قائلين:
لئن قَعَدْنا والنبيُّ يعملُ
لَذَاكَ منَّا العمل المضلَّلُ[*]
ويُريد عليُّ بن أبي طالب (رضي اللّه عنه) أن يزيد في حماسة القوم، فيرتجز:
لا يستوي من يَعْمرُ المساجدا
يدأبُ فيه قائماً وقاعداً
ومن يُرَى عن الغُبار حائداً[*]
ويستوي المسجدُ بناءً متواضعاً، بسيطاً، لا أثر فيه للأبَّهة، أو الزخرفة أو النقش، بل مجرَّد فِنَاءٍ من الأرض لا يتجاوز خمسةً وثلاثين ذراعاً في طُوله، ولا يقلُّ عن ثلاثين في عرضه، تحيط به جدران لا يزيد ارتفاعها على قامة الرجل إلا قليلاً، جُعلت له أبواب ثلاثة، أحدها من الشرق، والآخر قبالته من الغرب، وثالثُها في ناحيته الجنوبية. وقد أقيمت في أحد جوانبه ظُلَّة من الجريد على قوائم النخل، سميت الصُّفّة، بينما تُركت باقي الجوانب مكشوفة. وقد خصَّصَ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذه الزاوية لإِيواء الفقراء الذين لا مأوى لهم.
وهنا تكمن ناحية أخرى من نواحي السموِّ الفكري عند الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو يبتني للفقراء تلك الصفّة، فلا يكون بين المسلمين مشرَّدون في الأزقة والطرقات، بل يأوون إلى ملجإٍ لهم بجوار بيت بُني لعبادة الله تعالى...
ثم إن هذا المسجد لا يعبّر فقط عن عزم من عملوا في تشييده، بل هو أيضاً مظهرٌ من مظاهر قناعتهم وصدقهم في الوسيلة والغاية. ولئن كان المهاجرون يعرفون رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن كثب، ويعملون على أساس المنهج الذي استنَّه... فإن الأنصار حديثو العهد معه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومع ذلك فقد أبرزوا اندفاعاً في العمل ينمُّ عن القناعة بتصديق محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، والإيمان به وبدينه، ممّا يؤسس للدور العظيم الذي على الأنصار أن يباشروه في خدمة الرسالة..
أما أهل المدينة - إجمالاً - فقد كانوا يرون هذا التكاتف والتضامن بين المهاجرين والأنصار - ومنذ بدء العهد بينهم ـ، فيدهشون ويتساءلون: ما هذا الدِّينُ الجديدُ الذي يصهر الناس في مثل هذه اللُّحمة الشديدة؟
ويتداولون الأحاديث في ندواتهم فيقولون: من هذا الرسول، الذي يبني جامعاً للمسلمين، ثم يفكر بالفقراء، فيجعل لهم فيه مكاناً يأوون إليه؟!..
هذه الغايات السامية المتشعبة التي أبرزها بناء المسجد، تفرض على الإنسان أن يفكر بها كثيراً، وأن يقدّرها التقدير الذي تستحق، فلا يعود يتأثر بمظهر المسجد، ولا على أي شكل قام تشييده. فالأمر الأساسي، أنه بيت لله سبحانه، ويجمع المسلمين من مهاجرين وأنصار على أول عمل مشترك، وفيه نصيبٌ معين لإِيواء الفقراء. فحق أن يكون مثالاً للعمل الإسلامي الخيِّر الرائع..
ولم يقف بناء المسجد عند حدود تلك الغايات، بل إنه، ومع مرور الوقت، كان شأنه يزدادُ علوّاً، لأن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يقضي جُلَّ أوقاته فيه للتعبّد، والصلاة بالمسلمين وتعليمهم القرآن وأصول الدين ومفاهيمه... ثم أمر بتوسعة بنائه مرة ثانية حتى جُعلَ طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وعرضُه في مثلها فهو مربع[*].
ولقد اتخذ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في أول الأمر، مرقاةً له كي يخطب في الناس، كانت عبارة عن جذع من النخل، بقي يستعمله إلى أن جاؤوه بمنبرٍ من خشب مصنوع على شكل بسيط متواضع، فيه درجتان، ومقعدٌ للجلوس. فكان (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقف على أدنى الدرجتين كلَّما قام لإلقاء الخطبة، أو لوعظ المؤمنين.. ولم يكن في المسجد مصابيح تنيره ليلاً، فكان إذا اشتدَّ الظلام، أتوْا ببعض الحطب يشعلونه، كي ينتشر الضوءُ في جنبات المسجد. وظلت حالهم كذلك حتى قدم المدينة تميم الداريُّ من الشام، فجلب للمسجد مصابيح، وعلَّقها في سَواريه، مما أفرحَ الرسولَ الكريمَ، وقال له داعياً: «نوَّرتَ مسجدَنا، نوَّرَ اللَّهُ عليك»..
وهكذا تبدَّى أنَّ أول اهتمامات رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في المدينة كان بناء هذا المسجد الذي نَعْرفه اليوم بالمسجد النبوي الشريف .. إذ ما زال قائماً، منذ أن وضع الرسول الكريم أساسه، ولسوف يبقى، بإذن الله، قائماً ما بقي الدهر، مع ما زاد عليه الخيّرون من جمال البناء، ورونق العمارة وعظمة التقدير لصاحب المقام، التي تسبغ على الزائر زيادة في الإيناس، وعلى المصلّين في الحضرة الطاهرة مزيداً من نعمة الخشوع والتقوى.
معنى الصلاة وأهميتها في حياة المسلمين
ولكن لِمَ كان ذلك الاهتمام بإقامة المسجد قبل مباشرة أي شيء آخر؟.
لقد كانت له غايات سامية وكثيرة تجلت يومئذٍ للناس في الجهد الموحد الذي بذله المسلمون في إقامته.. ولكن تبقى الغاية الأهم - كما هي الحال في إقامة أي مسجد أُسِّسَ على التقوى - وهي إقامة الصلاة في المسجد في مواقيتها المحددة من كل يوم، وفي المناسبات العامة مثل صلاة العيدين، أو صلاة الاستسقاء، أو غيرها من العبادات التي يقوم بها المسلمون جماعة، أو فرادى..
والسبب أن الصلاة هي الصلة الأقوى والأمتن بين العبد وربه.
صحيح أن كلَّ فعلِ خيرٍ، سوف يلاقي فيه الإِنسانُ وجهَ ربه، وينعم من خلاله برضوانه ورحمته، وصحيحٌ أنه كلما اتسع عمل الخير فاضت نعمة المنعم على فاعله هدايةً وطمأنينة وبركات، إلاَّ أنَّ الصلاةَ تبقى الأساس، والركن الركين الذي يلجأ إليه المؤمن في كل يوم خمس مراتٍ على الأقل ما دام حياً على هذه الأرض. فأنت عندما تقيم الصلاة طاعةً للَّهِ (سبحانه وتعالى) فإنَّ حضورك في هذا الموقف لا يكون استحضاراً لغائب، إنما وقوفك في محراب طاعته - عز وجل - هو التعبير عن حضورك أنت من غيبة، وإفاقتك من غفلة، قد تكون تائهاً فيهما قبل عقد نِيَّة الصلاة.. ولا يعني ذكرُ الله (تعالى) ما ذهب إليه بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين، عندما يقول أحدهم: إنه يرى الله في كل شيء.. فإن كان يعني أنه يرى آثاره وشواهده في الخلق، التي تدل على حقيقة وجوده سبحانه، فهو قول صحيح، أما إن كان يعني وحدة الخالق والمخلوق، أو وحدة الوجود، الذي اعتقد بعضهم أنها تتحقق أثناء الصلاة، فهذا كذبٌ وتجديف، والقول به كفر بالله وبالمرسلين.. وعلى هذا فإن الإِنسان المؤمن عندما يتهيأ للصلاة، وينضوي في رحابها الفسيحة، فإنه أول ما يلج بوابةَ تلك الرحاب، تعاف نفسُهُ كل موبقات الأرض وماديات الحياة الزائفة، وتشرق في داخله أنوارٌ من الصفاء تنقله إلى آفاق الله العليا حيث تتجلَّى معاني العبودية للخالق العظيم، ومعاني القبول والرحمة من المعبود الكريم، وفي هذه اللحظات - توكيداً - تتحقق الصلة بين المؤمن وخالقه، وهي صلة - والله - لا أجلَّ، ولا أسمى.. وهنيئاً لعبد قدر على تحقيقها بصلاته وعبادته.
أوَليس في هذه الصلة شعورُ العبدِ المؤمنِ الموقِنِ بمعينٍ من الطمأنينة لا ينضب، ومددٍ من الرحمة لا ينقطع، وإدراكٍ لكنز من المعرفة لا ينفد؟
ولئنِ استطاع العبدُ أن ينال مثل تلك الطمأنينة أو الرحمة، أو أن يحوز على مثل هذا الإِدراك فإنه يكون قد حقق أسمى غايات وجوده، بالفلاح في تزكية نفسه، والاطمئنان إلى ثواب ربه.
وهل يمكن أن ينال هذه النعمة الكبرى إلاَّ عبدٌ صلَّى صلاةً تصله بخالقه، فانجذب إليها بصفاء نفس، ورقة حواس، وشفافية وجدان، حتى امتلأ وجوده وكيانه وذاته إيماناً بالله عزَّ وجلَّ، وخشية منه، وخشوعاً له، فكان جديراً بتلك النعمة؟ وهل إلاَّ بمثل هذه الصلاة تكون للإِنسان القدرة على التفكر بآيات الله العظمى التي تزوّده بالإيمان، وتمكنه من بلوغ الصلة، والتي تؤدي جميعها في النهاية إلى التعرف إلى حقيقة وجود الله ذي الجلال والإكرام؟
ثم إن الصلاة، وإن كانت في لبابها مناجاة العبد الذليل الخاشع لربه، إلاَّ أنَّ الإِسلام كما شرَّعها عملاً فردياً عينياً، فقد جعلها نظاماً جماعياً لتراصّ الصفوف في المجتمع الإسلامي، وتوحيد النية والعمل في سبيل الله تعالى.. فالتعبير الذي ورد في الكتاب والسنة لأداء الصلاة هو «إقامة الصلاة»، إذن فلم يقل: صلوا، أو ائتوا الصلاة، أو افعلوا الصلاة، بل قال: «أقيموا الصلاة». وقد قال العلماء في تفسير قوله تعالى:
{ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدَىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ} [البَقَرَة: 2-3] أي يؤدونها في جماعة، لماذا؟ لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». فيكون التجمع للصلاة، وتراصُّ الصفوف وانتظامها جزءاً من إقامتها، بحيث تهدف هذه الإِقامة إلى إشعار البيئة كلها بالمبادرة إليها، والمحافظة على أوقاتها، واحترام أصولها، وإحياء معانيها.
والإِسلامُ ينشدُ من ذلك أن يكون الخضوع لله تعالى ظاهرةً عامةً في المجتمع، لا مجرد مسلك فردي خاص وحسب. وإقامة الصلاة من أهم الأعمال التي تُبرز هذه الظاهرة وتحافظ على دوام تحقيقها، وفي سبيل ذلك تستقبل المساجدُ النساء والأولاد والرجال كي ينتظموا في صفوف متراصة وراء إمام يتلو القرآن ويكبر الرحمن. وبهذا فإن الإِسلام يضفي على أمته روح الخضوع لله تعالى، مما يجعل منه الرسالة الإِنسانية الكبرى حتى إذا مُكِّنَت الأُمَّةُ في الأرض أقامتِ الصلاة، لقوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ *} [الحَجّ: 41].
ومن فوائد هذه الظاهرة العامة أنها تجعل عبادة المسلم في صلاة الجماعة عبادة صحيحة، بحيث يتعرف إلى أركانها وركوعها وسجودها، وقراءاتها وتسابيحها، وكل ما يتصل بها بفضل الإمام العادل، المثقف والمربي الذي يحبّب الصلاة للمؤمنين بدلاً من أن ينفرهم منها. والذي يعلّمهم غيرها من الفرائض والطاعات والمعاملات في حلقات المسجد بالذات، فيجتني هو والمؤمنون أجراً عظيماً.. أجل إن المؤمن يجتني من صلاة الجماعة أصول الصلاة وفضائلها وبركاتها.. وإلاَّ فمن يجهل أركان الصلاة لا يحسن العبادة، شأنه شأن من يجهل شؤون الحياة، فلا يحسن الإفادة منها ولا التبريز فيها.
ومن أجل هذه الصِّلة الدائمة بالله العلي العظيم، والامتثال لأمره تعالى، وبلوغ الغاية التي ما خُلقَ الجنُّ والإنس إلاَّ لأجلها {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ *} [الذّاريَات: 56] كانت الصلاةُ أولَ فريضة من فرائض الإِسلام، وأكثرها دوراناً مع الليل والنهار، لأنها وحدها قبل غيرها، الوسيلةُ الكافية، الوافيةُ لتمكين العبد من لقاء ربِّه بالخشوع، والطاعة والاستسلام.. ولأن للصلاة تلك القيمة، فقد أراد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يبدأ عملَهُ في المدينة بإقامة بيتٍ للصلاة، حتى يُمكِّن للمسلمين من أن يَنْعَموا بتحقيق الصلة الربَّانية في رحابه، ويطلعوا على الحقائق التي يريد الإِسلام أن يهتدوا إليها، ويعملوا بوحيها، وبذلك يكونون قد تزوَّدوا للدارين..
بناء سكن رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
ولقد بقي رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) منذ قدومه المدينة يقيم في دارة أبي أيوب الأنصاري.. فالرجل قد عمل، ومنذ البداية، على توفير كافة أسباب الراحة لنبيّه الكريم، إذ شاءَ له أن ينزل في الطبقة العلوية، وأن يكتفي هو وعياله في السفلية، فقال لزوجته أم أيوب: «نمشي فوق رأس رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ؟ معاذ الله! سأذهب وأرجوه أن يتحوّل في العلو».
فقالت له زوجه: «الحق ما تقول يا أبا أيوب، لا يليق بنا، ولا بأحد من الناس أن يعلو سقيفةً ورسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تحتها»...
وجاء أبو أيوب يعرض ذلك على رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بقوله: «يا نبيَّ الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأُعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهَرْ أنتَ فكنْ في العُلْو، وننزل نحن فنكون في السفل»[*].
فقال له الرسول الحكيم: «يا أبا أيوب، إنَّ أرفقَ بنا وبمن يغشانا أن نكون في سُفل البيت»[*]. وتلعثم أبو أيوب (رحمه الله) فلم يعرف بماذا يجيب، لما أصابَهُ من الحرج والضيق، وهو لا يريد أن يخالف أمره (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فبانَ على وجهه الحزن، ولكنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) طيَّب خاطره ودعا له باليمن والبركة، وحمله على الاقتناع بأن مثل هذه الأمور المادية لا تؤثر في حياة الإِنسان، طالما أنه لا يبتغي إلاّ رضوانَ الله - تعالى - ورحمتَه.
وانصاع أبو أيوب للإرادة النبوية، فبقي وعياله في الطابق العلويّ، ولكنه كان يحاذر أن يأتي بأية حركةٍ قد يكون فيها شيءٌ من الإزعاج.. ففي مرة كُسِرت له جرَّة مملوءة بالماء، فقام هو وزوجه أم أيوب، ينشفان الماء بالثياب واللحف مخافةَ أن يقطر إلى الأسفل ولو قطرة واحدة منه..
وكان أبو أيوب يأبى إلاَّ أن يحمل بنفسه صفحة الطعام الذي تعدُّهُ زوجه، ويضعها بين يدي النبي (ص)، شاكراً، وممتنّاً له على قبولِهِ وتناوله... ولكن سرعان ما بدأت الحسرة تتسرب إلى نفسه، وهو يرى أكابرَ المدينة ينافسونه على هذا الفضل، وكان من بينهم سعد بن عبادة (سيد في الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام) الذي كان يحمل كل يوم لرسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جفنة ثريد اللحم أو ثريد اللبن[*]، تقديراً للمكانة التي يحتلها (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في نفوس هؤلاء الناس، وافتخارهم بوجوده بين ظهرانيهم!..
أجل، كان أبو أيوب (رضي اللّه عنه) يرقب ذلك فتداخله الوساوس، لولا أنه طرد الأثرة من نفسه، وكأنَّا به يقول: هؤلاء أيضاً أحبّاء رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فكيف لا تزيدني سروراً رؤيتهم يتوافدون على هذا النبي المبارك؟! وإني - والله - إن فعلت لرجل أناني!.. وأكره أن أكونه.. فحبي لله - تعالى - ورسوله العظيم مكرمة أعزَّني بها المولى الكريم، فيا حبذا لو تكون الزاد في المعاد.. وبذلك اطمأنت نفس أبي أيوب[*]، وهدأ باله، ولكنه ظلَّ على دأبه، مهما تكاثر الإخوة المسلمون على خدمة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فكان إذا رُدَّ عليه شيءٌ من الطعام، تيمَّم هو وزوجه موضع يده الشريفة فأكلا منه، يبتغيان البركة.. وبالفعل فكم كانت البركات تفيض على تلك الدار التي شرَّفها الرسول الأعظم بحلوله فيها..
وعلى الرغم من تلك الحفاوة الطيبة، فقد عزم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على بناء المسكن الذي يقيم فيه وأهله، فلما انتهى بناء المسجد، عادَ وشيَّد بالقرب منه بيتَه المتواضع[*]، ثم بعثَ زيدَ بنَ حارثة ومولاه أبا رافع إلى مكة، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم ليأتيا بأهله الذين لا يزالون في مكة، وهناك أمكنَ الله تعالى للرجلين من إخراج ابنة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أم كلثوم، وزوجه السيدة سودة بنت زمعة، كما حملا معهما زوجة زيد بن حارثة، وعبد الله بن أبي بكر مع عياله، في حين بقيت ابنة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) زينب لأن زوجها العاص بن الربيع منع - وكان لا يزال على الشرك - عليها مغادرة مكة، واللحاق بأبيها في المدينة.
وقد نزل كلٌّ من هؤلاء المهاجرين الجدد حيث يقيم أهله، فانتقل (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من بيت أبي أيوب، بعد إقامةٍ استمرت سبعة أشهر، للسكن مع زوجه السيدة سودة في إحدى الحجرتين اللتين ابتناهما، بينما سكنت ابنتاه أم كلثوم وفاطمة الزهراء في الغرفة الثانية، وعلى هذا النحو، كان (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلما تزوج بامرأة، ابتنى لها غرفة واحدة، حتى صارت مساكنه تسعة في جنوبي المسجد وشرقيه.
ولئن استقرَّ المقام برسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في أرض طيبة، إلاَّ أن تفكيره لم ينقطع عمَّا عليه القيام به بعد الهجرة التي نقلته ونقلت دعوته خطوة واسعة في دور آخر من أدوار هذه الدعوة.. فلم يعد أكثر همّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) التثقيف والتفاعل - لاسيما أن بين المهاجرين والأنصار تفاعلاً حقيقياً تبرز آثاره في هذه الحياة التي راحوا يعيشونها سوية - بل صار الإسلام واقعاً راهناً، ولا بدَّ له من تطبيقٍ عملي يمارسه الناس في مختلف علاقاتهم العامة والخاصة، وهذا لا يكون إلاَّ بإقامة الحكم المدعم بالقوة المادية، فضلاً عن أساسه المتين وهو قوة العقيدة وأحقيَّتها.. صحيح أن رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يخطط، ويحسب لكل شيءٍ حسابَهُ منذ خطواته الأولى على الدرب مهاجراً إلى «يثرب»، ولكنَّ معوَّلَهُ كان - دائماً - على ربّه ليسدّد خطاه وينصره في تحقيق الأمر الذي بعثَهُ به؛ فكان قلبه يخفق، ولسانه يلهج بهذا الدعاء {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيرًا *} [الإسرَاء: 80]، ولم يكن هذا الدعاء الذي علَّمه إياه جبرائيل الأمين بوحي من ربه تبارك وتعالى، إلاَّ لأنَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يعلم علم اليقين بأن حركة الإنسان في التاريخ لا تستقيم، ولا تصل إلى هدفها، إلاَّ بأن يستلهم الإِنسانُ مدَدَ ربه - تبارك وتعالى - فيتوجه إليه بسمعه وبصره وفؤاده وعقله وكل جوارحه، ليتلقى العون والنصر، في صدق الحركة وانتصار قيمها، ما دامت مقترنة بثبات الخطى على الأرض، وبتحمل المسؤولية بأمانة كاملة، وبصياغة حرية اختيار الإِنسان بما ينسجم في المدى القريب والبعيد، مع سنن الله - تعالى - وما يقدّر ويشاء..
وبدون هذا التناغم بين ما يشاء الله - عز وجل - وبين ما يختار الإِنسان، بين نور الله الذي هو نور السماوات والأرض وبين كثافة الأرض ووعورة مسالكها، وبدون هذا الحوار الدائم الفعال بين الإِنسان وخالق الإِنسان، بين عالم المشاهدة المباشرة وعالم الغيب البعيد، لن تكون هناك حركة جادة ولا مصير عظيم..
ولقد كان محور حركة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الإِسلامَ، دائماً. فما دام هذا الدين القيّم يحمل في طياته كل المقاييس والموازين للإنشاء والتفاعل والتكامل في الحياة، فإن وجوده في عالمنا يتناول - في جوانبه الهامة - دائرتين رئيستين وهما: دائرة الإِنسان، فالدولة...
ولقد اجتاز الإِسلام في مكة دائرة الإِنسان، بما ثبَّت في نفوس المسلمين من إيمان ومفاهيم وقيم جديدة.. في حين كانت العوائقُ تتسارع وبوتيرة مطَّردة لتحول بينه وبين الوصول إلى دائرة الدولة.. فالدولة هي الكيان السياسي الذي تنضوي تحته الجماعات البشرية. فهي ضرورة لا غنى عنها للناس عامة ، وللمسلمين خاصة لأنها مجالُ الدعوة الحيوي، وبدونها ستظل دائرة الإِنسان المسلم بلا سياج يحميها من الخارج المضاد لها بكل أثقاله وضغوطه وإمكاناته المادية.. ولن يستطيع الفرد المسلم، ولا الجماعة المسلمة، بدون دولة تحميهما أن يمارسا حرية الحركة، وحمل المسؤولية حتى النهاية، لاسيما إذا كانت القيمُ والتطلعات الاسلامية تمثل رفضاً قاطعاً للمبادئ والأفكار، والقواعد التي يقوم عليها الواقع الخارجي والأوضاع التي تنبثق عنه. فلا بد إذن من الأرضية الصالحة التي يتحرك عليها المسلم، قبل أن تقوى عليه الظروف الخارجية المعادية له، وليست هذه الأرضية سوى الدولة الإِسلامية التي انصبَّ عمل الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومعه المسلمون، على تأسيسها منذ بدء عهد الهجرة في المدينة المنورة..
نقطة الارتكاز لإنشاء الدولة
وهنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسل، ألاَ وهو الطور السياسي الذي أبدى فيه محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعل الإِنسان يقف مدهوشاً، وهو يطأطئ الرأس له إجلالاً وإكباراً. فقد كان أكبر همّه أن يصل بالمدينة - موطنه الجديد - إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من قبل في سائر أنحاء الحجاز، بحيث تكون هذه الوحدة هي النقطة التي يرتكز عليها الإِسلام في تطبيق أحكامه، وإنشاء جيشه لحمايتها من الأعداء. ولذلك توجّه اهتمامُه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى تنظيم صفوف المسلمين، وتوكيد وحدتهم للقضاء على كل ما يمكن أن يثير العداوات القديمة بينهم. وقد اتخذ الرسول أساساً لهذا الأمر وحدة العقيدة الإِسلامية التي تجمع بين المسلمين كافة من مهاجرين وأنصار، وتؤلف بينهم. فأفكارهم ومشاعرهم واحدة، وتنظيم علاقاتهم بالإِسلام أمر بديهي. وقد ركَّز (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في إقامة هذه العلاقات على الأساس الواحد الجامع المتين الذي هو العقيدة، ذلك الأساس الذي ظلَّ يقيم عليه بنيانه طوال ثلاث عشرة سنة، بقوة الإِيمان الصادق بالله الواحد الأحد، فبرز البناء شامخاً، وظهرت مآثره في حياة الفرد، كما في حياة الجماعة، عملاً صالحاً ينقطع به الفساد، ويعمُّ به الصلاح.. وما كان هذا النهج النبويّ إلاَّ لإيمانه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأن العقيدة - أياً كان شأنها - لا تكتب لها الحياة إن لم يكن حامل لوائها المثلَ الحيّ الصادق، والترجمة العملية لها، في كل ما يأخذ وما يدَع، وفي جميع ما يخفي وما يُعلن. ولذا لا بد من أن تمتلك العقيدةُ نفسَ الإِنسان، المؤمن بها كي يندفع إلى العمل في ظاهر الأمر وباطنه، وفي صغيره وجليله، وفي ما يتصل بشؤون نفسه وشؤون من حوله، سواء في ذلك القريب منه أو البعيد عنه. مع الاعتبار بأنَّ أكثر ما ينبغي أن يكون تركيزه عليه هو الإنسان الذي يشاركه في عقيدته، ويكون العضد له على تكريسها، ونشرها في سبيل النفع المرتجى منها لجميع الناس.
من أجل ذلك، ومن بين مآثره (صلّى الله عليه وآله وسلّم) التي كانت جميعها فريدة وعظيمة، كانت مأثرته الرائعة في دعوته المسلمين لترجمة العقيدة إلى واقعٍ رآه بتآخيهم في الله - أخوين أخوين - حتى يكون لهذه الأخوة الأثر الفاعل حقاً في أموالهم ومعاملاتهم، بل وفي كافة شؤون حياتهم.. فالتآخي وإن كان يربط بين المهاجرين والأنصار بأوثق الروابط وأشدِّها متانة ألا وهي رابطة الإِيمان والإِسلام، إلاَّ أنه من الناحية العملية يعزّز في نفوس الأنصار شعورهم بالمسؤولية تجاه إخوانهم المهاجرين، هؤلاء الذين تركوا وراءهم في مكة كلَّ شيء، وحلّوا بالمدينة وهم لا يملكون شروى نقيرٍ، بفعل قريش وحقدها..
وكان نبيُُّّ الله محمدٌ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد عقد أول عهد للتآخي بين المسلمين الأوائل في مكة قبل الهجرة، فقرر أن يعتمد العهد نفسه في المدينة المنورة بين المهاجرين من مكة، والأنصار في المدينة، وهو يقول لهؤلاء الأنصار:
«إنَّ إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد، وخرجوا إليكم»...
بهذه اللهجة الصادقة، قال الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الكلمة الفصل بمضامينها الجامعة، وأبرزها الروح الإسلامية التي يريدها روحاً إنسانيةً تقوم على أشد الروابط التي تجمع الإنسان بالإنسان. وليس أوثق لذلك من الأخوة التي تقوم على العقيدة، ولذلك استجاب لها الأنصارُ بعفويةٍ ونبلٍ عندما أعلنوا عن موقف واحد: «أموالنا بيننا قطيع يا رسول اللّه».
وانشرح صدر الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لهذه التلبية المثلى، فعمد من فوره إلى المؤاخاة التي كانت فعلاً أكبر تعبير عن عمق تفكيره، وعن تحركه السريع. فأعلن تجديد التآخي بين عمه حمزة بن عبد المطلب ومولاه زيد بن حارثة، وبين أبي بكر وخارجة بن زهير (أخي بلحارث بن الخزرج)، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك (أخي بني سالم بن عوف)، وبين أبي عبيدة بن الجراح (واسمه عامر بن عبد اللّه) وسعد بن معاذ (أخي بني عبد الأشهل)، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع (أخي بلحارث بن الخزرج)، وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة (من بني عبد الأشهل)، وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت (من بني النجار)، وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك (أخي بني سلمة)، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب خالد بن زيد (أخي بني النجار)، وبين بلال بن رباح وأبي رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي... وما زال يؤاخي بين المهاجرين أنفسهم، وبينهم وبين الأنصار حتى عمَّتهم الأخوة جميعاً. ولم يبقَ إلاَّ الأمر الأهم ألا وهو تآخي الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نفسه مع غيره من المسلمين، لأنه كان رائدهم في كل شيء، والمثال الذي يحتذون به في كل ما يستَنُّ من قول أو فعل. ولذلك ولما شملت تلك المؤاخاة المسلمين جميعاً ولم يبقَ إلاَّ علي بن أبي طالب، إذ لم يؤاخ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بينه وبين أحدٍ من الأنصار أو المهاجرين، حينئذٍ تقدم عليٌّ ليسأل عن حاله، وهو يقول: يا رسول اللّه! قد آخيت بين سائر أصحابك، ولم تؤاخ بيني وبين أحد...
فقال له الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «يا علي لقد أبقيتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة»[*]. «فكان رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، الذي ليس له مثيلٌ، ولا نظير من العباد، وعليُّ بن أبي طالب (رضي اللّه عنه)، أخوين»[*].
وبسرعة أثمرت نتائج التآخي في حياة المسلمين، كما يدلُّ عليها موقف سعد بن الربيع، إذ انطلق بأخيه في الإسلام عبد الرحمن بن عوف فدعا بطعام، فأكلا وقال له: لي امرأتان، وأنتَ أخي في الله، لا امرأةَ لك، فأنزل عن إحداهما فتزوجها.
قال عبد الرحمن: «لا، واللَّهِ».
قال سعد: «هلمَّ إلى حديقتي أشاطِرْكَها».
فقال له عبد الرحمن:
- لا، بارك الله لك في أهلك ومالك يا أخي، واللَّهِ ما أرغب إلاَّ أن تساعدني في معرفة السوق هنا، حتى أبيع وأشتري.
وكان لعبد الرحمن ما أراد، إذ بدأ، بتوجيه من أخيه سعد، يشتري ويبيع السمن والزبد والجبن، وقد استطاع بمهارته التجارية أن يحصّل الربح الحلال في زمن قصير، وأن يمهر إحدى نساء المدينة صداقاً قيّماً من ماله الخاص، وأن تكون له - من ثَمَّ - قوافل تذهب وتأتي مثل كبار التجار في المدينة المنورة.
ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وحده من المهاجرين الذين عملوا في ميدان التجارة، بل فعل مثلَهُ كثيرون غيره، لأنه كان لأهل مكة دراية واسعة في هذا المضمار حتى قيل في أحدهم: «إنه ليحيل بالتجارة رمل الصحراء ذهباً».
ومَنْ لم يدخل في التجارة، فقد اشتغل في الزراعة أمثال: أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وغيرهم، فكانوا يعملون في أراضي الأنصار مزارعة مع مُلاَّكها. وقد قال لهم الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه»[*]. ومن لم يجد عملاً في تجارةٍ أو زراعةٍ فقد انصرف إلى أي عمل شريف يزاوله ولو كان شاقاً أو زهيد الأجر حتى لا يكون كًلاًّ على غيره. ولم يكن بين المسلمين أحدٌ بلا عمل إلا جماعة من العرب، وفدوا على المدينة - فيما بعد - وأسلموا، وكانوا في حال من العَوز والمتربة بحيث لم يكن لأحدهم سكن يلجأ إليه، وهؤلاء هم الذين توقَّع النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وجود أمثالهم في المجتمع الجديد، فأفرد لهم الصُّفّة في المسجد حتى يبيتوا فيها ويأووا إليها، وجعل لهم رزقاً من مال المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين آتاهم الله رزقاً حسناً.
نعم لقد كانت المؤاخاة بوجْهيْها العقائدي والواقعي، مشاركة حقيقية في الأموال والأرزاق، وفي حاجات الدنيا كلها، تماماً كما كانت مشاركةً في المشاعر والأفكار، وفي التوجهات العامة.. وقد بلغ من حرص الأنصار على إنصاف إخوتهم المهاجرين حدّاً يفوق التصوّر، إذ لم تقتصر مشاركتهم على ما يملكون من الأموال المنقولة يقتسمونها معهم، أو على حقوق يتوزعونها مثلهم، بل طلبوا إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يقسم بينهم النخيل بقولهم:
»يا نَبيَّ الله، لقد بذلنا ما في وسعنا لنواسي إخواننا المهاجرين فيما آتانا الله من مال، ولم يبقَ لنا إلاَّ النخيل، فاقسمه يا رسول اللّه بيننا وبينهم»..
فقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: «لا، ويشركونكم في الثمرة!»[*].
قالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول اللّه.
وإذا كان الأنصارُ هم أصحابُ الفضل والعطاء، بما أعطوا وزادوا حتى استكثره المهاجرون أنفسهم، فإنَّ هؤلاء لم يكونوا - في واقع الأمر - يريدون أكثر من الإِيواء والكفاف، ولذلك فقد سيطر عليهم، من جرّاء ما قدَّمه لهم الأنصار، شعورٌ بالخوف على أنفسهم، فجاؤوا رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يشتكون قائلين:
»يا رسول اللّه، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، أحسن مواساة في قليل، ولا أكثر بذلاً من كثير، لقد كفونا المؤونة، وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله»[*]..
فقال الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مطَمْئِناً: «لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم»..
ذلك هو العطاء الحق.. العطاءُ الجزيلُ من الأنصار..
وذلك هو الشعور الحق.. الشعورُ الصادقُ من المهاجرين..
الكلُّ يريد أن يعطيَ بسخاء.. ولكنَّ الكلَّ لا يريد أن يأخذ من العطاء إلاَّ بمقدار..
وبين العطاء والامتنان لا أحدَ يريدُ إلاَّ ثوابَ الله تعالى، حتى كان الخوف من أن يعود أجرُ الله - سبحانه - لمن أعطى.. ولكنَّ قبولَ الممتنِّ، والدعاءَ منه لأخيه المعطي يجعل الأجر موزعاً بين الجميع إذا شاءَ الله، ما دامت النوايا صافية، والغاية معهودة!.. والجامع في ذلك كله هو الشعور الإسلامي، والأخوة الإسلامية..
ولم تكن تلك الأخوة الاسلامية ظرفيةً، أو لتموت بعد رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بل أرسى قواعدها لتبقى ذخراً للمسلمين إلى يوم الدين، وفي خبر بلالٍ خيرُ دليل، إذ «لما دوّن عمر بن الخطاب الدواوين بالشام، وكان بلالٌ قد خرج إليها وأقام فيها مجاهداً؛ قال له عمر (رضي اللّه عنه) : إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: مع أبي رُويحة، لا أفارقه أبداً، للأخوة التي كان رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عقد بينه وبيني»[*].
وإنَّ مثل تلك الأخوة الاسلامية لهي خير السبل التي تقوم عليها الحياة المنيعة الكريمة، لو اعتُمدت في أيامنا هذه، وعلى نفس النهج الذي عمل به المسلمون منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة.. وهي لو طبّقت فعلاً لكان من شأنها أن تغيّر أحوال المسلمين على غير ما نشهده اليوم من المآسي التي تصيبهم، بل ولو أخذ بها الناسُ - في الشرق والغرب - لكانت خيرَ معين على تحقيق إنسانية الإنسان!.. أما والأحوال بخلاف ذلك تماماً فأية إنسانية يُعوَّل عليها في دنيا الناس، والشبع قد أتخم فئاتٍ حتى ليكاد يقتلها، بينما الجوع يفترس بأنيابه كل الفئات الأخرى فيميت منها من يميت، ويخزي من يخزي، على مختلف بقاع الكرة الأرضية؟! وما يقال عن الجوع، لا يقل خطورة عن الجهل، والفقر، والمرض، وشتى أنواع البلايا التي ترزحُ تحت وطأتها جموع البشرية سواء في ذلك رعايا الدول المتقدمة أو رعايا الدول المتخلفة!!.. فأية أنظمة أقيمت وهي تقر بمثل تلك الفوارق المجحفة بين الناس، حتى راحت الصرخات تتعالى من المسؤولين في المنظمات الإِنسانية الدولية، وهي تظهر المخاطر التي تتهدد البشرية، إذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه؟.
والمسلمون أنفسهم لم ينجوا مما وصلت إليه تلك الأحوال، بل وقعوا في نفس الأخطار، إن لم يكن في أشدّها.. أما السبب في ذلك فهو الضعف الذي دبَّ في نفوسهم، من جرّاء ضعف الروح الأخوية المعطاء التي كان عليها المهاجرون والأنصار، فكان طبيعياً أن تضعف من ثمَّ الدولة الإِسلامية فيما بعدُ، ثمَّ تزول.. ويصبح المسلمون بالتالي تَبَعاً لغيرهم، بعد أن كانوا سادةً أعِزَّاء في جميع البلدان التي وصلوها بالإِسلام.. إذن فأين نحن اليوم، والعالم بأسره، من تلك النظرة الثاقبة عند محمدٍ رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في تركيزه على جمع المسلمين، وجعلهم كالبنيان المرصوص، من خلال تلك المؤاخاة التي ابتكرها واعتمدها. وقد استطاع (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بفعل تلك النظرة الهادفة نفسها أن يُعدَّ للمستقبل، وأن يهيىء لنشر الإِسلام.. ولم يكن أيّ إعداد أو تهيئة بميسورين، لو لم ينصهر المسلمون في بوتقة الحب والإِخاء والتضحية، ويجتمعوا على التكافل والتعاون والتضامن، حتى بات تطبيق الدين بين المسلمين واضح المعالم، سويَّ النهج، مستقيم التوجُّه، منذ بداية الحكم الاسلامي في المدينة المنورة..
وبعد إعداد السبل والتهيئة، كان لا بُدَّ للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من أن يبنيَ المجتمع الذي يريد.. وقد أراده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مجتمعاً يتعايش فيه كلُّ الناس - مسلمين وغير مسلمين - مواطنين متعاونين، يسودهم الوئام والانسجام، ويظللهم الأمن والسلام..
فكيف كان ذلك البناء بعد أن أُخذت له العُدَّة؟
المجتمع في المدينة
ليس بناء المجتمع - بمعنى البناء الشامل - أمراً سهلاً، بل يتطلب إيديولوجية معيّنة تعبِّر عن وجود الناس وحاجاتهم وأمانيهم وغاياتهم، على أن ينطلق ذلك كله من الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى، باعتبارها الحقيقة المطلقة، الأصيلة، الثابتة التي تُبنى عليها سائر الحقائق التي تتعلق بالإنسان والحياة والكون!.
فإذا كان الله - سبحانه - قد فطر في الإِنسان غريزة حبِّ البقاء، وكان من مظاهرها اجتماع الإِنسان مع أخيه الإنسان للحفاظ على الوجود، والكيان، والحماية من المخاطر.. إلا أن مجرَّد اجتماع الناس مع بعضهم البعض لا يؤلف مجتمعاً، بل يوجد مفهوم الجماعة، الذي يظل في حدوده الضيقة إذا ما اقتصرت حياتهم على مجرَّد التجمُّع. أمَّا إذا نشأت بينهم العلاقات، فإنها هي التي تجعل من تعايش الجماعات، مجتمعاً.
فكيف كان المجتمع في المدينة حين قدمها رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ؟
لقد أراد الرسول الأعظم، ومنذ حطَّ قدميه في المدينة، أن يبدأ بناء المجتمع الإسلامي، فأمر بتشييد المسجد ليكون مكاناً للصلاة والاجتماع، وللتشاور في الإِدارة والشؤون العامة.. وفي الوقت نفسه بيتاً للتقاضي، والحكم بين الناس، فكان (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقوم بأعمال الحاكم، والإِداري، والقاضي في آن معاً، إلى جانب أنه رسول من رب العالمين إلى الناس كافة.. من هنا كان الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يرى بأن بناء المجتمع السليم يجب أن يقوم على مفاهيم الإسلام، ونظرة هذا الدين إلى حياة الفرد والجماعة على حد سواء، فالمجتمع الاسلامي، وحده الذي يهيّئ لقيام دولة الإسلام باعتباره القاعدة التي تبنى عليها كل الأنظمة التي تتناول علاقات الناس وكيفية رعايتهم وإدارة شؤونهم، ولكن هل كان ذلك ميسوراً وهنالك قوى كثيرة تقف بالمرصاد لمنع بناء مجتمع إسلامي في المدينة، ومن ثم، للحؤول دون قيام دولة الإسلام؟!. وإذا كانت قريش قد حالت دون ذلك في مكة فإن نواة هذه الدولة الإِسلامية التي غرسها رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في المدينة قد بدأت تظهر للعيان، الأمر الذي جعل أعداء الإِسلام يَفْرَقون[*] خوفاً، ويسارعون في إظهار عداوتهم، تماماً كما كانت الحال عليه في مكة، ولكن مع الفارق بما سيكون عليه هؤلاء الأعداء هنا - في المدينة - لكثرة أطرافهم، مع ما يتبع ذلك من تنوع وسائلهم العدوانية، وتشعب أساليبهم الهدامة، في محاولاتهم للقضاء على فكرة الدولة التي يراد إنشاؤها!..
ولعلَّ الشر في نفوس أعداء الحق والخير لا يقبل البقاء في كمونه، فيحرّضهم على الاندفاع والمبادأة بالعمل.. كما حصل مع تلك الأطراف التي ظهرت متمثلة بأهل النفاق في داخل المدينة، وأعوانهم من اليهود، والأعراب المشركين، الذين أخذوا يتربصون بالمسلمين الدوائر!. مما يستدعي معرفة تلك الجماعات - ولو بنظرة عاجلة - لتستبين سبلُ عداوتهم، وإن كانت الأحداث المتعاقبة سوف تنبئ عما تقوم به تلك الجماعات لمحاربة الإسلام وأهله..
أما اليهود فكانوا يتوزعون في عدة أماكن: ديار بني قينقاع في داخل المدينة، وديار بني قريظة في ناحيتها الشرقية بالقرب من العوالي، وإلى الجنوب منهم ديار بني النضير حيث حصن كعب بن الأشرف، وعلى الطريق المؤدية إلى بلاد الشام كانت حصون خيبر.. وكما هو معروف، فقد كان اليهود أهل علم، وأصحاب كتاب سماوي، فكان أولى بهم، من دون الناس جميعاً في جاهلية العرب أن يؤمنوا بالنبي «محمد»، الذي يجدونه - بصفاته وأمارات زمانه - مكتوباً عندهم في التوراة، وأن يتبعوه على الدين الذي جاء به، والذي لا ينقض ما في كتابهم، بل يصدّقه ويؤمن به.. ولكن - ويا للأسف - لم يعملوا بشيء من ذلك، بل نبذوا كتابهم وراء ظهورهم، وغلّبوا الأثرة والهوى على الحق المبين.. فقد عزَّ عليهم أن يتحقق الوعد في التوراة، ويبعث الله تعالى النبيَّ الأميَّ العربي نبياً ورسولاً، فثارت ثائرتهم، وطمست المصيبة - كما توهَّموها - بصيرتهم، فراحوا يردّدون: لا، لن يكون نبيُّ آخر الزمان من العرب، ويتنزَّل عليه الكتابُ قرآناً عربياً..لا، لن نقبل إلاَّ أن يكون النبيُّ الموعود من بني اليهود.. ولم يكن هذا التوجُّهُ اليهودي ردةَ فعلٍ عابرةً، كما قد يُظنّ، بل نتيجةَ قناعةٍ ترسَّخت في نفوسهم: بأنهم أبناء الله وأحباؤه... واعتقادٍ خاطئٍ استحكم في عقولهم: بأنهم شعب الله المختار!..
وزاد في الطينة بلّةً على رؤوس اليهود أن رأوا «محمداً» يعمل على إرساء القواعد لدولة الإسلام، فزادهم الأمر حسداً، وامتلأت قلوبهم بالحقد والغيظ عليه، فاندفعوا يحاولون التشكيك في نبوته، وينشرون الأكاذيب والأباطيل حول رسالته، وأخذوا يرددون في كل محفل وناد:
لا!.. ليس محمَّد هو الرسول الذي ننتظر!.. وجريمة اليهود النكراء على مدى التاريخ أنَّ أحبارهم - وقد زيّن لهم الشيطان أعمالهم - كانوا قد حرَّفوا كتابهم التوراة، وطمسوا كل دليل فيه: من إشارة أو صفة أو اسم يؤكد نبوة محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ورسالته وهو الأمرُ الذي بيّنه الله ـ تعالى ـ بقوله العزيز: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيدِيهِمْ وَوَيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ *} [البَقَرَة: 79]؛ فكان من الطبيعي أن يقفوَ الخلفُ أثر السلف، وأن يكون أحبار اليهود في جزيرة العرب رأس الحربة في البغضاء والعداوة للإسلام، ونبيه محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فيوغلون، ومن ورائهم جميع بني اليهود، بالكفر، والكيد والمكر، في تصدّيهم للإسلام ونفث سموم الحقد على «محمد» ومن والاه على دينه..
وكان عبد اللّه بن سلام، من كبار أحبار اليهود وعلمائهم. فلم يأخذ بالتحريف المخزي الذي أدخل على كتاب التوراة بل ظل على تصديقه بالذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة مِن أن الله ـ تبارك وتعالى - يبعث نبيّاً معروفاً بصفاته وزمانه، فلما سمع بصدوعه بالدعوة في مكة، تريّث في السعي إليه، حتى تتبين حقيقة هذا النبي، ويتضح له فيما إذا كان يدّعي النبوة أم هو النبي المنتظر حقّاً.. وظلَّ على انتظاره إلى حين هجرة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ونزوله في قباء، على بني عمرو بن عوف، فجاءه رجل يسعى إليه، وهو على رأس نخلة في بستانه، فلم يتمالك نفسه، لمَّا سمع الخبر أن كبَّر الله - عز وجل - بأعلى صوته مما جعل عمته التي كانت تجلس تحته - وتدعى خالدة بنت الحارث - تدهش لأمره، فتقول له:
ـ «وواعجباً منك يا ابن سلام، واللَّهِ لو كنت سمعتَ بموسى بن عمران قادماً، ما زدت!»..
فقال لها، وهو ينزل عن الشجرة: أي عمّة: «هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه. بُعث بما بُعث به» فقالت: «أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنَّا نُخَبرُ أنه يبعث مع الساعة»[*].
قال: نعم، والله!.
قالت: فذاك إذن!...
ولم يلبث عبد اللّه بن سلام، أن ترك نخيله، وذهب مع عمته إلى حيث ينزل رسول اللّه، فأسلما على يديه ثم رجع هانىء البال، إلى أهل بيته، فأمرهم، فأسلموا ولكنه كتم إسلامه خوفاً من قومه اليهود. فلما حان الوقت ورأى أن الإسلام في منعةٍ، والرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ثابت القدمين في بناء أُسُس الدولة الإِسلامية في المدينة، راح يحذّره من شر بني قومه، أهل الزور والبهتان، لكي يتخذ الحيطة اللازمة منهم، ومما قاله له: يا رسول اللّه، إن اليهود قوم بهت، وإني أحب أن تبعث إليهم أن يأتوك ثم تغيّبني وتسألهم عني فإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني وعابوني..
ورأى رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يعمل بما أشار عليه عبد الله بن سلام، فأرسل في طلب اليهود، فجاء بعض الأحبار بالخلفية إيّاها من الحقد والرعونة، ولكنها كانت جلسة حجاج ومكاشفة، أرادها الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لانتزاع ما في نفوسهم، والتصديق بنبوته.. إلاَّ أنهم أصرّوا على الإنكار، حينئذٍ قال لهم ما مؤداه: «يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلاَّ هو إنكم لتعلمون أني رسولُ الله حقّاً وأنّي جئتكم بحق، فأسْلِموا»!
فقال كبيرهم: ما نَعلمه..
وردَّد آخرُ من بعده: ما نَعلمه..
ثم أعقبه غيرُه: ما نَعلمه..
فسألهم النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «فأيُّ رجل فيكم عبد الله بن سلام؟».
قالوا: «سيدنا وابن سيدنا، وأعْلَمُنا وابنُ أعْلَمِنا».
قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «أفَرأيتم إنْ أسْلَم».
قالوا: حاشا لله، ما كان ليُسلم».
عندها خرج عليهم عبد الله بن سلام، وقال لهم: «يا معشر يهود، اتقوا الله. فوالله الذي لا إله إلاَّ هو إنكم لَتعلمون إنه للنبي الأمّي العربي الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة، باسمه وصفته. وإني أشهد أنه رسولُ الله وأنه قد جاء بالحق، وإني أؤمنُ به وأصدِّقه».
فقالوا له: «كذبت.. إنك شرُّنا وابنُ شرِّنا».
فنظر عبد اللّه إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو يقول: «هذا الذي كنت أخافه يا رسول اللّه». ألم أخبرك بأنهم قومُ بهتٍ، وكذبٍ وفجورٍ؟!..
ولم يكن عبد الله بن سلام وحدَه الذي حفظ التاريخ شهادته على إفك اليهود وكفرهم، بل وحفظ شهادة أخرى لا تقل أهمية، وهي شهادة السيدة صفية بنت حيي بن أخطب[*]، من بني النضير - التي صارت فيما بعد زوجةً لرسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) - إذ تروي، أنها في حداثتها، كانت أحبَّ ولد أبيها وعمها أبي ياسر بن أخطب إلى قلبيهما، حتى كان يوم قدوم رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قباء، فغدا أبوها وعمها إلى تلك القرية مُغَلِّسَيْن[*]، وما عادا إلاَّ مع مغيب الشمس في فتور وكسل، شبه ساقطين من الإِعياء الذي يتملّكهما، فهشّت تلقاهما كعادتها إلاَّ أن أحداً منهما لم يتطلَّع إليها، فوقفت بقربهما مشدوهة، تستمع إلى عمها وهو يقول لأخيه: أهو، هُوَ؟!.. فيجيبه: نعم، والله!..
فيقول العم: أتعرفه بنعته وصفته؟!.
فيقول أبوها: نعم، والله!..
فيقول العمُّ: فما في نفسك منه؟!
فيقول أبوها: عداوتُهُ، واللَّهِ، ما بقيتُ!..
فذلكم بعض مما يحفظه التاريخ على اليهود، والموقف العدائي الذي اتخذوه حيال الإسلام ورسوله منذ بدء الهجرة إلى يثرب، بل ومنذ وصلتهم أخبارُ دعوته، وهو لا يزال في مكة!..
أما الذين كانوا مذبذبين، فقد زُيِّن لهم أن المسلمين، مهما بلغ باعهم، لن يقدروا على التصدي لليهود والمشركين، وخشية أن يتورطوا مع أحد الأفرقاء، آثروا الانتظار والترقب، وسلوك جانب الحيطة والحذر حتى تتبين لهم الأمور، وما تؤول إليه الأوضاع، فلما تبيَّن لهم أن سلطان «محمد» في المدينة يتوطّد شيئاً فشيئاً، وأن المسلمين يزدادون قوةً يوماً بعد يوم، راحوا يدخلون في الإسلام كذباً ونفاقاً، حفاظاً على مصالحهم الذاتية ومآربهم الخاصة.. ففريق نافق كرهاً بالإسلام الذي يفوّت عليه فرص النفع المادية الملتوية، وفريق نافق بسبب معتقداته الوثنية التي لا يريد للإسلام أن يهدمها، ويقتلعها من جذورها، في حين أجمع ظن هذه الجماعات على أن المهاجرين دخلاء على المدينة، ويشكلون عنصراً غريباً يجب العمل على إخراجه من بلدهم حتى لا يستولي على خيراتها، ويقوى بها عليهم.. فكانوا مثلَ اليهود - بل وأكثر - في موقع العداوة للإسلام، يقولون: «آمنّا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم»، ولذلك انطبق عليهم قول الله تعالى بأنهم «المنافقون» وهذا أشد خطراً، لأنهم - في ظاهر الحال - يشاركون المسلمين شعائرهم في الصلاة والصيام مثلاً، بينما هم - في باطنهم - ألدّ أعداء الإسلام وأهله، كما أبانَهُ القرآن الكريم، بالآيات التي تنسب إليهم الكذب والمواقف الخبيثة، والبهتان الذي كانوا يفترونه لضرب مسيرة الإسلام..
على أن تلك الفئة المنافقة لم تظهر بين المسلمين إلاَّ في المدينة المنورة، بينما لم تعرفها مكة من قبل.. ولعلَّ تلك الأحوال التي كان عليها المسلمون، يومئذٍ، من الضعف وعدم المواجهة مع المشركين، لم تستدع مجالاً للنفاق حتى يستخفي المنافق وراء كيده ومكره، فظهر المسلم مسلماً، والمشرك مشركاً، والوثني على وثنيته، ما دام المنافق لا يتظاهر باعتناق مبدأ إلاَّ رغبةً أو رهبة.. أجل، لقد سقطت في مكة بعض النفوس الضعيفة، ولكن ليس بسبب النفاق، بل لظن أصحابها أن دخولهم في الإسلام لا يوفر لهم الأماني.. فقد انجذب هؤلاء للإسلام بصورة طبيعية وتلقائية في بداية الأمر، فلما وقع أتباعه في المأزق، وحاق بهم العذاب، لم يجدوا إلاَّ الارتداد لأحضان قريش حتى ينعموا بالطمأنينة في ظل زعامتها من ذوي الطباع الشرسة، الذين تغلّبت عليهم مادية الحياة الدنيا، فغلّقوا منافذ الفطرة دون الإسلام وهديه...
ولكن تلك الفئة الساقطة لم تشكل في مكة أي خطر على المسلمين من داخل صفوفهم، بخلاف ما هي عليه الحال في المدينة حيث يتزيّن المنافقون بالثوب الإسلامي، فيندسّون بينهم لمعرفة أسرارهم، والاطلاع على خفاياهم، ومرامهم أن يمدّوا أعداء المسلمين بالمعلومات التي تتيح لهم رسم الخطط لمحاربة الإِسلام.. وكان رأس النفاق، وأشدّ المنافقين شراً عبد اللّه بن أبي سلول، الذي استبدَّ به الحنق على رسول اللّه، بعدما فقد الأملَ بتتويجه ملكاً.. إذ كان الأوس والخزرج قد أوشكوا أن يملِّكوه عليهم في يثرب، لولا أن قَدِمَها رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وثبت فيها أقدامه ممَّا جعلَ الناس يتخلّون عن ابن أبي سلول، وعن تمليكه عليهم، لاسيما وأنهم وجدوا شدة الفوارق بين خضوعهم لسلطان دنيوي تغلب عليه المطامع والأنانية، وبين انضوائهم تحت راية الإيمان بالله الواحد الأحد، واتباع النبيّ الذي بعثه اللَّهُ تعالى رحمةً للعالمين.
وإلى عداوة رأس النفاق ابن أبي سلول ومن حذا حذوه من المنافقين واليهود، اجتمعت عداوة الأعراب الذين كانوا يحيطون بالمدينة، ويقيمون في الطرق الواقعة بينها وبين مكة. فهؤلاء ظلوا على الشرك، كالأعراب الآخرين، المنتشرين في أنحاء الجزيرة العربية كلها، طالما أن الإِسلام لم يقوَ على كسر شوكتهم بعدُ، والقضاء على وثنيتهم.
وإلى تلك الأطراف، تضاف فئة صغيرة أيضاً من عرب الأوس والخزرج، التي ظلت على الشرك ولم تدخل في الإِسلام. ولكنّها بحكم عنصريتها القبلية، واشتراكها في العادات والتقاليد مع أبناء قومها، الذين صاروا في الغالبية من المسلمين، كان لا بدَّ لها أن ترجعَ في علاقاتها العامة للأفكار وللمشاعر الإِسلامية، وأن تخضع للنظام الإِسلامي الذي بدأ تطبيقه وإن لم تدخل في الدين الجديد.
تلك هي حالات الجماعات التي كانت موجودة في المدينة ومن حولها يوم أن بدأ الرسول بتأسيس النظام الإِسلامي فيها. وقد تباينت مواقفها من النظام الجديد تبعاً لخلفية المعتقدات والأعراف التي كانت تتحكَّمُ فيها، ناهيك عن النوازع الشخصية لقادة تلك الجماعات، وحرصهم على التمسّك بالامتيازات التي كانوا يملكونها!.. ومن هنا ظهرت مقدرةُ الرسول الأعظم في إقامة النظام الإِسلامي رغم تعدّدية الجماعات في البيئة الواحدة، وتعدد مذاهبها الفكرية، وأنماط حياتها المجتمعية..
ولقد برزت مقدرته السياسية في الصحيفة التي كتبها بين المهاجرين والأنصار، وفيها وادَعَ اليهود وعاهَدهم واشترط عليهم وشرط لهم، بما يشكل وثيقة لصيانة الحقوق، ولا سيما حقوقهم في حرية المعتقد الديني، ولكن ضمن النهج الواحد، الذي تُطبَّقُ قواعده على الجميع.
ولقد جاء في تلك الصحيفة - الوثيقة:
»بسم الله الرحمن الرحيم
»هذا كتاب من محمد النبيِّ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم (استقامتهم)، يتعاقلون بينهم، وهم يَفْدون عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها (أسيرها) بالمعروف والقسط بين المؤمنين»[*]. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار، من بَعدِ بني عوف: بني الحارث، وبني ساعدة، وبني جُشَم، وبني النجار، وبني عمرو بن عوف، وبني النَّبيت، وبني الأوس، إلى أن قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً (المثقل بالدين والعيال) بينهم أن يُعطوه بالمعروف في فداء أو عَقْل. وأنْ لا يحالف مؤمن مولى مؤمنٍ دونه. وإن المؤمنين المتّقين على من بغى منهم، أو ابتغى دَسِيعَةَ[*] ظُلم أو إثم أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان وَلدَ أحدهم. ولا يَقتُل مؤمنٌ مؤمناً بكافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن. وإن ذمّة الله واحدة، يُجير عليهم أدناهم. وإنه من تبعنا من يهودَ فإن له النصر والأسوة (المساواة) غير مظلومين ولا مُتَناصرين عليهم. وإنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدة، لا يُسالمُ مؤمنٌ دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاَّ على سواءٍ وعدلٍ بينهم، وإنّ كل غازية غزت معنا يُعقب بعضُها بعضاً.. وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن.. وإنَّكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنَّ مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد.. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين (الدية) ما داموا محاربين.. وإن يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلاَّ من ظَلَم أو أثِم فإنه لا يُوتِغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته.. وإن بطانة[*] يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد.. وإنّه لا ينحجز (لا يلتئم) على ثأر جرح. وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته، إلاَّ من ظلم. وإن الله على أبرّ هذا[*]. وإن على اليهود نفقتَهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصرَ على من حارب أهل هذه الصحيفة. وإن بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الإِثم. وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم.. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وإن الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم. وإنه لا تجارُ حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يُخاف فسادُه فإنَّ مردَّه إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) . وإن الله - والمؤمنين على الرضا - بما في هذه الصحيفة. وإنه لا تجارُ قريشٌ ولا من نصرها. وإن بينهم النصر على من دهمَ يثرب، وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبَسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإِنهم إذا دَعَوْا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلاَّ مَنْ حارب في الدين، على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي قِبَلهم. وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرّ المَحْض من أهل هذه الصحيفة. وإنَّ البر دون الإِثم، لا يكسب كاسبٌ إلاَّ على نفسه. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثمٍ. وإنه من خرج آمنٌ ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم. وإِنَّ الله جارٌ لمن برَّ واتّقى، ومحمد رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)»[*].
هذه هي الوثيقة السياسية التي وضعها النبيّ محمد بن عبد اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) منذ أكثر من ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين عاماً والتي تقرِّر الحقوق المدنية والسياسية، وتحرّم الجريمة والظلم، وتدعو إلى الوفاق والوئام، وإلى تقوى الله وبرّه، وإلى كل ما يكفل للإِنسان حياة مليئة بالقيم والمثل، وسليمة من الشوائب والرذائل. ويكفي أن تقرِّر هذه الوثيقة حرِّية العقيدة لأهل الأديان السماوية، حتى يبرز الإِسلام سمحاً، معطاء، غايته التكامل الإِنساني في الأرض، وعبادة الله وتقديسه.
وهذه هي الوثيقة التي حدّدت القواعد العامة أيضاً للعلاقات بين مختلف الفئات والجماعات التي تعيش في المدينة. فصارت المدينة وما وراءها حرماً لأهلها، عليهم أن يدافعوا عنها ويدفعوا كل عادية عليها، وأن يتكافلوا فيما بينهم لاحترام ما قرّرت هذه الوثيقة من الحقوق والضمانات. كما عيَّنت هذه الوثيقة الحدود التي يلتزمها كل طرف، حتى لا تكون دون قيود أو ضوابط، ولا يصار إلى سوء استعمالها، أو استغلالها وإشاعة الفوضى بما يضيّع فاعليتها، ولذلك كان لا بد من تعيين الحدود وفرض القيود والضوابط لتأتي متوافقة متفاعلة مع المصلحة العامة... فكان التحريم في الوثيقة لكل ما من شأنه أن ينتهك حرمة المدينة بحرب أو بنصرة على حرب، والتحريم على اليهود - خاصة - أن يجيروا قريشاً - عدوَّة الإِسلام، المتربصة في مكة للانقضاض والقضاء عليه - كما كان التحريم لأي فساد أو ظلم، والتشديد في كل حدث أو خلاف على تقوى الله تعالى، وأن يكون الفصل في كل أمر أو شأن للحاكم الوحيد في المدينة، محمد رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الذي يحكم بما أنزل الله، وإنِ الحكمُ - دائماً وأبداً - إلا لله العزيز الحكيم..
ولقد وقّع على تلك الصحيفة جماعات اليهود التي ذكرت فيها، كيهود بني عوف، ويهود بني النجار، ويهود بني الحارث، ويهود بني ساعدة، وبني جشم، وبني الأوس، وبني ثعلبة.. أما الآخرون منهم، الذين لم يشتركوا في تلك الصحيفة، أمثال بني قريظة، وبني النضير، وبني قينقاع، فإنهم عادوا وعاهدوا الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على الانصياع لأحكامه وأوامره، فعقد معهم صُحفاً مماثلة. وبذلك سُوِّيت العلاقات بين جميع أهل المدينة، ولم يبقَ نفرٌ أو قبيلٌ إلاَّ وقد عرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات..
وبتوقيع تلك الصحف - المواثيق، وما انبثق عنها من علاقات جديدة لم تعرفها المدينة من قبل، اطمأن الرسول الأعظم إلى هذا الفتح الجديد من الله سبحانه، الذي أيَّده به وحَباه بالعزة والمنعة، كي يقيم دعائم مجتمعه الذي يريده، وركائز دولته التي يعمل على تأسيسها، والتي سوف يكون هدفُها الأعلى نشر دين الإِسلام لا في ربوع الجزيرة العربية وحسب، بل في بقاع الأرض وأمصارها ما دامت للمسلمين النية والإخلاص والإرادة التي يتوجهون فيها إلى الله تعالى.
وكان الوحيُ يتنَزَّل متتابعاً على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالتشريع الذي يدعِّمُ نظام المجتمع الذي يبنيه. فأُوحيَ إليه بالأذان[*] للصلاة. وصار أهل المدينة يسمعون كل يوم، دعوةً تتردد خمس مرات، يطلقها بلال بن رباح مرتَّلةً بصوت رخِيٍّ أحسن ترتيل، فتنقلها الرياح نشوى، ويحملها الأثير إلى الآفاق البعيدة عبقاً، فتترنم بها العوالمُ مَغْناةً للحق الأزلي، وتتلقفها المسامع فتحيلها إلى القلوب ترنيمةً للإيمان الثابت، وذلك بالإعلان الذي تخشع له السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهنَّ، وهي تستمع إلى نداء «الله أكبر.. الله أكبر لا إله إلاَّ اللَّهُ.. لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ - محمدٌ رسولُ اللَّه.. محمدٌ رسول اللّه..» فهو النداء إلى تكبير اللهِ - تعالى ـ وتوحيده قبل كل شيء، لأنه سبحانه ذو الجلال والإكرام أكبر من الوجود ومخلوقاته، ومن الكون وعوالمه، لأنه سبحانه خالق الوجود، وخالق الكون، وخالق الأوصاف والنعوت..، فهو الله الذي لا إله إلا هو، وهو ربُّ العرش العظيم..
وبتلك الخطوات العقائدية والتنظيمية التي تعتبر فتحاً من رب العالمين، والتي قام بها الرسول الأمين بتدبيره الحكيم بدأت تلوح تباشير القوة المعنوية في حياة المسلمين، وهذا من شأنِهِ أن يطمئن إلى سلامة المسيرة، وغدها المشرق بإذن الله..
ومثل هذا الاطمئنان حدا بالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأن يفكر بترتيب بعض الشؤون الخاصة به.. فهذه عروسه عائشة، قد عقد قرانه عليها منذ ثلاث سنوات، يوم كان لا يزال في مكة، وقد هاجرت لتقيم مع ذويها في المدينة، فلم لا يدخلها بيت الزوجية، وقد صارت مؤهلة لذلك؟...
وبالفعل نقل (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عروسه، وبنى بها في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة[*]، فكان لها نعم الزوج المحبّ الرفيق، وكانت له نعم الزوجة الوفية الرفيقة التي تعايشه في حياته الجديدة في المدينة، بل ومن الخاصة الأقربين منه، الذين وهبوا أنفسهم لخدمته، ومشاركته - ولو نفسياً ومعنوياً - في أعبائه الثقيلة، كما هو الحال مع ابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي كانت لا تزال تعيش في الكنف النبوي بجميع مآثره..
الإسلام طريقة معينة للعيش
ولم تكن حياة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تختلف في واقعها عن حياة سائر المسلمين، اللَّهم إلاَّ ما يحمل من أثقال الدعوة.. فالكل يعيش حياة التواضع والألفة، وحياة التضامن والتكافل، والكل على أهبة الاستعداد للتلبية حينما يدعوه نداء الواجب.. وكل ذلك طبقاً لما للإسلام من طريقة خاصة في الحياة، قامت عليها الحضارة الإسلامية فيما بعد، التي تختلف - بطبيعتها - عن حضارات الدنيا، باعتبار أن الحضارة لا تعدو كونها مجموعة من النظم والقيم والمفاهيم عن الإنسان والحياة والكون، التي تنبثق دائماً عن عقيدة معينة تعتنقها الأمة وتنشئ على أساسها حضارتها.
وتتلخص طريقة الإسلام في الحياة بأمور ثلاثة:
أولها : أن الأساس الذي تبنى عليه هو العقيدة الإسلامية.
وثانيها : أن مقياس الأعمال في الحياة يتحدد تبعاً لأوامر الله - تعالى - ونواهيه، أو بعبارة أخرى إن صورة الحياة في نظر الإسلام تبرز في دائرتين: إحداهما تحتوي الحلال وما ينبثق عنه من خير، والأخرى تنطوي على الحرام وما يَنجُم عنه من شر.
وثالثها: أن معنى السعادة يختصر بمشاعر الطمأنينة الدائمة في النفوس، والتي لا تتحقق إلا برضوان الله تعالى.
هذه هي الطريقة التي تقوم عليها حياة المسلمين، وينشدون السيرَ على نهجها طلباً للسعادة، وهذه السعادة لا تتم إلاّ إذا كان لهم دولة تطبق الإِسلام وتنفِّذ أحكامه.
والمسلمون حين انتظموا في المدينة المنوَّرة تحت لواء الإسلام، بدأوا يعيشون على هذا النهج الذي تأسَّسَ على العقيدة الإِسلامية. وكان القرآن الكريم يتنزَّل تِباعاً على النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لتبيِّن آياتُه العظيمة حُكم الله - تعالى - في المعاملات والعقوبات، ولتكمّل ما لم يُتَنَزَّلْ بعدُ من العبادات.
فلما جاءت السنة الثانية للهجرة، نزلت فرائض الزَّكاة والصِّيام.. فالزكاةُ فُرضت تقريراً لقاعدة التكافل والتضامن بين جميع أفراد المجتمع، فلا يبيت فردٌ على جوع، ولا ينامُ آخر على تخمة.. والصيام شُرِّع لتقوية الإِرادة الفردية، وتربية النفس على التحمُّل والصبر، وإرهاف الإِحساس الإِنساني نحو الفقير والمسكين.. فضلاً لما للصوم من ميزة خاصة على سائر العبادات والتي يبيّنها الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به».. إذن فالزكاة والصيام فريضتان من الشارع الأعظم، ربنا تبارك وتعالى، لحمل الإِنسان على التكامل في حياته..
تحول قبلة المسلمين
وفي هذه الأجواء التي تعبق بشذى اتصال الوحي الإلهي بالأرض تحوَّلت قبلة المسلمين عن بيت المقدس إلى الكعبة المكرَّمة في مكة، ولمَّا يمضِ على مكوث النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في المدينة أكثر من سبعة عشر شهراً، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ *} [البَقَرَة: 144] وقوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ *وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ *} [البَقَرَة: 149-150]..
وظلت الآيات تترى نزولاً مع الوحي الكريم، لترسم للمسلمين كلَّ خطوة في العبادات والمباحات والمحرَّمات والعقود والمعاملات..
فنزل تحريم شرب الخمر، وتحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بهِ.
كما نزلت الآيات التي تبين حدودَ الله، والجنايات، وأحكام البيع، وتحريم الرِّبا، وما إليها من الأحكام التي تعالج مشاكل الحياة بأسرها..
وكان الرسول الأعظم يتلقَّى الوحيَ، ثم يبلِّغ الناس، ويفصِّل الأحكام التي يتلقَّاها، ويبين صورها ومفاهيمها وآثارها، ثم يقضي في أمور الناس، ويعالج مشاكلهم، ويدبِّر شؤونهم، ويَفْصِلُ في خصوماتهم على ضوء تلك الأحكام وبالاستناد إلى مضامينها.
وأكثر ما يدهش الإِنسان في هذه الحقبة من حياة الدعوة الإِسلامية، هو لطف رب العالمين بأهل الأرض، والعناية الإلهية بأولئك الناس الذين يدورون في فلك رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في دقائق أمور حياتهم الواسعة التي يتراحم بها الناس جميعاً فتطمئن نفوسهم، وتستقيم سبل حياتهم.
وتتجلى صورة من أجلّ صور الرحمة الربانية بالمسلمين، في حادثة خولة بنت ثعلبة وزوجها مالك بن أوس بن الصامت (من الأنصار)، فقد كانت تلك المرأة ذات حسن وجمال، وقد رآها زوجها ساجدةً في صلاتها فراقت له، حتى إذا فرغت من صلاتها دعاها إليه فأبت عليه.. ويبدو أنه كان امرأً سريع الانفعال، فإذا استحكم به الغضب جعل خُلقَ الجاهلية - الذي كانت بقايا آثاره لا تزال عالقة في بعض النفوس - يسيطر عليه، فلمْ يكنْ منه في سورة غضبه إلاَّ أن قال لها: أنتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي (وكان هذا الظِّهار من طلاق الجاهلية).. ثم لم يلبث أن استعادَ وعيه، فندم وقال لها:
- ما أراك إلاَّ قد حَرِمْتِ عليَّ.
ودهشت المرأة وصرخت في وجهه: ما ذكرت طلاقاً؟!
وحارَ الرجل في ما يفعل، فأشارت عليه أن يذهب إلى رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حتى يقضي له في هذا الأمر!..
ولكنَّ الرجل أبى، استحياءً منه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وخجلاً من سوء فعله.. فما كان من المرأة إلاَّ أن أتت نبيَّ الله، فوجدته يغسل رأسه الشريف، وزوجه عائشة تصب له الماء، فاندفعت تخبره بحالها وتبثُّ شكواها إلى الله، وهي تقول:
»يا رسول اللّه إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة جميلة ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبرت سني، ظاهَرَ منِّي، وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه فتنعشني به؟ وإني أشتكي إلى الله سبحانَهُ ما يؤول إليه أمري؟».
فأبدى لها رسولُ الله أنَّ الظهار هو من طلاق الجاهلية، ولم يتنزَّل به حكم تشريعيٌّ بعدُ من الله تعالى....
فقالت: يا رسول اللّه، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذَكَرَ طلاقاً، وإنه أبو أولادي وأحبُّ الناس إليَّ.
فأبدى لها الرسول بأن تنتظر لعلَّ الله تعالى يأمره في شأنها بشيء.. ولكنَّ المرأة، وهي ملتاعة، أبت إلاَّ حلاًّ لمعضلتها، فأخذت تجادله في زوجها وتشكو إلى الله تعالى فاقتها وشدة حالها، وصبية صغاراً إن ضمَّتهم إليه ضاعوا، أو إليها جاعوا، ثم راحت تتضرع وتقول: اللَّهمَّ أنزل على لسان نبيك ما تُنعش به أملي، وتسكِّن فيه روعي..
وكان (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في تلك الأثناء - ولشدة ما رأى من انفعال المرأة وتأثرها - قد انقطع إلى ربه - تعالى - يدعوه ويتضرع إليه أن يُستجاب سُؤْلُ هذه المرأة، بينما السيدة عائشة ترقب ما يدور، فلا تجد - وخولة تلِجُّ في الطلب، وتُلِحُّ في الدعاء - إلاَّ أن تقول لها:
- أقصري يا امرأة حديثك ومجادلتك، أما ترَين وجهَ رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ؟!.. فسكنت خولة وقلبها يخفق بالأمل والرجاء!..
وكان (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا أنزل عليه الوحي، أخذه مثل السُّبات.. حتى إذا سُرّيَ عنه نظر إلى المرأة وهو يتبسّم، وقال لها: يا خولة قد أنزلَ الله فيك وفي زوجك قولَهُ تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ *الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاََّّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ *وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ *إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ *} [المجَادلة: 1-5].
فيا سبحان الله!..
مَنْ مِنَ الناسِ، في مثل هذا الموقف، لا يقشعرّ بدنُهُ، ولا ترتجف أوصالُهُ؟! فالله ـ جلَّت عظمته ـ قد سمع قول خولة بنت ثعلبة، وهي تجادل النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في زوجها أوس بن الصامت وتشتكي إليه سبحانه ظلم هذا الزوج وما أوقعها وأوقع نفسه فيه من الورطة؛ إنه - تبارك وتعالى - يسمع - من فوق عرشه العظيم - تحاورها مع رسوله الكريم لأنه سبحانه هو السميع البصير..
نعم، من لا ترتعد فرائصه خوفاً ووجلاً وهو يعلم أن الله يراقبه في كل حركة يقوم بها، وفي كل قول يقوله، وفي كل تحاور يجريه؟.. أوَ يعلم الإِنسانُ ذَلك، ويَجرؤ من ثمَّ على قول بهتان أو زور، أو على فعل حرام أو منكَر؟!... ومن يفعل فإنما يكون من الظالمين لأنفسهم، وهذا في ما خصَّهُ هو بالذات.. فكيف لمن يسيء إلى وطنه أو لدينه أو لأمته؟! فتلك هي المصيبة الكبرى التي قد تحلُّ به وهو لا يتوقع حدوثها.. إيهِ أيها الإِنسان، تفكَّر وتيقّن أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد، وهو دائماً معك، يرقبك في كلِّ قولٍ وفعل. إنه يسمع حوارك، ويسمع همسات نفسك وخلجات صدرك ويرى فعالك،.. فهلاَّ اتَّقيت الله العليَّ الكبير، وخجلت من الخالق اللطيف الخبير فلا نويت، ولا قلت ولا فعلتَ إلاَّ خيراً؟!...
تلك هي نفحة من نفحات ظلال الرحمة التي كان يُحيطُ بها الله سبحانه وتعالى نبيَّهُ والمسلمين، فلا شأنَ ولا حدثَ فردياً أو جماعيّاً إلاَّ ويتنزَّلُ به الوحيُ حكماً يسري على مَدى الدهر، لأنَّ حكم الله - ولا ريب - عادل، ثابت، لا يتغيّر مهما دار الزمان، ولا يتبدل مهما اختلف المكان، ولذا كان حلالُ محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حلالاً إلى يوم القيامة، وحرامه حراماً إلى يوم القيامة.
أجل كان الرسول الأعظم يتلقى النفحة تلو النفحة من لدن العزيز الحكيم، ويتفيأ في ظلال الرحمة من رب العالمين، فيَنشر آيات الله تعالى أقوالاً وفعالاً تكرّس لنا شريعة ثابتة، وسنَّة نَبَويَّةً دائمة، لأنه في كل أقواله، وفي كل أفعاله، كان لا يقول إلاَّ الحق، ولا يفعل إلاَّ الحق الذي نزل إليه من الله الحق، فإنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى، إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى..
ومن جميل أقواله، وحسن فعاله، بَنَى الأساس للحضارة الاسلامية، التي - نجدها - تتلخص بإجابته لعلي بن أبي طالب (رضي اللّه عنه) حين سأله عن سُنَّته، فقال: «المعرفة رأسُ مالي، والعقلُ أصلُ ديني، والحبُّ أساسي، والشوق مَرْكَبي، وذكرُ الله أنيسي، والثقةُ كَنزي، والحزنُ رفيقي، والعِلْمُ سلاحي، والصبرُ ردائي، والرِّضى غَنيمتي، واليقينُ قوتي، والصدقُ شفيعي، والطاعةُ حسبي، والجهادُ خُلقي، وقرَّةُ عيني في الصلاة»[*].
هكذا كان محمدٌ رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بذاته، وسنته في القول والفعل - بل وفي سكوته - المثلَ الحيّ للتعاليم التي جاء بها، والتي برزت في تلقينها لأخيه في الإسلام، وابن عمه في القربى، عليِّ بن أبي طالب، لتكون سنَّةً نبويَّةً، للإنسانيةً، وحجر أساس للحضارة الإِسلامية.
وها هي شذراتٌ من خلقه العظيم، وسلوكه القويم، تنبئ عن رفضه الظهور في أي مظهر من مظاهر السُّلطان، أو المُلك أو الرياسة الزمنية، بل كان يردد على مسامع أصحابه:
»لا تُطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم، إنما أنا عبدُ اللّه، فقولوا عبد اللّه ورسوله»[*]. وخرج يوماً على جماعة من أصحابه وبيده عصا يتوكأ عليها، فقاموا له، فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظِّم بعضهم بعضاً»[*].. وكان إذا بلغ مجلساً من مجالس أصحابه جلس منهم حيث انتهى به المجلس. وكان يخالط أصحابه ويحادثهم ويلاطفهم، ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حِجْره، ويُجيب دعوة الحر والعبد والأمةِ والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويَقبل عُذر المعتذر، ويسبقُ من لَقِيَهُ بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ولا يجيء إليه أحد وهو يصلي إلا خفَّف صلاتَه وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته.
أما في سيرته الذاتية، وما يخص شخصه النبيل، فالتواضع نهجُهُ: يطهر ثوبه ويرقعه، ويحلب شاتَهُ، ويخصف[*] نعلَهُ، ويعقل ناقتَهُ، ويأكل مع خادمه.. والحدب شَجْوُهُ: يحنو على الأرملة والضعيف، ويقضي حاجة الفقير والمسكين، ويعين البائس وابن السبيل، يؤثرهم على نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة.. أما محبة الأهل وذوي القربى فهي ديدنه.. والوفاء للصحابة طبيعته.. والإسلامُ دينُهُ.. والقرآن كتابه.. ورضى اللَّهِ تعالى رجاؤه..أجل تلك نفحات من حياته الخاصة.. ولا تقف أخلاق محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وفضائله عند حدود الإنسان بالبر والرحمة، والمعاملة بالحسنى، ومحاربة الظلم والفساد.. وما إلى ذلك من صفاته النبوية والإنسانية، التي تعدُّ منهلاً يستقي منه الإنسان المدرك، والتي كانت الأساس الذي ابتنى فوقه المسلمون حضارتهم التي تتزود منها الحضارات.. أجل، لم يكنِ الإنسانُ وحدَهُ مدارَ اهتمامِ محمدٍ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بل عدّاه إلى الحيوان، فكان يفتح بنفسه الباب لهرةٍ تلتمس عنده الملجأ، أو يقوم على تمريض ديك مصاب، أو يعالج الأنعام بالكي، أو يمسحُ جواده بكم ثوبه... حتى شملت رحمته كلَّ ما اتصل بها، وأظلَّت كل من كان بحاجة للتفيؤ بظلالها..
إنه محمدٌ الرسول.. ومحمد الإنسان.. ومحمدٌ المثل الأعلى والأسوة الحسنة للمسلمين، ولجميع خلق الله ممَّن أراد أن يحتذي بسنته.. وقد اقتدى به كثيرون، فأقبلوا على الإسلام يزيدهم شرفاً وعزَّةً، ويزداد بهم قوةً ومنعةً.. فانطلقت الحياة في المدينة على طريقة الإسلام: فكراً، وقولاً، وعملاً صالحاً..
وأقبل المسلمون - في جلّ اهتمامهم - على ملازمة هذا الرسول الكريم، يتعلمون أحكام الدين، ويحفظون آيات القرآن، ويتثقفون بمعانيها الواعظة، ويتربّون بأخلاقها الفاضلة، وينهجون على سنة الله ورسوله...
ظهور النفاق في المدينة
إلاَّ أنَّ هذا الوضع الجديد الذي نشأ في المدينة بات يخيف اليهود والمذبذبين ويدفعهم للتفكير في ما يجب صنعُهُ تجاه هذه الدعوة التي يحملها «محمد»، والتي هي السبب في كلِّ ما يجري من حولهم، فهل يتركون هذه الدعوة تنتشر، وسلطانَها الروحي يمتدّ، مكتفين بالأمن في جواره، ثم لا يجدون أنفسهم إلاَّ وقد غلبت تعاليم دعوته على أفكارهم ومعتقداتهم، وصهرت الناس في هذا المعتقد الجديد، وهذا ما لا يرضونه على الإطلاق؟!.
لا، إنهم لا يريدون - أصلاً - الإِقرار بالإسلام، ولا التصديق بنبوة «محمد»، وبالتالي فلن يقبلوا بأن ترتفع أية مداميك للبناء الإسلامي!.. ولكن ما السبيل، وحال المسلمين قد تغيرت عمَّا عهده الناس في مكة؟ لقد استطاعت قريش أن تناصب «محمداً» العداءَ جهراً وعلانيةً، وليس هذا بمقدورهم هنا في المدينة، مما يجعل سلاحهم الأقوى الدسيسة والنفاق. ولذلك اجتمع الدهاقنة: عبد الله بن صيف، وعديُّ بن زيد، والحارث بن عوف ودعوا كبار الأحبار من اليهود لوضع استراتيجية العمل المقبل، الذي يقوم على اختيار أكفاء في ضروب الكذب والنفاق، فيعلنون دخولهم في الإسلام كي يتاح لهم أن يندسّوا بين المسلمين، وليقوموا من ثَمَّ بالأفاعيل التي يوجّههم إليها زعماؤهم، والتي من شأنها بذر الشك، والتفرقة، والعداوة بين صفوف المسلمين.. ومن جملة ما أوصوا به، أن يقول بعضهم لبعض: «تعالوا نؤمن بما أنزل على «محمد» غُدوة، ونكفر به عشية، حتى نَلبِسَ على المسلمين دينهم، لعلَّهم يصنعون كما نصنع، ويرجعون عن هذا الدين»[*].
وكان ما خطَّطَ له اليهود.. فدخل أحبار منهم في الإسلام كذباً ورياء، وراحوا بعد إعلان «إسلامهم» يجلسون إلى رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ويلقون عليه من المسائل، ما هو كفيل - بحسب ظنهم - أنْ ينشُرَ الشكوكَ حول العقيدة الإسلامية، وزعزعة ثقة المسلمين بنبيّهم.. ولكنَّ الله بالغُ أمره، فأنزل قرآنا مبيناً يفضح سرائرهم ويظهرُ النفاقَ وأهلَهُ بقوله تعالى: {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ} [آل عِمرَان: 72-73].
وهنا، وبهذا التنبيه من رب العالمين - فطن المسلمون لخطر المنافقين، فصاروا يَحذَرون منهم لئلا يستفحل كيدهم، كما حصل عندما وجد رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جماعة من المنافقين في المسجد، قد لصق بعضهم ببعض، وهم يتخافتون فيما بينهم، فأمر بإخراجهم ولو عنوةً وبالقوة...
ومع ذلك فقد استمروا في الدأب على الوقيعة بالمسلمين، ومثاله ما فعل شاس بن قيس وهو يرى نفراً من الأوس والخزرج يجتمعون سويةً على المودة والألفة، فغاظهُ صلاح ذات بينهم، كما حدَّثته نفسه وهو يقول: «قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، وما لنا معهم إذا اجتمع ملَؤهم من قرار».. وواتته الفرصة لإثارة الخلاف بينهم، إذ رأى فتًى يهودياً بالقرب منهم، فناداه وأسرَّ إليه أن يندسَّ بينهم، ويجهد ليذكر يوم «بعاث» وما كان فيه من انتصار للأوس على الخزرج.. وما إن سمع القوم بذكر تلك الواقعة المشؤومة حتى تنازعوا فيما بينهم، وهم يقولون لبعضهم البعض: «إن شئتم عدنا إلى مثلها»!.. وبلغَ رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خبرُهم، فأتاهم، ومعه جمع من الصحابة، يذكّرهم بما ألَّف الإسلام بين قلوبهم، وجعلهم إخواناً متحابّين.. وما يريد لهم اليهود والمنافقون من كيدٍ حتى يتفرَّق شملهم، وتذهب ريحهم.. وبدا عليهم التأثر ـ وهم يستمعون إلى نبيهم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو يرشدهم بالحكمة والموعظة الحسنة - حتى بكوا.. فتدافعوا يتعانقون، ويستغفرون الله على ما بدرَ منهم في نزعة جاهلية بغيضة، عافتها نفوسهم منذ أن منَّ الله عليهم بالإسلام.. ولمَّا لم تكن مثل تلك الدسائس التي كان يفتعلها اليهود والمنافقون لِتُجديَهم نفعاً، فقد تحوّلوا إلى أساليب في الدهاء أشدّ وأعتى، فصاروا يأتون النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إما منكرين نبوته، أو طالبين معجزات تثبت بعثته، كما فعل عبد الله بن صوريا الفطيوني عندما قال له: «ما الهدى إلا ما نحن عليه، وما أنزل الله عليك من آية فنتبعك لها»، وفي ذلك تنزَّل قول الله تعالى: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ *} [البَقَرَة: 99].
وجاءه مرةً رافع بن حُريملة، ووهب بن زيد، يقولان له: «يا محمد، ائتِنا بكتاب تُنزِّله علينا من السَّماء نقرأُه، وفَجِّرْ لنا أنهاراً، نتبعك ونصدقك»!..
فأنزل الله تعالى في ذلك قوله الحق: {أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ *} [البَقَرَة: 108].
ورأى أهل الكيد والمكر في صرف القِبْلة إلى الكعبة الشريفة منفذاً للإِيقاع برسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، لأنه ينقُض - على حسب اعتقادهم ـ ما جاء في الكتب السماوية السابقة، ويجعل «محمداً» يستنُّ لنفسه أموراً لا تأتلف مع تعاليمهم الدينية. فاجتمع إليه وفد منهم، وفيه: رفاعة بن قيس، وقَرْدَم بن عمرو، وكعب بن الأشرف، ورافع بن أبي رافع، والحجاج بن عمرو، (حليف كعب بن الأشرف)، والربيع بن الربيع بن أبي الحُقيق، وأخوه كنانة، قائلين:
»يا محمَّد، ما ولاَّك عن قبلتِك الَّتي كنتَ عليها، وأنت تزعم أنك على ملَّة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نَتَّبعك ونصدِّقك» - وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه كما هو بادٍ بوضوح - فأنزل الله تعالى فيهم: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا ولاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنْ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ *قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ *وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ *} [البَقَرَة: 142-145].
فهذه الآيات المبيّنة واضحة الدلالة على بطلان قول السفهاء، ذلك أنَّ الله - سبحانه وتعالى - هو الذي ولَّى رسوله محمداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن قبلته التي كان عليها - وهي بيت المقدس - إلى المسجد الحرام - في مكة المكرمة - حيث الكعبة الشريفة مصلّى الأنبياء.. وإنَّ أهلَ الكتاب ليعلمون أن هذا التولّي هو الحق من ربهم، وما على الرسول محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاَّ اتباع أمر ربه، لا اتباع أهوائهم، فأمرُهُ - عز وجلَّ - هو الحق، وليس ما يمترون!..
لقد جحدوا بتلك الآيات - واستيقنتها أنفسهم - فازدادوا غيًّا، حتى وصَلَ الأمر إلى حد الأذى العلني على الرغم مما يربط اليهود من عهد مع رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .. وحسبنا لتقدير هذا الوضع - بسبب الإِفك من تلك الفئة الباغية - أن نذكر ما جرى مع أبي بكر (رضي اللّه عنه) عندما كان يحاول أن يهدي يهودياً، يدعى فنحاص، إلى الإسلام، فما كان من ذلك اليهودي المارق إلاَّ أن كشَّر عن نابه، وهو يقول له: «والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير، وما ندعوه كما يدعونا. وإنا عنه أغنياء، وما هو عنّا بغنيّ، ولو كان غنياً عنا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم، وأعطانا وأَعطيناه، ولو كان غنيّاً عنا ما أعطانا»[*].
ولكنَّ أبا بكر - وهو ما هو عليه من دماثة خلق، وطول أناة ولينٍ في الطبع - لم يحتمل مقولة ذلك اليهودي، فغضب لله، ولطم فنحاص على وجهه لطمة شديدة، وهو يقول له:
ـ والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك يا عدو الله!..
واستغل اليهود هذا الحادث، منكرين جملة وتفصيلاً أن يكون فنحاص قال ذلك القول، أي بما يكذب أبا بكر (رضي اللّه عنه) ويسيء إليه.. بل وراحوا يشيِّعون بأن المسلمين هم الذين يستفزّونهم ليعتدوا عليهم، وينالوا منهم!... ولكنَّ كيدهم ارتدَّ إلى نحورهم، إذ تنزَّلت الآيات القرآنية التي تفضح كذب المنافقين، وتتوعدهم بعذاب السعير بقول العزيز الحكيم: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ *} [آل عِمرَان: 181].
وكان رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، على الرغم من تلك الحوادث، لا ينفك عن دعوة اليهود إلى الإسلام وترغيب الناس جميعاً في هذا الدين.. ولكن أنَّى للنفوس التي امتلأت بالشر والدنس أن تحيد عن غيِّها وسفاهة أحلامها، فقد كان أهل الكفر والشرك في كل مرة يدعوهم الرسول الأعظم إلى الهدى، يعكسون الآية ويحاولون إيقاع المسلمين في الفتنة، أو يردّون عليه - هو - بالرفض المطلق محتجّين بأنهم وجدوا آباءهم على ملة - وهم أعلم منهم - وهم يتبعون ملَّةَ آبائهم، كما احتجَّ بذلك رافع بن خارجة، ومالك بن عوف لدى رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كما يبينه قول الحق تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ *} [البَقَرَة: 170].
وفد نصارى نجران في المدينة
وفي ذلك الوقت الذي اشتدَّ فيه الجدال والخصام بين المسلمين من ناحية، والمنكرين من اليهود والمشركين من ناحية ثانية، قدم المدينة وفدٌ من نصارى نجران، عدّتُهُ ستون راكباً، وغالبهم ممَّن درس الكتاب، وحسن علمه في الدين، فكان ملوك الروم - وهم على النصرانية - قد شرَّفوه، وأمدّوه بالمال، والعقار والخدم، وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه المكرمات حتى صارَ من ذوي المكانة الرفيعة في بني قومه.. وقد جاء ذلك الوفد رغبةً في استطلاع خبر النبي - في آخر الزمان - ومعرفة الدين الذي يدعو إليه؛ واتصل الوفد أولاً بأحبار اليهود، وعقد معهم الاجتماعات لأنهم أهل كتاب مثلهم، أما ما دار بينهم فذلك شأنٌ هم يعلمونه.. المهم أن الوفد النجراني كان مقصده الرسول محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فجاؤوا يحاورونه، ويلقون عليه المسائل التي في ظنهم أنها تعجزه، والرسول يردُّ بالآيات القرآنية التي تبين حقيقة الإسلام وأحقية نبوّته، ثم يلقي عليهم الحجة بدعوتهم إلى الإسلام، مستفتحاً بقوله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ *} [آل عِمرَان: 64].
وزادهم الرسول الأعظم بأن يجتمع وإياهم إلى اليهود على أن يكون الحكم الفاصل نصوص التوراة والإنجيل وما تنزَّل عليه من آيات القرآن الكريم في كل ما يمكن أن تجري مناقشته أو يدور حوله من جدال، لأن الغاية هي الدعوة إلى الله - عز وجل - رب السماوات والأرض، ورب العالمين أجمعين.
فهل بعدُ أبسط وأقوى من هذه الدعوة الصريحة؟
وانعقد الاجتماع الذي شهدته المدينة المنورة والتقت فيه الرسالات السماوية الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام، في أول لقاء من هذا النوع في دنيا الناس.. وقبل الدخول في المسائل الفرعية، طرح محمدٌ رسول اللّه أن يكون محور الاجتماع الإقرار بالألوهية المطلقة، والربوبية المطلقة لله رب العالمين، وعمادُهُ قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *اللَّهُ الصَمَدُ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *} [الإخلاص: 1-4].
وأراد المجتمعون، ولاسيما اليهود، التملّص من بحث هذه المسألة، فابتدروا الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالسؤال عن رأي الإسلام في ما أنزل على الأنبياء والمرسلين، وبماذا يؤمن مما أنزل عليهم، وبمن يؤمن به منهم؟!..
وكان محمد رسول اللّه واضحاً في تبيان هذه المسألة التي لا يرقى إليها الشك لدى أحدٍ من المسلمين، وهو يتلو عليهم قول الله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ *} [البَقَرَة: 136].
فماذا يستطيع، بعدُ، اليهود، وماذا يستطيع، بعدُ، النصارى، أو غيرهم من الناس أجمعين، أن يقولوا في إيمان المسلمين الحق بالله الذي هو عماد الإيمان والتقوى، ومن ثم الإيمان بما أنزل إلى محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وما أنزل إلى جميع النبيين بلا أدنى تفريق بين أحد منهم؟!.. فقد بعثوا جميعاً بدعوة الحق، وكلمة السواء بين الناس: ألاَّ يعبدوا إلاَّ الله ولا يشركوا به شيئاً.. ولكن هل اتَّبعَ الناسُ، وأهلُ الكتاب خاصة، هذا المنهاج الرباني؟! ولماذا ابتعد الناس عن الدين حتى صارت الماديَّة شرعتهم؟! من هنا كان المعوّل على الإنسان وما تمتلك نفسه من بذور الإيمان أو الكفر للانصياع إلى الحق، أو الابتعاد عنه!..
فأما الإنسان الذي كرَّمه الله تعالى بالعقل والحسّ، وأودعَ فيه الفطرة السليمة فلا بدَّ أن يستشفَّ الإخلاص لله العلي العظيم، ويؤمن بحقيقة بعث جميع النبيين والمرسلين لهدي الناس، فلا يكون بالتالي من مجال له إلاَّ أن يؤمن بإيمان محمد رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأنه الإيمان الذي يسع الأديان كلها، وما حملت نصوصها الأصيلة - قبل أن يدخل عليها التحريف - وهو الإيمان الذي يجعله مسلماً لله تعالى، ويلتزم بأحكام الإسلام، ويعمل بتعاليمه..
ولكن، وكما يتراءى لنا في الحياة، فإنَّ مع الجانب النفسي هناك الجانب المادي - الذي يبدو الأشدّ تأثيراً على النفوس - والذي يطغى على الإنسان، ويجذبه إلى زخرف الحياة الدنيا وزينتها، فيخذله وينسيه آخرته، فيشتري زيف هذه الحياة الدنيا بأحقية الآخرة، كما يصرّح به «أبو حارثة»، أكثر أفراد الوفد النجراني علماً ومعرفة، وهو يسرُّ إلى أحد رفاقه بأنه على قناعة تامة بصدق «محمد» وأحقية كل ما يقول.. فهنا يسأله رفيقهُ:
ـ فما يمنعك منه وأنت تعلم ذلك؟!
فيكون جوابه الذي يعبّر عن الجانب المادي، وتأثيره على الناس، بقوله: «يمنعني ما صنع بنا هؤلاء القوم (يعني ملوك الروم): شرَّفونا، وموَّلونا، وأكرمونا، فلو فعلت (أعلنت صدق محمد) نزعوا منا كلَّ ما ترى»!..
وهذا هو شأن أكثرهم الذين غرَّتهم الحياة الدنيا الفانية، فاتبعوا أهواءهم، وتركوا الدين الذي أرادَه الله سبحانه وتعالى ديناً قيّماً، ليس للمسلمين وحدهم، ولا للنصارى أو اليهود وحدهم، بل للناس كافة..
ويبدو أن وفد نجران، وبعد تفكير طويل في كل ما أبداه «محمد» في المجادلات التي جرت، طلب من النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يبعث معهم حَكَماً للفصل في مسائل اختلفوا عليها، فانتدب لهذه المهمة أبا عبيدة بن الجراح[*] على أن يحكم بينهم بالكتاب والسنّة في ما اختلفوا فيه.. وفي رواية: إنَّ أهل اليمن قدموا على رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا: ابعث معنا رجلاً يعلّمنا السنَّة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة ابن الجراح وقال: «هذا أمينُ هذه الأمة»[*].
وهكذا وبقوة الفكر الإسلامي المبنيّ على القرآن الكريم، استطاع رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يفنّد، بالكلمة السواء والحجة البالغة، المجادلات الكلامية التي كانت تُثار من هنا وهناك.. وبذلك اختفت - أو كادت أن تختفي - الأفكار غير الإسلامية في المدينة، ولم يبق إلاَّ الإسلام الذي يقدر على حمل لواء الفكر الإنساني، في أسمى مراتبه، وإقامةِ الحكم بما أنزل الله تعالى.
بروز أجواء القتال
وعلى الرغم من تلك الظاهرة الإيمانية والحضارية التي كانت تعيشها المدينة المنورة في تلك الحقبة، فإنَّ أعداء التوحيد، وأعداء الرقيّ الفكريّ أبَوْا إلاَّ أن يعلنوها حرباً، متحلّلة من كل المقومات الأخلاقية للإجهاز على النظام الإسلامي الذي يقيمه محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قبل أن تكتمل قواعده وأسُسُه، وذلك للحؤول دون أن يكون للمسلمين القوة الفاعلة التي تضرب - أول ما تضرب - الذين يخادعون الناس، وما يخدعون إلاَّ أنفسهم ولكن لا يشعرون. فكان لا بدَّ من التخطيط للجهاد - الذي لم يغب يوماً عن بال رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) - بعدما برزت دوافعه العديدة، وكل دافع يشكل بمفرده سبباً كافياً لرصد تحرك الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، وإعداد العدّة لمنعهم من التمادي في طريق الغيّ والضلال التي اختاروها.. فالهدف الأسمى عنده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو نشر الدعوة الإسلامية، تلبية لنداء الواجب القدسي الذي فرضَهُ الله تعالى على النبيين والمرسلين ومَن والاهم من المؤمنين، فكان حريّاً بخاتم النبييّن أن يكون حاملاً لواء الدعوة إلى الله الواحد الأحد، وبشيراً ونذيراً لقوم يعقلون.. فإيصال الإسلام إلى الناس ديناً وعقيدةً، وحضُّهم على امتلاك القيم والمثل والمناقب التي يحملها هذا الدين، واعتناقهم أفكاره ثقافةً ومنهجاً - وذلك بطريق الإقناع والاقتناع، لا بطريقة المبشرين، كما هو معهود منهم على مر العصور، - أجل إن إيصال الإسلام إلى الناس على هذا النحو.. دونه الموانع والعوائق من أعداء هذا الدين الذين يمتلكون العدد والعدة المادية، ويبتدعون الطرق والأساليب الفكرية، التي من شأنها أن تقف حائلاً دون الإسلام وتحقيق أهدافه العليا، ولاسيما في ما خص تربية الإنسان في جوهره، وتخليصه من الشوائب والأدران التي تسيطر على عقله وقلبه، من جراء العبادات الصنمية المنوعة، والأهواء الشخصية المتقلبة، بحيث لا يبقى للإنسان البسيط إلاَّ الركضُ وراء المادية.. ومن هنا كان الجهاد - القتاليُّ والنفسيّ - فرضاً على عباد الله المخلصين لأنهم وحدهم يمتلكون القوة المعنوية، القائمة على الإيمان الصادق، والسلوك السويّ..
وكان واضحاً - منذ البدء - أن قبيلة قريش، ومن دار في فلكها، هي في طليعة أعداء الإسلام والمسلمين، فقد حاربت هذا الدين ونبيَّه منذ أن انبلج فجره النوراني في مكة، وكانت لا تزال أهم القوى التي تعمل جهراً وعلانيةً للقضاء عليه، مما يفرض على المسلمين أن تكون لهم القوة التي تحول دون قريش - وأمثالها - من تحقيق مآربها الخبيثة، وهذا يستدعي تهيئة الجيش الفاعل الذي يحمل مهمات الدفاع، وتبعات القتال، لاسيما وأن المواجهة مع قريش - بالذات - كانت من الأمور التي لا محيصَ عنها بسبب استيلائها على أرزاق المسلمين في مكة، ومنعهم من حمل أي متاع معهم، في مهاجرتهم، كي تتركهم يقعون في الضيق والجوع والفقر، لولا أن تداركتهم رحمة الله تعالى، وهبَّ إخوانهم الأنصار - بفعل الإيمان الذي يعمر قلوبهم، والمواساة النادرة التي كانت تعتمل في نفوسهم - يشركونهم بالأموال والأرزاق، ويرفعون عنهم العوز والفاقة..أمَّا وقد تغيرت الأحوال وعمَّ الشحُّ، وندرت الغلال بسبب القحط الذي حلّ بُعيدَ الحقبة الأولى من الهجرة، فإنه لم يعد بمقدور المهاجرين أن يزيدوا من الأعباء على كاهل إخوانهم الأنصار، كما أن الأعمال التي كانوا يقومون بها، لم تكن لتؤتي ثماراً كافية - في الغالب - بسبب تلك الظروف المحيطة بهم.. ويكفي للتدليل على الحالة التي وصل إليها المهاجرون - والتي لم تكن أخفّ وطأةً على الأنصار ـ أنه كانت تأتي عليهم أيام من غير أن يجدوا ما يحصّلونه من القوت والرزق، فكان المهاجر يستحي أن يلقى صديقاً أو رجلاً يعرفه، غريباً عن المدينة، ولا يدعوه ضيفاً عزيزاً على عادته في مكة... أو أن يقع أهله في ضائقةٍ ولا يستطيع دفعها، أو حاجة ولا يقدر على قضائها، حتى أشبعت نفوسهم بالمرارة والألم..
وكان من الطبيعي - في تلك الضائقة الشديدة - أن يرنو المهاجرون بأنظارهم إلى مكة، الموطن الذي تركوا فيه أموالهم ومتاجرهم لتظفر بها قريش، وتستولي عليها عنوةً، ثم لتحتلَّ الديار والبيوت، وتتصرَّف بها تصرف المالك بملكه[*].. إنهم يتفكرون في ما كانوا عليه من اليسر الكريم، وما هم فيه من الفقر المدقع، فيتأثرون كثيراً، ويتحفَّزون إلى ما لا يعلمون له تفصيلاً... ويزيدهم ترقباً هذا الحنين إلى الوطن الذي ترعرعوا في ظلاله، ومشوا على رماله، وعاشوا فيه حياتهم على الحلو والمرّ، حتى جاء اليوم الذي أخرجتهم منه قريش بالقوة، وجعلتهم أغراباً في موطن آخر.. إنهم مهاجرون يلوذون بالشوق والحنين، وليس لهم إلاَّ الحسرة على أيام الصبا الخوالي، والأمل في معاودة العيش مع العيال والأهل آمنين في البلد الأمين.. ولكنْ! أين هُمْ أولئك الأهل؟ وأين هم الأقارب والأصدقاء، وهم ينأون عن أنظارهم ورعايتهم؟! فقد أجبروا على الرحيل عنهم، ليخلّوهم إلى ذئاب مكة الآدميين، ينهشون كرامتهم، ويمزّقون عواطفهم.. إنهم هناك محاصرون من تلك الزمر الكافرة الخسيسة، وهم إما ممنوعون من الهجرة، وإمَّا غير قادرين على تحمل المشقات، وقطع المسافات، هذا فيما لو أجازت لهم قريش الخروج.. إنَّهم - في نهاية المطاف - في حبسٍ قسريٍّ، مجبرون على احتمال مهانة المشركين، وسوء فعال قريش وصلافتها..
فبالله! أية حالة تلك التي كان يعيشها المهاجرون بلا عيالٍ، ولا مال ولا ديار؟! وأية أعباء كانت تضغط عليهم بسبب ما يعانون من الهموم، فوق ما يعتمل في نفوسهم من مشاعر بالظلم والعدوان اللذين أوصلاهم إلى ذلك الوضع المقيت؟! ولقد انعكست تلك المشاعر على الأنصار الطيبين.. إذ لم يعد لعيشهم هناءةٌ على الرغم من أنهم في ديارهم، وبين عيالهم، وهم يرون إخوانهم المهاجرين، مهمومين قلقين، فقد صاروا مسلمين بفضل الله، والمشاعر الإسلامية تغلغلت في نفوسهم، فجعلتهم يتحسَّسون المشاركة الجماعية مع إخوانهم المسلمين في شتى أحوالهم المعنوية، وأوضاعهم المادية.. وليست العاطفة الإسلامية حيال المهاجرين هي وحدها التي كانت تدفع بالأنصار إلى رصد ما قد تنبئ به الأيام من أحداث وتطورات، بل إنَّهمْ هُم أيضاً كانوا يتطلعون إلى مكة حيث البيت العتيق، الذي كانوا يحجون إليه في جاهليتهم، فكيف وقد صارت الكعبة الشريفة قبلتهم التي يتوجهون إليها خمس مراتٍ كل يوم، لا يريدون إلاَّ وجْهَ الله تعالى، ولا يسألونه إلاَّ أن ينصر دينَهُ، فيتاح لهم أن يؤمّوا بيته الحرام، حاجين ومعتمرين وآمنين!..
أفتطيب لهم حياة وهم محرومون من الذهاب إلى ذلك البيت المقدّس، والطواف حول بُنيانه، والجلوس عند أركانه، والصلاة في أفنيته تقرباً إلى جوار الله في بيته المعظَّم؟ وهل كان ذلك البعد عن بيت الله الحرام إلاَّ بفعل قريش، الفئة الضالَّة الغاشمة؟ وهذا لا تطيقه شعلة الإِيمان التي تتوهج في نفوسهم كمسلمين، وهي التي تحفزهم على قتال أولئك المشركين، ومن ثَمَّ لأجل إعادة الكعبة إلى سابق عهدها، موئلاً للحجيج، وملاذاً للمؤمنين وعودة المهجَّرين إلى أهليهم وديارهم.. فهذه المشاعر التي كانت تتأجج في نفوس المسلمين في المدينة - من مهاجرين وأنصار - جعلتهم يترقبون على أحرَّ من الجمر اليوم الذي يؤذَن لهم فيه بالقتال، إعلاءً لكلمة الله تعالى، ولإِزالة الفساد من حول الكعبة الشريفة، ورجوع المهاجرين إلى ديارهم التي أُخرِجوا منها بغير حق، إلاَّ أن يقولوا: ربُّنا الله...
وكان رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يفكّر في كل تلك الأمور، فيأخذها بعين تقديره وحسبانه... فالميزانُ الأكبر في نَظَرِه، كان يحمل في إحدى كفتيه: الشركَ وعبادةَ الأصنام، وفي الكفة الأخرى: الإِسلام وعبادة الله الواحد الأحد. فإما أن ترجَحَ كفةُ الدين، ولا يكون ذلك إلاَّ بالقوة والغلبة، وإما أن ترجح كفة الشرك، ولا يكون ذلك إلا بالضعف والانكسار، وعندئذٍ قد لا تقوم للمسلمين قائمة على الإطلاق.. فالمسألة - إذن - مسألة حياة أو موت: إما الاسلام وعزّتُهُ وفيه الحياة للمسلمين قاطبة، وإما الجاهلية ووثنيتها وفيها موت للمسلمين عامّة!.. وهذا ما لا يرضاهُ ربُّ العالمين لعباده المؤمنين..
الإذن بالقتال
ولكنًّ رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن مخيراً في هذا الأمر الجلل ، بل كان ينتظر إذْنَ ربه - تعالى - بالقتال. ففي مكة رفع شعار التهدئة والصبر عندما كان يقول للمسلمين: «لم أُؤمر بالقتال».. أما اليوم في المدينة فقد بات الحال بالمسلمين غير السابق، وهم يقدّرون بأنهم على الحق، وأعداءهم على الباطل، وهو بدوره الرسوليِّ، وبتقديره النبوي لا يعقل أن يستبق أمر ربه تبارك وتعالى ... وإنَّه لعلى تلك الحالة من الترقب والانتظار، إذا بأمر ربه يتنزّلُ عليه بقوله تعالى {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ *الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ *} [الحَجّ: 39-41].
إذن فالمسلمون كانوا على حقٍّ في ما يفكرون، وما يأملون من قتال العدو اللدود قريشٍ، وها إن التنزيل الحكيم يبين أنَّ السميع العليم قد أذن لهم بالقتال لأنهم ظلموا... وقد برزت أهم مظاهر هذا الظلم في مكة بشتى أنواع السُّخرية، والعذاب والتهجير ومصادرة الأموال.. إلى حد التآمر على قتل النبيّ نفسه..، وإنَّ ما يحيق بالمسلمين الآنَ في المدينة هو الظلم بعينه أيضاً، ولكن بأساليب أخرى: النفاق، والتكذيب، وبذر التفرقة، والتآمر لضرب النظام الإسلامي.. فكان لا بدَّ أنْ يقاتلوا من أجل رفع الظلم عنهم بشتى أنواعه، بما في ذلك استعادة حقوقهم المسلوبة، وأموالهم المغتصبة التي يشرِّع العلي القدير استردادها بقوله المبين: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ *إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *} [الشّورى: 41-42].
وجمعَ الرسول الأعظم أصحابه يشاورهم في الأمر، ويتلو عليهم آيات الله العظمى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ *} [الأنفَال: 60].
وامتلأت قلوب المؤمنين فرحاً بإذن الله - تعالى - الذي جاء أمره يحضّهم على القتال وإعداد القوة لمجابهة الأعداء.. وتبدَّى هذا الأمر حماسة على الوجوه الشجاعة التي رأت أنه قد جاء اليوم الموعود، وولَّت أيام الهوان والانتظار، والسكوت على الظلم والكيد، ولاحت لهم أول تباشير التصدّي للإِرهاب القرشي، وبغي النفاق المدني، بل والصلَف الجاهلي برمته.. ودنا وقت الجهاد، حيث يتعانق الإيمان مع السيف في ساح الوغى، وحيث تتطلَّع النفوس المطمئنة، التي ترومُ رضوانَ ربها، وترنو إلى جنة خلدِهِ، راضية مرضية.. ولذلك كانت الاستجابة للنبيّ فورية، وهو يحثّ المسلمين على الاستعداد وتعبئة كامل القوى للقتال، فيما لو أراده الأعداء وأصرّوا عليه!.. ثم كانت أولى خطواته العملية، البدء بإرسال كتائب محدودة لتقصّي أخبار عير قريش، واستطلاع الطرق التي تسيّر عليها قوافل تجارتها، حتى إذا أمكن سدُّ الطريق عليها، انقطع الشريان الأهم الذي يمدُّها بأسباب القوة والجبروت..
وفي تلك المرحلة التي تُعدُّ انعطافاً هاماً في حياة المسلمين، اختار النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأول مهمة استطلاعية من هذا القبيل عمَّه حمزة بن عبد المطلب (رضي اللّه عنه)، فكان أميراً على أول سريّة من سرايا الإسلام..
سرايا المسلمين وغزواتهم الأولى
سَريّة حَمْزَة
وخرج حمزة في شهر رمضان من السنة الأولى هجرية (623 م) بثلاثين رجلاً من المهاجرين[*] دون الأنصار، بعدما حدَّد له النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وجهةً يتّبعها نحو شاطىء البحر من ناحية «العيص». وما إنْ أدركوا تلك المحلة حتى فاجأتهم قافلة لقريش جاءت من الشام، وعلى رأسها أبو جهل في ثلاثمائة راكب. وأراد حمزة - على قلّة عدد فرسانه، وكثرة أعدائه - أن يقاتلهم، لولا أن حجز بينه وبينهم مجدي بن عمرو - سيِّد جهينة ـ وكان موادعاً للفريقين، فانصرفوا عن بعضهم من غير قتال. ورجع حمزة فأَخبرَ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بما حدث، فأجازَه لأنه لم يأمره بقتال...
سرية عبيدة بن الحارث
وفي شوال من تلك السنة (623 م) بعث النبيُّ سرية استطلاعية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف في ستين راكباً من المهاجرين أيضاً - دون الأنصار - وانطلقت تلك السرية إلى أرض الحجاز حتى بلغت وادياً يدعى «رابغ»، من جانب الجحفة، فإذا على الماء هناك أبو سفيان بن حرب وهو في مائتين من أصحابه.. وتوافق قائد المسلمين مع إخوته على قتال أولئك المشركين، فكان أولُ البادئين سعد بن أبي وقاص، فرمى العدو بسهم[*]... ولكنَّ أبا سفيان أمر بعدم الرّد، وبعث من جماعته نفراً يعرضون عدم القتال، فوافق المسلمون لأن مهمتهم الاستطلاع؛ ولكن ما إن ابتعدوا قافلين إلى المدينة حتى لحق بهم المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان، وقد فرَّا من المشركين[*]، إذ كانا قد أسلما وكتما إسلامهما، فوجدا في تلك المناسبة فرصة للهروب والالتحاق بالمهاجرين في المدينة.
سرية سعد بن أبي وقاص
وفي شهر ذي القعدة من السنة الأولى الهجرية بعث النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سرية ثالثة بقيادة سعد بن أبي وقاص وفيها عشرون راكباً، إلى محلة تدعى «الخرّار» وهو واد يصب في الجحفة على طريق مكة.
وكان العهد إلى سعد بألاَّ يتجاوز الخرار، بل يتقصَّى أخبار عير قريش التي تمرُّ من هناك. فلما علم سعدٌ أن العير قد مرَّت بالأمس، عاد بسريته إلى المدينة، دون أدنى نتيجة..
وهكذا كانت تلك السرايا الثلاث، تهيئةً للظروف التي ستواجه المسلمين. إلاَّ أنَّ وجهها الإيجابي الآخر كان في إدراك المنافقين للجديّة في عمل المسلمين، كما كانوا يتوقعون، فهذه سرايا «محمدُ» قد بدأت تخرج فعلاً، لترقب تحركات قريش وقوافلها، إلاَّ أنهم آثروا الترقب والحذر، دونما أية مبادأةٍ بشيءٍ ضد هذا التحرك الإسلامي.
غزوة الأبواء[*]
أما وقد رأى النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن تلك السرايا التي بعثها، لم تفِ بأغراض التحرك الجديد، فإنه خرج بستين راكباً من الصحابة على رأس الشهر الثاني عشر من مقدمه المدينة، وهو يريد عيراً لقريش، قيل له إنها تمرُّ بالأبـْواء، فسار حتى بلغ ودّان، وهي قرية جامعة، فالتقاه سيد بني ضمرة بن بكر، وكان - يومئذ - مخْشي بن عمرو الضَّمْري، فعقد معه صُلْحاً على ألاَّ يغزوه ولا يغزوهم، ولا يعينوا عليه عدواً، وإذا دعاهم لنصرٍ أجابوه..
وقد اعتبر رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن هذا الصلح يُعدُّ بذاته نصراً للدعوة، إذ حوَّل أعداءً لها إلى مؤيدين عند الحاجة، ثم رجع إلى المدينة[*] مكتفياً بهذا الفضل من ربه تعالى، فكانت غزوة «الأبواء» أول غزوة غزاها رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
غزوة بواط[*]
وأقام النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شهراً بالمدينة، بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول بعد غزوة الأبواء أو غزوة ودّان[*]، ثم خرج على رأس مائتين من المهاجرين والأنصار فبلغ «بواط» من ناحية رَضْوى يريد قافلة لقريش تناهَى إليه خبرها بقيادة أمية بن خلف الجمحي، وكانت عدَّتها ألفين وخمسمئة بعير يحميها مئة مقاتل من قريش، فلم يدركها، لأن العيون كانت تترصّد حركات المسلمين، مما جعل تلك القافلة تتخذ - هرباً من حادث يفاجئها - طريقاً ملتويةً غير الطرق التي كانت تسلكها القوافل عادة، فنجت بذلك من المواجهة، فرجع (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولم يلقَ كيداً[*].
غزوة العُشَيْرة
وفي جمادى الأولى، خرج النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بعد أن استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، في حوالى مائتين من المسلمين، فنزل «العُشيرة» من بطن ينبُع، ومراده عير لقريش قد تخرج من مكة إلى الشام، بقيادة أبي سفيان بن حرب، ولكنه علم من بني مُدلج أن عير قريش قد عبرت فأقام بها بقية جمادى الاولى وبضع ليالٍ من جمادى الثانية وادَعَ خلالها بني مدلج، فكان (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مطمئناً لهذه الغزوة التي أكسبت صفوف المسلمين حلفاء جدداً، قد عاهدوه على ما عاهده عليه حلفاؤهم بنو ضمرة في غزوة الأبواء.
ويذكر أن النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كنَّى في هذه الغزوة علياً (عليه السلام) «أبا تراب» كما روى ابن إسحاق عن عمار بن ياسر حيث قال: «كنت أنا وعلي ابن أبي طالب رفيقين في غزوة العُشَيرة، فلما نزلها رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأقام بها، رأينا أناساً من بني مُدلج في عينٍ لهم وفي نخلٍ، فجئناهم، ننظر كيف يعملون (وكان ذلك طبعاً بعد عهد الموادعة من النبي معهم). ثم غشينا النوم في صُور من النخل (صغاره) وفي دقعاء من التراب (التراب اللين). فواللّه ما أهبَّنا (أيقظنا) إلا رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو يحرّكنا، وقد تترَّبنا من تلك الدقعاء التي نمنا فيها، فيومئذٍ قال رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعليّ بن أبي طالب: «ما لَكَ يا أبا تراب»!.. لما رأى عليه من التراب. ثم قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ألا أحدِّثكما بأشقى الناس رجُلين؟ قلنا: بلى يا رسول اللّه. قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : أُحَيْمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا عليّ على هذه - ووضع يده على قرنه - حتى يبلَّ منها هذه - وأخذ بلحيته[*] (أي أنه أشار (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيده إلى رأس عليٍّ ولحيته)، وهي ذات الكنية التي كنَّاه بها رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عندما وجده نائماً في المسجد، وقد ترب جنبه، فجعل يحثُّ التراب عن جنبه، ويقول له «قم يا أبا تراب»[*].
غزوة بدر الأولى
ولم يكد رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقيم في المدينة بعد «العشيرة» إلاَّ ليالي قلائل لا تعدو العشرة، حتى أغارَ كُرْز بن جابر الفهري ـ وكان من المتصلين بمكة وبأهلها من قريش ـ على إبل المدينة وأغنامها، واستاقها، وذلك أثناء رعيه في جبل من جبال جهينة بناحية رضوى. فخرج الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في طلبه، بعد أن استعمل على المدينة زيد بن حارثة، وراح يتعقب آثار كُرز حتى بلغ وادياً يقال له «سَفْوان» من ناحية بدر. فتوقف هناك بعدما تبين له أن كرزاً قد فاته، ولم يعد قادراً على اللَّحاق به. وعُرف ذلك الخروج ببدر الأولى.
... إنَّ تلك السرايا والغزوات، وإن لم تقع فيها مواجهات فعْلية، إلاَّ أنها كانت خطواتٍ ميدانيةً، وتهيئةً عملانيةً وجدّية للجيش الذي سيتولى مهمات القتال، وهو آتٍ لا محالة، فإمَّا فرضَهُ عليهم الأعداءُ، وإمَّا المسلمون أنفسهم من أجل الهدف الأعلى الذي يبقى فوق كل هدف وفوق كل حساب، ألا وهو نشر راية الإِسلام خفاقة في أنحاء الجزيرة العربية.. وإذا كانت قريش هي القوة المانعة لتحقيق ذلك الهدف، فإن الرسول الأعظم - وقد أرسى قواعدَ دولته في المدينة على مبدأ الإِسلام، ووفقاً للسياسة الحكيمة التي اعتمدها - كان يرى أن السياسة نفسها يجب تطبيقها أيضاً في مكة المكرمة. ولن تقف في وجهها عنجهيةُ قريش بإذن الله تعالى. وإذا كانت سراياه وغزواته لم تبدأ مناوشة أو قتالاً إلى الآن،، فإن الأمرَ بات يفرض الدخول في مثل هذه الأجواء.. ولأجل ذلك أعدَّ سريَّةً خاصَّة، وأودعَ قائدَها أوامِرَ تختلف عما سبقها من السرايا..
سرية عبد اللّه بن جحش
ولبضعة أيام خلَوْنَ من شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، بعثَ الرسولُ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عبد اللّه بن جحش بن رئاب، في اثني عشر رجلاً من المهاجرين[*]، في مسيرة حدَّد له وجهتها، من غير أن يعيّن له المكان الذي يقصد، إلاَّ أنه دفع إليه بكتاب وأمره ألاَّ ينظر فيه قبل يومين من خروجه، فإذا وقف على ما فيه، أطلع أصحابه عليه، وترك لهم الخيار في ما يفعلون، لأن الأساس ألاَّ يُستكره أحدٌ من المسلمين على القتال!!..
ولمَّا انقضى يومان على الانطلاق، فتح عبد اللّه الكتاب، فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فامضِ حتى تنزل نخلة، بين مكة والطائِف، فترصدَ بها قريشاً وتعلمَ لنا من أخبارهم»[*].. وأعلَمَ قائدُ السرية أصحابَه بالأمر، وبأنه لا يستكره أحداً منهم، فمن شاء رجع، ومن شاء تابع متابعةً قد تحمل الشهادة. فساروا متوكلين على الله، وإلى المصير الذي يشاءُ اللَّهُ تعالى لهم.. وقد تخلف عنهم في الطريق اثنان: سعد بن أبي وقَّاص الزهري وعتبة بن غزوان، وهما يبحثان عن بعير لهما قد تاهَ وبَعُدَ، فكان نصيبهما الوقوع في الأسر بين أيدي رجال من قريش، صادف التقاؤهم بهما.. وكان قائدُ السرية ومن بقي معه قد تابعوا سيرهم حتى نزلوا في بطن نخلة يترصَّدون قريشاً، وبقوا هناك إلى آخر شهر رجب، فإذا بعير لقريش قد أقبلت من الطائف، وكانت تحمل كعادتها من ذلك البلد الزبيب والأَدَمَ (الجلد) وعليها عمرو بن الحضْرمي، فأناخت بالقرب منهم؛ وقد روي أن عكاشة بن مِحْصَن الأسديّ (من رجال السرية الاسلامية) قد أشرف لرجال العير، وهو حليق الرأس، فقالوا: عمَّارٌ، لا بأس عليكم منهم..
وتشاور عبد اللّه وأصحابه الستة في ما يَصْنَعون!.. فهذا كتاب النبيِّ لا يشير إلى القتال، لاسيما وأنهم في الشهر الحرام والقتال فيه حرام فقال بعضهم لبعض:
ـ «والله لئن تركتم القومَ هذه الليلة ليدخُلُنَّ الحرم فليمتَنِعُنّ منكم به، وإن قتلتموهم لتقتُلُنَّهم في الشهر الحرام!»[*] وتردَّد رجال السرية وهابوا الإقدام على هذه الخطوة. وأخيراً استقرَّ بهم الرأي على مهاجمة القافلة، واغتنام أحمالها، ردّاً على قريش في استيلائها على أموال المسلمين جميعها في مكة.
وكانت، بالفعل، خطوةً جريئةً، عندما أقدم ذلك النفر القليل المسلم على قتال المشركين، وغايته ردّ بعض حق مسلوب، أو الشهادة، فأخذ واقد بن عبد الله التميمي سهماً ورمى به قائد العير، عمرو بن الحضرمي فقتله. ثم هجموا على رجال القافلة يقاتلونهم، ففرُّوا من أمامهم منهزمين، بعدما وقع رجلان من قريش بالأسر، وبذلك أمكن لتلك السرية الصغيرة أن تستولي على القافلة، ثم تقتاد الأسيرين، وتقفل راجعة إلى المدينة، لتلقى رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على غير الرضى الذي كانوا يأملونه، وذلك عندما قال لهم: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»[*]. وأوقف العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من الأموال شيئاً.
وأُسقط في يد عبد اللّه بن جحش وأصحابه، وظنوا أنهم قد هلكوا، وزادهم ألماً وندامة غضبُ رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وتعنيف بعض إخوانهم المسلمين على ما صنعوا!.
ولقد أيقن أصحاب تلك السرية أنهم أخطأوا!.. ولكنَّ الحرقة التي كانت تتأجج في صدورهم من صلافة قريش هي التي أبت عليهم إلاَّ أن يقاتلوا تلك القافلة المحمّلة بالطيبات، بينما قد لا يجدون - هم ـ ما يسدُّون به الرمق، إلاَّ أن ذلك قد حدث في الشهر الحرام، وهم لا يعلمون ما تأثيره عليهم كمسلمين، بل وما هو موقف الإِسلام من عمل من هذا القبيل؟..
إنَّ القتال في الشهر الحرام أمرٌ ذو أهمية خاصة ولكنَّ دوافعه لدى أولئك النفر من المسلمين متعددة وسببها الأول والأخير ظلم قريش العاتي، ولعلَّ الشعور بهذا الظلم هو الذي غلب عليهم، فأقدموا على قتال الظالمين.. تلك كانت الحالة، ولم يكن على الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاَّ أن ينتظر حكم الله - سبحانه - في هذا الشأن، لأنه - جلّت عظمته - يرقب مسيرة دينه خطوةً بخطوة، وتتجلَّى مشيئتهُ بأدق الأمور لتبيان الحق من الباطل، فكيف والموقف حاسمٌ وتترتب عليه آثار هامّة جداً، ولا سيما في ما يعود إلى القتال في الأشهر الحُرُم؟!...
ورأت قريش فرصةً كبيرة لإثارة الدِّعاية ضد «محمد» والتشهير به وبالإِسلام، فراحت تنادي في كل مكان: إن «محمَّداً» وأصحابه استحلّوا الشهر الحرام، وسفكوا الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا الرجال.
وتساءل الناس: أيكون في الشهر الحرام قتال؟
تساؤل فيه استنكار!.. إذِ اعتبر الناسُ أنَّ «محمّداً» هو الذي قام به - وإن كان على يد عبد اللّه بن جحش - فكيف يفعل ذلك، وهو الذي «يزعم» بأنه يسير في طاعة الله ربه، ويدعو إلى دين قيّمٍ ويهدي إلى صراط مستقيم؟!...
وكان من الطبيعي أن يستغلَّ اليهود - مثل قريشٍ بل وأكثر - هذا الظرف، ويدخلوا مع المسلمين في مجادلات طويلة، ونقاشات حامية بعدما رأوا في ذلك فرصة سانحة للكيد بالمسلمين الذين لا يجدون ما يدفعون به عن أنفسهم، لأنَّ العمل خطير، ويشكِّل قاعدة ثابتة في أنحاء شبه الجزيرة كلِّها. فقد كانت قبائلها، تتوقف عن القتال في الأشهر الحُرُم، مهما كانت العداوات شديدة، ومهما كانت الحروب قاتلة.. وراح اليهود يشنِّعون على فعل عبد اللّه بن جحش، ويشهرون به. حتى بات الوضع شديداً على المسلمين، إلاَّ أنهم باتوا ينتظرون الحُكمَ من الله سبحانه وتعالى. فإن كانت فيه مؤاخذة على فعل السريّة نال قائدها عقابه، فالأمر متروك إلى الله يحكم ما يشاء.. ونزل الوحي على النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالآيات المباركات: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} [البَقَرَة: 217].
وسرِّي عن المسلمين، لأنَّ التنزيل المبين ينقض عرفاً من أعراف الجاهلية الذي كان يقوم على تحريم القتال في الأشهر الحرم، ويسوّغ، في الوقت نفسه، النسيءَ - تبديل الشهر الحرام بغيره - وفقاً للمصالح والأهواء.. وعلى كل حال، ولئن كانت مثل تلك الأعراف تحرِّم القتال في أشهر معيَّنة من السنة، إلاّ أنها لا تسوِّغ لقريشٍ الصدَّ عن المسجد الحرام، ولا إخراج أهله منه بدون حق، كما أنها لا تخوِّل لطغاتها أن يفتنوا المسلمين عن دينهم، فذلك أكبر عند الله - عزَّ وجلَّ - من القتال في الشهر الحرام.. ثُم إنَّه ليس في هذا القتال شيء ضد إنسانية الإِنسان، بل الهدفُ منه حماية المسلمين من كيد قريش، وحماية الدعوة الإِسلامية من أعدائها، سواء أكان هؤلاء الأعداء قريشاً أم غيرَ قريش، ويجدرُ بالمسلمين أن يقاتلوهم أينما ثقِفوهم وفي أي وقت استطاعوا، فلم يعد من حسابٍ لأشهر حُرم أو غيرِ حُرم من أجل الجهاد في سبيل الله... وهكذا تنزَّلتِ الآيات الكريمة لتضع الأمور في نصابها. وبارك النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عملَ عبد اللّه بن جحش، وأخذ العير والأسيرين.. أمَّا من ناحية قريش فقد أرسلت تطلب الأسيرين من رجالها، فكان ردُّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا نفديكموهما حتى يُقدم علينا صاحبانا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنّا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحِبَيْكم[*].
ونزلت قريش على أمر رسول اللّه، وجرت المفاداة بالأسرى من الطرفين، الاَّ أن الحكمَ بنَ كَيْسان آثَرَ الإسلام والبقاء في المدينة، بينما رجع عثمان بن عبد الله إلى مكة ليلحق ببني قومه من المشركين.
هذه قصةُ سرية عبد اللّه بن جحش، وما عقبها من نتائج وآثارٍ هامة.. وقد كانت في واقعها حدثاً عادياً لا يزيد على قتال شارك فيه بضعةُ رجال من المسلمين وجماعة من المشركين.. ولكنَّ وقوعه في الشهر الحرام جعل له أصداءً بعيدةَ المدى، وكان لا بد من حُكم تشريعي يفصل في هذا العمل ويبين الحق من الباطل.. فالقتال في رجب الحرام كان يعتبر من الكبائر عند العرب، وقد اتخذت قريش منه سلعة لإثارة الرأي العام ضد المسلمين، ولكنَّ العدل الإلهي هو الذي يفصل بين الحلال والحرام، فكان لا بدَّ من مساءلة المشركين: أتستكبرون القتال في الشهر الحرام؟.. نعم إنه لكبير، ولكنْ أكبرُ منه أن تُبيحوا أيها المشركون لأنفسكم قتالَ المؤمنين، وصدّهم عن سبيل الله، وعن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه.. أجل إنَّ ذلك أكبرُ عند الله...وأيهما أكبر: الفتنة أم القتل؟
أوَ ليست الفتنة أن يقاتل المشركون والكفارُ أهل الإيمان حتى يردوّهم عن دينهم إن استطاعوا؟ أفلا تكون الفتنة - وهذه حالها - أكبرَ من القتل في الشهر الحرام أو في غيره؟ إذن فلا جناح على من يقاتلُ كلَّ مَن يعمل بالباطل، ويسعى بالظلم لفتنة الناس عن دينهم، ولصدِّهم عن سبيل الله تعالى، في أي وقت أمكنه فيه قتالَ الفتنِ وأهلِها..
هذه هي النتيجة التي يجب أن تعيها قريش وغير قريش، وهذا هو المنهج الذي بدأ المسلمون يسيرون عليه..
لقد كانت سريةُ عبد اللّه بن جحش مفترقَ طرق في السياسة الجديدة التي يجب على المسلمين انتهاجها، وفي طريقة التعامل مع أعداء الدعوة الإِسلامية. فالإِسلام لا يأخذ بأحكام الجاهلية، ولا بأحكام أهل الأرض كلها، بل يستقي الحكم من الله سبحانه وتعالى، لأنه الحكم الحق... وفي هذه الحادثة فإن حكمَ الله قد نسخَ تحريم القتال في أشهر معينة من السنة، طِبْقاً لما دلَّت عليه الآية 217 من سورة البقرة، في القرآن الكريم التي أباحت القتال في الشهر الحرام، أو في غيره من الشهور، إذا كان القضاء على فتنة قاتلة جماعياً، بوسيلة قتالٍ محدودٍ مادياً....
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢