نبذة عن حياة الكاتب
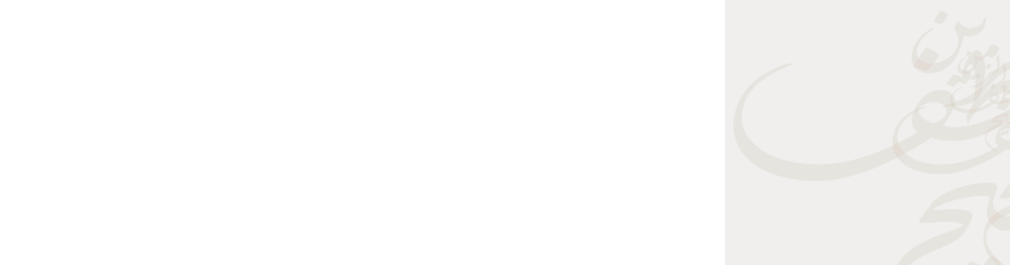
X
الروح والنفس والجسد
لعلّ أجلّ الغايات وأسماها في خلق الإنسان
استخلافه في الأرض
الروح والنفس والجسد
لعلَّ أجلَّ الغايات وأسماها في خلق الإنسان استخلافه في الأرض، إذ الخلافة تعني في المفهوم اللغوي عند الإنسان النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه.. وهي في المفهوم القرآني لتشريف المستخلَف،كما بيَّن سبحانه وتعالى عند ذكر خلق الإنسان، وذلك بما شَرَّفه به من خلافة كما فعل مع أوليائه في الأرض لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ} [فاطر: 39]، وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ} [الأنعام: 165].
ولكي تأتي هذه الخلافة مستوفية حقَّها وحقيقتها، فيما يلزم لقيامها، ووجودها، فقد جاء خلْق الإنسان في أحسن تقويم، وفي أحسن الصور، وذلك لقوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4] وقوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [التغابن: 3].
نعم إن الصورة هي ما يُنتقش به الأعيانُ ويتميَّز بها غيرها، وذلك نوعان: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة من الإنسان، بل وكثير من الحيوان، مثل صورة الإنسان والحيوان والنبات والجماد الخارجية المتمثلة في جسده؛ والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختُصَّ بها الإنسان من العقل أو التمييز أو الرؤية، وكصور المعاني التي خُصَّ بها شيء بشيء.. والنوعان عناهما سبحانه وتعالى بقوله: {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}، وتصويره له في أحسن الصور؛ إذ ليس في المخلوقات كالإنسان في قوامه وتكامل أعضائه، مضافاً إلى ما منحه الله تعالى من العقل المفكِّر والقدرة المدبِّرة.
وقد أُريد بالصورة، ما خُصَّ الإنسانُ به من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة، التي فضَّله الله بها على كثير من خلقه، وفي هذا الخلق تشريف لآدم، ورفعة لمقامه وسمو خلْقه، ولأولياء الله من بني آدَمَ بعد أبيهم (عليه وعليهم السلام).
وما دامَ للإنسان هذا الخلْق، وما دامت تلك وظيفته فلا يكون مستغرباً أن يكون الإنسان سيد المخلوقات على هذه الأرض، وأن ينشىء الحضارات؛ ويقيم المَدَنيات، وأن ينطلق في آفاق الفكر حتى يتخطّى حدود أرضه التي عليها يعيش، فيستكشف العوالم البعيدة بمنظاره، ويحطّ بقدميه على أقرب الكواكب السيارة إليه.
ولكن رغم ذلك كله، هل عرف الإنسان حقيقة تكوينه؟ أي حقيقة هذا الخلق الذي هو عليه بكل ما فيه من عناصر مادية وغير مادية؟ أم أنه أدرك بعض هذه العناصر ولم يدرك بعضها الآخر، لأنه مهما بلغ من سعة العلم والمعرفة، فإنَّ علمه سوف يبقى قليلاً بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى؟
ما من شك بأنَّ «الإنسان هو ذلك المجهول» كما عبّر عنه ألكسيس كاريل Alexis carrel أي الكائن الذي لم يستطع أحد أن يحدِّده تحديداً نهائيًّا وأخيراً، من حيث تكوينه غير الفيزيولوجي، ومن حيث قدراته وإمكاناته على الإبداع والاكتشاف والعطاء أكثر فأكثر.. فكلما تقدمت بنا العلوم، كلما أذهلتنا هذه القدرة للإنسان فيما وصل إليه، وتزداد بنا الحيرة عندما نعلم أنَّ ما نراه اليوم من إنجازات الإنسان ليس إلاَّ شيئاً يسيراً مما ينتظره في المستقبل، على حسب ما تعد به النظريات العلمية في مختلف فروع العلوم، وفي شتى المجالات.. وطبعاً كل ذلك بفعل الإنسان «الذي اختلفت النظرة إليه والذي أيّاً كان حكمه على نفسه، أو حكم الناس عليه، وأياً كان موضعه من النجاح أو الفشل، ومن نضج الفكر أو سلامة الفطرة، فإن العلم عاجز في النهاية عجزاً تامًّا عن أن يتفهم فهماً صحيحاً كيف جاء إلى هذا الوجود، وكيف نما، وكيف تطور، ومن أين جاء، وإلى أين يعود، وكيف يفكر، وكيف يتخبط في فكره وفي شعوره إلى آخر الحدود، ومع ذلك تحنو الطبيعة عليه حنوّاً عجيباً حيناً، وتقسو عليه أحياناً ـــــــ كيما يصبح في نهاية المطاف هو السيد الآمر فيها لا العبد المسود».
ويعبّر ابن خلدون، عن هذا العجز العلمي، بالعجز العقلي ليس عن إدراك كُنه الإنسان لذاته وحسب، بل وعن إدراك كنه الأشياء بذاتها فيقول: «ولا تثقنَّ بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات، وأسبابها، والوقوف على تفصيل الوجود كله، وسفهْ رأيَك في ذلك. واعلم أن الوجود عند كل مدرك، في بادىء رأيه، منحصر في مداركه لا يعدوها. والأمر في نفسه بخلاف ذلك، والحق وراءه». ولكنَّ ابن خلدون يعود ويستدرك، لئلا يفهم من كلامه اتهام العقل بالعجز المطلق، فيقول: «وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، وأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما رواء طوره، فإن ذلك طمع في محال، ومثال ذلك: مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به الجبال. وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق، ولكن العقل قد يقف عنده، ولا يتعدَّى طوره، حتى يكون له أن يحيط بالله وصفاته، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه».
ولعلَّ هذا العجز كان هو السبب في اختلاف النظرة إلى الإنسان من حيث تكوينه الذي خلقه الله تعالى عليه. فاعتبر عند البعض مادة مثل سائر المواد، بينما اعتبره البعض الآخر عبارة عن روح لا صلة لها بالمادة مطلقاً، في حين استقرَّت غالبية الأفكار على اعتبار الإنسان كائناً من روح وجسد، ولكنها في الإجمال، خلطت ما بين «الروح» و«النفس» ولم تميِّز بينهما؛ فتارة يعبّرون عن الروح بالنفس، وتارة يعبّرون عن النفس بالروح، في حين أن لكلٍّ منهما ماهيته الخاصة، ومميزاته التي تجعله مستقلاً عن الآخر، وإن كانا يتشاركان في مَدِّنَا بالحياة كما يظهر لنا ذلك في كل شيء في وجودنا: بقيامنا وقعودنا، ومأكلنا ومشربنا، وسيرنا ونومنا، وتفكيرنا وشعورنا، وما إلى ذلك من مظاهر هذا الوجود وحركته.
فأما مدارس المادية فقد صورت الإنسان كأنه «قطعة من جماد لا تختلف عن غيرها إلاَّ بوظائفها العضوية؛ أو أنه كائن يحبو على قدمين لا يختلف كثيراً عن تلك التي تحبو على أربع، بحيث إن جمهرة من العلماء الماديين ـــــــ الذين يؤمنون بقوة المادة كل إيمان ـــــــ أنكروا الروح واعتبروها وهماً مطلقاً وخرافة باطلة، معتقدين أن وجود الإنسان يتحقق في هذه الحياة، أي في دنيا الأرض، فإن مات أو فنيَ كانت حتمية زواله إلى الأبد، ولذلك أنكروا حقيقة الحياة بعد الموت».. وعلى هذا فقد اخترع أصحاب المذهب المادي تفسيراً لنشأة الحياة الأولى من المادة الميتة؛ فزعم بعضهم أن أصل الحياة كُرَيَّة بسيطة ذات خلية واحدة، وزعم آخرون أن الحياة عبارة عن كتل زلالية حية صغيرة هي أدنى من ذات الخلية الواحدة وأبسط، ولذلك سمَّوها (مونيرا Monèra) أي الوحدة البسيطة في اليونانية، وزعموا أنها تتكون من الجماد (بالتولُّد الذاتي). ومن أشهر القائلين بذلك العالم البيولوجي الألماني «أرنست هِيجل» الذي يقول:
»إن الكون مؤلف من المادة، والمادة مؤلفة من الذرات. ومن هذه المادة ظهر كل ما في الكون من أحياء وغير أحياء. وحركة العالم هي حركة تطور دائم، يبتدئ من أبسط الذرات، وينتهي إلى أرقى الكائنات. فهذه الكائنات كلها، حيُّها وجمادها، تتألف من عناصر واحدة، لا فرق في ذلك بين حيٍّ وغير حيّ، لأن عناصر المواد العضوية موجودة بذاتها في المواد غير العضوية، وأن بالإمكان تحضير بعض مركَّبات عضوية بطريقة صناعية». وعلى هذا الأساس يقول هيجل: إن أبسط أنواع اليوان نشأت من مادة (غير حيَّة) بطريق (التولُّد الذاتي).
هذه خلاصة نظرة الماديين التي تُرجع الإنسان، مثل سائر الكائنات، في نشأته إلى مادة غير حيَّة عن طريق التولد الذاتي، والتي تنفي بالتالي قيمته الروحية والنفسية، بما ينتقص كثيراً من قدره، ومن حقيقة تكوينه..
ثم جاء العلم الروحي ليبرهن بأن الإنسان روح لا جسد، كما يعبِّر عن ذلك الدكتور (رؤوف عبيد) الذي يقول: «وجوهر علم الإنسان الآن هو علم الروح بعدما تبين أن «الإنسان روح لا جسد» وأن للعلم الروحي دوره الفعال في تقدير قيمة الإنسان واحترام مشاعره البناءة وعقله الباحث عن الحقيقة أبداً. ولا أعتقد أن ثمة فلسفة أخرى يمكنها أن تزعم أنها تحترم قيمة الإنسان وتقدرها حق قدرها مثلما يفعل بحث علمي بقوم على أن الإنسان روح لا جسد، وأنه خالد لا يموت، وأنه يسير سيراً حثيثاً في طريق التقدم والكمال، بالغة ما بلغت ضآلة قدره بحسب مظهره الخارجي الآن ـــــــ وفي ماضيه السحيق ـــــــ من ناحيتي الخلق أو المعرفة».
وبمثل هذا الاعتقاد كان عنوان مؤلَّف الدكتور عبيد (الإنسان روح لا جسد) الذي فسَّر اختياره له بقوله: «قد يعترض البعض ابتداء على هذا العنوان قائلاً: لماذا لا تقول: إن الإنسان روح وجسد معاً فتكون أقرب إلى الواقع؟ لكن الواقع هو أن الإنسان في العلم الروحي، روحٌ فقط، ذلك أن الجسد الأرضي إن هو إلا رداء بال يحبس الروح، ويذلها إلى حين.. فهل يصح أن نعرِّف شخصاً بالرداء الذي يرتديه ولو كان من أفخر نوع، فما بالك إذا كان من تراب؟! وهل يصح أن نعرف درَّة ثمينة بصندوق من طين يحتويها إلى حين»؟!.
ويتابع قائلاً: «لذا كان من الشائع في هذا العلم (أي العلم الروحي) القول: إن الإنسان روح لها جسد، لا جسد له روح. وأقرب من ذلك إلى الصواب في رأيي أن أقول: إن الإنسان ـــــــ وهو يمثل الذات الواعية الناطقة فينا ـــــــ محض روح. أما الجسد المادي فهو المظهر الخارجي الذي به نتعارف إلى حين، فلا صلة له بتعريف هذه الذات، ولا هو ملك لها، بل هو ملك لأمه الأرض التي منها جاء وإليها يعود».
وبين أصحاب العلوم المادية الذين ينكرون حقيقة الروح، وأصحاب العلم الروحي الذين يرون الإنسان روحاً لا جسداً، أجمع الباحثون الآخرون على أن الإنسان هو «روح وجسد» أو «نفس وجسد»، لأنهم لم يميِّزوا ـــــــ كما قلنا ـــــــ في كثير من الأحيان بين (الروح) و(النفس) واعتبروهما شيئاً واحداً.. فهذا الفيلسوف والشاعر العربي أبو العلاء المعري يقدم برهانه على إمكان بعث الأجسام بقدرة الذي خلقها وصورها وأنشأها أول مرّة، فيقول:
إذا ما أعظُمــــــــــي كانـــــت هباءً فإنَّ اللَّه لا يُعْييهِ جَمْعـــــــــــــي
وقوله:
ومتـــــــــى شــــــــاءَ الذي صوَّرنــــــــــــــا أشعَرَ الموتَ نشوراً فانتشـــــــر
وقوله:
وأعجَبُ ما تخشاه دعوة هاتفٍ أتيتم فهبُّوا يا نيام إلى الحشر
أما في الروح فيقول:
أمـــــــــا الجسومُ فللتراب مآلهـــــــــا وعيت بـــــــالأرواح أنَّــــى تذهــــــبُ
وقوله:
روحٌ إذا اتَّصلت بجسم لــــــــــــم يـــــــــــــــــزل هو وهْيَ في مرض الفناء المكمدِ
إن كنتِ من ريحٍ فيا ريــــــح اسكنــــــــــي أو كنت من نارٍ فيا نار اخمدي
وقوله:
إن يصحب الروح عقلي بعد مظعنها للموت عني فأجدر أن ترى عجبا
وإن مضت في الهواء الرحب هالــكـة هلاك جسمي في تربي فواشجبــــــــا
فهذه كلها أقوال لا نفهم منها سوى أن الروح شيء غير الجسد، وأنها تتصل به لتقاسي ألم الحبس، ويقاسي هو ألم الحياة؛ وأنَّ أبا العلاء لا يدري ما هي الروح، وهل لها وجود مستقل عن الجسد أم هي وظيفة الجسد في حياته وتفنى بموته، ولكنَّ كرهه الحياةَ، يجره إلى افتراض كونها ريحاً أو ناراً، كما زعموا، يتمنَّى سكونها أو خمودها.
أما الشيخ الفيلسوف ابن سينا، الذي يُعدّ إمام فلاسفة المسلمين في دراسة النفس فإنه يؤكد حقيقة الإنسان من نفس وجسد فيقول في رسالته (معرفة النفس الناطقة وأحوالها): «اعلم أن الجوهر الذي هو الإنسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن بل هو باق لبقاء خالقه تعالى. وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن، لأنه محرك البدن ومديره ومتصرِّف فيه. والبدن منفصل عنه تابع له. فإذن لم يضر مفارقته عن الأبدان وجوده».
ويقول أيضاً: «ثم إن الإنسان في نومه يرى الأشياء ويسمعها، بل ويدرك الغيب في المنامات الصادقة بحيث لا يتيسر له في اليقظة. فهذا برهان قاطع على أن جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدن، بل هو يضعف بمقارنة البدن ويقوي بتعطُّله. فإذا مات البدن وخرب تخلَّص جوهر النفس عن جنس البدن».
ويقول أيضاً: «لو كانت القوة الناطقة قوة جسمانية لكان لا يوجد أحد من الناس (على مرِّ السنين) إلا وقد أخذت قوته تنقص، ولكن الأمر في أكثر الناس على خلاف هذا. بل العادة جرت في الأكثر أنهم يستفيدون ذكاء في القوة العاقلة وزيادة بعيدة. فإذن ليس قوام القوة المنطقية بالجسم والآلة، وإذن هي جوهر قائم بذاته».
أما ابن القيم الجوزية الذي توفي سنة 751 هجرية فإنه يميِّز تمييزاً واضحاً ما بين الروح والنفس والجسد، وذلك عندما يتساءل عن ماهية النفس وهل هي الروح فيقول: «ما حقيقة النفس، وهل هي جزء من أجزاء البدن، أو عرضٌ من أعراضه، أو جسم مساكِنٌ له مودَعٌ فيه، أو جوهر مجرَّد؟ وهل هي الروح، أو غيرها؟ وهل الأمَّارة واللوَّامة والمطمئنة نفس واحدة لها هذه الصفات أم ثلاث أنفس؟».
»وبعد أن يستعرض شتى الآراء في هذه الأمور ينتهي إلى ترجيح الرأي القائل: إن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهي جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح»..
ويأتي ابن مسكويه فيفضِّل نظرية المعرفة الحسيَّة والعقلية، معتبراً أن النفس هي مكمن المعرفة العقلية.. ولذلك فإنه بعد أن يتكلم عن النفس، ويبرهن على أنها ليست بجسم ولا عَرَض، يقول: «إن الجسم قواه لا تعرف العلوم إلا من الحواس. أما النفس فإنها، وإن كانت تأخذ كثيراً من مبادىء العلوم عن الحواس، فلها من نفسها مبادىء أُخر، وأفعال لا تأخذها عن الحواس البتة، وهي المبادىء الشريفة العالية، التي تبنى عليها القياسات الصحيحة. وذلك: أنها إذا حكمت أنه ليس بين طرفي النقيض واسطة، فإنها لم تأخذ هذا الحكم بشيء آخر، لأنه (أوليّ) ولو أخذته من شيء آخر لم يكن أوليًّا.
فالحواس تدرك المحسوسات فقط. وأما النفس فإنها تدرك أسباب الاتِّفاقات، وأسباب الاختلافات، التي في المحسوسات، وهي معقولاتها التي لا تستعين عليها بشيء من الجسم، ولا آثار الجسم.
وكذلك إذا حكمت على الحس، أنه صدقٌ أو كذب، فلست تأخذ الحكم من الحس، لأن الحسّ لا يضادّ نفسه، ونحن نجد النفس العاقلة فينا، تستدرك شيئاً كثيراً من أخطاء الحواس.. ثم إن النفس إذا علمت أنها أدركت معقولاتها، فليست تعلم هذا العلم من علم آخر، فإنها لو علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم نصاً إلى علم آخر، وهذا يمرُّ بلا نهاية.
فإذن علمُها «بأنها علمتْ»، هو من ذاتها وجوهرها، أعني «العقل» وليست تحتاج في إدراكها ذاتها إلى شيء آخر غير ذاتها».
وأما عن مصير النفس بعد الموت، فإن ابن مسكويه يقول: «الموت ليس بشيء أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها، وهي الأعضاء التي يسمى مجموعها بدناً، كما يترك الصانع استعمال الآلة. وإن النفس جوهر غير جسماني وليست عرضاً، وإنها غير قابلة للفساد، وإن ذلك الجوهر مفارق جوهر البدن، مباين له كل المباينة بذاته وخواصه وأفعاله وآثاره. فإذا فارق البدن على الشريطة التي شرطها من الخير بقيَ البقاءَ الذي يخصُّه، ونُفيَ من كدر الطبيعة، وسعد السعادة التامة، ولا سبيل إلى فنائه أو عدمه».
هذه آراء طائفة من العلماء والشعراء والفلاسفة المسلمين الذين تحدثوا عن الروح والنفس والجسد؛ وهم في جلّهم لم يبحثوا موضوع «الروح» بوصفه مستقلاً عن موضوع «النفس»، لأن من تحدث عن النفس، لم يتحدث عن الروح، والعكس بالعكس، ومن تحدث عنهما كان حديثه نوعاً من الخلط بينهما حتى ليظهر أنه يعتبرهما شيئاً واحداً.. ولعلَّ البعض من أولئك العلماء استطاع أن يميّز بوضوح بين الروح والنفس، كما هو الحال عند ابن القيم الجوزية، الذي تساءل عن حقيقة النفس وهل هي الروح، ثم عادَ وفرَّق بينهما معتبراً أن الروح جسم نوراني علوي يسري في أعضاء الجسد ويمنحه الحسَّ والحركة الإرادية، بينما النفس هي مصدر المعرفة العقلية، وعلمُها ينبع من ذاتها ولا تحتاج إلى إدراك هذه الذات لأي شيء آخر غيرها.
ومن علماء الصوفية الذين تحدثوا عن النفس والروح الشيخ الأكبر (كما يسمونه) محيي الدين بن عربي، فقد كتب في (تحفة السفَرة إلى حضرة البررَة) يقول: «قال الله تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} [الشمس: 7]. الوصول إلى المقامات لا يحصل إلاّ بتزكية النفس، وتنقية القلب، وتخلية الروح، والمقصود بالذات تخلية الروح ولا تحصل تخلية الروح إلّا بتصفية القلب، ولا تحصل تصفية القلب إلّا بتزكية النفس، فالتزكية من مقدمة الواجب. وذهب بعض المشايخ إلى أن تزكية النفس تحصل بتصفية القلب، لأنه من اشتغل بتزكية النفس لا تحصل تزكيتها بالتمام والكمال في مدة طويلة، ومن اشتغل بتصفية القلب تحصل تزكيتها في مدة قليلة».
ويتابع في فصل تزكية النفس قائلاً: «قال الله تعالى: {إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [يوسف: 53] وقال: «أعدى عدوك نفسك بين جنبيك» فيفسّر ذلك بقوله:
»النفس قوة شهوية تتعلق بجميع البدن على السوية، وهي منشأ الصفات الذميمة، وتزكيتها طهارتها عن جميع الصفات الذميمة واتصافها بالصفات الحميدة. اعلم أن الغضب والشهوة صفتان ذاتيتان للنفس وجميع الأوصاف تتولد ـــــــ منها ـــــــ وتزكيتها باعتدالها. لأن الهوى إذا تجاوز يتولد منه الشره والحرص، والأمل، والخسة والدناءة والبخل والجبن والغيبة والبهتان. وإذا تجاوز الغضب يتولد التكبر والعداوة والحدة والعجب والفخر والخيلاء والكذب، وإذا اعتدلت صفة الهوى يظهر في النفس الحياء والجود والسخاء والمحبة والشفقة والتعظيم والصبر، وإن اعتدلت صفة الغضب فيظهر فيها التواضع والحلم والمروءة والقناعة والشجاعة والبذل والإيثار، وإن تعادلتا يظهر فيها التزكية، فالتزكية تحصل باعتدال هاتين الصفتين».
وفي فصل في تحلية الروح يقول ابن عربي: (قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85] وقال النبيُّ (ص): «الأرواح جنود مجنَّدة». فالروح جوهر لطيف نوراني غني عن التغذية، وللروح ستة أحوال. حالة العدم قال الله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ} الآية [الدهر: 1]. وحالة الوجود في عالم الأرواح قال النبيُّ (ص): «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي سنة». وحالة التعلق. وحالة النفخ {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي} [الحجر: 29] وحالة المفارقة {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185]. وحالة الإعادة {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً} [الكهف: 47].
أما فائدة حالة العدم فلحصول المعرفة بخلقة نفسه وبقدم صانعه. وأما فائدة حالة الوجود في عالم الأرواح فلمعرفة الله بالصفة الذاتية من القادرية والعالمية والحياتية والوجودية والسمعية والبصرية والمتكلمية والمريدية. وأما فائدة تعلقه بالجسد فلاكتسابِ كمال المعرفة في عالم الغيب والشهادة من الجزئيات والكليات.
وأما فائدة نفخ الروح في الجسد فلتحصيل المعرفة بالصفات الفعلية من الرازقية والثوابية والغفارية والرحمانية والرحيمية والمنعمية والمحسنية والوهابية، وكثوب الرزق في مقام العندية الذي قال الله تعالى فيه: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ} [القمر: 55].
وأما فائدة الإعادة فلحصول التنعمات الأخروية التي قال عنها الله في حديث قدسي: «وأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».
ثم يضيف ابن عربي قائلاً: «إذا اشتغلت النفس بالعصيان واتِّباع الشيطان يظهر في الروح نقطة سوداء، فمتى يزداد عصيان النفس يزداد سواد الروح حتى إذا اسودت النفس بالكلية فانسدَّت أبواب لطف الله تعالى لأن له وجهين: وجه إلى عالم الغيب، ووجه إلى عالم الشهادة فكل فيض يصل إليه من حضرة الله تعالى يؤدي إلى القلب، والقلب يقسم إلى سائر الأعضاء فيظهر في الأعضاء فعل مناسب لذلك الفيض. فانجلاء سواده يحصل بالإيمان كما قال علي (رض): إن الإيمان يبدو لمظة (اللمظة هي النكتة من البياض) في القلب فمتى ازداد الإيمان ازدادت اللمظة، فإذا ازداد الإيمان انجلى حتى ينجلي بالكلية وزالت حجبه، فإذا انجلى بالكلية فيظهر فيه مشاهدات الروحانية والغيبية».
وأما السهروردي فقد اعتبر بأن الجسم ليس سوى سجن حبست فيه الروح، فما دام فيه يبقى مرتهناً، ولكن إلى زمن، فإن أدركه الموت، انفلت من عقاله، ولذا فإن الموت ليس غير نقلةٍ من دنيا الأرض. وفي ذلك يقول:
أنا عصفـــور وهــــذا قفصي طرت عنه وبقي مرتهنـــــا
وأنا في السور هذا جسدي كان ثوبي وقميصي زمنا
وأنـا الآن أنـــــاجــي مــــــــــــــــــــلأً وأرى اللَّه جـــــهاراً عــلنـــــــــا
لا تظنوا الموت موتــاً إنـــــــــــه ليس إلّا نقلـــة مـن ههنــــا
هذا وبعد هؤلاء العلماء والشعراء والفلاسفة المسلمين، بعدة قرون قام عدد من فلاسفة الغرب الذين بحثوا في العلاقة ما بين الكيان المادي والكيان الروحي للإنسان، وكانت لهم لذلك نظريات متباينة، استقت من آراء الفلاسفة المسلمين الشيء الكثير، قبل أن تستوي نظريات فلسفية مستقلة.
ومن فلاسفة الغرب هؤلاء نجد أن (توماس أكويناس) اتهم ابن رشد بالإلحاد والإنكار لأنه أنكر وجود الشخصية الفردية الإنسانية، وقال بفنائها مع الجسد.. فبينما نراه من ناحية يعرِّف الشخصية بأنها مزيج من الجسم والنفس، ويعتبر، في بعض أقواله، الجسم والنفس حقيقة واحدة موحدة، نراه من ناحية أخرى يقول: إن النفس حقيقة غير جسمية، وإنها شيء روحي يبعثه الله فينا. وفي حين يقول: إن هذه القوة الروحية الموجودة فينا تبقى بعد موت الجسد، يقول حيناً آخر: إن النفس ليست ذات شخصية، فهي لا تقدر أن تحس أو تريد أو تفكر بل هي طيف لا قوة له، ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغير الجسم، وإنها لا تكوِّن شخصية منفردة خالدة إلاَّ إذا عادت للاتحاد مع الجسم.. أي أنه يُقرُّ ببعث الإنسان بعد موته نفساً وجسداً..
أما الفيلسوف (ديكارت) فقد اعتمد في نظريته على تفسير الحياة، وكيفية اتصال العقل الروحاني بالجسد المادي على القول: بأن أصل الحياة هو الدم. وبعد أن يعلل مفهوم الدورة الدموية، يعود ويردُّ الاتصال ما بين العقل الروحاني والجسد المادي إلى وسيط هو الغُدَّة الصنوبرية. ولكنه في النهاية ـــــــ وعندما يجد نفسه عاجزاً عن إثبات ماهية الروح، وكيف تتصل بمادة الجسم ـــــــ يعود فيؤكد قائلاً: إننا لا نستطيع أن نعرف كيف يتم هذا الاتصال بين الروح والمادة، فلم يبقَ لنا إلاَّ أن نعلله بأنه آية من آيات الخلاق الحكيم القادر، تماماً كما قال القرآن الكريم بذلك، أي بأن الروح سرٌّ إلهي ولا يعلم الإنسان من أمرها شيئاً.
وكذلك (مالبرانش) أيضاً فقد كان مثَلُه مثلَ (ديكارت) ولم يوفَّق إلى تفسير الاتصال بين العقل الروحاني والجسد المادي ولذلك انتهى إلى القول بأن: «الأفكار الإلهية هي وحدها التي تتمتع بالوجود، ونحن نرى هذه الأفكار بالله، فليس هنالك أفكار فطرية مركوزة في عقولنا، ولا أفكار صنعيَّة تكوِّنها عقولنا، ولا إدراكات حسيَّة تتلقاها هذه العقول من الأشياء.. ولكن الموجود هو الأفكار الإلهية، ونحن لا ندرك العالم الخارجي بذاته، بل ندركه بالله الذي عنده علم الكُلّ».
وهذه هي نظرية الرؤية بالله، أو المشاهدة.. وبمقتضاها لا يرى (مالبرانش) لزوماً لإقامة البرهان على وجود الله، طالما أننا نراه ونرى به كل شيء ـــــــ حسب ادِّعائه ـــــــ، فلسنا نعرفه من طريق الأفكار الفطرية والأوليات البديهية الموصلة إلى إثبات وجوده بالبرهان، بل نحن نعرفه بالرؤية، والبداهة المباشرة، فلا حاجة إذن لإثبات وجوده بالأدلة والبراهين..
وهذا ما قال به بعض الصوفية، وهو كلام لا يتوافق مع البحث الفلسفي الذي يقوم على النظر العقلي الخالص أو البرهان العقلي القاطع؛ فالقاعدة أن الإيمان بالله لا يمكن أن يكون عن طريق (المشاهدة) الصوفية أو غير الصوفية إذ جلَّ عن أن تراه العيون، بل يكون بالعقل الذي وهبنا الله تعالى إيَّاه، وبالبراهين العقلية التي أعطانا ـــــــ سبحانه ـــــــ القوة والقدرة على تركيب مقدماتها واستخراج نتائجها. ولولا ذلك لما دلَّنا في كُتبه، وعلى لسان رُسله، على هذه البراهين، وقد قال تعالى في القرآن الحكيم: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: 53]. وقال تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [يوسف: 105]. ثم قال تعالى: {بَلْ هُوَ أَيَّاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت: 49].
على أنَّ هذا الإيمان الصوفي الذي اعتنقه (مالبرانش) قد أدَّى به لأن ينكر الاتصال ما بين الروح والجسد إنكاراً تامّاً، ويسلِّم بجبريَّة مطلقة هي التي تسّير الإنسان في كل شيء، وذلك عندما يقول: «إن الفعل لله وحده، فلا الأرواح تعمل ولا الأجسام تعمل؛ ولكن هذا النظام الذي نشاهده ونظن أنه اتصال بين الروح والجسم، ما هو إلاَّ تناسق بين ميول الأرواح وحركات الأجسام. وكل ذلك من فعل الله وحده، فهو يخلق الميول والرغبات وحركات الأجسام، وهو يحرك الأجسام وفق ميول الأرواح».
ولعل (مالبرانش) لم يميِّز بين ماهية الروح وماهية النفس، فاعتبر أن الميول والرغبات تكون للروح، في حين أنها في الحقيقة تنبع من النفس، وليس للروح أي شأن بها، وهذا ما جعله يقول بميول الأرواح ورغباتها بحيث تتحرك الأجسام وفق هذه الميول.
وعلى النهج نفسه يأتي (لايبنز) ليفسِّر الاتصال بين الروح والجسم بنظريته المعروفة (بالتناسق السابق التوطيد) فيقول بأن العالم بما فيه من أجسام وأرواح يتكون من (ذرَّات روحيَّة) وكل ذرَّة مستقلة عن الأخرى، وتسير بمقتضى قوانين لها بدون أن تتصل بسواها. وكل ذرَّة فيها جانب مادي (منفعل) وجانب روحاني (فاعل). وهذه الذرَّات تسير بإرادة الله وتعمل بقدرته، بصورة يظهر منها أنها تتصل ببعضها، وهي في الحقيقة لا تتصل، ولكن قدرة الله تجعل كل ذرَّة تسير سيراً يوافق سير الذرَّات الأخرى.. أي أنه يقول أيضاً بجبريَّة تخضع لها هذه الذرَّات التي تتألف منها الأجسام والأرواح.
ويتابع (لايبنز) شرح نظريته فيقول: وهكذا شأن العقل والجسد؛ فللعقل نظامه، وللجسد نظامه، ولكنهما بإرادة الله يسيران مستقلَّين بتوافق وتناسق (موطَّد سابقاً) بحيث يستحيل أن يتخلف عمل أحدهما عن عمل الآخر. فكل خلجة عقلية تقابلها حركة في الجسد كأنَّ بينهما علاقةً واتصالاً، وهما في الحقيقة غير متصلَين ولا متفاعلَين، ولكن هذا الذي يظهر لنا من التوافق هو أثر (التناسق السابق التوطيد) الذي وضَعَهُ الله فيهما.
وعلى خلاف ما ذهب إليه كل من (مالبرانش) و(لايبنز) في اعتقادهما بالجبريَّة التامة في حياة الإنسان، يقول الفيلسوف (كانت) بحرية الإرادة التي يتوصل إليها عن طريق ما يسميه (القانون الأخلاقي أو الضمير)، كما يستدل بحرية وإرادة على يوم الحساب وعلى خلود النفوس في حياة أخرى.
وهكذا فإن (كانْت) عندما انتهى به الأمر إلى الإقرار بصعوبة البرهنة على وجود الله بالعقل النظري، عاد واخترع عقلاً آخر أسماه (العقل العملي La raison pratique) ويعني به الضمير، وبواسطة هذا العقل العملي استدلَّ على وجود الله تعالى.. وما يهمنا هنا أنه بواسطة هذا العقل الذي يقول عنه (كانتْ): إنه قانوننا الأخلاقي الذي فطرت عليه نفوسنا كما فطرت عقولنا على قوانينها المنظمة لها، يستدل على خلود النفوس فيقول: «إن قانوننا الأخلاقي يستلزم أن نكون أحراراً في اختيارنا للخير والشر (على عكس القائلين بالجبريَّة). ونحن نرى في هذا العالم أنه من النادر أن يُكافأ فاعل الخير على عمله بل نرى أن فعل الخير كثيراً ما يكون مجلبة للشقاء والبلاء، فلا بدّ إذن أن تكون لنا حياة أخرى ننال بها جزاء ما فعلناه من الخير، وهذه الحياة الأخرى توجب أن تكون النفوس خالدة لتنال جزاءها. ولا مجال لإنكار خلود النفوس لأنه يؤدي إلى إنكار القانون الأخلاقي الذي قلنا إنه حقيقة لا ريب فيها».
هذا هو الدليل الأخلاقي الذي اختاره (كانتْ) ليس فقط لإثبات خلود النفوس، بل وبه استدلّ على يوم الحساب، وعلى وجود الديَّان الحكم العادل، القادر، الخالد، الذي يعود إليه وحده إقرار العدالة في اليوم الآخر.
وهكذا يتبيّن من ملخص بعض الآراء والنظريات عند بعض العلماء والفلاسفة من المسلمين وبعض العلماء والفلاسفة من المسيحيين وغيرهم، أن تلك الآراء لم تتفق على ماهية العلاقة ما بين الروح والجسد (أو ما بين النفس والجسد) وكيف يتم الاتصال ما بين الكيان الروحي والكيان المادي للإنسان، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن عجز الإنسان عن فهم حقيقة الروح، كما يقرِّرُه ويؤكده الدِّين الإسلامي.
وإذا كنا في غير معرض مناقشة تلك الآراء والنظريات، للوقوف على وجه الصواب والخطأ في كل منها، فإنَّ ما نريد التأكيد عليه، هو أن الإنسان في تكوينه ثلاثة عناصر: الروح والنفس والجسد.. وقد قدَّرها الخالق العظيم وأوجدها في هذا الإنسان حتى يستوي في أحسن تقويم، وأحسن صورة، وإنَّ باجتماعها فيه تتحدَّد الحياة التي يحياها بكل مظاهرها العقلية والفكرية والحسية.
وسوف نبيِّن لك أيها القارىء الكريم كيف أنَّ كلاًّ من الروح والنفس، هو عنصرٌ مختلف عن الآخر، وله وظيفة خاصة يقوم بها، بدون أي تشابك أو اختلاط بينهما.
فأما الروح فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم لتدلَّ بلفظها الواحد على معانٍ متعددة:
فقد أريد بها أولاً جبرائيل (ع) بقوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ} [الشعراء: 193] وأريد بها ثانياً الشريعة الإسلامية، بقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا} [الشورى: 52]، ثم أريد بها قدرة الله ومشيئته، بقوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي} [الحجر: 29]. وأريد بها أيضاً إدراك الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى، أي كون الأشياء مخلوقة لخالق خلقها وأنها تعبِّر عن صلة المخلوق بالخالق، وأن الروح هي إدراك هذه الصلة. ولذلك كان الروح سرَّ الحياة، ومحرضك الجسد، وباعث الحياة، وموقظ الشعور بها، وبدون هذا الروح تنعدم الحياة.
إلاَّ أن ماهية الروح، ومعرفة حقيقتها، وكيف تبعث الحياة في الجسد ـــــــ أو كما عبَّر عنه الفلاسفة كيف يتم اتِّصال العقل الروحاني بالجسم المادي ـــــــ فهذه أمور أُغلقت على الإنسان، ولم تستطع العقول النيرِّة إدراكها، ولذلك بقيت اللغز الكبير الذي عجز الإنسان عن حلِّه، فصرَف الله تعالى الناس عن التفكير بها لتحديدها بقوله العظيم لرسوله الكريم: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ ـــــــ يا محمد ـــــــ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً } [الإسراء: 85].
وفي تقديرنا أن الإنسان لن يكون قادراً على حلَّ هذا اللغز، مهما تقدمت به العلوم، ومهما بلغ عنده النضوج الفكري، لأنَّ القرآن الكريم يؤكد عجز الإنسان، وقصر علمه عن إدراك حقيقة الروح لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ}..
ولكن إذا كنا عاجزين عن إدراك حقيقة ماهية الروح، فإنَّ بعض أئمة المسلمين قد أشار إلى عمل الروح التي يكون بها التنفُّس والتحرك، ولذلك فهي التي تبعث الحياة والحركة في الإنسان، ويمكن تحديدها وتعريفها بهذا القدَر البسيط ـــــــ والعظيم في آنٍ واحدٍ ـــــــ وهي أنها: من أمرِ الله الذي يتيح للمخلوق الحيِّ هذه الحياة وتلك الحركة.
أما النفس فقد ورد ذكرها أيضاً في كثير من آيات القرآن الكريم كما في قوله تعالى: {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ} [يوسف: 53]، وقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] وقوله تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} [الشمس: 7 ـــــــ 10]. أي: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا} باختيار الأعمال الصالحة وجعلها متَّصفةً بالصفات الحسنة، يعني عرَّفها معنى الطاعة وبعثَها في الطريق المستقيم.. {وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} بتمرُّغ صاحبها في حمأة الأعمال السيئة والصفات الرديئة. وعلى هذا تتَّصف النفس إما بالطاعة وإما بالمعصية، لأنها هي التي تجتني الخير أو تجتلب الشرَّ. وقد كان رسول الله (ص) إذا قرأ هذه الآية يقول: «اللَّهم آتِ نفْسِي تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّها وَمَوْلاَهَا، وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا».
وبمقتضى هذه الآيات وغيرها يتبيَّن أن النفس هي التي تُسأل يوم القيامة عمَّا عملت من خيرٍ أو شرٍّ.. ولذلك كانت للنفس ملكةُ المعرفة عند الإنسان، لقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا} وكان بها العقل والتمييز، والاطمئنان والقلق، والراحة والنصب، والجوع والعطش، والشبع والارتواء، والحسد والطمع، والقناعة والرضى.. إلى ما هنالك من مُدْرَكات وأحاسيس وغرائز.
ومن هنا كانت الروح والنفس شيئين متغايرين. ولذلك فإن الآيات القرآنية عندما تتحدث عن الروح أو عن النفس فإنها تميِّز بين خصائص كلٍّ منهما بوضوح، كما يستدلُّ على ذلك من الآيات التي ذكرنا بعضها ولم نذكر أكثرها.
ويفرِّق ابن عباس (رض) بين الروح والنفس، فيقول: «يوجد في بني آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها التنفُّس والتحرك. فإذا نام الإنسان قبض الله سبحانَهُ نفسَهُ ولم يقبض روحه. وإذا مات قبضَ الله سبحانه نفسَهُ وروحَهُ». وهذا ما نُقل أيضاً عن الإمام الباقر (ع) إذ قال: «ما مِن إنسانٍ ينام إلاَّ وتعرُج نفسُه إلى سماءِ الله وتبقى روحه في بدنه، ويصير بينهما شعاع كشعاع الشمس، فإذا أذِن الله بقبض الرُّوح أجابتِ النفسُ، وإذا أذِنَ الله ببقاء الروح رجعت النفس».
وما قاله ابن عباس والإمام الباقر (رض) جاء تفسيراً لقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الزمر: 42].
وقال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأنعام: 60].
ومن منطلق هذا التوضيح القرآني كان الرسول الأعظم عندما يستلقي على جَنْبِهِ الأيمن يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله: «اللهم إنْ أمسكتَ نفسي فاغفر لها، وإن أرسلْتَها فاحفظها بما تحفظُ به عبادكَ الصالحين».
هذا عن الروح، والنفس... أما عن الجسد، فهو وإن كان عند الفلاسفة عنصراً ماديًّا، يعيق الروح (أو النفس)، بحيث يكون سجناً لها في هذه الحياة ـــــــ كما يدَّعون ـــــــ إلاَّ أنه في الحقيقة من أعظم آيات خلق الله إبداعاً وتكويناً، وأروعها في اتقان صنعه وفي اتِّزانه وحُسن تقويمه، وتناسب حركاته وتوافق غاياته.. لا نريد أن نستفيض في تعداد مزايا هذا الجسد، وكيف يؤدي كلُّ عضو أو جهازٍ فيه ـــــــ من أدق الشُّعيرات إلى أكبر الأعضاء، أو أعظم الأجهزة ـــــــ دَوره بدقة متناهية وتنظيم عجيب، بل نكتفي بالإشارة فقط إلى أنه كلما تقدَّمت علوم الطب المختلفة، كلما اكتشفت عوالم في تركيب الإنسان تقف العقول قاصرةً حائرة أمامها وأمام هذا التنظيم والإحكام والعديل والترابط والتجاوب والتعاون والتناسق بين ملايين الملايين من الذرات والخلايا والأعصاب التي تمنحنا الحياة، بحيث لا يسعها إلاَّ أن تسبِّح الخالق العظيم الذي خلق كل شيء فقدَّرة تقديراً {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل: 88] {مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]. وهكذا وبمقتضى كتاب الله المبين نعرف أنَّ الله تعالى قد خلق جسد الإنسان ـــــــ بداية ـــــــ من ترابٍ، ثم نفخ فيه من روحه فحلَّت به الحياة، ثم وهبه ملكة العلم والمعرفة حتى تكون لديه قابلية الربط للمعلومات فيتكوّن عنده الإدراك والتمييز، فتقم على أساس هذا الإدراك والتمييز حريةُ الاختيار عند الإنسان.
وإذا كانت بداية الخلق من تراب، فإن الله تعالى أوجَدَ نظاماً خاصًّا يتتابع الخلق من جرائه وعلى أساسه، فخلق الزوجَين الذكر والأنثى، اللَّذين باجتماعهما يكون هذا الخَلق.. وفي ذلك يقول الله تعالى في محكم آياته البينات: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً} [المؤمنون: 12 ـــــــ 14]. وقوله سبحانه وتعالى: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ} [السجدة: 7 ـــــــ 9]. وبقوله سبحانه أيضاً: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى} [النجم: 45] ويقول عزَّ وجلَّ: {وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [الذاريات: 49] ويقول تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً} [فاطر: 11] ويقول عزَّ من قائل: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: 6].. {يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ} [الزمر: 6].
فيكون الإنسان في حقيقته كائناً حيًّا من جسد وروح ومن تداخل الروح بالجسد تتكون النفس، ثم يتكون الإنسان بعدُ، من جسدٍ وروحٍ ونفس.
على أن بعض الأديان قد نظرت إلى أن الكون فيه المحسوس والمغيَّب، وأن الإنسان فيه السموُّ الروحي والنزعة الجسدية، وأن الحياة فيها الناحية المادية والناحية الروحية. وأن المحسوس يتعارض مع المغيَّب، وأن السمو الروحي لا يلتقي مع النزعة الجسدية. وأن المادة منفصلة عن الروح. ولذلك فهاتان الناحيتان (الروحية والمادية) منفصلتان عندها، لأن التعارض بينهما أساسي في طبيعتهما ولا يمكن امتزاجهما، وأن كل ترجيح لإحداهما في الميزان فيه تخفيض لوزن الأخرى. ولهذا كان على مريد الآخرة أن يرجح الناحية الروحية.
من هنا قامت في المسيحية سلطتان: السلطة الروحية والسلطة الزمنية «ما لقيصر لقيصر وما لله لله».. ولما كان رجال السلطة الروحية هم رجال الدين وكهنته، فقد عملوا كي تكون السلطة الزمنية بأيديهم حتى يرجحوا عليها السلطة الروحية في الحياة، الأمر الذي أدَّى إلى نشوء النزاع بين رجال الحكم الذين بيدهم السلطة الزمنية، ورجال الكنيسة الذين بيدهم السلطة الروحية، فأدَّى الصراع الذي نشب يومئذٍ إلى استقلال رجال الكنيسة بالسلطة الروحية، وإبعادهم عن السلطة الزمنية، فكان أن نشأت نظرية فصل الدين عن الحياة لأنه كهنوتي، وكان هذا الفصل من الأسس التي قام عليها المبدأ الرأسمالي الذي يعتبر أساس الحضارة الغربية الحديثة.
على أن هذا المبدأ يعتبر أيضاً قوام القيادة الفكرية التي يحملها الاستعمار الغربي للعالم، ويدعو إليها، ويجعلها عماد ثقافته، ويزعزع بالتالي على أساسها عقيدة المسلمين بالإسلام، لأنه يقيس الإسلام بالمسيحية على طريقة القياس الشمولي.. ولذلك نقول: إن كل من يحمل هذه الدعوة: «فصل الدين عن الحياة» أو فصل الدين عن الدولة أو عن السياسة، إنما هو موجَّهٌ بوجيه قيادة فكرية أجنبية، أو هو جاهل بالإسلام، لأن الدِّين الإسلامي يرى أن الأشياء التي يدركها الحس هي أشياء مادية. والناحية الروحية مخلوقةٌ ومرصودةٌ للخالق عزَّ وجل، ولذلك كانت الروح تُتيح إدراك الإنسان لصلته بالله تعالى.. وعلى ذلك فإنه لا توجد ناحية روحية منفصلة عن الناحية المادية، ولا توجد في الإنسان أشواق وميول روحية، ونزعات ورغبات جسدية، بل في الإنسان حاجات عضوية، وغرائز لا بدّ من إشباعها؛ ومن هذه الغرائز غريزة التديُّن التي هي منتهى التقديس للخالق، ومنتهى الاحتياج إلى الخالق المدبِّر، وهي ناشئة عن العجز الطبيعي في تكوين الحياة.
وإنَّ إشباع هذه الغرائز لا يسمَّى ناحية روحية ولا ناحية مادية، وإنما هو إشباع فقط.. إلاَّ أن هذه الحاجات العضوية والغرائز إذا أشبعت بنظام مفروضٍ من عند الله تعالى، بناء على إدراك الصلة بالله كانت مسيَّرة بالروح التي هي هنا «الشريعة الإسلامية» أي أوامر الله ونواهيه.. وإذا أشبعت بدون نظام، أو بنظام من عند غير الله، كان إشباعاً مادياً بحتاً، وهذا هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الشقاء..
وبناءً على هذا تكون الروحانيات في الإسلام، هي الأعمال المادية المتعلقة بأوامر الله تعالى ونواهيه، أما الأعمال التي لا تكون مسيَّرة بأوامره ونواهيه فإنها تقف عند حدود الماديات، وهي لا تتعلق أبداً بالأوامر والنواهي الربَّانية.. وعلى هذا الأساس تُبنى جميع أفكار الإنسان وتصرفاته، بحيث لا يعود هاجسه كيف يتم الاتصال ما بين الروح والجسد؟ لأنَّ هذا الاتصال موجود وثابت، وهو بفعل الله سبحانه وتعالى الذي يهب فيه الحياة للإنسان، ولكل كائن حي، وفق القانون الإلهي الذي حدَّد كيفية الخلق وجعلها خاضعة لمشيئته وحده، دون أن يكون للإنسان أية علاقة بهذه الكيفية، التي فرضت عليه، والتي لا يستطيع، مهما بلغ سعةً في العلم أن يغيرِّها أو يعدِّلها.. وهذه حقيقة راهنة لا مجال لإنكارها، إذ لم يقدر الإنسان، ولن يقدر أن يغيرِّ شيئاً في قانون الخلق الإلهي، لأنه أعجز من أن يخلق بعوضة، فكيف يقدر أن يغيِّر الناموس الأزلي الثابت الذي أوجده الله تعالى دلالةً على قدرته وعظمته؟ وذلك قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 73 ـــــــ 74].
وأما الاختلافات في الرأي التي ظهرت حول البعث، وهل يكون بالروح أم بالنفس؟ وهل إنَّ انحلال الجسد في التراب هو انحلال نهائي ودائم؟ فهذه الاختلافات كانت عديدة ومتشعبة سواء عند الفلاسفة المسلمين أم عند فلاسفة الغرب، بحيث لا نجد نظرية كاملة تعيد الأمر كلَّه إلى الله سبحانه، فهو قادر على أن يعيد الإنسانَ كما أنشأه أول مرة، وليس ذلك يعجز الله سبحانه في شيء، ما دام يقول للشيء: كن فيكون.
ومن تلك الآراء حول كيفية البعث القول ببقاء النفس بعد فناء الجسم وتناسخها من بدن إلى بدن على نحو يصبح بينها وبين الثاني من العلاقة مثل ما كان بينها وبين الأول؛ ويدَّعي القائلون بالتناسخ أن النفس المطيعة لله تعالى تنتقل بعد موت الجسم إلى أبدان السعداء وأهل الجاه والثراء، وإذا كانت عاصية شقية تنتقل إلى أبدان الحيوانات، وإذا كانت ممعنة في الشقاء اختير لها بدن أخسّ وأكثر تعباً وعناء.
وجاء عن صدر المتألِّهين في كتابه المبدأ والمعاد من الأسفار «إن النفس الإنسانية إذا انتقلت إلى بدن إنسان سُمِّي ذلك نَسْخاً، وإذا انتقلت إلى بدن حيوان كان مَسْخاً، وإذا انتقلت إلى النبات فهو الفَسْخ، وإلى الجماد فهو الرَّسْخ».. والقائلون بالتناسخ بجميع أشكاله، لا يلتزمون، على ما يبدو، بالبعث والحساب، بل تنتقل النفس عندهم من كائن إلى كائن، وتظل تنتقل إلى ما لا نهاية له!!!.
ومثل فكرة التناسخ شاعت في كثير من الأوساط فكرة التقمُّص، وهي تقوم على أن الجسد أو الجسم البشري ثوب للنفس أو الروح، تتقمصه الروح عند الولادة وتنتقل منه بالموت فوراً إلى جسد مولود دون تمييز جنسي أو عنصري أو مكاني، وتظل بعد كل موت تخلع الثوب البالي وتلبس ثوباً جديداً إلى نهاية الأجيال..
وإذا كان التناسخ يقوم على إنكار البعث والحساب، فإنَّ التقمُّص على خلاف ذلك يأخذ بنظرية الثواب والعقاب على قاعدة العدل الإلهي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في الدهر الطويل لا في مدى حياة واحدة بخيرها وشرها وقصرها وطولها، بحيث يمنحها الدهر الطويل فرص الاكتساب والتطور والامتحان والتبدل كي تحاسب حساباً عادلاً على مجموع ما كسبت؛ وفي أدوار انتقالها من جسد إلى جسد تكتسب من المعرفة والعلوم الروحية ما ينقلها من درجة إلى درجة في مراقي التكامل حتى تبلغ درجة الإمامة إذا كانت مؤهَّلة، وهي منتهى الرفعة وأعلى مراتب الدِّين في آخر أدوار التقمُّص المقصود منه بلوغ الكمال الإنساني.
وعقيدتا التناسخ والتقمُّص تعود إلى قدماء المصريين وتعاليم فيثاغورس وبوذا وغيرهم ممَّن طوى همَّه على كشف الغطاء عن أسرار الروح ومصيرها. وقد علل أفلاطون نمو المعرفة في الأجيال البشرية وطاقة استيعابها للحقائق، فافترض مرور الأرواح في حياة سابقة.
وإذا كان الصوفية قد تمسَّحوا بالروح، فإنَّ عقائدهم في الحلول والاتحاد، ووحدة الوجود، إنما هي إنكار للبعث والحساب في حقيقتهما..
فالحلول يعني أن الله سبحانه يحل في الإنسان وفي غيره من أجزاء هذا الكون، وذلك عندما يتجرد هذا الإنسان من كل أثر من آثاره، وصفة من صفاته فيتلاشى الجسم تقريباً ويذهب ولا يبقى فيه إلاَّ الحالُّ، وبذلك يكتسب المخلوق صفة الخالق ويصبح (هو هو)، كما يعبر أبو يزيد البسطامي عن نفسه.
والاتِّحاد يعني أن يصبح الاثنان شيئاً واحداً بعد اتِّحادهما ببعضهما.. وهو يحصل عندما تزول من الإنسان كل صفة من صفات الجسم ويزول عنه كل ما هو غير روحاني، وعندما يتم ذلك يتحد الإنسان بالله ويصبح كل ما لله من الصفات والإمكانيَّات لهذا الإنسان، بنحوٍ تكون الكلمتان: «الله والإنسان» تعبيراً عن معنى واحد.. وقد جاء في جمهرة الأولياء للسيد محمود أبي الغيطى أن الجنيد (وهو من شيوخ الصوفية الكبار) قد خطا الخطوات الفاصلة فانتقل من حالة الفناء والبقاء اللَّتين يمر بهما الصوفي إلى فكرة الاتحاد. وذهب إلى أن المتصوف قد يصل إلى درجة تتحد فيها الروح اتحاداً تامّاً بالخالق وذلك بالتجرد عن حول العبد وقدرته إلى حول الله وقدرته فيقوى بذلك وتتلاشى شخصيته البشرية في الذات الإلهية عن طريق عدم رؤية العبد لنفسه.
أما وحدة الوجود فيبدو من آراء الفلاسفة والمتكلمين وغلاة الصوفية أن المراد منها هو أن الموجود وواجب الوجود شيء واحد، فلا واجب بمعنى كونه علَّةً لغيره، وآخر ممكن ناقص يستمد وجوده من الغير، وإنما الموجود واحد هو واجب الوجود الأزلي والظاهر والباطن، والله سبحانه هو عين الموجودات، فكل شيء هو الله والاختلاف في الموجودات اختلاف في الصور والصفات وليست الموجودات إلاَّ صوراً للموجود الواحد.
هذه تعاريف سريعة للحلول، والاتحاد، ووحدة الوجود، وهي الأفكار التي بنى عليها الصوفية معتقداتهم التي سوف تكون مدار بحوث لاحقة في هذا الكتاب ـــــــ إن شاء الله ـــــــ وقد أشرنا إليها هنا لتعلقها ببحث الروح والنفس والجسد، وما يؤول إليه الإنسان حسب معتقداتهم تلك، بحيث يرتفع إلى مرتبة الألوهية بعد أن يتخلى عن صفاته البشرية.
على أنه مهما كان الحال، فإن الحلول، أو الاتحاد، أو وحدة الوجود، بالإضافة إلى التناسخ والتقمُّص، أفكارٌ جميعها نوع من الأوهام والافتراضات التي لا تقوم لا على أساس علمي ثابت، ولا على قواعد دينية معروفة. وقد ظهرت هذه الأفكار أولَ ما ظهرت بين المعتقدات الصينية والهندية، ومنها انتقلت إلى الزرادشتية والمانوية، وأخذها فيما بعد غلاة الصوفية كالبسطامي والشبلي والحلاج والجنيد وابن عربي والجيلاني وغيرهم، في جملة ما أخذوه، وحاولوا إدخاله على تعاليم الإسلام.. وسواء كان ذلك منهم عن حسن نية، أو عن سوء نية فقد حكم عليهم المسلمون وقالوا: إنها نوع من البدع والخرافات لتضليل الناس وتشويه العقيدة الإسلامية.
أما فيما يتعلق بالإسلام، فقد وردت الآيات في القرآن المجيد صريحة ودالَّة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وعلى بعث الإنسان، بحيث يكون هذا البعث كاملاً: بالروح والنفس والجسد.. فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 36 ـــــــ 40].
وأما عن بعث الإنسان، فقد قال تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة: 3 ـــــــ 4] وقال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس: 78 ـــــــ 83].
ففي هذه الآيات بيِّنات واضحة صادقة على إحياء الموتى يوم القيامة، وعلى بعث الأجسام، لأنَّ مَن خلقَها وأنشأها أول مرة من العدم قادرٌ على أن يعيد خلْقها وإنشاءها مرة أخرى، فيجمع العظام وهي رميم، ويسوِّي بنانَ الإنسان من جديد، حتى يكون الحساب، وحتى تكون الجوارح كلها شاهدة على الإنسان فيما كسبت نفسُهُ في دنيا الأرض.. وفي ذلك يقول الله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النور: 24]. وقوله تعالى: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يس: 65].
إذن فلا مجال لإنكار البعث الذي يكون فيه إحياء الموتى، وإعادة خلْقهم كما كانوا حتى يكون الحساب، ويكون الثواب والعقاب.. وأما من ينكر ذلك، ويدَّعي خلوداً للنفوس أو للأرواح قبل يوم الحساب الموعود، فقد أنكر غيرهم من قبل {وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} [الأنعام: 29] وكان إنكار الكافرين أشدَّ، إذ قالوا: {هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} [ق: 2 ـــــــ 3] ولكنَّ الله القادر كان حكيماً في الردّ على أولئك جميعاً بقوله تعالى: {أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} [ق: 15].
هذه حقيقة الإنسان في حياته على دنيا الأرض، حيث يتوجب عليه القيام وفق أوامر الله ونواهيه، فتكون أعماله المادية والروحية في هذا السبيل، لا خلافَهُ، وإلاَّ فقد عصى خلْقَهُ وخالقَهُ. وأما إحياؤه بعد موته، وحقيقة بعثه، فلا مجال للبحث فيها، طالما أنَّ القرآن الكريم يقررها في كثير من آياته البيِّنات، ويعطينا الأدلَّة والبراهين على البعث والنشور وعلى الحساب والجزاء.. أفلا يتفكَّرون ويعقلون؟..
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢