نبذة عن حياة الكاتب
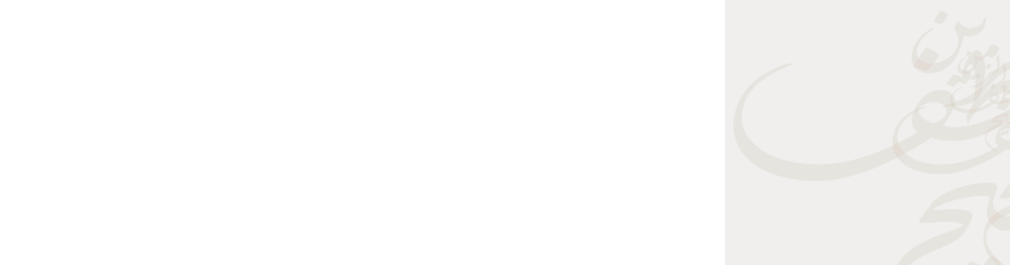
X
الهاربون من المسؤوليات في الحياة
من هو الهارب من الحياة؟
هل رأيت سعيداً في حياته الشخصية أو العائلية، أو ناجحاً في أعماله، أو مرموقاً بين أترابه، أو من هو سليم الصحة والعقل ويحاول أن يهرب من واقعه الجميل فيكون هارباً من الحياة؟
الهاربون من المسؤوليات في الحياة
من هو الهارب من الحياة؟
هل رأيت سعيداً في حياته الشخصية أو العائلية، أو ناجحاً في أعماله، أو مرموقاً بين أترابه، أو من هو سليم الصحة والعقل، ويحاول أن يهرب من واقعه الجميل، فيكون هارباً من الحياة؟
لا!.. إنَّ أيًّا من هؤلاء، وغيرهم من الذين وجدوا سبيلاً يشدهم إلى الحياة، لا يمكن أن يفكروا في الهروب منها، لأنَّ هذا الهروب معناه عدم مواجهة مشاكلها وصعابها، أو عدم قدرة الإنسان وصبره على تحمّل ما تفرزه المشاكل والصعاب من آلام ومتاعب، مما يجعله يستسلم إلى نوعٍ من القهر النفسي، أو خيبة الأمل، أو الذل الوجداني، وهذا ما يدفعه للبحث عن أسلوب جديد في الحياة، يتوهم فيه وجود الراحة التي ينشد، والملاذ الذي إليه يأوي.. ويختلف هذا الأسلوب عند الأفراد باختلاف نزعاهم وميولهم، فقد يكون في الاندفاع وراء الملاذِّ والشهوات، وقد يكون في الانفراد والعزلة، أو في التقشف والجوع والسهر.. إلى غير ذلك من الأساليب التي تخرج عن مسار الحياة الطبيعي..
على أنه غابَ عن هؤلاء الهاربين من الحياة، أن لجوءهم إلى أي نوع من أنواع الهروب هذا، سوف يؤدي حتماً إلى إفساد الغرائز وإهلاكها، لا سيما وأنَّ الإلحاح في تجويع البدن، وإماتة الإحساس الجنسي ـــــــ وهما مصدر الطاقات الظاهرة والباطنة في حياة الإنسان ـــــــ قد ينتهي بالإنسان إلى أن يصبح فريسةً للوساوس، والخيالات الفاسدة والخواطر السوداء، كما قد يغدو متبرماً بالحياة، ساخطاً على كل شيء فيها، ساعياً لما يقرّب إليه الخلاص منها، وذلك بعد أن تصبح الحياة عنده بلا غاية وبلا مطلب، ممَّا يدفعه إلى القيام بأي عمل أرعن، بما فيه الانتحار الذي هو أفظع ما يصل إليه الإنسان في وجوده.. والعجيب في أمر الإنسان، أنه متى فقد الغاية من الحياة، أو بمعنى آخر إذا لم يعد لديه هدف معين يسعى إلى تحقيقه، فإنَّ بين أفراده مَن لا يتوانى عن رفض الحياة، حتى ولو كانت كل سبأ الراحة المادية متوفرة له.
وهذا ما نجده عند كثيرين في الغرب، ممن تأمنت لهم كل سُبُل الرفاهية والدعة، إذ يقدمون على الانتحار، لأن الدوافع المعنوية ماتت عندهم، ولم يعد هنالك ما يشدُّهم إلى الحياة.
إذن فالحياة محك اختبار عظيم للإنسان، فإما أن ينجح في هذا الاختبار، فيواجه الحياة بكل حُلْوها ومُرِّها، وإما أن يسقط في هذا الاختبار عندما يفقد القدرة على المواجهة، ثم تكون النتيجة الهروب من هذه الحياة إما بالقضاء عليها، أو باعتماد نهج جديد لا يتوافق مع المفهوم السليم عن الحياة وما تتطلَّبه من كفاح ومثابرة، ومعاناة وجلد، وكثيراً ما نجد عند هؤلاء اللامبالاة في اللباس وحب تحقير النفس والجسد، وهذا ما عرف عند الناس خطأ بالزهد، أو بصورة أوضح ما نشهده اليوم في الحركات التي قامت في الغرب، وانتشرت منه إلى سائر أقطار الأرض، حيث ظهرت بأشكال مختلفة مثل الإدمان على الرقص والغناء، أو تلك الأنواع من الفنون المختلفة، والتي نجد أصحابها يلهثون وراء المتعة الجسدية، أو ينغمسون في المسكرات والمخدرات للهروب من واقع الحياة، وما إلى ذلك من أساليب التهافت على الانفلات من القيم والمبادىء السامية، التي تشكل محور الحياة المستقيمة، ومدار الوجود الحقيقي..!
ففي الغرب اليوم موجات فكرية غريبة، لا تقل بشاعة عن تلك التي سادت العصور الوسطى.. ففي حين أن تلك العصور اشتهرت بالإقطاع والعبودية، وتحكُّم الأسياد برقاب العباد، مما أهدر كرامة الإنسان وقضى على وجوده المادي والمعنوي، نجد اليوم، في عصرنا هذا، تلك الموجات الفكرية الجديدة التي لا تقل شأناً في الحط من كرامة الإنسان، وابتعاده عن قيمته الإنسانية، حتى بات أصحابها عبيداً لانفعالاتهم النفسية، وكأنهم عادوا لقاعدة الاستعباد، ولكنه الاستعباد النابع من ذواتهم، والذي اختاروه بملء حريتهم وإرادتهم.. والسبب في انتشار هذه الظاهرات الجديدة إنما يعود إلى الحرب العالمية الثانية، وما خلّفته من مآسٍ وويلات، وما أدت إليه من خراب ودمار..
لقد انتهت تلك الحرب فعلاً، وسكت أزيز الطائرات، وخرست أصوات القنابل المدوية، ولكن ماذا وجد الناس من حولهم، وخاصة الشبان منهم؟!.
لقد وجدوا الدور خراباً، والاقتصاد منهاراً، وحيث ذهبوا كانت تطالعهم قبور الأحباء، وتلاحقهم ذكريات الأعزاء..
هذا ما وجدوه، وما كان يحيط بهم بالفعل، وينتصبُ ماثلاً أمام أعينهم باستمرار، يستوي فيه المنتصرون والمنهزمون على حدٍّ سواء، لأنهم كلهم ذاقوا طعمه مرًّا، وشمُّوا رائحته آسنةً، ورأوا مفعوله قاتلاً!.. فخيَّم نوع غريب من الشعور، كان عند الجميع مزيجاً من اليأس والقلق والتهوُّر..
وفي ردَّة فعل عنيفة، قام دعاة الإصلاح في الاجتماع والاقتصاد والعمران، يشدُّون عزائم الشباب، ويحركون همم الأمم، فاستوى كل شيء من جديد، بل وأحسن مما كان عليه من قبل، فعادت عجلة الحياة، وعادت دورات الاقتصاد، واندفع الركب في التصنيع والبنيان، وإقامة المدن والمنشآت، حتى غدت الأماكن أجمل مما كانت عليه، وباتت الحياة رخاءً أكثر من السابق... ولكن هل أذهب ذلك كله المرارة من النفوس، وأبْعَدَ عنها وساوس القلق والخوف واليأس؟!.
لا نظن ذلك، لأنَّ ما خلّفته تلك الحرب البشعة كان أقوى من أن تمحوه مظاهر الحياة الجديدة، ولذلك عاش الجيل الجديد في أوروبا، بل وكل من أذهلتهم النتائج التي تمخَّض عنها الصراع الدولي، الذي عادَ يستشري من جديد، عاشوا حياة فكرية مضطربة، وحالةً نفسية متعثرة، ودليلها ما شهدته باريس ـــــــ وهي مرآة العالم المتحضِّر وبيت الرصد للموجات الفكرية والانفعالات النفسية في كل أوروبا ـــــــ ومعها عواصم الغرب كلها، من حالات الاضطراب الفكري والتعثر النفسي، إذ امتلأت بالأماكن والجحور التي تعجُّ بأولئك الذين خلَّفوا الحياة السويَّة وراءهم، وهاموا على وجوههم حيارى، ظامئين، يطلبون الفرح واللذة من أي سبيل...
ومن هؤلاء اليائسين أبلغ اليأس، ومن هؤلاء المقبلين على المتعة في شراهة المجانين، تولدت تلك الشرارات الفكرية الجديدة، فكانت غريبة الألوان، متعاكسة الاتجاهات، تبني عالماً للفكر بقواعد مبتدعة، لا ارتباط بين مقدماتها ونتائجها.. ولعلَّ أهم مظاهر هذا العالم الفكري الجديد تبرز فيما عرف بالبيتلز (Beetles) في أوروبا، والهبيين في أمريكا، أو فيما راج في سوق السينما والتلفزيون من أفلام خلاعية، أو أفلام عنف وجاسوسية، وفيما انتشر على نطاق واسع من بيوت اللذة والمتعة، ومواخير الدعارة والقذارة، إلى جانب أماكن المخدرات والمسكرات، وظهور العصابات والمافيات التي عجزت الحكومات عن مقاومتها، والسيطرة عليها.. وهذا بالإضافة إلى النظم السياسية والاقتصادية، التي تحمي الاحتكارات الجشعة، وتحمي التمايز الطبقي، أو تهيمن كلية على الدولة والمجتمع، وأدوات الإنتاج، بحيث تقتل المبادرة الفردية، وتقضي على الحرية الشخصية إلاَّ في إطار النظام، والإيمان بعقيدة الحزب الحاكم...
ولم يكن الفن بعيداً عن هذا العالم الفكري الجديد، لا، بل على العكس، كان له فيه صرحٌ كبير، ولكنه صرحٌ تلاقت فيه شتى أنواع الفنون كالموسيقى والنحت والرسم والتصوير، والشعر والكتابة، على ملامح جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهي ملامح ليست لبناء حضارة أكثر مما هي تعبير عن مشاعر أصحابها من ذوي الأدمغة المنجذبة بالفرح واللذة، الساعية وراء المتعة والنسيان.. لقد اعتدَّ هؤلاء بفنونهم أيما اعتداد حتى صار يشار إليهم بالبَنان، فأقاموا الحفلات والمعارض، في جميع الأقطار، ولكنَّ غالبيتهم ظلوا مشردين في الطرقات، يعرضون نماذجهم الفنية إما على الأرصفة أو في أمكنة مختصة بهم، همهم كسب دريهمات من ورائها، حتى يشتروا بها لباساً من نوع مميَّز، يأنف الإنسان العادي من ارتدائه، أو حتى يؤمِّنوا به لقمة العيش أو المسكر الذي يخدر أعصابهم ويجعلهم يهيمون في النشوة والخيال!!.
ولقد قامت صرخات مدوية في الغرب، ترفض مثل تلك الحركات، وتعلن مساوئها وما تجرُّ إليه من انعدام روح المسؤولية، وعدم رؤية المستقبل بصورة واضحة، تعيد للإنسان ما فقده من كرامة، وما يطمح إليه من سعادة، إلاَّ أنَّ تلك الصرخات لم تؤد إلى أية نتائج إيجابية، وما زال الإنسان يعيش واقعاً مؤلماً، يدفعه للهرب من الحياة بشتى الصور والأشكال..
إن هذه الصورة الحقيقية التي تشير إلى فترة من فترات اختلال التوازن في الفكر العالمي، عقب أزمة الحرب الماضية، قد أدت إلى تنحية عدد كبير من أبناء الجيل الماضي عن الحياة الواقعية، فتعلقوا بأسوار الوهم، ووقفوا يصرخون بآرائهم المضحكة حيناً، والمحزنة حيناً آخر.
وإن هذه الفترة التي اختل فيها ميزان الإدراك والتصور، واختلطت فيها المقاييس المنطقية والعقلية بالمشاعر والانفعالات، والرؤى المغلوطة، تقرِّب إلينا، من الواقع الملموس، صورة لما يشهده العالم من تأثير الصدمات الشديدة في اتِّزان المقاييس الفكرية، وفي وضوح الغايات المختلفة في الحياة.. ولما كانت الإنسانية، وهي تتقدم في ساحة الحياة الرحيبة المتماوجة، لا تملك أن تلتمس طريقها الصحيح إلّا بدليل واحد هو الفطرة السليمة المستقرة في جوانحها، ثم لما كانت هذه الفطرة السليمة تستنكر ببداهتها «الهروب من الحياة» وتستقبح تزييف الواقع، أو الفرار منه، أو محاربته بالصور الكاذبة، كانت تلك الفترة التي أعقبت الحرب الكبرى والحرب العالمية الثانية ـــــــ والتي امتازت بكثرة عدد الخائفين من الواقع، والذين يمكن وصفهم بضحايا الفن وسواقط الفطرة ـــــــ جديرةً بالدراسة والتأمل، وحَرِيَّةً بملاحظة المتناقضات العقلية التي ازدحمت بها واشتهرت عنها، وجعلتها من أكبر العوامل التي أدت إلى هذا الموقف الشاذ الذي يقفه العالم من نفسه، في هذا الظرف الخطير..
وقد لا يكون غريباً أن تكون هذه هي وجهة النظر الأوروبية إلى الموضوع. فإنه على الرغم من هذا الاختلال في ميزان العقل المعاصر، ظهر بعض المفكِّرين الذين رمقوا هذه الحالة المؤلمة من بعض الزوايا، وتنبأوا بالمصير السيّئ.. وقد أعطَوا مثالاً على ذلك تطاحن أصحاب مبدأ «الكلية» فيما بينهم، وعدم قدرتهم على شرحه للناس؛ وهذا أمرٌ طبيعي، لأنه نوع من الاختلاط الجسدي والعقلي، يُعرف ولا يُعَرَّف، ويمارس بالقدوة ولا يُشرح باللفظ؛ أو مثال دعاة «السريالزم» من تلاميذ العقل الباطن، الذين يدأبون على نشر ترَّهاتهم، ويقتتلون كالأنعام في سبيل محاربة العقل الواعي، بمنطق العقل الواعي.. وبين هؤلاء وأولئك ظهرت طائفة، من الذين فقدوا أبناءهم في الحرب، أخذت تهدر الوقت في الهذيان عن «الأرواح» وكيفية استحضارها والتحدُّث إليها، وذلك بعد أن كان قد ظهر ما يعرف بـــــــ«علم الرُّوح» في بلدان أميركا وأوروبا، وأنشئت له هيئات ومعاهد عديدة أخذت أسماء مختلفة مثل «الكلية البريطانية للعلم الروحي» التي أسست سنة 1920، «والمعمل الوطني للبحث الروحي» في جامعة لندن الذي أسس منذ سنة 1925 والذي يصدر جريدة، ونشرة منتظمة بأعماله.. «والمعهد الدولي لما وراء الرُّوح» و«المعهد السيكولوجي العام» في فرنسا.. وغيرها من المعاهد والجمعيات في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية.
وهكذا نشهد الهاربين من الحياة ينقسمون إلى فريقين متعاكسين في الاتجاه، متفقَين في النتيجة: فريق «المُدْمنين» وفريق «الروحانيِّين»؛ ويقوم أبناء الفن بالخلط بين الحياتَين، فهم في حياتهم اليومية فُسَّاقٌ فاجرون مُدمنون، فإذا ما ظهروا على صفحات الكتب أو الصحف أمام «الزبائن» فهم النجوم الساطعة في سماء الفن وهم أهل القداسة والحماسة الذين يحلِّقون فوق الأبراج العاجية إلى آفاق العوالم النورانية والإلهية!.
ولعلَّ القارىء لا يستكثر على هؤلاء المرضى بعقولهم، هذا التحديد لحقيقتهم، إذا ما علم أنه، خلال الفترة بين الحرب الكبرى الأولى والحرب العالمية الثانية، أُنشئت آلاف البيوت التي انطوت جدرانها على أفظع مشاهد الدعارة الشاذَّة تحت عنوان الفن، وباسم التجارب الحيوانية على مشاعر الإنسان وجسده لابتكار صور وألفاظ جديدة...
وإن هؤلاء الهاربين من الحياة كانت لهم نظائر في عالم الشرق القديم، أولئك الذين اتبعوا طريق الزُّهد، متقمِّصين حياة التقشُّف والجوع والسهر، هائمين على وجوههم في الأسواق والفلَوات، لا يلوون على شيء، وليس لهم من همٍّ سوى الابتعاد عن شؤون الحياة، وتناسي موجباتها وأهدافها، متوهِّمين أنَّ في زهدهم ذاك ما يحقق لهم السموَّ الروحيَّ، ويرفعهم إلى أعلى المراتب حتى يتَّصلوا بالحضرة الإلهية..
ولقد ظهرت هذه الحالة بصورة واضحة، بعدما ضعفت الدولة الإسلامية، حيث راحت تعاليم الصوفية ومذاهب الزهاد من «الروحانية» يتردد صداها في خواطر الأتباع من الموالي والأعاجم بحكم ما ألفوه قديماً من تقاليد المجوسية وطقوسها الصوفية، وما ورثوه من أنظمتها وعاداتها وأفكارها؛ وحيث وجدت طائفة متصلة الحلقات من رجال التصوف والزهد، تعيش إلى جانب الطوائف الأخرى التي نبتت على أرض الوثنيات القديمة لتدَّعي في الإسلام بما تشاء، ولتعمل على تغشية دعوته الكريمة بالجهالات والضلالات والخرافات..
فقد قام في بلاد فارس في القرن الثالث قبل الهجرة مذهب يعرف بالمانوية كانت تعاليمه خليطاً من العقائد الوثنية الهندية. وهو يدعو إلى الزهد في الحياة، والتقشُّف في العيش، واستعجال الفناء من طريق إضعاف الجسم بالجوع والمرض والإهمال، وذلك بحجة تقوية الروح، وتخليص النفس من أدران الجسد!.
وقد ظل هذا المذهب المانوي قائماً إلى أن فتح المسلمون بلاد الأعاجم، فدخل فريق كبير من أتباعه في الإسلام، ولكنهم سرعان ما وجدوا تبدلاً كبيراً في نمط الحياة التي ألفوها، إذ حلَّ النظام والتنظيم بدل الفوضى التي كانت سائدة، وانتشرت الحوافز للعمل بدلاً من الدعة والكسل، وحلَّ العدل محل الظلم، وعمت هداية الله تعالى وشريعة الحق بدل التعاليم العقيمة الفارغة... وهذا كله جعل ذلك الفريق الصوفيَّ المانويَّ ـــــــ في طبيعته ـــــــ يحقد على الإسلام، ويضمر العداء لمن جاؤوه به، فراحوا يعملون في الخفاء على استنبات عقائدهم المانوية في حقل الشريعة الإسلامية، فكانوا كمن يبذر مع الزرع بذور الآفة التي تأكله.. ولم تلبث هذه البذور المانوية الشريرة أن أثمرت الانحلال والضعف في نفوس من لم يعرفوا طبيعة الإسلام العملية من حديثي العهد به من الأعاجم، ومن قصرت همّتهم على إدراك مقاصده السامية، وتفهُّم ما في قوانينه من دواعي التنشيط المجتمعي، وأغراض البعث الحيوي والعقلي للأفراد، فلما تمَّ لهؤلاء الكهَّان المضللين ما أرادوه من توهين النفوس، وتوطئتها لقبول فكرة الزهد على أنها، هي دون غيرها، حقيقة الإسلام ولبابه، عملوا على إشعال الفتنة بين هؤلاء الزهاد والكسالى بإثارة المسائل الجدلية بينهم، ونقلها إلى الناس عنهم؛ فبدأوا باقتفاء ما لا يدرك من حقائق الوجود، وأخذوا في مطالبة الدين الجديد بالانحراف معهم إلى عالم التيه الفلسفي ليستأنفوا ما بدأه الكهنة القدماء من الخوض في تلك الأسئلة التي لا جواب عليها حول: الروح، والقدَر، وأصل الخليقة، والخير والشر.. واسترجاع تلك الحانات الكلامية لذاتها؛ وبذلك استحكمت الفوضى العقائدية نتيجةً لاشتغال الناس بالجدل، وانقسمت كلمة المسلمين بتعصب كل فريق منهم إلى رأي وانحياز كل فرد منهم إلى جماعة.. ومن ثمَّ نشأت الفرق التي فرقت وحدة الأمة، وأتت على بنيانها من القواعد. بينما بات المسلمون العرب في هذا الخضم مجتمعين وحدهم على دينهم، مصطلحين على تسمية هؤلاء الشعوبيين المتكلمين الذين دعوا إلى الإلحاد من طريق الزهد باسم «الزهاد الزنادقة». ولم يسلم كثير من العرب من الانغماس في تلك التيارات، بل لقد غاص الكثيرون منهم في خضمِّ هذه الموجات الجارفة، وكان منهم سادة وقادة وواضعو أسسٍ وقواعد لتلك الضلالات التي نحن بصدد دراستها وتحليلها..
وهكذا، مُنيت تعاليم الإسلام بالنزعات المانوية على أرض الأعاجم، فبرزت لأول مرة في تاريخ الإسلام، فكرة الزهد ينادي بها زعماء طائفة «الروحانية» من أمثال رياح بن عمرو القيسي الذي اتخذ «الزهد» وسيلة يتقرب بها إلى الله، وقسم الزهد إلى مراتب جعل نهايتها مرتبة سماها مرتبة «الخلَّة» أي على ما يَدَّعي، على وجه الخلَّة مع الله وعدم الكلفة فيما بينهما.. ومنهم ابن حيان الحريري صاحب المذهب الذي يحض على مطاوعة ما يشتغل به القلب حتى لا يقف حائلاً بين تحقير الدنيا ونبذها! ومنهم أبو العتاهية الشاعر الذي كان يتغنى بالزهد فأكثر فيه القول، وهو أطمع الناس في المال والجاه! ومنهم عبد الواحد بن زيد أول من أدخل نظام «الخانقاه» في الحياة المجتمعية ليجتذب به المتعطلين والمستضعفين، وكان من الزهَّاد الذين أوقفوا جهودهم لاختراع الأحاديث ووضعها في فضل الزهد والزهاد!!.
ثم ظهرت بوادرُ الصوفية، فهضم أفرادها العديدون تعاليم هؤلاء الزهاد، وإن تجنبوا ـــــــ بدافع الحذر ـــــــ ما وقع فيه أسلافهم من إعلان العقائد المانوية والظهور بمظهر الزيغ والإلحاد، وقد تسمَّوا بالصوفية ليدفعوا عن أنفسهم ما اشتهر به الزهاد من فاحش القول والعمل، ولذا أظهروا الصلاح والتقوى، إلاَّ أنهم غالَوا في أسباب التقشُّف حتى البَلَه.
وفي عصر الترجمة ورواج الفلسفة اليونانية وتعاليم الأفلوطينية قام في الأمة الإسلامية فريق ممن كانت غايتهم التوفيق بين الفلسفة والدين، كالفارابي وابن سينا، يفلسفون الزهد بمنطق اليونانيين من أمثال فيثاغورس وأفلاطون وغيرهم من اليونانيين الذين انحصرت برامجهم الأخلاقية في صرف الناس عن حياة الترف إلى حياة التقشُّف والزهد.
إلى هذه الفرق التي استمدت فكرتها من المانوية الفارسية أو الفلسفية اليونانية، يرجع نشوء فكرة «الزهد» وقيام حركة «التصوف» في البيئة الإسلامية خارج البلاد العربية، وقد تعددت صور هذه الفكرة وتكيَّفت بحسب أهواء الرجال؛ ففريق يبني زهده على التشاؤم والسخط على العيش، لشدة ما أصابه من الحرمان؛ وفريق آخر من الزهاد يقيم مذهبه على عدم المبالاة فيبيح المحظورات تحقيراً للدنيا!! وفريق ثالث جعل غايته من الحياة حمل النفس على المكروه حتى يستوي عنده الخل والعسل، والقبيح والمليح، وتختلط عنده الحدود بين الحلال والحرام، فتسقط عنه التكالف!! وفريق رابع ذهب إلى أن الدنيا كلها حرام، فبحسْب المرء منها ما يقيم الأود ويدفع الموت؛ ومنهم من تظاهر بالزهد واتخذه حرفة لجمع الأموال، فكم من زاهد كان يدعي الفقر والعوز في حياته، فوجدت أكداس مكدسة من الذهب في مخلفاته بعد مماته، وفريق غير هؤلاء اتخذ الأربطة والتكايا لإظهار الزهد..
على أنه مهما اختلف أولئك الزهاد أو الصوفية في مذاهبهم، فقد اتفقت كلمتهم على أن الزهد هو ترك الدرهم والدينار، وتحريم الامتلاك والادِّخار، والتجرد من العمل والكسب، والإعراض عن الزواج والطيبات من الرزق، والاكتفاء باللقمة الخشنة والخرقة البالية. وفوق ذلك لزم الخلوة للقضاء على حظ النفس.. فما أشبه ذلك بحياة تؤدي إلى الموت الأبيض، وهو عبارة عن نوع من العقوبات، عرفتها فرنسا في القرون الوسطى، تقضي بتجريد المجرمين من أبناء الأشراف من كافة حقوقهم الشخصية كالميراث والزواج والتملك، وحرمانهم من الإتجار ومزاولة الأعمال، وإلزامهم فوق ذلك حياة خاصة حتى تستنفد أعمارهم، وتستهلك أيامهم..
إن هذا «الموت الأبيض» كان يؤدي إذاً إلى حياة هي بمثابة حكم الإعدام على شخصية بعض الأفراد، بحيث لا يعود من معنًى لحياتهم أبداً، وهي حياة تشبه في كثير من تفاصيلها، معيشة الحرمان والخمول التي يَفني فيها العاجزون والمتصوفون أعمارهم باسم الزهد والتقشُّف والتصوُّف، ولكن مع فارق بأن هؤلاء يحكمون على أنفسهم بأنفسهم، في حين أنه في الموت الأبيض تكون أعراف المجتع وقوانينه وقواعده السائدة هي التي تحكم على الأفراد!!.
وعندما يحرّم الزهاد والصوفية المكاسب ـــــــ بما يؤدي إلى إيقاف الدولاب الاقتصادي ـــــــ فإنهم يقولون بأن البيع والشراء باطلان، وأن السعي في طلب الرزق معصية لأنه سوء ظن بالله، وتكذيب لوعوده، وهم يعنون بذلك قوله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6] ناسين قوله عزَّ وجلّ: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ} [الملك: 15] وأن الرِّزق يُسعى إليه ولا يسعى بنفسه ولا ينزل خبزاً مخبوزاً ولا طبخاً ناضِجاً ولا أسماكاً مقليَّة وفراريج مشويَّة، ومتناسين أن من تضيق به الحال ويهاجر، {يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً} [النساء: 100] وأن من قعد ينتظر دخول الرزق عليه من تلقاء نفسه، لن يدخل عليه إلاَّ الجوع والوسخ والذل، نتيجة هروبه من مسؤوليات الحياة.
وهم ـــــــ أيضاً ـــــــ يقولون: إن فقدان المال خير من وجوده وإن صُرِف في طريق الخير (كما يرى أبو حامد الغزالي)، لأن التدبير للمال يشغل القلب عن العبادة.. هذا ويعتبرون المال كذلك بأنه حجاب النفس، وأن حبسه يتنافى مع التوكل!.
أما عن المطاعم فيقولون: إن الأفضل ترك المباح، وهم لذلك لا يذوقون الطيبات وفيهم من يحرِّمها، ويمتنعون عن كل ما يصلح أبدانهم، ومنهم من لا يتناول الطعام حتى تضعف قواه، وتصيبه الخيالات الفاسدة فيهذي من فرط الجوع والألم، ويدَّعي وهو على هذه الحال ـــــــ من المكابرة الغبيَّة ـــــــ أنه من الواصلين، وأنه يرى من العجائب ما لا يراه الناس، وأنه يطلع على الغيب ويخاطب الملائكة!. بل إن من شِرارهم من يدَّعون حلول الخالق، تبارك وتعالى ـــــــ في أجسادهم الفانية، وغير ذلك مما أُثر عن الصوفية، ومما يبدو الإسراف فيه، نشوء ما يعرف في أوساطهم «بفضيلة الجوع» التي أدت إلى قيام فكرة «معاقبة الجسم لتكفير الذنوب» وتأديب النفس بالجوع والسهر، والمبالغة في تحمل المشاق، كما أن كتب الصوفية نفسها تروي الأخبار الغريبة عن ذلك.. فقد جاء في الرسالة القشيرية عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: حفظت القرآن وأنا ابن ست سنين وكنت أصوم الدهر وقوتي خبز الشعير إلى أن بلغت اثنتي عشرة سنة. فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى البصرة أسأل عنها، فجئت البصرة وسألت علماءها فلم يشف أحد منهم عني شيئاً فخرجت إلى عبادان وفيها رجل يعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله، فسألته عنها فأجابني، ثم عدت إلى تستر وجعلت قوتي من الشعير فاشتريت شعيراً بدرهم، فكنت أفطر كل ليلة على أوقية من خبز الشعير بغير ملح ولا أدام، فكان ذلك الدرهم يكفيني إلى سنة كاملة، ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال وأفطر ليلة، ثم خمساً وأفطر ليلة، ثم سبعاً وأفطر ليلة، ثم خمساً وعشرين ليلة وبعدها خرجت أسيح في الأرض.. فتصورْ قوَّة هذا السائح بعد أن صار يأكل يوماً ويطوي على الجوع خمسةً وعشرين.. ثم لا تعجبْ، واسأل أَكْلةَ الشعير عن القوة التي يعطيها هذا الطعام.. وصدِّق، أو لا تصدِّق قوله!..
وجاء في تلبيس إبليس لابن الجوزي أن رجلاً قال لأبي يزيد البسطامي: أريد أن أجلس في مجلسك الذي أنت فيه، قال: لا تطيق ذلك.. فقال له الرجل: إن رأيت أن توسع لي في ذلك؛ فأذن له أبو يزيد وجلس الرجل يوماً لم يطعم فيه فصبر على الجوع، فلما كان في اليوم الثاني، قال له: يا أستاذ، لا بدّ مما لا بدَّ منه، فقال له البسطامي: يا غلام لا بدّ من الله.. فقال: نريد القوت! قال البسطامي: القوت عندنا طاعة الله. قال: يا أستاذ أريد شيئاً يقيم جسدي في طاعة الله عزَّ وجلَّ، فقال له البسطامي: إن الأجسام لا تقوم إلّا بالله.. وصدِّقْ قول هذا «الملاك» الذي يعيش بالتسبيح والتقديس، وقد قطع مرحلة أكل الشعير!..
وفي طبقات الشعراني أن إبراهيم الدسوقي أحد أقطاب الصوفية، في القرن الرابع الهجري، كان إذا ألبس المريد خرقة الصوفية يقول له: اعلم يا ولدي أن صحة هذه الطريقة وقاعدتها ومجلاها ومحكمها الجوع فإذا أردت السعادة فعليك بالجوع ولا تأكل إلا على فاقة، فإن الجوع يغسل من الجسد موضع إبليس...
وهكذا ابتدع الصوفية تجويع الجسد باسم الزهد، متناسين أن الجوع يولِّد الوهن والضعف، وأن العقل السليم في الجسم السليم، وأن بالجوع لا يعود الفرد معه قادراً على العمل، وعلى تحصيل الرزق حتى ولا على مواجهة أبسط أمور الحياة بما تستحق من العزيمة والصبر، فيصبح الصوفي وكأنه عالة على مجتمعه وعلى أمته..
ومثل الجوع، كانت للصوفية بدعٌ أخرى في اللباس. فقد اعتبروا أن مظاهر الزهد عندهم لبس المرقَّعات والصوف حتى صاروا به يعرفون. وقد جاء في تلبيس إبليس لابن الجوزي أن هشام بن خالد قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول لرجل لبس الصوف: إنك قد أظهرت آلة الزاهدين فماذا أورثك هذا الصوف؟ فسكت الرجل؛ فقال له: يكون ظاهرك قطنياً وباطنك صوفياً...
وقيل لأحد الصوفية: أتبيع جبتك الصوفية هذه؟ فقال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد!..
وكان أويس القرني، كما تذكر كتب الصوفية، يلتقط الخرق والرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها ويلبسها.. وبعضهم كان يأخذ ثوبين أو ثلاثة مختلفي الألوان فيجعلونها خرقاً ثم يخيطونها ثوباً ليظهر للناس أنه مجموعة من الخرق البالية، وكان هذا النوع من المرقَّعات أحب إليهم من لبس الصوف لأنه أدل على الزهد من الصوف...
وجاء عن مالك بن دينار أنه كان يقول محذِّراً الناس من أحابيلهم: إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلّا البصير بين أناس قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم فطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسهم حتى لا تقعوا في شباكهم.
وكان أبو الحسن البسطامي أحد شيوخهم، يلبس الصوف صيفاً وشتاءً، ويقصده الناس يتبركون به، فلما مات وجدوا عنده أربعة آلاف دينار، مما يبيِّن كيف أن اختيارهم لباس الصوف والمرقَّعات كان نوعاً من الدجل والرياء..
هذا بعض ما جاء في كتب الصوفيَّة وهو قليل من كثير مما نقله عنهم الثقات، ليظهروا تلك الأنماط من العيش التي ابتدعها الصوفية باسم الزهد، أو ما كانوا يتظاهرون به، بل وما أرادوه لتضليل العوامِّ من الناس، وتجريدهم المفاهيم الإسلامية من محتواها الذي يتَّفق مع العقل والفطرة، ويساير الحياة مهما بلغ شأنها من التقدم والرقي..
وهكذا نجد أن الهاربين من الحياة، سواء في الغرب أم في الشرق، هم أناس لم يعرفوا معنى الحياة، ولم يقدروا الحياة حق قدرها، أو أنهم عرفوها وفشلوا أمام مسؤولياتها فلجأوا إلى ما يغطِّي فشلهم ويُخفي جُبنهم بما طلبوه من مظاهر الشهرة عن طريق الشذوذ عن قواعد الحياة وسُننها وعن طريق الجرأة على سُنن الله في خلقه ونواميسه لعباده. ولئن كانت أوروبا قد عاشت في دياجير ظلام القرون الوسطى، ثم جاءت حقبة القرن العشرين بآفة الحرب الأولى، وأعقبتها آفة الحرب الثانية، لتحفر في النفوس كل عوامل اليأس والقلق، ولاسيما بعدما اشتد الصراع الدولي بوجود الجبارين، وانتشرت الأسلحة الاستراتيجية الفتَّاكة حتى بات الخوف على المصير هو علة العلل، مما أوجد الاختلال في التوازن الفكري، وأنشأ ذلك العالَم الرهيب من أناس هم ضحايا الصراعات والأفكار، فانساقوا وراء الموبقات والمفاسد، والانحلال الأخلاقي.
ـــــــ أقول: لئن كانت أوروبا قد انزلقت في هذه الهوَّة الخُلقية وعانت هذه العوامل الرهيبة، فإن الشرق أيضاً بصورة عامة، وبلاد المسلمين بصورة خاصة، لم تسلم هي الأخرى من كثير من الآفات والأمراض التي نخرت نفوس الكثيرين من أبنائها، فانقادوا وراء الخرافات والأضاليل التي ابتدعها دعاةٌ مضللون، أطلقوا عليها اسم «الزهد» أو «التصوف» إما لإضعاف المسلمين، وتفتيت بنيانهم الديني والأخلاقي، وإما لخدمة أهوائهم ومصالحهم الشخصية، حتى يكونوا أصحاب مقامات، وذوي نفوذ ومراكز، ولو في ظل العجز والتخلف وفقدان المنعة والسيادة..
وإذا كانت الحالات التي ظهرت في الغرب قد وصلت إلى حالة المرض الذي يدفع للهرب من الحياة، فإنَّ تلك الأحوال التي ظهرت في بلاد المسلمين تحت ستار الزهد أو التصوف هي أكثر من هروب من الحياة، بل هي ضرب من الجنون قد أصاب أصحابه نتيجةً للإمعان في العُزلة، والمغالاة في الجوع والسهر، وكبت الغرائز وإفسادها، فإن المرضى بجنون «الزهد» أو «التصوف» يصابون بذلك الإحساس المعقد الذي يصوِّر لهم الدنيا وكأنها رجس وشرور وآثام، فيدفعهم إلى الهرب منها؛ بل إن حياتهم نفسها تصبح عندهم وكأنها إثم يجب الخلاص منه، والتكفير عنه، فيحاولون القضاء عليها، هم يتوهمون بأنهم يجدون لذة شاملة في تعذيب النفس، والركض وراء البلاء، والتعرض له، أو طلب وقوعه بأي سبيل؛ ومن هنا نشأت عندهم فكرة «التمحيص والاختصاص بالبلاء»؛ ثم نمت هذه الفكرة عندهم حتى سادت تعاليمهم وسيطرت على كافة أحوالهم، وأضحت عماد دعوتهم وطريق سلوكهم وارتقائهم.
وإنَّ فكرةً شأنها وقوامها تفضيل البلاء على النعماء، والفقر على الغنى، والمرض على العافية، لهي أشدّ الأمراض المجتمعية خطراً، وأكثرها إفساداً للعقول والنفوس.. ومن هنا فإننا نجد الصوفي يخضع لتعاليم شيخه خضوعاً تامًّا، ويطيعه طاعة عمياء، حتى يمتلكه الشعور بالمذلة والتفاؤل، ويدفعه هذا الشعور إلى مهانة نفسه، وعدم تقدير شخصيته، فيوقن أنه دون الناس في كل شيء.
وقد يلازم هذا الإحساس صاحبه حتى لا يعود قادراً على التخلص منه، فتأتي بالتالي تصرفاته تعبيراً عمَّا في نفسه، ولذلك فهو لا يتوانى عن المبيت في المقابر أو في الخربات أو على المزابل، إذ يعد نفسه من الأموات أو المهملات، كما أنه لا يأنف أكل فضلات الناس، أو ملازمة دورات المياه في المساجد وغيرها، يتعهدها بالنظافة.. كما أنه لا يتورع عن أن يعلِّق مخلاةً في رقبته يروح بها ويغدو، شأنه شأن الحيوان الأعجمي، الذي يُطعم التبن والشعير، أو أن يحمل نعله فوق رأسه ويسير به في السوق أمام الناس ليظهر بمظهر نافرٍ عن مظاهر الآخرين في كل حال..
فهل يقبل الإنسان، سواء في شرق الأرض أم في غربها، بمثل هذه الحالات الغريبة الشاذَّة؟! وهل الذي يقومون بها إلاَّ هاربون حقًّا من مسؤولياتهم في حين أن الحياة بنظرهم غاليةٌ بمقدار ما يلفظونها ويستهينون بها؟.
على أن الإسلام كان صريحاً من هذه الدعوات كلها، وواضح الرأي بهذه الأضاليل.. فقد قال تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: 77]. وقال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]. وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172]. وقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].
إذن فأين الدَّعوة في قول الله تعالى إلى الزهد، وإلى التقشُّف، وتجويع البدن، ولبس المرقَّعات والصوف، وإيلام النفس والجسد بشتَّى أنواع التعذيب؟ إنها على العكس، دعوةٌ إلى الأخذ من الدنيا بنصيبها دون أن ننسى الآخرة، ودعوةٌ إلى أكل الطيِّبات من رزق الله سبحانه، والتمتع بزينة الله تعالى فيما أخرجه لعباده، بل وهي دعوةٌ إلى العمل من أجل إيجاد الرزق الذي فيه الحلال والطيّب، وكل ما يُفرح قلب الإنسان، ويشفي غليله، ويُحمي نفسه.. وإن في الرزق لحياة الإنسان، لأنه بلا طعام ولا شراب، لا يمكن أن يقوى على العيش، ولا يمكن أن تستمر حياته، وما فعلَه الصوفيون كذبٌ مصطَنعٌ ومن يتحدَّى سُنن الطبيعة تنتقم الطبيعةُ منه {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229] والصوفيون ظالمون لأنفسهم، وظالمون لغيرهم، وهم ـــــــ بالتالي ـــــــ ظالمون شديدو الظُّلم بما نسبوا لربهِّم.
وتبقى سيرة الرسول الأعظم (ص) نموذجاً حيًّا يقتدي به المؤمنون على مرِّ العصور والدهور، فها هو ذا يرى يوماً رجلاً يلبس ثياباً وسخةً، فيبادر قائلاً: أما كان هذا يجد ما يغسل ثيابه؟! وجاءه مرةً رجلٌ بثيابٍ رثَّة رديئة، فقال له: هل لك مال؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال له: من أي المال؟ قال الرجل: من كل المال آتاني الله من الإبل والخيل والغنم وغير ذلك. فقال (ص) له: إذا آتاك الله مالاً فَلْيُرَ عليك، وإذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى آثار النعمة عليه.
وجاء عن الصحابة الأبرار أنَّ رسول الله (ص) كان إذا خرج كان في أحسن هيئة في زيِّه ولباسه.. وأنه أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص حين التزم صيام النهار وقيام الليل وترك النساء والملذات وقال له: أرغبت عن سنَّتي يا عبد الله؟ قال: بل سنَّتك ما أبغي. قال له (ص): فإني أصوم وأفطر وأنام وأنكح النساء، ومن رغب عن سنَّتي فليس منِّي.. وهو موقفه نفسه من جماعة من صحابته أراد كل واحد منهم أن يتخذ لنفسه حالةً خاصةً، إما بالصوم، أو بالصلاة، أو بهجر الأزواج أو بالعزوبة وما إلى ذلك.. فقد نهاهم عن ذلك وأمرهم باتِّباع سنَّته التي تقوم على الاعتدال في كل شيء.
وكان عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام يحث المسلمين دوماً على العمل ويرغِّبهم فيه حتى لا يكون الإنسان كلاًّ على غيره.. وإن قوله (ص) مشهور عن صاحب يدٍ كان يكد ويعمل في سبيل عياله، إذ أمسك يده وقال: «هذه يدٌ يحبُّها الله ورسولُهُ».. وما زال القرآن يطالب المسلمين بالعمل الصالح ويوصيهم به، حتى جعل ذلك شعاره وشعار الإسلام في تحديد منهاجه في الدنيا والآخرة: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}.. ولم يكن للقرآن، وهذه هي دعوته في استنهاض الهمم للعمل والكفاح.. ليهمل أمر المال، فهو عصب الحياة، وعليه تقوم دعائم النشاط في الأمة، فجعل له مكاناً بارزاً في قوانين الحصول عليه، والإنفاق منه، والتوريث فيه.. وذلك كله بخلاف ما دعا إليه الصوفية، وعملوا ضدَّه.
إذن فليس في القرآن الكريم، ولا في سيرة رسول الله (ص) ما يدعو إلى الزهد، أو إلى التصوُّف.. وقد أتى القرآن الكريم على مادة «الزهد» في موضوع واحد فقط، وعلى صورة ليس بينها وبين معاني الزهد عند الصوفية أدنى ارتباط، وذلك في قوله تعالى في سورة يوسف: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ}. أي من غير الرَّاغبين فيه لأنه بنظرهم قد يشكل عبئاً عليهم، فأرادوا التخلص منه بأقل ثمن.
فعبارة: {وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} ليست اصطلاحاً على التقشف، وإنما هي أداء للمعنى البسيط للكلمة، وهو عدم الرغبة في أي شيء على السواء، من غير تحديد.. ومع ذلك فالصوفية يتبجَّحون بعراقة الزهد في الإسلام مع امتناع النص وانعدام الصلة.
والقرآن الكريم قد حدَّد طوائف «المسرفين» و«العاملين والعاجزين».. وهو ما فتىء من حيث الإسراف يبيِّن أن هلاك الأمم ودمار الشعوب هو في تهافتها على الترف، وافتنانها بزخارف النعيم، وفقدانها بذلك القوة على النضال ومغالبة الخطوب، فقال سبحانه وتعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً} [الإسراء: 16]. ولهذا السبب وحده حذَّر القرآن الكريم من الاطمئنان إلى رغد العيش، ومتاع الدنيا، مع أنَّ ما فيها متاع قليل، ومثَّل لحياتها بحياة الزرع والنبات، وهي حياة قصيرة الأمد، حتى لا يخلُد الناس إليها فتلهيهم عن الجد، وتشغلهم عن الحق، وتستجرهم إلى الترف، ثم تغريهم بالإثم والتكاسل، حتى تسلمهم آخر الأمر إلى الفسوق والطغيان، فتكون عاقبتهم كمن قال الله تعالى فيهم: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ} [الأحقاف: 20].
وأما من حيث العمل فقد توهم بعض الصوفية، أو أرغموا أنفسهم على التوهم، بأن هذه الآيات إنما جاءت لتصرف الناس عمّا أخرج الله تعالى لعباده من طيِّبات الرزق، وما وهبهم من النِّعم، ولتسلك بهم بعد ذلك في طريق الزهد والتقشف، بينما الثابت من اتجاهها الصريح أنها لحماية الإنسانية من الفساد والطغيان، لا لصرف الناس عن الأرزاق والطيِّبات، والعمل والكسب بحسب ما أمَرَ الله تعالى من أجل أن تستوي الحياة وتعمر.. كما أن الآيات الكريمة لا تعني، ولا يُستدل بها على شيء على وجوب التجويع والظمأ والمهانة.. لأنَّ القرآن لم ينزله الله تعالى لكبت الغرائز الإنسانية أو نقض الطبيعة البشرية، أو تكليف النفوس شططاً، ولذلك لم يغفل قطُّ أمر الدنيا، ولم يغفل قطُّ أمر الآخرة، بل دعا الإنسان إلى العمل من أجل هذه وتلك، حتى تكون رسالة الحياة مستوفية شروطها، وأهمها قيامها على الاعتدال سواء في حياة الأفراد أم في حياة الأمم. ولذا فقد أبان القرآن الكريم أن هلاك الأمم يكون بالإعراض عن نِعم الله، وجحودها وكفرانها، كما يكون دمارها بسبب الترف ومطاوعة الشهوات.. ومن هنا فإن الحياة الإسلامية العادلة هي وسط بين الحالتَين: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 268]. {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} [الفرقان: 67] (أي وسطاً).
وأما من حيث العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب العاجزين ولا الكسالى الذين يسلكون طريق الاستضعاف ولا يعملون جاهدين للوصول إلى مراكز القوة والمنعة والاستغناء. وهذه المجموعات الفاشلةُ من البشر ليس لها مأوى في دار الدنيا ولا في الدار الآخرة إلا جهنَّم، لأنها لا تستحق، في نظر الإسلام، أن تنعم بالجنَّة، إذ لم تسعَ لها سعيها،لا وذلك قولُه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً} [النساء: 97].. وأما العاملون بإخلاص وصدق فهمُ الذين يستحقون الراحة والاستقرار، والنعيم الدائم، والنهاية السعيدة ومرافقة الأنبياء والصالحين والملائكة المقرَّبين، وذلك قولهُ تعالى: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 32].
وفي النتيجة يبدو جليًّا، مما جاء في القرآن، وفي سنَّة رسول الله (ص)، تلك الدعوة إلى حياة عادلة لا إسراف فيها يجرُّ إلى الترف والفسوق والخيلاء والكبرياء؛ ولا تقتير يؤدي إلى تعذيب النفس وإهانتها وفساد غرائزها، وإذا ما حذَّر الدين من الدنيا والانصراف إلى ملاذها، فلكي لا تكون مبالغة في هذا الانصراف حتى لا يغفل الإنسانُ ما لنفسه عليه من حق، فلا يضيع في موبقات المادة وشهواتها، وما لغيره عليه من حقوق فلا يهدرها من جراء إسرافه وتماديه في أمور الدنيا، وبالتالي حتى لا ينسى دينه، ولا يتنكر لإيمانه، فيخسر من جراء ذلك كلَّ شيء، لأنه يقع في المعاصي والمحرمات، وليس من ينتشله من عذاب أليم أعدَّه الله تعالى للعاصين..
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢