نبذة عن حياة الكاتب
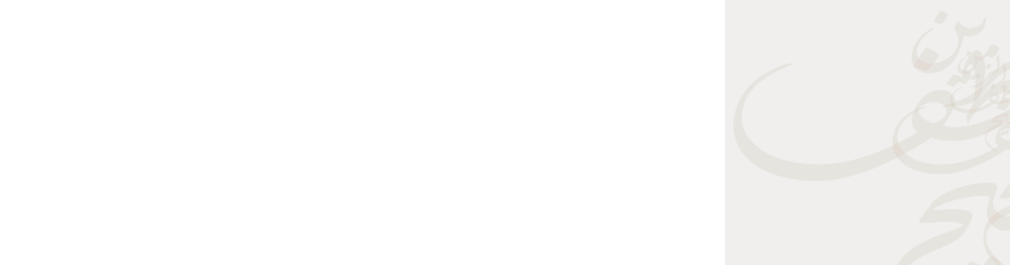
X
معجـم إعـراب مفـردات ألـفـاظ القـرآن الكريـم - الجزء الأول
الفـاتـحـة
أسماؤها
لقد كثرت أسماءُ فاتحةِ الكتاب، كتابِ الله المبين والقرآن المجيد، لما لهذه السورة المباركة من جليل الأثر، وعظيم الفضل.. والأسماءُ التي اشتهرت بها عديدةٌ، وأبرزها:
1 - «فاتحةُ الكتاب»: فهي السورة التي تفتتحُ المصاحفُ بكتابتها، والصلاةُ بقراءتها، بل وافتتاح الصلاة بها واجب حتى لا تبطل، ولذلك كانت فاتحةً لما يليها من سور القرآن في الكتابة والقراءة.
2 - «الحمد»: وسميت بذلك لأن فيها ذكر الحمدِ للّه تعالى، فآية {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *} [الفَاتِحَة: 2] إنما تعني أن الأسماء الحسنى، والصفات العليا، والثناء الحسن، والمثل الأعلى كلها لله تعالى، الذي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشّورى: 11]، وقد حقَّتْ له العبادة وحدَهُ لأنه القادرُ على أصول النعَمِ والفاعِلُ لها، ولأنَّه وحدَهُ الذي ينشىءُ الخلقَ وهو ربُّهم، ومربّيهم، ومصلح شأنهم. ولذلك أوجبتِ الآية الكريمة علينا أن نحمدَهُ لأنه ربُّنا وربُّ العالمين، على ما أولانا من نعمه ظاهرة وباطنة، وأن نتعلم كيف نحمدُهُ ونشكر له سبحانَهُ وتعالى.
3 - «أم الكتاب»: وسمّيت بذلك لأنها متقدمة على سائر سور القرآن، والعرب تسمّي كل جامع أمرٍ أو متقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعُهُ «أُمًّا»، فيقولون «أمّ الرأس» للجلدة التي تجمع الدماغ، و«أُمّ القرى» لمكَّة لأن الأرض دحيت من تحتها، فصارت «أمّاً» لجميع البلدان، وقيل: لأنها أشرف البلدان، فهي متقدمة على سائرها.
وقيل سميت أول سورةٍ من القرآن بـ«أمِّ الكتاب» لأن الأمَّ هي الأصل، وهي أصلُ القرآن لأنها تحوي معانيه كاملاً، فكما أنَّ الأمَّ هي الحاضنة، فكذلك الفاتحة هي الحاضنةُ لجميع معاني القرآن، فهي أولاً تتناول الإِقرار بالربوبية المطلقة لله تعالى، وبعبودية العباد له في عبادتهم وتعبّدهم لخالقهم. ثم إنها تشتمل على مقوِّماتِ الوجود البشري كله في المبدأ والمعادِ والمعاش..
أما المبدأ فهو في قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *} [الفَاتِحَة: 2-3]، فكان حمدُهُ لابتداءِ نعمةِ خلقِهم بالنشأة الأولى، ومن ثمَّ برحمته بهم، وتراحمهم فيما بينهم؛ ففي الحديث الشريف: «إنَّ للَّهِ عزَّ وجلَّ مئة رحمة، فمنها رحمةٌ يتراحم بها الخلق، وتعطف الوحوش على أولادها، وأخَّرَ تسعةً وتسعين إلى يوم القيامة - وفي رواية - فإذا كان يوم القيامة ضمَّها» ليرحم عبادَهُ.
وأما المعاد فهو في قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *} [الفَاتِحَة: 4] أي يوم الحساب، عند القيامة، حيث إليه يُرجعون ليقيم الموازين الحق، ولتُوَفَّى كل نفس ما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شراً يرَهُ... فالله - عزَّ وجلَّ - وحدَه المالك، المتصرف في ذلك اليوم، فلا ملك إلاّ له ومشيئتُهُ يومئذٍ مطلقة، ولكنها مشيئة الخالق العظيم، الرحمن الرحيم، الحاكم العادل، الذي أحبَّ عبادَه الطائعين، وقد أخلصوا له الدين؛ وحكم بالعدل على عبادِهِ العاصين، الذين ضلّوا عن سواء السبيل.
وأما المعاش فهو في قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *} [الفَاتِحَة: 5-7] و«إياك نعبُدُ» لأنه سبحانه ما خلق الإنس والجن إلاَّ ليعبدوه، وأن يكونوا مخلصين له الدين، ولذلك دخلت العبادة في الشأن الحياتي للإنسان، إذ بها لا يُطعم إلاَّ من الرزق الحلال، ومن جرائها يتوصل في الآخرة إلى الفوز العظيم. و«إياك نستعين» على جميع حوائج الدنيا والآخرة في المبدأ والمعاد والمعاش، ولولا عون الله تعالى وتوفيقه لعبادِهِ، ولطفه ورحمته ورأفته بهم ما ترك على ظهرها من دابَّة، فكان المدَدُ والعون منه - سبحانه - وكانت الإِجابة من المؤمنين الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر.. «اهدنا الصراط المستقيم».. أي الاستقامة في الحياة الدنيا في كل قول أو فعل أو نيَّة، وهذه الاستقامة الدنيوية هي الزادُ الذي يعين على جوازِ الصراط المستقيم يوم الحساب، ولولا تلك الاستقامة لما استقام شيءٌ في هذه الحياة الدنيا، بل ولَمَا استقامت الدنيا نفسها.. «صراط الذين أنعمت عليهم» بالصحة العقلية والنفسية، والعافية البدنية، وبالحكمة والهداية، وبكل ضروب النعم التي لا تُحصى، ولو تفكَّر العبد فيما يحيط به، وفيما يحققه، لوجَدَ أن كل شيء مردُّهُ إلى الله تبارك وتعالى، لأنَّ النعم كلها من أمره، ومما يشاءُ لعبادِهِ الذين أنعَمَ عليهم بكل نعمِهِ الظاهرة والباطنة... ولوجد أنَّ اختلافاً كبيراً بين الحياة التي يعيشها من أنعَمَ ربهم عليهم، وبين حياة غيرهم. «المغضوب عليهم والضالين» الذين أُبعدوا عن رحمته تعالى، فعاشوا حياةً مادية بحتة قوامها الرغبات والأهواء الضالّة، والتَّبعِيَّة الفاسقة، والنزوع إلى متاع الحياة الدنيا بكل أنواعه، فضلاً عن التكبّر والاستعلاء، والظلم والجور، وسلب الآخرين حقوقهم إلى غيرها كثير من الممارسات والتصرفات التي تشكل أنماطاً لحياتهم. وهذا شأنهم - كما نراهُ يومياً - في حياتهم الدنيا.. أما في الآخرة فويل لمن غضب ربُّهُ تعالى عليه، وأبعدَهُ عن رحمته، وويلٌ لمن ضلَّ عن سبيل الله، وأضلَّ غيرَهُ، فالساعة آتيةٌ لا ريب فيها، ويوم الحساب واقع لا محالة، يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاَّ من أتى الله بقلبٍ سليم. أجل، إنَّ يومَ البعث حق، ويوم الدِّينِ حق، والجزاء حق.. وكل نفسٍ بما كسبت رهينةٌ!.
وبهذه المعاني البديهية كانت «الفاتحة» تحوي المعاني الثلاثة: المبدأ والمعاد والمعاش، بل والدليل على أنها تحوي هذه المعاني أنه عندما سئل رسول الله (صلى الله اليه وآله وسلم) عَمَّا يُستحَبُّ أن يقرأ المسلمُ مع «الفاتحة» قال (صلى الله اليه وآله وسلم): «اقرأوا ثُلثَ القُرآنِ» قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال (صلى الله اليه وآله وسلم) : سورة الإِخلاص لأنها تتضمن المبدأ، أي واحداً من المعاني الثلاثة التي تتضمنها سورة «الفاتحة»..
4 - «السَّبْعُ»: وسميت بذلك لأنها سبعُ آيات، لا خلافَ في جملتها.
5 - «المثاني»: وذلك لأنها تُثنَّى بقراءتها في كل صلاةٍ: فرضٍ ونفلٍ.
وإلى هذه الأسماء المشهورة لـ«الفاتحة» فقد ذُكِرَ في أسمائها:
6 - «الوافية»: لأنها لا تنتصف في الصلاةِ.
7 - «الكافية»: لأنها تكفي عمَّا سواها، ولا يكفي ما سواها عنها، ويؤيد ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي (صلى الله اليه وآله وسلم) ، أنه قال: «أمُّ القرآن عوضٌ عن غيرها وليس غيرُها عِوضاً عنها».
8 - «الأساس»: لِمَا رُوِيَ عن ابن عباس: أن لكل شيء أساساً، وساق الحديث إلى أن قال... وأساسُ القرآنِ الفاتحة، وأساس الفاتحة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *} [الفَاتِحَة: 1].
9 - «الشفاء»: لما رُوي عن النبي (صلى الله اليه وآله وسلم) قال: فاتحة الكتاب شِفاءٌ من كل داء.
10 - «الصلاة»: لما رُويَ عن النبي (صلى الله اليه وآله وسلم) قال: قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نِصفُها لي ونِصفُها لعبدي، فإذا قالَ العبدُ «الحمد للَّهِ ربّ العالمين» يقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال «الرحمن الرحيم» يقول الله: أَثْنَى عليَّ عبدي. فإذا قال العَبدُ «مالكِ يومِ الدين» يقول الله: مَجَّدَني عبدي. فإذا قالَ العبدُ «إِيَّاكَ نعبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعينُ» يقولُ الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد «اهدنا الصراطَ المستقيمَ صِراطَ الذين أَنعَمْت عليهم غيرِ المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين» يقول الله عزَّ وجلَّ: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أورَدَهُ مُسلم بْنُ الحجّاج في الصحيح، فهذِهِ عَشْرَةُ أَسْماءٍ.
وبذلك تكون الفاتحةُ قسمين:
الأول: وهو الثناء على الله - عزَّ وجلَّ - لأنه الخالق، المدبر الرازق، الحاكم العادل.
الثاني: وهو الدعاء إليه تعالى بأن يلهمنا ويقدرنا على أن نعبده ولا نعبد سواه وأن نستعينه ولا نستعين بسواه.
فَضْلُها
نقلاً عَمَّا ذَكَرَهُ الشيخ أبو الحسين الخبازي المقري في كتابه في القراءة، بإسناده عن عددٍ من الرواة وصولاً إلى أبي أمامة عن أبيِّ بنِ كعبٍ أنه قال: قال رسول الله (صلى الله اليه وآله وسلم) : أيُّما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أُعطِيَ من الأجرِ كأنما قرأ ثلثي القرآن، وأُعطيَ من الأجْر كأنما تصدَّق على كل مؤمن ومؤمنة. ورُوِيَ من طريقٍ آخَرَ هذا الخبرُ بعينه إلا أنه قال: كأنما قرأَ القُرآنَ.
ورُويَ غيرُهُ عن أبيِّ بنِ كعبٍ أنه قال: قرأتُ على رسول الله (صلى الله اليه وآله وسلم) فاتحة الكتابِ فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا في القرآن مثلها، هي أمُّ الكتابِ، وهِيَ السَّبْعُ المَثَاني، وهِيَ مَقْسُومَةٌ بين الله (تبارك وتعالى) وبين عبدِهِ ولعبدِهِ ما سَأَلَ.
وفي كتاب محمد بن مسعود العياشي بإسناده أن النبي (صلى الله اليه وآله وسلم) قال لجابرِ بْنِ عبد الله الأَنْصاري: يا جابر، أَلا أعلّمُك أفضل سورة أنزلها الله تعالى في كتابه! قال: فقال له جابر: بَلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله عَلِّمْنِيها! قال فعلَّمَهُ الحمدَ أمَّ الكتاب؛ ثم قال: يا جابرُ، أَلاَ أخبرُكَ عنها! قال: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله فأخبرني! فقال (صلى الله اليه وآله وسلم): هي شِفاءٌ من كلِّ داءٍ إلاَّ السَّامَ، والسامُ هو الموتُ.
وعن سلَمَة بنِ محرز عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال: مَنْ لم يُبرِئْهُ الحمدُ لم يُبرِئْهُ شيءٌ.
ورُويَ عن أميرِ المؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه قال: قال رسول الله (صلى الله اليه وآله وسلم): إنَّ الله تعالى قال لي: يا محمدُ ولقد آتيناك سَبْعاً من المثاني والقرآن العظيم، فأفْرَدَ سبحانَهُ الامتنانَ عليَّ بفاتحةِ الكتابِ، وجعَلَها بإزاءِ القرآن. وإنَّ فاتحة الكتاب أشرَفُ ما في كنوز العَرْشِ. وإنَّ الله خصَّ محمداً وشرَّفَهُ بها ولم يُشرك فيها أَحداً مِنْ أنبيائه ما خلا سليمانَ فإنه أعطاه منها «بسم الله الرحمن الرحيم»، ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: «إني أُلقِيَ إليَّ كتابٌ كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم»؛ أَلاَ فَمَنْ قَرَأَها معتقِداً لموالاة محمد وآلِهِ (عليهم صلوات الله وسلامه) منقاداً لأمرِها، مؤمناً بظاهرِها وباطنها، أعطاه الله بكل حرف منها حسنةً، كلُّ واحدةٍ منها أفضلُ من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها. ومَن اسْتَمَعَ إلى قارئٍ يَقرأُها كان له قدرُ ثُلثِ ما للقارئ، فَلْيَسْتَكْثِرْ أحدُكم من هذا الخير المُعْرَض له فإنَّهُ غنيمة، لا يذهَبَنَّ أوانُهُ فتبقى في قلوبكُمُ الحسرةُ.
فَضْلُ «بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
رُوي عن علي بن موسى الرضا رضي الله عنه أنه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» أقربُ إلى اسم اللَّه الأعظم من سوادِ العين إلى بياضها. ورُويَ عن ابن عباس عن النبي (صلى الله اليه وآله وسلم) أنه قال: إذا قالَ المعلِّمُ للصبي قُلْ: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبيُّ: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله (تعالى) براءة الصبيّ وبراءةً لأَبَوَيْهِ وبراءةَ المعلِّم.
وعن ابن مسعود قال: من أرادَ أن ينجيه الله من الزَّبانِيَةِ التِّسعَةَ عَشَرَ فليقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» فإنها تسعةَ عَشَرَ حَرْفاً يَجعلُ الله كلَّ حرفٍ منها جُنَّةً مِن واحدٍ منهم.
إعرابُ سورة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم
معنى الاسم: مشتق من السمو وهو الرفعة، وأصله «سِمْوٌ» بالواو لأن جمعه أسماء مثل قِنْو وأقناء، وحِنْوٌ وأَحْناءُ وجمع أسماء: أسامِي. وتصغيره «سُمَيٌّ» وقيل إن الأصل: سِمٌ وسُمٌ، وأنشَدَ أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت: «بِسْمِ الذي في كلِّ سُورةٍ سُمُهْ»(*) .
وقيل: إنه مشتق من «الوسم والسمة» والأول أصح، لأن المحذوف الفاء (فاء الفعل)، نحو صلة ووصل، وعدة ووعد لا تدخله همزة الوصل، وإلا كان يجب أن يقال في تصغيره «وُسَيْمٌ» كما يقال وُعَيْدَةٌ ووُصَيْلَةٌ في تصغير عِدَة وصِلَة، والأمر بخلافه.
الإعراب:
بِسْمِ: الباء حرف جر، أصله الإلصاق. والحروف الجارّة موضوعة لمعنى المفعولية، ألا ترى أنها توصل الأفعال إلى الأسماء وتوقعها عليها؟ فإذا قلتَ: مررتُ بزيد، أوقعتِ الباءُ المرورَ على زيد، فالجالب للباء فعل محذوف من نحو: «ابْدَأوا بِسْمِ الله»، أو «قُولوا: بِسْمِ الله» فمحله النصب لأنه مفعول به، وإنما حُذِفَ الفعلُ الناصِبُ لأن دلالةَ الحالِ أغْنَتْ عن ذكره، وإلى هذا ذهب الفراء فقال: موضعُ الباء وما بعدها: نصبٌ، بمعنى: أَبْدأُ بسم الله الرحمن الرحيم.
وعند البصريين: إن محل الباء رفعٌ على تقدير مبتدأ محذوف، وتقديره: «ابتدائي بِسْمِ الله» فالباء على هذا متعلقة بالخبر المحذوف الذي قامت مقامَهُ أي (ابتدائي ثابتٌ بِسْمِ الله) أَو ثَبَتَ، ثم حُذِفَ هذا الخبرُ فأفضى الضميرُ إلى موضع (الباء) وهذا بمنزلة قولك: زيدٌ في الدَّارِ، ولا يجوز أن يتعلّق (الباءُ) بـ(ابتدائي) المضمر لأنه مصدر، وإذا تعلقت به صارت من صلته وبقي المبتدأُ بلا خبر.
وقال الزجاج: التقديرُ: أَبدأ باسْمِ الله، أو بَدَأْتُ باسْمِ الله أو ابدأْ باسمِ الله، وأضْمَرَ قومٌ فيها اسماً مفرداً على تقدير: ابتدائي باسم الله، فيكون الظرفُ خبراً للمبتدأ، فإنْ قدَّرتَ: أَبدأُ - أو - ابْدَأْ، يكون (باسم الله) في موضع النصب مفعولاً به. وإذا قدَّرت: ابتدائي باسم الله، يكون التقدير: ابتدائي كائِنٌ باسم الله، ويكون في (بِسْمِ الله) ضميرٌ انتقل إليه الفاعل (أي ما كان على وزن: فاعل) المحذوف، هو الخبرُ حقيقةً.
والألف في (بسم الله) حذفت من اللفظ، لأنها ألف وصل أو همزة وصل. وهمزة الوصل تسقط في الدرج. وحذفت ها هنا في الخط أيضاً لكثرة الاستعمال، ولوقوعها في موضع معلوم لا يُخاف فيه اللبسُ، ولا يحذف في نحو قوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العَلق: 1] لقلة الاستعمال. وإنما تُفكُّ (اللام - في - الله) إذا تقدمته الفتحة أو الضمة تفخيماً لذكره، وإجلالاً لقَدْرِهِ تعالى وليكون فرقاً بينه وبين ذكر (اللات).
الله: اسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والأصل: اللاهُ أو الإلَهُ، فحذف ألف الوصل اختصاراً، وجرى التشديد.
الرَّحمنِ: صفة لـ«الله» مجرورة مثله وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها.
الرَّحِيمِ: صفة ثانية لـ«الله» مجرورة أيضاً مثله وعلامة جرها الكسرة الظاهرة.
وقيل إن «الرحمنِ الرحيمِ» اسمان رقيقان أحدهما أرقُّ من الآخر، وهما يفيدان المدحَ، كما قيل إن «الرحمن» خاص بالله - عزَّ وجلَّ - و«الرحيم» يمكن أن يتصف به بعض عبادِهِ، فقدَّمَ الأول لمنزلتِهِ في الخصوصية.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *} [الفَاتِحَة: 2]
الحَمْدُ لِلَّهِ: «الحمْدُ» رُفِعَ للابتداء، والابتداء عاملٌ معنويٌّ غيرُ ملفوظٍ به، وهو خلوُّ الاسم من العوامل اللفظية ليُسنَدَ إليه خبر، وخبرُهُ، في الأصل، جملةٌ هي فعلٌ مسندٌ إلى ضميرِ المبتدأ، وتقديرُهُ (الحمدُ حقَّ أو استقرَّ لِلَّهِ) إلاَّ أنه قد استُغْنِيَ عن ذكرها لدلالة قوله «لِلَّهِ» عليها، فانتقلَ الضميرُ منها إلى حيثُ سدَّ مسدَّها، وتُسمى هذه جملةً ظرفيةً (هذا قول الأخفش وأبي علي الفارسي)، وأصل «اللام» للتحقيق والملك. وأما نصبُ (الدال) فعلى المصدر تقديره (أَحمدُ الحمدَ لِلَّهِ، أَو أَجعلُ الحمدَ لِلَّهِ) إلاَّ أنَّ الرفعَ بالحمد أقوى وأمدح لأن معناه: الحمدُ وجَبَ لِلَّهِ، أو استقرَّ لِلَّهِ، وهذا يقتضي العمومَ لجميع الخلق.
ربِّ العالَمِينَ: «ربِّ» مجرور على الصفة لِلَّهِ (تعالى) و«العالمين» مجرور بالإضافة وعلامة جرِّهِ الياء لأنها من جنس الكسرة ولأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون عند سيبويه كأنها عِوَضٌ لما مُنِعَ من الحركة والتنوين، وعند أبي العباس، محمد بن يزيد المبرد: «النون» عِوَضٌ من التنوين؛ وعند أبي إسحاق: «النون» عوضٌ من الحركة، وفتحت فرقاً بينها وبين نون الاثنين؛ وعند أبي الحسن الأخفش: «ربِّ العالمين» مجرور على الصفة، والعامل في الصفة كونه صفة، فذلك الذي يرفعُهُ وينصبُهُ ويجرُّهُ، وهو عامل معنوي، كما أن المبتدأ إنما رفعه الابتداءُ، وهو معنًى عَمِلَ فيه. واستدلَّ على أن الصفة لا يُعمل فيه ما يُعمل في الموصوف بأنك تجدُ في الصفات ما يخالفُ الموصوفَ في إعرابِهِ، نحو: أيا زيدُ العاقل، لأن المنادى مبنيٌّ والعاقل الذي وصفه معرب. ودليلٌ ثانٍ وهو: أن في هذه التوابع ما يُعرَبُ بإِعراب ما يتبعه، ولا يصح أن يُعملَ فيه ما يُعمل في موصوفهِ وذلك نحو: أجمع وجمع وجمعاء، ولمَّا صَحَّ وجوبُ هذا فيها، دلَّ على أنَّ الذي يعمل في الموصوف غير عامل في الصفة لاجتماعهما في أنهما تابعان.
وقال غيرُهُ من النحويين: العامل في الموصوف هو العامل في الصفة.
ومَن نصب «ربّ العالمين» فإنما ينصبه على المدح والثناء، كأنه لما قال «الحمد لله»، استدلَّ بهذا اللفظ على أنه ذاكر لله، فكأنه قال: أذكرُ الله ربَّ العالمين. فعلى هذا لو قُرئ في غير القرآن «رب العالمين» مرفوعاً على المدح أيضاً لكان جائزاً على معنى: هو ربُّ العالمين، قال الشاعر:
لا يَبْعُدَنْ قَومِي الَّذينَ هُمُ
سُمُّ العُداةِ وآفَةُ الجُزْرِ
النَّازِلينَ لكلِّ مُعْتَرَكٍ
والطيِّبونَ معاقِدَ الأُزْرِ
وقد روي: النازلون والنازلين، والطيبون والطيبين، والوجه في ذلك ما ذكرناه.
العالمين: مجرور بالإضافة، والياءُ فيه علامةُ الجرّ وحرف الإعراب وعلامة الجمع لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. (والنون) هنا عوض عن الحركة في الواحد، وإنما فتحت للتفريق بينها وبين (نون التثنية). تقول: (هذانِ عالِمان) فتكسر نون الاثنين لالتقاء الساكنين. وقيل إنما فتحت نون الجمع - وحقها الكسر - لثقل الكسرة بعد الواو كما فُتِحت (الفاء: من سوف) و(النون: من أينَ) ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء.
{الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *} [الفَاتِحَة: 3]
الرحمنِ الرحيم: في محل جر على أنهما صفتان لاسم الجلالة «اللَّهِ»، وعلامة جرهما الكسرة في آخر كل منهما، وهما صفتان للمدح، وإنما أعاد ذكر «الرحمن الرحيم» للمبالغة. وقال علي بن عيسى الرماني: في الأول ذِكْرُ العبودية فَوَصَلَ ذلك بشكرِ النِّعمِ التي بها يَستَحِقُ العبادة، وها هنا ذكرُ الحمدِ فوصَلَهُ بِذكرِ ما بِه يَستحقُّ الحمدُ مِنَ النِّعَمِ، فليس فيه تكرارٌ.
{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *} [الفَاتِحَة: 4]
مَالِكِ: مجرور على الوصف للَّهِ (تعالى) أي فهو صفة رابعة لاسم الجلالة «اللَّهِ»، وما جاء من النصب فعلى ما ذكرناه من نَصْبِ «ربّ العالمين» ويجوز أن ينصب «ربَّ العالمين» و«مالك يَوْمِ الدينِ» على النداء، كأنك قلت: (الحمدُ يا ربَّ العالمينَ، ويا مالِكَ يومِ الدِّينِ).
ومَنْ قَرَأَ: مَلْكِ يوم الدِّينِ (بإسكان اللام) فَأصله مَلِكٌ، فَخَفَّفَ كما يُقالُ: فَخْذٌ وفَخِذٌ.
ومَنْ قرأَ: مَلَكَ يَومَ الدِّينِ، جَعَلَهُ فِعْلاً ماضياً.
يومِ: مجرور بإضافةِ (مَلِكِ) أو (مالِكِ) إليه.
الدِّينِ: مجرور بإضافة «يوم» إِليه. وهذه الإضافة من باب: يا سارِقَ الليلةَ أهلَ الدارِ، اتَّسَع في الظرف فنصَبَ المفعول به، ثم أضيف إليه على هذا الحد، كما قال الشاعر، أنشدَهُ سيبويه:
ويوم شهدْناهُ سُلَيْماً وعامِراً
قليلٍ سوى الطَّعْنِ النَّهَالِ نَوَافِلُهْ
فكأنه قال: هو مَلِكُ ذلك اليوم، ولا يُؤتي أحداً الملكَ فيه كما آتاهُ في الدنيا، فلا مَلِكَ يومئذٍ غيرُهُ سبحانَهُ.
ومن قَرَأَ: «مالِكِ يومِ الدِّينِ»، فإنه قد حذَفَ المفعولَ به من الكلام للدلالة عليه، وتقديره: مالِكِ يومِ الدينِ الأحكامَ والقضاءَ، لا يملكُ ذلك ولا يَليهِ سِواهُ، أيْ لا يكونُ أحدٌ والياً سِواهُ. وقيل إنَّ التقديرَ: مالِكِ أحكام يوم الدِّينِ، والأولُ أصوبُ.
وإنما خصَّ «يومِ الدِّين» بذلَكَ لتَفَرُّدِهِ تعالى بالملك في يومِ الحسابِ، وجميعُ الخلقِ يضطرُّونَ إلى الإقرارِ والتسليم. وأما الدُّنيا فليست كذلك، فقد يَحكُمُ فيها ملوكٌ ورؤساءُ، وليست هذه الإِضافة مثل قوله تعالى: {عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}(*) [لقمَان: 34] لأن الساعة مفعولٌ به على الحقيقة، وليست مفعولاً به على السعة، لأن الظرف إذا جُعِلَ مفعولاً على السَّعَةِ فمعناهُ معنى الظرف، ولو كانت (الساعة) ظرفاً لكان المعنى: يَعْلَمُ في الساعةِ، وذلك لا يجوز لأنه تعالى يَعلَمُ في كلِّ وقتٍ، والمعنى أنه يَعْلَمُ الساعة، أي يعلَمُ وحْدَهُ مَأْتَاهَا.
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *} [الفَاتِحَة: 5]
إِيَّاكَ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدَّم لفعل «نعبُدُ» على الاختصاص، وقال الزجّاجُ: موضِعُ «إِيَّاكَ» نَصْبٌ بِوقوع الفعل عليه وموضع: «الكاف» في «إيَّاك» خفضٌ بإضافة (إِيّا) إليها. و(إيَّا) اسمٌ للضمير المنصوب، إلاَّ أنه ظاهرٌ يُضاف إلى سائرِ المُضمرات، نحو قولك: إِيَّاكَ ضربتُ، وإيَّاهُ ضربتُ وإيَّايَ حَدَّثْتَ. ولو قُلتَ: إيّا زيدٍ حَدَّثْتَ كان قبيحاً، لأنه خُصَّ به المضمرُ، وقد روى الخليل عن العرب: إذا بلغَ الرجلُ الستينِ فإياهُ وإيّا الشَّوَابَّ (أي الشاباتِ من الفتياتِ) وهذا كلام الزَّجَّاج(*) .
وردَّ عليه الشيخ أبو علي الفارسي فقال: إن (إِيَّا) ليس بظاهر بل هو مضمر يدلُّ على ذلك تغيُّرُ ذاتِهِ وامتناعُ ثباتِهِ في حال الرفع والجر، وليس كذلك الاسم الظاهر. أَلا تَرَى أنه يعتقب عليه الحركات في آخره ويحكمُ له بها في موضعِهِ من غير تغيُّر نفسه. فمخالفتُهُ للمظهر فيما وصفناه يدلُّ على أنه مضمر ليس بمظهر، قال وحكى السرَّاج عن المبرِّد وأبي الحسن الأخفش: أنه اسمٌ مفردٌ مضمرٌ يتغيَّرُ آخرُهُ كما تتغيَّرُ المضمراتُ لاختلاف أعداد المضمرين. و(الكاف) في «إِياك» كالتي في (ذلك) وهي دالَّةٌ على الخطاب فقط، مجردةٌ عن كونها علامةً للمضمر، فلا محل لها من الإِعراب(*) .
والحكمُ في (إيَّايَ وإيَّانا وإيَّاهُ وإيَّاها) أنها حروف تلحق (إِيّا) فالياء في (إِيَّايَ) دليل على التكلّم، والهاء في (إِيّاه) تدل على الغيبة لا على نفس الغائب، ويجري التأكيد على (إِيَّا) منصوباً، تقول (إِيَّاكَ نَفْسَكَ رأيتُ، وإِياهُ نفسَهُ ضربتُ، وإِيَّاهُم كُلَّهم عَنَيْتُ).
ولا يجيز أبو الحسن: إِيَّاكَ وإِيَّا زيدٍ، وينقل روايتهم عن العرب: «إذا بَلَغَ الرجلُ الستينَ فإِيَّاه وإِيَّا الشوابَّ» - كما أشرنا إليها آنفاً - ويحمله على الشذوذ، لأن الغرض في الإضافة التخصيص والمضمر على نهاية التخصيص. فلا وجه إذاً للإضافة .
والأصل في «نستعينُ» نستعونُ، لأنه من المعونة والعون، لكن الواو قلبت ياءً لثقل الكسرة عليها، فنقلت كسرتها إلى العين قبلها، فتصير - الياء - ساكنةً لأن هذا من الإِعْلال الذي يتبع بعضُهُ بعضاً نحو أَعانَ يُعينُ، وقامَ يقَومُ.
«ونعبُدُ ونستعينُ» مرفوعٌ لوقوعه موقعاً يصلح للاسم، أَلا تَرَى أنك لو قلتَ: أنا عابدُك وأنا مستعينُكَ، لَقامَ مقامَهُ؟ وهذا المعنى عمل فيه الرفع، وأما الإِعرابُ في الفعل المضارع فلمضارعته الاسم، لأن الأصل في الفعل البناءُ وإِنما يُعرَبُ منه ما شابَهَ الأسماءَ، وهو ما لحقتْ أولهُ زيادةٌ من هذه الزياداتِ الأربعِ: الهمزة، والنون، والتاء، والياء.
{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *} [الفَاتِحَة: 6]
اهدنا: فعل تضرع ودعاء مبنيٌّ على حذف حرف العلة «الياء» وفاعلُهُ الضميرُ المستكنُّ فيه وجوباً «اللَّهِ تعالى»، والهمزة في أولِهِ مكسورة لأن ثالث المضارع منه مكسور، و«نا» ضمير متصل - لجمع المتكلم - مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول.
الصِّراطَ: مفعول به ثانٍ، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
المُسْتَقِيمَ: صفة لـ«الصراطَ» منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها.
{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *} [الفَاتِحَة: 7]
صِرَاطَ: «صراطَ» صِفَةٌ لـ«الصِّرَاطَ المستقيمَ»، منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وهي مضافة. أو هي منصوبة على البدل.
الَّذينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإِضافة، ولا يقال «اللذون» في موضع الرفع، لأنه اسم غير متمكن، وقد حكي (اللذون) شاذاً كما حكي (الشياطون) في حال الرفع.
أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ: «أنعمْتَ» فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بالتاء، و«التاء» ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة «أنعمت» صلة الموصول لا محل لها من الإِعراب، «عليهِمْ» جار ومجرور متعلقان بـ«أنعمتَ»، وكسرت «الهاء» في «عليهم» لمجاورتها الياء. وصلة الموصول قد أتمَّ بها اسماً مفرداً يكون في موضع جرّ بإضافة «صراط» إليه، أي: صِراطَ المُنْعَمِ عليهم، وفي «عليهِم» خمسُ لغاتٍ قُرئ بها كُلِّها: قرأ ابن أبي إسحاق (عبد الله بن زيد بن الحارث الحضرمي البصري): «أَنعمتَ عليهمو» - بضم الهاء وإثبات الواو - وهذا هو الأصل أن تَثْبُتَ الواو كما تثبتُ الألف في التثنية. وقرأ الحسن: «أَنعمتَ عليهِمِي» - بكسر الهاء وإثبات الياء وكسر الهاء - لأنه كره أن يجمع بين ياء وضمة، والهاء ليس بحاجز حصين، وأبدل من الواو ياءً لما كَسَرَ ما قبلها.
وقرأ أهل المدينة: «عَلَيْهِمْ» - بكسر الهاء وإسكان الميم - وهي لغة أهل نجد.
وقرأ حمزة وأهل الكوفة: «عَلَيْهُمْ» - بضم الهاء وإسكان الميم - فحذفوا الواو لثقلها، وإنَّ المعنى لا يَشْكُلُ إذ كان يقال في التثنية: عَلَيْهُمَا.
غير المغضوبِ عليهِمْ: «غير»: وسيأتي حكم إعرابها في حالتي الجر والنصب، بعد قليل.
«المغضوبِ»: مضاف إليه، مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
«عليهِمْ»: على: حرف جر، و«هِمْ» ضمير متصل - لجمع الغائب - مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل لاسم المفعول «المغضوبِ»، أو لفعله بتقدير: غضبَ عليهم.
«غيرِ»: منهم مَنْ جرَّ «غير» ومنهم من نصبه، وفي جرِّهِ ثلاثةُ أوجُهٍ:
أحدُها: أن يكون بدلاً من «هِمْ» في «أنعمتَ عليهِم» كقول الفرزدق:
على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتِماً
على جُودِهِ لَضَنَّ بالماءِ حاتِمِ
فَجَرَّ حاتِمِ على البدل من الهاء في جوده.
وثانيهما: أن يكون بدلاً من «الذين أنعمتَ عليهم».
وثالثها: أن يكون صفة لـ«الذين أنعمت عليهم» وإن كان أصلُ «غيرِ» أن يكون صفةً للنكرة، تقول مررتُ برجلٍ غيرِكَ، كأنك قلت: مررتُ برجلٍ آخر، أو برجلٍ ليس بِكَ. قال الزجَّاجُ: وإنما جاز ذلك لأن «الذين» - ها هنا - ليس بمقصود قصدهم، فهو بمنزلة قولك: إِني لأمرُّ بالرجلِ مِثلِكَ فأُكْرِمهُ. وقال علي بن عيسى الرُّماني: إنما جاز أن يكون نَعْتاً «للَّذين»، لأن «الّذين» بصلتها ليست بالمعرفة المؤقتة كالأعلام نحو زيد وعمرو، وإنما هي كالنكرات إذا عُرِّفت، نحو الرجلُ والفرسُ، فلما كانت «الذين» كذلك كانت صفتها كذلك أيضاً؛ كما يقال: لا أَجلِسَنْ إِلاَّ إلى العالمِ غيرِ الجاهلِ، ولو كانت بمنزلة الأعلام لَمَا جازَ كما لم يجز: مررتُ بزيدٍ غيرِ الظريفِ، بالجرِّ على الصفة.
وقال أبو بكر السرّاج: والذي عندي أنَّ «غيرِ» في هذا الموضع ما أضيف إليه معرفة، لأنه حُكْمُ كلِّ مُضافٍ إلى معرفةٍ أن يكون معرفةً، وإنما تنكرت (غير ومثل) مع إضافتها إلى المعارف من أجل معناهما، وذلك أنك إذا قلت: رأيتُ غيرَكَ، فكلُّ شيءٍ تَرَى سوى المخاطب فهو غيرُهُ. كذلك إذا قلتَ: رأيتُ فعْلك، فما هو مثلُهُ لا يحصى. فأمَّا إذا كان شيءٌ معرفةً له ضدٌّ واحدٌ، وأردتَ إثباتَهُ ونَفْيَ ضِدِّهُ فعلم ذلك السامعُ فَوَصَفْتَهُ بـ (غير) وأضفت (غير) إلى ضده فهو معرفة، وذلك على نحو قولك: عليكَ بالحركة غير السُّكون، فغيرُ السكون معرفة وهي الحركة. فكأنك كررت الحركة تأكيداً فكذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [الفَاتِحَة: 7] فـ«غيرِ المغضوب»: هُمُ الذين أنعَمَ اللَّهُ عليهم. فمتى كانت «غير» بهذه الصفة فهي معرفة. وفي نصب «غيرَ» ثلاثةُ أوجهٍ أيضاً:
أحدها: أن يكون نصباً على الحال من المضمر في «عليهم»، والعامل في الحال «أنعمت»، فكأنه قال: صِراطَ الذين أنعمتَ عليهم لا مغضوباً عليهم.
وثانيها: أن يكون نصباً على الاستثناء المنقطع لأن «المغضوب عليهم» من غير جنس المُنْعَمِ عليهم.
وثالثها: أن يكون نصباً على أعني، كأنه قال: أَعني غيرَ المغضوبِ عليهم، ولم يَجُزْ أن يقال: «غيرَ المغضوبين عليهم»، لأن الضمير قد جُمِعَ في «عليهم» فاستغنى عن أن يجمع «المغضوب»، وهذا حكم كل ما تعدَّى بحرف جرِّ، تقول: رأيت القومَ غيرَ المذهوبِ بِهم، استغنيت بالضمير المجرور في «بهم» عن جمع المذهوب.
«ولا»: الواو: حرف عطف، و«لا» زائدة لتوكيد النفي على قول البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنَّ «لا» بمعنى غيرِ، ووجه قول البصريين أنك إذا قلت: ما قامَ زيدٌ وعمرٌو، احتملَ أن تريد ما قاما معاً، ولكن قام كل واحد منهما بانفراده، فإذا قلتَ: ما قام زيدٌ ولا عمرٌو، زال الاحتمال، و«غير» متضمِّنٌ معنى النفي.
وقال علي بن عيسى الرُّماني: من نصب على الاستثناء جعل «لا» صلةً، كما أنشدَ أبو عبيدة:
في بئرٍ لا حورٍ سَرَى وما شَعَر
أي في بئرٍ هلكةٍ، وتقديره: غيرِ المغضوب عليهم والضَّالين، كما قال: «ما منعك أن لا تسجد» بمعنى أن تسجد.
«الضالين» عطفٌ على «المغضوب عليهم»، والكوفيون يقولون: نَسَقٌ، وسيبويه يقول: إشراكٌ أي أشرك اللَّهُ سبحانه وتعالى الضالّين والمغضوبَ عليهم في صراطٍ واحدٍ خاصٍّ بهم هو غيرُ صراطِ المؤمنين، وهَمَزَ أيّوبُ السُّختياني فقرأ: «ولا الضَّأْلينَ». والأصل في «الضالّين»: الضالْلِينَ، ثم أُدغِمتِ اللامُ في اللامِ، فاجتمع ساكنان، وجازَ ذلك لأنَّ في الألف مَدَّةً، والثاني مدغم.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢