نبذة عن حياة الكاتب
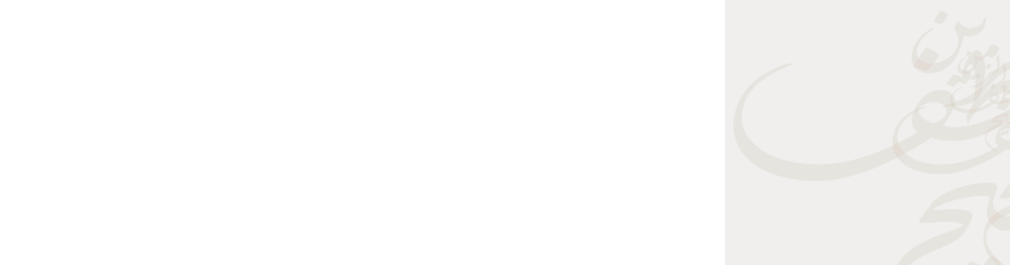
X
معجـم إعـراب مفـردات ألـفـاظ القـرآن الكريـم - الجزء الأول
المقدمة
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمدُ للَّهِ الذي لا يُحصي نَعماءَهُ العادُّون، ولا يؤدِّي حقَّهُ المجتهدون؛ الأولِ فلا شيءَ قبلَهُ، والآخرِ فلا شيءَ بعدَهُ، والظاهرِ فلا شيءَ فوقَهُ، والباطنِ فلا شيءَ دونَهُ.
هو الذي أرسل محمداً (صلّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) بالهدى ودينِ الحقِّ، وأنزلَ على قلبِهِ القرآنَ نوراً لا تُطفَأُ مصابيحُهُ، وسِراجاً لا يخبو توقُّدُهُ، وبحراً لا يُدرَكُ قعرُهُ، وجعلَهُ ريّاً للعلماء، وربيعاً لقلوب الفُقَهاءِ، ومحاجَّ لطُرُقِ الصُّلَحاء.. وهو ناطقٌ لا يعيا لسانُهُ، وبيتٌ لا تُهدَمُ أركانُهُ، وعزٌّ لا تُهزَمُ أعوانُه، وهو حُجّةُ الله على خلْقِهِ، الآمِرُ الزاجِرُ، والصامِتُ الناطِقُ..
النطق خاصيّة الإِنسان
وإِنَّهُ لمِنَ الأمورِ الطبيعيةِ التي حتَّمتْها أسبابُ الحياة، والبديهياتِ التي فرضتْها ظروفُ العيش، أن يحصلَ الاتصالُ بين الإِنسانِ والإِنسان، طالما أنَّهُ لا يُمكِنُ لأحدٍ أن ينفردَ بحياتِهِ، أو أن يَنزوِيَ بعيداً عن أبناء جنسِهِ، لعلَّةٍ جوهريةٍ وهِيَ حاجتُهُ إلى غيرِهِ في شتَّى شؤونِهِ وشجونِهِ، ولذا كان ذلك الاتصالُ مظهراً من مظاهر التكتُّلِ والاجتماعِ، ما دامتْ في الإِنسان غريزةُ حُبِّ البقاءِ، التي تَدفعُهُ للحفاظِ على وجودِهِ، والصِّراعِ من أجلِ بقائِهِ.
ومِنَ التكتلاتِ البشريةِ، والعلاقاتِ المصلحيَّةِ نشأتِ البيئاتُ المختلفةُ، والمجتمعاتُ المتنوِّعة. ومِنَ الخصائصِ التي أودعَهَا الخالقُ في الإنسانِ، وجعلَتْهُ يَتَمَيَّزُ عن سائِرِ المخلوقاتِ الحيةِ الأخرى، كانتِ الوسيلةُ الأجْدى التي تُمكِّنُهُ مِنَ التفاهُمِ مَعَ أبناءِ جِنْسِهِ، وإقامةِ العلاقاتِ مَعَ أبنَاءِ البيئاتِ الأخرى، الوسيلةَ الأساسيةَ والجذريةَ لذلِكَ وهِيَ النُّطقُ، يكيِّفُهُ لغةً تتنوَّعُ بتنوُّعِ الشعوبِ والقبائل وتتعدَّدُ بتعدُّدِ الأقاليمِ، وأنماطِ العيش، وتتناسَبُ واختلافَ أَلسِنَتِهِمْ وألوانِهِم. ولذلك لم يكُنْ خَلْقُ النُّطقِ، كخاصيّةٍ من خصائصِ الإِنسان، عَبَثاً، بل كان إحدى الآياتِ الكُبرى التي تَتَجلَّى فيها قُدرةُ الله تعالى في هذه الصناعة الدقيقةِ للإِنسان، وفيما خلق فيه من الأعضاء والجوارحِ التي يَقومُ كلٌّ منها بأداءٍ خاصٍّ أُعدَّ له، كما هي الحال في هذا اللِّسانِ الذي وَجَبَ أن يُظهرَ الأصواتَ المُعبِّرةَ عن النُّطقِ، ولذا قيلَ في التعارف إنَّ النُّطقَ يتمثّلُ بالأصواتِ المقطَّعةِ التي يُظهرُها اللسانُ، وتَعِيها الآذان، وذلك - حكايةً عن النبيِّ إبراهيمَ عليه السلامُ حينَما خاطَبَ الأصنامَ - بقولِهِ تعالى: {مَا لَكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ *} [الصَّافات: 92]. والنطقُ لا يَكادُ يُقالُ إلاّ للإِنسان، ولا يُقالُ لغيرِهِ إلاَّ على سبيلِ التَّبَعِ، نحو: الناطقُ والصامتُ، فيُرادُ بالناطقِ ما له صوتٌ، وبالصامتِ ما ليس له صوتٌ؛ ولا يُقالُ للحيوانات «ناطق» إلاَّ مقيَّداً، وعلى طريقِ التشبيهِ، كما في قول الشاعر:
عَجِبْتُ لَهَا أَنَّى يَكونُ غِنَاؤها
فَصِيحاً وَلَمْ تَفْغَرْ لِمَنْطِقِها فَمَا
والنطق - بالمفهوم الشامل - قد يعني أيضاً الدلائلَ الْمُخبِرَةَ والعِبَرَ الواعِظَةَ، فيقالُ للأشياءِ مثلاً إنها لا تنطِقُ كقوله تعالى: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنْطِقُونَ *} [الأنبيَاء: 65]. أي لقد علمتَ أنَّ الأصنامَ ليستْ من جنسِ الناطقينَ، والمقصودُ أنْ يربطَ النُّطقَ بالعقلِ، حتى يكونَ الكائنُ العاقلُ قادراً على التعبيرِ عمّا يختار مِنَ القولِ، ومِنْ ثَمَّ الفعلِ.
وأما قوله تعالى: {عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ} [النَّمل: 16]، فإنه سمّى أصواتَ الطيرِ نُطْقاً اعتباراً بسُليمانَ عليه السلامُ الذي كان يَفْهَمُهُ، فَمَنْ فهِمَ مِنْ شيءٍ مَعْنًى، فَذلك الشيءُ بالإِضافةِ إليه ناطقٌ، وإِنْ كانَ صامِتاً، وبالإِضافة إلى من لا يَفْهَمُ عنه صامِتٌ، وإنْ كانَ ناطقاً.
وقوله تعالى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} [الجَاثيَة: 29] يعني أن اللَّوحَ المحفوظَ ناطِقٌ، ولكنَّ نطقَهُ لا تُدركُهُ العينُ ولا تسمعُهُ الأُذنُ، كما أنَّ الكلامَ كتابٌ، لكنْ يُدركُهُ السَّمعُ. ويقول: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *} [فُصّلَت: 21]، وهو للتدليل على جَلالِ قُدْرَةِ الله تعالى التي تُودِعُ في الأشياء خصائِصَها وفقاً لما يُرادُ لها أن تَقومَ بِهِ، وعلى الوجهِ الذي يجبُ أنْ تؤدِّيَهُ، وأبرزُها - كما أشرنا إليه ـ خاصيَّةُ النُّطقِ عندَ الإِنسان، وقد شاءَ خالقُهُ أن يَجعلَهُ ناطِقاً حتى يكتمِلَ خلقُهُ البشريّ، ويكونَ على أَحسنِ صورةٍ وفي أحسنِ تقويمٍ.
وإنَّ خلقَ الإنسان - وعلى هذا النحو - يبيّنُ بوضوحِ أنه كانَ لا بُدَّ للإنسانِ مِنَ النطق، بل لم يجد الإِنسانُ بذاتِهِ، ما يعوِّضُ عَنْ هذا النُّطقِ بوسيلةٍ أُخرى يستخدِمُها في تقويمِ أمورِ حياتِهِ، أو تُساعدُهُ على تدبير شؤونِهِ. ولم تَكُنِ الوسائلُ الأُخرى كإشاراتِ التعبيرِ والرموزِ وغيرِها، لِتَفِيَ عَنِ النطقِ، أو تَفِيَ بالغرَضِ المطلوبِ، وحتَّى الكتابةُ التي عرَفَها في أولِ عهودِها، فقد انحسرَتْ في صورِها الأُولى من الرُّموزِ والأشكالِ، لتحلَّ محلَّها الحروفُ التي تجمع الكَلِمَ بأقلِّ الرسومِ، وأبسَطِ التَّصويرِ، وذلك بما يتوافَقُ - طبعاً - مع اللَّفظِ في مَخارِجِ الأَصواتِ.
وبما أن النطقَ، بوصفهِ خاصيةً مميِّزةً للإِنسانِ - واللَّفظُ هو تعبيرُهُ - فقد باتَ بحُكمِ الضرورةِ عدمُ إمكانيةِ استغناءِ الإِنسانِ عنهُ، فاسْتخدمَهُ ليشمَلَ جميعَ الموجوداتِ محسوسةً ومعدومةً، وجميعَ المعلومات مُمْكِنَةً أو مُمْتَنِعَةً، وذلك كلُّهُ بوضْعِ اللّفظِ إزاءَ ما أُريدَ مِنْ تلكَ المعاني، وبقَدَرِ ما يُعبَّرُ به عَمَّا في الذهنِ، كُلَّما خطرَتْ في نفسِ الإِنسانِ الخواطرُ أو جالتْ عندَهُ الأفكارُ، بلْ وكلَّما أرادَ أمراً مِنَ الأمورِ، أيّاً كانَ هذا الأمرُ.. فاللفظُ كان دائماً الْمُعينَ الأفضلَ الذي يُسعِفُهُ، والدليلَ الأقوى الذي يَقودُهُ.. ومن الدلالاتِ المعبِّرةِ على ذلك ما أَوصَى بهَ أحدُ الحكماءِ أبناءَهُ وهو يقولُ لهم:
«يا بَنِيَّ، أَصْلِحُوا ألسنِتَكُمْ فإنَّ أحَدَكُمْ تَنوبُهُ النائِبَةُ فيتجمَّلُ بها، فيَستَعيرُ مِنْ أخيه سيارتَهُ، ومن صديقِهِ قلمَهُ، ولكنَّهُ لَنْ يجِدَ أبداً من يُعيرُهُ لسانَهُ».
ومِنْ وقائع الحياةِ بكل تشعُّباتِها نَستقي أهميةَ النُّطقِ، وما له من تأثيرٍ على العلائِقِ والتعاملِ بشتّى أشكالِهِ وصورِهِ، إنْ على الصَّعيدِ الفرديِّ والمُجْتَمَعيِّ، وإنْ على الصعيدِ الداخليِّ والخارجيِّ.. ومن قبيلِ ذلك مَثَلاً أنَّهُ ما مِنْ إنسان مَلَكَ لسانَ قومٍ آخَرين، إلاَّ واستطاعَ أن يَختبرَ شؤونَ حياتِهِم، ويقِفَ على عاداتِهِم وتقاليدِهِم، ويتعرَّفَ إلى ما عندَهُم من قِيَمٍ وحضارةٍ، وفي ذلك ما فيه من تبادلٍ للمعارفِ، وإقامةٍ للعلاقاتِ بين الأفرادِ والشعوبِ، وفيه ما فيه من إغناءِ البشريَّةِ جمعاءَ بالعطاءِ والتنوّعِ والأَثرِ.
على أنَّ ما يَجْدُرُ التنبيهُ إليهِ هو أنَّ اللفظَ غيرُ الفِكر.. لأنَّ الفكرَ نحكُمُ به على الواقع بعدَ نقلِ هذا الواقعِ إلى الذهنِ بواسطةِ الحواسِّ مع وجودِ معلوماتٍ سابقةٍ تفسّرُهُ، بينما اللفظُ لم يوضَعْ للدلالةِ على حقيقةِ الواقعِ، ولا للحُكمِ عليهِ، وإنما وُضِعَ للتعبيرِ عمَّا في الذهنِ، سواءً جاءَ مُطابقاً للواقعِ أو مُخالفاً له.. ومِنْ هنا كانتِ اللُّغاتُ عبارةً عن الألفاظِ الموضوعَةِ لِلمعاني، إذ إنَّ دلالةَ الألفاظِ على المعاني التي أُريدتْ منها إِنما تُستفادُ مِنْ وَضْعِ الواضِعِ، فكانَ لاَ بُدَّ مِنْ معرِفَةِ الوَضْعِ أولاً، ثم معرفَةِ دلالةِ الألفاظِ... ولما كانَ الوضعُ هو تخصيصَ لفظٍ بمعنًى، ومَتى أطلِقَ اللفظُ أمكَنَ فهمُ المعنى، كان لا بُدَّ عندئذٍ مِنْ وضعِ اللُّغةِ سبيلاً للتعبيرِ عمّا في النفسِ، وأساساً للتفاهُمِ، بينَ أبناءِ الجنسِ البشريِّ.
فاللُّغةُ إذاً، هِيَ الألفاظُ المعبِّرةُ عَنِ المعاني، وبعبارةٍ أُخرى هِيَ كلُّ لفظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى، ولذلِك كانت اللُّغةُ اصْطِلاحاً، وأداةً للتفاهُمِ بينَ النَّاسِ...
مراحِلُ ظُهورِ اللُّغة
أما فيما يتعلَّقُ بالمراحلِ التي اجتازتْها لغةُ البشرِ، فَيَرى البعضُ أنَّ هذه اللُّغةَ نشأتْ ناقصةً، ساذجةً، مُبهمةً في نواحي أصواتِها ومدلولاتِها وقواعدِها، ثم سارتْ بالتدريجِ في سبيلِ الارتقاءِ.
وقَدِ اختلفَ الباحثون اختلافاً كبيراً في بيانِ المراحِلِ الأُولى لِلُّغةِ، وذَهَبَ بعضُهم إلى أنها سارتْ في ثلاثِ مراحلَ:
- مرحلةِ الصُّراخِ.
- مرحلةِ المدِّ: وفيها ظهرتْ أصواتُ اللِّين.
- مرحلةِ المقاطعِ: وفيها ظهرت الأصواتُ الساكِنَةُ.
ويعتمدُ أصحابُ هذِهِ النظريةِ في تأييدها على أمورٍ مُستمدَّةٍ مِنْ نُطقِ الطفلِ، ونُطقِ الأممِ البدائيةِ.
أما البعضُ الآخرُ فقد نَظَرَ إلى الموضوع من ناحية مفردات اللُّغةِ، ودلالةِ بعضِها على معانٍ جُزئيَّةٍ، وبعضِها الآخرِ على معانٍ كُلّيَّة... ورأى فريقٌ من هؤلاءِ، وعلى رأسِهِم (ماكس مولر)، أن اللُّغةَ الإِنسانيةَ بدأتْ بألفاظٍ دالَّةٍ على معانٍ كُليَّةٍ، ثم تَشعبتْ عن هذِهِ الألفاظِ الكلماتُ الدالةُ على المعاني الجُزئيةِ.. في حين تساءل فريقٌ منهم عن المراحلِ التي ظَهَرَ فيها كلٌّ مِنَ الاسمِ والصفةِ والفعلِ والحرفِ في الكلامِ الإِنساني؟!... وأشهرُ نظريةٍ بهذا الصددِ هي نَظريةُ العلاَّمةِ (ريبو) التي تقرِّرُ أنَّ الصفةَ هي أولُ ما ظهرَ في اللغةِ الإِنسانيَّةِ، ثم تَلَتْها أَسماءُ المعاني، وأسماءُ الذَّواتِ، ثم ظهرت الأفعالُ - وبظهورِها دخلتِ اللُّغةُ الإِنسانيةُ في أهمِّ مراحلِ رُقيِّها - ثم اختُتِمَتْ مراحلُ الارتقاءِ بظُهورِ الحروفِ..
هذا وقد بحثَ كثيرون في تطورِ اللُّغةِ الإِنسانيَّةِ من ناحيةِ ما يتعلَّقُ بقواعدِ الصرفِ والتنظيمِ. وأشهرُ من قالَ بهذه النظريةِ العلاّمةُ (شليجل) وتابَعَهُ فيها جَمْهرةٌ مِنْ علماءِ اللُّغة. وتُقسِّمُ هذهِ النظريةُ اللُّغاتِ الإِنسانيةَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
- القسم الأول: ويشتملُ على اللُّغات المتصرِّفةِ أو التحليليَّة، وهي تمتازُ بأنَّ معانِيَ كلماتِها تتغيَّرُ بتغيُّرِ أبنيتِها، وبأنَّ أجزاءَ الجُملةِ يتصِلُ بعضُها ببعضٍ بروابطَ مستقلة تدلُ على مختلفِ العلاقاتِ؛ ومن قبيلِها اللُّغةُ العربيةُ التي تتغيرُ معاني كلماتِها بتغيرِ بنْيَتِها: فيُقالُ: عِلْمٌ للدلالةِ على المصدر، عَلِمَ للدلالةِ على الفعلِ الماضي، وعَلَّمَ للدلالةِ على تعدِّي الفعل، واعْلَمْ للتدليلِ على الأمرِ، والعلوم للتدليلِ على جمْعِ العلْم، والمعلومُ لبيانِ ما وقع عليه العلم، والعلامةُ لتوضيحِ وسيلةِ العِلْمِ.. وهَلُمَّ جَرّاً... هذا مِنْ ناحيةِ الصَّرفِ.
أمّا من ناحيةِ التنظيمِ فإنَّ عناصِرَ جُمَلها يتَّصلُ بعضُها ببعضٍ عن طريقِ روابطَ مستقلةٍ تُشيرُ إلى مختلفِ العلاقاتِ، مثلُ الواو، من، إلى، وعلى إلخ... وما قيل في اللُّغةِ العربيةِ يُقالُ أيضاً في بقيةِ اللُّغاتِ المُتَصرّفَةِ أو التَّحْليليَّةِ مثلِ الفارسيةِ والهنديةِ واللاتينيةِ والإِغريقيةِ والجرمانيةِ والعبريةِ..
- القسم الثاني: ويَشتمِلُ على اللُّغات اللَّصْقِيَّةِ أو الوَصْلِيَّةِ، وتَمتازُ بأنَّ تَغَيُّرَ معنى الأصل وعلاقَتَهُ بما عَدَاهُ مِنْ أجزاءِ الجُملةِ يُشارُ إليها بحروفٍ تلصَقُ بذلك الأصلِ، وتُوضَعُ هذِهِ الحروفُ أحياناً قَبْلَهُ فُتسمَّى (سابِقةً Préfixes ) وأحياناً بَعْدَ الأصلِ فتُسمَّى (لاحِقةً Suffixes)، وبعضُ هذِهِ الحروفِ ليس له دلالةٌ مستقلةٌ، كانَ معظمُها في الأصل كلماتٍ ذات دلالةٍ ثُمَّ فقدتْ معانيها وأصبحتْ لا تُستخدمُ إلاَّ للمُساعدةِ على تغيُّرِ مَعنى الأصلِ الذي تُلصَقُ بِهِ، أو للإِشارةِ إلى علاقتِهِ بما عَداهُ مِنْ أَجزاءِ الجُملة.. ومنْ أشهر لُغاتِ هذا القسم اللغةُ اليابانيةُ، والتُّركيةُ، والمنغوليةُ، والمنشوريةُ ولغات الباسكِ، وبعضُ لغاتِ الأممِ القديمةِ (كالأيروكوا Iroquois ) و(البنتوس Bantous )... إلخ..
- القسم الثالث: ويَشتمِلُ على اللغاتِ غير المُتصرفةِ أو العازلةِ، وهِيَ تَمتازُ بأنَّ كلماتها غيرُ قابلة للتصرُّفِ - كما يَدُل عليها اسْمُها - لا عَنْ طريقِ تغييرِ البنيةِ، ولا عَنْ طريقِ لَصْقِ حُروفٍ بالأصْلِ، فَكُل كلمةٍ تُلازِمُ صورةً واحدةً وتدُلُّ على معنًى ثابتٍ لا يَتغيرُ... وتمتازُ بعدَم وجودِ روابطَ بينَ أجزاءِ الجُملةِ، للدلالةِ على وظيفةِ كل منها وعلاقتِهِ بما عَداهَ، بَلْ تُوضَعُ هذه الأجزاءُ بعضُها بجانبِ بعضٍ، وتُستفادُ وظائِفُها وعلاقاتُها من ترتيبها أو مِنْ سِياقِ الكلامِ... ومِنْ هذِهِ اللغاتِ اللغة الصينيةُ، والساميةُ، والتيبتيةُ، وكثيرٌ من لغاتِ الأممِ البِدائيةِ.
عِلْـمُ اللُّـغـة
وفيما يعودُ إلى علمِ اللُّغةِ فإنَّ عنايةَ الباحثينَ بهذا العلمِ اتَّجهتْ إلى كشفِ القوانينِ التي تَخضعُ لها الظواهرُ اللُّغويةُ في مختلفِ أشكالِها ومناحِيها. وقد اهتدَوْا إلى طَائفةٍ كبيرةٍ من هذه القوانين، منها ما يتعلَّقُ بالأصواتِ، ومنها ما يتعلَّقُ بالدلالاتِ، ومنها ما يتعلَّقُ بحياةِ اللُّغةِ، ومنها ما يتعلَّقُ بوظائِفِها... وبعضُ هذه القوانين خاصٌّ ينطبقُ على لغةٍ معيَّنةٍ، وبعضُها عامٌّ يَصدُقُ على فَصِيلَةٍ معيَّنة مِنَ اللُّغاتِ، وبعضُها أعمُّ يَشملُ جميعَ اللُّغاتِ.
وإنَّه في ضوءِ هذهِ القوانين، لا تسيرُ الظواهِرُ اللغويةُ وفقاً لإِرادةِ الأفرادِ والمجتمعات، أو تِبْعاً للأهواءِ والمُصادفاتِ، وإنَّما تسيرُ وفقاً لنواميسَ لا تقلُّ في ثباتِها وصراحتِها واطِّرادِها وعدم قابليتِها للتخلُّف، عن النواميسِ التي تخضعُ لها ظواهرُ الفَلَك والطبيعةِ، فقد يكونُ باستطاعةِ الفردِ أو باستطاعةِ الجماعةِ اختراعُ لفظٍ أو تركيبٍ، ولكنْ لمجرَّدِ أنْ يُقذَفَ بهذا اللفظِ أو بهذا التركيبِ في التداولِ اللُّغويِّ، وتتناقلهُ الألسنُ، فإنه يفلتُ من إرادة مُخترعِهِ ويخضعُ في سيرِهِ وتطوّرِهِ وحياتِهِ لقوانينَ ثابتةٍ صارمةٍ لا يستطيعُ الفردُ ولا الجماعةُ تعويقَها أو تغييرَها.. وعلى هذا فإنه ليس في قدرة الأفرادِ أو الجماعاتِ أن يُوقفوا تطوُّر لُغةٍ ما، أو يَحُولوا دونَ تطورِها على الطريقةِ التي تَرسمُها قوانينُ اللُّغة.. ومهما أجادوا في وضْعِ معجماتٍ لها، وتحديدِ ألفاظِها ومدلولاتِها، وضبطِ قواعدِها وأصواتِها وطريقةِ كتابتِها، ومهما بذلُوا مِنْ قوة في محاربةِ ما قد يطرأ عليها من لحنٍ أو خطأٍ أو تحريفٍ.. فإنها لا بدَّ من أن تفلت مِنْ هذهِ القيودِ، وتسيرَ في السُّبُلِ التي تحمِلها على السيرِ فيها سُنَنُ التطورِ والارتقاءِ التي ترسمُها قوانينُ اللُّغة.
وإنَّ مَنْ يرجِعْ إلى بحوثِ علمِ اللُّغةِ وموضوعاتِها وأَغراضِها وقوانينِها، يَجِدْ أنَّ تلكَ البحوثَ هِيَ من العلومِ، وأنها بالتحديدِ مِنْ فصيلةِ علمِ المُجتمع..
أما أنها من العلوم، فذلك لأنها ترمي من وراءِ دراستِها للظواهر اللُّغويةِ إلى أغراضٍ تحليليةٍ ترجعُ إلى الوقوف على حقيقتِها والعناصر التي تتألَّفُ منها، والوظائفِ التي تؤدِّيها، والعلاقاتِ التي تربطُها ببعضِها وتربطُها بما عداها، وأساليبِ تطورِها.. وبالجملة فهيَ تدرسُ الظواهرَ اللغويةَ لشرحِ ما هُوَ كائِنٌ، لا لبيانِ ما يَنبغي أنْ يكونَ.. وهذا هو شأنُ كلِّ عِلْمٍ.
وأما أنها مِنْ علوم المجتمعِ فذلك لأن موضوعَ هذِهِ العلومِ هو دراسةُ العلاقاتِ التي تتكونُ بين أفرادٍ يضمُّهم مجتمعٌ واحدٌ.. فالنُّظُم التي يَسيرُ عليها أفرادُ أمَّةٍ ما، في تفاهُمِهِم والتعبيرِ عمّا يجولُ بخواطرهِمِ، لا تختلفُ في هذِهِ الناحيةِ عَنِ النُّظُمِ الاقتصاديةِ التي يَسيرون عليها في مُبادلاتِهِمِ، والنُّظُمِ الدِّينيَّةِ التي يَتَّبعونَها في عباداتِهِم وعقائِدِهِم وفهمِهِم لِمَا وراءَ الطبيعةِ، والنُّظُمِ الخُلُقِيَّةِ التي يَتراضَوْنَها، والنُّظُم العائليةِ التي يخضعون لها، والنُّظُمِ السياسية التي يحتذونَها. فكما أن كُلاًَّ مِنْ تلكَ النُّظم - اقتصاديَّةً كانتْ أو سياسيَّةً مثلاً - تنظِّمُ ناحيةً من العلاقاتِ في المجتمع، كذلك النُّظُمُ اللغويةُ تنظِّمُ ناحيةً هامةً من تِلكَ العلاقاتِ، وهي الناحيةُ المتصلةُ بالتفاهُمِ بينَ الأفرادِ، والتعبيرِ عن تطلعاتِهِم وأفكارِهِم ورغباتِهِم... إلخ..
نَشْأةُ اللُّغَةِ العربيَّةِ الْفُصْحَى
واللُّغُة العربيَّة لا تختلفُ عن أيةِ لُغةٍ أخرى من حيثُ وضعها.. ويردُّ الباحثون نشأتها وتكاملَها إلى هجرةِ بعضِ القبائلِ اليمنيَّةِ إلى الحجاز، وإقامتِهم هناك. ومن تلك القبائلِ (جُرْهُمُ) التي تزوَّجَ منها إسماعيلُ - عليه السلام - الذي كان أبناؤهُ نواة العربِ المستعربةِ حوالي 1900ق.م. ويشيرُ الباحثون إلى اندماج اللُّغةِ اليمنيَّةِ باللُّغةِ العربيةِ بعد انهيارِ سدٍّ مأربَ سنة 115ق.م. وهجرةِ اليمنيين بلسانِهم وحضارتِهم إلى مكةَ والمدينةِ، وتَغَلغلِهِم في بلادِ العدنانيين ومُخالطَتِهم، بعدَ أن حَمَلُوا معهم لغتَهم السبئيَّةَ أو الحميريَّةَ وما بها من كلماتٍ جديدةٍ ليس للعدنانيِّين بها عهدٌ؛ وأدّى ذلك الاختلاطُ الشديدُ إلى انْدماجِ اللُّغتينِ وتكوينِ لغةٍ واحدة يفهمُها الجميعُ. وظلت اللُّغتان تَتَفاعلانِ مدى خمسةِ قرونٍ، ثم تكوَّنتْ منهما لُغةٌ واحدةٌ هي التي جاءَ بها الشعرُ الجَاهليُّ كلُّهُ.
ومِن مميِّزاتِ اللُّغةِ العربية ليس الاصطلاحُ على وضعِها من حيثُ هِيَ وحسبُ، بل ذلك العملُ الذي أدَّى إلى انتقاء ألفاظِها وجعْلِها سَلِسةً، غايةً في الطواعيةِ والانقيادِ للذهنِ واللسانِ.. وقد حصلَ ذلك عندما كانت الوفودُ تأتي من مختلفِ أنحاءِ شبهِ جزيرةِ العربِ في مواسمِ الحجِ إلى مكة، وتجتمعُ في سوقِ عُكاظ أو ذي المَجنَّةِ وغيرِهِما، ثم تتبارَى في الشعرِ والخطابةِ، لتعودَ وتنزلَ على حُكمِ قريشٍ، وذلك لعلْمها أنَّ ما يقولُهُ القرشيُّون هو أفصحُ اللِّسَانِ العربيِّ، وأشدُّهُ بلاغةً، وأكثرُهُ متانةً.
وكانتْ تلكَ الوفودُ تستعدُّ قبل مجيئها، فتختارُ أعذبَ الألفاظِ لأَشْعَارِها، وأقوى المعاني لما تَشتركُ فيه بالمباراةِ، وغايتُها أن تنالَ السبقَ على غيرها، وتفوزَ بالحكمِ لصالِحِها.. وهذا كُله أدَّى إلى انتشارٍ واسعٍ للألفاظِ، وما حملَتْهُ من معانٍ رقيقةٍ، وصورٍ بيانيَّةٍ معبِّرةٍ... ولم تقتصرِ الفائدةُ على القبائلِ في تهذيبِ لهجاتِها، بل إنَّ قريشاً نفسها أفادتْ كثيراً من ذلك، إذ كانتْ تأخذُ خيرَ ما تراهُ في تلك اللَّهجاتِ، وأجملَ ما تحتويهِ، ثم تُضيفُهُ إلى ما عندَها من فصيحِ الكلام، حتى بلغتْ ذلك الأثرَ الكبيرَ في صَقلِ اللُّغةِ وتهذيبِها، وصارتْ لغتُها أمَّ اللهجاتِ ولغةَ العرب الفُصْحَى، بدليلِ قولِ العرب بأنَّ النبيِّ: «هو أفصحُ العرب، بَيْدَ أَنّه مِنْ قُريشٍ، وهو أفصحُ مَن نطقَ بالضَّاد...».
هكذا كانتِ اللغةُ العربيةُ قبلَ الإِسلام، وقد وصفَها (بروكلمان) فقال بأنها: «تتميَّزُ بثروةٍ واسعةٍ في الصورِ النحوية، وتُعدُّ أرقى اللُّغاتِ الساميةِ تطوراً مِنْ حيثُ تراكيب الجُمَل ودقة التعبيرِ؛ أما المفرداتُ فهي فيها غنيَّةٌ غِنىً يَسترعي الانتباه. ولا بِدْعَ فهِيَ نهرٌ تصبُّ فيه الجداولُ من شتَّى القبائِلِ، حتى بَهَرَ ثراؤها عُلماءَ اللُّغةِ ومؤلِّفي المعاجِمِ، وصارَ هذا البدويُّ القويُّ الملاحظَةِ، قادراً على أن يصوِّرَ بلغتِهِ كل دقائقِ الحياةِ الصحراويةِ والصفاتِ والحيوانِ، وكلَّ ما عدا ذلكَ من الأمورِ الواقِعِيَّةِ والحياتِيَّةِ».
اللُّغةُ العربيَّةُ غيرُ تَوْقِيفِيَّة
إنَّ التركيبَ الأساسيَّ لِلُّغة العربيَّة - الذي هو غايةٌ في القوةِ بحيثُ استطاعتْ أن تحملَ رسالةَ السماءِ، وكلماتِ الله، وأن تؤدِّيَ ذلك كلَّهُ للبشرِ على نحوٍ غايةٍ في القُدرة والاقتدارِ - قد جعلَ البعضَ يعتبرُ أنها ليستْ من اصطلاحِ العربِ ووضْعِهم، بل هِيَ توقيفِيَّةٌ مِنْ عندِ الله سبحانهُ وتَعالى؛ ويُسندُ هذا البعضُ رأيهُ إلى النصِّ القرآنيِّ الكريم: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البَقَرَة: 31].
إنَّ هذا الاعتقادَ يخرجُ ولا شكَّ، عن كل ما هو متعارفٌ عليه بالنسبة إلى وضع اللُّغات والاصطلاح عليها، ويدخلُ في ذلك طبعاً اللُّغة العربية.. كما أنَّ هذا الاعتقاد لا يتفقُ أبداً مع المعنى الذي أُريدَ مِنَ النصِّ القرآنيِّ.. ذلك أنَّ ما أُريدَ منه هُوَ تعليمُ آدمَ مسمَّياتِ الأشياءِ، أي تعليمُهُ حقائِقَ الأشياءِ وخواصَّها، وإعطاؤهُ المعلوماتِ التي يمكنُهُ أن يستعملَها للحُكم على الأشياء.. وهذا أمرٌ بديهيٌّ لأنَّ الإِحساسَ بالواقع لا يَكفي وحده للحُكم عليه وإدراكِ حقيقتهِ، بل لا بدَّ مِنْ معلوماتٍ سابقةٍ كي يُمكِنَ أنْ يُفَسَّرَ بها هذا الواقعُ.
وإنَّ الله - سبحانَه وتَعالى - عندما علَّمَ آدمَ الأسماءَ، قد علَّمهُ مسمَّياتِ الأشياءِ التي يُحِسُّها، وأعطاه المعلومات التي يُفسِّرُ بها واقعَ تلكَ الأشياء، وإذا نَزَل تعبيرُ القُرآنِ بكلمةِ «الأسْماءَ» فإنَّ هذه الكلمةَ مقصودٌ بها «المسمَّياتُ» أي أنَّ القرآنَ الكريمَ أطلقَ الاسمَ، وهُوَ قد أرادَ المُسَمَّى، كما يَدُلُّ على ذلِكَ الواقعُ..
وعلى هذا فإنَّ آدم عليه السلام عرَفَ الأشياءَ ولم يعْرِفِ اللُّغاتِ. وكل ما تُعرَفُ ماهيتُهُ، ويُكشَفُ عن حقيقتِهِ يكونُ محلاًَّ للتعليم والمعرفة.. ولما كانت اللُّغةُ وسيلةً للتعبير وحسبُ، فإنَّ سياقَ النصِّ القُرآنيِّ يُوحي بَأنَّ المُرادَ من تعبير «الأسماءَ كلَّها» إنما هو «المُسمياتُ» أي حقائقُ الأشياءِ وخواصُّها.
ولما كان آدم عليه السلام في خَلْقِهِ وإيجاده، وبما جَرى عليه صُنْعُهُ من دقةٍ وضبطٍ في جميع أجزائه، قادراً بعد نَفْخِ الرُّوحِ فيه، وبعد تعليمِهِ من ربِّهِ، على أن يربِطَ عن طريقِ الدماغِ ما بينَ الوقائعِ والمعلوماتِ التي أُعطيها، فإنه صارتْ لديْهِ - بنتيجةِ هذا الربطِ - القدرةُ على فَهمِ حقائقِ الأشياءِ، ومِنْ ثَمَّ تَسمِيَتِها..
وأما قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ} [الرُّوم: 22] - أي لُغاتِكُمْ - فلا يَعني أنَّ اللُّغاتِ هي مِنْ وَضْعِ الله تعالى، بل يعني أنَّ من الأدلةِ على قُدرةِ الله - سبحانَهُ - في خلْقِهِ، أن جَعلَ بني آدم على لُغاتٍ مختلفة، وأنَّ حكمتَهُ - جلَّ وعَلا - في ذلك يُبرزُها قولهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ *} [الحُجرَات: 13].
فالله سبحانَهُ وتعالى جعل للبشر - جميعاً - نظاماً واحداً هو نظامُ الزوجيَّة (من ذكر وأنثى) ولكنه مع وحدةِ هذا النظامِ، فرَّق الناس شُعوباً عديدةً، وعلى ألسنةٍ متنوعةٍ، ولُغاتٍ مختلفة، تصطلحُ كل جماعةٍ على لسانٍ، وتضعُ لُغَةً خاصَّةً بها، ثم يأتي الاختلاطُ بينَ الناسِ، وتتمُّ معرفةُ ما عندَ بعضِهم البعْضِ، فينشأ مِن جَرَّاءِ ذلك كلِّهِ: التبادلُ والتعاونُ، وتَتمُّ عمارةُ الأرض... تلكَ هي الإِرادةُ الرَّبانِيَّةُ السنيةُ التي شاءتْ أنْ تجعلَ الناسَ شعوباً وقبائلَ، حتى يكونَ التنوعُ أساسَ العُمرانِ، والاختلافُ أصلَ البُنيانِ، والتمازُجُ سبيلَ التقدمِ والارتقاءِ.
وأما الدليلُ القاطعُ، الذي لا سبيلَ لتأويلِهِ، على أنَّ اللُّغاتِ كلَّها، ومنها اللُّغةُ العربيةُ، هي من اصطلاح الناس وَوَضْعِهمْ، فهو أنه لو كانتْ أيَّةُ لغةٍ منها - العربيةُ أو غير العربية - توقيفيَّة من عند الله سبحانه وتعالى، فإنَّ الحكمة والعدل يقضيان بأن تكونَ سائرُ اللُّغاتِ الأخرى توقيفيَّةً أيضاً، ولَوَجَبَ من جرَّاء ذلك تقدُّمُ بعثةِ الرسلِ على معرفةِ اللُّغاتِ، أي أنْ يُبعَثَ رُسُلٌ خاصَّةً كي يعلِّموا النَّاسَ اللُّغَة التي يُريدُها الله لكل قبيلٍ مِنْ هؤلاءِ الناسِ، ثم يتولَّى هؤلاءِ الرُّسلُ أنفسُهُمْ، أو يُكلَّفُ غيرُهُم بتبليغِ رسالاتِ ربِّهم في الدِّينِ والعبادةِ والتعامُلِ... وإنَّهُ لمِنَ الثابتِ أن البعْثَة كانت دائماً للنَّاس وهم ناطقون - وبأكمل النطقِ وأتمِّهِ، أي لإِنسانٍ كان يتكلَّمُ وعندَهُ لغتُهُ الخاصةُ به، وكان الرسولُ يُبعَثُ لكل قومٍ بلسانِ هؤلاءِ القوم بدليلِ ما قرَّرَهُ الباري، عزَّ وجلَّ، في مُحْكَمِ كتابِهِ الكريم: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4].
وهكذا صار من الثابت لدينا أن اللُّغةَ - أيةَ لُغةٍ - ليستْ توقيفيَّةً عن طريقِ الوَحْيِ، بل هِيَ مِنْ وَضْعِ الإِنسانِ، وبما اصْطَلَحَ عليه أبناءُ جِنسٍ واحدٍ، أو أمةٍ واحدةٍ مِنَ الناسِ...
رقيُّ اللُّغة العربية وانتشارُها
إنَّ اللغاتِ التي اتصلتْ بالعربيةِ هِيَ السريانيةُ والعبريةُ والفينيقيةُ والآشوريةُ والبابليةُ والحبشيةُ. وفي وقتِ نزولِ القرآنِ الكريمِ وظهورِ الإِسلامِ كانتِ القبطيةُ في مصر، والبونيفيةُ في الشمالِ الإفريقي، والنبطيةُ في العراقِ، وكانتْ هناك أيضاً الفارسيةُ القديمةُ في فارسَ، والروميةُ في الشامِ.
ومن مقارنة هذه اللُّغات بالعربيةِ (أو بعضِها مثلِ الكلدانيةِ والآشوريةِ والفينيقيةِ والعِبْريةِ) يظهرُ الفرقُ البعيدُ والبوْنُ الشاسعُ بين كمالِ العربيةِ ووضوحِها، وفقرِ اللُّغاتِ الأخرى وغموضِها. ويرجعُ سببُ ذلك إلى «عراقَةِ اللُّغةِ العربيةِ وقِدَمِ تطورِها حيثُ بلغتْ مرتبةَ الكمال والنُّضجِ عندما كانتِ اللُّغاتُ الساميةُ الأخرى في أوائلِ مراحِلِ التطوُّرِ».
وإذا كانتِ اللُّغةُ العربيةُ، بالمقارنةِ مع اللُّغاتِ الأخرى الشقيقاتِ، هِيَ الأرْقى، فإنَّ لغة قريشٍ كانتْ بدورِها أرقى لهجاتِ اللغةِ العربيةِ، وهِيَ التي نَزَلَ بها القرآنُ الكريمُ.
وإنَّ في هذه العربيةِ منَ القوة والرَّونقِ والجمالِ ما لا يَخْفى على أحدٍ، إنْ أرادَ الوقوفَ على مكنوناتِها، ومعرفة سرِّ الوَضْعِ فيها.. ومن يَفْقَهِ الطريقةَ التي مَشَى عليها الواضِعُ في صِياغة أصولِها، وكيفَ أحسنَ التفريعَ على تلكَ الأصولِ، مع مُراعاةِ التناسُب بينَ كلِّ أصلٍ وفرعِهِ، لا يملك نفسَهُ عَنِ الإِعجابِ بذهنِ العربِ الشفَّافِ الذي عرَفَ كيفَ يحوِّلُ الكلماتِ الجامدةَ، إلى حياةٍ نابضةٍ مما ألبَسَها حُلَلَ الكمالِ، وإلى درجةٍ لم تتغيَّر معها أيَّ تغيُّرٍ يُذكرُ، حتى أنها لم تُعرفْ لها في كل أطوارِ حياتِها، لا طفولةٌ ولا شيخوخة، ولا نكادُ نعلمُ من شأنِها - كما يقول «إرنست رينان» صاحبُ كتابِ «التاريخُ العامُّ لِلُّغاتِ الساميةِ» - إلاَّ فتوحاتِها وانتصاراتِها التي لا تُبارَى، ولا نعلمُ شَبَهاً لهذهِ اللغةِ التي ظهرتْ للباحثينَ كاملةً من غيرِ تدرُّجٍ، وبقيتْ حافِظةً لكيانِها خالصةً مِنْ كل شائبةٍ.
ويقول رينان:
لقد استفاضَ انتشارُ اللُّغةِ العربيةِ فاستولتْ على أوسعِ المسافاتِ وأبعدِ البُلدانِ. أجلْ لقد كانَ لليونانيةِ واللاتينيةِ مثلُ حظِّها أنْ تُصبحا لُغتيْنِ عالمِيتَيْنِ تذيعانِ عقيدةً دينيةً، وتنشُران أنظمةً سياسيةً تغلبتْ على تبايُنِ الشعوبِ والأجناسِ والمشاربِ في توحيدِ الكلمةِ وتعريفِ الغاية، فشاعتِ اللاتينيةُ من إسبانيا إلى الجُزُرِ البريطانيةِ، ومن نهرِ الرّينِ إلى جِبال الأطْلسِ، وشاعتِ اليونانيةُ مِنْ صقلِيةَ إلى شواطىءِ دِجْلَةَ والفراتِ، ومن البحرِ الأسودِ إلى بلادِ الحبشةِ، ولكنْ ما أضْأَلَ هذا الانتشارَ إذا قوبِلَ بانتشارِ اللُّغةِ العربيةِ التي تناولتْ إسبانيا والقارةَ الإفريقيةَ حتَّى خطِّ الاستواءِ، وسيطرتْ على آسيا الجنوبيةِ حتَّى «جاوه» واقتحمتْ جميعَ دولِ البلقانِ.
وليسَ هذا الانتشارُ وحسبُ هُوَ ما امتازتْ به اللُّغةُ العربيةُ، بل إنَّ لها طريقةً عجيبةً في التوليدِ والاشتقاقِ، جعلتْ آخِرَ هذه اللُّغةِ يتصلُ بأولِها في نسيجٍ ملتحقٍ من غير أن تذهبَ معالِمُها، أو أن يُبْهَمَ على الأجيالِ ما خلَّفَهُ السلفُ من تُراثِها، فإذا أخذْنا مثلاً كلمة «كَتَبَ» واشْتَقَقْنا منها كاتِباً وكِتاباً ومكتبةً ومكتوباً ومَكْتَباً، وجدنا أنَّ الحروفَ الأصليةَ موجودةٌ في كل كلمةٍ من هذه الكلماتِ المشتقَّةِ، وأن معنى الكتابةِ موجودٌ كذلك، على عكسِ اللغاتِ الأوروبيةِ حيثُ لا توجدُ في كثيرٍ مِنَ الأحيانِ صلةٌ ما بينَ كلماتِ الأُسرةِ الواحدةِ و«كَتَبَ» في الإنجليزية (Write) والكتابُ (Book) ومكتبةٌ (Library) ولا علاقةَ بينَ حروفِ هذه الكلماتِ. وهذا ما جعلَ لغةً مثلَ الإنجليزيةِ تختلفُ من جيلٍ إلى جيلٍ ولا توجدُ تلك الصلةُ اللغويةُ بين ماضِيها وحاضِرها، فلغةُ «شكسبيرَ» وهُوَ مِنْ أدباءِ القرنِ السابعَ عَشَرَ لا تَكادُ تُفهمُ عندَ جمهرةِ المثقفينَ اليومَ، اللَّهمَّ إلاَّ المختصِّينَ في الأدبِ الإنجليزيِّ، وهذا يَرجعُ إلى اختلافِ النطقِ وتطورهِ من جيلٍ إلى جيلٍ، وإلى نموِّ اللُّغةِ بطريقةٍ مختلفةٍ عن طريقةِ الاشتقاقِ العربيِّ، وإلى انقطاعِ الصلةِ بين كلماتِ الأسرةِ الواحدةِ في أغلب الأحيانِ.
محاولاتُ القضاء على اللُّغة العربية
كانتِ اللُّغةُ العربيةُ بعيدةَ الأثرِ في اللغاتِ المعاصرةِ للإِسلام: شرقيةٍ وغربيةٍ، وتجلَّى هذا الأثرُ بالإِحياءِ والاستمرارِ كما حدثَ لِلُّغاتِ: التركيةِ والفارسيةِ والسواحليةِ، أو بالإِفناءِ والإِبادةِ كما حدث لِلُّغات: القبطيةِ والسريانيةِ والعبريةِ، أو بدخولِ مئاتِ الألفاظِ إليها كما حدث لِلُّغاتِ الغربية: الإنجليزيةِ والفرنسيةِ والإسبانيةِ.
وهذا الأثرُ ناتج من أنَّ اللغةَ العربيةَ لغةُ اشتقاقٍ تَقومُ على أبوابِ الفعْلِ الثُّلاثيِّ التي لا وُجودَ لها في جميعِ اللغاتِ الهِنديةِ والجرمانيةِ، وهي اللغاتُ التي تُكتَبُ بالحروف اللاتينية. فإذا قابلْنا العربيةَ باللغاتِ الاشتقاقيةِ كالإِنجليزيةِ والفرنسيةِ نجد أنَّ العربيةَ امتازتْ بخصائِصَ أكفلَ بحاجةِ العلوم، فمِنْ ذلك سعتُها، فعددُ كلماتِ كلٍّ مِنَ الفرنسيةِ والإنكليزيةِ لا يكادُ يزيدُ على مئةِ ألفِ كلمةٍ، أما العربيةُ فعدَدُ موادِّها 400 ألف مادة (لا كلمة)، ومعجم لسان العرب يحتوي على 80 ألف مادة، ومواد اللغة العربية تتفرعُ إلى كلماتٍ. فإذا فرضْنا أنَّ نصفَ موادِّ المُعجم متصرفةٌ، بلغَ عددُ ما يُشتقُّ منها نصفَ مليونِ كلمةٍ، وليس في الدنيا لغةٌ اشتقاقيةٌ أخرى غنيةً بكلماتِها إلى هذا الحدِّ. وبسببِ غِنى العربيةِ وسَعَتِها تجدُ فيها للمعاني - ذواتِ التقارُبِ الشديدِ - كلماتٍ خاصَّةً بكلِّ معنىً مهما كانتْ درجةُ التفاوتِ. هذا وهيَ تَحْسَبُ حسابَ الفِكرةِ والخاطر والمِثالِ، فضلاً عن تميُّزِها بتنوعِ الأساليبِ والعباراتِ. إذ إنَّ المعنى الواحِدَ يُمكنُ أنْ يُؤدَّى بتعبيراتٍ مختلِفةٍ: كالحقيقةِ والمجازِ والتصريحِ والكِنايةِ.
ومِنَ الغريبِ، أنه على الرغمِ من تلكَ المميزاتِ لِلُّغةِ العربية، قد وَجَدْنا منذُ أواخرِ القرنِ الماضي دعواتٍ مغرِضةً، حاقِدَةً، لم يتورَّعْ أصحابُها عن حملِ معاول الهدمِ لتقويضِ صُروحِ اللغةِ العربيةِ الفُصْحى، والقضاءِ عليها.
وقد حملَ لواءَ تلك الدعواتِ الاستعمارُ بأشخاصٍ من بلادِهِ أوكلَ إليهم تلك المهمة، وبأذنابٍ له من بلادِ الإِسلام استأجرَهُم لتلكَ الغايةِ... فمنذُ أنْ قَدِمَ الاستعمارُ إلى العالمِ الإسلامي كانَ في أهدافِهِ عملٌ واضحٌ، متكاملُ الخطةِ في مواجهةِ اللغةِ العربيةِ وتوسعِها، وذلك بتجميدِها وإيقافِها، واتخاذِ الوسائِل - كلِّ الوسائلِ - لتحقيقِ هذا التجميدِ، وهو عملٌ مُمَهِّدٌ لغايةٍ هِيَ أكبرُ وأهمُّ عند أصحابها.
هَدْمُ قِيَمِ الفصحى ومفاهيمها
وإنَّ السنواتِ الخمسينَ والمئةَ الأخيرةَ تكشفُ عن ذلك بعلاماتٍ واضحةٍ وأدلةٍ صادقةٍ. فقد استطارتْ في ظلِّ الاستعمارِ الدعوةُ إلى العاميَّةِ، واللهجاتِ المحليةِ، واللُّغاتِ القديمةِ والحروفِ اللاتينيةِ؛ وظهرتْ كتاباتٌ مختلفةٌ تُحاولُ أنْ تُجدِّدَ ما اندرسَ مِنَ اللُّغات القديمةِ كالقبطيةِ في مصر مثلاً، إذْ ظهرَ من يهتمُّ بجمعِ الكلماتِ العربيةِ العاميةِ التي لها أصلٌ قبْطيٌّ، وتعالت الصيحاتُ بدعوةِ المصريينَ إلى الْتِماسِ لُغتِهِمِ القديمةِ، بل إنَّ منهم من قال بأنَّ اللُّغةَ العربيةَ لغةٌ أجنبيةٌ، وأنهُ يجبُ أن تعودَ مصر إلى لُغتِها القديمةِ.
وتلك الحربُ التخريبيةُ التي شنَّها الأجنبيُّ على اللُّغةِ العربية، اعتمدَ فيها على القوى الرسميةِ التي يمتلكُها في داخلِ بلادِ العَرَبِ، أو - على الأقل - على تلك التي يُسيطرُ عليها، من أجل الوصول إلى تحقيقِ مآربِهِ الاستعماريةِ... ووسيلَتُهُ لذلك التعليمُ والمدرسةُ.. فقد كانتِ الخطةُ تَستهدفُ طَرْدَ اللُّغةِ العربيةِ - في العالم الإِسلامي كلِّهِ - من المدارس والجامعاتِ، وذلك بجعْلِ الدراساتِ كلِّها باللغاتِ الأجنبيةِ، وإحياءِ اللهجاتِ، ودَفْعِها بقوةٍ حتى تصبح لغَةَ التداول والتعلّم والكتابة، ابتداءً بالصحافة، ومروراً بالكتاب المدرسي والأدبيّ والعلمي انتهاءً إلى الكتابِ الدينيّ!!.. فالدَّور الذي قام به القسُّ (دوجلاس دنلوب) المستشار الإِنجليزي في وزارةِ المعارفِ المصريةِ كان واضحاً عندما اضطهدَ مدرِّسي اللغةِ العربيةِ في مصرَ ورجالها، وعمِلَ على إلغاءِ المقرَّراتِ والكتبِ التي كانت تُدرَّسُ قبلَ الاحتلالِ واستبدال أخرى بها، وكلُّ ذلكَ في سبيلِ إضعافِ اللغةِ العربية، توطئةً للقضاءِ على القرآنِ - الذي هو الغايةُ والمُنْتَهى عندَ المُخطِّطينَ - كما بدا واضحاً من المؤامراتِ التي حِيكتْ، والأساليبِ التي اعْتُمدَتْ، وكما فَهِمَ العالمونَ باللغاتِ، والمُدركونَ لخلفياتِ تلك الحَمَلاتِ. وكما ظهرتْ جليةً بعد 11 أيلول سبتمبر (2001 ميلادية) الأوامرُ التي أُعطيتْ خطياً من الولاياتِ المتحدةِ الأميركيةِ، إلى الدول في العالم العربيِّ بتقليصِ تَدْريسِ الحِصَصِ المخصَّصَةِ لِلتعليمِ الدينيِّ في المدارسِ إلى أدنى حدودٍ ممكنة، بحيثُ لا تزيدُ على أربعِ ساعاتٍ في الأسبوع!... وكما ظهرت بصورة أكثر وضوحاً، وبشكلٍ علنيٍّ سافرٍ دعوة الرئيس الأميركي خلال شهرِ أبريل (نيسان) من عام 2002 ميلادية، عندما دعا العرب والمسلمين إلى استبدالِ لفظ «القاتل» بلفظ «الشهيد»، ومأربُهُ الذي لا يخفى من وراء ذلك القضاء على لغة القرآنِ المجيد التي تتغنَّى بالشهيد وفضائله عند ربه، ورب العالمين أجمعين!!..
ومثلُ محاولاتِ هدمِ اللغةِ العربيةِ الفُصْحى عنْ طريقِ التعليم، جرتْ كذلك محاولاتٌ أُخرى اتخذتْ أشكالاً متنوعةً، إنْ في مجالِ الاقتصادِ، أو المحاكمِ المختلطةِ، بحيثُ يمكنُ من خلالِها تغليبُ لغةِ المستعمرِ، وإحياءُ اللهجاتِ المحليةِ أو الإقليمية، ودفعُها بالتالي حتى تصبحَ لغاتٍ منفصلةً يُكْتَبُ بها ويُعَلَّمُ.. ومن تلك المحاولات أيضاً كتابة العربية بالحروف اللاتينية... وكان عبد العزيز فهمي في مصرَ أولَ عربيٍ حملَ لواءَ تلك الدعواتِ، وتبنَّاها على رؤوسِ الأشهاد في مَجْمعِ اللغةِ العربيةِ عام 1944، بعد أن كان قد سَبَقهُ إلى ذلك أحدُ المستشرقين الهولنديين الذي اقترحَ عام 1929 على الحكومةِ المصريةِ كتابةَ العربيةِ بالحروفِ اللاتينية. ومثلُ عبد العزيز فهمي في مصر، حَمَلَ في لبنانَ الشاعرُ سعيدُ عقل الدعوةَ إلى الأمرين معاً: الكتابةِ بالحروف اللاتينية، وإحلالِ اللهجاتِ العاميةِ بدلاً من اللغةِ الفُصْحى، وتوالتْ بعد ذلك الدعواتُ من المستشرقين، ومن أهلِ البلادِ العربيةِ نفسِها...
وقد ظلَّ الاستعمارُ البريطانيُّ والفرنسيُّ يغذِّيانِ تلكَ الاتِّجاهاتِ زمناً طويلاً، حتَّى إذا انحسَرَ ظلُّهُما قامتْ بدلاً منهما قُوىً أُخرى، منها الصهيونيةُ العالميةُ، والنفوذُ الأميركيُّ.. يقول الأستاذ محمد جبر: «تسلَّم الأميركيون عَلَمَ محاربةِ اللغةِ العربيةِ عام 1945، ودَعَوا البعضَ إلى زيارةِ أميركا فعاشُوا فيها عاماً أو أكثرَ ثم عادُوا يَدعونَ إلى التعليم باللغة العاميةِ، والتخلي عن التعليمِ بالعربيةِ الفُصْحى، وكان هذا سبباً في أنَّ الجيل الذي تَلَقَّى تعليمَهُ منذ عام 1945، وبالطريقةِ التي ابتكروها والتي من شأنها البعدُ كُل البعدِ عن العربيةِ الفُصْحى، كانَ هذا الجيلُ لا يكادُ يكتُبُ كلمةً واحدةً صحيحةً... ولعلَّ هذا هو السببُ في انصرافِ هذا الجيلِ عنِ القراءةِ الأدبيةِ إلى قراءةِ التافِهِ مِنَ الكُتُبِ العاميَّةِ». أما الصهيونيةُ العالميةُ فقد عمدَتْ في السنواتِ العشرينَ الأخيرةِ إلى محاولةِ خلقِ جوٍّ مِنَ الاحتقارِ لِلُّغة العربيةِ بتحقيرِ القائمينَ بها، وهي نفسُ الخطةِ التي سارَ عليها (دنلوب) قبلَ ثمانينَ عاماً... وهذا يُبيِّنُ مدى ما كانَ الاستعمارُ يَسعَى إليه في إعلانِ حِقْدِهِ على اللغةِ العربية، وذلك من خلالِ ازْدراءِ القائِمينَ بتعليمِها (وسعيُهُ هذا لم يختلف عن سعيِهِ للغَضِّ منْ شأنِ الإِسلامِ بالعملِ على الانْتقاصِ منْ قَدرِ القائمينَ بدراستِهِ والدعوةِ إليه).
ولا ننْسى في هذا المجال ما قامتْ به دوائرُ التبشيرِ والإِرساليات، وذلك بالعملِ ضدَّ اللغةِ العربيةِ الفُصحى - لأنها لغةُ القرآن - مستهدفةً دعمَ العاميَّةِ، وخلقَ تيَّارٍ عاميٍّ بأسلوبٍ غربيٍّ، ومنهجيةٍ غربيةٍ متكاملَيْنِ!.. ثم جاءتِ المرحلةُ التاليةُ حيثُ أخذَ كُتَّابُ المهجرِ يستخدمون هذا الأسلوبَ ويتَّخذونه مُنطلَقاً لهم. ثم جاءَ بعضُ كتَّابِ لبنانَ في الخمسينياتِ فاصْطَنَعُوا هذا الأسلوبَ في النثرِ، وفي الشعرِ الجديدِ، وتابَعَهُم بعضُ كتابِ العربِ.. ولا يزالُ أسلوبُهُم يكشفُ عن هويتِهم، ثم ما زالتِ اللغةُ الفُصحى صامدةً في وجوهِهِم تصفعُهُمْ وتُخزيهم وتَطويهم في مجاهِلِ النسيانِ مَعَ جميعِ ما اقترحُوهُ. والنكتةُ في هذا المجال أنَّ شُهرتَهُمُ الشعريةَ أو الأدبية إنَّما قامتْ على اللغةِ العربيةِ الفصحى بعينها، وأنَّ ما اصطنعوهُ من دونها، كان أجْهَلَ ما خطَّ بِهِ قَلَمٌ...
وهذا بعضٌ يسيرٌ مِنَ المحاولاتِ التي جَهدَ أصحابُها في دعوتِهِم للقضاءِ على اللغةِ العربيةِ الفُصحى، وإبدالِ اللهجاتِ العامية أو الإِقليمية بها، ولكنَّ تلك المحاولاتِ والجهودَ باءتْ جميعُها بالفشل. فقد عجزتِ «العامية» أن تستوعبَ الأدبَ العربيَّ والرسالةَ الإِسلاميةَ، وأكَّدتْ أنَّها لا تستطيعُ أن تَصِلَ إلى أعماقِ القلوبِ أو تُرضِيَ الأذواقَ العاليةَ أو تُعالِجَ الموضوعاتِ الدقيقَة. وما ذلكَ الجوُّ العامُّ الذي أوجدَهُ دعاةُ «العامية» بما نَشَروا مِنْ عديدِ كُتُب الأزجالِ والمواويلِ والقصصِ العاميّةِ، والأُحدوثاتِ، والأغاني الشعبية، إلاّ أكبرُ دليلٍ على ضَعْفِ تلك الحركةِ، لأنها كانتْ كالهشيمِ لم تلبثْ أن ذرتْها الرياحُ هَباءً، وبقيتِ «الفُصْحى» هِيَ اللغةَ الأمَّ، والسيدةَ بلا مُنازعٍ.
ويمكنُ القولُ: إنَّ مِنْ أبسط الدلائلِ على فَشَلِ دُعاةِ «العامية» وعَجزهِم أنهم لم يَستطيعوا أن يُدافِعوا عَنْ حَرَكتهم إلاَّ باللُّغةِ الفُصْحى، وأنَّ وَهْنَ عَجْزِهِمْ كانَ في بعض تلك الكتاباتِ العامية الرخيصة التي قدَّموها للناس، والتي لم يُلاقِ أصحابُها إلاَّ سُخريةً، أو انتقاصاً كَشَفَ عن عواره وباءَ بالخزي..
أجل - وبكل جدية - لقد قيل: «إن دُعاةَ اللهجةِ العاميةِ في الكلمةِ المقروءةِ الذين أثارُوها حرباً شعواءَ ضدَّ الفصحى أو ضدَّ اللسانِ العربيِّ الْمُبينِ الذي هو لُغةُ القرآنِ الكريمِ، قد خَسِروا حربَهُمْ مع الجولةِ الأولى، بلْ إنهم لمْ يَستطيعوا أنْ يستخدمُوا في معركتِهِم ذلكَ السلاحَ المفلولَ «العاميةَ» فلجأوا إلى الفُصحى في ذِيادِهِم عن العامية المتهالكة».
ويَكفي للردِّ على هؤلاءِ الدُّعاةِ الهدَّامينَ أن نوردَ بعضَ ما قاله فيهم (نيلا سبازا): «إنّي لأعجبُ لفئةٍ كثيرةٍ عدُّوها من أبناءِ هذا الشرقِ العربيِّ تنفرِطُ منْ عقدِ قوميتها، ويتظاهرُ أفرادُها بتفهُّم الثقافاتِ الغربيةِ تفهُّماً تاماً، وَهُمْ يَعجزون عن تفهُّمِ لغةِ قومِهِم. ولَكَمْ رأيتُ في هذه البلدانِ العربيةِ أناساً يَخدعونُ أنفُسَهُم ليُقالَ عنهم إنهم مُتمدِّنون رَاقُونَ متعالونَ إلى أسْمى درجاتِ المدنيةِ».
أما (فتيجو) فينصح العرب قائلاً: «على العرب أنْ يقاوموا الدعايةَ المؤلِمةَ التي تُطالبهم بالتخلِّي عن شرفِهِم وتقاليدِهِم وإبائِهم، وأنْ يَسْتَسْلِمِوا إلى القوى المستعمرةِ ورؤوسِ أموالِ البنوكِ، وأن يُخْضِعوا طريقتهُم في التفكيرِ والعملِ إلى تلكَ المدنية الزائفة التي لا تُؤمِنُ بالله، وتطمَحُ إلى إخضاعِ العالَمِ لجوٍّ مِنَ المختاراتِ الأمريكيةِ المكتوبةِ بلغةٍ إنجليزيةٍ سقيمةٍ. وسَتَسْقُطُ جميعُ هذِهِ المصنوعاتِ المقلَّدةِ الزائفَة في وقتٍ قريبٍ. وليقاوِمِ العربُ ويُثابِروا، فالعالمُ في حاجةٍ إليهم، وعلى العرب أنْ يَتَمَسَّكوا بلغتِهِم: تلك الأداة الخالِصَة مِنْ كل شائبةٍ، والتي نَقَلتِ الإِنتاجَ الفكريَّ العالميَّ مَنْ غيرِ محاولةِ نَقْصِهِ أو خَفْضِهِ».
الحُججُ والغاياتُ الباطلةُ في مُحاربةِ الْفُصْحَى
ومن الحجج الباطلةِ التي اعتمدَها دعاةُ القضاءِ على اللُّغة العربية، نعتُهم هذه اللغة بأنها لغةٌ صعبَةٌ، وانتقادُهُم فنونَ الكتابةِ فيها ولا سيَّما الشعر، لأنهُ بُنِي على القافيةِ والأوزانِ، فاعتَبَروا القافيةَ قيداً، والوزنَ تعجيزاً، ولذلك أحلُّوا لأنفُسِهم أنْ ينظموا شِعراً لا يقوم على مقاييسَ، وقالوا عنه: إنه «شعرٌ منثورٌ»!.. متناسِينَ أنَّ الشعرَ يَبقى شعراً، وأن النَّثْرَ يبقى نَثْراً، ولا يُمكِن الخلطُ بينهما لمجردِ الأهواءِ والنزواتِ.. ومِنْ تلك الحججِ المضحكةِ التي لجؤوا إليها لذمِّ الشعر، قولُهُم بأنهُ يحملُ الكذِبَ والهِجاءَ والتملُّقَ والباطِلَ وما إلى ذلك من مواضيعَ قبيحةٍ. ونحن لنْ نَعتبر تلك الحججَ نوعاً منَ التجنِّي والبهتانِ، بلْ نقولُ إنها ساقطةٌ جملةً وتفصيلاً.. فذمُّ شعر العربية - بتلك الادعاءاتِ والمقولاتِ - ينبغي أن يشملَ ذمَّ أشعارِ جميعِ اللغاتِ، لأنَّها تحبلُ بكل ما يصدرُ عن النفسِ البشريةِ منْ مشاعِرَ وعواطِفَ..
وعلى هذا فإنَّ الزعمَ بوجوب ذَمِّ الشعرِ لأنَّ فيهِ الهزلَ والكذبَ والباطلَ.. ينبغي أن يؤديَ بأصحابه إلى إسكاتِ الألسنةِ جميعاً، وذمِّ الكلامِ كلِّه، وأن يُفضِّلوا الْخَرَسَ على النُّطق، والعيَّ على البيان، لأن منثورَ الكلام أكثرُ بكثيرٍ من منَظْومِهِ، ولو جُمِعَ هذا المنثورُ الذي يُحكى، غيرُ الذي يُكتبُ، لتبيَّنَ أن فيه من المستهجَنِ والقبيحِ، الذي يُؤْتَى ولو لفترة وجيزةٍ من الأيام!.. أجل لو جرى ذلك على سبيل الاستدلال، لتبينَ أنه يربو كثيراً على ما قالهُ الشعراءُ في أزمانٍ، ذلك لأن الشعراءَ في كل عصرٍ قليلٌ، ومَنْ يكتُب نثراً، ويَحكي قولاً، هم الأكثرُ عدداً ولا شك...
وأما مَن زعمَ أنه ذمَّ الشعر لأنَّه على الوزنِ، وأنَّ هذا الوزنَ يعيقُ السجيَّةَ، فإنه وَقَعَ أيضاً في سخفِ ما يزعمُ؛ ذلك أن الشعر مرآةُ النفسِ، وهو تعبيرٌ تَفيضُ به هذه النفسُ أحاسيسَ وخواطرَ، فيصدُر بطريقةٍ فنيَّةٍ، يكونُ تأثيرُها أقوى منِ استعمالِ طُرقِ النثر.. بل إنَّ صاحبَ الشِّعر يمتازُ عن غيرِهِ بالنبوغِ الذي هو هبةٌ مِن الله سبحانَه وتَعالى، لا تُعطى إلاَّ للقلائِلِ مِنَ الناس...
وكما انتقَدَ أولئكَ الْمُغرضون شِعرَ العربيةِ، كذلك انتقدوا أدَبَها بصورةٍ عامَّةٍ، ولا سيَّما الأدب الجاهلي، ولم تسلَمْ من نقدِهِم قواعدُها وعلومُها وسائرُ ما يتعلقُ بها... ففي مجال النَّحْو مثلاً، قد أصْغروا أمرَ هذا العلمِ، وتهاونوا بِهِ حتَّى كان صنيعُهُم أشبه بأنْ يكون صدّاً عن عِلْمٍ لا غنى عنه.. ولقد جعلوا حُجَّتَهُم في ذلك ما وَجَدوا في عِلْمِ النحو من مسائِلَ ومقاييسَ، وما تضمَّنَ من قَواعدَ وضوابطَ، استكثروها واستصعبوها لدرجة أنهم رَفضوا الأصلَ والفرع، وأَبَوْا إلاَّ الإِنكارَ لأيِّ فضلٍ يعودُ إلى هذا العلمِ..
على أنه ومهما تَكُنِ الانتقاداتُ التي وُجِّهَتْ إلى عُلوم اللُّغةِ العربيةِ الفُصْحى ومقاييسها وقواعدِ كتابتِها ونُطقِها، ومهما تَكنْ حملاتُ العداوةِ لها، فإنَّ المقصودَ ليس الشعرَ مثلاً، وما حَمَلَ من معانٍ اعتبروها غير متوافقةٍ مع مذاهِبِهم، أو ما كانَ عليه مِنْ قافية أو وزن، بل إنَّ المقصودَ، فعلاً وواقعاً، هو محاربةُ اللُّغةِ العربيةِ الفُصحى بذاتِها، والدسُّ على أساليبِها والانتقاصُ من رونَقِها، وذلك كُلُّه من أجلِ غاياتٍ بعيدةٍ أرادُوها، ومقاصِدَ خبيثةٍ سعَوْا إلى تحقيقِها، وفي طليعَتِها: إبعادُ الناسِ عنها، وتخويفُهم منها حتَى يَجِدَ كلُّ من أراد الصناعةَ فيها، أو حتى مَنْ ينطِقُ بها، أنه يقع في الخَطَأ دائماً، ولا يستطيعُ أن يضبطَ لسانَهُ وقلَمَه أبداً.. ومن ثَمَّ إيجادُ فُرْقَةٍ شديدةٍ بين أبناءِ العربيةِ الذين يتكلَّمونها ويكتبونَها، والعملُ على القطيعةِ بينَ أبناءِ الشعبِ العربيِّ الواحدِ، بحيثُ يُصبحُ مِنَ العسيرِ على ابْنِ العراقِ أن يتفاهَمَ مع ابْنِ مصرَ، وابنِ لبنانَ أنْ يفهَمَ على ابْنِ المَغْرِبِ وهكذا... ومنْ ناحيةٍ أُخرى يظهرُ الهدفُ الرئيسيُّ الذي هُوَ: إيجادُ القطيعةِ بينَ المُسلمينَ وبينَ اللُّغةِ العربيةِ الفُصْحى، حتى يَتَحقَّقَ الجَفاءُ - الذي يَصْبُون إليه - ما بينَ المُسلمينَ وبينَ القرآنِ الكريمِ والذي لا يمكن أنْ يكونَ إلاَّ صدّاً عن هذا القرآنِ، وبالتالي طَمْساً لمعالِمِهِ ومضامِينِهِ، وإخفاءً لمعانيهِ وحقائقِهِ، وكلِّ ما فيه مِنْ عقيدةٍ ونظامٍ أرادَهُما الله سبحانَه وتَعالى لبني البشرِ على هذه الأرض.. ولكنْ لعلَّ أصحابَ تلكَ الأغراضِ والمآربِ نَسُوا أنَّ القرآنَ الكريمَ هو كتابُ الله المبينُ، وأنَّ الذي أنزلَهُ قد تكفلَ بحفظِهِ وجمْعِهِ، بدليلِ قولِهِ تَعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *} [الحِجر: 9]. و{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ *} [القِيَامَة: 17].. وكيف لا يكونُ حِفْظُ القرآن أمراً مَرْهوناً بمشيئة الله - عزَّ وجلَّ - ما دامَ هو الكتاب المبين، الذي يَهدي للتي هِي أقومُ؟ وكَفَى بِهِ تعريفاً وتذكيراً أنه قرآن مجيد من لَدُنِ العزيزِ الحكيم.
ولقدْ برزتْ جهودُ أعداءِ القرآنِ عندما أرادُوا إخضاعَ نَظمِهِ ونَسْجِهِ لقواعِدِ الإِعراب التي وَضَعُوها واصْطَلَحُوا عليها، والتي من ثَمَّ ابْتَدعُوا الصعوبةَ في فهمِها وعدمِ إمكانيةِ معرفةِ دقائِقِها...
وإذا كُنا نوافقُ على أنَّ ما وُضِعَ للُّغةِ العربيةِ مِنْ قواعِدَ ومِنْ علومٍ كانَ فيه صعوباتٌ، فإنَّ مما لا شكَّ فيه - وبعدَ مرورِ هذِهِ القرونِ على نُزُول القُرآنِ، ودخولِ الضعفِ والوَهْنِ إلى الأذهانِ والعقولِ - أنَّ علومَ اللُّغة العربية، شأنُها شأنُ العلوم الأخرى، لا يُمْكِنُ لأحدٍ الإِحاطة بها، أو بعلمٍ منها مِنْ جميعِ جوانبِهِ...
أما ما لا نُوافق عليه أبداً فهو ما ذَهَبُوا إليهِ من إخضاعِ نَظْمِ القرآنِ إلى قواعِدِ النحو والإِعراب، لأن الأصحَّ هو وجوبُ إخضاعِ قواعدِ الإِعرابِ إلى نَظْمِ القُرآنِ الكريمِ، لأنه إنْ لَمْ يَكُنْ هذا القرآنُ العربيُّ المبينُ المصدرَ الأساسيَّ الوحيدَ لعلوم الإِعراب، فإنَّهُ - بلا ريبٍ، وبلا أدنى شَكٍّ -، وبما فيه مِنْ نَظْمٍ وبلاغَةٍ ومَعَانٍ، أعظمُ مصدرٍ للإِعراب، بلْ ومن أجلِهِ وُضِعَتْ علومُ الصرفِ والنحوِ، وإنَّهُ هُوَ وحدَهُ قد حَفِظَ لُغةَ العربِ الفُصْحى من الضَّياعِ والاندثارِ، وسيَبْقى هذا القرآنُ السدَّ المنيعَ الذي يَنتصِبُ بكلِّ صلابةٍ وقوةٍ في وُجوهِ أعدائِهِ، وأعداءِ الإِسلامِ، مهما كَثُرتِ المَطالِبُ، ومهما تألبَتِ الدعواتُ لمحاربةِ هذا الدينِ القويم. فمِنَ القُرآنِ نَستقي القواعِدَ، وعلى أساسِهِ نضعُ الأصولَ، ما دامَ هُوَ الأصل، وما عَداهُ فروعٌ تنبثِقُ عَنْهُ.
القرآنُ عربي
من هنا كان لا بدَّ من توضيحِ هذه المسألةِ الهامَّةِ، التي تتعلقُ بالقرآنِ من حيثُ كونُهُ {قُرْآناً عَرَبِيًّا} [الزُّمَر: 28] ومن حيثُ إنَّ ما وضِعَ من علومٍ في النحوِ والتصريفِ والإعرابِ لم يكنْ إلاَّ على أساسِ لغةِ القرآنِ العربيةِ، بلْ ومِنْ أجلِ فَهْمِ هذا القرآنِ وتفسيرِهِ..
وأما حقيقةُ هذا التوضيح فلأمرٍ هامٍّ وضروريٍّ، وهو أنْ يعرفَ المسلمون أولاً مقدارَ عظمةِ كتابهِمْ، وفضلِهِ على اللُّغةِ العربيةِ، وهذا يَكفي لكيْ يُدركوا ما يدورُ حوَلَهُمْ من مؤامراتٍ ودسائسَ لا ترمي إلاَّ لبقائِهِمْ على التخلُّفِ والتشتُّتِ.. والحقيقةُ الأُخرى التي يجبُ أن يعرفوها هي أنَّ العالمَ كلهُ في حالةِ إفلاسٍ عقائديٍّ، ووحدَهُمْ هُمُ الذين يملكونَ العقيدةَ الصحيحةَ، القويمةَ، الثابتةَ التي تَقدرُ على تحريرِ الإِنسانِ مِنْ أوهامِهِ وضَياعِهِ، والتي تَستطيعُ أنْ تأخُذَ بيدِهِ إلى معارِجِ الرقيِّ، والوصولِ إلى السعادةِ التي يَنشُدُها في الداريْنِ..
إذاً فالقرآنُ عربيٌّ لا ريب في ذلك.. وقد نزل، كما يقول ابن جني في كتابه «الخصائص»، بلغةِ العربِ التي كانوا يَنظمونَ فيها شعرَهم، ويُلقونَ خطبَهُم، ويتخاطبون بها فيما بينَهم، ومصداقُ ذلك قولُهُ تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] وقد جاءت صفةُ «مُبين» نَعْتاً لِلِّسانِ العربيِ والقرآنِ وللكتابِ والرسولِ اثنتَيْ عشرَةَ مرةً في القرآن الكريم. وقد جعلَ الله - سبحانه - كتابه المبينَ عربيّاً، بقوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا} [الزّخرُف: 3] و{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ *} [الشُّعَرَاء: 195] «ومَنْ أصْدَقُ مِنَ الله حديثاً» بلْ وهلْ بَعْدَ قولِ الله تبارَك وتَعالى قولٌ أو فصلٌ أو خطابٌ؟!.. ومَنْ يعرفْ حقيقةَ القرآن يدرِكْ أنه اشتمَلَ على ألفاظٍ قيلَ إنها مأخوذةٌ من لغاتٍ أُخرى، ولكنّ ذلك لم يُغيِّرْ من طبيعتِهِ شيئاً... ومن تلك الألفاظِ مثلاً، لفظةُ «المشكاة» وقد قيل بأنها هندية، وقيل بأنها حبشية، وهي تعني الْكُوَّة... ولفظة «القسطاس» وهي رومية وتعني الميزان.. ولفظتا «الإستبرق وسجِّيل» والأولى تعني الدِّيباج الغليظ، والثانية: الحجر من الطين، وهما من الألفاظ الفارسية..
إن اشْتمالَ القُرآنِ الكريمِ على مثلِ هذِهِ الألفاظِ لاَ يعني أنه تضمَّنَ كلماتٍ غيرَ عربيةٍ، بل إنها كلماتٌ قد عُرّبتْ حتى صارتْ عربيَّةً خالصةً، ولذلك فإنَّ القُرآنَ قد اشْتملَ على ألفاظٍ مُعرَّبةٍ لا على ألفاظٍ غير عَرَبيةٍ، لأنَّ اللفظَ المعرَّبَ هو لفظٌ عربيٌّ، شأنُهُ شأنُ اللفظِ الذي وضعَهُ العربُ سواءً بسواء.. ومِنْ قبلِ أن ينزلَ القُرآنُ كان في الشعر الجاهلي ألفاظٌ معرَّبَةٌ، مثلُ كلمةِ «السجنجل» في شعر امرئ القيس - وهي تعني المرآة - وغَيرِها من الكلمات الأُخرى، وهي كثيرةٌ عند شعراءِ الجاهليةِ... وكان العربُ يَعتبرونَ اللفظَ المعرَّبَ لفظاً عربيّاً كالذي وضعُوهُ هُم، من دونِ أدنى ريبٍ في ذلك... لأنَّ التعريبَ إنما هُوَ صوغُ الكلمةِ الأعجميةِ صياغةً جديدةً بالوزنِ والحروفِ حتى تصبحَ بها لفظةً عربيةً في وزنِها وحُروفِها.. والتعريب جائزٌ في كلِّ عصرٍ، شرطَ أن يكون المُعرِّبُ مُجْتَهِداً في اللُّغةِ العربيةِ - وهو يكون كالاشتقاق من اللُّغة الأم تماماً - وما ذلك إلاَّ لأنَّ الاشتقاقَ إنما يقومُ على أن يُصاغَ مِنَ المصدر فِعلٌ، أو اسمُ فاعلٍ، أو اسمُ مفعول، أو غيرُ ذلك من المشتقاتِ مِنْ حُروفِ العربيةِ، وعلى استعمالِ العرب، سواء أكان المصوغ مما قد قاله العربُ، أم لم يقولوه.. وعلى هذا فإن التعريب يكون جائزاً ما دام صياغة وليس بوضْعٍ. ولكنْ ما تَنبغي الإِشارةُ إليه هو أنَّ التعريبَ خاصٌّ بأسماءِ الأشياءِ، ولم يَجْرِ عندها تعريبٌ في غيرِها مِنَ المَعاني والجُمَلِ الدالَّةِ على الخَيالِ أوْ غيرِ ذلِكَ..
إذاً فالقرآنُ عربيٌّ جملةً وتفصيلاً {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا} [فُصّلَت: 3]، ولا مجال أبداً للجدال أو النقاشِ بشأن صفته العربية، ولذلك فهو يُعتبرُ المرجعَ الأساسيَّ لِقِياسِ اللغةِ العربيةِ الفُصحى وصِحَّتِها، وهُوَ الذي حَفِظَ هذه اللغةَ مِنَ الاعتلالِ، كما حفظَ اللسانَ العربيَّ الفصيحَ البليغَ، الصَّافِي.. ولولاه لاَعْتَوَرَ العربيةَ كثيرٌ مِنَ اللسانِ الأعجميِّ، ولَخالَطَ هذا اللسانَ الخطأُ والزللُ مِنْ وجوهٍ عديدةٍ.
فضلُ القرآنِ على اللُّغةِ العربيةِ
يقولُ الأستاذُ فيليب دي طرازي تحت هذا العنوان:
«إنَّ القُرآنَ هو الكتابُ الوحيدُ الذي احتفظَ بلغتِهِ الأصليةِ وحفظَها على قيدِ الحياة وسيحفظُها على مرِّ الدهورِ. وستموتُ اللُّغاتُ الحيةُ المنتشرةُ اليومَ في العالم كما ماتتْ لغاتٌ حيةٌ كثيرةٌ في سالف العُصور إلاَّ العربية، فستَبْقى بمنجاةٍ مِنَ الموتِ، وسَتَبْقى حيةً في كل زمانٍ، مخالفةً النواميسَ الطبيعيةَ التي تَسري على سائِر لُغاتِ البَشَر. ولا غَرْوَ فهِي متصلةٌ بالمُعْجزةِ القُرآنيةِ الأبديةِ. فالكتابُ العربيُّ المقدسُ هُوَ الحِصنُ الذي تَحتَمي بِهِ اللُّغةُ العربيةُ. وتُقاوِمُ أعاصيرَ الزمَنِ، وعواصِفَ السياسةِ المُعاديةِ، ودسائِسَها الهدامة».
ويقول أيضاً الأستاذ جوستاف برونيباوم:
«عندما أوحى الله رسالته إلى رسوله محمد أنزلها {قُرْآناً عَرَبِيًّا} [الزُّمَر: 28] والله يقول لنبيه: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا *} [مَريَم: 97] وَما من لغةٍ تستطيعُ أن تُطاوِلَ اللُّغةَ العربيةَ في شرفِها، فهِي الوسيلةُ التي اخْتِيرتْ لتحمِلَ رسالةَ الله النهائيةَ، وليستْ منزلتُها الروحيةُ هِيَ وحدَها التي تسمُو بها على ما أودَعَ الله في سائِرِ اللغاتِ من قوةٍ وبيانٍ، أما السعة فالأمرُ فيها واضحٌ، ومَنْ يتتبَّعْ جميعَ اللُّغاتِ لا يجِدْ فيها سعَةَ الآفاقِ التي تُضاهي اللغةَ العربية. ويُضافُ جمال الصوتِ إلى ثروتها المدهشةِ في المُتَرادفاتِ، كما أنها تزينُها الدقةُ ووجازةُ التعبير، بل تمتاز العربية بما ليس له مثيلٌ من اليُسرِ في اسْتعمالِ المجازِ، فإنَّ ما بِها مِنْ كناياتٍ ومَجازاتٍ واستعاراتٍ يرفعُها كثيراً فوق كل لغةٍ بشريةٍ أُخرى. ولها كذلك خصائِصُ جمَّةٌ في الأسلوبِ والنحو ليسَ من المُستطاعِ أن يُكتَشَفَ لها نَظائِرُ في أية لغةٍ، وهِيَ مَعَ هذه السَّعَةِ والكَثْرةِ أشدُّ اللغاتِ اختصاراً في إيصالِ المعاني. ومِنَ النَّقل إليها، يتبيَّنُ لك أنَّ الصورةَ العربيةَ لأي مثلٍ أجنبي أقصرُ في جميع الحالات، وقد قال الخفاجي عن أبي داود المطران وهو عارف باللغتين العربية والسريانية: إنه إذا نَقَلَ الألفاظَ الحسنةَ إلى السريانيِّ قَبُحَتْ وخَسَّتْ، وإذا نَقَلَ الكلام المُختارَ من السريانيّ إلى العربيِّ ازْدادَ حلاوةً وحُسْناً. وإنَّ الفارابي على حق حين يُبرِّرُ مَدحهُ العربيةَ بأنها مِنْ كلامِ أهلِ الجنةِ ولسانُ العربِ هو المنزَّهُ بين الألسنةِ مِنْ كل نقيصةٍ والمعلّى عن كل خسيسةٍ، وهو أوسطُ الألسنةِ مَذْهباً وأكثرُها ألفاظاً».
أما فضلُ القرآن الكريمِ على اللُّغةِ العربيةِ فيظهر بما «كانَ له من أثر في حفظها مِنَ الانْقراضِ، وفي الحد من تطور اللهجاتِ الإِقليميةِ العامية. وبذلك يكونُ كتابُ الإسلام قد بَقِيَ أيضاً عاملاً هامّاً مِنْ عوامل التقارُبِ بين العرب بحيثُ لم تتمكنْ هذه اللهجاتُ منْ أنْ تتطورَ إلى لغاتٍ مستقلةٍ قائمةٍ بنفسِها. وذلك أنَّ وحدةَ الأمةِ الروحيةَ القائمةَ على القرآن، بقيتْ سليمةً بعد أن تجزأتِ الأمةُ سياسيّاً. ولقد استمرَّ العربُ المسلمونُ في عهدِ انقسامهمِ السياسي كما كانوا في عهدِ وحْدتِهم يتلُونَ القرآنَ كلَّ يومٍ خمسَ مراتٍ في صلواتِهِم، وظل القرآنُ وَبقِيتِ الفُصْحَى».
يُضافُ إلى ذلك أنَّ أي مُطلعٍ مفكرٍ يحكُمُ بأنه لولا القرآنُ لما كانتْ هنالكَ قواعدُ للغةِ العربية، ولما اهتمَّ المسلمون بإنشاءِ علومِ اللغةِ، إذْ كان القرآنُ الكريمُ هو الدافِعَ الرئيسيَّ والأساسيَّ لوضعِ تلكَ العلومِ.
وإننا نتساءلُ: هل كان إقبالُ الأممِ على تعلُّمِ اللغةِ العربيةِ من أجل فَهْمِ المعلقاتِ السبعِ، أمْ من أجْلِ فَهْمِ هَذا القُرآنِ الكريم، وفَهمِ السُّنَّةِ النبويةِ الشريفةِ مِنْ بعدِهِ؟..
إنَّ هذا الفضلَ للقُرآنِ الكريمِ على اللُّغةِ العربيةِ هو منَ الحقائقِ المطلقةِ التي لا تَخْفى.. ولكنْ على الرغم من أنَّ كتاب الله قد نَزَلَ بلسانٍ عربي، فإنَّ أحداً لا يُنكرُ بأنَّ فهمَهُ لم يَكُنْ دائماً ميسوراً على الناس، بلْ لم يقدرْ على هذا الفهمِ بعد رسولِ الله (صلى الله اليه وآله وسلم) إلاَّ نُخبةُ صحابتِهِ الأخيارِ، الذينَ واكبُوهُ في مسيرَةِ الدعوةِ حيثُ كانَ يَتَلقَّى الوحيَ مِن جبرائيلَ الأمينِ، فينطبع في قلبِهِ، ويَفْقَه كلَّ ما فيهِ وما يَرمي إليه، بحيثُ يكونُ قادراً على نَقْلِهِ للناسِ، وعلى تَلْقينِهِ لأولئكَ الصحابةِ، حتَّى يحفظُوهُ ويَعْمَلوا بموجبِهِ.
وإنَّ تنزيلَ القُرآنِ على مدى ثلاثٍ وعشرينَ سنةً، في مكةَ والمدينةِ، جَعَلَ تلك المدة كافية لأنْ يُودعَ الرسولُ الأعظمُ (صلى الله اليه وآله وسلم) ، في قلوب أصحابه أولئك، ونفوسهِم، وعقولهِم، كلَّ ما اشتملَ عليه القُرآنُ الكريمُ من آياتٍ بيِّناتٍ، ومِنْ معانٍ واسعةٍ حولَ الكونِ والإِنسانِ والحياةِ، كما كانتْ كافيةً أيضاً لكيْ يعلِّمهُمُ الرسولُ (صلى الله اليه وآله وسلم) كيفَ تُحْفَظُ آياتُ القُرآنِ، وكيفَ تكتَبُ أو تُقْرأ قراءةً صحيحةً. فلما لحِقَ رسولُ الهُدى بالرفيقِ الأعلى، كانَ القُرآنُ في أمانٍ، إذْ بَقِيَتْ في المسلمين تِلكَ النخبةُ منَ الصحابةِ، القادرةُ على تفسيرِ القُرآنِ وإظهارِ مَعانيه، واستخراجِ عِبَرِهِ وعظاتِهِ، وبيانِ مَراميهِ وأهدافِهِ... ولكنَّ الأحداثَ، بعدَ وفاة الرسولِ (صلى الله اليه وآله وسلم) ، راحتْ تتعاقبُ بسرعةٍ هائلةٍ، فوقعتْ معاركُ كثيرةٌ قويةٌ بين المسلمينَ والرومِ، وبينَ المسلمينَ والفرسِ، وكانَ الصحابةُ، الذين نُقِشَ القُرآنُ في صدورِهِم، قبلَ أن يُنْقَشَ في السُّطورِ على رُقَعِهمْ، يتساقطونَ، الواحدَ تلوَ الآخرِ، وهمَ يقومونَ بواجبِ الجهادِ المقدسِ، حتى استُشْهِدَ منهُم نفرٌ كبيرٌ، ومَعَ الأيامِ شاخَ مِنهُمْ أيضاً نفرٌ آخرُ، وباتَ على وَشَكِ مُفارقَةِ هذِهِ الدنيا، بحيثُ لَمْ يبقَ مِنهُمْ إلاَّ فئةٌ قليلةٌ، إلاَّ أنَّ هذَا الوضْعَ لم يكُنْ مُريحاً للمسلمينَ، فقدْ خافوا أن ينتهِيَ الصحابةُ الكرامُ، القائمونَ على القرآن.. ولذلك هُرِعُوا إلى الخليفةِ عثمانَ بنِ عفانَ (رضي الله عنه) يُظهرونَ قلقَهُم مِنْ أنْ تُؤدِيَ الحالُ إلى تحريفٍ في القُرآنِ، أو تأويلٍ غيرِ سَوِيٍّ لآياتِهِ، وذلك يُخالِفُ إرادةَ الله الذي أنزلَهُ، ويخالفُ حقيقة القُرآنِ مِنْ كونِهِ حجةً على الناسِ في شتَّى أمورِ دينهِمِ، وسائِرِ شؤونِ حياتِهمِ...
وكيفَ لا يكونُ الأمرُ كذلك - بالنسبة للخائفينَ - والقُرآنُ هو الكتابُ المجيدُ الذي يَحتوي بين دفَّتيه: الشريعةَ بكامِلِها؟ وهَلْ مِنْ حياةٍ حقَّةٍ للمسلمينَ من دونِ هذه الشريعة؟...
أوَلَيْسَ القُرآنُ هو الكتابُ المبينُ الذي يَجِبُ أن يُسَطَّرَ بحُروفِهِ ورُسومِهِ، وآياتِهِ، وسُورِهِ، وألفاظِهِ، كما بلَّغه الرسولُ الأعظمُ؟ وذلك من أجلِ أن يبقى الإِسلامُ - كما أرادَهُ الله سبحانَهُ وتعالى - الدينَ الحقَّ، دينَ الحنيفية السمحاءِ، مهما تعاقبتْ عليه الأزمانُ أوِ اختلَفَتِ الأَمصار...
مِنْ أجلِ ذلك كلِّهِ كانتِ المطالبةُ للخليفةِ عثمانَ (رضي الله عنه) أن يُبادِرَ إلى جَمْعِ القُرآنِ وتَدْوينِهِ..
جَمْعُ القُرآنِ وتَدْوِينُهُ
لقد نزلَ القُرآنُ المجيدُ على لسانِ الرسولِ العربي الكريم، محمدِ بنِ عبد الله (صلى الله اليه وآله وسلم)، فكان عربيّاً يُمثِّلُ أعلى ما ينتظمُهُ اللسانُ العربيُّ من لغاتٍ، وأوسعَ ما يجمعُ من لهجاتٍ؛ وكانت لغةُ مُضَرَ أعلى ما يجري على لسان قريش وأوسعه، فنزل بها القرآن، وفي هذا يقول عمر: نزلَ القرآنُ بلغةِ مضرَ. وكانت لغةُ مضرَ هذه تنتظمُ لغاتٍ سبعاً لقبائلَ سبعٍ، هِيَ: هذيلُ، كنانةُ، قيسُ، ضبَّةُ، تَيْمُ الرَّباب، أسدُ بنُ خزيمة، وقريشُ... ولقد مثَّلَ القرآنُ هذه اللغاتِ السبعَ كلها مفرقَة، لكلِ لغةٍ منه نصيبٌ. وهو أولى الأقوالِ بتفسيرِ الحديثِ: «نَزَلَ القُرآنُ على سبعةِ أحرفٍ». وقد مرَّ تدوينُ القُرآنِ بمراحلَ ثلاثٍ:
أولى هذه المراحل تلك التي كانت في حياة النبيِّ (صلى الله اليه وآله وسلم) ، فلقد كان من حولِهِ كتّابه الذي يَكتبونَ الوحيَ الذي يُمليهِ عليهم، ومنهم: أبو بكر الصديق، وعمرُ بن الخطاب، وعثمانُ بنُ عفان، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، والأرقمُ بن أبي الأرقمِ، والمغيرةُ بن شعبةَ، وشرحبيلُ بنُ حسنة (رضي الله عنهم) وغيرهم.... وكان عليُّ بنُ أبي طالب وعثمانُ بنُ عفان أكثرَ الصحابةِ كتابةً للوحي، فإنْ غابا كتبَهُ أُبيّ بنُ كعبٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ.. وكان الرسول (صلى الله اليه وآله وسلم) حريصاً على ألاَّ يُكتَبَ عنه شيءٌ آخَرُ غيرُ القُرآنِ، حتى لا يلتَبِسَ به أيُّ شيء، ويَروونَ عنه (صلى الله اليه وآله وسلم) أنه قالَ: لا تَكتُبوا عني شيئاً سوى القُرآنِ، فَمَنْ كتب عني شيئاً سوى القُرآنِ فليمْحُهُ.. ولم يترك رسولُ الله (صلى الله اليه وآله وسلم) دُنياهُ إلى آخرتِهِ إلاَّ بعد أن عَرَضَ ما في صدرِهِ على ما في صدورِ الحَفَظَةِ، وقد كانوا كثرةً من حولِهِ. كما أنَّ القُرآن كان مكتوباً كله على صحائِفَ متنوعةٍ منها العُسبُ (جريدُ النخل) واللِّخافُ (صفائحُ الحجارة)، والرّقاعُ، والأديمُ، وعظامُ الأكتافِ، والأقتابُ (ما يوضع على ظهور الإِبل).
والثانية من تلك المراحل ما كان مِنْ عُمَرَ مع أبي بكرٍ (رضي الله عنهما) حين استحرَّ القتل بالقراء في اليمامة، أيام خلافة أبي بكرٍ فاتفقا على أن يكِلا إلى زيدِ بن ثابت جمع المُصحفِ، وذلك قبل أن تأتيَ المواقع على حفَظَة القرآن، كما أسلفنا؛ هذا مع العلم أنه كان هنالك جمع سابق على يد نفر من الصحابة، مثل ما فعل عليٌّ (كرم الله وجهه). وما فعلَ ابنُ مسعود، وما فعل عبدُ الله بنُ عباس، إذ جَمَعَ كلٌّ منهم - رضوان الله عليهم - مُصْحَفاً وكتبَهَ بخطِّ يدِهِ، فعُرِفَ كل مُصْحفٍ باسمِ الذي كتبَهُ...
ولكنَّ هذه المصاحف لم تتخذْ طابعَ النشرِ والتعميم، إلى أنْ كان جمعُ المُصحفِ أيامَ الخليفةِ الأولِ على يدِ زيدِ بنِ ثابت، ومع ذلك فإنَّ هذا المصحف لم يأخذْ طريقَهُ الرسميَّ إلى الأمصار، ولعل مقتلَ عُمَرَ هو الذي أخَّر ذلك.
والمرحلة الثالثة والأخيرة، هي التي تمَّت على يد عثمانَ بنِ عفانَ، عندما جاءَهُ النذيرُ من المسلمين بأنْ يدوِّنَ القرآنَ الكريمَ وينشرَهُ في الناس، بوصفِهِ خليفةَ المسلمين؛ ولم يتوانَ عثمانُ عن الاستجابةِ لنداءِ الواجبِ فدعا إليه رجلينِ هما: زيدُ بنُ ثابت ليكتُبَ له، وسعيدُ بن العاص ليُمليَ عليه، وكان عثمان من ورائهما يُراجعُ ما يكتبانِهِ حرْفاً حرْفاً، وكلمةً كلمةً ويُصلحُ ما فاتهُما، حتى انتهى من عملِهِ المجيدِ هذا، فعرضَهُ على الصحابةِ، واجتمع معه في الرأي عليه اثْنا عَشَرَ صَحابيّاً، جمَعهُم عثمانُ لهذا العملِ الجليلِ؛ ولقد أرسلَ عثمانُ مِنْ هذا المُصْحَفِ نُسَخاً للأمصارِ، وأمَرَ بأنْ يُحْرَقَ ما عَدَاها.
ويرجِّحُ المتصلونَ بالتراثِ العربي أنَّ هذا المصحَفَ هو الذي كانَ بدارِ الكتبِ بمدينة «ليننجراد»، ثم انتقل منها إلى إنجلترا، ولا يزالُ بها إلى اليوم.
ولقد كانَ في دارِ الكتبِ العلويةِ في النجفِ مصحفٌ بالخطِ الكوفيّ، مكتوبٌ في آخره: كتَبَهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ في سنةِ أربعينَ من الهجرةِ، وهِيَ السنةُ التي تُوفِّيَ فيها عليّ عليهِ السلامُ.
نشأةُ علمِ تفسيرِ القُرآنِ
هكذا كانَ الاهتمامُ بتدوينِ القُرآنِ الكريمِ، كتابِ المسلمينَ الذي يجمعُ لهم عقيدتَهُم، وما يتفرعُ عنها من طُهر ونقاءٍ، وكتابِ العربِ الذي يجمعُ لسانَهم في بيانٍ وفصاحةٍ، فكان انكبابُهم جميعاً عليه - مسلمينَ وعرباً - يَستنبطونَ ما يُعالجُ مشاكلَهم في الحياة، ويفهمونَ الأمورَ التي تتعلقُ بغيرهم من الأممِ، ويتحسَّسُون مصيرَهم - إن حاولوا أن يخالفوهُ، ويتلمَّسون بواسطتِهِ أهميةَ ما اعتقدوهُ - إنْ هُمْ أطاعوهُ.... وكان النحوُ عمادَ هذهِ العلومِ جميعِها، إذْ نشأ في ظلِّ علمِ التفسيرِ الذي ظهر كأولِ علمٍ من علومِ القرآنِ...
ولسنا على يقينٍ منْ أن علم النحو أسبقُ على علمِ التفسيرِ أو أنه أتى بعده مباشرةً، ولكنْ منَ الثابتِ أنَّ علمَ النحوِ لم يتخلَّفْ كثيراً عن علمِ التفسيرِ.
وقد بدأتْ محاولاتُ التفسيرِ في عهدِ الخلفاءِ الراشدينَ، على يدِ صحابةٍ أجلاَّءَ، في طليعتِهم عليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بن عباسٍ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ (رضيَ الله عنهم جميعاً).. وإذا كانتِ التفسيراتُ قد بدأتْ مع هذا النَّفَرِ منْ صحابةِ رسولِ الله (صلى الله اليه وآله وسلم) ، إلاَّ أنَّ تفسيرَ القُرآنِ لم يستوِ عِلْماً قائِماً بذاتِهِ معَ تلك التفسيراتِ، بلْ لم تظهرْ كتبُ التفسيرِ، بمعناهُ الشاملِ والمعروفِ لدينا، إلاَّ مع أوائلِ القرنِ الثاني الهجريِّ...
أهميةُ علم النَّحْو
إذا كانَ تفسيرُ النص القُرآنيِّ ضروريّاً لِفَهْمِ تركيبِ كلماتِهِ وآياتِهِ، وبالتالي فهمِ المعاني والمرامي مِنْ كلامِ القرآنِ، فإنَّ علم النحوِ لا يقلُّ ضرورةً عن علمِ التفسيرِ، بل إنهما يرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً.
وما دام أنَّ اللغة العربية الفُصحى هي لغةُ القرآنِ، فإنَّ فضلَ النحوِ لا يقتصرُ على فهمِ القرآنِ وحسبُ، بل تظهرُ له حتميةٌ جليةٌ في حفظ الروابطِ العقليةِ والأدبيةِ بين الأجيالِ المتباعدةِ في الزمان. والشاهدُ على هذا، ما نقرأهُ أحياناً في بعضِ دواوينِ الأدبِ من أزجالٍ وفنونٍ عاميةٍ، كديوانِ ابنِ قُزمانَ الأندلسي، وكان منْ أحسنِ شُعراءِ عصرهِ، وقد آثرَ أن ينظِم جُمهورَ أشعارِهِ باللغةِ العاميةِ الأندلسيةِ، فراجتْ في عصرِهِ رواجاً عظيماً؛ أما الآن فما نَظُنُّ - أن نجد - قارئاً مغربيّاً أو مشرقيّاً لديوانه، يزعمُ أنه يفهمُ جميعَ نصوصِهِ، أو يستطيعُ أن يفسِّرَ جميعَ مشكلاتِ التعبيرِ التي تعترضهُ في كل صفحة من صفحات ذلك الديوان... والسببُ واضحٌ في ذلك، وهو أنَّ تأثيرَ الزمنِ - الذي لا يفتُرُ يغيِّرُ مِنْ كلِّ مظاهرِ الحياةِ - قد غيَّرَ كثيراً من المظاهر التي عاش فيها الأديبُ القديم... وهكذا الحالُ في كلِّ أدبٍ شعبيٍّ يبعدُ زمن منشئِهِ عن زمانِنا، فإنَّا لا نجدُ فيه مِنَ المتعةِ ما نجدُ من ذلك في الأدبِ الشعبيِّ المعاصرِ لانقطاعِ الصِّلاتِ بين القديمِ والحديثِ... ولو أخذنا أي بلدٍ عربيٍّ اليومَ، لبنانَ أو مصرَ أو تونسَ، فإننا نجدُ فيه دواوين كثيرةً من الأزجالِ والفنونِ العاميَّةِ، وهي تلذُّ لقارئيها من هُواةِ هذه الأنواع وإنْ كانوا قِلَّةً قليلةً نسبيّاً. ولكنَّها بعد حِقبةٍ من الزمنِ تصبحُ عديمةَ المتعةِ بالنسبةِ للأجيالِ القادمةِ، لانْقطاعِ الصلةِ بينَ ما قامتْ عليه هذه الفنونُ وما سيأتي بديلاً عنها في مقبلِ الأيامِ. وسوفَ يكونُ حكمها في المستقبلِ حكم ديوانِ ابنِ قزمان الأندلسي اليومَ...
نشأةُ علمِ النَّحوِ
يرجع السببُ في إيجادِ علمِ النحو إلى ما خالَطَ اللسانَ العربيَّ من لُكْنَةٍ، وما استعصى على الأمم الأعاجم - التي دخلتْ في الإِسلام - من فهمٍ للقرآنِ الكريمِ، هذا فضلاً عن أن العرب أنفسهم، لم تكُنْ لهُمُ القدرةُ على فهمِ نصوصِ القرآنِ ومعانيهِ ومراميهِ. من أجل ذلك كان لا بد من علمٍ يعيدُ اللسانَ العربي إلى صوابيتِهِ، ويسهِّلُ على المسلمين قراءة كتابِهِم قراءةً صحيحةً، ويُرْشِدُهُمْ إلى فهمِ ما يقرأونَ...
ولقد أجمَعَ الباحثونَ على أن نشأة علمِ النحوِ تعودُ إلى أيامِ أبي الأسودِ الدُّؤَليِّ المتوفى سنة 69هـ. فقد رُوي أنَّ أبا الأسودِ دخلَ يوماً على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهِ السلامُ وهو في الكوفةِ، فوجدهُ مطرِقاً متفكِّراً، فلما سأله عنْ سببِ ذلك قال له عليٌّ عليه السلام: إني سمعتُ ببلدِكمْ هذا لحْناً فأردتُ أن أضَعَ كِتاباً في أُصولِ العربية.
وعادَ أبو الأسود بعد فترة وجيزة، فألقى إليه عليٌّ (كرم الله وجهه) برقعةٍ أو صحيفةٍ كتبَ فيها الأصولَ التي أرادَها ومنها: أنَّ الكلامَ كلَّهُ اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ: فالاسمُ هو ما أنبأَ عن المُسَمَّى، والفعلُ ما أُنبِىءَ بهِ، والحَرفُ ما أَفادَ مَعْنًى.
ويُروى أنُه قالَ يومَها لأبي الأسودِ: انْحُ هذا النحوَ، وأضِفْ إليه ما وَقعَ إليكَ.. واعْلمْ يا أبا الأسود أنَّ الأشياءَ ثلاثةٌ: ظاهرٌ، ومضمرٌ، وشيءٌ ليسَ بظاهرٍ ولا مضْمرٍ، وإنما تفاضلُ العلماءِ - أو الناسِ - بمعرفةِ ما ليسَ بظاهرٍ ولا مضْمرٍ (وهو قد أراد بذلك الاسم المبهم).
ويقولُ أبو الأسود: إنني أضفتُ إلى ما وضَعَ عليٌّ (كرم الله وجهه) منْ أصولٍ، أبوابَ: العطفِ، والنعتِ، والتعجبِ والاستفهامِ، إلى أن وَصلتُ إلى باب (إنَّ وأخواتِها)، فلما عرضتُها على عليٍّ (كرم الله وجهه) أمرَني بضَمِّ «لكنَّ» إليها.. وكنت كلما وضعت باباً آخرَ من أبوابِ النحوِ عرضتُهُ عليه إلى أن حصَّلتُ ما فيه الكفايةُ..
وقد قالَ لِي عليٌّ عليه السلام: ما أحْسَنَ هذا النحوَ الذي نَحَوْتَ يا أبا الأسودِ.
ولعلَّ هذا هو السببُ في تسميةِ هذا العلمِ «بعلمِ النحو».
(وكان أبو الأسود من الذين صَحِبوا عليَّ بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، والذين اشتهروا بمحبتِهِ ومحبةِ أهل بيتِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّمَ).
وكما كانَ حافزُ الإِمام عليٍّ عليه السلامُ على وضْعِ بعضِ قواعدِ اللُّغةِ العربيةِ هُوَ ما سمعَهُ من لحْنٍ دَخَلَ على اللِّسانِ العربي، كان ذلك نفسَ الحافزِ الذي جعل أبا الأسودِ ينكبُّ على وضعِ أبوابٍ جديدةٍ في النحو.. فقد وَصَلَ الحالُ بالناس لأن يخفِضُوا المرفوعَ، أو أن يَرفَعُوا المنصوبَ، ومن ذلك ما فعله قارئٌ للقُرآنِ وهو يتلو قول الله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التّوبَة: 3]!.. أي أنه جرَّ كلمة «رسولُهُ». ففزِعَ لذلك أبو الأسود فزعاً شديداً وقالَ: عزَّ وجهُ الله تعالى أنْ يبرأ من رسولِهِ. فالقراءةُ الصحيحةُ هيَ الرفع أي «ورسولُهُ» بحيث إن المعنى هو: إنَّ اللّهَ تعالى بريءٌ من المشركين، ورسولُهُ كذلك بريءٌ منهم.. ومثل ذلك أيضاً ما سمِعَهُ أبو الأسود من أهلِ بيتِهِ، فقد جلَسَ ذاتَ ليلةٍ ينظرُ إلى السماءِ وهِيَ تتلألأُ بنجومِها المضيئةِ، وكانتِ ابنةٌ له بجانبِهِ، فقالتْ:
ما أحسنُ السماءِ؟
وقدَّر أبو الأسود أنها تريدُ الاستفهام، فأجابها: نجومُها، يا بنتي. فقالت أريد التعجب لا الاستفهامَ، فقال لها: قولي: ما أحسَنَ السماءَ، وافتحي فَاكِ...
ومهما كانت الأسبابُ في نشأة علم النحو، أو أيّاً كانت السبل إلى تلك النشأة، فإنَّ في اللغة العربية عباراتٍ قد تحمِلُ على اللَّبْس والإِبهام إن لم يُعْرَفِ المعنَى المرادُ من اسْتعمالِها، لأنَّها في الأصل قد تُستعمَلُ لأغراضٍ شتّى، وتُؤدي إلى معانٍ مختلفةٍ، فلو أخذنا أمثلة على ذلك استعمالَ «ما» و«مَن»، فإننا نرى أن أيّاً من هاتين اللفظتين يكون له تأثيرٌ في الاستعمالِ يختلفُ عنهُ في استعمالٍ آخرَ، فإذا قُلتَ:
ما أحسنَ زيداً، يكونُ المقصودُ التعجب، أي التدليل على حُسْنِ زيد..
وإنْ قلتَ: ما أحسَنُ زيدٍ؟ يكون المقصود الاستفهام، أي ما هو أحسَنُ شيءٍ في زيد. وأما إذا قلت: ما أحَسَنَ زيدٌ، فيكون المقصود النفي، أي أن زيداً لم يأتِ بشيءٍ حَسَنٍ. وهكذا تكون «ما» دالةً على التعجبِ أو الاستفهامِ أو النفيِ بحسب ما أُريد لها من معنىً، وبحسبِ الكلام الذي استُعملتْ فيه من رفعٍ أو نصبٍ أو خفضٍ..
وأما فيما يعودُ إلى عملِ «مَنْ»... فهي قد تكون شرطيةً أو موصولةً أو استفهاميةً، على النحو التالي:
فإن كانتْ شرطيةً، فإنها تجزمُ الفِعليْنِ، مثلُ قولكَ: مَنْ يُكرِمْني أُكرِمْهُ.
وإن كانتْ موصولةً فإنها ترفعُ الفعلين: مَنْ يكرمُني أكرمُهُ، أي أكرم الذي يكرمني.
أما إذا كانت استفهامية فإنها ترفع الفعلَ الأولَ وتجزمُ الثاني لأنهُ جواب غيرُ مقترنٍ بالفاء فيقال: مَن يكرمُني أكْرِمْهُ؟.
من هذين المثالين تتبينُ لنا أهمية علمِ النحو من حيث استعمالُهُ في الوقوفِ على ما أُريد من تركيب الكلامِ وجمعِهِ إلى بعضِهِ البعضِ حتى يؤديَ المعنى المطلوبَ.
وينطبقُ على هذه الحالة القولُ المأثور:
الجاهلُ يعتمدُ على أصلِهِ، والعاقلُ يعتمدُ على علمِهِ.
وقد قيل للمهلَّب: بِمَ أدركت ما أدركت؟ قال: بالعلْمِ.. قيل له: فإنَّ غيرك قد عَلِمَ أكثرَ مما عَلِمت ولم يُدركْ ما أدركت.. قال: ذاك عِلْمٌ حُمِلَ، وهذا علمٌ استُعمِلَ..
إذاً فلمْ يكنْ علمُ النحو من حيثُ هو علمٌ، بل من أجلِ استعمالِهِ للمقاصد التي أُوجِدَ من أجلها.
وأما المثلُ الدَّالُّ المعبّر، بل المثلُ الجميلُ، الذي لا يمكن أن نستقيه إلاَّ من القُرآنِ الكريمِ، كتابِ الله المبينِ، والذي دون روعتِه كلُّ مثلٍ، فهو ليس عبارةً، ولا جملةً، ولا آيةً كاملةً، بل هو كلمةٌ واحدةٌ في آية:
الآية هي الثامنةُ والعشرونَ من سورة «هود»، والكلمةُ هي «أُنُلْزِمُكُمُوها»... وهذه الكلمة بحق، لا يمكن أن نُدرك ما تحتوي عليه من بلاغةٍ وتعبير، أو ما تُثيرُهُ مِنْ صُوَرٍ وأحاسيس، أو ما تَشتملُ عليه من معنىً ومغزىً، إلاَّ إذا أَمكن لنا تحليلُها وإعرابُها.
وقبل الولوج في تحليلِ الكلمة، لا بُدَّ من إلقاء نظرةٍ على ظِلال الآيةِ القرآنيةِ التي وردتْ فيها الكلمة. فالآيةُ جاءتْ إخباراً من الله سبحانه وتعالى لنبيِّه الكريم محمَّد صلى الله عليه وآله وسلم أنْه عندما أرسلَ نوحاً عليه السلام إلى قومِهِ نذيراً مبيناً، ألاَّ يعبُدوا إلاَّ الله، خوفاً عليهم من عذاب يومٍ عظيمٍ، لم يستجبْ له قومُه، وخاصةً أشرافهم الذين كفروا وهزِئوا به، وجابَهوهُ بأنه ليس إلاَّ بشراً مثلهم، فكيف تكونُ له الرسالةُ وهم يَرون أنَّ الذين يتبعونَهُ أراذلُ القومِ، وأنه بحدِّ ذاتِهِ لا يستحقُّ الاتِّباع فيما يدَّعي..
فكان جوابُ نوحٍ عليه السلامُ أن قال: «يا قوم أرأيتم إنْ كُنْتُ على بيِّنَةٍ من ربي وآتاني رحمةً من عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عليكم، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وأَنْتُمْ لها كارِهُونَ؟».
أي: ماذا أصنع وقد اختارني ربي لرسالته، وخصَّني - من دونكم - برحمته، وزوَّدني - لإِتمام حُجَّةِ رسالتِهِ - بالآياتِ والبيِّنات؟ وما ذنبي أنا إذا عُمِّيتْ عليكم نُبوَّتي؟ هل نُلزِمُكُمْ - ربِّي وأنا - بالإِيمان ونُكرهُكُم على التصديق وأنتم عُمْيُ الأبصار كارهون للإِيمان والنبوّة؟ وما يحصلُ إن أُلْزِمْتُمْ، والإِلزامُ يَزيدُ القلبَ عمايةً، والنفس غِوايةً عن الحق؟ لا يا قومِ، ما كان لي أن أَحملكم على الإِذعان لأمري لتنالكمُ الرحمةُ من ربِّي، ولا أن أُكرهكم على الإِيمان برسالتي ليرتفع عنكم عذابُ الله، ولا أنا قادرٌ على إلجائكم إلى البحث عن الحقيقة، أو إجباركم على العمل بما يؤدِّي إلى الرحمة والرضوان!..
ومن المعاني البعيدةِ التي تحملُها الآية أيضاً: أن نوحاً عليه السلام قد تلطَّف في توجيهِ أنظارِ قومِهِ نحو التبصُّر والتدبُّر، ورَمَى إلى ملامسةِ وجدانِهم، وإثارةِ أحاسيسِهِم، وإيقاظِهِم من غفلتهم، لإِدراك القِيَم الخفيَّة عليهم، ولحملِهِم على فهمِ الحقائق التي ضَلُّوا عنها في أَمرِ الرسالةِ السماويَّةِ، وفي أمر الاختيار لها؛ وكان تبصيرُه لهم يَرمي إلى أنَّ الأمرَ ليس موكولاً إلى الظواهرِ السطحيةِ المحسوسةِ التي يَقيسون بها، بل إن القاعدة السليمةَ المستقيمةَ هي في اختيارِ العقيدةِ عن نظرٍ، وتدبُّرٍ وتفكُّرٍ، ومن دونِ أي قهرٍ، أو سلطانٍ، أو استعلاءٍ.
وفي سياق هذِهِ الظلالِ وردتْ كلمة «أَنُلزِمُكُمُوهَا» التي تكوِّن بحد ذاتها، قصة الإِيمانِ النابعِ من أعماقِ الإِنسان، المستشرفِ للحقيقةِ، بلا أدنى إكراهٍ، بل بملامسةٍ بسيطةٍ للفطرة فيهِ، وبعرض لَيِّنٍ للعقيدةِ، وهُما كفيلانِ بإقناعِهِ.
أوليستْ هذِهِ اللفظةُ القرآنيةُ إذنْ، دُنيا زاخرةً بضروبِ المعاني؟
بلى وإنَّ لَفِيها دُنيا مماثلةً في المباني..
- إنها - بعد التجريد - فعلٌ ثُلاثيٌّ هو «لَزِمَ»، متعدٍّ؛ يُفيدُ - لغةً -، كون الشيء مُلاصِقاً للشيءِ لا يفارقُهُ ولا ينفكُّ عنهُ.
- ضُوعفَ تعدّيهِ بالهمزِ فصارَ «أَلْزَمَ»، وأخذ مفعولَين، هما الضميران: (كاف الخطاب) و(ها) الغائبة.
- جاء بصيغة المضارع للمتكلِّمين «نُلزِمُ»، مضموماً إليه «الضميران»، ومزاداً فيه حرف «الواو» فصار لفظةً هي «أنُلْزِمُكُمُوهَا».
فَمِمَّ تتألفُ هذِهِ اللفظةُ؟
1 - هِيَ عَشْرَة أحرفٍ: ثلاثةٌ فيها أصليةٌ، وسبعةٌ مَزيدةٌ.
2 - زيدت الأحرفُ السبعةُ على «الفعل الأصلي» زيادةً لا يُستغنى عن أي حرفٍ منها، لتَبقى ناهِضةً بما تحملُهُ من بلاغةِ القولِ، وفصاحَة الأداءِ، وعُمقِ المعنى المرادِ بها.
3 - «الألفُ» تكررتْ فيها مرَّتَينِ: واحدةً لحملِ همزةِ الاستفهامِ والإِنكار، وثانية أُلحِقتْ بضميرِ الغائبِ لتفرّقَ بين تذكيرِ الضميرِ وتأنيثِهِ. 4 - «الميم» تكررتْ فيها مرّتَينِ: مرةً هِيَ مِنْ أصلِ «الفعل»، ومرةً علامةً على جمعِ الذكورِ.
5 - «النونُ» تصدرتْ «مضارعَهُ» أي الفعل المضارعَ.
6 - «الكافُ» جاءت ضميراً للمُخاطَبِ.
7 - «الواو» وقعت فيها زيادةً جماليّةً، لَيِّنةً لطيفةً، أُقْحِمتْ بين الضميرَيْنِ، وإنْ أنت اختزلْتَها وألغيتَها من «الكلمة الكاملةِ» تصبحُ الكلمةُ «مَأْمَأَةً» جافَّة، على الرغم مِنْ بقائها صريحةَ المعنى، موفيةَ الأداءِ، لا غُبارَ عليها في عالَمِ الصرفِ، والنَّحوِ، واللُّغةِ «الجافَّةِ» التي تَفْقِدُ عذوبةَ اللفظةِ وحسن الجرْسِ، وبلاغةَ التجويدِ!.
8 - استَكَنَّ في اللفظة ضميرٌ للمتكلم بالصيغة الدَّالة على العظمة، لأنَّ الخطابَ أصلاً آتٍ من عظيم «نحن» - تعبيراً عن الله العلي العظيم -.
9 - ظَهَر فيها الضميران البارزانِ: المخاطَبُ (كُمْ) والغائبةُ (ها).
10 - جاءَتِ الضمائرُ الثلاثة على أحْسن ترتيبٍ، إذْ بدأَ بالمتكلمِ المستترِ لأنهُ الأخصُّ بالفعل، وهو المعبَّرُ عنه بـ: «نُـ»، وثَنَّى بالمخاطَبِينَ لأنهم المقصودون بالحُكم، وانتهى بالغائب المتمّم للمعنى المُرادِ؛ ولم يُستَعْملْ معها ضميرٌ منفصل - مع جواز ذلك: أنلزمكم إيّاها - لئلاَّ يحصل بُعْدٌ بين عناصرها التركيبية البليغة، ولكي لا ينتُجَ التفريقُ بين موادِّ الصيغة البديعةِ.
لقد عظمَتْ حقّاً كلمةٌ - في القرآن - كانت تتألفُ من «ثلاثةِ» حروف، عندما صيغَتْ بسبْكٍ فنيٍّ مدهشٍ، ثم وصلت إلى «عشرة» حروف، إنْ أنتَ نزعْتَ حرفاً واحداً منها أفسدتَ رونقَها، وروعتَها، وجميلَ سبكِها... وهل عبثاً أَنْ تأتيَ هذه اللفظة على عَشَرَةِ حروفٍ، وتقعَ في نفس السورة (الآيةُ 13) التي يتحدَّى فيها اللّهُ تعالى كل الكائنات أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ مِثْلِ سُوَرِ القُرآن إن كانوا صادقِين؟ وهي قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *} [يُونس: 38].
فَمزيداتُها تلك ضاعفتْ حروفَها ثلاثَ مراتٍ، ثم زادتْ حرفاً ليس من عناصرها الكثيرة، ومع ذلك بدا تناسقُها الفنيُّ وهو يرسُمُ لها الصورة التي تُبيِّنُ الجوَّ الذي صدرتْ فيه حكايةً عن نبيِّ الله نوح عليه السلام، وذلك بإدماج ذلك «الفعل» مع تلك «الضمائر» في النطق، وبشدِّ بعضها إلى بعضٍ، كما يُدْمَجُ قومُهُ الكارهون لدعوته، مع ما يكرهون، وكما يُشَدُّونَ إليه وهم منه نافرون، فظهر فيها ذلك اللَّون من التناسق، الذي كان أعلى من البلاغة الظاهرية، وأرفَعَ من الفصاحة اللفظية!!
وإلى جانب تلك المعاني، والمباني، فإنَّ هذه اللفظة تحمل أيضاً عدة أحكام:
- ففيها نَفْثةُ نبيٍّ مصدورٍ، مُتْعَبٍ من عنادِ قومِهِ ومكابرَتِهِم.
- وفيها جَدَلٌ بالتي هي أحسنُ.
- وفيها أنه لا إِكراهَ في دينٍ، ولا جَبْرَ في عقيدةٍ.
- وفيها اسْتفهامٌ إنكاريٌّ موجَّهٌ لمخلوقينَ عاصينَ، يَرأفُ بهم خالقُهُم ونبيُّهم، ويُثيرانِ في نفوسِهِم عوامِلَ التأمّلِ والتفكّرِ..
فَباللَّهِ عليك أيُها القارئُ:
مِنْ أين فهمنا ما فهمنا مِنْ هذِهِ «الكلمةِ» المفردةِ منْ كتابِ الله الكريمِ، وإنْ كانَ، ربما، قد فاتَنا الكثيرُ، وخَفِيَ عنا الأكثرُ؟
إنه لم يكُنْ ليتأتَّى لنا ذلك لولا التحليلُ.. أي لولا: الصَّرف والنحو.. يعني: لولا الإِعراب الذي هُوَ الأداةُ الأُولى لمعرفةِ التفسيرِ..
فلولا الإِعراب، ومعرفة قواعدِهِ، ما كان ليتسنّى لنا أن نفهم معانيَ القُرآن المبين، ولا أن ندرك مواطن جماله، ومَحَالَّ بلاغته وإعجازه، وسائرَ أوامره ونواهيه، ومصادر أحكامِهِ في حلاله وحرامِهِ، وآيات وعده ووعيدِهِ.
فما أحْرانا إذاً بإتقانِ الإِعراب، لنكشِفَ عن غوامضِ لُغتِنا، وكنوزِ قُرآنِنا العظيمِ!
وما أجدرنا بفهم ما هو على نَسَقِ لفظةِ «أَنُلْزِمُكُمُوهَا» في هذا القُرآن الكريم مثل: {فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ} [الحِجر: 22] و: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزَاب: 37] و: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} [البَقَرَة: 137] و: {إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا} [محَمَّد: 37]. وما إلى ذلك من العبارات والألفاظ التي تحملُ التحدِّيَ الدائمَ للعقلِ البشريِّ...
وبعد أنْ أوردْنا مثالاً، كان عبارةً عن لفظةٍ واحدةٍ منَ القرآنِ الكريمِ، نورِدُ الآنَ للقارئ الكريمِ، مَثَليْنِ آخرَيْنِ مِن الكتابِ المُبينِ، يُبيِّنانِ أهميةَ معرفةِ الإِعرابِ - بقواعد صرفِهِ ونحوِهِ - من أجلِ الضرورةِ الماسَّةِ إلى فهمِ التفسيرِ الدقيقِ لكتابِ الله الذي لا يأتيه الباطلُ من بَينِ يديهِ ولا من خَلْفِهِ.
المثلُ الأولُ هُوَ «الآية 24 من سورة البقرة» حيث يقولُ الله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البَقَرَة: 124].
إنَّ هذا المطلع للآيةِ الكريمةِ يدلُّ على الابتلاءِ، ولكنه ليس ابتلاءً بالمعنى الحقيقي بمقدارِ ما هُوَ اختبارٌ منهُ سبحانه وتعالى، وهو الذي يُعَامِلُ عبادَهُ المؤمنين معاملة المُبْتَلَين، للتأكيدِ على امتثالهمِ الدقيقِ لأوامرِ ربِّهِم العليِّ القديرِ، وذلك مَعَ علمِهِ المُسَبقِ بما سيفعلونَهُ قبل وُقوعِ الفعل مِنْهُمْ.
ولكن أين الابتلاءُ أو الاخْتبارُ في الآية؟
لقد قيل في التفسير: إنَّ الابتلاءَ كان عندما أرى اللّهُ سبحانَهُ خليلَهُ إبراهيمَ في المنام أنه يذبَحُ ابنَهُ إسماعيلَ عليهما السَّلام.. فإبراهيمُ، وهو المُمْتَثِلُ لأمر ربِّهِ، قد جاءَتْهُ تلك الرؤيا، فكانتْ أعظَمَ بلاء وابتلاء لهُ، لأنَّهُ ليس أشَدَّ على الإِنسانِ من أن يذبَحَ فِلْذَةَ كبده بيدِهِ؛ أفلا تكون تلك الرؤيا - إذاً - أصعبَ اختبار من اللّهِ - سبحانَهُ - لعبدِهِ، وأعظَمَ ابتلاءٍ عند ذلك العبدِ؟
بلى.... ولقد قيل في تفسيرٍ آخر: إنَّه سبحانَهُ وتعالى قد كلَّف أبا الأنبياءِ عليه السلامُ بحَمْلِ العقيدةِ الحنيفيةِ بكامِلِها، والقيامِ بتكاليفِها، ولم يُكلَّفُ بمثلِها نبيٌّ قبلَهُ، فكان التكليفُ شديداً، وكان الابتلاءُ على قدر تلك الشدة، والاختبارُ على قدْرِ صعوبةِ الاحْتمالِ..
على أنه، سواءٌ كانَ الاختبارُ في الرؤيا، أو التكليفُ بحملِ العقيدةِ، هُوَ المقصود فإنَّ في ذلك دلالةً على الابتلاء والاختبار. ولكنْ هل كان يظهرُ لنا ذلك لو جاءتِ الآية على غير ما وردت عليه من تركيب؟ يحتمل الذهنُ الساذجُ أنَّ التركيب يمكن أن يكون: «وإذ ابتلى الربُّ إبراهيمَ بكلماتٍ،...»، فلو صحَّ مثل هذا الاحتمال، لجاءَ المعنى مجرد إخبارٍ عن موضوع الابتلاء، ولكنه يَضيعُ معه جلالُ قصةِ الابتلاء المنوَّه عنه في الآية المباركة، وتنزل قيمةُ القصة عن موقِعِها المَهِيبِ الذي تتبوّأه.
ويتوضَّحُ لنا ذلك، إذا لجأْنا إلى التدقيقِ في بناءِ الآيةِ وعرفْنا إعرابها... فبهما نلاحظُ أنَّ:
- الواو: جاءت بمعنى: اذْكُرْ (يا محمَّدُ) القصة التي حدثت لنبيٍّ من أنبيائي.
- إذْ: ظرفيةٌ تدلُّ على زمانٍ حدثتْ فيه تلك القصةُ.
- إبراهيمَ: حصل هنا تقديم المفعول به على العامل فيه، مع أن رتبة الفاعل تتقدم على رتبة المفعول عادة، أي أن التقديم قد جرى على عكس ما نألف في اصطلاحنا.
ربُّهُ: حصلَ فيه تأخُّرُ الفاعِلِ عن معمولِهِ لفظاً، وإنْ كان ينبغي أن يتقدمَ رُتبةً.
إِذْ قد قال النُّحاةُ، لا يجوزُ تقديمُ الضميرِ لفظاً ورتبةً، لأنَّ من شأنِهِ أن يعودَ على سابقٍ إمَّا لفظاً وإمَّا رتبةً، ولا يجوزُ أن يعودَ على متأخرٍ لفظاً ورتبةً.. وقد حصلَ التقديمُ والتأخيرُ في الآيةِ الكريمةِ خِلافاً لِمَا نألفُهُ نحن من الاصطلاحات.
فما معنى ذلك التقديمِ والتأخيرِ؟
إن التقديم يَكشِفُ عن مدى الاهْتمامِ بالابتلاءِ الحاصلِ من الله تعالى لعبده. فمن المعلوم أنَّهُ عزَّ وجلَّ هو الذي يَبتَلي، وأنَّ العبد هو الذي يُبْتَلَى، ولا شُبْهَةَ تَحصَلُ مِنْ مخالفةِ العُرف المتَّبعِ في تركيبِ الجُمَل؛ لذلك عَمَدَ إلى تقديمِ المفعولِ وتأخيرِ الفاعلِ عنه، ومن ثَمَّ تأخير الضميرِ المتصلِ العائدِ لذلك المفعول، مع قَرْنِهِ بالفاعِلِ، وفَعَلَ ذلك كلَّه من أجلِ أن ينصبَّ الاهتمامُ على الغايةِ الكبرى المَعْنِيَّةِ في الألفاظِ القليلةِ... أَلاَ وهي أهميَّةُ الموضوعِ الذي عَرضتْ له الآيةُ الكريمةُ.
فلَو أنَّ تركيبَ الآية جاءَ عاديّاً، على غير النحو الذي وردتْ فيه، لكانتْ مجردَ خبرٍ مؤدَّاهُ أنَّ الله تَبارك وتَعالى ابتلَى رسولَهُ إبراهيمَ بتكليفٍ ما... وأنَّ هذا التكليفَ كان عبارة عن كلماتٍ أوْحاها إليه فتقبَّلهُنَّ مِنهُ وأَتَمَّهُنَّ... ولكنْ أنْ تجيءَ الآيةُ بتلك الصيغةِ التي هِيَ عليها، فهذا يُوحي بجَلالِ التكليفِ وبعظيمِ شأنه، كما أنه يُنبىء عن منتهى البلاغة التي فرض عليها أن تراعي ما يجب أن يحمله التركيبُ من معانٍ سامية، وصور هائلة: سواء كانت لملحمة يذبَحُ فيها نبيٌّ ابنَهُ، أو كانت لقضية تكليف ثقيل بشريعة صعبة أنزلها الله تعالى على نبيٍّ، هو خليلٌ له، وأمَرَهُ باتِّباعها دفعةً واحدة، وبإيصالها إلى الناس كاملةً... ومن هنا ندرك عظمة القرآن وجلاله بما فيه من آياتٍ بيِّنات.
أما المثل الثاني فهو «الآية 100 من سورة الأنعام» وفيها يقولُ اللّهُ تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [الأنعَام: 100].
فاسْتِفْتاحُ الآية بـ«وَجَعَلُوا» يَدُلُّ على قضيةٍ بالغةِ الاهْتمامِ، وهِيَ قضيةُ الافْتِراءِ على الله سبحانه وتعالى من بعض الناس، ذلك الافتراء الذي جَعَلَهُم يقولون بأنَّ له شُركاءَ، في حين أن خَلْقَهم وتسييرَهمُ يُنبئانِ بأنهُ ليس لخالقهم مِنْ شريكٍ..
وكذلك، إذا عزلنا عبارة: {لِلَّهِ شُرَكَاءَ} [الأنعَام: 100] وحدَها، نجدُها شبهَ جملةٍ يتجمَّعُ فيها كل معاني الشِّرك، ولكنَّ وضْعَها بعد «الْجَعْل» الذي يحمل بحدِّ ذاتِهِ الاستهجانَ والافتراءَ، يُضيفُ إليها معنَى استنكار الشِّركِ، فكان لزاماً أن يأتيَ ذلك الاستفتاحُ وأنْ يليَه شِبْهُ الجملة لتأدية كلِّ المطلوب.. ذلك أن «شِبه الجملةِ» في اللُّغة يُهيىءُ استفتاحُهُ دائماً الأذهانَ لمعرفة ما قدْ يحمِلُ الكلامُ منْ مفاجأةٍ أو إخبارٍ أو حَدث الخ.. فإذا قلنا لواحدٍ من الناس: «في بيتِكم...» وسكتنا، فإنَّ ذهنَهُ يتهيَّأُ لمعرفةِ ما في بيتِهِ: أهُوَ فرحٌ، أو ترحٌ، أم عزيزٌ أم عدوٌّ... فاستفتاحُ كلامِ الله سبحانهَ (بالجَعْلِ) جاء يُفاجىءُ السامِعَ أولاً، وَلِيُخْبِرَ بعد المفاجأة بافتراء الشريك، تنويهاً بعظيم الاهتمام منه تعالى للحدَث، وتنديداً بفظاعة الافْتراء من قِبَلِ المشركين..
ولو أنَّ تركيب الآيةِ جاءَ على نحو آخر، مثل: «وجعلوا الجنَّ شركاءَ للّهِ» لكان ذلك مجرد إخبار بأنَّ أناساً أو بعضاً من الناس قد أشرَكُوا الجنَّ مَعَ الله، أو أنَّ الذين أشركوا الجنَّ مع الله هم من الناسِ... والأمرُ هكذا معروفٌ عندَ الذين قالوا بالشَّريك، وعند الذين اتَّبعُوهُم عليه.. وهذا لا يَستدعي الإِنكار ولا الاستهجانَ!...
أما أنْ يأتِيَ تركيبُ الألفاظِ على الشكلِ الذي ورد في الآيةِ المباركةِ، فإنَّ الوضْعَ يختلفُ عندئذٍ تماماً، لأنه يُبيِّنُ هَوْلَ الصُّورة التي أرادَ اللّهُ سبحانَهُ أن يرسمَها في الأذهان عن شرك المشركين، وهو نبأ عظيم من مُوجِدِهم وخالقهم ورازِقِهمْ، إلاَّ أنهم مع ذلك الوجودِ والخلقِ والرزقِ، استكبرُوا وأَشرَكُوا معَهُ في الألوهيةِ والقُدرةِ غيرَه!.. فكان لا بُدَّ، ولكي تظهرَ تلك الصورةُ على فظاعتها، من تقديم لفظة «شُرَكَاءَ» للاستهجان من الشِّرك أولاً، ثُمَّ للتَّنويه الساخر بالشريك المجعول الذي هو خلقٌ ضعيف أمام ألوهية الله الخالق. وهكذا كان لتقديم لفظ «شُرَكَاء» على لفظِ «الْجِنَّ» أهمية كبرى، إذ أوضح فظاعةَ الشِّرك وقُبْحَهُ، ودلَّ على إنكار الله - سبحانه - لذلك الشِّرك إنكاراً عظيماً، لأنه يُعتبر ظُلْماً شديداً لقدسية ربوبيتِهِ - وهُوَ لاَ يَغفِرُ أنْ يُشرَكَ به - ثم ثَنَّى بلفظةِ «الْجِنَّ» لاستِثْباتِ ضعْفِ الجِنِّ المَخْلوقِ أمامِ الله الخالِقِ..
ولم يَكُنْ مِنْ داعٍ لا للإِنكارِ ولا للاستهجانِ، لو لم يَكُنْ في الأمرِ مخالفةٌ للمبدأ الأصيل: وهُوَ أنهُ لا يَنبغي أن يكونَ لله شريكٌ لا مِنَ الْجِنِّ ولا مِنَ الإِنْسِ.. أَمَا وإنَّ بعضَ المُشركينَ قد عَبَدوا مخلوقاتٍ ضعيفةً تفتقِرُ بوجودِها إلى موجِدٍ، فقدْ جاءَتِ الآيةُ الكريمةُ تحملُ المفاجأةَ التي تقرَعُ السَّمْعَ وتُوقِرُ الذِّهنَ وكأنَّها تصرُخُ في خلائقِ السماواتِ والأرضِ كلِّها: أَنِ انْظروا إلى ذلكم المخلوق الذي اتخذ شريكاً لخالقه، أَمَا تفكَّر بأنَّ من اتَّخذه شريكاً إنَّما هو مفتقرٌ إلى غيره في أصل وجوده، بل ومفتقر في كينونته ومصيره إلى الله تعالى الذي لا إلهَ إلاَّ هُوَ، وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، سبحانَه وتَعالى عمَّا يَصِفُونَ!
إذاً فقدْ جاءتِ الآيةُ الكريمةُ تبيِّنُ أهميةَ الموضوعِ المخبَرِ عنهُ. وليسَ غيرُها أبداً، بقادر على أن ينقُلَنا إلى جوِّ تلك الصورةِ المستنكَرَةِ للشركِ مَعَ ما فيها من هولٍ مليءٍ بالسُّخرية والاستهجانِ.. وهِيَ في الوقتِ نفسِهِ لا تَتَخلَّى عَنْ روعةِ التعبيرِ، وبلاغةِ السَّبْك، اللَّتيْنِ لولاهُما لما هزَّت المفاجأةُ المشاعِرَ، ولا حرَّكتِ الأحاسيسَ لِتُشيع نورَ الألوهيةِ الحقةِ في القلوبِ الموحِّدَةِ المؤمنةِ التي تُنَزِّهُ الخالقَ سبحانَهُ وتعالى عن كل شريكٍ ونِدٍّ...
ومثلُ هذِهِ الآية قولُهُ تَعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فَاطِر: 28] [فاطر: 28] حيث نرى التَّنويه عن خشية الله الباعثة على الالتزام بأوامره ونواهيه، والتي تجعل الملتزم بها من عباد الله الصالحين.. فبعد التأكيد بـ(إنّ) حَصَرَ حصولَ الخشية بِـ«العُلماء» من خلقِهِ دون غيرِهِمْ، لأنهُمْ همْ أكثرُ من غيرهمْ تفكُّراً بعظمتِهِ وجلالِهِ، وتأمُّلاً بقدرتِهِ وسلطانِهِ... وقد كان تقديمُ شِبهِ الجُملة {مِنْ عِبَادِهِ} [فَاطِر: 28] لبيان أهمية العلم الموصِل لخَشيةِ الله تبارك وتعالى. ولذا نرى أنه قد ذَكَرَ (العلماء)، بعد أن نبَّهَ الأذهانَ وهيَّأ الإِدراك لسماع ذكرِهِم، لأنَّهُم وحدَهُم يَحتلُّون تلك المرتبة السامية التي تُؤدي إلى رضوانِ الله ورحمتِه.
وهكذا، وبناءً على هذا الفهمِ المتواضعِ لمواقعِ بعضِ كلامِ القرآنِ الكريمِ، مِنْ وراءِ اختلافِ التركيبِ عنِ المألوفِ، تيسَّرَ لنا إدراكُ جانبٍ مِنَ المَعنى الذي أنبأَ عنه اختلافُ المَبْنى الذي نعهدُهُ. والإِعرابُ هُوَ - وحدَهُ - الذي أَتاحَ لنا أن نكشف النقاط الدَّقيقة التي رمتْ إليها الآياتُ الكريمةُ.
ومن هنا يتبيَّنُ أنَّ الإِعرابَ يجبُ أنْ يدورَ دائماً مع فهمِ النَّصِّ القُرآنيِّ الكريمِ، وليسَ النصُّ القرآنيُّ هو الذي ينبغي أن يخضع لقواعد الإِعراب البدائية التي نتعلَّم منها نُتَفاً مبثوثة في كتب قواعد النحو والصرف. وإنه بدون فهم معنى القرآن العظيم لا يتأتَّى لنا أن نعرف الإِعراب، علماءَ كنَّا أو مبتدئين.
فإذاً، لن يُفهَمَ القرآنُ دون فهم الإِعرابِ والعكسُ يَصحُّ. أي أنَّنا إذا فَهِمْنا القرآن فهِمْنا الإِعراب، بل لولا القرآن لَمَا عرفْنا الإِعرابَ، لأنه لا يُستقَى إلاَّ من نبعِهِ الأصيلِ... فكما أن القرآن الكريم هو مصدرُ تشريعٍ، فإنَّه كذلك مصدر ابتكارٍ لقواعِدِ الإِعرابِ، وعنهُ صَدَرَ هذا العلمُ.. فَلْنَتَعَلَّمْ...
طبقاتُ النُّحاة
تلك كانت نشأةُ علم النَّحْوِ، وقد نشط علماءُ اللُّغةِ في ميدانِ تنميةِ ذلك العلمِ، وإكمالِ أبوابِهِ، وتفصيلِ مسائلِهِ، وقد بلغَ البحثُ فيه ذُروتَهُ في بلادِ العراقِ وخاصةً في مدينَتَي البصرةِ والكوفةِ.
أما الطريقةُ التي اعتمدتْ في دراسة علم النحو فلم تشُذَّ عمَّا كان مألوفاً في تلك الأيامِ، ونعني بذلك الطريقة القائمة على التلقي الشفهي أو المقرون بالإِملاء أو ببعض القراءات لمؤلفات إنْ وجِدَ شيءٌ منها. فكان المتعلّم يأخذ عن أستاذِهِ ما يلقيه أو يمليه عليهِ، أو كان يقرأ الكتب ويشرح عباراتها، ويعلِّق على مسائِلِها ثم يُضيفُ إلى ذلك ما يتكوَّنُ لديه مِنْ آراء.
وكانَ أولئك الطلابُ، بعدَ أنْ تكتمِلَ معلوماتُهُم، وبعد أن يأخُذوا نصيبهُم مِنَ التعلُّمِ والمعرفة، يعودون إلى أدب مَن سبقهُمْ بإقامةِ حَلَقاتٍ للدرس أو أماكِنَ للبحثِ، تقصدُها طائفةٌ من الطلاب الجدد كي يأخذوا عنهم، ويرووا ما سمعوا وما دوَّنوا... وبذلك نشأت للنحاة طبقاتٌ أو مدارسُ متعاقبةٌ، كان أشهرُها سبعَ طبقاتٍ من البَصرِيين، وخمسَ طبقاتٍ من الكُوفيين، برز في كلِّ طبقةٍ عددٌ من العلماءِ اهتمُّوا بناحية أو بأخرى من نواحي النحوِ.
ومن علماء البصرة:
الطبقةُ الأولى: وأشهرُ رجالها: أبو الأسود الدؤلي. وقد أخذ عنه ثلاثة هم: عَنْبَسة الفيل، ونصر بن عاصم الليثي، ويحيى بنُ يعمُر.
الطبقةُ الثانية: وأشهر علمائِها: أبو عمرو بن العلاء، وابن أبي إسحاق الحضرمي، وعيسى بن عمر الثقفي، وقد اهتمت هذه الطبقة بالقياس والتعليل وبالعناية بتتبُّع النصوص، واستقراء الشواهد، ومن ثم جمع مسائل النحو المعروفة في ذلك الوقت في كتب قامت على وَضْعِها..
الطبقةُ الثالثةُ: وكان شيخها الخليل بن أحمد (100 - 175هـ). فقد عكف على علم النحو يستنبطُ أصولَهُ، ويجتهد في هذه الأصول ويُفَرِّعُ عنها، بطريقة لم يسبِقْهُ إليها أحدٌ مِنْ قبلُ. وهو أولُ مبتكرٍ للمعاجِمِ العربيةِ. وقد سُمِّيَ أولُ مُعْجمٍ وضَعَهُ «العين».
الطبقةُ الرابعةُ: وشيخُها سيبويه - عمرو بن عثمانَ بن قَنْبَرِ - كان أعلم المتقدمِين والمتأخرِينَ في علمِ النحوِ، ولم يوضَعْ فيه مؤلَّفٌ يعلو على مؤلَّفِ «الكتاب»! وعنه قالَ الجاحِظُ: «لم يكتُبِ الناسُ في النحوِ كتاباً مثلَهُ. وجميعُ كُتُبِ الناسِ عِيالٌ عليه».
الطبقةُ الخامسةُ: وإمامُها أبو الحسنِ سعيد بن مسعدةَ، المعروفُ بالأخفشِ. أخَذَ عن سيبويهِ، وإليهِ يرجِعُ الفضلُ في نَشْرِ كِتابِهِ.
الطبقةُ السادسةُ: وسيدُها أبو عثمانَ المازنيُّ، إمامُ عصرهِ في النحوِ والأدبِ.
الطبقةُ السابعةُ: وشيخُها أبو العباس محمدُ بنُ يزيدَ المبرِّدُ. وقد ذَكَرَ له صاحب الفهرسْت (44) مؤلَّفاً في الأدبِ واللغةِ والنحوِ والعروض والبلاغةِ والقُرآنِ. ومن كُتُبِهِ «الكاملُ»، الذي يجمَعُ ضُروباً مِنَ الآداب بين نثرٍ وشعرٍ، ومَثَلٍ سائرٍ، وموعظةٍ بالغة، وخطبٍ ورسائل، مع تفسير كل ما يقع فيها من كلامٍ غريبٍ أو معنى مغلقٍ.
أما أبرزُ علماءِ الكوفةِ فهُمْ:
الطبقةُ الأولى: وشيخُها أبو جعفر محمدٌ الرؤاسي. أولُ من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو دعاه «الفيصل».
الطبقةُ الثانيةُ: وشيخُها عليُّ بن حمزة مولى بني أسدٍ، وهُوَ المشهورُ بالكسائي. كان من أصل فارسي، ويعتبر بحقٍّ مؤسس المذهب الكوفي، ويعد من القراء السبعة. استقدمه الخلفاءُ العباسيون إلى بغداد ليعلِّم أبناءَهم.. وقد قدَّمه البرامكة فارتفعت منزلتُه. وكان الخليفةُ الأمينُ يتعصَّب لمعلِّمه الكسائي في المناظرات.
الطبقةُ الثالثةُ: وشيخُها الفرَّاءُ، أبو زكريا يَحيى بنُ زيادٍ. تتلمذَ على يدِ الكسائي. وقد أمره المأمون أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع من العرب. ومن كتبه: «معاني القرآن» و«كتاب المذكَّر والمؤنَّث».
الطبقةُ الرابعةُ: وشيخها أبو يوسفَ، يعقوبُ بن السِّكِّيتِ. وهُو الذي قال عنه المبرِّد: ما رأيت للبغداديين كتاباً خيراً من كتاب يعقوب بن السِّكِّيت في إصلاح المنطِقِ.
الطبقةُ الخامسةُ: وشيخُها أبو العباس أحمد بن يَحيى، المعروف بثعلب؛ وكان إمام الكوفيين في النحو واللُّغة في زمانه.
فهؤلاء وغيرُهمْ منْ علماءِ الكوفةِ، ومثلُهُم منْ علماءِ البصرةِ، وصلوا بعلم النحو في أواخر القرن الثالث الهجريِّ إلى الغاية، ورتَّبُوا مسائِلَهُ ونظَّموا أبوابَهُ. ولمّا كانت بغداد، في حقبة من التاريخ، موئلاً للعلماءِ وقبلة للدارسين، فقد حظي علماء النحو الكوفيون بتشجيع الخلفاء العباسيين، ونيل رضاهُم. على أنَّ ذلك لم يمنَعْ نُحاةَ البصرة عَنِ الذهابِ إلى بغدادَ، فقد غَشِيَها فريقٌ منهم، واتَّسَعَ أمامَهُمُ المجالُ لعرْضِ آرائِهِم. وبذلك أُتيحَ للبغدادِيينَ أن يَنْظُروا في المذهَبَيْنِ: البصريِّ والكوفيِّ، وأنْ يُوازِنُوا بين آراء الفريقين، حتى تسَنّى لهم إنشاء مذهبٍ خاصٍّ بهم، يقومُ على المُستحسَنِ من ذَيْنِكَ المذهَبَين، مع إدخال آرائهم الخاصة عليه: وممَّن برز من نُحاة بغداد: ابن خالويه، أبو الحسن بن أحمد بن خالويه الهمذاني، وأبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، وابنُ جنيِّ أبو الفتح عثمان، والربعيُّ أبو الحسن علي بن عيسى البغدادي، وكان منهم أيضاً التبريزي والزَّمخشري محمود بن عمر، وغيرُهم وغيرُهم...
ومثلُ أهلِ العراقِ، كان لعلمِ النحوِ بحَّاثون أيضاً من أهلِ الأندلسِ والمغربِ، ومن بلادِ مِصرَ والشامِ. ذلك أنه بعد إغارةِ التَّتَارِ على بغدادَ وسقوطِها على أيديهِمْ، مع ما أعقبَ ذلك مِنْ إحراقِ مكتباتِها وتشريد العاملين بالبحث والدرس، عمد هؤلاء إلى الأمصار الأخرى ليتابعوا صِناعَتَهُمْ تِلكَ. لهذا نشأ بحّاثُون عَمِلوا جميعاً على تعويضِ النَّقْصِ الذي حَصَلَ مِنْ جرَّاء وحشيةِ التَّتارِ، وإقامةِ بناءِ العلومِ العربيةِ مِنْ جديدٍ، مُعتمدينَ على البقيةِ الباقيةِ منْ ذخائِرِ المتقدمينَ، مِمَّا لم تلتهِمْهُ نيرانُ المُغيرينَ، فعكفوا على التأليفِ والجَمْع والشَّرْحِ، حتى أثمرَتْ جهودُهم في الميادينِ التي خاضُوها، وكان فضلُهُم كبيراً على تلكَ العلومِ.
الاختلافُ في تحديدِ دائرةِ القواعدِ النَّحويةِ
ذلك التشعُّبُ الذي حصل في المدارس والمذاهب، أو الاختلاف الذي ظهر في الطرق والأساليب أثناء دراسة علم النحوِ، إِنَّما كان مردُّه إلى الاختلاف في تحديد دائرة القواعدِ النحويةِ. فمِن الباحثين من رأى أن تشتمِلَ هذه القواعدُ على أساليبِ اللُّغةِ منْ جميعِ نواحيها، ومنهُم من قَصَرها على ضبطِ أواخرِ الكلماتِ، ومعرفةِ البُنيانِ فيها، واشتقاقِها وتصريفِها.
وإذا كان من سببٍ يُعزى إلى ذلك الاختلافِ فهُوَ يرجع إلى صلةِ علمِ النحوِ بالفروعِ الثقافيةِ الأُخرى للعربية، لأنَّ علم النحو هُوَ أحدُ هذه الفروعِ، وقد كانتْ تشتملُ في أوائل الأمر على النحو واللُّغة والأدبِ، ثم اتَّسَعَ نطاقُها لتشملَ الأخبار والسير، ثم ازدادتْ حتى أصبحت اثنَي عشر فرعاً، وهِيَ:
اللُّغةَ - الصَّرف - الاشتقاق - النحو - المعاني - البيان - الخط - العروض - القافية - قرض الشعر - إنشاء الخطب - الرسائل والتاريخ.
ولقد كان النحو في الأدوار الأولى للثقافة الإِسلاميةِ مُمتزجاً باللغة والأدب وعلم القراءات. ومن هنا نشأَ الخلطُ بين علمِ النحوِ وعلمِ الإِعرابِ، حتى أن بعضهم وهو يحدِّد النحو كان لا يميِّزه عن الإِعراب. ولهذا فقد سمَّوا ما كشفُوا من عللٍ وأسبابٍ لضبطِ أواخرِ الكلمات: عللَ الإِعراب - أو عللَ النحو، ثم لم يلبثُوا أن أوْجزُوا، فسمَّوْها علم النحو أو الإِعرابِ.
والواقعُ أنَّ لكلٍّ من النحوِ والإِعرابِ دوراً يؤديه في علمِ اللغةِ، أو مهمة يقومُ بها في الأداءِ.
تعريفُ علمِ النَّحوِ
النحوُ - لغةً - له معانٍ متعددةٌ مثل: الطريق: (نَحَوْتُ نحو المسجد)، والمقدار: (عند فلانٍ نحوُ مئة درهمٍ أو نحو عشرةِ أكياسٍ منَ الحنطة)، والميل، والقصد وما إلى ذلك من معانٍ مختلفة.
وقد وردتْ للنحو تعاريفُ مختلفةٌ، فقيل بأنه: قانونُ تأليفِ الكلام وبيانٌ لكلِّ ما يجبُ أن تكونَ عليه الكلمةُ في الجُملة، والجملةُ مَعَ الجُمَلِ حتى تتَّسقَ العبارةُ وتؤديَ معناها... وذلك أنَّ لكلِّ كلمةٍ، وهي منفردةٌ، معنًى خاصّاً، تتكفل اللُّغة ببيانه. وللكلماتِ مركَّبةً معنًى، هُوَ صورةٌ لما في أنفُسِنا وما نقصدُ أن نُعبِّر عنه ونؤديَهُ إلى الناس... وتأليفُ الكلماتِ في كل لغةٍ يجري على نظامٍ خاصٍّ بها، فلا تكونُ العباراتُ مفهومةً ولا مصوِّرةً لما يُرادُ، حتى تجريَ عليهِ ولا تحيدَ عنهُ.. والقوانينُ التي تمثلُ هذا النظامَ وتحددُهُ، إنما تستقرُ في نفوس المتكلِّمين وملكاتهم، وعنها يصدر الكلام، فإذا كُشفَتْ ووُضعتْ ودُوِّنَتْ فهِيَ علمُ النحوِ.
ولقد أورد ابن جنِّي في كتابِهِ «الخصائص» تعريفاً للنحو على الشكل التالي: «النحو هو انتماء سمت كلام العرب في تصرُّفه من إعراب وغيره: كالتثنية والجمع، والتصغير والتكسير، والنسب والإِضافة وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها، أو إن شذَّ بعضهم عنها رُدَّ إليها».
فالنحو عند ابن جنِّيّ هو ما يهدف إلى محاكاة العرب في طريقة كلامهم تجنُّباً للَّحن، وتمكيناً للمستعرب في أن يكون كالعربي في فصاحته وسلامة لغته عند الكلام. وإن العلم الذي يضم القواعد التي تحقق هذَين الغرضَين يكون علم النحو.
مهمة الإِعراب
والإِعرابُ في اللغة هو: الظهورُ والإِبانةُ. وأعربَ الرجلُ: إذا تكلم بالعربية.
والإِعرابُ اصطلاحاً: هو بيانُ أثرِ العامِلِ. أو كما يذهبُ إليه الباحثون، له معنيان:
الأولُ: بيانُ علاقةِ الكلمات بعضها ببعض في الجملة، فيقالُ لك مثلاً:
«أعرِبْ هذه الجملةَ»، أي بيِّنْ علاقاتِ ألفاظِها بعضِها ببعضٍ من حيثُ كونُها فاعلاً أو مفعولاً، أو مبتدأ أو خبراً، أو نعتاً أو حالاً إلخ...
والثاني: الحالةُ التي تقتضيها تلك العلاقةُ في آخر الكلمة لفظاً أو محلاًّ. وهذه الحالةُ لا تخرجُ عن أن تكون رفعاً أو نصباً أو جرّاً أو جزماً. ولكلٍّ من الرفعِ والنَّصبِ والجرِّ والجزم علامةٌ تختلفُ باختلافِ نوعِ المُعْرَبِ.
وقد قالَ الزجَّاجُ في كتابه «الإِيضاح»: «والإِعرابُ: أصلُهُ البيانُ. ثم إنَّ النَّحويينَ لمَّا رأَوْا في أواخرِ الأسماءِ والأفعالِ حركاتٍ تدل على المعاني وتُبينُ عنها... سمَّوها إعراباً، أي بياناً. وكأنَّ البيان بها يكونُ».. ومما جاء في كتابهِ:
«إنَّ الكلام سابقٌ للإِعراب. وإن الإِعراب عَرَضٌ داخلٌ في الكلام لمعنًى يوجده ويدل عليه. فالكلامُ إذاً سابقُهُ في المرتبةِ. والإِعرابُ تابع من توابعِهِ»... وقد مثَّلَ لرأيه - هذا - بدلالة الأسماء على مسمَّياتها... نحو: زيد. محمد. جعفر...ودلالة الأفعالِ على المعاني الفعلية، دونَ حاجةٍ إلى الإِعرابِ.
توضيح المفاهيم
لقد تبينَ أنَّ علماءَ اللُّغة لم يتفقُوا على تحديدٍ واضحٍ للنحو، فكانتْ له تعاريفُ عديدةٌ، ومنها نشأَ الخلطُ ما بين النحوِ والإِعرابِ. ومهما تكن الآراءُ فإن النحوَ قسمان: قسم: مصطلحات أو تسمياتٌ تضافُ إليها أحكامٌ خاصة كتسميةِ الفاعلِ والمفعولِ والمبنيِّ والمُعْرَبِ إلخ... وقسمٌ: فهمٌ وتمييز.
وهذانِ القسمانِ لا ينفكُّ أحدُهما عَنِ الآخر. ولا بأسَ منْ أن نُطلِقَ على القسمِ الأول «اسمَ النحو» الذي هو عبارة عن استظهارِ المُصطلحاتِ أو التسمياتِ، وعلى القسمِ الثاني «الإِعراب» الذي هو التطبيقُ من حيث فهم وتمييز كل لفظة في مقامها وبتحريكِها بموجبِ هذا المقامِ الذي شغلته، وإن كان علم النحو عند الإِطلاق يشملهما معاً.
وعلى هذا فإنَّ النحو هو علمٌ بأصولٍ، تعرفُ بها أحوالُ أواخرِ الكلمِ من جهةِ البناءِ، في حين أنَّ الإِعرابَ هو معرفة كيفيةِ تحريكِ الكلمةِ في أواخرها.
ولقد كان الاهتمام في الأصل مُنصبّاً على العلوم القُرآنيةِ، وبما أنَّ علمَ النحوِ هو عمادُ تلكَ العلوم، فإنَّ الإِعرابَ هو خلاصَتُه، إذْ لا يَملكُ زمامَ النحوِ متعلِّمٌ إلاَّ إذا مَلَكَ الإِعرابَ، وإلاَّ وَقَفَ عند حد الاستظهارِ، ولم يتجاوزْهُ إلى التطبيقِ الذي هُوَ ثمرةُ العلم. والعيبُ الذي لَحِقَ بفنِّ الإِعرابِ مِنَ الإِسرافِ فيه لا يصحُّ أن يعوقَ الأخذَ به، فمَعَ كل تطبيقٍ إسرافٌ، ولولا هذا الإِسراف لم يكن ذلك الذي مكث مما ينفع الناس.
في التمييز ما بينَ الصرفِ والنحوِ
لو أخذْنا على سبيلِ المثالِ لفظةً من الألفاظِ الدالةِ على معنًى، كلفظةِ «سامر» فإنها من حيثُ هي: اسمٌ مفردٌ. وإن المُثَنَّى له: سامِران، والجمع: سامِرونَ... وإنَّ بَحْثَنا هذا هُوَ منْ مباحثِ علمِ الصَّرْفِ.
وإذا أخذْنا لفظة «ذَهَبَ» من حيثُ إنَّها: فعلٌ ماضٍ مجردٌ، وإنَّ مضارعها يذهبُ، واسمَ الفاعلِ منها ذاهِبٌ... إلى آخر ما هنالكَ، فإنَّ بَحْثَنا يكون أيضاً من مباحِثِ علمِ الصرفِ.
أما إذا بَحَثْنا في تركيب اللفظتيْنِ مع بعضِهما البعضِ (مثل: ذهبَ سامرٌ أو سامرٌ ذاهبٌ...) وعلاقةِ الواحدةِ بالأُخرى في هذا التركيبِ، فإنَّنا نجدُ أن لفظة «سامر» في التركيبِ الأولِ كانت فاعلاً للفعل «ذَهَبَ»... وفي التركيبِ الثاني مبتدأ مُخْبَراً عنهُ... فإنَّ بحثَنا هذا كان من مباحِثِ النَّحوِ..
ولنُوضِّحْ أيضاً بأمثلةٍ أُخرى تدلُّ على الغاية:
فمِنَ الأمثلةِ في التَّصريفِ:
- سُئل مرة أبو عثمان المازني في حضرةِ الخليفةِ المتوكل عن قول الله عزَّ وجلَّ: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا *} [مَريَم: 28]، فقيل له: كيف حُذِفَتِ الهاءُ، وبغيُّ فعيلٌ، وفعيلٌ إذا كان بمعنى فاعل لَحِقَتْهُ الهاءُ نحو: فتيٍّ وفتيَّةٍ؟
فقال: إنَّ بغيّاً ليست بفعيل إنما هي فعولٌ بمعنى فاعِلَةٌ، لأنَّ الأصلَ فيها بَغُوْيٌ، ومن أصولِ التصريفِ إذا اجتمعتِ الواوُ والياءُ، والسابِقُ منهما ساكِنٌ قُلبتِ الواوُ ياءً وأُدغمتِ الياءُ في الياء.
ومن الأمثلة في النحو عن أبي عثمان المازني أيضاً:
سألتْهُ جماعةٌ من النَّحويين: يا أبا عثمان: إذا قُلتَ: زيدٌ قائِمٌ: زيدٌ ابتداءٌ، وقائمٌ خبُرُه... فإذا قلت: إنَّ زيداً قائمٌ، عَمِلَتْ (إنَّ) في الابتداء وبقيَ الخبرُ على حالِهِ، لأن «إنَّ» لا تعملُ في الخبرِ، فخبرُها خبرُ الابتداءِ، وهذا مذهبُ الكسائي.
قال أبو عثمان المازني: هذا خطأٌ.
وسألهم: أخبروني عن «إنَّ» لِمَ نَصبت عندكم؟
قالوا: لأنَّها مشبهةٌ بالفعلِ.
قال: فإذا قُلتُم: إنَّ زيداً قائمٌ... زيدٌ عندكمْ إنِّهُ ماذا؟
قالوا: عِندَنا إنه مفعولٌ مقدمٌ.
قال: فما الفِعلُ فيهِ؟
قالوا: إنَّ.
قال: فبين (إنَّ) وبين قائم، سببٌ؟
قالوا: لا.
قال: فهل رَأَيْتُمْ فعلاً قطُّ نصبَ ولم يرفعْ شيئاً؟
قالوا: هذا محَالٌ، لأنَّ الفعلَ إذا لم يرفعْ خلا مِنَ الفاعِلِ.
قال: فالشيءُ إذا شُبِّهَ بالفعل فلا يَنبغي أن ينصِبَ فقط، ولا يرفَعَ، لأنه إن كان كذلك فليس هُو مشبَّهاً بفعلٍ، لأنه لا فِعْلَ في الكلام نصَبَ ولم يَرفعْ.
ثم أضاف: فيجبُ في الحرف المشبَّه بالفعل أن يكون الاسمُ المنصوبُ بعدَهُ بمنزلة المفعول، ويكون الخبرُ بمنزلةِ الفاعلِ حتى يكون هذا الحرف مشبَّهاً. وعلى هذا فإنَّ: (إنَّ وأنَّ وأخواتهما) تعمل في الاسم والخبر. الاسم بمنزلة المفعول المقدم، والخبرُ بمنزلة الفاعل المؤخَّر.
وفي مجلس جمع أبا عثمان المازنيَّ، وأبا الفضل الرياشي وسعيد بن مسعدة الأخفش، قال هذا الأخيرُ عن «مُنْذُ»... إن «منذُ» إذا رُفِعَ بها فهي اسمٌ مبتدأٌ، وما بعدها خبرٌ، كقولك: ما رأيتُهُ منذُ يومان.. فإذا خُفِضَ بها كقولك: ما رأيتُهُ منذ يومينِ، فحرفُ معنًى ليس باسم.
قال الرياشي: فلمَ لا يكون في الموضعين اسماً، فقد نرى الأسماء تَخفضُ وتَنصبُ، كقولك: هذا ضاربٌ زيداً غداً، وهذا ضاربُ زيدٍ أمسِ. فلِمَ لا تكونُ «منذُ» بهذِهِ المنزلةِ؟
عندها قالَ المازنيُّ: لا يُشبِهُ «منذُ» ما ذكرتَ - وهو يخاطِبُ الرياشيَّ - لأنَّا لم نرَ الأسماء هكذا تلزمُ موضِعاً واحداً إلا إذا ضارعَتْ حروفَ المعاني نحو: أينَ، وكيفَ.. فكذلك (منذ) هي مضارعة لحروف المعاني فلزمتْ موضِعاً واحداً.
فُسئِلَ: أفرأيتَ حروفَ المعاني تعملُ عملَينِ مختلفَيْنِ متضادَّيْنِ؟
قال المازنيُّ: نعمْ، مثل: قام القومُ حاشا زيدٍ، وحاشا زيداً، وعلى زيدٍ ثوبٌ، وعلا زيدٌ الفرسَ، فتكون مرةً حرفاً، ومرةً فعلاً بلفظٍ واحدٍ.
من هذه الأمثلةِ وغيرِها، يمكن القولُ: إنما الغَرضُ الأساسيُّ من النحوِ في مَبْدأ الأمرِ كانَ ضبطَ القواعدِ التي يسيرُ عليها إعراب المفرداتِ ليسهل تعلمُها وتعليمُها واحتذاؤها في الحديثِ والكتابةِ، ولتعصِمَ الناسَ من اللحنِ الذي أخذَ يتفَشَّى منذُ صَدْرِ الإِسلامِ من جراءِ تطور اللُّغةِ واختلاطِ العربِ بالعجمِ. ثم أخَذَ نطاقُ هذا العلمِ يتسعُ قليلاً قليلاً وأخذَ علماؤه يعرضون كثيراً من الموضوعات المتصلة بأجزاء الجملة وترتيبها، وأثر كل جزء منها في الآخر، وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض، وطريقة ربطها، وأنواع الجمل، وعلاقة الجمل التي تتألف منها العبارة بعضها ببعض، وأقسام الكلمة، وأنواع كل قسم منها، ووظيفتِهِ في الدلالة، حتى شملَ جميعَ البُحوثِ التي يُطلِقُ الفرنجةُ على مثلِها اسم «السنتكس التعليمي» أي «علم التنظيم التعليمي».
وأما الصرف فموضوعُهُ ضبطُ القواعد بأوزان الكلماتِ العربيةِ واشتقاقها وتصريفها وتغيُّر أبنيتها بتغيُّر المعْنى، وما يتصلُ بذلك من البحوث التي يُطلِقُ الفرنجةُ على مثلِها اسمَ «المورفولوجيا التعليمية» أي «علم البنية التعليمي».
وقد كانتِ العنايةُ مقصورةً في المبدأ على البحوث النحوية، وظلَّ الأمرُ كذلك حتى أواخر القرنِ الأولِ الهجريِّ. ثُمَّ أخذَ العلماءُ يُعالجون بعض مسائلِ الصرفِ استطراداً وفي خلالِ دراستِهِم لمسائلِ النحوِ.
ثم أخذتْ مسائِلُ الصرفِ تنفصِلُ شيئاً فشيئاً عن مسائل النحوِ، وتُدرَسُ على حدةٍ، حتى تكوَّنَ منها علمٌ متميّزٌ. غير أنَّ هذا العلمَ لم يستقلَّ تمامَ الاستقلالِ عن النَّحوِ. فلا تزالُ طائفةٌ كبيرةٌ من مسائلِهِ ممتزجةً بالنحو، ولم ينفكَّ الباحثونَ، إلى عهدٍ قريبٍ، يَنظرونَ إلى الشعبتَيْن نظرتهمْ إلى علمٍ واحدٍ ويُعالجونَ مسائلهُما في مؤلفاتٍ موحدةٍ.
إعرابُ القُرآنِ الكريمِ
وكما نشأ علمٌ متميِّزٌ عن النحو هُوَ علمُ الصرفِ، كذلك كانَ نشوءُ فنِّ الإِعراب. وفي الجُملةِ عِلمُ النحوِ أخذَ يستقلُّ، وكان استقلالُهُ في ظِلِّ القُرآنِ لأن أولَ ما تناولَهُ النَّحويونَ في هذا المضمارِ أنهم بنَوْا استشهادَهم في أكثرِهِ على القُرآنِ، وذلك من قبيلِ ما فعلَ «سيبويه» في مؤلفِهِ «الكتاب» وغيرُهُ كثيرون من الذين كانت لهم مثلُ تلكَ الصناعةِ. ثم أخذَ إعرابُ القُرآنِ الكريمِ يخلُصُ وحدَهُ، ويكونُ عِلْماً مستقلًّا قائماً بنفسِهِ.
ومهما تكُنِ الأبحاثُ، أو العلومُ التي نشأتْ، فإن القرآنَ الكريمَ يَبقى في نظمِهِ ونَسْجِهِ، وإحكامِ تركيبِهِ المصدرَ الذي يُرْجَعُ إليه في كلِّ علومِ اللُّغةِ العربيةِ وفنونِها. ولكنَّ المُعانِدين والمُنكرِين، أولئكَ الذين كبُرَ عليهم أن يَستظهرَ القُرآنُ الكريمُ على جميعِ الكتبِ السماويةِ بعدما حُرِّفتْ عنْ مواضعها، لم يجدوا سبيلاً إلى النَّيل من عظمتِهِ إلاَّ بتشغيلِ خيالاتِهِمِ الضعيفةِ إلى فترةٍ، وادِّعاءِ الافتراءاتِ والأباطيلِ الناقمةِ، وذلك كلُّهُ استشفاءً لنفوسهم المريضةِ، واستجداءً لأسيادهم المستعمرين.. وعلى هذا ذهب أولئك الحاقدون، إلى الزعم بأن في القرآن كثيراً من المواضع والتراكيب التي تنافي البلاغة لأنها تُخالفُ قواعد العربية، وذلك لكي يُظهروا بأن القرآن لا ينطوي على إعجاز، وليس هو نسيج وحده - كما يقول المسلمون...
فهل إنَّ مثل هذا الادِّعاء صحيحٌ، أم إنه بهتانٌ وتضليلٌ؟
إن ادِّعاءً يقومُ على الحقدِ والكراهيةِ، إنما هو ادِّعاءٌ يحمِلُ بذورَ هدمِهِ بنفسِهِ، ويدلِّلُ على مبلَغِ ما وصَلَ إليه دُعاتُهُ من «علم» - بل من جهل ـ على الأصح. {فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ *} [الأنعَام: 5]. ومع ذلك فلا بد من تبيان بطلان ذلك الادِّعاءِ، وهذا البطلانُ قائمٌ مِنْ وجهَيْنِ:
الأولُ: أنَّ القُرآنَ أُنزِل بينَ ظَهْرانَيْ بُلَغاءِ العَرَبِ وأكثرهِمْ فَصَاحةً، وقد تَحدَّاهُمْ إلى معارضتِهِ بالإِتيانِ ولو بسورةٍ واحدةٍ من مثلِهِ، فحاوَلوا وعَقَدوا الندواتِ لأجلِ ذلك، ولكنهم قصَّروا وفَشِلوا أيَّما فَشَل.. ولو وجدوا فيه ما يُخالفُ لغةَ العربِ، فإنّهم وهم الْعَالِمُون بتلك اللُّغةِ والضّالعون بمعرفة مزاياها وخصائصها، لكانوا أخذوه حجة عليه، ولعَابوه وجرَّحوه، لأنهم بذلوا قصارى جهودهم من أجل الوقوف على خلل فيه، فما أفْلَحُوا.. ولو أنَّ شيئاً مِنْ هذا القبيلِ قد حدَثَ، لَكانَتْ تمسَّكتْ به قريشٌ، المناوِئةُ للقُرآنِ، ولاحتفَظَ بهِ التاريخُ، وتواتَرَ نقلُهُ بينَ أعداءِ الإِسلام، يَحملونَهُ جيلاً بعد جيلٍ..
وما حدثَ كان عكسَ كل ذلك تماماً، فقد أعجز القرآنُ الكريمُ كلَّ بليغ، وأسكت كلَّ فصيح، ودُهِشَ له أئمةُ البلاغةِ والمعاني، وجهابذةُ الفصَاحة والبيانِ، ومن أرادَ معارضتَهُ لم يجدْ بدّاً من الإِقرارِ بعجزهِ عن تلك المعارضةِ، بل والاعترافِ - ولو كُرْهاً - بما له من خاصِيَّةٍ، لم تكنْ لكتابٍ غيرِهِ، لا مِنَ الكُتُبِ السماوية ولا من كتب أهلِ الأرضِ...
الثاني: أنَّ القرآنَ الكريمِ أُنزلَ في زمانٍ لم يكنْ فيه عَينٌ أو أثرٌ لما يُسمَّى أصولَ اللُّغة العربية وقواعدَها وإنما ظهرت هذه بعدَ التنزيلِ، ومن استقراءِ كلماتِ العربِ وتتبُّع تراكيبِها... والقُرآنُ الكريمُ - سواءٌ شاءَ الإِنسانُ أم أبَى - هُوَ وَحْيٌ مِنَ الله سبحانَهُ وتَعالَى. ولَو كَان غيرَ مُوحًى به - كما يزعُمُ المغرضون - على الرغم مِمّا في هذا الزّعمِ من افتراءٍ على الله، وكذبٍ على ربِّهم وربِّ القرآن فصَدَقَ فيهم قولُهُ تعالى: {مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ً * أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *} [البَقَرَة: 39]، [الأنعَام: 21] أجلْ، إنه وإن كان القرآنُ موضِعَ افتراءٍ مِنْ أعداءِ الله، وأعداءِ الإسلام منذ اللحظات الأولى لتنزيله، إلاَّ أنَّهُ كان بلسانِ العربِ، وكَلامُه كلامٌ عربيٌّ بليغٌ، بل لم يصل أي كلامٍ للعربِ إلى مرتبتِهِ بلاغةً وبياناً ونظماً وتركيباً، ومعانِيَ وأفكاراً، وتاريخاً، وكل ما يجعل له ذاتية خاصةً، يتفرَّدُ بها ويختصُّ... ومن هنا، فإنه بالنسبة إلى علومِ اللغةِ العربيةِ، يكونُ المصدرَ الأولَ والمرجعَ الأعلى لتلكِ العلومِ جميعاً.. ولا يُمكنُ لأيِّ مفكرٍ نزيهٍ، أو عالمٍ منصفٍ، عَرَفَ اللغةَ العربيةَ على حقيقتها، كما لا يمكن لباحثٍ مدقِّقٍ وَقَفَ على كلامِ أهلِ البلاغة مِمَّنْ عاصَروا النبيَّ محمداً صلى الله عليه وآلِهِ، إلاَّ أن يُقِرَّ بأن القرآن قد سما على ذلك الكلام، بل إنه فوقَهُ بمراتِبَ عاليةٍ فلا يُدانيه شيءٌ منه...
والواقعُ، بناءً على ما تقدمَ، أنَّ القاعدةَ المستحدثة في أي علمٍ من علومِ اللُّغةِ العربيةِ، إذا ما خالفت القرآن الكريم، فإنما تكون مخالفتُها نقضاً للقاعدة الأصلية، ولا يمكنُ أن تكونَ أبداً نقداً على ما استعمَلَهُ القُرآنُ المجيدُ... وعلى هذا فإنَّ كل قواعدِ علمِ النحوِ يجبُ أن تُقاسَ على نَظْمِ القُرآنِ، فإنْ وافقتْ هذا النظمَ كانتْ قاعدةً صحيحةً، وإلاَّ كانتْ مستحدثةً، وفاسدةً في آنٍ معاً.
وفضلُ النحو أنهُ يجعلُ السليقَةَ تتخلَّقُ بالتعبير السويِّ الصحيح، سواءٌ أجاء هذا التعبيرُ على شكل كلامٍ منثورٍ أم كلامٍ منظومٍ.. فلو أخذنا النظم - باعتباره أشدَّ تأثيراً في الوقع على النفس وفي التعبير عن المشاعر والخواطر - لإِظهار فضْلِ النحوِ، فإنهُ من البديهي القولُ بأنَّ النظم الجيد السليم لا يكون إلاَّ بوضْعِ الكلام وفق ما يقتضيه علم النحو، والْتزامه بقوانينه وأصوله، والسير على مفاهيمه، وبالتالي المحافظة على الرسوم التي رسمت له، وعدم تخطِّي حدودِهِ..
ومن قبيل ذلك أنَّ على الناظم أن يعلمَ وجوه كل باب من أبواب الإِعراب وفروعه، فينظر في المبتدأ والخبر مثلاً إلى ما يمكن أن يحتمل من وجوه من مثل قولك: سليم يقبل، سليم هو يُقبل، سليم هو المقبل، وسليم هو مقبِلٌ.. أو أنْ ينظر في الشرطِ والجزاءِ إلى الوجوه التي تكون عليها: إنْ تذهبْ أذهبْ، وإنْ ذهبتَ ذهبتُ، وإنْ تذهبْ فأنا ذاهب، وأنا ذَاهبٌ إنْ ذهَبْتَ، وأنا إن ذهبتَ ذهبْتُ.. وأنْ ينظر أيضاً في الحال ووجوهِهِ: جاء عليٌّ مُسرِعاً، وجاءني يُسرعُ، وجاءني وهو مسرعٌ، وجاءَ عليٌّ وقد أسْرَعَ.
ومِنْ واجبِ الناظمِ أن ينظرَ في الحروفِ التي تشتركُ في معنًى، وما ينفردُ به كل واحدٍ منها في هذا المعنى، فيضعَ كلاًّ منها في خاصِّ معناه... فيستعمل مثلاً «ما» في نفي الحال... و«لا» في نَفْي الجنس وطلبِ التَّرْكِ، وأن يعرف كيفَ يستعمِلُها حتى يأتيَ نتاجُهُ كلاماً عربيّاً فصيحاً، غير ملحونٍ ولا مَغلوطٍ..
وعليه كذلك أن ينظرَ في الجُمل التي يُركِّبُ، فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ويعرف أين هو موضعُ «الواو» مِنْ موضِعِ «الفاء»، وموضعُ «الفاء» منْ موضِعِ «ثمَّ»... وموضِعُ «أو» منْ موضِعِ «أم»... وموضعُ «لكن» منْ موضِعِ «بل»... وهلمَّ جرّاً...
وأنْ ينظر أيضاً في التعريفِ والتنكيرِ، والتقديمِ والتأخيرِ.. وفي الحذْفِ والتكرارِ، والإِظهار والإِضمار فيضع كلاَّ ً في موضعه، ويستعملَهُ على وجهِ الصحةِ، وما يَتَناسبُ معهُ، وما ينبغي أن يكونَ عليه... وهكذا الأمرُ في شتَّى أبوابِ النحوِ، وسائر ما يتعلقُ بالنحوِ من صرْفٍ وإعرابٍ... بحيثُ يعلَمُ الشاعرُ أو الكاتبُ أو الخطيبُ، وكلُّ صاحبِ صِفةٍ في اللغةِ، تفاصيلَ هذه العلومِ، وأن يعرفَ بالتالي كيفَ يستعمِلُها حتى يأتيَ نتاجُهُ كلاماً عربيّاً فصيحاً، غير ملحونٍ ولا مغلوطٍ..
وزيادةً في التوضيح، يمكنُ القولُ بأنه لا شيءَ في اللُّغةِ العربيةِ الفُصحى يَرجِعُ صوابُهُ إنْ كان صواباً، إلاَّ إلى معرفةِ النحوِ وما يتبعُهُ، ولا يرجِعُ الخطأ فيه، إن كان خطأً، إلاَّ إلى الجهل بالنحو وما يتصلُ بهِ... ولا يوجد كلامٌ له معنًى، يمكن وصفه بالحسَن أو يكونُ له مزيةٌ عن غيرِهِ، إلاَّ ويعودُ في ذلك إلى معاني النحو وأحكامه، ويدخلُ في أصلٍ منْ أصولِهِ ويتصلُ ببابٍ من أبوابِهِ، وإلاَّ خَرَج عن ذلك ووُصِفَ ذلك الكلامُ بالفاسدِ، وبأنهُ كلامٌ غيرُ فصيحٍ أو غيرُ صحيحٍ..
وإنَّ مَنْ عرف ماهية علمِ النحوِ، وعَمِلَ وفق قوانينِهِ، أمكنهُ أيضاً الوقوفُ على ما قرّرُوا أنهُ حسَنٌ، وشَهِدوا لَهُ بالفضْلِ - إنْ كان شِعْراً أو نَثْراً - وما حَمَلَ هذا الأثر من معنًى لطيف مثلاً، أو حكمة بالغة، أو تصوير رائع.. ومن ذلك ما نجد في هذه الأبيات للبُحتري:
هُوَ المرءُ أبْدَتْ لَهُ الحَادِثا
تُ عزْماً وشِيكاً ورَأياً صَلِيبَا
تَنَقَّلَ في خُلُقَيْ سُؤْدَدٍ
سَخَاءً مُرجًّى وبأْساً مَهِيبَا
فَكَالسَيْفِ إنْ جِئْتَهُ صارِخاً
وكَالْبَحْرِ إنْ جِئْتَهُ مُسْتَثِيبَا
فما من أحدٍ قرأ هذا الشعرَ، إلاَّ وقد أعجبَهُ، ووجدَ أنَّ لهُ اهتزازاً في نفسِهِ، فأكبَرَهُ. فليبحثْ إذاً عن سبب الإِعجاب والإِكبار. وإنْ فعلَ فسَيرى أنَّ شاعرَنا لم يأتِ بما أتى، إلاَّ لأنه قدّم وأخَّر، وعرَّف ونكَّر، وحذف وأضمر، وأعادَ وكرَّرَ... وتوخَّى على الجُملةِ، وَجْهاً من الوجوهِ التي يقتضِيها علمُ النحوِ، فأصابَ في ذلك كلِّهِ، ثم لطّف موضع صوابِهِ، حتى كان له ذلك الفضل في ما أتى...
أفلا نَرى أن البحتري، وهو يقول: «تَنَقَّلَ في خُلقَيْ سُؤْدَدٍ» قد قامَ بتنكيرِ السُّؤْدَدِ وأضافَ إليه «خُلُقَيْ»؟... ثم عطفه بالفاءِ في لفظةِ «فكالسيفِ» مع حذفِهِ المبتدأ، لأن المعنى: فهُوَ كالسيفِ.. واستعملَ الكافَ مكررةً في كلمةِ البحرِ بعدَ كلمةِ السيفِ، وهُوَ في ذلك قد قرن (إنْ) إلى واحد من التشبيهَينِ شرطاً جعل جوابه فيه؟... ثم أخرج من كل واحد من الشرطيْنِ حالاً، على مِثالِ ما أخرَج مِنَ الآخَرِ وذلك بقولِهِ «صارخاً» في الصدرِ، و«مُستثيبا» في العَجُزِ؟...
وعلى غرارِ شعْر البحتريِّ، نجدُ حُسْنَ النظمِ فيما قالَهُ إبراهيمُ بنُ العباسِ في محمد بن عبدِ الملك الزياتِ، عندما قالَ:
فَلَو إذْ نَبَا دَهْرٌ وأنْكَرَ صاحِبٌ
وسُلِّطَ أعداءٌ وغَابَ نَصيرُ
تَكُونُ عنِ الأهوازِ دَاري بنَجْوةٍ
ولكِنْ مَقَادِيرٌ جَرَتْ وأُمُورُ
وإنّي لأَرْجُو بَعْدَ هَذا محمَّداً
لأفْضَلِ ما يُرجَى أخٌ ووزيرُ
ولو وَقَفْنا قليلاً عند هذهِ الأبياتِ لَوجدْنا أنَّ فيها من الرَّوْنق والطلاوة، ومن الحُسنِ والحلاوةِ، ما وقف عليه القارئُ... ثم بالإِضافة إلى ذلك ما استعمل من أسلوبٍ فنيٍّ في تقديمِ الظَّرْفِ الذي هو «إذْ نَبَا» على عاملِهِ الذي هو «تكونُ»، مِنْ غيرِ أن يقول: فلو تكون عن الأهواز داري بنَجْوَةٍ إذْ نَبَا دَهْرٌ... وقال: تكون... ولم يَقُلْ: كان.. ثم إنه نكَّرَ الدهرَ ولمَ يقُل: فلو إذْ نبا الدهرُ، وأنَهُ ساق هذا التنكيرَ في جميعِ ما أتى به في هذِهِ الأبياتِ.
ثم ما قالَهُ: وأنْكَرَ صاحِبٌ.. ولم يَقُل: وأنكرْتُ صاحِباً...
مِنْ هذهِ الأمثالِ، يتبينُ أن مزيةَ النظمِ الحَسَنِ، ومزيةَ كَل كلامٍ حسنٍ، إنَّما ترجع في ذلك إلى فَضْلِ النحوِ ومعانيهِ..
وإذا كانَ ما رأينا من نَظْمِ الناسِ، فما عسَانا نجدُ في نَظْمِ القُرآنِ الكريمِ، وفي الأسلوب القُرآني؟...
نأخُذُ ثلاثَ آياتٍ كشواهِدَ على ما في كَلامِ القُرآنِ مِنْ جمالٍ هوَ فوقَ كل وَصْفٍ أو تصوير، ومزايا وخصائِصَ هِيَ فوقَ طاقةِ البشر. وهذه الآياتُ البيّناتُ هيَ:
1 - الآية 44 من سورة هود، وفيها يقول الله تعالى: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *} [هُود: 44].
إنَّ في الآية إخباراً عن نهايةِ طُوفانِ نوحٍ عليه السلامُ، عندما أمَرَ الله تعالى الأرضَ بأن تبتلعَ الماءَ الذي نَزلَ عليها، والسماءَ أن تُقلِعَ عن إنزالِ هذا الماء. ويكمِّلُ الأسلوبُ القرآني الإِخبارَ بما جَرَى فعلاً، عندما غِيضَ الماءُ، ثم اختُتِمَ الإِخبارُ بما انتهى إليه الأمرُ، وما جَرى للسفينةِ، وفي أي مكانٍ استقرَّتْ، ثم أخيراً الإِخبارَ عَنِ الحُكمِ الذي صدرَ بحقِّ القوم الذين كذَّبوا النبيَّ نوحاً عليه السلام ولم يصدِّقوا ما قاله لهم، وكانوا بذلك قوماً ظالِمينَ..
فأيُّ كلامٍ فيه مثلُ هذا الإِيجاز والوضوحِ، يُمكِنُ أن يحمِلَ المعانيَ التي حملتْها هذه الآيةُ الكريمةُ بحيث تُنْبِىءُ وحدَها عن كلِّ ما كان سَبَقَها من أحداثٍ، وما عَقبَ هذه الأحداثَ. وما انتهتْ إليه مِنْ نتائِجَ..
ولقد جاءَ الإِخبارُ، من حيث المبنى، بصيغةِ المَجهول «وقيلَ»... في مَطْلعِ الآيةِ، وقبل خِتامِها... فَمَنْ قال؟.. واستعمالُ النداءِ للأرضِ والسماءِ وهُما مِنَ الجَمادِ، يُضفي عليهما الحياةَ والامتثالَ للأمرِ الذي صدَرَ إليهما... والمرادُ من ذلك قدرةُ الله سبحانَهُ وتعالى، دون الإِخبار عن هذِهِ القُدرةِ، ولكنْ بما يُفيدُ عنها. وكذلك استعمالُ واو العطف في تركيبِ الجُملةِ كلِّها، حتى تكون هذه الواوُ هيَ الرابط بينَ تسلسُلِ الأحداثِ التي تُصوِّرُها لنا الآية..
ثم لِنَرَ في خيالنا ما هِيَ تلك الصورةُ التي ترسمُها الكلماتُ: أرضٌ غطَّتْها المياهُ، بكلِّ ما فيها من مُنْخَفَضٍ ومرتَفَعٍ، وفوقَ هذا البحرِ الذي يُغطي الأرضَ، لا وجودَ لشيء، إلاَّ لسفينةٍ تعلو فوقَ الماءِ، ومِنْ ثمَّ يَرى الناظرُ فجأةً أَنْ قدِ انقطعتِ السماءُ عن إنزالِ المطرِ، وأخذَ ذلك البحرُ منَ الماءِ يختفي في باطن الأرضِ...
فأيَّةُ صورةٍ هذه نتخيَّلُ، ولا تقشعِرُّ لها الأبدانُ، وتذوبُ الأنفس؟ بل ماذا يفعلُ إدراكُ هذِهِ الصورةِ في الأنفسِ وقد أيقنتْ قُدرةَ الله؟...
ثم ذلك الإِخبارُ بالمجهول عن مصير القومِ الظالمين باستعمالِ عبارةِ «بُعْداً»... وهيَ تعني إبعادَهُم.. إلى أين أُبْعِدُوا؟.. أُبعدوا عن الحياة الدُّنيا، وعَنْ رحمةِ الله سبحانَهُ، وعنِ الذاكرةِ لأنهم لا يَستحقُّون ذِكْراً ولا ذكْرى.. ولذلك جاء التعبيرُ وقد انتصبَ على المصدرِ، وهو يحمِلُ في آنٍ معاً معنى الدُّعاءِ..
وإنَّ في الآية مِنْ بدائعِ الفَصاحةِ، وعجائِبِ البلاغَة، بحيثُ لا يُمِكنُ لكلامِ بَني البشر أن يقارِبَها، بل لا يُدانيها منه شيءٌ عندما جاء التعبيرُ بصيغةِ الأمرِ، ومنحَ للجمادِ حياةً بما يُدلِّلُ على القُدرةِ الإِلهية..
وإنَّ مِنْ محاسِن الآيةِ أيضاً ذلك التقابُلُ في المعنى وائتلافُ الألفاظ، ومن ثم حسنُ البيانِ، مع روعةِ التصويرِ، واستعمالُ الإِيجاز دون الإِخلالِ ببيانِ المقصِدِ...
ويُروى بالنسبةِ إلى هذهِ الآيةِ، أنَّ كفارَ قُريشٍ الذين كانُوا جهابذة فصاحةٍ، وأسيادَ بلاغةٍ، عندما سمعُوها، عَكفوا على لُبابِ القمحِ ولحومِ الضأْنِ، وسُلاف الخَمرِ، لمدةِ أربعين يوماً، وذلك حتى تَصْفُوَ أذهانُهم، وتكونَ لهم القدرةُ على أن يأتوا بكلامٍ مشابهٍ لكلام الآيةِ، أو كما كانوا يَزعُمونَ - وهم في حالةِ السكرِ والتَّياهِ - ما يتفوقُ عليها.. ومضتْ تلك المدةُ ووجَدوا أنَّ لا جدوى فيما فعلوا، وليس بمقدورِهم أنْ يُدانوا كلامَ القُرآنِ، عندَها عَقَلوا وقال بعضُهم لبعض: إن هذا كلامٌ لا يشبهُهُ شيءٌ من الكلامِ، ولا هو يشبِهُ كلامَ المَخْلوقِين... ثم انفضُّوا من خَلْوتِهِم، وتركوا ما أخذوا فيه، مفارقين المعارضة التي أرادُوها للقُرآنِ..
2 - الآيات 30 وما بعدها من سورة الأنبياء، وفيها يقول الله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ *وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ *وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ *وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ *} [الأنبيَاء: 30-33].
إنَّ في هذه الآيات جولةً عاجلةً في الكونِ، وهي تحملُ في طياتِها تفسيراً لما حدثَ في ظواهِرِ الكونِ المرئيةِ وغيرِ المرئيةِ، من حيثُ إنَّ عوالِمَ هذا الكون كانتْ ملتصِقَةً ببعضِها البعض، ثم كانت المشيئةُ الإِلهيةُ بإحداثِ التجزئةِ التي نشأتْ عنها المجموعاتُ الكونيةُ الكبرى، وما تشتمِلُ عليه كلُّ مجموعةٍ مِنْ أجزاء، وذلك كلُّهُ وفق أنظمةٍ دقيقةٍ لا تحيد عنها كما قدَّر لها العزيزُ الحكيمُ..
إنَّ هذه الحقائقَ التي جاءَ العلمُ يُقرُّها، هل كانَ بمقدورِ العَرب، أو بمَقدورِ غيرهم من شعوب الأرض كافةً - في شرقِها وغربها - أنْ يُدرِكُوها، قبلَ أن يُنزَّل القُرآنُ؟ قَطْعاً لا، لأنَّ اكتِشافَها كانَ بعد نُزولِ هذا الكتابِ المُبينِ..
وأما من حيثُ التركيبُ اللغوي، فإنا نجدُ في تلك الآياتِ أنَّ النصَّ القرآنيَّ يبدأُ بالاستفهامِ، ولكنَّه استفهامٌ يُرادُ به التقريعُ لبني البشر، وهُمُ الذينَ تبدُو لَهُمْ آلاءُ الله جليّة، ولكنهم يعرِضونَ عنها، كُفْراً واستِكْباراً.
ويأتي بعد ذلك الاستفهام التقريعي الإِعلامُ عمَّا كانت عليه السماوات والأرض، ثم بيانُ أمرِ الله بأنْ تتفتّقا، وهذا يعني أنه لم يكُنْ قبلَ هذا الأمرِ وجودٌ للأرضِ، ومِنَ الطبيعي ألاَّ يكونَ وجودٌ للمطرِ، حتى إذا أوْجَدها الله سبحانَه، وحدَّدَ لها النظام الذي تسيرُ عليه، كان من دقائِقِ هذا النظام نزولُ المطرِ عليها، ومِنْ ثَمَّ تكوينُ الماءِ حتى تَنْشَأ الحياةُ، لأنه لولا الماءُ لما كانَتْ حياةٌ لإِنسان أو حيوانٍ أو نباتٍ.. فالماءُ هو مهدُ الحياة الأولى، ومنه حياةُ كل ذي روحٍ ونَمَاءٍ.
وبعد هذا التوضيح لنتأمَّلْ عبارة: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبيَاء: 30] فإنْ لم نفهَمْ حقيقةَ نحْوها وإعرابِها نَضِلَّ عَنِ المَعنى الذي قرَّره الله سبحانَه وتَعالى فيها... فكلمةُ (حيٍّ) نعتٌ (لشيءٍ) وهي تابِعَةٌ لها في إعرابِها. وهذا يَعني أنَّ كلَّ شيءٍ حيٍّ يجبُ أنْ يدخُلَ الماءُ في تركيبه العُضوي، كائناً ما كانَ هذا الشيءُ.. أفلا تَرى أننا إذا اعتبرنا لفظةَ (حيٍّ) مفعولاً ثانياً للفِعْلِ (وجعلْنا) يَصيرُ نصُّ الآية: وجعلنا من الماء كلَّ شيءٍ حيّاً، ونكونُ قد وقعْنا في الخطأ الفاحشِ الذي يقتضي حياةَ كل شيءٍ يمتزجُ فيه الماءُ: كالترابِ إذا مزَجْناهُ فيه وجعلناهُ طيناً، وكالطحينِ إذا عَجَنَّاهُ، وكالدواءِ الجافِّ إذا حَلَلْناهُ، وغيرِ ذلك ممَّا لا يحصيهِ عدٌّ؟
فتأمَّلْ بينَ جَعْل لفظةِ (حيٍّ) نَعْتاً أو مَفْعولاً، كَمْ يكونُ الفارقُ كبيراً في المعنى، بلْ وفي تكوينِ الخلائِقِ على سطحِ الأرضِ.. فبحَسْبِ أنها نعتٌ، يكونُ كلُّ كائنٍ حيٍّ قد دخلَ في تركيبِهِ العُضوي الماءُ، بينَما بحَسْبِها مفعولاً، يذهَبُ وجودُ الكائِنِ الحيِّ، ويصيرُ مَثَلُهُ مَثَلَ طحينٍ خُلِطَ بهِ الماءُ فَعُجِنَ، أو تُرابٍ مُزِجَ بالماءِ وهَلُمَّ جرّاً...
إنَّ كل خطأٍ في فهم النحوِ والإِعراب للجملةِ القرآنيةِ، أو اللفظةِ فيها، يؤدي إلى فهمِها على غير حقيقتِها، ويؤدي بالتالي إلى تفسير خاطىءٍ نشوّهُ به جمالَ نظمِ القُرآنِ، ونبتعدُ فيه عن فهم معانيهِ، ونَضِلُّ عن تَطبيقِ قواعدِهِ وأحكامِهِ... فإعرابُ القُرآنِ إعراباً صحيحاً، هُوَ مفتاحُ فهمِ نصِّهِ الصحيحِ الصريح دونَ أدنَى جدالٍ، ومَنْ فَصلَ النحوَ عن التفسيرِ ضلَّ عن التفسيرِ الواقعيِّ ضَلالاً بَعيداً.
ثم يأتي تأكيدٌ آخرُ في معرض توجيه التساؤل الاستفهامي: أفلا يؤمنون؟! بل قُلْ إنه التعجبُ من جَهالةِ الناسِ أو استكبارِهم عنِ الإِيمانِ بهذا القُرآنِ الذي يَدلُّهُمْ على الحقائِقِ، بينما هُمْ عنها يُعرِضونَ..
وفوقَ ذلك الإِعجازِ فيما تَحْفِلُ به الآياتُ القليلةُ من معانٍ واسعةٍ ودقيقةٍ - وهلْ أوسعُ من الكونِ بأسره وما فيه، وهلْ أدقُّ منَ الحياةِ وما هِيَ - نَجدُ للنظمِ الرائعِ مقامَهُ، وللانسجامِ الكاملِ في رسمِ الكلمات وحروفها رونقه، بحيث يأتي النظمُ متوافِقاً مع المَعْنى الذي يُرادُ أداؤهُ وبما يرمي إليه من تأكيدٍ على قُدرةِ الله العظيمِ في الخلقِ، وعلى الدَّعوةِ إلى الإِيمانِ بالخالِقِ رَبّاً قديراً مُقتَدِراً، وتَنْتَفي بعدَ ذلك أيَّةُ حُجةٍ للإِنسانِ في البَقاءِ على كُفرٍ أو شِرْكٍ..
ولا يجوز أن نُغْفِلَ في هذا المقامِ استعمالَ (العطف) المتكررِ، بحيثُ لم يكنْ تكرارُهُ عبثاً، بل كان بياناً متلاحقاً لما في الأرضِ مِنْ معالمَ، والغايةُ منهُ إيجازُ هذهِ المعالم وَمَدَى نفعِها للإِنسانِ وهو يَسكنُ الأرضَ؛ ثم بعدَ هذا الربطِ بحروفِ العطفِ يأتي الاستئنافُ لعرض مشاهد عن النظام الشمسي، والتقرير النهائي عن ماهية هذا النظام، ووجوده في الكون الفسيح.. وما ذلك إلاَّ لأنَّ الأرض كوكب في هذا النظامِ وتابعة له، فلا يعقل إيراد حقائق عن هذه الأرض من غير بيان النظام الذي ترتبطُ بِهِ هذه الأرضُ... إلى غير ذلك ممّا يحتاجُ إلى بُحوثٍ مستفيضةٍ ليس هنا محلُّها لولا الشاهِدُ على عظمة القرآن وبلاغته.
3 - مطلع الآية 80 من سورة يوسف - عليه السلام - حيث قال الله تعالى: {فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا} [يُوسُف: 80].
بمثل هذا الإِيجاز الرائع، يبدو المشهدُ ماثِلاً أمامَ الأعيُنِ، ويَرتَسِمُ هذا المشهدُ بانْصرافِ إخوة يُوسفَ مِنْ عندِهِ، بعدما يَئسِوا مِنْ إقناعِهِ بترك أخيهِمُ الصغيرِ - عطفاً على ما تقَّدمَ من آياتٍ - ثم ها هُم يَعقِدونَ اجْتماعاً فيما بينَهُم وَحْدَهم، لا يشارِكُهُم فيه أحدٌ، يَتَناجَوْنَ فيما يجِبُ عليهِمْ فعلُهُ، وكيفَ يَتَصرَّفونَ إزاء تلك الواقعةِ التي حلَّتْ بِهِم...
إنهُ مشهدٌ من المَشاهدِ التي تُصوِّرُها ألفاظُ القُرآنِ، وهِيَ ترسُمُ الصُّورَ، لتتركَ لذوي العقولِ والمشاعرِ التفاعلَ مع تَعبيراتِ هذِهِ الصُّورِ. وها هِيَ ألفاظُ الآيةِ لا تَذْكُرُ المناقشاتِ والمُحاوراتِ التي تدورُ بينَ إخوةِ يوسفَ، ولكنها مَعَ ذلك تُنبىءُ بأهميةِ ما يدورُ. وتتركُ الانطباعَ عَنِ الانشغالِ والاهتمامِ السائِدينِ في الاجتماعِ..
فهلْ أروعُ مِنْ هذا الإِيجاز الذي يحملُ الإِخبارَ، والتصويرَ، وبيانَ حالةِ النفوسِ، مع أقلِّ لَفْظٍ وَأَجْزَلِ مَعْنى؟!... وهل إلاَّ القُرآنُ، وألفاظُ هذا القُرآنِ، وحدَهُ القادرُ على ذلك؟!.... وهل في دُنيا الأرضِ من نظمٍ يَحتوي على فصاحةٍ أعلى مِنْ هذِهِ الفصاحةِ؟!
4 - الآية 28 وما بعدها من سورة ياسين قال الله تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ *إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ *} [يس: 28-29]. أي لا حاجة لإرسال جنودٍ من السماء واستئصال شأفتهم، فصيحةٌ واحدةٌ كافيةٌ لإبادتهم. فإذا هم خامدون لا حراك فيهم. والذي يلفتُ النظرَ في هذه الآيةِ الكريمة أنها تشتمل في تركيبها على أربعة أحرف جر: حرف «على» وقد ورد مرةً واحدة، وحرف «من» وقد كُرِّرَ ثلاث مرات.
يتبين من معاني حرف «مِنْ» ما يلي:
1 - «مِن بعده» ظرفية لأن حرف «من» زائد.
2 - «من جندٍ». «من» زائدة وجندٍ مجرور لفظاً منصوب محلًّا.
3 - «من السماء». صفة لجند أي جندٍ سماويٍّ فتأمل عظمة هذا التركيب القرآني.
آياتٌ مِنَ القُرآنِ الكريمِ عَرَضْناها للتَّدليلِ على أهمية علم النَّحوِ، كَيْ يُمكِنَ قراءةُ اللُّغةِ العربيةِ قراءةً صحيحةً، وبيانُ المعاني التي تحمِلُها الألفاظُ، حتى يُمكِنَ الاهتداءُ إلى المقاصدِ التي يَنطوي عليها الكلامُ المكتوبُ.
الخـلاصـة
من جملةِ ما تقدَّمَ، يستطيعُ القارئُ الكريمُ أن يتبينَ كيفيةَ نُشوءِ اللُّغةِ العربيةِ الفُصحى، ونشوءِ علومِ هذه اللُّغةِ، وما كانَ لأهلِ العلمِ من فضلٍ في إبرازِ قواعدِها وأصولِها، كَمَا ظهرَ له جليّاً ما تشتمِلُ عليه هذه اللُّغةُ الكريمةُ من قُدرةٍ على التعبير، وإمكانيةٍ في الأداءِ، وجزالةٍ في البلاغةِ والفصاحةِ، وكلِّ ما يجعلُها لغةً حيةً جميلةً، قادرةً على احتواءِ كل جديدٍ قدْ يطرأُ في مسيرةِ هذهِ الحياةِ. ومنْ هنا تبرُزُ الأهميةُ في الحفاظ عليها لأنها لا تُشكِّلُ تُراثاً وحسب، بلْ وهِيَ عبارةٌ عَنْ حضارةٍ قائمةٍ بنفسِها... ومنْ أجلِ ذلكَ كان لا بُدَّ من علم النحوِ، ومعرفةِ الصَّرْفِ، وإتقانِ الإِعرابِ، كي تؤديَ اللغةُ العربيةُ رسالتَها في دنيا الأرضِ.
وما النحوُ، كما رأينا، إلاَّ القواعد والأصول التي تُعرفُ بها أحوالُ الكَلِمِ عندما يَحصَلُ تركيبُ بعضها مع بعض مِنْ بناءٍ وإعرابٍ وما يتفرَعُ عنهما. وإن مراعاة تلك القواعدِ والأصولِ تحفظُ اللسانَ العربيَ من الخطأ في النُّطقِ، وتعصِمُ القلمَ عَنِ الزَّلَلِ في الكتابَةِ..
وعلى الرغم من الجهودِ الجبارة التي بُذِلَتْ للقضاءِ على اللُّغةِ العربيةِ، وما حَمَلَتْ من الدسٍّ والتآمُرِ، ومنَ اللَّحْنِ والإفقارِ، من أجلِ غايةٍ بعيدةٍ ومُغْرضَةٍ ألا وهِيَ الدسُّ على القُرآنِ، والإِدخالُ عليه بما يجعلُهُ كتاباً مثلَ غيرِهِ مِنَ الكُتُبِ الدينيةِ أو الدنيويةِ؛ فإنَّ تلكَ الجهود والمحاولات باءتْ جميعُها - والحمدُ لله - بالفشلِ الذريع، ولم تجْدِ حامليها فتيلاً، لأنَّ القُرآنَ أُنزِلَ عربياً، وبقِيَ بالمرصادِ، مَرْجعاً أبعدَ ما يكونُ عن النيلِ منهُ، وأعلى مِنْ أنْ يُتَطاوَلَ عليه، إذْ هُوَ المصدرُ الأوحدُ والأساسِيُّ الذي يحفظُ لغتهُ من الضياع، ويصونُها منْ كل مارقٍ عابث.. إلاَّ أنه ونظراً للأوضاعِ التي يَتَخبَّط بها الإِنسانُ، وخطورةِ الحالاتِ التي يَعيشُها، فقد باتَ الإنسانُ المُسلمُ بحاجةٍ ماسةٍ إلى التذكير دائماً بآياتِ الله البيّنات، حتى تبقى لديه الملكَةُ السليمةُ التي تمكنُهُ مِنْ أن يتكلَّم، أو يكتبَ، أو يقرأَ بلغةٍ صحيحةٍ، لا اعوجاجَ فيها.. من أجل ذلك لجأْنا إلى إعرابِ مُفرداتِ ألفاظِ القُرآنِ الكريمِ مِنْ خِلالِ سِياقها في الآياتِ الواردةِ فيها، لأنَ فهمَ معانِيها ومدلولاتِها إنما يتوقفُ على فهم إعرابها، وفي ذلك فائدةٌ قصوى نرجوها من ربنا تباركَ وتَعالى لهذا الإنسانِ المُسلمِ، بلْ ولكلِّ منْ يريدُ أنْ يَتَفَقَّهَ في معاني القُرآنِ، حتى يتحصَّنَ في مسيرةِ حياتِهِ ضِدَّ الشر المُستطيرِ الذي يحيقُ به منْ كلِّ جانبٍ.
وقد اعتمدنا في هذا الإعراب النمط البسيطَ، بقدرِ ما أمكنَ، حتى يُمْكِنَ للقارئِ الكريم أن يَفْهَمَ مدلولَ اللفظةِ الواحدةِ، أو الجُملةِ في الآيةِ الواحدةِ، أو الآيةِ بكامِلِها، وارتباطها مع ما قد يَسبِقُها، بعيداً عن الشروحات المطولة، والآراءِ المتعددةِ وذلك منعاً للإِسهاب في الإعرابِ، الذي لا يحتاجُهُ إلا المتخصِّصونَ في مجالاته.
ولعلَّ القارئ يتساءلُ: لماذا هذا الإعرابُ لمفرداتِ ألفاظِ القرآنِ الكريم؟ وهنا نعودُ للتذكير - ولعلَّ في التذكير إفادةً - بأنَّ القُرآنَ أُنزِلَ عربياً، واللُّغةُ العربيةُ هي لغتُهُ، وهو نفسُهُ الذي حفظَ «الفُصحى» على مرِّ العصور من التَّصْحيفِ والاعْتوارِ، على الرغم مِنْ كل الجهودِ التي بُذِلت، والدعواتِ المشبوهةِ التي أُطلقتْ لمحاربةِ هذهِ اللُّغةِ والقضاءِ عليها - كما قلنا - والتي تمتْ جميعُها مِنْ قِبَلِ أعَداءِ القُرآنِ، ومِنْ قِبَلِ عملاء لهم في بلادِ العَرَبِ، باعُوا أنفُسَهُم للشيطانِ.. ولم تكُنْ تلك الخططُ التي وضعوها، والجهودُ التي بذلوها، والأموالُ التي صرفوها إلاَّ للوصول إلى وقتٍ لا يعودُ أحدٌ فيهِ يهتمُّ للقرآن، فيبتعد الناسُ عنه شيئاً فشيئاً، ولا يعودون قادرين على فهمِهِ وتفسير أحكامِهِ، وبذلك يتمُّ ضربُ المسلمين في أقدس مُقدساتِهِم..
هذا في المقاصِدِ البشريةِ الخبيثة!!...
ولكنَّ تلك المقاصد لن تتحقق أبداً.. فالقُرآنُ كتابُ الله، أنزلَهُ نُوراً للناس جميعاً، وهو سبحانَه وتَعالى قد تكفَّلَ بحِفظِهِ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *} [الحِجر: 9] ولكنْ، وعلى الرغم مِنْ ذلك، أيْ وإنْ كان القرآنُ مصُوناً، ولا خوْفَ عليه مِنْ عَبَثِ البَشَرِ إلاَّ أنَّ ذلك لا يمنع أنْ يظلَّ في المسلمين علماءُ أجلاَّءُ، يقومونَ على خدمتِهِ مِنْ أجلِ خدمةِ الإِنسانِ منْ خلالِ القُرآنِ ذاتِه، أداءً للواجِبِ المقدَّسِ الذي فرضَهُ الله تعالى على أهلِ العِلمِ، وتقويةً لعهدِ الإِنسان مع ربِّهِ وخالقِهِ بأنْ ينصُرَ الحقَّ، ويَهديَ للإِيمانِ على مرّ الزمانِ وتعاقُبِ العصورِ والدهورِ، وإلى أن يرِثَ الله - سبحانه وتَعالى - الأرضَ ومَنْ عليها.
ونلفِتُ نظر القارئِ الكريم إلى أننا قُمْنا، في هذا العمل (إعراب القُرآنِ الكريم) بترتيبِ أوائِلِ الآيات المُعربةِ - جزئياً أو كليًّا - على الحروف الألفبائية. وإنّا نستعينُ بالله عزَّ وجلَّ أنْ يُلهِمَنا التوفيقَ لأداءِ هذهِ المهمةِ، وإعطاءِ الأحسنِ، والأصْوَبِ، لما فيه خدمةُ القُرآنِ وخدمةُ المسلمينَ، داعين للصلاةِ على سيدِنا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ المنتجبينَ ومن تبِعَهُ بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.
وسوف نبدأ إن شاء السميع العليم بإعراب آيات سورة الفاتحة المباركة، ثم ننتقل بعدُ إلى الإِعراب على ترتيب الحروف الألفبائية.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢