نبذة عن حياة الكاتب
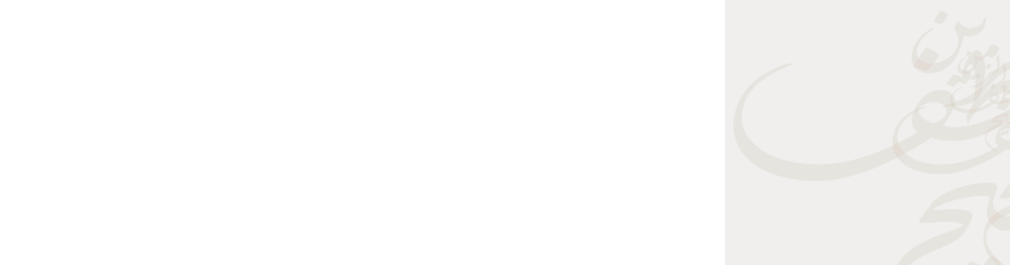
X
صفات الداعية وكيفية حمل الدعوة
القَانُون المَدَني ونظرِيَّة الالتِزام
وأيضًا: فإن التشريع الغربي بيرز فيه ما يسمَّى بالقانون المدني أي التشريع المتعلق بجميع المعاملات سواء التي تنظم علاقة الفرد بأسرته أو التي تنظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد من حيث المال.
أما نظرية الالتزام الّتي هي الأصل الفقهي لجميع القوانين؛ والتي تتمثُل بالتقنينات اللاتينية أو الجرمانية، فهي الحقّ الشخصي في القانون المدني.
وقد عُرِّفَ الالتزام عدة تعاريف، لكنها كلها كانت تدور حول جعل محل الالتزام إعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل. ولقد اخترنا منها هذين التعريفين:
الاِلتزام بالتعريف الأول هو (اتفاق يلتزم بمقتضاه شخصٌ أو أكثر نحو شخص آخر، أو أكثر، بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل).
وهو بحسب التعريف الثاني: حالة قانونية، يجب على الشخص بمقتضاها أن ينقل حقًّا عينيًّا، أو أن يقوم بعمل، أو أن يمتنع عن عمل). وإذا قارنَّا هذَين التعريفَين بتعريفهم للحقّ الشخصي بأنه رابطة بين شخصين دائن ومدين يخوِّل الدائن بمقتضاه مطالبة المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يظهر لنا أن نظرية الالتزام هي عينُها الحقّ الشخصي. فيكون الغرب قد عرَّف الحقّ، ثم قسَّمه قسمَين: عينيَّ وشخصيّ، ثم أقام على الحقّ الشخصي نظرية الالتزام وجعلها أساس القوانين المدنية كلها في النظام الرأسمالي. وتُعدّ هذه النظرية عنده من أهم النظريات في التقنينات الرأسمالية جميعها. والناظر في الفقه الغربي وفي التقنينات الغربية جميعها، وعلى اختلاف أنواعها، يستدل من العناية الكلية بنظرية الالتزام على ما لها من شأن وخطر. فهي عندهم بمنزلة العمود الفقري من الجسم.
فإذا ظهر فسادُها وعدم صلاحيتها تبيّن بوضوح فسادُ جميع التقنينات الغربية وظهر فساد جميع القوانين المتفرِّعة منها.
وبذلك تبرز الغرابةُ والدهشةُ من مهاجمة الغرب للتشريعات الإسلامية، بمعالجات فاسدة، وتحدِّيه بهذا التشريع الباطل. لكنّ الأغرب منه والأعجب، هو أن ينهزم المسلمون أمام هذا التضليل الفاسد!
ولنرجع إلى نظرية الالتزام أو الحقّ الشخصي فنقول: إن الالتزام عندهم يقوم على رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين وهذه الرابطة التي يقوم عليها الالتزام هي في نظرهم سلطة تُعطى للدائن على جسم المدين لا على ماله، وهذا هو الذي يميز عندهم بين الحقّ العيني والحقّ الشخصي.
فالأوّل سلطة تُعطى للشخص على شيء.
والثاني سلطةٌ تُعطى للشخص على شخص آخر.
وبناء على ذلك كانت سلطة الدائن على المدين سُلطةً واسعة يدخل فيها الإعدام وحقّ الاسترقاق وحقّ التصرف بما يراه متفقًا مع مصلحته.
وبناء على قيام هذه النظرية على حرية الفرد، فإنها كذلك تقضي بترك الفرد حرًّا في تعاقده، يلتزم بما أراد مهما أصابه من غبن في ذلك. فهو حرٌّ في الالتزام وتكون النتيجة = إذا التزم بشيء = أنه مجبرٌ على الوفاء بما التزم به.
والناظر في نظرية الالتزام أو الحقّ الشخصي يمكنه أن يتبيَّن فسادها رأسًا من بطلان تعريف الحقّ وحده، لأنها انبثقت عنه، ويتبيَّن له فسادها من تقسيم الحقّ عينيًّا وشخصيًّا، لأنها نتيجة لهذا التقسيم وجزء منه، ولكن لأجل أن يضع المرء إصبعه على المعاملات الفاسدة التي نشأت عن هذه النظرية نعرض بعض ما في هذه النظرية من خطأ وفساد.
1 ـــــــ تعريف النظرية «بأنها اتفاق يلزم بمقتضاه إلخ...».
يعني جعل الالتزام اتفاقًا، وعلى ذلك فإنه لا يشمل المعاملات التي لا يوجد فيها اتفاق كالهبة مثلًا، مع أنها عندهم من الحقّ الشخصي، وتخرج عنه المعاملات التي تصدر عندهم من شخص واحد ولا تتوقف على غيره كالمعاملات التي يقول إنها تصدر بالإرادة المنفردة مثل الوعد بجائزة، والوصية، والجمعيات التعاونية، مع أنهم جعلوها داخلةً تحت نظرية الالتزام وتشكل مصدرًا من مصادره، فضلًا عن أن هناك معاملات أخرى تحصل عند البشر ولا يشملها الالتزام مثل الوقف الخيري، وإعطاء الزكاة والصدقات وما شاكل ذلك. وهذا كله يدل على فساد التعريف؛ فلا بد إذًا من التدقيق في هذا الواقع لإِعادة تعريفه. وأيضًا تعريف النظرية «بأنها حالة قانونية» يعني جعل الالتزام حالة قانونية مع أن حقيقته هو علاقة يُقرُّها القانون وليس حالةً قانونية فحسب.
فمثلًا: أمرُ الدولةِ الناسَ ألّا يبنوا في المرافق العامة، هو حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن يمتنع عن عمل.
وعلى هذا فإن هذه الحالة تكون، بحسب تعريف القانون المدني، من نظرية الالتزام، مع أنها ليست منه ولا صلة لها بالالتزام؛ وبهذا يتبيَّن فساد هذا التعريف أيضًا؛ أما قولهم: إن الالتزام يقوم على رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين، فهو خطأ سواء قيل عنها رابطة شخصية أو رابطة مادية، لأنها ليست رابطة بل هي علاقة للإنسان وُجِدَت من جراء محاولته إشباع حاجاته العضوية وغرائزه، من جراء عيشه مع غيره من بين الإِنسان.
ولا يوجد في الموضوع التزام لا بالمعنى الشخصي ولا بالمعنى المادي. لأن المسألة ليست رابطة بين دائن ومدين. ولا توجد هذه الرابطة مطلقًا، ولا هي رابطة بين شخص ومال، أو سلطة لشخص على مال. وإنما الموضوع يتلخص في أن هناك علاقة بين شخصين موضوعُها المصلحة، وقد تكون مالًا وقد تكون غير مال، وقد تكون العلاقة عند الإِنشاء وقد تكون عند التنفيذ. وهذه العلاقة توحيها المصلحة، أي جلب منفعة أو دفع مضرة، وينظِّمها القانون. فالبيع علاقة بين شخصين عند الإِنشاء موضوعها المال. والوعد بإعطاء جائزة لمن فاز بالسباق علاقة بين شخصٍ وشخصٍ، موضوعها المال، والزواج علاقة بين شخصين موضوعها المصلحة وهي هنا ليست المال، وإلى جانب ذلك علاقة ناشئة عن المال فقط مثل إقامة المعابد وإنشاء السبيل العام من مياه الشرب وبناء المدرسة أو المستشفى وما شابه ذلك.
وعليه فنظرية الالتزام نظرية مغلوطة، فتكون جميع الاجتهادات الفقهية التي بُنِيَتْ على أساسها أو انبثقتْ عنها مغلوطةً مهما تفرَّعت وتنوّعت لأنها جميعها فروع لأساس فاسد.
ومما يجعل المرء يلمس = ويحسّ ماديًّا = فساد نظرية الالتزام، هو استعراض موقفها حين عرضتْ لها المشاكل المتجددة والمتعددة في المجتمع مع سَيْرِ الزمن، فإنها لم تثبت لهذه المشاكل ولم يستطع أصحابها الصمودَ عليها، مما اضطرهم إلى التأويل والتفسير والبعد منها حتى استطاعوا إيجاد حلول للمشاكل المتجددة.
فهذه النظرية كانت منذ عهد الرومان، وجاءت جميع التشريعات الغربية فنقلتها عن الرومان، واستعملتها في أول الأمر من دون تغيير يذكر. ولكن لما بدأت مشاكل الحياة تتجدد ظهر فساد هذه النظرية للذين نقلوها، وبرز لهم عدم صلاحيتها على الدوام، فعدّوا هذا الفساد قصورًا عن الإِحاطة بالمشكلات، وليس كونها هي باطلة.
وهكذا أخذوا يغيِّرونها زاعمين أنها تتطور؛ أي أخذوا يبتعدون عنها ويغيِّرون أصولها بحجة التطوير، أي الانتقال من حال إلى حال، وبحجة المرونة، أي قابلية التفسير. والحقيقة أن هناك عوامل متعددة أبرزت فساد النظرية، وأثَّرت فيها حتى تغيَّرت كثيرًا وتبدَّلت على مختلف العصور.
فالنظريات الاشتراكية التي ظهرت في أوروبا قبل ظهور المبدأ الشيوعي، أظهرت عدم صلاحية نظرية الالتزام، فاضطرّ الفقهاء لأن يغيِّروا نظرتهم للالتزام. ولما أُدخلت على عقود العمل، قواعدُ وأحكامٌ تهدف إلى حماية العمال وإلى إعطائهم من الحقوق ما لم يكن من قبل، كحقّ الاجتماع بأعداد كبيرة، وحقّ تكوين النقابة وحقّ الإضراب لكونهم الجانب الضعيف وفي أكثر الأحيان هو الجانب المغبون، مع أن نصّ نظرية الالتزام الرومانية لا يبيح مثل هذه القواعد، ولا يعطي مثل هذه الحقوق.
ونظرية العقد ذاتها التي تقول إنها توافق إرادتين على إنشاء التزام كانت قوة الالتزام فيها تُبنى على إرادة الفرد، ونظريّة الغبن لم تكن موجودةً بل لم تكن نظرية الالتزام تجيزها.
فقد كانت النظريات الفردية تَقضي بوجوب تركِ الفرد حرًّا في تعاقُدِه يلتزم بما أراد مهما أصابه من غبن في ذلك.
ولما تبيَّن فسادُ هذه النظريات الفردية وفسادُ نظرية الالتزام أُدخِلت نظريةُ الغبن على بعض العقود ثم أَخذت تتسع حتى أصبحت في القوانين الحديثة نظرية عامة تنطبق على جميع العقود. وهكذا كان نشوء أفكارٍ عن الحياة تخالف الأفكارَ القديمة، وظهور فساد الأفكار القديمة أثّر في نظرية لالتزام بحيث أظهر فسادها وعدم صلاحيتها؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كان استعمال مختلف الآلات الميكانيكية وتقدم الصناعة، ووجود حروب عالمية قد أوجد مسائل عملية تبرز فساد نظرية الالتزام؛ إذ إن استعمال الآلات اقترن بمخاطر كثيرة يُستَهْدفُ لها الناس، فبعد أن كان الشخص لا يدفع تعويضًا عن الضرر الذي يحدث لشخصٍ آخر إلاَّ إذا قام هو بالعمل الضارِّ متعمدًا الإِضرار بالغير صار يدفع تعويضًا كذلك عن الضرر إذا صدر عن الأشياء التي يملكها، وصار إلْحاق أيِّ أذًى في العامل يُلْزِم صاحبَ العمل بالتعويض، وهذا تقضي به نظرية الالتزام. كما صار عقد التأمين في القوانين الغربية لا يقتصر على الشخص بل يشمل الغير. فوجدت نظرية الاشتراط لمصلحة الغير؛ كما إذا أمَّن شخصّ على حياته لمصلحة أولاده سواء كان له أولادٌ وقت التأمين أو لم يكن، وهذا يخالف نظرية الالتزام لأنها رابطة بين شخصين والأولاد الذين لم يوجدوا بعدُ لا يدخلون في هذه الرابطة، مع أن العقد في القوانين الغربية أصبح يُدخِلهم؛ وفضلاً عن ذلك فإن نظرية الوفاء بِعمْلَةٍ نقصَ سعرُها، وفي التسعير الجبري للسِّلع، والتقدير الجبري للأجر وفي عقود التزام المرافق العامة، ما يناقض نظرية الالتزام ومع ذلك أُدخِل في القوانين الحديثة.
وزيادة على تلك النظرية التي تقضي بأن الغش يُفسد العقد، والقاعدة القائلة بأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الآداب والنظام العام، والالتزام بوجوب الامتناع عن الأضرار بالغير من دون حق؛ كما إذا رعتْ دابة زرعَ آخر بسبب إهمال صاحبها والإثراء بلا سبب. (وهو ما يمنع الشخص من أن ينتفع على حساب غيره) كمن يقيم بناء على أرض الغير أو يدفع دينًا غير موجود. كل ذلك يخالف نظرية الالتزام ويدل على فسادها؛ لأنها تقييد وليست حرية، وهي تناقض الحقّ الشخصي وتهدمه كونه حقًّا مطلقًا غير مقيد، على أن الالتزام من حيث هو عندهم يقوم على رابطة قانونية بين الدائن والمدين توجب على الشخص أن ينقل حقًّا. وهذا يعني عدم اشتراط الرضا بالحوالة أي إن الحوالة توجد من دون رضا المحال عليه بحوالة الحقّ، وعدم اشتراط رضا المدين بحوالة الدين لأن الحالة القانونية تُلزِم الشخص بنقل الحقّ عينًا أو دينًا وهذا لا يضمنن تحقيق العدل.
لذلك ظهر فساده، فمجرد تبليغ المُحال عليه لا يكفي، بل لا بد من قبوله، لأن العقد في الحوالة كما في غيرها يجب أن يكون برضا أطراف العقد.
هذا إجمال لبعض المشاكل المتجددة التي عرضت نظرية الالتزام للنقد، ومنه يتبين أنها لا تصلح ميدانًا للتفكير، لأن كثيرًا من أنواع العلاقات بين بَني الإِنسان لا يُمكن استنباطُها منها، مثل كون الغش يفسد العقد.
وهي لا تصلح أن تكون مجالًا للتعميم، لأن المسؤولية على الخطأ المفروض كالأذى الناجم عن الآلة، وحوالة الدين، والاشتراط لمصلحة الغير (مثل التأمين على الأولاد الذين لم يولدوا) والإِرادة المنفردة مثل الوصية والوقف الخيري وما شابه ذلك من العقود والمعاملات، لا يمكن أن تشملها لا بمنطوق ولا بمفهوم، كما أنها لا يوجد فيها قابلية لتوحيد مختلف الشعوب والبيئات في تشريع واحد، بدليل ظهور قصورها حين ظهرت النظريات الاشتراكية، وحين تقدمت الصناعة، وهي أن أساسها خاطئ بلا شك، لأنها تقوم على حرية الملكية والحرية الشخصية. وهذه الحرية هي التي تسبب الفساد بين الناس وهي التي تمكن من الاستغلال والاستعمار، لأن إعطاء الحرية في التملك وإعطاء الحرية الشخصية التي يحميها القانون حين بُني على نظرية الالتزام تمَّ في ذلك الفساد والشقاء. هذا هو واقع التشريع الغربي الذي تحدّى التشريع الإِسلامي؛ أو بعبارة أخرى هذا هو واقع النظام الرأسمالي الذي تحدّى نظام الإِسلام.
أما التشريع الإِسلامي الذي أوسعه الغربيون هجومًا ونقدًا، فهو ليس نظريات ظنية تنبثق عنها الأحكام والمعالجات كما هي الحال في التشريع الغربي، وإنما هو منبثق عن عقيدة عقلية قطعية لا يتطرق إليها ارتياب.
فليس أصله نظرية في الحق ولا هو منبثق عن نظرية الحقّ الشخصي أو الحقّ العيني، وإنما أصله عقيدة جازمة لن يتوصل العقل إلى أصلح منها، لذلك قطع بها قطعًا لا يرقى إليه الشك.
فما انبثقَ عن هذه العقيدة فهو تشريع إسلامي.
وما لم ينبثقَ عنها فليس بتشريع إسلامي.
فأيهما التشريع الحقّ؟
التشريع المنبثق عن عقيدة ذات أصول وفروع وقواعد عامة وركائز ثابتة، يتفرع منها ما لا يحصى من القواعد والأحكام التي لا يتطرق إليها أدنى ارتياب لأنها صادرة عن رب الأرباب!؟
أم التشريع المنبثق عن نظريات ظنية وضعها إنسان وقد ينقضها إنسان آخر؟
فالتشريع الإِسلامي منبثقٌ عن الكتاب والسنَّة المقطوع عقلًا بأنهما وحيٌ من عند الله عزَّ وجلَّ.
وعندما يُبحث هذا التشريع من حيث هو؛ فإنما يُبحث على أنه وحي من الله وليس من وضع البشر.
وهذا هو أساس القضية في بحث الإِسلام وأساس النظرة إلى الإِسلام؛ وما دام قد ثبت عقلًا أن الشريعة الإِسلامية هي من عند الله، فقد كانت قطعًا هي شريعة الحقّ، لأن من صفات الله التي تقتضيها الألوهية الاتِّصاف بصفات الكمال المطلَق، والتنزه عن صفات النقص؛ وعلى هذا الأساس تكون شريعتُه صحيحة وصالحة على الوجه الأكمل الذي جاءت عليه وأنها جاءت للناس جميعًا في كل عصر وفي كل جيل، لأنها شُرعت للناس، وأنزلها الله تعالى لسائر الناس وخاطب القرآن الكريم بها جميع الناس. لذا كان من المحتم أن تكون ميدانًا للتفكير، تُستتَنبط منها الأحكام في جميع علاقات الإِنسان، لأن مجالها واسعٌ للتعميم لكونها تشمل جميع الحوادث المتجددة والمتعددة، وهي بالتالي وبالتأكيد تربةٌ خصبةٌ للتفريع من القواعد الكلية فيها، والأخذ من الأفكار العامة التي تحتويها؛و ما دامت للإِنسان من حيث هو إنسان، فإنها ـــــــ ولا شك ـــــــ تعالج مشاكل جميع الشعوب مهما اختلفت جنسياتها وبيئاتها؛ وهذا كلّه كونُها شريعةً من عند الله أوحى بها لنبيه ليبلِّغها فيعملوا بها في كل عصرٍ وفي كل مصر.
هذه هي قضية الشريعة الإِسلامية فإنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد لسائر العباد أي إنها علاجُ للمشاكل أوحى بها الله سبحانه وتعالى، فإذا حرَّم الربا فإنه لا يُسأل هل هذا التحريم موافقٌ للعصر أم غير موافق، أو يتفق مع المدنية الحديثة أم لا؟
وإنما يُسأل هل هذا التحريم جاء به الوحي من الله حقًّا وحقيقة... فإذا كان كذلك كان حكمًا صحيحًا وإلا فلا.
ولا ينبغي أن يقال: إن هذا التحريم يعطل المعاملات التجارية، ويعرقل عجلة الاقتصاد في الداخل، ويقطعها مع الدول الأجنبية في الخارج، وربما جعل البلاد في عزلة تامة؛ لا يقال ذلك لأن الأساس الذي بنيت عليه وجهة النظر في الحياة هو الشرع وحده؛ لذلك لا يُعدّ غيره مقياسًا. بل كل ما دونه يُرمى به عرض الحائط، ولا قيمة له، ولا لأي اعتبار آخر مطلقًا مهما كان.
هذا إذا نظرنا إلى التشريع الإِسلامي كتشريع إلهي لا مجال لنقضه بالعقل الذي قد ينقض تشريعاته عقل آخر. أما من حيث واقع الإِسلام نفسه، فإن الإِسلام أفكار، والفكر هو الحكم على واقع، فيكون الإِسلام أحكامًا على وقائع، وهو لا يمانع أن تجري العملية العقلية في كل ما جاء به، بل يسمح للعقل أن يدرك كثيرًا من علل التشريع فيه إدراكًا حسيًّا، أو أن يدرك فحوى أصول الأحكام التي جاء بها؛ وفي هذا المجال لا بد من أن يَفهم العقلُ النصَّ الذي حوى ما جاء به؛ سواء كان لفظُه من الرسول كأحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وليس فيه شيء لا يُدركُ العقلُ وجوده أو وجود أصله، ولا فيه نص لا يفهمه العقل ويشرح أسباب الحكم فيه. اللَّهم إلا بعض الأمور التعبُّدية التي ما شرعها الله تعالى إلا لمصلحة العباد وإن كانت تخفى عليهم الحكمة من تشريعها على الرغم من الاجتهادات الكثيرة التي قيلت حولها، كالوضوء للصلاة، والركوع والسجود والمسح على الرأس وغيره. فالإِسلام كونه أفكارًا أساسه العقل، والعقل هو الأداة القادرة على فهمه فقط؛ ومن هنا كان العقل هو الأساس الذي يقوم عليه الإِسلام، والأساس الذي تُفْهم به نصوص الإِسلام؛ فالإيمان به متوقف على العقل أولًا وأخيرًا؛ وإذا استثنينا الحروف الرَّمزية التي أنزلها الله تعالى في افتتاحيات بعض السور، والتي لم يهتدِ العقل إلى حلها كليًّا لوقتنا هذا، فإننا لا نجد في جميع نصوص القرآن طلاسم، لا يعلمها إلا الله، بدليل قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]. والعقل حين يُسْتعمل للوصول إلى نتائج مرضيّة، يجب أن يفرِّق بين استعماله في العقيدة للوصول إلى الإيمان، وبين طريقة استعماله في الأحكام الشرعية للوصول إلى فهم النصوص. فإذا استُعمل العقلُ في العقائد، وَجَبَ أن يكون استعمالُه من أجل اتخاذ دليل عليها واتخاذ حكم على صحتها أو فسادها. أما إذا استُعمل في الأحكام الشرعية، فينبغي أن يكون استعماله من أجل فهم النصوص وما دلَّت عليه، أي لفهم الأدلة التي جعلتها أحكامًا شرعية.
والدليل الشرعي على إثبات عقيدة لا بد من أن يكون دليلًا قطعيًّا؛ بخلاف الأحكام الشرعية فإنه يجوز أن يكون دليلها دليلًا ظنيًّا إلى أن يتسنّى للعقل أن يرجعها إلى قواعد كُبرى وأصول عامة. فالعقيدة الإِسلامية هي التصديق الجازم المطابق للواقع عن يقين؛ والتصديقُ غيرُ الجازم لا يُعدّ من العقيدة الإِسلامية، كما أن التصديق الجازمَ غيرَ المطابق للواقع لا يُعدّ من العقيدة الإِسلامية، بل لا بد من أن يجتمع في الفكر أمران.
أحدهما : الجزم في التصديق.
وثانيهما : مطابقة للواقع عن يقين ـــــــ حتى يُعدّ هذا الفكر من العقيدة الإِسلامية. لذلك كان القرآن الكريم يأمر، في صريح آياته، أمرًا جازمًا بأن تكون العقائد عن يقين، وينهى نهيًا جازمًا عن أخذ العقائد من الدليل الظني، فقد قال تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23]. وقال عزَّ وجلَّ: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} [الانعام: 116] وقال جلَّ شأنه {وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} [يونس: 66].
ففي هذه الآيات دليلٌ شرعيٌ يُثبت أن العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين ولا تؤخذ بالظن.
أما وجه الاستدلال بها، فهو أنها محصورة في العقائد، وموضوعها العقائد فحسب... وقد ذمَّ اللهُ بها الذين يبنون عقائدهم على الظنِّ وقال: {وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ} [البقرة: 78].
وقال عن الذين لا يؤمنون بالآخرة إنهم لم يبنوا اعتقادهم على العلم؛ أي على اليقين، بل بَنَوه على الظنِّ، ثم ختم الآية: بأنَّ الظنَّ لا يُغْني عن الحقّ شيئًا؛ فكان عليهم أن يتحروا ويبحثوا، حتى يكون اعتقادهم مبنيًّا على الجزم والقطع، بحيث يكون الدليل دليلًا يقينيًّا؛ وبهذا يكون الإسلام قد حدَّد الكيفية التي يتوصل بها المسلم إلى أخذ الأساس الذي يقوم عليه الإِسلام.
ومن يَتَّبع الشرعية يجد الأدلة اليقينية محصورة في ثلاثة، هي: العقل ـــــــ القرآن الكريم ـــــــ الحديث المتواتر. (وهو الحديث الذي يثبت أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قاله، ثبوتًا قطعيًّا لا يتطرّق إليه أدنى ارتياب).
وما عدا هذا الأدلة الثلاثة فلا تؤخذ منه العقيدة مطلقًا، بل يَحْرُم أخذ العقيدة من غيرها؛ لأن العقيدة عندئذٍ تكون مبنيَّة على الظنِّ، والظنُّ ليس بشيء...
أما الأحكام فإنه لا يشترط لأخذها أن يكون دليلها دليلًا قطعيًّا مجزومًا به دائمًا، بل يكفي أن يكون ظنيًّا عند العجز عن تحصيل دليله، والتردُّد بين الالتزام به أو الوقوع في الإِثم ومعصية الله.
فإذ غلب على ظنِّ المسلم أن هذا الحكمَ هو حكمُ الله في المسألة، جاز أخذه، بل أصبح حكمَ الله في حقه. والآية من القرآن، إذا كانت تحتمل عدة معانٍ، قد تكون دلالتُها على الحكم الشرعي دلالةً ظنيَّة، وقد يفهمها شخصٌ على وجه، ويفهمها شخصٌ آخرُ على وجهٍ آخر، وفي هذه الحالة يكون فهمُ كلٍّ منهما حكمًا شرعيًّا، وكذلك الحديث المتواتر إذا كان يحتمل عدة معان.
وأما الحديث غيرُ المتواتر فهو ظنيٌّ في أيّ حال، وقد يصلح لأن يكون دليلًا على الحكم الشرعي، لكن دلالته تبقى دلالةً ظنية سواء أكانت ألفاظُه لا تدل إلا على معنى واحدٍ، أم كانت تدل على عدة معان. وعلى هذا فلا يجوز أخذُ الحكم الذي يدل عليه، ولا إنزاله في مرتبة الحكم إلا من باب الاحتياط لكيلا يفوت الإِنسان واجبٌ ولكيلا يقع في محرَّم... والشاهدُ على أن الدلالة الظنيَّة كافية لأخذ الحكم في الحالة التي ذكرناها، ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الأحزاب، وهو قوله: (لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ العصرَ إلاَّ في بني قُرَيْظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق؛ فقال بعضُهم: لا نصلّي حتى نأتيها. وقال بعضُهم: بل نصلِّي، لم يُرِدْ منَّا ذلك، ذُكِرَ ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يعنف أحدًا منهم؛ وهذا صريحٌ بأن الرسول قد أقرَّ أخذ الحكم الشرعي بغلبة الظن في الحالات الفوتيَّة التي تعرِّضُ الإِنسانَ لكسبِ طاعةٍ أو تلافي محرَّم.
فالتشريع الإِسلاميُّ لا يسير على الطريقة التي يسير عليها التشريع الغربي، وهو لا يجعل الحرية موضع بحثٍ مطلقًا، لا في الإِثبات ولا في النفي وإنما يجعل موضع البحث الأساسي أفعال الإِنسان. والتشريع بحدِّ ذاته إنما جاء لمعالجة أفعال الإِنسان، ولم يأتِ ليقرِّر الحريَّة أو ينفيها، وهو لا ينظر إلى الإِنسان من حيث قيامُه بأفعاله على أساس الحرية ولا عدمها؛ وإنما يقوم على أساس أن هذه الأفعالَ تصدُر من الإنسان، فما هو حكمها؟
لذلك أوجب بعض الأفعال، ورتَّبَ عقابًا من الدولة على من لا يقوم بها، وحرَّم أفعالًا أخرى ورتب عقابًا من الدولة على من يقوم بها، ثم وعدَ بثوابٍ جزيلٍ ونعيمٍ مقيمٍ، يوم القيامة لكل من فَعَلَ واجبًا وترك مُحرَّمًا وتوعَّدَ بعقاب أليم لكل من فعل المحرَّم وترك الواجب.
ثم جعل بعض الأعمال مندوبات، أي مستحبَّات، وطلب فِعْلَها من دون أن يرتِّب أي عقاب على الترك، وهو يُثيب على الفعل، لأن فيه امتثالًا لأمره تعالى؛ ثم جاء إلى أفعال فطلب تركها لكنه لم يرتب أي عقاب على فعلها وهي المكروهات.
هذه إلى جانب أفعال خُيِّر الإِنسانُ في فعلها أو تركها أي إنه أباحها.
فالقضية إذًا، في نظرة التشريع الإِسلاميِّ لأفعال الإِنسان، هي أنه عمد إلى بعض أفعال الإِنسان فأوجبها، وإلى بعضها فحرَّمها، وعمدَ إلى أفعال أخرى فرغّب فيها من غير أن يرتب أي عقاب على تَرْكِها، وعَدَّ أفعالًا أخرى غير مرغوب فيها من غير أن يرتب أي عقاب على من لم يلتزم بالنهي عنها، وجعل بالأخير أفعالًا من أفعال الإِنسان مباحًا له فعلُها أو تركُها.
هذا هو موقف التشريع الإِسلامي من الإِنسان وعلى ذلك فالحريَّةُ ليست واردة في بحث التشريع الإِسلامي لا نفيًا ولا إثباتًا، إلا إن تقسيم أحكام فعل الإِنسان إلى حلال وحرام ومندوب ومكروه ومباح لا يعني أن التشريع الإِسلامي حصر أفعالًا فأوجبها بعينها، وحصر أفعالًا أخرى فحرَّمها بعينها، وحصر أفعالًا معنية فرغّب في فعلها، وحصر أفعالًا فنفَّر من فعلها، ثم أباح باقي الأفعال.
بل في التشريع الإِسلامي أوامرُ ونواهٍ من الله تعالى جاءت بمعانٍ عامة محددة الوصف كالبيع والربا مثلًا: أحلَّ اللهُ البيع، وحرَّم الربا، فالمخاطب بالحكم هنا هو الإِنسان، لكنَّ محلَّ الخطاب هو أفعال الإِنسان وهذا الحكم الذي خوطب به لا يترك له حريَّة فعل ما يراه، ولا هو يقيِّد هذه الحرية.
لكنه علاجُ لمشكلةٍ تقع له كثيرًا في هذه الحياة؛ فهو بيانُ حكمٍ لفعلٍ يصدر من الإِنسان بصفته إنسانًا. والناظر في أوامرِ الله ونواهيه يجد أن خطابه تعالى متعلّق بفعل الإِنسان من حيث هو إنسان، ومتعلقٌ بأفعالٍ موصوفة وصفًا عامًّا، أي إن هذا الخطاب قد جاء بمعانٍ عامة تنطبق على كل ما يندرج تحتها. فحين أعطى حلول المشاكل، أي أحكام الوقائع، جعل هذا الحكم خطًّا عريضًا أي معنى عامًّا، أو بعبارة أخرى، أعطى حكمًا لنوع الفعل ينطبق على كل فعل من نوعه، وعلى كُلِّ ما يدل عليه الوصف العام وما يندرج تحت المعنى العام إن كان الوصفُ غير معلَّل، وعلى كل ما ينطبق عليه الوصف العام أو يندرج تحت المعنى العام مع كل ما تنطبق عليه علَّة الحكم للوصف إن كان الوصف معلّلًا، فهو يقول في حكم البيع مثلًا أو في حكم خيار البيع أو في حكم الصرف: «أحلَّ الله البيعَ» ويقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ( البَيعان بالخيار، ما لم يتفرَّقا ) ويقول ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد )... ومن هنا يأتي الاستنباط من هذه المعاني العامة لإِيجاد حكم لكل مشكلة من المشاكل المتجددة والمتعددة للإِنسان عبر الأزمان؛ ولهذا لا يمكن أن تَحْدثَ واقعة إلا ولها حكم منصوص عليه، أو مستنبط، ولا تقع حادثةٌ إلا ولها حكم، ولا تُفْتَرَض مشكلةٌ إلا ولها كذلك حكم، وقد أعطى الشارع النصَّ، وترك للعقل البشري أن يجدَّ ويجتهد ويبذل أقصى ما عنده لاستنباط أحكامٍ للمسائل المتجددة والمتعددة من النصوص الخاصة أو القواعد العامة، ولم يجعل الاجتهاد مباحًا فحسب، بل جعله فرْضَ كفاية لا يمكن أن يخلوَ منه عصرٌ من العصور، وإذا خلا عصرٌ من مجتهدين فقد أثم المسلمون جميعًا:
ـــــــ هذا هو واقع التشريع الإِسلامي.
ـــــــ وذاك هو واقع التشريع الغربي.
ـــــــ وهذا هو الفرق الشاسع بين الشريعين بين تشريعٍ حقٍّ مبنيٍّ على أساس قطعيٍّ يعطي التشريعات الصحيحة التي تُعدّ في العالم كله وحدها هي الصحيحة، وبين تشريع ظنيٍّ خاطئ تقوم عليه تشريعات العالم اليوم.
فمن آيات الله العليِّ الحكيم قوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} [محمد: 1 ـــــــ 3].
ومما يؤسف له أن الذي حصل في الواقع، هو أن التشريع الغربي الباطل تحدّى التشريع الإِسلامي تحديًا صارخًا وقحًا، ثم كان من نتيجة ذلك أن هزم المسلمون.
ثم كان من نتيجة هذه الهزيمة أن دُمِّروا سياسيًّا تدميرًا تامًّا، ومُزِّقوا شر ممزَّق.. وإنَّ المرءَ ليَأخذُه العَجبُ والدهشة حين يدرك قصور التشريع الرأسمالي عن مواجهة كل مشكلة تعرض للإنسان، وقصوره عن حلِّها الحلّ الصحيح، ثم يشاهد هزيمة المسلمين أصحابِ المبدأ الحقّ أمامَ تحدِّي المبدأ الباطل!.
إن المسلمين حين هاجم الغربيون بالتشريع الرأسمالي كانوا مشدوهين بالتفوُّق الصناعي الهائل الذي حصل في الغرب، فانساقوا في الرد على هذا التحدي على الصعيد الخاطئ، ومشوا على مزاعمِ مَنْ قالوا لهم: إن النظام الرأسمالي يعالج كل المشاكل فهل في الإِسلام علاج لكل المشاكل يا ترى؟
فربط المسلمون أنفسهم بالعلاج الرأسمالي للمشاكل، مأخوذين بعظمة الاختراعات والصناعات، وصاروا يبحثون في الإِسلام عن علاج للمشاكل وَفْقَ ما عالجها التشريع الغربي. ومن هنا حصل الخلل في البحث، وحصل الخلل في التفكير، وكان من جراء ذلك حصول فُقدانِ الثقة في أحكام الإِسلام التي يخالف علاجها علاج أحكام الغرب وتشريعه. وما هو أدهى وأمرُّ من ذلك هو أنهم أخذوا يبحثون في الإِسلام عن رأي يوافق ما يقوله النظام الرأسمالي، أو لا يخالفه على الأقل، حتى يبرهنوا على صلاحية الإِسلام لمجاراة العصر فكانت الهزيمة النكراء.
فمثلًا: حين يسأل المسلمون عن المصارف (أي البنوك) لايُسألون هل الإِسلام قادرٌ أن يقول فيها ما يقوله النظام الرأسمالي أي، من حيث تنظيمها وإباحة الربا وكثيرٍ من مشاكل الصيرفة. وإنما يُسأل المسلمون ما رأي الإِسلام في المصارف، فيكون الجواب: إنّ واقع المشكلة في المصارف هو أن عملها يقوم بصورة رئيسية على الربا في القروض الطويلة والقصيرة الأجل، والحساب الجاري والاعتمادات وما شابه ذلك، ويقوم كذلك بتوصيل المال من بلدٍ إلى بلدٍ وبحفظ الأمانات وما أشبه ذلك.
أما توصيل المال وحفظ الأمانات فهو مباحٌ شرعًا سواء أكان بأجرةٍ أم بغير أجرة، وأما معاملات الربا كلها فإنها حرام قطعًا لأن الله تعالى يقول: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ويقول: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279].
والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما الرِّبا في النَّسيئة».
ويقول: و«الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد عينًا بعين مِثْلًا بمثْل. فما زادَ فهو ربا».
وكلمة الربا في القرآن والحديث جاءت عامة تشمل كل ربا لأنها اسم جنس مُحَلّى بالألف واللام فيشمل جميع أنواع الربا سواء أكان ربا الفضل، أم ربا النَّسيئة، ربًا معروفًا في أيام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أم ربا غير معروف حدثَ جديدًا.
ولهذا لا يوجد أي احتمال لِحل أي نوع من أنواع الربا لعموم اللفظ.
والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، على أن قول الله تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279] وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فما زاد فهو ربًا هما قولان صريحان في تحريم كل ما يزيد على رأس المال من ربًا، مهما قلَّ ومهما كان اسمه ومهما كان نوع معاملاته؛ فالربا بجميع أشكاله حرام.
هذا هو رأي الإِسلام في الربا سواء وافق العصر أو خالفه، وافق مصلحة الفرد أو خالفها، وافق المجتمع أو خالفه، فكل ذلك لا قيمة له ما دام الدليل الشرعي يجل على حرْمته، وهذا لا يجعل الشريعة الإِسلامية غير صالحة لهذا العصر لأنه لا يوجد فيها ما يحلل الربا من أجل المحافظة على الوضع الاقتصادي.
بل هي صالحة لأنها قادرة على أن تقول رأيها في المشكلة مهما كان هذا الرأي صعبًا على عقل الإِنسان القاصر من معرفة وجوه الحكمة من التشريع.
والربا من المسائل التي لا توجد إلا في المجتمع الرأسمالي وهي غير موجودة في المجتمع الشيوعي ولا في المجتمع الإِسلامي.
فحين يُطلب رأي الإِسلام فيه أو رأي الشيوعية، يُطلب الرأي في واقع المشكلة، لا الرأي الذي يوافق هوى النظام الرأسمالي وتشريعه المصلَحيّ.
وقِس على ذلك جميع المسائل التي تحدّى النظامُ الرأسماليُّ فيها نظام الإِسلام، وهاجم فيها التشريع الإِسلامي واتهمهُ بعدم مجاراة العصر، لأنه ليس فيه حلولٌ للمشاكل التي توافق أهواء الرأسمالية والصهيونية، ومما يؤسف له أيضًا، أنه لم يكن رد المسلمين محتويًا على بيان رأي الإسلام في المسائل كما دلت عليه الأدلة الشرعية التفصيلية، لكنه كان محاولة إيجاد حلول في الإِسلام تتفق مع ما يقول به النظام الرأسمالي؛ وبالطبع لا يمكن أن توجد هذه الحلول، للتناقض البيِّن بين النظام الرأسمالي والإِسلام؛ لذا بدأ التأويل لكنه ما نفع، ولا وافق هوى النظام الرأسمالي والتشريع الغربي، فشاعت وذاعت من جراء التأويل مفاهيمُ مغلوطةٌ هي على درجة كبيرةٍ من الخطر على المسلمين وعلى مفاهيم الإِسلام، روَّجها أعداء الإِسلام وخصومه من الطرفين.. لذا نوديَ بمفاهيم جديدة؛ أولها : أن الإِسلام مرن متطور.
وثانيها: أنه لا بد للإِسلام من مسايرة الزمن.
وثالثها: أنه لا بد من إيجاد انسجام بين الإسلام والعالم الحديث.
ونودي باقتراحات كثيرة تنطوي تحت عنوان أن الإِسلام يمكن تأويله، ولكل امرئ أن يتخذَ الرأي الذي يريده ولو ناقض أسس الإسلام وأحكامه؛ وقصدوا بذلك معنى مرونته وتطوره، وقصدوا به مسايرة العصر إذ لا يجوز أن يسير المسلمون في جهةٍ والغربيون في جهةٍ أخرى، وخصوصًا أنهم يسودون العالم في العصر الحديث؛ فيجب علينا أن نؤوِّل الإِسلام بحسب رغبات الغرب، ونغيِّر المفاهيم حتى نوجد انسجامًا بيننا وبين العالم المتمدن، وهذا يعني أنه يجب علينا بالتالي أن نترك الإِسلام ونتبع النظام الرأسمالي، لأن الإِسلام يناقضه ولا يُقرُّه على سُنَنِه وبِدَعِه...
فكل دعوة للتوفيق بين الإِسلام وغيره من الأنظمة، هي دعوة لأخذ الكفر وترك الإسلام، وفي هذا ما فيه من خطر على المسلمين وعلى الإِسلام، صحيح أن الإِسلام وضع خطوطًا عريضة في كثير من الأحكام، وترك للعقل البشري أن يستنبط الأحكام الشرعية للمشاكل المتجددة كل يوم، والمتعددة بتعدد الوقائع. لكنه لم يترك حالة إلا جعل لها حكمًا منصوصًا أو مُجْتَهدًا فيه، من دِيَةِ القتيل حتى أَرْش الخَدْش، أي فِدية من يخدش خده أو جسمه أو يخدش غيره عمدًا... وذلك لا يعني أن هذا مرونة وتطور، فيمكن للمرء أن يأخذ أي حكم يريده منها، لأنها لا تعطي إلا ما فيها مما دل عليه اللفظ، وكذلك لا يعني أن هذه المعاني العامة تساير كل عصر، بل يعني أن كل عصر يجد حلول المشاكل التي تحصل فيه ضمن هذه الخطوط العريضة.
ويجب أن يعلم المسلمون أن العالم الحديث ليس يعني الصناعات والاختراعات والاكتشافات. فإن هذه ليست محل نزاع بين العالم والمسلمين، لأنها عالمية وفي استطاعة كل واحد من الفريقين أن يستعملها، بل الصراع قائم بين المسلمين وغيرهم على طريقة العيش، أو النظام المعين لمعالجة المشاكل وحلها، أو بعبارة أوضح على الأيديولوجية.
والعالم الحديث الذي هو الرأسمالية ومعها الديمقراطية والقانون المدني وما شابه ذلك، كله في نظر الإِسلام باطل لا بد من إزالته، وإحلال الإيديولوجية الإِسلامية محلَّه وجعل طريقة الإِسلام للعيش في الحياة هي السائدة، ونظام الإِسلام في معالجة المشاكل هو الذي يتحكم، من أجل نشر لواء العدل في الأرض وتخليص الإِنسانية مما تعانيه من ظلم الإِنسان لأخيه الإِنسان.
فكيف يمكن أن يفكر من آمن بالإِسلام وفهِمَهُ، أن يحاول إيجاد الانسجام بينه وبين تلك الأنظمة الفاسدة التي يجب على المسلم إزالتها وإحلال الإِسلام محلها.
ولكن نقول بكل أسف وبكل حسرة، قد سادت المسلمين المفاهيم الغربية، وسيطرت عليهم فكرةُ محاولة تأويل الإِسلام ليوافق النظام الرأسمالي وغيره، فكانت هنا الهزيمة النكراء، وكان هنا النصر المدمر للقيم الإِنسانية الذي أحرزه الغربيون على العالم الإِسلامي كله.
وكان هنا بدء تحول التاريخ إلى وجهة أخرى. غير الوجهة التي كان يتجهها، وتحوَّل زمام العالم من أيدي المسلمين إلى أيدي الغربيين فكان طبيعيًّا أن يتسرب الخلل إلى الثقة بأحكام الإِسلام وأفكاره، وأن يثار التساؤل عن صلاحية الشريعة الإِسلامية لمعالجة مشاكل العصر الحديث، ومماشاة الزمن، فكان هذا أول الوهن في كيان الأمة الإِسلامية إذا أخذنتا الأمة بمفهومها الحقيقي كمجموعة من الناس تجمعها عقيدة عقلية ينبثق عنها نظامها. أي إنها مجموعة من الناس مع مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات تربطها عقيدة واحدة. فإذا تسرب الخلل إلى هذه المفاهيم والمقاييس والقناعات فقد تسرب إلى كيان الأمة كلها يعمل فيها تهديمًا وتخريبًا.
وهذا الوهن في الأمة تسرب إلى كيان الدولة الإِسلامية. لأن مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات الإِسلامية التي كان يمسك بزمامها المسلمون قد اعتراها الخلل ومن ثم تسرب إلى كيان الدولة فضربَ فيها بمعول الهدم والإِزالة.
وهذا ما حدث بالفعل، وما ظهرت نتائجه خلال قرن واحد؛ فإن الاستعمار عندما يئس من غزو الدولة الإسلامية وتحطيمها، وتكوَّن لديه رأي بأن الجيش الإِسلامي لا يُغلب، عمد إلى غزو الأمة الإِسلامية بالأفكار الغربية ليزعزع كيانها التي تنبثق عنه دولتها؛ ومن أجل الوصول إلى غايته قام بالغزو الفكري عن طريق الإِرساليات التبشيرية والمدارس والمستشفيات والكتب والنشرات والجمعيات السرية؛ واتخذ مراكز له في مالطة وغيرها. ونشطت إلى جانب ذلك السفارات الأجنبية في اسطنبول والقاهرة ودمشق وبيروت؛ وبلغ النشاط أشدَّه في الأوساط السياسية كما في الأوساط الفكرية فاستمالَ أعداءُ الإِسلام كثيرًا من شباب الجامعات والمدارس، وكثيرين من الذين يشغلون مناصب في الدولة وفي الجيش، فكان لهذا أثره في بعث حب الثقافة الغربية في نفوس المسلمين وتشكيكهم في الإِسلام وصلاحيته للعصر الحديث.
والحجة التي بنيت عليها تلك السياسات كانت تحت ستار حب الاستفادة مما عند الغرب مع اصطناع المحافظة على الإِسلام بشكل ظاهري. وهكذا كانت البداية عندما راح السوس ينخر في جسم الأمة كما راح ينخر في جسم الدولة.
وانتقلت الدولة الإِسلامية من دور المَدِّ إلى دور الجَزْر كما انتقلت الأمة الإِسلامية من دور حمل الدعوة الإِسلامية إلى دور تلقّي الثقافة الاستعمارية بنوع من التضليل الخبيث ولما استفحل الأمر، وأيقنت الدول المستعمرة = ولا سيما إنكلترا وفرنسا = أن الانحلال بدأ في الأمة الإِسلامية، وأن الوهن قد تغلغل في دولتها، بدأت بالفِعْل تُغيرُ على أطراف الدولة الإِسلامية تقتطع منها الأجزاء تباعًا ثم عمَّ الطمعُ جميع َ دول أوروبا، فصارت روسيا وألمانيا تحاولان الاشتراك في هذه الغنائم، وعلى الرغم من اختلاف الدول على اقتسام الدولة الإسلامية وصراعهم عليها فإنهم اتفقوا جميعًا على إزالة نظام الإِسلام من الأرض.
لذلك فكَّرت الدولُ الغربية جميعُها في إجبار الخلافة في اسطنبول على التخلي عن نظام الإِسلام في الحكم والمجتمع والسياسة، وإكراهِهَا على تطبيق التشريع الغربي في القضاء، والنظام الرأسمالي في الاقتصاد، والنظام الديمقراطي في الحكم. فكان مؤتمر برلين الذي عقد سنة 1850م بين الدول الأوروبية وكان حينها رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلي اليهودي ورئيس وزراء ألمانيا بسمارك.
واتفق المؤتمر على إرسال مذكرة إلى خليفة المسلمين يطلب فيها منه أن يترْك النظام الديني وأن يأخذ بالنظام المدني. ثم بُعِثت المذكرةُ بلهجةٍ تهديدية وما إن سُلِّمت إلى الباب العالي في اسطنبول حتى نشط المثقفون والسياسيون في الدعوة إلى إيجاد النظام المدني والسير مع العصر، فأثَّر نشاطهم في الخليفة، إذ وُجد في الأوساط السياسية والأوساط المتعلمة رأيٌ عام لتغيير الأحكام الشرعية، وإحلال القوانين الغربية محلَّها؛ وما هي إلا فترة قصيرة حتى بدأ هذا التغيير. ففي سنة 1275 هجرية 1858م، وُضع قانون الجزاء وقانون الحقوق والتجارة. وفي سنة 1276 هجرية 1868م، وضعت المجلة قانونًا للمعاملات، ووضعت قانونًا من الأحكام الشرعية مع ملاحظة بشيء من التوفيق بينها وبين أحكام القانون المدني. وفي سنة 1288 هجرية 1870م جُعِلت المحاكمُ قسمَين: محاكم شرعية - ومحاكم نظامية. وفي سنة 1295 هجرية 1877م، وُضِعَت لائحة تشكيل المحاكم النظامية.
وهكذا استبدلت القوانين الإِسلامية تدريجًّا، وحل محلّها القانون الغربي، لذلك كان زوال الدولة الإِسلامية أمرًا مقررًا؛ ولم تبق المسألة إلا مسألة وقت ليس غير؛ لأن الأمة الإِسلامية تخلَّت عن نظام الإِسلام عمليًّا في القضاء والحكم، وزعزعت ثقتها بصلاحيته للعصر الحديث؛ ولأن الذين كانوا يتولَّون تطبيق نظام الإِسلام صاروا يَرون ضرورة تركِه وأخذ النظام الرأسمالي؛ ولم تبقَ المسألة عندهم إلا مسألة أسلوب في الأخذ فقط. لهذا لم يكن سقوط الدولة الإِسلامية، وزوال الخلافة أمرًا مفاجئًا: فالأمة وصلت فيها الحال إلى أن ضابطًا من ضباط الجيش الإسلامي، هو مصطفى كمال، يخرج على الخليفة وينشئ حكومةً غير حكومته في أنقرة، ثم يحاربه ويخلعه ثم يزيل الخلافة من الوجود، من غير أن يحفل بمشاعر الأمة كلها ولا بتأييدها لوجود خليفة للمسلمين وقد ساعده على ذلك وقوف الكثيرين من دعاة التجديد إلى جانبه، ولم يعارضه في عمله إلا القليل. لكنَّ السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: هل كان يمكن أن يحصل ذلك والإِسلام كعادته يتحكَّم في أفكار الأمة ومشاعرها؟ لا، لا يمكن. فإذًا كان من الطبيعي أن يحدث إلغاء الخلافة الإِسلامية من الوجود، ثم مباشرة الغرب حكم المسلمين من جراء وهنهم وضَعْفِ عقيدتهم في نفوسهم وتنازلهم عن ممارستها فِعْلًا...
وعندما صار الأمر كله للغربيين صاروا يُنَصِّبون حكامًا من المسلمين ويختارونهم ممن هم أشد منهم عداءً للإِسلام، وأحرص على محوه؛ وها قد مضى ما يزيد على نصف قرن من الزمن والأمة الإِسلامية خاضعة لنفوذ النظام الرأسمالي، حتى أشرفت على خطر الفناء ولم يبق بينها وبين الفناء إلا مسألة زمن، إلا أن يتداركها الله برحمته.. أوَليست فكرةُ فصل الدين عن الدولة رأيًا عامًّا يسود جميع أوساط الأمة الإِسلامية بلا فرقٍ بين الأوساط السياسية والأوساط الشعبية أو بين أوساط المتعلمين والمتدينين أو بين الشيوخ والشباب؟ فكلهم صار ينادي بفصل الدين عن الدولة لأن الأمر صار عندهم رأيًا عامًّا وعُرْفًا عامًّا. والله سبحانه وتعالى يقول: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة: 49]. والأمة في عصرنا هذا تفصل الدين عن الدولة عمليًّا، مع أن أكثر الأفراد لا يعرفون ماهية فصلِ الدين عن الدولة، لكنهم يمضون مع ما يراه الناس، ويرضخون بالنتيجة إلى هذا الفصل، وإلى الحكم بالنظام الغربي.
أليست الرابطة صارت بين الشعوب الإِسلامية رابطة صداقة أو رابطة جوار، أو مصلحة أو رابطة أخوة عرقية فقط بينما انعدمت فيها رابطة الأخوة الإسلامية؟ أو ليس على هذا الأساس صار الرأي العام لا ينطق برابطة الأخوة بين إيران والعراق ولا بين سوريا وتركيا، ولا بين الأفغان وباكستان وإنما ينطق برابطة الصداقة والجوار والمصلحة المشتركة، ولم يبق ممن ينطق برابطة الأخوة الإِسلامية سوى الأفراد الذين لا يُسمع لهم صوت؟
هذا، مع أن الرابطة الوحيدة التي تربط المسلمين بعضهم ببعض إنما هي الإِسلام ليس غير، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10].
والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول (المسلم أخو المسلم).
ولم تقف الحال عند رابطة الشعوب بل صارت رابطة الشعب الواحد هي الوطنية أو القومية، ولم يعد الرأي العام يرى رابطة الإِسلام في أي قطر من الأقطار التي تشكل دولًا في العالم الإِسلامي. ثم ألم يستسيغ المسلمون أن يكون التركي في سوريا أجنبيًّا، والإيرانيُ في مصر أجنبيًّا؛ واللبنانيُّ في السنغال أجنبيًّا، والسوريُّ في الكويت أجنبيًّا، والأردنيُّ في اليمن أجنبيًّا؛ ورضوا أن يسمّوا المسلمَ أجنبيًّا في بلاد الإِسلام؟
ثم ألم يبهر المسلمونَ النداء للوطنية والقومية فتثور مشاعرهم لذلك، ثم لا تتحرك لهم عاطفة عند النداء لإعادة حكم الإِسلام؟
ثم أليس مقياس المسلمين صار المنفعة بدلَ الحكم الشرعي، وصار مقياس الأحكام الشرعية موافقتها للمصلحة المادية لا للدليل الشرعي؟
ثم ألا يَستَبْعِدُ جمعٌ غفير من المسلمين رجوع الإِسلام إلى معترك الحياة، بل يستنكِرُ ذلك الكثيرون ويعدُّونه من المستحيلات؟
أو ليس هذا هو واقع الأمة الإِسلامية التي تجمعها في الأصل عقيدة واحدة هي التي انبثق عنها نظامها فسادت الدولة الإِسلامية يومئذٍ على أساسه؟
فإذا كانت هذه الأمة قد انفصل نظامها عن عقيدتها عمليًّا، وصار هذا الفصل هو العرق العام المقبول، فكيف تبقى بعد ذلك أمة مستكملة الربط؟
وإذا كانت الأمة مجموعة من الناس مع مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات تربطها عقيدة واحدة = كما رددنا وقلنا = وقد أصبحت لدى أمتنا أكثرُ المفاهيم مفاهيمَ غير إسلامية، وأكثر المقاييس مقاييسَ غير إسلامية، وصارت أكثر القناعات قناعاتٍ غيرَ إسلامية، فكيف يُمْكن أن يبقى كيان هذه الأمة إسلاميًّا بعد أن تغيَّرت فيه كل مقومات الكيان الإِسلامي؟ إنه لمِنَ الخطأ أن يقال: إن الأمة الإِسلامية على مفترق طرق، فإن ذلك كان قبل نحو قرن أي يوم بدأت تأخذ أفكار الغرب إلى جانب أفكار الإِسلام.
أما اليوم فقد انزلقت أقدام الأمة الإِسلامية في أوحال الغرب، ولوثتها شريعتُه الظالمة، ومدنيتُه الضالة المضللة. ولكن، من الضلال أيضًا، أن يقال إن الأمة الإِسلامية يمكن أن تفنى، قد يكون ذلك يوم أن دُمّرت الخلافةُ الإِسلامية وتقلَّص حكمُ الله من المجتمع في جميع أنحاء الأرض، ويوم أن صار فصلُ أحكام الإِسلام عن الدولة رأيًّا عامًّا، أما يوم أن تعود الثقة والولاء، وتترسخ أفكار الإِسلام في الأذهان وتتحرَّك بقايا التراث الروحي وتنبعَثُ من جديد، فإن فناء الأمة وذَوبانها في خضمِّ أنظمة الكفر أمر مستحيل، لأنَّ موت العقيدة الإِسلامية هو في الأصل، ضرب من المستحيل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [لحجر: 9].
فالأمة الإِسلامية لم تصل إلى حافة الهاوية وإن كانت قد أوشكت أن تصل إليها.. فهلاّ وعيتم ذلك أيها المسلمون؟!
إنّ واقع الأمة الإِسلامية يتردَّى في انعدام الثقة بصلاحية الإِسلام لأن يكون نظام حياةٍ في العصر الحديث
وهذه هي القضية التي يجب أن توضع الأصبع عليها، والتي يجب أن تكون محل البحث وموضوع العلاج.
لذلك كان من الخطأ أن يقال إن القضية هي قضية العقيدة الإسلامية، لأن هذا يعني اتِّهام المسلمين في إيمانهم، وهذا غير صحيح، وهو أمر في منتهى الخطورة. فالعقيدة الإِسلامية موجودة في كل مسلم والحمدلله، لكنَّ الأمة الإِسلامية فقدت ثلاثة أمور مهمة:
أولًا: فقدت علاقتها بأفكار الحياة وأنظمة التشريع فغاضت منها الحيوية، من جراء تنكرها لعقيدتها العقلية التي إذا ما انفصلت أفكارها عنها ماتت وانتهت إلى جثة هامدة.
ثانيًا : فقدت تصوُّرها ما بعد الحياة، فكأنها لم تعُد مصدقة أنها ستواجه في سيرها يومَ القيامة وحسابَه ولم تعد تخشى عذاب الله، ولم تعد تُخيفها جهنم، ولا يُرعبها الجحيم.
كما أنها لم تعد تستهدف الجنة، ولا تشتاق إلى نعيمها حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرَ على قلب بشر. وبالتالي لم تعد تستهدف رضوان الله غاية الغايات عند المسلمين.
ثالثًا: فقدت الرباط الإِسلامي كجماعة، فصار المسلمون شعوبًا ودولًا ودويلات وجمعيات وأُسرًا بل صاروا أفرادًا متفرِّقين.
إن فقدان هذه الأمور الثلاثة يوشك أن يجعل الأمة الإِسلامية أمة ميتةً إن لم يدق المسلمون النفير، ويصيحوا صيحة الغاضب الثائر على الجهل، والغي، والضلال.
أما العقيدة الإِسلامية نفسها فلا تزال موجودة عند كل مسلم، ولا يزال كل مسلم يقول صباح مساء: لا إله إلَّا الله محمد رسول الله.
وإن كان بعضهم عندما يقولها لا تتحرك شعرةٌ في بَدنه، ولا خلجةٌ في قلبه، ولا شيء من مشاعره، ولا تجعله يتقدم في الحياة قدر إصبع، ولا تُوجدُ في طريق تأخُّره وانحطاطه أي عائق من العوائق ولا أي حاجز من الحواجز؛ من هنا كان تأكيدنا على أن المسلمين لم يفقدوا العقيدة الإِسلامية، وإنما فقدوا الثقة فيما ينبثق عن هذه العقيدة الصحيحة السليمة.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢