نبذة عن حياة الكاتب
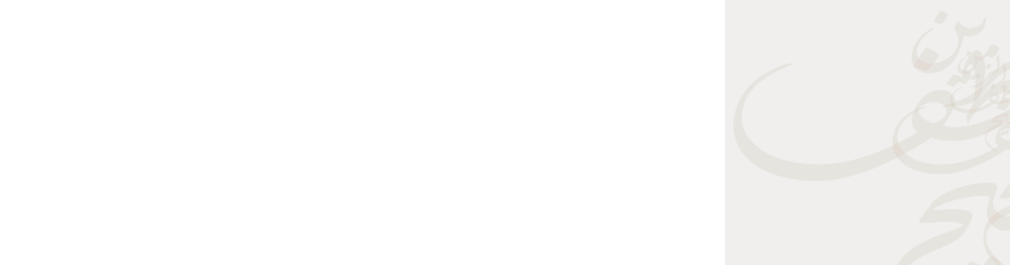
X
المعاملات والبينات والعقوبات
التقليد والاجتهاد الطريقة العملية للاجتهاد
الأوامـر والنـواهـي:
قال الله تعالى في محكم تنزيله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحَشر: 7]. وندرك من دلالة النص أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نأتمرَ ونعملَ بما أتانا به رسوله الكريم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، وأن ننتهيَ عما نهانا عنه. فلا يكون أمام المؤمنين إلاَّ الامتثالُ لطلب العزيز الحكيم وهو أن يأخذوا ما آتاهم الرسول بقوة وعن رضا وطاعة، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه في غير ترخُّصٍ ولا تساهل. فيكون هذا الطلب هو الأمر والنهي معاً، لأن الأمرَ هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والنهيَ هو طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء. ولذلك لم يكن الأمر والنهي، في كل ما أمَرَ به الشارع أو نهى عنه، على وتيرةٍ واحدة، بل إنه يختلف باختلاف القرائن المتعلقة بالأمر أو النهي التي تقرِّب من مدلول النص ومعناه، وتوجب بالتالي ما يقتضيه إما فعلاً أو تركاً. وعلى هذا فقد يكون الأمر للوجوب، أو الندب، أو الإباحة أو الإرشاد... وقد يكون النهي للحرمه، أو الكراهية أو الإرشاد..
وقد اتفق الأصوليون على أن الأوامر تَرِدُ على ستةَ عشرَ وجهاً إذا كانت مطلقة، عاريةً من القرائن، وأن النواهيَ ترد على سبعةِ وجوه. وذلك على النحو الآتي:
أ - الأوامر:
1 - الوجوب: كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ} [الإسرَاء: 78].
2 - الندب: كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} [النُّور: 33].
3 - الإرشاد: كقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا} [النِّسَاء: 15]. وهو قريبٌ من الندبِ، غير أن الندبَ لمصلحةٍ أُخرويّةٍ، والإِرشادَ لمصلحةٍ دنيويّةٍ.
4 - الإِباحة: كقوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} [المَائدة: 2].
5 - التأديب: وهو داخلٌ في النّدب كقولك: (كُلْ ممّا يليك).
6 - الامتنان: كقوله تعالى: {وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} [المَائدة: 88].
7 - الإكرام: {ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ *} [الحِجر: 46].
8 - التهديد: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فُصّلَت: 40].
9 - الإنذار: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ *} [هُود: 65]، وهو بمعنى التهديدِ.
10 - السخرية: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ *} [الدّخان: 49].
11 - التعجيز: {كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا *} [الإسرَاء: 50].
12 - الإهانة: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ *} [البَقَرَة: 65].
13 - التسوية: {فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا} [الطُّور: 16].
14 - الدعاء: {رَبِّ اغْفِرْ لِي} [الأعرَاف: 151].
15 - التمني: كقول الشاعر: ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انجلِ.
16 - كمال القدرة، كقوله تعالى: {كُنْ فَيَكُونُ *} [غَافر: 68].
فصيغة الأمر «افعلْ»، إنها وإن كانتْ ظاهرةً في الطّلَبِ والاقتضاءِ، وموقوفةً بالنسبةِ إلى الوجوبِ والندبِ، فيُمكن أن تكونَ للإِباحةِ وللإذنِ في الفعلِ كما تقدّمَ. فإذا وردَتْ بعدَ التحريم، احتُمِلَ أن تكونَ مصروفةً إلى الإِباحة ورفْع الحظر كما في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المَائدة: 2]، {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزَاب: 53]. {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا} [الجُمُعَة: 10]. وقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «كنتُ نهيتُكُمْ عنِ ادّخارِ لحومِ الأضاحي فادّخروا»[*]، واحتُملَ أن تكونَ مصروفةً إلى الوجوبِ كما لو قيلَ للحائضِ والنفساءِ: إذا زالَ عنكِ الحيضُ فَصلّي وصُومي»[*].
ب - النواهي:
إن صيغة «لا تفعل» هي النهي، أي الأمر بترك الفعل. وقد أوردها الأصوليون، كما قلنا في سبعة وجوه:
1 - التحريم: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى} [الإسرَاء: 32].
2 - الكراهة: {وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} [لقمَان: 18].
3 - التحقير: {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ} [الحِجر: 88].
4 - بيان العاقبة: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً} [إبراهيم: 42].
5 - الدعاء: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البَقَرَة: 286].
6 - اليأس: {لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} [التّحْريم: 7].
7 - الإِرشاد: {لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المَائدة: 101].
فهي حقيقةٌ في طلبِ التركِ واقتضائهِ، ومجازٌ فيما عداه.
وهكذا كما تبيّن لنا، فإنَّ الأمر والنهي هما طلب من الله سبحانه وتعالى، أو هما خطاب الشارع بصيغة الطلب أمراً أو نهياً. فأما الأمر فقد يكون جازماً أو غير جازم:
فالأمر عندما يكون جازماً يدل على الوجوب، ويكون فرضاً على المكلف أن يقوم به. وهذا الأمر الجازم تدل على القرائن كقوله تعالى: {فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا *} [النِّسَاء: 103]، وقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ *الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ *} [المَاعون: 4-5]. ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقول: «بين العبد والكفر تركُ الصلاة»[*].
فهذه الآياتُ وغيرها، وكذلك الأحاديثُ التي حثت على الصلاة، تُعتبرُ جميعاً من القرائن التي تدل على معنى الوجوب أو الفرض. ولذلك كان الأمر بها جازماً.
والأمر عندما لا يكون جازماً يكون مندوباً أي مستحباً، وهو ما يؤجر المرء إذا قام به، ويُعدُّ نافلةً.
وأما النهي، فهو كالأمر، قد يكون جازماً وغير جازم: فالنهي الجازم هو ما يدل على أنه حرام، والحرام معناه المحظور، أي أن على المرء أن يبتعد عنه، لأن القيام به يعاقب عليه.
وهذا النهي الجازم يحتاج إلى قرائن تدل على أنه جازم، كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وسَاءَ سَبِيلاً *} [الإسرَاء: 32] وقوله وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النُّور: 2]. فهذه النصوص هي قرائن على النهي الجازم، أي أن القرينة هي التي جعلته جازماً. وكذلك الأمر بالنسبة لجميع القرائن، التي تجعل هذا الأمرَ الناهيَ جازماً أو غيرَ جازم.
وعندما لا يكون النهي جازماً، يكون مكروهاً، يُثابُ المرء على تركه، ولا يُعاقبُ أو يُذمُّ على فعله.
وهذه الأوامر والنواهي، التي وردت في الكتاب والسنة، هي التي يتعقبها المجتهد، ويدقق في معانيها ومدلولاتها، ويتحرى القرائن التي تحدد اتجاهها، وتعيّن معانيَ النص، لأن خطابَ الشارع أو الحكمَ الشرعيَّ هو ما جاء في الكتاب والسنة من أوامرَ ونواهٍ، ويفهم بالنص وبالقرائن.
وهذا النوع من الأوامر والنواهي هو الذي يعنينا في موضوعنا الذي يتعلق بالطريقة العملية للاجتهاد، لأننا في الأصل إنما نبحث عن الحكم الشرعي الذي يتعلق بالحلال والحرام، والمندوب والمكروه، وما بينها جميعاً وهو المباح..
ولقد اخترنا من أجل ذلك أن نتكلم عن مواضيعَ تخص، في عصرنا الحاضر، الشبابَ والشابّاتِ بل وجميع المسلمين الذين تأخذهم الحيرة بين واقعٍ لا يستطيعون الهروب منه، وهو يواجههم يومياً في حياتهم، وبين أحكام واجتهاداتٍ تمنع عليهم ملامسةَ هذا الواقع، وقد تحرم عليهم التعاطيَ معه، فماذا يفعلون؟ من أجل ذلك كان الاجتهاد ضرورياً في مثل هذه المواضيع حتى يرتاح المسلمون، - والمؤمنون منهم خاصة - ويباشروا شؤون حياتهم باطمئنان، ويحفظوا بذلك دنياهم وآخرتهم.
من تلك المواضيع التي نؤثرُ البحثَ فيها: التصويرُ، والصورة، والموسيقى، والغناء، والألعاب، واللحية، والحجاب، وغيرها من المواضيع التي سوف نأتي على ذكرها إن شاء الله العلي القدير.
ولم يكن اختيار هذه المواضيع إلاَّ لأنها مواضيع يجوز الاجتهاد فيها. إذ لم ترد أحكام لها في القرآن المبين - الذي هو قطعيُّ الثبوت - إلاَّ تلميحاً، بينما وردت على شكلٍ صريحٍ في السنة النبوية عن طريق حديث الآحاد الذي هو ظنيُّ الثبوت. كما أنَّ هذه المواضيع ليست من أحكام العبادات والمطعومات والملبوسات، وهي الأمور التي لا يجوز الاجتهاد فيها لأنها توقيفيَّة عن الله سبحانه وتعالى. فمثلاً لا يجوز لأحد أن يعترض على تحليل لبس الحرير الخالص للنساء وتحريمه على الرجال، ولا أن يقول: لماذا فرضت صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربعاً؟.. أو لماذا جُعِل الصومُ شهراً متتابعاً، فلو كان أسبوعاً كل ثلاثة أشهر لكان أيسرَ على المسلم؟. أو لماذا يحلُّ أكل لحم الجمل، ويحرمُ لحمُ الخنزير مع أنه يقال إنَّ لحمَ الخنزير أطيبُ طعماً؟...
لا يجوز هذا ولا غَيرُهُ في كل ما يتعلق بأحكام العبادات والمطعومات والملبوسات، لأنها يجب العمل فيها كما ورت دون البحث أو الاجتهاد لاستنباط علّة شرعية أحلَّها الله تعالى أو حرمها لأجلها، ولأنها أحكام ليست معللة. وذلك بخلاف بقية الأحكام الشرعية، التي تتعلق بسائر شؤون الحياة الأخرى، والتي يجوز أن نفكِّر فيها، وأن نجتهد لكي نستنبط منها علة شرعية باستطاعة العقل أن يفهمها وأن يقيس عليها، على ألاَّ يكون ذلك إلاَّ لمن توفرت فيه الكفاءة والشروط للاجتهاد.
وهذا يعني أن كلّ مسلم يمكنه أن يفهمَ خطاب الشارع، لأن مناطَ الأمر وتطبيقَ الحكم الشرعي يقع على عاتقه. فخطابُ الشارع موجهٌ إلى جميع الناس في الأساس، وليس إلى المجتهدين والعلماء وحدهم. فكان لزاماً أن يفهمَ كلُّ واحدٍ خطابَ الشارعِ ويعرفَ حكمَ الله تعالى.
وتتبيّن لنا هذه الأمورُ عندما يأمرُ الله عزَّ وجلَّ رسوله محمداً (صلى الله عليه وآله وسلّم) بأن يظهر للناس أنه رسوله الذي حمَّله الخطاب والأحكام ليبلِّغها إليهم، وذلك بقوله تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعرَاف: 158]، وكذلك في الآيات الكريمة التي جاء فيها قوله العزيز: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النِّسَاء: 135]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البَقَرَة: 178]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *} [البَقَرَة: 183]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ *} [الحُجرَات: 13].
فهذه الآيات هي خطاب من الشارع الأعظم. فكان على من سمع الخطاب أن يؤمن به. وعلى من آمن به أن يَفْهَمَهُ ويَعْمَلَ بهِ، لأنَّهُ هو الحكمُ الشرعيّ. ولذلكَ كانَ الأصلُ في المسلم أن يَفْهَمَ بنفسِهِ حُكْمَ الله تعالى الموَجّهَ مباشرةً للجميعِ، وليس للمُجْتَهِدين، ولا للعلماءِ فقط، بلْ لجميعِ المكلّفينَ. وصَارَ فَرْضاً على المكلّفينَ أن يَفْهَمُوا هذا الخطابَ حتى يتأتّى لهمْ أنْ يَعْمَلُوا بِهِ لأنّهُ يستحيلُ العَمَلُ بالخطابِ دون فَهْمِهِ. وأصبح استنباطُ حُكْمِ الله تعالى فرضاً على المكلّفينَ جميعاً، أي صارَ الاجتهادُ فَرْضاً على جميعِ المكلّفينَ. ومنْ هنا كانَ الأصلُ في المكلّفِ أنْ يأخذَ حكمَ الله تعالى بنفسهِ من خطابِ الشّارعِ.
ولكنَّ واقِعَ المكلّفينَ يُظهرُ أنهم متفاوتون في الفَهْمِ والإِدراكِ، وأنهم مختلفونَ منْ حيثُ العلمُ والجهلُ. فكانَ منَ المتعذرِ على الجميعِ استنباطُ جميعِ الأحكامِ الشرعيّةِ من أدلّتها. بل ومن المتعذّرِ أنْ يكونَ جميعُ المكلّفين مجتهدينَ. ولذلكَ كانتْ قضيّةُ الاجتهادِ فرضاً على الكفايةِ، إنْ قامَ بهِ البَعْضُ سَقَطَ عنِ الباقينَ. وكانَ فَرْضاً على المكلّفينَ المسلمين أنْ يكون فيهمْ مجتهدونَ لكي يستنبِطُوا الأحكامَ الشرعيّةَ، في مواجهة مشاكل الحياة ومستجداتها.
وقبل أن نتكلّم عن الاجتهاد، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المسلم حتى يكون مجتهداً لا بد من كلمة وجيزة من التقليد.
التقليـد:
التقليد في اللغة: اتِّباع الغير دون تأمل. يقال: قلَّده في هذا الأمر إذا تبعه فيه من غير تأمل ولا نظر. والتقليد في اصطلاح الفقهاء هو العمل برأي الغير من دون حجة مُلزِمة.
والتقليد شرعاً إما أن يكون في العقيدة، وإما أن يكون في الأحكام الشرعية.
أما التقليد في العقيدة فلا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى ذمَّ المقلّدين الذين اتبعوا آباءهم دون التفكر والتبصر بما جاءهم به أنبياؤهم ورسلهم من عقيدة التوحيد، التي تنهى عن الشرك والوثنيّة. قال الله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ *} [المَائدة: 104]. وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ *} [البَقَرَة: 170].
وأما التقليد في الأحكام الشرعية فجائز شرعاً لكل مسلم. قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ *} [الأنبيَاء: 7]، وقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البَقَرَة: 282]، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلمكم فتتقون، مما يتبيَّن معه تقدم العلم مكانةً على التقوى وعلى العمل. ولذلك كان فرضاً على المسلم أن يتعلَّم أحكام الله تعالى التي تلزمه قبل العمل.
ولكي يعلم المسلم الأحكام الشرعية فلا بد أن يسأل عنها، حتى يأخذ الحكم ويعمل به، فيكون بذلك مقلِّداً.
الاجتهـاد:
الاجتهادُ هي اللّغةِ استفراغُ الوُسع في تحقيقِ أمْرٍ منَ الأمورِ مستلزمٍ للكُلفَةِ والمشقّةِ. وأمّا في اصطلاح الفقهاء فهو استفراغُ الوُسع على وجه الخصوص في طَلَبِ الظنِّ بشيءٍ منَ الأحكامِ الشرعيّةِ، وعلى وجْهٍ يحسّ المجتهد من نفسه العجزَ عنِ المزيدِ فيهِ.
والاجتهادُ ثابتٌ بنَصِّ الحديثِ. فقد رُوِيَ عنِ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنّهُ قالَ لمعاذٍ، حينَ أرسَلَهُ والياً إلى اليمنِ: «كيف تقضي؟» قالَ: أقضي بكتاب الله.
قالَ: فإنْ لمْ تجِدْ في كتاب الله.
قال: فبسنّةِ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم).
قال: فإنْ لمْ تجِدْ.
قالَ: أجتهد رأيي. فقالَ: الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم): «الحمدُ الله الذي وَفّقَ رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسولَهُ»[*].
وهذا صريحٌ في إقرارِ الرّسولِ (صلى الله عليه وآله وسلّم) لمعاذٍ على الاجتهادِ. وما وُجِدَ بين المسلمينَ قطّ مَنْ نازَع في الاجتهادِ.
وليسَ منَ الاجتهادِ تطبيقُ الحكمِ على المسائلِ التي تندرِجُ تحتهُ، بلْ هوَ فَهْمٌ للمسائل التي تندرج تحت الحكمِ الشرعيّ فقط، لأنّ الاجتهادَ هو استنباطُ الحكمِ منَ النصِّ: إمّا من منطوقِه، أو مِنْ مفهومِهِ، أو منَ دلالَتِهِ، أوْ منَ العِلَّةِ التي وردتْ في النصِّ، سواء كانَ ذلكَ استنباطَ حكمٍ كليّ منْ دليلٍ كليّ، كاستنباطِ «أنَّ على النّاهِب عقوبةً» وقد جاء هذا الاستنباط منْ جعْلِ الشّارعِ قَطْعَ اليدِ حدّاً للسرِقَةِ، أو كانَ استنباطَ حكم جزئي منْ دليل جزئيّ كاستنباطِ حكمِ الإِجارَةِ منْ قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطّلاَق: 6]. أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «أَعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يجِفّ عَرَقُهُ»[*]، فهو دليلٌ جُزئيّ لحكم جزئي. فهذا هو الاستنباط للحُكْمِ الكليّ منَ الدليل الكليّ، والاستنباطُ للحكمِ الجزئيّ من الدليلِ الجزئيّ.. كلّ ذلكَ يُعْتَبَرُ اجتهاداً لأنّهُ أخْذٌ للحكمِ من الدليلِ، سواءٌ كانَ حكماً عامّاً منْ دليلٍ عامّ، أم حكماً خاصّاً منْ دليلٍ خاصّ.
أمّا تطبيقُ الحُكْمِ على المسائلِ المسْتَجِدَّةِ الداخلةِ في معناهُ والمُدْرَجَةِ تحْتَهُ فلا يُعْتَبَرُ اجتهاداً. فإذا قيلَ: «حرّمَ الله الخمرةَ» كانَ كلّ شيءٍ مندرجٍ تحتَ هذهِ القاعدةِ محرّماً فيدخل فيه كل أنواع الخمور المستَجدَّة ممَّا لم يكنْ موجوداً قبلاً: ومنها الجنّ، والويسكي، والبيرة، والفرموث، وما شابهها. وكذلكَ تحريم الميتة، سواءٌ ماتتْ ميتَةً طبيعيّةً، أمْ ضرِبتْ على رأسِها حتى ماتَتْ، أمْ فُصِلَ رأسُها في المعْمَلِ وَوُضِعَتْ في عُلَبٍ، فبيعُها وأكْلُها محرّمٌ، لأنها لمْ تُذْبَحْ ذَبحاً شرعيّاً.
وليس ذلكَ منْ قبيلِ الاجتهادِ الذي هوَ استنباط الأحكامِ منَ الأدلّة الشرعيةِ، بل من قبيلِ تطبيقِ الأحكامِ على الجزئيّاتِ، أو فهمِ الجزئيّاتِ وتطبيقِ الأحكامِ عليها.
ونصوصُ الشريعةِ الإِسلاميّة تستوجبُ منَ المسلمينَ الاجتهاد لأنّ النصوصَ الشرعيّةَ لمْ تأتِ مُفصّلةً، وإنما جاءَتْ مجمَلَةً تنطبقُ على جميعِ وقائعِ الحياةِ،ويحتاجُ فَهْمُها واستنباطُ حُكْمِ الله تعالى فيها إلى بَذْلِ الجُهْدِ لأخْذِ الحكمِ الشرعيِّ. حتى النصوصُ التي جاءَتْ مُفَصَّلَةً إنما تعرّضتْ للتفصيلاتِ التي هيَ في حقيقتِها عامّة ومجمَلَة. فآياتُ الميراثِ - مثلاً - جاءَتْ مُفَصَّلَةً وتعرّضَتْ لتفصيلاتٍ دقيقةٍ، ومعَ ذلكَ فإنها منْ حيثُ الأحكامُ الجزئيّةُ احتاجَتْ إلى فَهْمٍ واستنباطٍ في كثيرٍ منَ المسائلِ، كمسألةِ الكلالةِ ومسائلِ الحَجْبِ، فإنّ جميعَ المجتهدينَ، يقولون: إنّ الوَلَدَ يحجُبُ الإِخوة سواءٌ كان ذكراً أم أُنثى، لأنّ كلمةَ ولدٍ تعني كلّ ولدٍ ابناً كانَ أو بنتاً. وابن عبّاس يقولُ: إنّ البنتَ لا تحْجُبُ، لأن كلمةَ ولد تعني «الذكَر» فقط، وذلكَ يدلّ على أن النصوصَ، حتى التي تعرّضت للتفصيلاتِ، جاءَتْ مجمَلَةً، يحتاجُ فَهْمُها واستنباطُ الحكمِ منْها إلى اجتهادٍ.
شروط الاجتهاد:
عُرِّفَ الاجتهادُ - كما رأينا - بأنّهُ بَذْلُ الوسعِ في طلبِ الظّنِّ بشيءٍ منَ الأحكامِ الشرعيّةِ على وجْهٍ يحسّ المجتهد من نفسِهِ العجزَ عنِ المزيدِ فيه. أي هو فَهْمُ النصّ الشرعيّ من الكتابِ والسنَّةِ بعدَ بذْلِ أقصى الجُهْدِ في سبيلِ الوصولِ إلى هذا الفَهْمِ، لمعرفة الحكمِ الشرعيّ.
ومعنى ذلكَ أنّهُ لا بد أن تتوفّرَ في استنباطِ الحكمِ الشرعيّ ثلاثةُ أُمورٍ، حتى يكونَ الاستنباطُ باجتهادٍ شرعيّ:
1 - بذلُ كامل الجهد الذي يقدر عليه المجتهد، حتى يحسَّ من نفسه أنه عجز عن أن يزيد شيئاً على ما توصل إليه.
2 - أن يكونَ هذا البذلُ في طلبِ الظنِّ بشيءٍ من الأحكام الشرعيّة.
3 - أن يكونَ طَلَبُ الظّنِّ من النصوصِ الشرعيّةِ.
أما النصوصُ الشرعيّةُ التي يعتمدها الباحث أو المجتهد فهي الكتابُ والسنّةُ وما دلَّ عليه الكتابُ والسنةُ لا غير. وأما ما عداهما من النصوصِ فلا يُعْتَبَرُ منَ النصوصِ الشرعيَّةِ مهما كانتْ منزِلَةُ قائله. ومن هنا كانت شُرُوطُ الاجتهادِ كلّها تدورُ حولَ أمرينِ اثنينِ هما: توفّرُ المعارفِ اللغويّةِ والمعارفِ الشرعيّةِ. وقد كانَ المسلمونَ في فجرِ الإسلامِ وحتى نهايةِ القَرْنِ الأول لا يحتاجونَ إلى قواعدَ معيّنَةٍ لِفَهْمِ النصوصِ الشرعيّةِ،لا منَ الناحيةِ اللّغويّةِ ولا منَ الناحيةِ الشرعيّةِ، نظراً لقربِ عهدِهِمْ برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وصَرْفِ عنايَتِهِمْ في الحياةِ إلى الدينِ، ونظراً لسلامةِ سليقتِهم اللغويّة وبُعْدِهِمْ عنْ فسادِ اللسانِ، ولذلكَ لم تكنْ هنالكَ أيّ شروطٍ معروفةٍ للاجتهادِ.
وكانَ الاجتهادُ أمْراً مألوفاً، فكانَ المجتهدونَ يُعَدّونَ بالآلافِ. وقد كانَ الصحابةُ كافّةً مجتهدينَ. ويكادُ يكونُ أكثرُ الحكّامِ والولاةِ والقضاةِ منَ المجتهدينَ.
ولما فَسَدَ اللسانُ العربيّ، ووُضعَتْ قواعدُ معيّنَةٌ لضبطِهِ، وشُغِلَ الناسُ بالدنيا، وقلّ مَنْ يُفرّغُ أكثرَ وقتهِ للدينِ، وفشا الكذبُ في الأحاديثِ عنْ لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، وُضِعَتْ قواعدُ للنّاسخِ والمنسوخ لأخْذِ الحديثِ أو رَفْضِهِ، ولِفَهمِ كيفيّةِ استنباطِ الحُكْمِ منَ الآيةِ، أو الحديث. وعندئذٍ قلّ عددُ المجتهدينَ، وصارَ المجتهدُ يسيرُ باجتهادهِ على قواعدَ معيّنةٍ، يصلُ منها إلى استنباطاتٍ مُعيّنَةٍ، تخالف قواعدَ غيره. وتكوّنَتْ هذهِ القواعدُ عندهُ، إمّا منْ كثرةِ ممارستِهِ لاستنباطِ الأحكام منَ النصوصِ، وإمّا لاتباع قواعدَ معيّنَة تمّ الاستنباطُ بحسَبِها. فنتَج عنْ ذلكَ أن صارَ المجتهدُ مجتهداً في طريقةٍ معيّنَةٍ لفهْمِ النصوصِ الشرعيّةِ، ومجتهِداً في أخْذِ الحكْمِ الشرعيّ من النصوص الشرعيّةِ. وصارَ بعض المجتهدينَ يقلّدونَ شخصاً في طريقتهِ في الاجتهاد، ولكنهمْ لا يُقلّدونَهُ في الأحكامِ، بلْ يستنبطونها بأنفسِهِمْ على طريقة ذلكَ الشخص. وصارَ بعضُ المسلمين ملمّينَ بشيءٍ منَ المعارفِ الشرعيّة في مسائلَ معيّنَةٍ تعرِضُ لهمْ، لا في جميع المسائلِ. فكانَ بذلكَ ثلاثةُ أنواعٍ منَ المجتهدينَ:
مجتهدٌ مطلق.
ومجتهدُ مذهب.
ومجتهدُ مسألة، أو مجتهدٌ مجتزئ.
فالمجتهِدُ المطلقُ لهُ شروطٌ، أهمّها اثنان:
- أحدهما: معرفةُ الأدلّةِ السمعيّةِ التي تُنتزعُ منها القواعدُ والأحكامُ.
- ثانيهما: معرفةُ وجوهِ دلالةِ اللّفْظَةِ المعْتَدِّ بها في لسانِ العربِ واستعمالِ البلغاءِ.
أمّا الأدلّةِ السمعيّةُ فيرجعُ النّظرُ فيها إلى الكتابِ والسنّةِ والاجتهادِ وإلى القدْرَة على الموازنةِ والجمع بينها، وترجيح الأقوى على ما هو دونَهُ عندَ تعارضِهِما. كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطّلاَق: 2]، وقوله تعالى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المَائدة: 106]. فالآيتانِ وردتا في الشهادةِ: الأولى تنص على أنْ يكونَ الشهودُ من المسلمينَ والثانية تنصّ على أن يكونوا منَ المسلمينَ وغيرهم. فلا بدّ من معرفة الجمع بينهما، أي لا بد منْ معرِفَةِ أنّ الآيةَ الأولى في الشهادةِ جاءت على الإطلاقِ، وأن الآيةَ الثانيةَ في الشهادةِ جاءت لأجل الوصيةِ في السفر. وهاتان الآيتانِ تدلاّنِ على أنّ البينةَ تكونُ بشاهدينِ عدلينِ.
وتؤيّدهما آيةٌ أُخرى وهي قولهُ تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البَقَرَة: 282]. فكيفَ يتفِقُ ذلكَ مع ما ثَبَتَ في الصحيحِ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنّهُ قَبِلَ شهادَةَ امرأةٍ واحدةٍ على الرضاعةِ، وأنّهُ قبلَ شهادَة شاهدِ واحدٍ معَ يمينِ المدعي. كما ورد عن أميرِ المؤمنينَ علي (عليه السلام) أنه قالَ: «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) قضى بشهادةِ شاهدٍ واحدٍ ويمينِ صاحبِ الحقّ» فيبدو من هذا تعارضٌ بين الأدلّةِ؟
هنا يأتي دور المجتهد الذي يتبين له بعد التدقيق أن الآية ذكرت النِّصاب الأكملَ في الشهادةِ. فإذا لم يكتمل هذا النصابُ الأكملُ فليس معنى ذلك أن لا تُقبلَ الشهادةُ ما دونه، لأنّ النصابَ إنما هو للتحمّلِ. أما في الأداءِ والحكم منْ قِبَلِ القاضي فلا يُشْتَرَطُ نصابُ الشهادةِ، بلْ تُشْترطُ البيّنَةُ، وهَيَ كلّ ما يُبيّنُ الحقّ ولو كانَ ذلكَ شهادةَ امرأةٍ واحدةٍ، أو شهادةَ رجلٍ واحدٍ مع يمينِ صاحبِ الحقِّ كما ثبت في السنة النبوية الشريفة، إلاَّ إذا جاءَ النصّ الشرعي الذي يُعيّنُ نصابَ الشهادةِ ويجعله ملزماً،كما في شهادةِ الزِّنا، فحينئذٍ يتقيّدُ بالنصِّ. وبهذا البيانِ ومثلِهِ يذهبُ تزاحُمُ الأدلّةِ.
فالمقدرَةُ على فَهْمِ الأدلّةِ السّمْعيّةِ وعلى الموازنةِ بينها شَرْطٌ أساسيّ. وعليهِ فلا بُدَّ أن يكونَ المجتهدُ المطلقُ عارفاً بمداركِ الأحكامِ الشرعيّةِ وأقسامِها، وطُرُقِ إثباتها، ووجوهِ دلالَتِها على مدلولاتها، واختلافِ مراتبِها، والشروطِ المعتَبَرةِ فيها. وعليهِ أنْ يعرِفَ جهاتِ تَرجيحها عندَ تعارضِها. وهذا يُوجِبُ عليهِ أنْ يكونَ عارفاً بالرّواةِ وطرقِ الجرحِ والتعديلِ، وأن يكون عارفاً بأسبابِ النزولِ والناسخِ والمنسوخِ في النصوصِ.
وأمّا معرفةُ وجوهِ دلالةِ اللّفظِ فمعناها أن يكونَ مُلِماً بعلوم اللغةِ العربيّةِ ليتمكّنَ من معرفةِ معاني الألفاظِ، ووجوهِ بلاغتِها ودلالتِها، حتى يُرجّحَ روايةَ الثّقاتِ وما يقولُهُ أهلُ اللغةِ. فلا يكفي أنْ يعرفَ منَ القاموسِ أو المعجم أنّ القروء مثلاً تدلّ على الطّهْرِ والحيضِ، وأنّ النكاحَ يدلّ على الوطْءِ والعَقْدِ. بلْ لا بدّ من معرفةِ اللغةِ العربيّةِ بشكلٍ عامّ من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وبيانٍ وغيرِ ذلك، معرفةً تمكِّنُهُ من الوقوفِ على وجوهِ دلالةِ اللّفْظِ الواحدِ والجملةِ الواحدة حسب لسانِ العربِ واستعمالِ البلغَاءِ، وتمكّنُه منَ المراجعةِ في كتبِ العربيّةِ وفهم ما يحتاجُ إلى فَهْمِهِ منها.
ولا يعني ذلكَ أنْ يكونَ مجتهداً في كلِّ فرعٍ من فروع اللّغةِ، بل يكفي أن يكونَ عالماً بأُسلوبِ اللّغةِ بحيثُ يميّزُ بينَ دلاَلةِ الألفاظِ والجملِ والأساليبِ، كالمطابَقَةِ والتضمينِ والحقيقةِ والمجازِ والكنايةِ والمشتركِ والمترادفِ، وما شاكلَ ذلكَ. وبالجملةِ فإنّ درجَة الاجتهادِ المطلقِ لا تحصلإُلاَّ لمنِ اتّصفَ بفهمه مقاصدَ الشريعةِ في الكتاب والسنة، لِفَهْمِ الأدلّةِ السمعيّة أولاً، وفهمه اللغة العربية ومدلولات ألفاظها، وجملها وأساليبها ثانياً.
وعليه فليس وجودُ المجتهد المطلق بالأمر العسير بل هو ممكن ومتيسر إذا صحت الهمم.
وأما مجتهد المسألة أو المجتزئ فهو كلُّ من اتصف بمعرفة ما لا بد منه من المعارف الشرعية واللغوية، وهذا ميسور بوفرة إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا، فإن معنى المجتهد، لغةً، هو الذي يجدُّ ويبالغ في طلب الشيء، أيّ شيء. وقد عرفه الفقهاء بأنه: «العالم الذي يعرف أصول الشريعة، ويملك القدرة التامة على استنباط الأحكام الشرعية وردها إلى أصولها».. أي أنه هو الذي يميّز بين آيات الأحكام وغيرها، وبين الصحيح والضعيف من الروايات، وبين ما أجمع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه. فإذا أراد أن يعطيَ حكماً شرعياً، أي أن يجتهد في بيان حكم الحادثة التي يبحث فيها، وكان مستوفياً لمؤهلات النظر ووسائل المعرفة، فإنه يمكنه أن يكشف الغموض الذي يحيط بالحكم، وأن يبرزه بصورة عامة. وهذا التمحيص الدقيق يسمى استنباطاً أي استنباط الحكم الشرعي من الأدلة والقرائن.
أقسام الاجتهاد:
ينقسم الاجتهاد باعتبار مورده إلى أقسام:
1 - أن يجتهدَ المكلَّفُ في مورد النصِّ القطعيِّ ثبوتاً ودلالة. ومعنى قطعيِّ الثبوت أن نعلم بوجوده يقيناً، لوروده في كتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) التي جاءنا بها الخبر المتواتر الذي لا تتطرق إليه الريبة. ومعنى قطعيِّ الدلالة أن يكون واضحاً وضوحاً لا يقبل الشك، ولا يحتمل التأويل.
وقد أجمع المسلمون من الشيعة والسنة، على منع هذا الاجتهاد، وأنه لا يمكن بحال أن يكون محلاً للبحث والتساؤل، لأن الاجتهاد إنما يكون في الظنيات لا في القطعيات، وهذا النوع من الاجتهاد، في حال وجوده، يؤدي إلى تعطيل النصوص، إذ مهما أفتى فيها المجتهد فلن يأتيَ بحكم جديد.
2 - أن يجتهَد في فهم النصِّ الموجودِ في كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه الكريم الثابتةِ بالخبر المتواتر وغيره. وقد أجاز الفقهاءُ هذا الاجتهادَ على شريطة أن يكونَ النصُّ ظنيَّ الدلالة، وأن لا يتجاوزَ التفسيرُ الحدودَ المقررة. مثال ذلك الآية الكريمة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البَقَرَة: 228] فإن الدلالة على القرء ظنية، لأنه ينطبق على الحيضة والطهر. وعلى الفقيه أن يبحثَ عن القرائن التي ترشده إلى أحد المعنيين. فإذا أدَّى به النظر إلى الطهر أو الحيضة عمل به، حتى ولو خالف السلف بكاملهم، وحُرِّم عليه متابعتهم ما دام على يقين من خطأهم.
والخلاصة أنه لا اجتهاد عند الجميع في مقابل النص القطعيِّ: القطعيِّ الثبوت والقطعيِّ الدلالة. وقد امتنع عنه المسلمون جميعاً، لأن الاجتهاد في معرض النص غير جائز، حتى في القوانين الوضعية طبقاً للقاعدة المعروفة «لا اجتهاد في معرض النص». أما الاجتهادُ في تفسير نصٍّ غيرِ قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت، وفيما يعتمد على العمل واليقين، فجائزٌ عند المسلمين جميعاً.
فضل المجتهد:
قال الفقهاء من الشيعة والسنة: إن لله تعالى حكماً معيناً في كل حادثة وقعت، أو تقع، ونصب الدليلَ عليه بالخصوص أو بالعموم. فمن ظفر به، وتفهمه على حقيقته فهو المصيبُ وله أجران: أجرٌ على ما بذل من جهد، وأجرٌ على الإصابة تفضلاً من الله سبحانه. ومن أخطأه أو أخطأ في فهم المراد منه فلا وزر عليه، وله أجرٌ على جهده. ومما استدلوا به على ذلك الحديث المشهور عند السنة والشيعة: «إذا حكم الحاكم فله أجران وإن حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر»[*].
عدالة المجتهد:
لقد عرفنا بأن الاجتهاد هو بذل العالم كل ما في وسعه كي يفهم النص الشرعي من الكتاب والسنة الذي يؤدّي به إلى معرفة الحكم الشرعي. ولا بدَّ أن تتوفر للمجتهد المعارف اللغوية والمعارف الشريعة، أي العلم باللغة العربية معنًى ولفظاً، والعلم بالآيات المتعلقة بالأحكام وروايتها... فإذا أمكن لكل طالب اجتهاد أن يصل إلى هذه الدرجة كان مجتهداً حقاً، وحرّم عليه أن يقلّد غيره. والمجتهد يحرم عليه الرجوع إلى غيره عادلاً كان أم فاسقاً. وإنما العدالة شرطٌ أساسي لتنفيذ حكمه في حق الغير، ولأخذ الفتوى عنه، أي أن المجتهد يجب أن يكون صاحب عدالة، حتى يقلده الناس ويعملوا بما أفتى.
ولو أن إنساناً لم تتوفر فيه شروط العدالة، فإنه، وإن بلغ من العلم كل مبلغ، وإن عرف أحكام الله تعالى على حقيقتها، لا يجوز الرجوع إليه في القضاء والإفتاء، على الرغم من صدقة وإصابته في أقواله، لأن العدالة شرطٌ تعبُّدي غير منوط بإصابة الحكم على الواقع وموافقته.
قال الإمام الصادق (عليه السلام): «أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه».
علوم الاجتهاد:
يقصد بعلوم الاجتهاد المعارفُ التي ينبني عليها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، ويُتوصل بها إلى إعطاء الحكم الشرعيّ، ولا يمكن أن يحصل الاجتهاد بدونها، تماماً كما لا يمكن الاختصاص بأي علم أو فن إلا بعد حيازة شهادة معينة لهذا الاختصاص.
من هذه المعارف علومُ اللغة العربية ألفاظاً ومعانيَ، لأن الشريعة أنزلها الله العلي العظيم باللّغة العربية، والمطلوب من المجتهد أن يبلغ في معرفتها درجة يفهم معها كلام الفصحاء، كما يفهمه العربي الأصيل بفطرته.
ومنها أيضاً العلمُ بآيات الأحكام الشرعية وروايتها، وأحوال الرواة من الجرح والتعديل، وموارد إجماعات الفقهاء..
ولا بد مع هذا كلّه من ذوق معتدل سليم، وذهن حاذق متحرك، وعقل فاحص ناقد، وملكة قوية يقتدر بها على إقامة الدليل على الحكم والدفاع عنه بالبرهان، ثم تطبيق الفرع على مورد الأصل. قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «علينا أن نلقيَ إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا». وقال (عليه السلام): «لا يكون الفقيهُ فقيهاً حتى تلحنَ له، فيعرف ما تلحن له»، والمراد باللَّحَن هنا الفطنة، أي تقولُ له قولاً يفهمه هو ويخفى على غيره.
الأدلـةُ الشرعيَّة:
الدليلُ، لغةً، بمعنى الدّالِّ. وقدْ يُطْلَقُ الدليلُ على ما فيهِ دلالَةٌ وإرشادٌ وهذا هو المسمّى دليلاً في تعريفِ الفقَهاءِ. وقد عرَّفَهُ علماءُ الأصولِ بأنه: «الذي يمكنُ أن يُتَوَصَّلَ بصحيح النَّظَرِ فيهِ إلى العلْمِ بمطلوبٍ خبريٍّ». وبعبارةٍ أُخرى هو الذي يُتَّخَذُ حجَّةً على أنَّ المبحوثَ عنهُ حُكمٌ شرعيّ. وكلّ دليلٍ شرعي إمّا أنْ يدلّ على الحُكْم دَلالةً قطعيّةً أو ظنيّةً. فالقطعيّةُ كالقرآنِ والحديثِ المتواتر، والظنيّة كحديث الآحاد. وما كان قطعيَّ الدلالةِ أيضاً فلا إشكالَ في اعتبارِه، وإنْ دلّ على الحُكْمِ دلالَةً ظنيّةً. فإنْ كان أصله قطعيّاً وهو الكتاب والحديثُ المتواترُ فهو مُعْتَبَرٌ أيضاً، وإن كانَ أصلُهُ ظنيّاً كخبر الآحاد فحينئذٍ يجبُ التثبتُ منهُ.
والأدلّةُ الشرعيّةُ نوعانِ: أحدهما ما يرجعُ إلى النّقْلِ المحْضِ، وهو الذي يرجعُ إلى النصِّ المحضِ،أي إلى الألفاظ وما يدلّ عليهِ منطوقُها ومفهومُها. والنّقْلُ المحْضُ هو الكتابُ والسنّةُ والإِجماعُ، وهو يحتاجُ إلى الفهمِ والنظرِ. والثاني ما يرجعُ إلى الرأيِ المحْضِ وهو الذي يرجعُ إلى معقولِ النصِّ أي إلى العلّة الشرعيَّةِ التي دلّ عليها النصّ الشرعيّ والدليلُ الشرعيّ. ولكي يعتبَر حجّةً فلا بدَّ أنْ يقومَ الدليلُ القطعيّ على حجيّته من الكتاب والسنة.
أما الكتاب فهو القرآنُ الكريمُ كما نُقِلَ نقْلاً متواتراً. وأمّا نَقْل الآحاد فليسَ منَ القرآنِ. والذي يجبُ لَفْتُ النّظَرِ إليهِ أنّ القرآنَ قدْ نُقِلَ بالمشاهَدَة عن الرّسولِ (صلى الله عليه وآله وسلّم)، عنِ الوحيِ حينَ نزولهِ بهِ، وسُجّلَ كتابةً إلى جانبِ حِفْظِهِ.
فالصحابةُ رضوانُ الله تعالى عليهم لم يرْوُوا القرآنَ الكريمَ روايةً عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)، وإنما نَقلوهُ نقلاً. أي نَقَلُوا ما نزلَ بهِ الوحيُ عينُهُ وما أمَرَ الرّسولُ بكتابتهِ، بخلافِ الحديثِ فإنّهُ رُويَ عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) روايةً ولم يُسَجّلْ حينَ قولهِ أو روايتهِ، وإنما جرى تدوينُهُ وتسجيلُهُ في عَهْدِ تابعي التابعينَ.
إذاً فالقرآنُ قد دُوِّنَ وسُجِّلَ حينَ نزولِ الوحْي بهِ، ونَقَلَ الصَّحابَةُ ما نَزَلَ بهِ الوحْيُ نفسُهُ، ولهذا يُقالُ: إنّ الصحابةَ قد نقلوا لنا القرآن الكريمَ نَقْلاً.
يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن لبشرٍ أن يقول عن أيِّ قولٍ أو لفظٍ: هذا من القرآن وهو ليس من القرآن، لأن الإعجازَ القرآنيَّ إعجازٌ دائمٌ ونهائيٌّ إلى أن يرثَ الله تعالى الأرض ومن عليها. فلا تحريفَ لكلام الله عزَّ وجلَّ وهو القائل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *} [الحِجر: 9].
والقرآنُ الكريمُ مُشْتَمِلٌ على أياتٍ مُحْكَمَاتٍ وأُخَرَ متشابهات. قالَ الله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عِمرَان: 7].
أمّا المحكمُ فهو ما ظهرَ معناهُ وانكشفَ كشفاً يرفعُ الاحتمالَ كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البَقَرَة: 275]، وأمّا المتشابهُ فهو المقابلُ للمُحْكَم، وهو ما يحتمِلُ أكثرَ من معنى، إمّا بجهةِ التساوي أو بغير جهةِ التساوي.
فأما المعنى بجهة التساوي فقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البَقَرَة: 228]، فإن لفظَ «القروء» يمكنُ أن يكونَ المرادُ بهِ الحيض أو الطهرَ.
وقولهُ تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البَقَرَة: 237] فإنّ الذي بيدهِ عقدةُ النكاح يمكنُ أن يكون المرادُ به الزوجُ أو الوليّ.
وقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النِّسَاء: 43] لترددهِ بينِ اللمْسِ باليدِ والوطءِ.
وأما المعنى على غير جهة التساوي فقولُه تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرَّحمن: 27]، {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} [الحِجر: 29]، {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا} [يس: 71]، {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عِمرَان: 54]، {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزُّمَر: 67]، وما إليها من الآيات التي تحتمل عدة معانٍ حَسَبَ فَهْمِ اللغة العربيّةِ من حيثُ أساليبُ العربِ، وحَسَبَ المعاني الشرعيَّةِ، فهَذا كلّهُ متشابهٌ.. وإنما سُمّيَ متشابهاً لاشتباهِ معناهُ على السامع، وليس لأنه لا يفهم معناه، إذ لا يوجدُ في القرآن شيءٌ لا يُفْهَمُ معناه، لأنّ اشتمالَ القرآنِ على شيءٍ غير مفهوم يُخْرجُهُ عن كونهِ بياناً للناس، وهو خلافُ قوله تعالى: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ} [آل عِمرَان: 138]. وأما السؤال عن حروف المعجم في أوائل السوَر، فإنّ لها معنى، لأنها أسماء للسور ومعرِّفةٌ لها، بل هي الإِعجاز القرآني لإثبات عجز الثقلين عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فلا تدخل في باب فهم هذا الكتاب المبين أو عدم فهمه.
- وأما السنة فهي كما يقال في اللغة: سَنَّ الله تعالى سُنَّةً: أي بيّن طريقاً قويماً. كما في قوله عزَّ وجلَّ: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} [الأحزَاب: 38] والسنة هي: السيرةُ حسنةً كانت أم قبيحة.
ويقالُ لكلِّ من ابتدأ أمراً عملَ به قومٌ بعدَهُ: هو الذي سنَّهُ.
فتكون السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة. وأما إذا أُريدَ منها الاصطلاحُ الشرعيُّ فإنما يرادُ بها أمران:
الأول: وبه تُطْلَقُ السنة على ما قابلَ الفرضَ، فيكون معناها: الناقلة المنقولة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) كالنوافل في الصلوات.
والثاني: وبه تطلقُ السنة على ما قابلَ القرآن الكريم، فيكونُ المراد بها: ما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير.
والسنة إما أن تكون مُبيِّنةً للقرآن، وإما أن تكونَ تشريعاً جديداً يدل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النِّسَاء: 59]. والرَّدُّ إلى الله تعالى يكونُ بالرد إلى القرآن الكريم. وأما الرد إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) فيكونُ في حياته بالرجوع إليه، وبعد مماته إلى ما صدر عنه، أي إلى سنته.
والردُّ إلى السنة يشملُ مطلقَ السنة، سواء أَكانت قوليةً أم فعلية، وسواء أكانت تبييناً أم تشريعاً جديداً. ولذا يجبُ الأخذ بالقرآن وبالسنة معاً. ولا يجوز مطلقاً للمسلم أن يقتصرَ على الأخذ بالقرآن، وتركُ الأخذ بالسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحَشر: 7]. والرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) أتى بالكتاب والسنة فلا يجوزُ لنا أن نأخذَ شيئاً مما أتى به، ونتخلى عن شيء. كما أنه لا يجوزُ لنا أن نقولَ: نعملُ بالقرآن لأنه لا خلافَ عليه بين المسلمين، ونتركُ السنةَ لأنه يوجدُ خلافٌ كبيرٌ حولها. فهذا القولُ وأمثاله لا يجوز الأخذُ به لأنه تركٌ لما ألزمنا الله تعالى به.
وقد حَذَّرنا الرسولُ الكريم من ذلك بقوله: «يوشكُ رجلٌ منكم متكئاً على أريكَته يُحَدِّثُ بحديثٍ عني فيقولُ: بيننا وبينكم كتابُ الله فما وجدناه من حلال استحللناه وما وجدناه من حرامٍ حرمناه. ألا وإن ما حرَّمَ رسول الله مثلُ الذي حرَّم الله»[*].
والسنة بالنسبة للقرآن مبيِّنةٌ له لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النّحل: 44]، فتكون بذلك مُفَصِّلةً لمُجمله، مُخَصِّصةً لعمومه، مُقَيِّدةً لمطلقه، أو مُلحقةً فرعاً بأصل، أو جاءت بتشريعاتٍ هي وحيٌ من الله العزيز الحكيم. وأحببنا أن نأتي على ذكرها هنا ملخصاً، بعدما أتينا من قبل - أي في كتاب المقدمة لهذه الموسوعة في الفقه الميسر - على ذكرها مفصلاً، كي يتمكن القارئ من فهمها، ومن ثمَّ ينتقل إلى إدراكها فاستيعابها.
وهذا شرحٌ لما جاءت به السنّة:
أولاً: تفصيلُ مجمل القرآن.
والمجملُ هو اللفظُ الذي لم تتضحْ دلالته. فقد ورد في القرآن الكريم وجوبُ الصلاة والزكاة والحج غير أنه جاء بشكلٍ مجمل دون بيانٍ لكيفياتِ كلٍّ منها. فجاءت السنةُ فبيَّنت أوقاتَ الصلاة وعددَ ركعاتها وكلَّ ما يتعلقُ بها. وذكرت السنةُ في أي حال تُدفعُ الزكاةُ والأشياءَ التي تجبُ فيها والمقدارَ الذي تفرض عليه . كما أنها بينت مناسكَ الحج. وقولُ الرسول الكريم في الحج واضحٌ وصريحٌ: «خذوا عني مناسككم»[*]. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجهاد، حيث بيّنت السنةُ كيفيةَ السير فيه وما يسبقهُ ويتبعه وما يترتبُ عليه من علاقات، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية.
ثانياً: تخصيصُ عام القرآن الكريم:
والعام: هو اللفظُ الذي يستغرقُ جميعَ ما يصلحُ له، فالألفاظ التالية هي مثلٌ على ذلك: الرجال، النساء، الأولاد، المؤمنون، المسلمون، المشركون إلى آخره. وقد ورد في القرآن الكريم ألفاظٌ عامةٌ وجاءت السنة فخصصتها. فقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النِّسَاء: 11]، هو عام في توريث الأبناء من الآباء، ولكنَّ السنة خصصت هذا العامَّ وجعلته لغير المرتدين عن الدين الإسلامي، ولغير القاتلين آباءهم لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «مفارق الجماعة لا يرث، قاتل أبيه لا يرث»[*].
وقول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النُّور: 2] فهو عام شامل لكل من يزني، محصناً أو غير محصن. فجاءت السنة وخصصت ذلك بغير المحصن، وأوجبت رجم المحصن.
ثالثاً: تقييدُ مطلق الكتاب:
والمطلق: هو اللفظُ الدالُّ على مدلولٍ شائع في جنسه. فقد وردَ في القرآن الكريم آياتٌ مطلقةٌ، وجاءت السنة وقيدت هذا المطلقَ بقيدٍ معينٍ مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المَائدة: 38]. فالعقوبة هنا مطلقة في كل سرقة، لكنَّ السنة قيدت مقدار السرقة بربع دينار ذهباً فصاعداً، وقيدت قطع اليد من مكان معين.
رابعاً: إلحاق فرع من فروع الأحكام ورد في السنة بأصل موجود له في القرآن.
فقد ورد في القرآن الكريم تحريمُ الجمع بين الأختين، قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النِّسَاء: 23] ولم يذكر القرآن الكريم حرمة جمع نكاح المرأة مع عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها أو ابنة أختها. فجاءت السنة وبينت ذلك بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها. فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»[*]، فألْحَقَ ذلك كله بتحريم الجمع بين الأختين.
وكذلك في تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة قال تعالى: {وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النِّسَاء: 23]. فجاءت السنة وألحقت بهذا الأصل سائرَ القراباتِ من الرضاعة اللاتي يحرمن من النسب، كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت الخ، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم): «إن الله تبارك وتعالى حَرّمَ من الرضاعِ ما حرَّم من النسب»[*].
خامساً: السنةُ جاءت بتشريعاتٍ جديدةٍ هي وحيٌ من الله العزيز الحكيم، وتبيانٌ لأوضاع معينة في حياة الناس، مثل جعل مرافق الجماعة والنفط ومعادن الذهب والحديد والفضة والنحاس، وغيرها من المعادن، والأنهار والبحار والمراعي والأحراش من الملكية العامة. وذلك لقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «الناس شركاءُ في ثلاث: الماءِ والكلأ والنار»[*] وقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «مِنىً مَناخُ من سبق»[*].
ومن ذلك أيضاً استردادُ الأرض ممن يُعَطِّلُهَا ثلاث سنوات متوالية فقد جاء في الأثر: «ليس لمحتجرٍ حقٌّ بعد ثلاث سنين».
وبذلك تكون السنّةُ دليلاً شرعياً كالقرآنِ، وهيَ وحْيٌ منَ الله تعالى. والاقْتصارُ على القرآنِ وتَرْكُ السنّة كُفْرٌ صراحٌ، وهو رأيُ الخَارجين على الإسلامِ.
أما أنَّ السنّةَ وحيٌ منَ الله تعالى فذلك واضحٌ في القرآن الكريم الذي يبيّن أنه عزَّ وجلَّ أوصى رسولَهُ (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يقول للناس: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعَام: 50]. كذلك فإنه سبحانه وتعالى يبين للناس كافة أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) لا يقول شيئاً من عنده، فيقولُ عزّ من قائل: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [النّجْم: 3-4].
كما أن السنَّةَ واجبةُ الاتباع كالقرآن الكريم. وهذا الأمر صريحٌ في القرآن أيضاً. قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحَشر: 7]. ومنَ المعروفِ أنّ السنَّةَ هيَ كلامُ الرسولِ (صلى الله عليه وآله وسلّم) وفعالهُ وسكوتهُ، فتكون واجبةَ الاتباعِ كالقرآنِ الكريم.
غيرَ أنّه لا بدّ أنْ يثبُتَ أنّ الرسولَ (صلى الله عليه وآله وسلّم) هو الذي قالَ هذا الكلامَ، أو فَعَلَ هذا الفعلَ، أو سكتَ عن هذا الأمر أو عن هذا الفعْل. وإذا ثبتتِ السنّةُ صَحّ الاستدلالُ بها على الأحكام الشرعيّةِ وعلى العقائدِ، وكانتْ حجّةً على أنّ هذا الثابتَ بالسنّةِ حكمٌ شرعيّ أو عقيدةٌ من العقائد.
إلاَّ أنّ ثبوتَ السنّةِ، إمّا أنْ يكونَ ثبوتاً قطعيّاً كأن يرويها جَمْعٌ من تابعي التابعين عنْ جمعٍ منَ التابعينَ عنْ جمْعٍ منَ الصحابةِ عنِ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم)، بشرْطِ أنْ يكونَ كلّ جَمْع يتكوّنُ من عددٍ كافٍ، وبحيثُ يُؤمَنْ عدمْ تواطئِهمْ على الكذبِ. وهذهِ هيَ السنّةُ المتواتِرَةُ أو الخبرُ المتواترُ.
وإمّا أنْ يكونَ ثبوت السنة ثبوتاً ظنيّاً، كأن يرويه واحدٌ أو آحادٌ متفرِّقون، من تابعي التابعينَ، عن واحدٍ أو آحادٍ من التابعينَ، عن واحدٍ أو آحَادٍ منَ الصحابةِ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم). وهذا هو حديثُ الآحادِ أو خبرُ الآحادِ.
ومنْ هنا كانت السنّة من حيثُ الاستدلالُ قسمينِ اثنينِ هما: الخبرُ المتواتر وخبرُ الآحادِ.
أمّا الخبرُ المشهور، وهو الذي يُروى بطريقِ الآحاد عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم)، ثمّ يشتهِرُ في عصرِ التّابعين أو تابعي التابعينَ، فإنّهُ من خبرِ الآحاد، وليسَ قسماً ثالثاً، فالسنّةُ قد وردت إما بالتواتر، وإمّا بخبر الآحاد، ولا ثالثَ لهما.
وخبر الآحادِ إذا كانَ صحيحاً أو حسناً يُعْتَبَرُ حُجّةً في الأحكامِ الشرعيّةِ كلّها، ويجبُ العمَلُ بهِ، سواءٌ كانتْ أحكامَ عباداتٍ أم معاملاتٍ أم عقوباتٍ. والاستدلالُ بِه هوَ الحق، فإنّ الاحتجاجَ بخبرِ الآحادِ في الأحاديث في إثباتِ الأحكامِ الشرعيّةِ هو الثابتُ. والدليلُ على ذلكَ أنّ الشرعَ اعتبرَ الشهادةَ في إثباتِ الدعوى، خبرَ آحادٍ. وعندئذٍ يمكنُ أنْ يُقاسَ قبولُ الروايةِ وقبولُ الآحادِ على قبولِ الشهادةِ، لأنّه ثبتَ بنصِّ القرآنِ الكريمِ أنّهُ يُقْضَى بشهادةِ شاهدينِ رجلينِ أو رجل وامرأتينِ في الأموال، وبشهادةِ أربعةٍ من الرّجالِ في الزِّنا وبشهادةِ رجلين في الحدودِ والقصاص.
وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بشهادَة شاهدٍ واحد ويمين صاحب الحقِّ، وقبلَ شهادةَ امرأةٍ واحدةٍ في الرضاعِ، وهذا كلّهُ خبر آحادٍ.
والقضاءُ إلزامٌ بترجيحِ جانبِ الصّدقِ على جانبِ الكذبِ، ما دامتِ الشّبهاتُ التي تجعَلُ الخبرَ مظنّةَ الكذبِ قد اتبعتْ وغيرَ ثابتةٍ. وهذا الإلزامُ ليسَ إلاَّ عملاً بخبرِ الآحادِ.
والثابتُ عن الصحابةِ فيما اشتهرَ بينهُمْ واستفاضَ عنهُمْ، أنّهُمْ كانوا يأخذونَ بخبر الآحادِ إذا وثقوا بالرّاوي. وعلى ذلكَ يكونُ خبرُ الواحدِ حجَّة في الأحكام الشرعيّةِ، ولكنه ليس حجةً في العقائد، لأن العقائد يجب أن تكون يقينية وليست ظنية. ولذا لا يصح أن يكون الخبر دليلاً على العقائد إلا إذا كان متواتراً.
تلك هي الأصول والمعاني والمعارف التي يجب أن يتقنها من أراد الاجتهاد، واستوفى في نفسه شروط المجتهد على ما أوضحنا، وليس ذلك صعبَ المنال إذا صدقت النية، وصحَّ العزم.
الطريقة العملية للاجتهاد:
أما بخصوص الطريقة العملية للاجتهاد، أو العملية الاجتهادية التطبيقية، فإنها تتطلب ما يلي:
1 - أن يفهمَ المجتهدُ، قبل أيّ شيء، واقعَ الشيء أو المسألة التي يريد أن يستنبط لها حكماً شرعياً، فهماً دقيقاً، بحيث لا يعتريه شك بعده بصوابية فهمه.
2 - أن يفهمَ نصّ الدليل والقرائن التي تحيط به، أو التي لها علاقة بالشيء أو المسألة، فهماً عميقاً، ودقيقاً وسليماً أيضاً.
3 - أن يربطَ بين الواقع والدليل ربطاً محكماً.
4 - أن يعطيَ الحكم بناء على غلبة ظنه بأنه حكم الله تعالى في هذا الشيء، أو في هذه المسألة.
فإذا عرف من أراد الاجتهاد كلَّ تلك المعاني والأصول، وكانت له ملكةُ الفهم العميق، والقدرةُ على الربط المحكم، مع ما يملك من قدرة وبصيرةٍ على إعطاء الحكم الصحيح وفقاً للكتاب والسنة.. يمكننا أن نقولَ عنه إنه بلغ درجة الاجتهاد، وصار من المجتهدين.
ومن أجل تطبيق كل ما تقدم من أفكار حول مفاهيم الاجتهاد والأدلة الشرعية فقد اخترنا - كما قلنا من قبل - بعض المواضيع الهامة للتدليل على كيفية الاجتهاد بطريقة عملية. وهي محاولة نرجو الله الكريم أن تكون موفقة، وتدل - بعونه تعالى - أصحاب النوايا الصادقة، والعزم الثابت على منهجية العمل الاجتهادي التَّطبيقي.
أما تلك المواضيع التي آثرنا معالجتها في هذا السياق فهي تلك التي تشغل بال المسلمين، والشباب منهم خاصة، وأبرزها في رأينا، ما يتعلق بالصورة والتصوير، وصناعة الأفلام السينمائية، والأعمال التلفزيونية واللوحات والمعارض، وما يتأثرون به من موسيقى وغناء، أو ما يمارسونه من لعب وتسلية وترفيه، وكذلك حلق اللحية عند الرجل، أو وضع الحجاب عند المرأة، وأخيراً ما يشاهدون من شعوذات السحر، وما يطلبون من الإقبال على التنجيم من معرفة المستقبل عن طريق الأبراج.
فالمسلمون يرون أن الحياة كلها تعجُّ اليوم بتلك الأشياء وهم يعرفون أن السلف الصالح كانت له آراء فيها تدل إما على الحرمة أو الكراهية. ومن هنا حيرة الشباب المسلم المؤمن الذي يقع فريسةً بين واقعٍ يواجهه أينما ذهب، وحيثما وجد، وبين تمسكه بدينه وحرصه على ألاَّ يقع في المحرمات أو المكروهات.. فهم مثلاً يخشون من حلق اللحية، ويحرجون في أوساطهم من النظر إلى التلفزيون أو سماع الأغاني، أو يرهبون اقتناء لوحة عليها صورة إنسان أو حيوان. فكيف يفعلون إزاء كل ذلك، وهم لا يقدرون على الهرب من حياة العصر؟!
من هنا كان على العلماء والفقهاء أن يهتموا بحياة أبناء الأمة، وألاَّ يتركوهم عرضةً للخوف والتردد والحيرة. ومن هنا كان اختيارنا لتلك المواضيع لما رأينا فيها من أهمية بالغة في مسيرة حياتنا المملوءة بالمشاكل والإشكالات والمستجدات، حتى نصلَ بالشباب إلى ما يهدئُ خواطرهم ويُصلحُ بالهم...
وإنَّ أوَّل ما يجب معرفته بهذا الخصوص، وعدم نسيانه في أي لحظة من اللحظات، هو أن كل ما في هذا الوجود لا يخرج عن كونه من خلق الله العزيز الحكيم. فما يراه الإنسان في محيطه، أو في البلدان التي يسافر إليها، أو ما قد يقرأ أو يسمع عنه من أشياء لا يراها بالعين المجردة.. كل ذلك من صنع الله الخالق العظيم. وهو - سبحانه - الذي وهب الإنسان الملكاتِ والحواسَّ ليعرف آياته ومخلوقاته إن في واقعها المحسوس، وإن من خلال البحث والاكتشاف..
ولعلَّ ما قد يتوصل إليه الإنسان في مقبل الأيام هو أهمُّ، وأخطرُ، وأكثرُ بكثير، مما حققه حتى الآن في مجالات العلوم والمعارف على اختلافها.. فإذا كان الأمر كذلك، فما هو موقف المسلم إزاء تلك المواضيع التي ذكرنا بأنها ستكون مدار أبحاثنا في الطريقة العملية للاجتهاد؟ وأولها موضوع: التصوير والرسم.
التصويـر والرسـم
التصوير هو جعل الشيء على هيئة معينة.
والصورة هي بيِّنة مقوَّمة على هيئة ظاهرة. وهي ما ينقش به الأعيان، ويُتميز بها عن غيرها. والرسم هو تمثيل الشيء على ما يقابل الحقيقة، وهو يطلق على تمثيل الأشياء أو الأشخاص أو المناظر الطبيعية بقلم رصاص أو بريشة المصور. والرسام هو النقاش. مما يعني أن هنالك دائماً واقعاً محسوساً، فتأتي عملية الرسم لتنسخَهُ على نفس الحالة الموجود فيها، ومن ثَمَّ لتزخرفَهُ وتُلوِّنَهُ شريطة أَلاَّ تغير من معالمه الأساسية شيئاً. وهذا يدل على أن الإنسان في كل هذه العملية، لم يبتدع شيئاً جديداً من عنده، أي لم يوجد شيئاً لم يكن موجوداً في الأصل. بل اقتصر عمله على نقل هذا الشيء مع التفنن والإتقان في نقله حتى لَيُحِسَّ الرائي أن هذه هي هيئته التامة، وذلك لانطباقها على حقيقة واقع الشيء الذي نقله أو رسمه. وهنا يكمن السرُّ في عظمة الخالق الذي يخلق الأشياء ومن ثم يصورها وينفخ فيها الحياة. وهو ما يعجز عنه الإنسان الذي يبقى عمله مقصوراً على النقل دون الخلق، لأن ميزة الخلق هي للعلي القدير وحده سبحانه وتعالى.
ولقد كانت الصورة والتصوير مدار بحث عند الفقهاء المسلمين. وقد استندوا في أبحاثهم إلى بعض الأحاديث لإعطاء آرائهم حول هذا الأمر.. وعلى ذلك فقد كان هنالك شبهُ إجماعٍ على أن الأحاديث قد وردت صريحة وصحيحة في النهي عن صناعة التماثيل. بل وقال الفقهاء بعدم جواز تصوير كل ما فيه روح من الإنسان والحيوان والطير. أما ما لا روح فيه كالجوامد، وقد عدوا منها الأشجار والنبات والبحار والأنهار، فقد أجازوا تصويره. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخَ فيها الروحَ وليس بنافخ»[*]. وكان هذا الحديثُ السندَ الأساسيَّ الذي بنى عليه الفقهاء آراءهم، والتي يمكن إيجازها وفقاً لما يلي:
- قال الشيعة الأمامية: إنه وردت عن أهل البيت (عليهم السلام) أحاديثُ صريحة تدل على النهي عن صنعِ التماثيل وعن التصوير. ومن ذلك ما ذكره الإمام جعفر الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن التصوير وذلك بقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ»[*].
وروى محمد بن مروان أنه سمع الإمام الصادق (عليه السلام) يقول بأن ثلاثة يعذبون يوم القيامة، أذكر منهم قوله (عليه السلام): «من صور صورة من الحيوان يُعذَّبُ حتى ينفخَ فيها وليس بنافخ»[*].
وقال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام): إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ. إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير»[*]. وقد روي أن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) كان يكره للرجل أن يصلِّيَ وعليه ثوب صورت فيه تماثيل[*]. كما سأل سائلٌ أباه محمداً الباقر (عليه السلام) قائلاً: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ فقال (عليه السلام): «لا، اطرحْ عليها ثوباً»[*].
- أما الأئمة الأربعة[*] فقد رأوا أن الصورة إذا صورت لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتُعْبد من دون الله تعالى. أو للتقرب إليه عزَّ وجلَّّ بواسطتها، فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء. أما إذا كانت لغرض صحيح، كالتعلم والتعليم، فإنها تكون مباحة، ولا إثم فيها. ولذلك فقد استثنى بعض الفقهاء ألعاب الدمى: كالعرائس وأجازوا صناعتها وبيعها واللعبَ بها من الصغار، وذلك لما ورد عن السيدة عائشة أنها قالت: كنت ألعب بالبنات (الدمى) فربما دخل عليَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وعندي الجواري (جمع جارية وهي الشابة الصغيرة) فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن»[*].
وعن السيدة عائشة أيضاً: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قدم من غزوة تبوك (وقيل خيبر) وفي سهوتها (الرف) ستر، فهبت الريح فكشفته عن بناتٍ هي لُعبٌ لها، فسألها (صلى الله عليه وآله وسلّم): «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي. ورأى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) بينها فرساً له جناحان، فقال (صلى الله عليه وآله وسلّم): «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس. قال (صلى الله عليه وآله وسلّم): «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان. قال (صلى الله عليه وآله وسلّم): «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) حتى بدت نواجذه[*].
وقد أجاز المالكية الصورةَ بدون ظل، فقالوا: إذا كانت الصورةُ مجسدةً، ولكن لا ظلَّ لها بأن بنيت على الحائط ولم يظهر منها ظلها، فإنها لا تحرم[*].
وكذلك أجاز الفقهاء، من مختلف المذاهب، الصورةَ إذا كانت مرسومةً على ثوبٍ مفروش، أو بساطٍ أو مخدة، لأنها في هذه الحالة تكون ممتهنة، وبعيدةَ الشبه بالأصنام.
مما تقدم يتبين لنا: أن التماثيل على أشكالها محرَّمة. والسبب في تحريمها أنها كانت تُستعملُ أصناماً يتعبدها المشركون ويتقربون بعبادتها إلى الله تعالى، بحيث جعلوها أنداداً لربِّ العزَّة والجلال. فنزل القرآن ليقضي على الشرك في جميع أشكاله. وقد ذمَّ، بل حرّم، تلك الأصنامَ التي جعلوها شركاء لله - عزَّ وجلَّ - افتراءً وكذباً..
والآيات القرآنية التي تحرِّم التماثيل وتذمُّ الأصنام لا تكاد تخلو منها سورة إلا في القليل النادر. ويكفي ما يقصُّ كتابُ الله تعالى عن إبراهيم (عليه السلام) وحكاية التماثيل التي يصنعها قومه ليتّجروا بها، أو ليعبدوها، {إِذْ قَالَ لأَِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ *} [الأنبيَاء: 52]، {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} [الأنبيَاء: 58]..
أما السيرة النبوية الشريفة فمشهور فيها أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) عندما فتح مكةَ المكرمةَ كان أولَ ما فعله تحطيمَ الأصنام في الكعبة الشريفة وما حولها، وإزالَة جميع الصور والتماثيل من داخل البيت الحرام، ومن حوله، ومن ثَمَّ في كلِّ مكانٍ من أرض الجزيرة، ليمحوَ معالم الشرك من أمام الأعين، ويغرس عقيدة التوحيد في نفوس المؤمنين، وفي أرجاء دنيا الناس أجمعين..
وهذا ما أُنزلَ لأجله الدينُ الإسلاميّ، أي القضاء على الوثنية والشرك ومحو آثارهما بشتى الأشكال والصور. فكل ما يدني من الشرك أو يثير ذكراه يكون محرَّماً، سواء أكان تصويراً أم غيره.
ولذلك يكون من الصور ما هو مباح وجائز، ومنها ما هو محظور وحرام. فالصور المرسومة باليد على شكل لوحاتٍ فنيةٍ أو غيرِ فنية، ملونةٍ أو غيرِ ملونةٍ، والصورُ الفوتوغرافيةُ التي تؤخذ لنا بواسطة الآلات أو التي ترسمُ باليد، والصُور المنشورةُ في المجلات والجرائد، والمرئيةُ في السينما والتلفزيون، كلُّها جائزةٌ ما دامت تحافظُ على الأصل، وتكون ناسخةً له، وبعيدةً عن كل ما يحطُّ من كرامتنا. أما تلك التي تُظهرُ الخلاعةَ والتبذلَ، وخاصةً تلك التي تظهر العريَ وتحرّضُ على الفحشاء، وكلِّ أنواع المنكر، فهذه محرَّمةٌ ولا ريب، على أي شكل رُسمت، وعلى أي شكل ظهرت، لأنها تخالف الشرعَ الإسلاميَّ لما تنطوي عليه من السوء ولما تدفع إليه من الإثم..
ومثلها أيضاً في التحريم أيَّةُ صورةٍ تخرجُ عن مألوف الموجود وتُعتبرُ كأنها نوعٌ من خلق جديد، لأن الخلق معناه أن يوجد الله العزيز الحكيم شيئاً لم يكن موجوداً من قبل، ثم يصوره على الصورة التي يشاؤها له، وذلك لقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [الأعرَاف: 11]، وهذا محرَّم على الإنسان أن يفعله، وهو ما قصده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في حديث ابن عباس، وفي روايات أهل البيت. وحُرمته أن الخلقَ صنعُ الله العزيز الحكيم، لأنه وحدَهُ الخالق، البارئ المصوّر، أي أنه تبارك وتعالى هو الذي يخلق الخلق ويجعل فيه الحياة، بعد أن يعطيَه الصورةَ التي شاء أن يصوره عليها. وسواء كان هذا الخلق من الإنسان أم من الحيوان أم الطير فلا يجوز للإنسان أن يبتدع صورةً وكأنها خلق جديد لأنه ملزم أن يمنحها الروح وليس هو بقادر على ذلك. فكان ابتداعه هنا حراماً، لأنه لا يجوز لمخلوق أن يتطاول على صفةٍ هي للخالق عزَّ وجلَّ.. وهذا ما يثبته القرآن الكريم في خلق آدم (عليه السلام)، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ *} [الحِجر: 28-29]..إلاَّ إذا أذن الخالق العظيم لنبيٍّ من أنبيائه أن يصنع خلقاً هو في الأصل من خلق الله تعالى، وذلك كما في مخاطبته عيسى ابن مريم (عليه السلام) في قوله عزَّ وجلَّ: {تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي} [المَائدة: 110].
فالآية الأولى واضحة الدلالة على أنه تبارك وتعالى خلق آدم (عليه السلام): «إني خالق بشراً» ثم منحه الحياة بالنفخة من روحه. بينما الآية الثانية لا تشير إلى أي خلق جديد، بل إلى صناعةٍ على هيئة طيرٍ مخلوق سابقاً، ولكنّ الإذن الإلهي أمدَّه بالروح على يد عيسى بن مريم (عليه السلام)، فيكون الصنع والإذن من الله العزيز الحكيم، والمخلوق ليس جديداً لأنه سبحانه وتعالى كان قد أوجده من قبل.
وهذه من الدلائل والبيِّنات على أن الله عزَّ وجلَّ هو وحده الخالق، وقد تفرَّد الخلق تأكيداً لألوهيته المطلقة، وعلى هذا فهو - سبحانه - يخلق ما يشاء، ويمنحه الصورة التي يشاء، ولذلك كان هو {الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوِّرُ} [الحَشر: 24].. وأمره في ذلك: {كُنْ فَيَكُونُ *} [البَقَرَة: 117] الكلمة التي تخلق كل شيء، وتجعله على أية هيئة أو صورة أو جنس قدَّرته، لأن كل شيء عنده سيحانه وتعالى بمقدار وحسبان، فهذا خلقٌ يهبه الحياة، وهذا آخرُ من جماد، وهذا ثالث من دخان أو نار أو غيرهما، إلى آخر ما تقتضيه الحكمة الإلهية في الخلق والصنع.
أما الإنسان، هذا المخلوق، مثل سائر المخلوقات الأخرى، فهو أعجز من أن يخلق، أو يصور شيئاً غير مخلوق من الله عزَّ وجلَّ.. وبالتالي لا يملك أن يهبَ حياةً، فكان من غير الجائز له أن يصور شيئاً لم يخلقه الله تعالى، أو لم يكن له في الخلق مثيلٌ. وبعبارة أخرى لا يجوز له أن يسوّيَ أو يصنعَ شيئاً يضاهي خلق الله العلي القدير. وهذا هو بالضبط ما نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقد جاء في الأثر: «يا عائشة! أشد الناس عذاباً عند الله تعالى يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». وكذلك في قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) الذي نقله ابن عباس وقد سبق ذكره.
فالحرام في التصوير إذاً أن يصوّر الإنسان شيئاً جديداً لا وجود له بين المخلوقات. ومعنى أن يصوِّر هنا أن يبتدعَ من عنده شيئاً يعتقد بعدم وجوده، ثم ينسبه إلى نفسه على أنه من صنعه وخلقه..
أما ما قد يُرسمُ من الناس والحيوانات والطيور والأشجار والجبال والبحار والأنهار، أي مما هو معروف لدى الناس، فلا يُعدُّ تصويراً بالمعنى الحقيقي للتصوير، بل هو رسمٌ أو نسخٌ لأشياءَ موجودةٍ، فيكون الإنسان راسماً أو ناسخاً وليس مصوراً، أي هو يرسم أو ينسخ ما قد خلق الله عزَّ وجلَّ من ذي حياة أو غير حياة، ويظهره لنا على هيئته وشكله. ويكون رسمه أو نسخ انعكاساً لما في الوجود أي قد عكس الصورة الحقيقية التي صوَّرها الله تعالى. وقد تكون هذه الصورة لإنسانٍ أو لحيوانٍ ماثلٍ أمامه أو في ذهنه، وما هي إلاَّ مثل صورة الإنسان أو الحيوان التي تنعكس على صفحة الماء، أو على وجه المرآة تماماً، فلا يدخلها بالتالي حرام ما دامت لا تنبئ عن شطط الخيال، وتوهم البدعة، والظن الباطل..
ولا فرق في ذلك بين نقل الصورة باليد، أو بالآلة التي تسهل وتسرّعُ عمل اليد، وسواء أكانت الصورة التي نقلها، أو رسمها ساكنةً كما في اللوحة المعلقة على الجدار أو المطبوعة في المجلة، أم كانت متحركةً كما هي على الشاشة المرئية، وسواء أكانت تلك الصور للإتجار أم للاقتناء، أم لإشباع الموهبة التي حباها الله تعالى لبعض عباده حتى يظهروا لنا تلك المناظر الخلابة التي تسبِّح بحمده وفضله على خلائقه.. فكلها صورٌ ناسخة للأصل أو عاكسة له، ولذلك لم يدخلها التحريم.
ومن هنا رأى الشافعية أنه «يجوز التفرج على خيال الظل في السينما أو التلفزيون». ومن هنا أيضاً جاز ويمكن مشاهدة الأفلام التي تعرض بواسطة هذه الوسائل ما دامت لا تخرق القاعدة التي وجهنا إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، ولا تتعارض مع ديننا الذي يأبى على الإنسان أن يحط من كرامته، ويمتهن خلقه ووجوده. أي أن وجه الجواز ألاَّ نأتي بصور مبتدعة لا أصل لها، ولا بصور خلاعية تنم عن الفسق والفساد، أو بصور القتل والسرقة والاعتداء، وكل أنواع الإجرام التي هي الآن المدار والأساس في مجال وسائل الإعلام المرئية، وكما تعرضها الأفلام المصوَّرة من أجل تشويق الناس وجذبهم، وبالتالي صرفهم عن القيم والمثل العليا. ومثل هذه الصور لا يجوز مشاهدتها لا على الشاشة التي تعرضها، ولا في المعارض والساحات والمتاحف، ومن باب أولى لا يجوز تصويرها في الأصل لمنافاتها الشرع الحنيف والقيم والإنسانية. أما ما قد يستعمل وسيلة للبحث العلمي أو لاكتشاف أمورٍ قد تخدم الأغراض الإنسانية، فإنه يبقى في دائرة أصحاب الشأن والتحقيق، ويجوز تصويره واستخدامه لتلك الأغراض الشريفة.
وخلاصة القول: إن التماثيل محرَّم صنعها أو اقتناؤها لأنها تعبّر عن الوثنية، وإن كان غيرَ محرمٍ رؤيةُ التماثيل في الأماكن التي تتواجد فيها بصورة قسرية على المسلم. أما الصور المجسَّدة سواء كانت ذاتَ ظل كالسينما أو التلفزيون، أم ليس لها ظل كالنقوش والرسوم على الجدران والورق، أو التي تطبع على الألبسة والستور، وفي المجلات والصحف، وكذلك الصور الفوتوغرافية، فهذه كلها جائزة ما لم تَمسَّ صفة الخلق، أو تمتهنَ كرامة الكائنات الحية، وخاصة الإنسان منها، ولاسيما تلك التي تثير الشهوات وتنشر الفساد فتصبح محرمة.
الموسيقى والغنـاء
مما لا شك فيه أن العالم قد عرف كثيرين من الذين برزوا في فنون الموسيقى والغناء، كما في سائر الفنون الأخرى. وقد ذاع صيت بعض هؤلاء حتى صارت آثارهم بمثابة التراث البشري العام، الذي تقام لإحيائه حفلات وندوات خاصة في كثير من الدول، ولا سيما تلك التي تهتم بمثل هذا التراث، تأكيداً منها على أهمية تلك الفنون ومدى تأثيرها في حياة الناس. لا بل لقد اعتُبِر بعض أنواع الموسيقى بمثابة لغة عالمية لمخاطبة الأذواق والمشاعر الحسَّاسة، بعيداً عن أي تعصّب عرقي أو ديني.
ومثل هذا الاهتمام بعالم الموسيقى والغناء ليس جديداً على الناس، فقد عُرف منذ عصور قديمة، ولدى شعوب عديدة مختلفة.
وعندما جاء الإسلام انصبت اهتماماته في المقام الأول على تربية النفس الإنسانية لإبعادها عن الوثنية والشرك، وقيادتها نحو طاعة الله عزَّ وجلَّ، وتدريبها على عمل الخير والفلاح والصلاح. ولذلك لم يجعل المسلمون الأوائل مدار اهتمامهم غير أمور العقيدة والتربية الإنسانية. إلاَّ أنهم في الوقت نفسه لم يغفلوا بصورة نهائية عن الأمور الأخرى التي يعايشها الناس، مثل الموسيقى والغناء، ولذا نرى الرسول نفسه (صلى الله عليه وآله وسلّم) قد أقرّ في مواقع معيّنة ما يغنّيه الناس أو يعزفونه، كما في تلك الملاقاة، وذاك الترحيب اللّذَيْن استقبله بهما أهل المدينة، عندما قدم عليهم، في هجرته الميمونة، وقد انطلقت حناجرهم بالأرجوزة الغنائية الشهيرة:
طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا
ما دعا للّه داع
أيها المبعوث فينا
جئت بالأمر المطاع
جئت شرَّفت المدينا
مرحباً يا خيرَ داع
إذاً فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) قد أحلَّ العزف والإنشاد في مثل هذا الموقع، وفي غيره من المواقع والمناسبات المماثلة التي تعبّر إما عن الشعور الديني، أو عن أفراح الناس وأعراسهم، وإما عن أنسهم في الأسفار، أو في العمل كما فعل المسلمون وهم يحفرون الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب، أو كما يفعل أبطالهم وهم يلاقون الأعداء في ساح الوغى: إذ كانوا في جميع تلك المواقع ينشدون، ويغنون مفاخرين بدينهم وأفعالهم. ولكن بالمقابل نجد الإسلام يحرِّم في المواقع الأخرى أي نوع من أنواع الموسيقى والغناء، التي يكون من شأنها إثارة الفسق والمجون، وإشاعة التهتك واللذات التي تؤدي إلى المعاصي. وهذا ما يدلُّ عليه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) عندما قال: «ليشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله تعالى بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير»[*].
ولقد ترك المسلمون آثاراً لهم في الموسيقى، ومثالها «كتاب الموسيقى الكبير» للفارابي، إذ يقارن فيه بين الموسيقى والشعر فيقول: «إن الموسيقى والشعر يرجعان إلى جنس واحد، وهو التأليف، والوزن، والمناسبة بين الحركة والسكون، فكلاهما صناعة تنطبق بالأجناس الموزونة. والفرق بينهما واضح في أن الشعر يختص بترتيب الكلام في معانيه على نظم موزون مع مراعاة قواعد النحو في اللغة، أما الموسيقى فهي تختص بمزاحفة أجزاء الكلام الموزون وإرساله أصواتاً على نسب مؤتلفة بالكمية والكيفية، في طرائق تتحكم في أسلوبها بالتلحين. فإذا اقترن حسن المعنى في الشعر مع جودة الصناعة في لحنٍ تامٍّ، صحيح الإيقاع، من صوت مليح النغمة، فإن النفس تنجذب إليه بالغريزة وتنصت وتنتابها حينئذٍ عوامل شتى».
إلاَّ أنه وعلى الرغم مما لأنواع الموسيقى والألحان الجميلة، والراقية من تأثير في النفس الإنسانية فإن ما يشهده العالم اليوم من موجاتٍ وابتكاراتٍ جديدةٍ في عالم الموسيقى والغناء، قد يكون شيئاً مختلفاً عما سبقه. فما هو سائد اليوم ليس إلا فوضى موسيقية، وأصواتٍ صاخبةٍ تجتاح الشرق والغرب على السواء، وتفعل في نفوس الشباب فعل السحر، فتجدهم مولعين بها إلى حد الهوس، يستمعون إلى أشرطتها في المنزل، وفي السيارة، وفي الملهى، وفي كل مكان يتواجدون فيه. أما الحفلات التي تروّج لهذه الأنواع من الموسيقى، ولهؤلاء المغنين والمغنيات فحدِّث ولا حرج. وقد يحضرها ألوف حيث يهيمون في أجوائها طرباً، ويترنحون على صخبها نشوةً، ورقصاً، وتمايلاً، وضماً وشمّاً.. إلى آخر تلك المعزوفة التي تلفظها الأذواق السليمة، وترفضها العقول الرصينة، وتأباها كرامة الإنسان المؤمن!..
وفي هذه الأجواء الفاسدة المفسدة على هذا النحو السائد، يتساءل الشباب المسلم: وماذا نفعل نحن؟ فأينما ذهبنا وحيثما كنا تحيط بنا ظاهرات هذا العصر سواء من الموسيقى والغناء، أو من السينما والتلفزيون، أو من صالات اللهو واللعب إلى غيرها كثير. ونحن لسنا بقادرين على الابتعاد عنها، أو حتى تلافي آثارها على حياتنا، إذ يصِمُنا غيرنا بالتحجر والرجعية، وبالتخلف وعدم التمدن، وهذا ما لا يليق بنا وبمسيرة حياتنا.. بل لا نستطيع أن نقول اليوم بأننا قادرون على أن نتحاشى سماع الموسيقى والأغاني الحديثة، ولا أن نتلافى رؤية المشاهد التي تعرض في التلفزيون. وكيف ذلك والدنيا كلها باتت على مسمع ومرأى كل إنسان بواسطة هذه الأجهزة المرئية والمسموعة التي تمكِّن أي فردٍ، وفي أي بلدٍ، من أن يسمع ويرى ما يدور في سائر البلدان الأخرى. فالأميركي قادرٌ على أن يعرف ما يجري في روسيا، والروسي قادر على أن يعرف ما يدور في أميركا، والشرق أوسطي يرى على شاشته أحداث أوروبا ويسمع على مذياعه صوت أميركا، أو ما تقوم به الشركات اليابانية، أو ما يفعله الطلاب في الصين..
وهذه التساؤلات التي تواجه الشباب المسلم اليوم تفرض على مجتهديهم وأهل الحل والعقد أن يجدوا لها الحلول، وأن يستنبطوا لها الأحكام الشرعية التي تريح شبابنا، ولا تبقيه في حالة الحيرة والتشتت. أما المعالجات السلبية فتظل مقصرة عن أن توصل إلى المطلوب. بل وقد تعطي في أحيان كثيرة ردات فعل عكسية..
ولعلَّ ما يواجهنا في وقتنا الراهن من مسائل كثيرة يفرض علينا التصدي لها بالروح الإيجابية البناءة، بدلاً من اعتماد السلبية غير المجدية في مواجهتها. فمثلاً قد اتخذ مجلس الشورى في إيران، قراراً يقضي بمنع الأطباق - الصحون - التي تسهل إيصال الصورة والصوت عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك للحدِّ من تلك المشاهد، والألحان والأصوات التي تؤثر على سلوك الشباب المسلم الإيراني سلباً.
وليس هذا هو الحل الأمثل والعلاج الأنجع في رأينا، لأن الوسائل السمعية والبصرية مع التقدم التكنولوجي سوف يبقى لها تأثيرها المباشر على الناس جميعاً، سواء منعت الأطباق أو الرادارات أم لم تمنع.. وإذا كان الأمر كذلك فما هو العلاج الأمثل والدواء الأنجع لتلافي أضرار هذا الواقع وليس منعه، لأنه ليس بمقدورنا هذا المنع لاسيما وأنَّ الكرة الأرضية بأسرها أصبحت كما أشرنا إليه سابقاً كالبلد الواحد بالنسبة للمواصلات والاتصالات؟
لقد عرفنا أن الحكم الشرعي الإسلامي لا يقتصر تطبيقه على قوة الجندي فحسب، ولا على قواعد موضوعية إلزامية مثل تلك التي يسنها الغرب أنظمة صارمة ويعتبر أنها من مظاهر التقدم عنده، بل إن تطبيق الحكم الشرعي في الإسلام يستند إلى أربعة أمور:
- تقوى الفرد المؤمن، وهي أولاً وقبل كل شيء. فلما لم تكن هذه التقوى راسخة في النفس، فلا يمكن لأي حكم أن يكتب له النجاح الكامل في التطبيق، حتى لو وضعت له أشدّ القواعد وأقساها. فالحكم الشرعي بقطع يد السابق لم يمنع السرقة بتاتاً، ولكن التقوى التي تتعمق في النفس كفيلة بمنعها عن أي مسلم تقي.
- عدالة التشريع الإسلامي.
- تعاون الأفراد مع بعضهم البعض على تطبيق الأحكام الشرعية.
- وأخيراً قوة الجندي التي تفرض التقيد بالنظام أو بالأوامر التي يصدرها الحاكم.
ولذلك نرى أن المؤمنين يقومون بتطبيق الأحكام الشرعية من تلقاء أنفسهم، فهم يقومون بالصلاة والصيام والزكاة والحج حتى ولو كانوا يعيشون في البلاد التي تحكم بغير الإسلام، وذلك بدافع من تقوى الله تعالى. ثم هم يؤمنون بعدالة التشريع الإسلامي الذي ينظر إليهم جميعاً على قدم المساواة: لا فضل لعربي على أعجمي إلاَّ بالتقوى. ومن ثَمَّ تراهم يحثّون بعضَهم بعضاً على تطبيق الأحكام الشرعية، لما فيها من الطاعات والبعد عن المعصية امتثالاً لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة: 2]. وإذا لم يستجب البعض لأوامر الله تعالى استعملت السلطات أخيراً قوة الجندي لإلزامه على القيام بفرائضه، أو على تنفيذ الأوامر التي ترى فيها السلطات خيراً للأمة.
ولذلك كان على السلطة في إيران أن تعمل أولاً وقبل كل شيء، وبواسطة الإعلام، والدعاة والموجهين، على أن تغرس التقوى في نفوس أبنائها المسلمين، وأن تجعل العامة تعي عدالة التشريع الإسلامي حتى يبتعدوا تلقائياً عن تلك الأمور، التي تريد منعهم عنها بواسطة مصادرة الصحون أو غيرها..
فإذا ما تعمقت التقوى في النفوس، وآمن الناس بعدالة التشريع الإسلامي، وتعاونوا فيما بينهم على تطبيق هذا التشريع، فإنهم هم أنفسهم يطالبون الدولة عندها بمعاقبة كل من يخالف الشرع الذي يؤمنون به. وحينئذٍ يحق للدولة أن تستعمل قوة الجندي، متعاونة مع أفراد الأمة، لفرض هيبة الإسلام.
إذاً فالمسلمون المؤمنون هم الذين يدفعهم دينهم الذي ارتضوه، لكي يسيروا على المنهج السليم الحق، مهما أحاطت بهم الظروف، أو تشابكت حولهم الأوضاع وتنوعت..
ولكن هذا الأمر يفرض على قادتهم، وعلمائهم ودعاتهم أن يغرسوا في نفوسهم الثقة، ويوضحوا لهم قواعد السلوك، وطرق العمل بتعاليم شرعهم وأحكامه. وإن الأمور الأربعة التي ذكرناها (قوة التقوى في نفس الفرد، وعدالة التشريع، وتعاون أبناء الأمة على تطبيق الأحكام الشرعية، واحترام الأنظمة التي يفرضها الحاكم) هذه الأمور هي التي تحصّن الإنسان المسلم تلقائياً، وتمنحه القوّة على مواجهة جميع الظروف والأوضاع.. وإلاَّ فلا أحد يضمن ألاَّ يتاح المجال واسعاً أمام الفاسقين من أن يحرضوا على تعاليم الإسلام، وأن يجعلوا البسطاء من أبناء الأمة يقعون في أحابيلهم، ويصدقونهم بأن الإجراءات التي اتخدتها الدولة في إيران هي كبتٌ للحريات، ومصادرةٌ لمسيرة الحياة وتقدمها. مع أنَّ الحقيقة هي بخلاف ذلك تماماً، لأن ما أرادته السلطات في إيران، وسعت إليه في اعتمادها لتلك الإجراءات، لم يكن إلاَّ وسيلةً لإصلاح الحياة الفاسدة لهذا الشباب الضال، الذي استبدَّ به وهج الحياة الملتوية، والموبوءة بأفكار الغرب وأساليبه، فجعلته ينجذب إلى إغراءاتها بعيداً عن الإيمان الصادق واليقين القوي بأحقية إسلامه، وكمال هذا الدين الذي يهيب بالمسلم أن ينأى عن المحرمات حتى ولو كانت صوراً وأفلاماً على شاشات التلفزيون والسينما.
من هنا ومن أجل مواجهة جميع المستجدات كانت دعوتنا إلى الاجتهاد البنّاء حرصاً على مصلحة أجيالنا..
ومن هنا كانت مخاطبتنا المسلمين، والشباب المسلم خاصة، قائلين بأن الإسلام في الحقيقة إنما يحرم التهتك، والاستهتار، والعبث، وكلَّ ما يؤدي إلى الفساد والإفساد، وكلَّ ما من شأنه إبعاد المسلمين عن التفاعل مع الحياة.. ولذلك فقد حرَّم علينا الإسلام أفعالاً، وكرَّه إلينا أفعالاً أخرى، وفي الوقت نفسه أطلق لعقولنا المجالَ لفهم الواقع من حولنا، ومعالجة هذا الواقع بل وكافة شؤون الحياة بما يؤمن مصلحتنا. هذا في الوقت الذي جعل القليل هو الحرام والمكروه، بينما جعل الكثير هو الحلال والمباح، ثم ترك لنا مجال الاختيار، ومرونة التفكير والحركة.
ولقد حضَّ الإسلام على العمل فقال أولاً: اعملْ.. واستثنى ثانياً فقال: لا تقرب.. وهذا ما نستدله من قوله عزَّ وجلَّ: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *} [فُصّلَت: 40].. إذاً فالمدار هو ماذا نعمل، وكيف نعمل، وماذا نقرب، وماذا لا نقرب.. وهو أمر يتعلق بكل شيء في هذا الوجود: مما أمر الله تعالى به أو نهى سبحانه عنه..
والموسيقى والغناء ليسا إلا من هذه الخيارات التي ترك فيها الإسلام للإنسان مجال الاختيار بين النافع منها والمفيد، أو بين الضار والمؤذي، أو ما يعبّر عنه شرعاً بين الحسن والقبيح. وإن الموسيقى والغناء في الأصل هما من الآيات الدالة على قدرة الصانع العظيم الذي أبدع هذا الكون بتناغم وتناسق، بما فيه هذه الأرض التي تزخر الحياة فيها بالأنغام والألحان.
ولكن قبل أن نبحث في هذا الأمر، كما هدانا إليه الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نتعرف إلى آراء المذاهب في الغناء وفي الموسيقى والعزف على آلاتها، وما ورد في السنة النبوية الشريفة مما يمُتُّ إلى هذه الأمور بصلة..
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «يظهر في أمتي الخسف والقذف»، قالوا: متى يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلّم): إذا ظهرت المعازف والقينات وشرب الخمور، والله لَيبيتَنَّ أناسٌ من أمتي على أشرٍ وبطرٍ ولعبٍ، فيصبحون قردةً وخنازير لاستحلالهم الحرام»[*]. وفي رواية ثانية: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والخنازير والخز والمعازف»[*]. وفي رواية ثالثة أتينا على ذكرها من قبل قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «ليشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يُعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات..»[*].
وروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنه قال: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب منه الدعوة، ولا يدخله الملك»[*].
وإن من يدقق في تلك الروايات جميعها يتبيَّن له بوضوح أن ما نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) هو المجون والفساد، وكل ما يؤدي إليهما سواء كان عزفاً، أم غناء، أم شرب خمر، فلا شك بأنه حرام إطلاقاً. فالروايات الثلاث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نجد فيها ذكر الخمر مصاحباً للمعازف والمغنيات، مما يدلُّ على أن كل ما يُذهب العقل، ويعمي البصيرة، ويبعد الفؤاد عن الوعي والإدراك هو محرّم، لأن فيه الاستهتار والتفلُّت، والانسياق وراء الملذات والشهوات، والمتع الرخيصة. وكان من الطبيعي أن يحرَّم غناء، وأن تحرم موسيقى يصاحبهما مثلُ تلك الأمور التي تحط من كرامة الإنسان، وتدفعه إلى ارتكاب المعاصي والذنوب، وتصرفه عن الطاعات والعبادات، والتعامل السوي القائم على الاستقامة مع الناس..
ولا يختلف ما جاء في قول الإمام الصادق (عليه السلام) عما ورد في الأحاديث النبوية، بل هو متوافق معه، وموضّحٌ لآثاره على الحياة الشخصية.. كما أن لكل أُذن ما سمعت ولكل عين ما رأت، ولكل فؤاد ما وعى. والقرآن الكريم صريح وواضح بأن الإنسان مسؤول عن كل ما يسمعه وما ينظر إليه، وما يحفظه ويعيه في قلبه وعقله: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً *} [الإسرَاء: 36].
- وقال الحنفية: التغني المحرم ما كان مشتملاً على ألفاظ لا تحل كوصف امرأة معروفة وما زالت على قيد الحياة، ووصف الخمر المهيج لها. وما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب محمول على النوع المحرم منه. ويكره تحريماً عند الحنفية ضرب الأوتار من الطنبور والرباب والقانون والمزمار والبوق ونحو ذلك.
- وقال المالكية: إن آلات اللهو المشهورة والتي تستعمل للنكاح - أي للأعراس - هي جائزة فيه خاصة، كالدف والطبل والمزمار والبوق، إذا لم يترتب عليها لهو كثير استناداً لقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «أعلنوا النكاح واضربوا بالغربال»[*] (والغربال هو الدَّف) ويباح ذلك للرجال والنساء.
وقال بعضهم: إنه يجوز ذلك في كل سرور حادث، فلا يختص بوليمة النكاح. أما الغناء: فإن الذي يجوز فيه هو الرَّجز الذي يشبه ما جاء في غناء جواري الأنصار.
- وقال الشافعية: يكره الغناء وسماعه ولا يحرم، لما روي عن السيدة عائشة، قالت: «كانت عندي جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر، فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)؟ فقال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم): «دعها، فإنها أيام عيد»[*].
ودليل الشافعية على الإباحة: أنه لم تصح عندهم أحاديث المنع. قال الفاكهاني: «لم أعلم في كتاب الله، ولا في السنة حديثاً صحيحاً صريحاً في تحريم الملاهي، وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بها، لا أدلة قطعية»[*].
- وقال الحنبلية: لا يحل شيء من العود والزمر والطبل والرباب ونحو ذلك. وإذا اشتملت الوليمة على شيء منه، فإنه لا يحل الإجابة إليها. أما بالنسبة للغناء فإن تحسين الصوت والترنيم في ذاته مباح. بل قالوا: إنه مستحب عند تلاوة القرآن الكريم إذا لم يُفضِ إلى تغيير حرف أو إلى زيادة لفظة وإلاَّ حرم. والترنم وتحسين الصوت بعبارات الوعظ والحِكم ونحوها كذلك. وقالوا: إن قراءة القرآن بالألحان مكروه، وإن السماع مكروه.
وهكذا يلاحظ أنه يحرم في المشهور عند معظم المذاهب استعمال الآلات التي تطرب كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار والرباب وغيرها. واستدلوا على تحريم الغناء والمعازف من القرآن بقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمَان: 6]. قال ابن عباس: هي الملاهي.
وقد أجازوا الغناء المباح وضرب الدف في العرس والختان. وحرموا الأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور في الزفاف وغيره، أي أنهم حرموا كل الملاهي المحرمة[*].
ونحن نرى أن الآلات الموسيقية تباح أو تحرَّم من خلال استعمالها. فإذا كان استعمالها للفجور، والمجون، والميوعة وإثارة الشهوات فهي بلا شك حرام، ولا يجوز اقتناؤها،ولا بيعها أو شراؤها، وهي آلات صمّاء، صنعت في الأصل من موادّ أحلها الله سبحانه وتعالى، وليست محرَّمة بذاتها كآلات، بل لأن الفجور، والمجون وكلَّ ما يثير الشهوات والرغبات المحرَّمة إنما هو حرام، فلذا كانت حرمتها لأنها آلات أو أدوات تساعد على المعاصي وارتكاب الذنوب، أو تثير الأحاسيس التي تؤدي لذلك. أما إذا استعملت لأغراض أخرى تسمو بالنفس، وتهذب الشعور، وتصقل السلوك، وتُشعر الإنسان براحة واطمئنان وهدوء وأنس، فيكون استعمالها أو اقتناؤها حلالاً، وليس في شيء من ذلك حرمة على الإطلاق. بل ولماذا تكون الحرمة طالما أنه ليس في استعمالها أو اقتنائها معصية أو تعدٍّ أو ارتكاب ذنب؟ فالمذياع مثلاً (الراديو) يمكن أن يستعمل للتعليم، والترويح عن النفس، وتقديم الأخبار، والقصص، والدروس العلمية وغيرها من الأمور المشروعة، فيكون في كل هذه الاستعمالات حلالاً بل ومطلوب لنفع الإنسان ومصلحته. أما إذا استعمل للأغاني الصاخبة، والتوجه اللاخلاقي، وإثارة النَّعرات الطائفية أو المذهبية، أو إثارة المشاكل وغيرها، فيكون عندئذٍ حراماً ومرفوضاً. ومثل المذياع التلفزيون وأيَّة آلة موسيقية مهما كان نوعها.
وكما الآلات والأدوات فكذلك بعض أنواع الموسيقى التي باتت ضرورية في حياة الناس ولا سيما تلك التي تستعمل في المناسبات الرسمية مثل نشيد الدولة، أو ما يُنشد عند استعراض الجيوش، أو استقبال الزائرين والوفود الرسمية، أو ما يُعزف في مناسبات الأعياد والأعراس، والحزن والحداد، أو الموسيقى التي تعزف على قبر الجندي المجهول، أو عند تأبين شهيد، أو في أية مناسبة مماثلة. فالنشيد والآلات التي تستعمل في هذه المناسبات كلِّها تكون مباحةً ولا يدخلها التحريم.
وأما بالنسبة لما جاء في الكتاب المجيد عندما أتى على ذكر داود (عليه السلام) بقوله تعالى: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ *} [الأنبيَاء: 79].
فيبدو أن داود (عليه السلام) كان له صوت حسن، فيه حنان ورقة وصفاء، والصوت الحسن هبة من الخالق العظيم، يمنحه للبعض من الناس، ليكون من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى، وأنعمه التي يتفضل بها على عباده. وأهمية هذه الهبة الربانية تكمن في كيفية استخدامها: إما للصلاح والخير، وإما للفسق والشر... وداود (عليه السلام) قد استخدم هذه الهبة، كما يبيّن القرآن الكريم، في التسبيح لله الملك القدوس العزيز الحكيم. وكانت تتجاوب معه الجبال والطيور، مسخّرةً بأمر ربِّها، فتسبح بحمده - عزَّ وجلَّ - مع تسابيح داود (عليه السلام) التي تتصاعد في الآفاق أناشيدَ شكرٍ وطاعةٍ وثناء.. فداود (عليه السلام) لم يستعمل هبة الله تعالى له إلا فيما يليق بتلك الهبة. ولم يشر القرآن الكريم إلى أنه استعملها لطربه وأنسه، ولا لِلَذته الشخصية، ولا لطرب الناس وإيناسهم، بل استعملها للتسبيح، فحق للجبال والطير، بل وللكائنات كلها أن تشارك في تسبيحه..
ولكن أين داود (عليه السلام) من أولئك الملوك، والقادة، والأمراء الذين شيَّدوا القصور، وعمروا الجنائن، وأوسعوا في الساحات لكي يقيموا حفلات الغناء والطرب للمجون والفسوق وشرب الخمور، وتعاطي المحرمات؟. فكم صوَّر لنا التاريخ القديم والحديث أوضاعاً نافرة، مخزية، استغلَّ فيها الحكام والأمراء وأصحاب النفوذ وأمثالهم الأصوات الجميلة، والراقصات الخليعات ليقيموا الحفلات والاحتفالات العامرة بالمحرمات!.. نعم إن تسابيح الجبال والطير مع داود (عليه السلام) هي حقائق من القرآن تبيّن كيف أن الله سبحانه وتعالى يخرق النواميس، والسنن، ويجعل الجبال والطير تسبِّح مع داود (عليه السلام) ليدلنا على أن هباته وعطاياه سبحانه هي للحق، والخير، والمتعة الرفيعة.
نستدلّ من كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الغناء ولا الموسيقى تحريماً قاطعاً في جميع الحالات، بل إنه سبحانه خلق الأنغام والألحان لتتجاوب أصداؤها في جنبات الكون، الذي يتحرك بانتظامه وإيقاعه، وتناغمه وتجانسه، ليكون الشاهد الأكبر على قدرة الله تعالى في خلقه وحكمة صنعه.
هكذا يجب أن نفهم الغناء والموسيقى على أنهما من عطاء الله تعالى فالغناء، الذي فيه ذكرُ الله وتمجيده، أو ما يريح النفس الإنسانية - ولا يكون فيه إثارةٌ للشهوات والغرائز، ونوعٌ من الإباحية والمجون - فهو مباحٌ، وكذلك الموسيقى التي تهدّئ الأعصاب وتتآلف مع الذوق السليم فهي مباحة أيضاً لأنها تنمُّ عن موهبة الموسيقيّ التي هي من هبات الله تعالى. وهذه المنظومات من الأصوات والمشاعر يجب أن تتوافق مع تكامل النواميس الربانية، وثبات السنن الإلهية. ثُمّ ألسنا نسمع في خرير المياه أنغاماً، وفي حفيف الأشجار أنغاماً، وفي أصوات الطيور أنغاماً.. فكيف نقول إن الله سبحانه وتعالى قد حرَّم الألحان والموسيقى وقد خلقها عزَّ وجلَّ في مختلف جوانب هذه الحياة التي نحياها؟. ثم أليست تلك الأنغام مثل هذه الألوان للثمرات والجبال والناس والحيوان في اختلافها وتنوعها، كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ *} [فَاطِر: 27-28].
ومن يدقق في هذه النصوص القرآنية البديعة يجد بوضوح كيف أن عنصر الجمال يبدو مقصوداً في تصميم السماوات والأرض وتنسيقهما. فالتعبير عن الألوان يدل على التنوع في الخلق من إنسان وحيوان وجماد، وهو يجمع بين الأحياء والجماعات ليكتمل معرض خلق الله الجميل الرائع فيشمل الأرض كلها، ومن عليها وما عليها.. فيتآلف الكل مع بعضه البعض، ويعطي للحياة رونقها وجمالها. وعندما تتضح هذه الصورة الشاملة لذوي البصائر وهي تسبِّح بعظمة الخالق، وصنعه البديع،ينطلق الكل من الأصل تسبيحاً، ويعود الكل إلى هذا الأصل تسبيحاً.. وهذا ما لا يدرك سرَّه وجلالَ قدره إلا العلماءُ الذين يتلون القرآن، وينظرون في ملكوت الله تعالى، فتتبيّن لهم معرفةُ الله العزيز الحكيم: يعرفونه بآثار صنعه، ويدركونه بآثار قدرته، ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه، ومن ثم يخشونه حقاً، ويتّقونه حقاً، ويعبدونه حقاً.. فالألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين، وروائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء. وكذلك الموسيقى والألحان والأصوات الجميلة تعابير عن البدائع والروائع في الخلق، فلا يجب أن نستخدمها إلاَّ لما يكون فيه طاعةُ الله (تعالى) أو صلاحُنا،وراحتُنا وصفاءُ أنفسنا..
لقد خلق الله تعالى الآذان للسمع، والعيون للبصر، فكما تدرك العيونُ جمالَ الألوان، كذلك تدرك الآذانُ جمالَ الألحان والأنغام..
ونحن في حقيقة الأمر، وانطلاقاً من واقع الحياة، نرى بأن الخالق الصانع المبدع قد أوجد الأنغام والألحان. وما كان منهما متوافقاً مع الوجود الأرضي ومع حركة الكون فهو ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نسمعه ونأنس به. وما كان منهما يصادم وجودنا الأرضي ويتنافر مع حركة الكون فهو ما يجب أن نبتعد عنه، بل ونحاربه.. فالله عزَّ وجلَّ يريد للإنسان أن يحيا حياة طاهرة، صافية، فيها احترام للذات والكرامة الإنسانية. والأنغام والألحان يضفيان على هذه الحياة رونقاً وجمالاً، ولذلك كان مستحباً التغني بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ، وعلى ذكر الله تعالى، أو المشتملة على وصف ما في هذا الكون من أزاهير ورياحين، وبحارٍ وجداول وأنهار، وما فيه من ألوان بهيجة.. بل إن إظهار فضائل الإنسان، وإبراز خصاله الحميدة وصفاته النبيلة وأعماله المجيدة أو التعبير عن مشاعره الرصينة هي ممّا يستحب التغني به، لنشر القيم والمثل السامية بين الناس، وذلك من دون إطراءٍ، وتبذّلٍ، وتصنّعٍ وتكلُّف..
وأما ما كان من الغناء والموسيقى محرّضاً على الرذيلة، وعلى المجون والفساد، أو مما يحرك الشهوات ويثير الصخب والضجيج بدون طائل كاللهو والرقص والمتعة الرخيصة، وما يصاحب ذلك من فجور - كما يشاهد في الحفلات، وصناعة «الفيديو كلوب» - وتعاطي المسكرات والمخدرات.. فكل ذلك من الملاهي المحرمة التي لا يجوز للمسلم سماعُها ومقاربتها.
وأما ما يتعلق بالحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل، وما شابه، فهو مباح لا بأس في فعله واستماعه. وقد أقره النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)، كما أقر نشيد الأعراب، فيجوز سماع سائر أنواع الإنشاد، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يسمعه فلا ينكره[*].
وأما الشعر، فقد ذم الله سبحانه وتعالى الشعراء الغاوين المغوين، ومدح المؤمنين والصالحين منهم بقوله عزَّ وعلا: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الشُّعَرَاء: 224-227]. إنه قول الحق تبارك وتعالى في ذم الشعراء، والغاوين الذين يتبعونهم. وقد ذمّهم لأنهم يستوحون من الخيال، بعيداً عن عالم الواقع والحقيقة. ولذلك يشبههم القرآن، وأتباعهم، بأنهم يهيمون في أودية الخيال الوهمية، التي لا وجود لها إلا في تصوراتهم وانفعالاتهم، مما يجعل كل أشعارهم كذباً بكذبٍ، وخيالاً بخيال، لا يلامس حقائق الحياة. إنك ترى الشاعر يتصوّر نفسه وكأنه رَقِيَ في السماء، وسبح في الغيوم، وطال النجوم بيديه، بينما هو في حقيقته، لا يعدو هذا الكائن البشري العاجز، القاصر، الضعيف، الذي يلتصق بتراب الأرض. فكيف لا يكون ما يقوله كذباً صراحاً يستدعي ذمّه، هو ومن يتبعه، ويسير على نهجه في خداع نفسه، وتكاذبه على الخلق؟
ولكن ليس كل الشعراء مذمومين لقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الشُّعَرَاء: 227] فهؤلاء المؤمنون لم يشغلهم الشعر عن العمل الصالح والتعبد إلى الله تعالى. إنّ شعراء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قد انتصروا لدعوة الإسلام ولحامل الدعوة، بعد أن ذاق (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأصحابه في مكة مرَّ العذاب والهوان.. هؤلاء الشعراء، وقد اتخذوا سبيل الرشاد، انبروا للدفاع عن الإسلام، بهجاء الكفار وإغاظتهم. وكان منهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، الذين ناصروا الحق، وانتصروا بالحق بعد الظلم الذي وقع على النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والمسلمين.. وقد أثنى عليهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأكرمهم، كما فعل عندما أعطى كعب بن زهير، بردةً كانت عليه، لما أنشده لاميته المعروفة: «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول».
ولذلك يكون حكم الشعر، كحكم الموسيقى والغناء، بل وسائل الكلام في حظره وإباحته، وكراهيته واستحبابه: فحسنه كحسنه، وقبيحه كقبيحه. وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): «إن من الشعر لحكمة»[*]، كما قال (صلى الله عليه وآله وسلّم): «الشعر بمنزلة الكلام: حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام»[*].
وخلاصة القول: إن كل ما يصدُّ عن ذكر الله تعالى، ويلهي عن طاعته، سواء أكان موسيقى أم غناء أم شعراً، أو كان لعباً ولهواً، فهو حرام. وكذلك كل ما لا يتجاوب، ولا يتوافق مع مخلوقات الله تعالى في الفطرة التي فطرها عليها، فهو أيضاً حرام لأنه يصادم سنن الله تعالى التي لا تبديل لها ولا تحويل عنها.
نعم هذا ما نهى عنه الإسلام، وحرَّم ممارسته أو متابعته، شأنه شأن كل عمل قد يوقع الإنسان في المعصية والإثم. حتى البيع الحلال - «وأحلَّ الله البيع»ـ يصبح حراماً عندما يلهي ويبعد عن ذكر الله تعالى وطاعته. أوليسَ ربنا تبارك وتعالى قد أمرنا أن نترك البيع، وكلَّ شيء، عندما يحين موعد صلاة الجمعة، لنذهبَ إلى المسجد ونؤديَ هذه الفريضة جماعة لقوله عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ} [الجُمُعَة: 9-11]. وهو قولٌ كريم فيه من الوضوح والدعوة إلى إقامة صلاة الجمعة ما لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير أو توضيح. وهو أمر واجب يستدعي الطاعة والعمل به. حتى إذا فرغنا من الصلاة كان الأمر بالإباحة {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجُمُعَة: 10] إما سعياً وراء الرزق الحلال، وإما طلباً للدعة والراحة. وكله فضل من الله تبارك وتعالى، يأتينا به دائماً ذكره العزيز الذي تطمئن به القلوب.
إننا نتوجه للشباب المسلم ناصحين له بوجوب الابتعاد عن كل الأجواء التي تعج بالموسيقى والغناء والألحان التي تزين التفلّت، وتحضُّ على الرذيلة، وتثير الشهوات والرغبات.. إياكم يا شباب الإسلام والانخراط في مثل هذه الأجواء، سواء في الحفلات التي تقام في البيوت، أو في النوادي، أو في الاحتفالات العامة، التي لا تميّز بين فضيلة ورذيلة، ولا بين طاعة ومعصية، ولا بين حلال وحرام!!.. فارتيادُ مثل هذه الحفلات أو النوادي أو صالات الرقص يؤدي حكماً إلى المعصية، والابتعادُ عنها ومحاربتها فيهما طاعة لله تعالى، ورضوانٌ منه وفضلٌ كبير.
اللعب واللـهـو
يقال في اللغة: لعب فلان إذا كان لا يقصد في فعله مقصداً صحيحاً، فيكون فعله لعباً.
ويقال: إن اللهو هو ما يشغل الإنسانَ عما يعنيه ويهمه.
وهكذا نجد في الحياة، وانطلاقاً من هذه المعاني، أن كثيراً من الناس يغلب عليهم حب التمتع بالدنيا، فينساقون وراء اللعب واللهو حيث يجدون فيهما منافذَ لإشباع الشهوات والرغبات واللذائذ التي يعتبرونها هدفاً في حياتهم. كما يجدون الأجواء متاحةً ومؤمّنةً لذلك إنْ: بالوسائل والأدوات المتوفرة، وإن بالأماكن التي تفتح أبوابها لأصحاب تلك الأهواء والرغبات.
وأغرب من ذلك أن من الناس من يتخذ المقامرة، والمعاقرة، والمعاشرةَ السيئةَ والمجونَ تعبيراً عما يرغب به من اللعب واللهو، وهم يظنون أنها تؤمن لهم إراحة الأعصاب، والهربَ من الإرهاق، علماً بأن واقع حياة مثل هؤلاء الناس يثبت غير ذلك، بل وعلى عكس منه تماماً..
وهذا بخلاف ما دعا إليه الإسلام تماماً، وهو السعي والعمل والجدية في الحياة، دون أن ينسى إعطاء البدن والنفس حقهما من الراحة والارتياح، ونوال الطيبات الحلال التي خلقها الله تعالى للتمتع والتلذذ بها في هذه الحياة الدنيا. ومن هنا كان على الإنسان المسلم أن يختار بين ما يرضي الله تعالى ورسوله الكريم، وبين إقدامه على ارتكاب المعاصي والذنوب، مهما كان نوعها صغيرة أو كبيرة، التي تغضب الله عزَّ وجلَّ، وتشيع الفاحشة بين الناس.
ولذلك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتبر اللعب واللهو من وسائل التسلية والترفيه، بل عليه أن يميّز بين ما هو مباح منهما، وما هو مكروه أو حرام.
وسوف نذكر ونبحث حكم الشرع في بعض أنواع اللعب ومنها:لعب الورق والنرد (الطاولة) والشطرنج. وحكمها ينطبق على سائر ما يشبهها أو يماثلها. ثم نأتي بعد ذلك على حكم الشرع بالنسبة لليانصيب وسباق الخيل، وهما من الألعاب الشائعة.
1 - لعب الورق:
ويقسم إلى نوعين: ما فيه مقامرة، وما خلا من القمار.
فأما ما يتعلق بلعب القمار فهو حرام باتفاق جميع الأئمة، لأنه من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه بقوله العزيز: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المَائدة: 90]، {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ *} [المَائدة: 91].
فالميسر لغة، قد جاءت تسميته من: يَسَرَ القومُ الناقةَ: جزؤوا لحمها واقتسموه. والقمار من قمر قمراً أي راهن ولعب في القمار. وقَمَرَ الرجل: غلبه في القمار. وقَمَرَ الرجلَ مالَهُ: سلبه إياه. وتقامر القوم: تراهنوا ولعبوا في القمار.
والقمار، كما هو معروف في الحياة العامة هو كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً، سواء كان بورق اللعب، أو بالسباق، أو بالمغالبة أو بالمصارعة، أو بأي لعب يكون فيه الشرط أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً. وحتى إذا جرى عقد بين اثنين على ذلك، فيعتبر العقد باطلاً ولا قيمة شرعية له..
ولذلك كان اللعب الذي يؤدي إلى المقامرة مهما اختلفت أنواعها محرّماً بالنص القرآني. وقد ساوى الله عزَّ وجلَّ بين الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في نفس الآية. ثم ذكر أنَّ الشيطان جعل من الخمرة والميسر وسيلة يوقع بسببها العداوة والبغضاء بين الناس، كي يبعدهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة الواجبة. ولذلك جاء النهي عنهما بصورة جازمة قاطعة، تفرض على المسلم أن ينتهي عنهما حتى لا يقع في الحرام.
بالإضافة إلى أن حرمة القمار فيها معالجة لكثيرٍ من المفاسد التي قد يتعرض لها المقامر، وأهمها: خسارةُ المال، أو كسبُهُ بالسلب، وضياعُ الوقت الذي يجب أن يكون للعمل والسعي لكسب الحلال، وهدرُ الصحة في تمضية الليالي والسهر وراء الطاولة، والابتعادُ عن أهله وأولاده. وقد يرافق القمارَ معاقرةُ الخمرة، أو تعاطي المخدرات - كما هو شائع اليوم في أوساط المقامرين - إلى غير ذلك من المآسي التي تنعكس سلباً على كرامة الفرد، وعلى الحياة العائلية، بل وعلى المجتمع بشكل عام..
ويكفي أن نتطلع إلى تلك الكازينوهات المعدّة للقمار على أنواعه، سواء اللعب بالورق، أم بالآلات والوسائل التي تفننوا باختراعها لجذب الناس إلى لعب القمار،وإلى تلك الصالونات والبيوتات التي تُعِدُّ غرفاً خاصة فيها للعب القمار، وما نراه من اجتماع السيدات والرجال على طاولة واحدة، وقد تركوا أبناءهم وبناتهم للخدم، حتى يمضوا لياليَهم على تلك الحالة من الفساد.. نعم يكفي أن نتصور ذلك حتى نتبيَّن شرَّ القمار، وضرورة تركه!..
وأما ما يتعلق بلعب الورق الذي يخلو من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما، أي الذي يكون من أجل التسلية فقط، فقد أجمع الفقهاء على كراهيته، لأنه لا يخلو من إضاعة الوقت عبثاً،والانشغال بأمور تافهة، في حين أن المسلم عليه أن يشغل أوقات فراغه بذكر الله تعالى، وبالاطلاع على أحكام دينه، أو بالقيام بمطالعةٍ تنفعه، أو غير ذلك من الأمور النافعة التي ترفع من شأن الإنسان وتفيده في دنياه وآخرته.
2 - الطاولة (النرد):
النرد هو الزهر الذي يقذفه اللاعب للحصول على رقم معين. وهو يستعمل في لعب الطاولة أو غيرها من الألعاب، من أجل المقامرة غالباً. ولذلك كان اللعب بالنرد محرماً. وحسب اصطلاح الحنفية هو مكروه تحريماً في كون دليل الحكم فيه ظنياً، لما روى أبو موسى الأشعري: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»[*].
وروى بريدة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه»[*].
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من تكرر منه لعب النرد لم تقبل شهادته، سواء لعب به قماراً أم غير قمار، لأنه إن لم يقامر فعمله عبث ولهو، وذلك لقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لهو ولعب. (أو: فهو سهو ولغو) إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الهدفين (ويقصد به تعلم الرماية)، وتعلم الرجل السباحة»[*].
وقد ربط بعض المطَّلعين اللعب بالنرد (الطاولة) بالأبراج، وقالوا: إن هذه اللعبة وضعها أحد ملوك فارس، وسماها النردشير، وربط بينها وبين علاقة مستقبل الإنسان بالأبراج[*] أي فكما أن الشطرنج يرمز إلى نوع من الوثنية، بواسطة أحجاره التي يمارسون فيها لعبه، والتي هي عبارة عن أصنام، فكذلك قالوا إن الطاولة وتقسيمها إلى خانات، وترقيم أحجار النرد، جميعها ترمز إلى الأبراج.
فالأبراج قد ورد ذكرها في القرآن الكريم بقوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا} [الفُرقان: 61]، وعدد هذه الأبراج إثنا عشر برجاً، وأسماؤها هي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء أو (السنبلة) والميزان والعقرب والقوس أو (الرامي) والجدي والدلو والحوت. وهكذا فإن عدد أرقام خانات النرد (أو الزهر) هو 6 تتدرج من 1 إلى 6 في كل خانة، زائد 6 في خانات الحجر الثاني تساوي 12 وهو عدد الأبراج. وأحجار الطاولة منها بيضاء وهي ترمز إلى النهار ومنها سوداء وهي ترمز إلى الليل. وعلى هذا فإن اللاعب عندما يقذف بالنرد فإن أقصى ما يصل إليه هو الرقم 24 (6 × 2 مسحوبة مرتين = 24) أي يحقق الاكتمال، كما يكتمل اليوم بعدد ساعاته الأربع والعشرين.
3 - الشطرنج:
رأي الشيعة الإمامية: يرى بعض فقهاء الشيعة الإمامية أن الشطرنج محرم وذلك لقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ *} [الحَجّ: 30]. فإنهم يفسرون {الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} [الحَجّ: 30] أنه يدخل فيه أحجار الشطرنج التي هي عبارة عن أصنام من معاطاة الوثنية. ويفسرون «قول الزور» بأنه: الغناء. ويقولون: إذا قلت حقاً وباطلاً فأين تضع الغناء؟ ويجيبون: يوضع حتماً في خانة الباطل...
- وقال الحنفية والمالكية والحنبلية: يحرم الشطرنج، وذلك لما ورد عن علي (عليه السلام) أنه قال: «الشطرنج من الميسر». ويروون أن علياً (عليه السلام) مرَّ بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
- وقال الشافعية: يكره اللعب بالشطرنج، لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعو إليه، فكان تركه أولى، ولا يحرَّم، لأنه لم يرد نص بتحريمه. ثم إن الأصل في الأشياء الإباحة. أما إذا كان على عوضٍ من الجانبين أو من جانب واحد يأخذه الغالب من المغلوب، فهو حرام. فالشافعية إذاً يرون في لعب الشطرنج الكراهية وليس التحريم، وخاصة إذا استبدلت أحجاره المعروفة حالياً بأشكال جديدة ليس فيها هيئة التماثيل وصورها.
وعلى هذا فإن تحريم الشطرنج كان لارتباطه بالأصنام والتماثيل، وإن تحريم النرد كانَ لارتباطه بالأبراج أي من قبيل الكشف عن المستقبل، وهو ما يدخل في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
ولكن الناس في عصرنا هذا لا يفكرون في ذلك الربط أبداً، أي لا يدخل في روعهم أثناء لعبهم بالشطرنج أنّ أحجاره لها علاقة بالأصنام والتماثيل، بل هي بنظرهم مجرد دُمىً للعب ينقلونها ويحركونها وفقاً لرغبتهم ومهارتهم في هذه اللعبة. وكذلك النرد فإنهم لا يفكرون بأن له علاقة بالأبراج وخاصة أثناء نقل الأحجار من خانةٍ إلى أخرى..
وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر أدوات اللعب الأخرى كالورق والبرجيس، والآلات والماكينات على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإنهم يتخذونها إما وسلية للتسلية وإما وسيلة للمقامرة. ففي الحالة الأولى تكون مكروهة وفي الحالة الثانية تكون محرَّمة حتى ولو أقيمت لها المباريات في النوادي وغيرها، شأنها في ذلك شأن أية لعبة مهما كان نوعها، فإنها تكون محرمة إذا جرت فيها رهونات وعقدت عليها معاوضات.
4 - اليانصيب:
ومن الأشياء الشائعة بين الناس «اليانصيب»، وهو ما بات متداولاً بين أيدي الناس في معظم دول العالم حيث يقدمون على شراء أوراقه بغية كسب كمية كبيرة من المال، أو كسب شيء أو سلعة معينة. وأوراق اليانصيب هذه تنقسم إلى قسمين:
- قسم يتعلق بالمراهنة وهو حرام.
- وقسم يتعلق بجائزة وهو حلال.
فأما القسم الأول المتعلق بالمراهنة فهو أوراق اليانصيب التي تصدرها الدولة تحت اسم «الإصدار الوطني» أو «اللوتو» أو أي اسم آخر؛ والمراهنة فيه واضحة لأنك تدفع مبلغاً معيناً من المال مراهناً على أرقام قليلة وعديدة بين مجموعات هائلة من الأرقام تكون مطبوعة على أوراق اليانصيب، بحيث يكون حظك في الربح مجرد احتمال نسبي أي نسبة 1/ كذا...، وهذا الاحتمال مرتبط دائماً بدورة دواليب مرقمة أو دورة طابات مرقمة داخل آلة معينة مخصصة لهذا الغرض. فإن صادف وقوف الدواليب أو الطابات داخل الآلة على الأرقام التي تحوزها كنت رابحاً، بينما خسر الآخرون الذين كانوا ينتظرون مصادفة الحظ مثلك.
فهذه المراهنة التي تحتمل الخسارة بنسبة كبيرة جداً، بينما تحتمل الربح بنسبة قليلة جداً، والتي هي في الأصل رهينة الصدفة، هي حرام لأن المراهنة بمعناها الحقيقي تُعدُّ من القمار، والقمار حرام أياً كان شكله أو نوعه أو غايته. ونقول غايته لأن البعض يُقدمون على شراء أوراق اليانصيب وفي ظنهم أن ريعها سوف يعود إلى الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، فهم يظنون أنهم يقومون بعمل خير، وهذا ما يخالف الدين لأن نيَّةَ المشتري في الأصل متجهة إلى المراهنة والربح، وإلاَّ كان بإمكانه أن يدفع هذا المبلغ الذي يشتري به ورقة اليانصيب إلى جمعية خيرية أو إلى فقيرٍ أو عاجز وما إليه، ولذا لا يكون رهانه بشراء ورقة اليانصيب مقصوداً فيه الخير في الأساس.. ثم سواء راهن من أجل عمل الخير أو من أجل الربح فقط فكله حرام لأن الحرام آتٍ من المقامرة التي يمارسها من خلال ورقة اليانصيب التي لا تعدو كونها رهاناً على أرقام.
وأما القسم الثاني أي الذي يتعلق بنيل جائزة فهو يختلف تماماً عن الأول، ذلك أن من يحتاج سلعة معينة فلا بد له من شرائها لإشباع حاجته، وقد استفادت المؤسسات التجارية من هذا الواقع، أي واقع الحاجة التي تتطلب الإشباع، فعمدت إلى وضع السلع بتصرف المستهلك ثم جعلت له حافزاً أقوى للشراء بأن جعلت على شراء كل سلعة ورقة من اليانصيب يحصل من خلالها، وبنتيجة السحب على تلك الأوراق التي حازها المشترون، على جائزة معينة قد تكون مبلغاً من المال، أو ليرات ذهبية، أو سيارة، أو سلعة معينة وما إلى ذلك..
- والمؤسسات التجارية إنما تفعل ذلك انطلاقاً من مبدأ المنافسة في السوق لكي ترغِّب المستهلكين بالإقبال على سلعها، بإغرائهم بما تقدم لهم من جوائز. وهي بذلك تبيع أكثر، ويزداد رِبْحها أكثر، فتكون الورقة التي تعطيها للمستهلك من قبيل الوعد بالجائزة، فلا تدخل إذاً بمفهوم المراهنة أي المقامرة، بل هي مجرد وعد قد يتحقق من خلاله نيل الجائزة وقد لا يتحقق. مِن هنا يحل لمن يشتري السلع أن يأخذ هذه الأوراق التي تقدمها له المؤسسة لأنه في كل حال سوف يقدم على شراء سلعته إشباعاً لحاجاته، سواء بوجود أوراق الجائزة أو بعدم وجودها!
ثم إنَّ الوعد بجائزة يكون من قبيل الإرادة المنفردة سواء من الفرد أو من المؤسسة ولا يكون من قبل مراهنَيْن، أي من قبل إرادتَيْن، بنية الربح أو الخسارة.
5 - سباق الخيل:
وسباق الخيل هو كاليانصيب تماماً، منه ما هو حرام إذا كان قائماً على المراهنة وهذا ما هو شائع في أندية سباق الخيل، ومنه ما هو جائز إذا كان للفروسية فقط أو لنيل الجائزة عند إجراء سباقات الفروسية. ووجه الجواز في الحالة الثانية هو مشروعية الفروسية لأنها من أنواع الرياضات الهامة في حياة الناس، وتحتاج إلى كفاءات ومهارات معينة قد لا يستطيع كل واحد ممارستها.
وقد روي عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أجرى الخيل وجعل سَبْقَها أواقيَّ من فضة»[*].
ومثل سباق الخيل سباق الكلاب أو غيرهما من أنواع السباقات الأخرى التي تنظمها بعض أندية البلدان بحسب عاداتها وتقاليدها، حتى صراع الديكة بات من المباريات التي يجري تنظيمها، والتي لم تخل من المراهنة عليها.
وقد تنوعت في عصرنا هذا وكثرت أنواع وسائل المراهنات في العالم، حتى باتت الألعاب المشروعة، بما فيها الألعاب الرياضية سبيلاً إلى المراهنة. فإن قامت مباريات بين لاعبين مشهورين في الملاكمة، أو بين فريقي كرة قدم، أو بين متباريين بالمصارعة بدأت من ورائها المراهنات التي تنظمها مؤسسات محترفة غالباً ما تكون بأيدي المافيا في هذا البلد أو في غيره. فمثل هذا النوع من الرياضة أو هذه الألعاب مشروعة بحدِّ ذاتها ولكن المراهنات التي تجري عليها هي محرمة.
مما تقدم يتبين أن الحرام من الألعاب هو ما يعتبر قماراً أو ما فيه رهان، وما لا يدخل فيه مثل ذلك يكون مكروهاً. فإن أراد الشبابُ تمضية أوقاتهم فهنالك مجالات كثيرة أمامهم مما يفيدهم ويعتبر مباحاً لهم إتيانه. أما الكبار فليس أمامهم أفضل من قراءة القرآن الكريم لملء الفراغ الذي يعانون منه والانصراف إلى الصلاة، وخاصة بقضاء ما فاتهم في سابق أيامهم، وحضور حلقات الدرس وسماع المحاضرات المفيدة، وقراءة الكتب القيمة ولاسيما تلك التي تبحث في الأحكام الشرعية وتهدي إلى سبيل الدين والرشاد، وما إلى ذلك من الأمور التي يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل المفيد لهم ولأسرتهم وأمتهم.
أما فيما يتعلق باللهو، فقد ردَّه بعض الفقهاء إلى قول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ *} [لقمَان: 6]. وفي تفسير هذا النص القرآني قال كثيرون، ومنهم ابن عباس وابن مسعود (رضي الله عنه): «إن لهو الحديث هو الغناء، وما يتبعه من آلات الطرب وضياع العقل». وهذا التفسير صحيح وحقيقي طالما هو مقصور على الحديث، أي على ما يصدر عن الإنسان من كلام سواء بالغناء أو غيره..
ولكن اللهو، لا يقتصر على الحديث، بل إن الأفعال التي يقوم بها الإنسان والتي تصرفه عما يعنيه ويهمه من شؤون الدين والدنيا، تعتبر جميعها من اللهو. فما قدَّمناه عن مضيعة الوقت في صالات التسلية، وفي بيوتات السهر والرقص، وفي ارتياد النوادي المتخصصة بالقمار، والسباقات التي تقام فيها المراهنات، والتردد على الحانات.. كل هذه تعتبر من اللهو، ويتخذها الناس وسائل للتلهي عن الأعمال المفيدة..
فيكون كل ما يبعد عن الجدية، وعن تحمل المسؤولية، ويصرف عن العمل النافع المفيد يدخل في باب اللهو. ولذلك يعتبر اللهو الذي يُمارس في أجواء فاسدة حراماً، ويكره منه ما كان بعيداً عن الفساد والعبث وعن مخالفة أوامر الله تعالى ونواهيه..
6 - الألعاب المباحة:
الألعاب المباحة وهي كل ما لا يدخله عوض أو فيه نوع من الرهان أو المقامرة. ومن قبيل ذلك السباقات المشروعة في الألعاب الرياضية، وسباق السيارات والدراجات، والسباق على الأقدام، وما شابه.. فهذه تنمي مدارك الشباب وأبدانهم، وتساعدهم على صرف أوقات فراغهم بما هو مفيد ونافع.
حلق اللحية
إن اللحية هي من المواضيع التي تهم المسلمين، بعدما تبين أنه ليس للوجه زي معين في عصرنا، وأن في جميع شعوب العالم مسلمين وغير مسلمين، من يترك لحيته أو من يحلقها وفقاً لظروف كل فرد وقناعته.. وهذا يستدعي البحث الدقيق عن حكم اللحية في الإسلام..
ومن الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة نجد أن أحاديثَ كثيرةً وردت حول ترك اللحية وحفِّ الشارب. ومن تلك الأحاديث ما رواه ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: «خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى»[*]. وعن ابن عمر أيضاً «أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية»[*].
وقد روى مصعب بن شيبة عن السيدة عائشة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم[*]، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء»[*]، وتابع مصعب روايته فقال: ونسيت العاشرة، إلاَّ أن تكون المضمضة» وقال النووي عن العاشرة: لعلها الختان.
- وقد روى الشيعة الإمامية أحاديث عديدة بذلك عن أئمتهم (عليهم السلام): فعن الإمام جعفر الصادق (عليهم السلام) أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: «حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تَشبَّهوا بالمجوس»[*]. وعن الصادق أيضاً عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: «إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى، وهي الفطرة»[*].
ومعنى إعفاء اللحية: تركها وعدم حلقها. وحف الشارب: قص ما طال منه على الشفتين حتى يبين بياضهما. ولكن إعفاء اللحية لا يعني تركها جميعها وعدم حلق أي جزء منها، بل يقضي بترك مقدار معين منها لا يحلق، وهو ما يشير إليه قول الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سئل عن المقدار من اللحية الذي يجب تركه وعدم جزه، فقال (عليه السلام): «تقبض بيدك على اللحية، وتجز ما فَضَل»[*].
وسئل الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) عن تفسير قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البَقَرَة: 124] فقال (عليه السلام): «هو ما ابتلاه الله تعالى به في نومه من ذبح ولده إسماعيل، فأتمها إبراهيم (عليه السلام) وعزم عليها، وسلَّم لأمر ربِّه عزَّ وجلَّ، فلما عزم قال تعالى ثواباً له: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البَقَرَة: 124]، ثم أنزل عليه الحنيفية وهي عشرة أشياء: خمسة منها في الرأس، وخمسة في البدن. فأما التي في الرأس: فأخذ الشارب، وإعفاء اللحية، وطمّ الشعر، والسواك والخلال. وأما التي في البدن: فحلق الشعر من البدن، والختان، وتقليم الأظافر، والغسل من الجنابة، والطهور بالماء. وهذه الحنيفية الطاهرة التي جاء بها إبراهيم (عليه السلام) لم تنسخ، ولن تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [النِّسَاء: 125]. وعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن قص الشارب، أمن السنة؟ قال: نعم»[*]. وعن نفس السند أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: «لا يُطيلنَّ أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأً يستتر به»[*].
ومن هذه الأحاديث اعتبر معظم فقهاء الشيعة أن إعفاء اللحية، وحف الشارب من السنة.
- وقال الحنفية: إن حلق اللحية مكروه تحريماً. واعتبروا أن «المسنون في اللحية هو القبضة. أما الأخذ منها دون ذلك، أو أخذها كلها فلا يجوز»[*].
- وقال المالكية والحنبلية بتحريم حلق اللحية بصورة مطلقة.
- وقال الشافعية: يكره حلق اللحية. وقد أظهر النووي أن العلماء ذكروا عشر خصال مكروهة في اللحية، وبعضها أشد من بعض، منها حلقها، إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها[*].
ولو دققنا في هذه الأحاديث مجتمعة لتبين لنا ما يلي:
1 - أن إعفاء اللحية يعتبر من الفطرة، ومن الحنيفية التي جاء بها إبراهيم (عليه السلام).
2 - أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) قد حضَّ المسلمين على ترك اللحى، وذلك لكي «يخالفوا المشركين». كما ورد في حديث ابن عمر، أو «يخالفوا المجوس» كما ورد عن الصادق عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم). وروايات أخرى من هذا القبيل.
3 - أنه يجوز قص شيء من اللحية على أن يترك منها مقدار قبضة اليد.
وعلى هذا يمكن القول بأنه لم يرد نص صريح بتحريم حلق اللحية، وهذا يجعل حلقها مكروهاً شرعاً، وتركها على شكلٍ معيّنٍ مستحباً. والمكروه هو ما لا يعاقب المرء على فعله، ويثاب على تركه. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون ثواب على ترك اللحية دون حلقها، ولكن حلقها لا يعاقب عليه.
ولعلَّ هذا الحكم يتناسب مع ظروف عصرنا، ذلك أن غاية الرسالة كانت تفرض في البداية أن يتميز المسلمون عن غيرهم من المشركين والمجوس، لأن هؤلاء جميعاً كانوا يحاربون النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ودعوته، ويكيدون للمسلمين كيداً كبيراً. فأراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يجعل للمسلمين سمةً خاصة بهم تدل عليهم في الظاهر، فأخذ من الفطرة ما يستقيم مع تلك السمة، وجعلها في اللحية والشارب، وهما مما يدلُّ على الرجل، ويعيّن دينه وصفاته في ذلك الوقت... أما اليوم وبعد أن أصبحت التابعية أو الجنسية هي التي تميز رعايا كل دولة عن غيرها، فلم يبق مجال للقول إن هذا الإنسان مسلم لأنه ملتحٍ، وهذا الإنسان غير مسلم لأنه غير ملتح. وكيف يكون ذلك ونحن نرى كثيراً من المسلمين وغير المسلمين أصحابَ لحى، حتى صارت اللحية وكأنها إحدى «موضات» هذا العصر. ففي أميركا وأوروبا، كما في اليابان والصين، والهند، وسائر بلدان العالم نجد أناساً كثيرين يتركون لحاهم ولا يحلقونها. وهذا ليس بدافع ديني، بل بدافعٍ من إرادة الإنسان واختياره..
من هنا نقول: إن الحكم الشرعي في اللحية هو كراهية حلقها، ما دام لم يثبت وجودُ نص صريح أو قرائن تؤكد على تحريم حلقها.
فمن أراد أن يثاب في هذا الأمر فعليه أن يعفي عن لحيته ولايحلقها، وإلاَّ فلا عقاب على الحلق.
تقليم الأظافر
وكما وردت أحاديث تتعلق باللحية والشارب فقد وردت روايات أيضاً تدل على استحباب تقليم الأظافر. ومنها أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: «تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويزيد الرزق»[*].
وقال (صلى الله عليه وآله وسلّم): «إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان على ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافر»[*].
وعن موسى بن بكر أنه قال للإمام الصادق (عليه السلام): إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة؟ فقال (عليه السلام): «سبحان الله، خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيام»[*].
من هذه الروايات يتبين لنا أن قصّ الأظافر من المستحبات وتركها من المكروهات. وذلك لأنّ السنة النبوية قد بيّنت عدة فوائد في قص الأظافر، منها: الحفاظ على الصحة، ذلك أن ترك الأظافر يترك مجالاً لأن تتجمع تحتها الأوساخ، وهذا ما يؤدي إلى وجود ميكروبات في تلك الأوساخ من شأنها أن تؤذي صحة الإنسان. فضلاً عن أن الهندام والرونق وحسن المظهر هي من الأمور التي حثَّ عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأوصى بها المسلمين. فجميلٌ أن ينظر المرء إلى يديك وهي نظيفة، بدل أن يشمئزّ من مرآها وهي مليئة بالأوساخ ولا سيما تحت الأظافر.
وهكذا يتبين من الأحاديث الشريفة مجتمعة أن حلق اللحية، وجزّ الشارب أو حفّه، وتقليم الأظافر جميعها من الفطرة. وبما أن قص الأظافر من المستحبات، وتركها من المكروهات لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) بأن «الشيطان يسكن تحت الأظافر»، وبما أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) قد حضَّ أيضاً على حف الشارب وعدم إطالته حتى لا يتخذه الشيطان مخبأ يستتر به، فيكون حفُّه من المستحبات وعدمُ حفه من المكروهات، مما يشير إلى وجود القرينة التي تجعل حكم الأظافر مثل حكم الشارب، ومن ثم كان حكمهما معاً مثل حكم اللحية.
على أن ذلك كله راجع إلى اهتمام الإسلام بالإنسان، فكما يحث هذا الدّين العظيم على تزكية النفس وصلاحها، فإنه يدعو الإنسان إلى الاعتناء ببدنه وبمظهره الخارجي، والاهتمام بما يجب أن يكون عليه المسلم من الرونق، والحفاظ على الصحة، بحيث جعل كل ما يفيد الإنسان وينفعه واجباً أو مستحباً، وكل ما يضره أو يؤذيه محرَّماً أو مكروهاً.
الحجاب واللباس الشرعي
الحجاب واللباس الشرعي من أوامر الله تعالى، فهما من ضرورات الإيمان عند المسلمين. وقد أنزلت بهما في كتاب الله المبين آيات بيّنات تدل على كل منهما وتميّزه عن غيره بوضوح، منها ما هو مخصوص بنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)، ومنها ما هو لعموم نساء المؤمنين.
أما ضرورتهما الإيمانية فلسببين: أحدهما أنهما تشريع إلهي أي من الأحكام الشرعية التي يجوز فيها الاجتهاد وفقاً للكتاب والسنة، وثانيهما حياتي، ويتعلق بالنظام الاجتماعي في الإسلام الدي يميّز بين المرأة والرجل في تكوينهما، وفي مظهرهما الخارجي الذي يدلُّ على الرجل رجلاً، وعلى المرأة امرأة، وليس كما بات الوضع في هذا الوقت الرديء، حيث يصعب أن تميّز بين رجلٍ وامرأةٍ في أحيان كثيرة نظراً لتشابه المظاهر في حلق شعر الرأس وفي اللباس وما له من أنواع الموضة، وحيث ترتدي المرأة زي الرجل، فلا تفرقها عنه.. أما إذا لبست المرأة أزياءها العصرية فحدِّث عن التهتك وعدم الحشمة ولا حرج.. فقد ترتدي هذا اللباس الضيق لإبراز مفاتنها، أو هذا اللباس القصير الذي يظهر معظم عوراتها وكأنها تستصرخ في الرجل تعمّدَ النظر إليها وإثارة الشهوة تجاهها.. إلى ما هنالك من مظاهر، وكأنما الاستهتار بكيان المرأة وحرمتها بات سمة العصر..
لذلك يرفض الإسلام مثل هذه المظاهر ويحرِّمها. وهو يشدد على المرأة بضرورة ارتداء اللباس الذي يميزها عن الرجل، ويظهرها بالمظهر الذي يليق بكرامتها من الحشمة والأدب، ويجعل قدرها مرفوعاً في المجتمع.. ولعلَّ في مقارنة بسيطة بين امرأة متبذلة، أو متهاونة في لباسها، وبين أخرى محتشمة، أو محافظة على هندامها، ما يفرض على كل رأي حصيف، وعلى كل مؤمن ملتزم، أن ينظر إلى الثانية نظرة مختلفة ملؤها التقدير والاحترام..
واللباس هو غير الحجاب. فالحجاب هو ما يُستر به بدنُ المرأة كله، بما في ذلك الوجه والكفّان، وهو خاص بنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)، اللواتي فرض الله تعالى عليهنّ، من عليائه، في سورة الأحزاب، أن يَقرْنَ في بيوتهن، وأن يحتجبن عن الظهور، فلا يخاطبن أحداً إلا من وراء حجاب. فكان هذا الاحتجاب وكذلك الحجاب، من خصوصيات نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) دون غيرهن من النساء.
لذلك بات من الواجب أن يُعرف بأن الحجاب هو المقصود فيه ستر جميع البدن بما في ذلك الوجه واليدان. وهذا غير مطلوب من النساء المسلمات. إذ المطلوب منهنَّ شرعاً هو ارتداء اللباس، ويمكن أن يأخذ هذا اللباس طابعاً شرعياً، ويسمى اللباس الشرعي إذا كان يستر كامل بدن المرأة ولا يظهر شيئاً من زينتها ما عدا وجهها وكفيها.
وهذا اللباس الذي يستر البدن دون الوجه والكفين، جاء النص به عاماً لكل النساء المسلمات، قال تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النُّور: 31]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} [الأحزَاب: 59].
ومن يتأمل في لفظتي: {بِخُمُرِهِنَّ} [النُّور: 31] و{جَلاَبِيبِهِنَّ} [الأحزَاب: 59] يعرف أنهما تدلان على الثوب الفضفاض الذي يجب أن تلبسه المرأة المسلمة، والذي يجب أن يكون مرسلاً من فوق الرأس وحتى القدمين. وهذا هو اللباس أو الرداء الذي يستر بدن المرأة فلا يظهر منه شيء من زينتها (أي مفاتنها أو عوراتها). وليس في الآية الكريمة، ولا في أي نص آخر، أو في السنة الشريفة ما يدل على أن هذا الرداء يشمل أيضاً الوجه والكفين. بل على العكس إن ما ورد في صحيح السنة، وهو ما يبيِّن ويوضح أحكام الكتاب، يؤكد أن «الجلباب» أو «الخمار» إنما يعني فقط الثوب وليس الحجاب، فيكون لكل البدن دون الوجه والكفين. وقد ثبت أن النساء أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كن يكشفن عن وجوههن وأكفهنَّ في حضرته دون أن ينكر عليهن ذلك. كما أن المرأة المسلمة مدعوة لمشاطرة الرجل الحياة العامة. ولذا هي بحاجة إلى استعمال كفَّيها، وإلى عدم تغطية وجهها، لما لذلك من تأثير على الأعمال التي تقوم بها، والتي يجب طبعاً أن تراعي فيها تقوى الله تعالى، وحرمتها كامرأة، دون أن تتخلى عن دورها في المجتمع، كلما كان بحاجة إلى عملها.
والنساء المسلمات قد مارسنَ أعمالاً كثيرة أيام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)، فكن يشاركن معه في الغزوات، ويتاجرن في الأسواق، ويساعدن أزواجهن في العمل، إلى ما هنالك من أمورٍ كانت تفرض على المرأة مشاركة الرجل في الحياة العامة.
والمجتمع الإسلامي بحاجة إلى أن تلتزم المرأة باللباس الشرعي لأمرين أساسيين:
الأول: التمايز بين الجنسين في الذكورة والأنوثة، بحيث تعرف المرأة من لباسها، فلا تتعرض للأذى من أي نوع كان، طالما أنها تحافظ على شرفها وكرامتها، وتصون كيانها.
والثاني: استقرار المجتمع، عندما يقسِّم الحيّز بالنسبة للحجاب إلى عالمين: عالم الداخل، ويقصد به المنزل والدار وهو الحيِّز الخصوصي أي الذي يختص بالرجل وزوجته فقط وعلاقة أحدهما بالآخر، وعالم الخارج ويقصد به السوق والظهور بين الناس، وهو الحيز العمومي الذي يرتاده الناس جميعاً نساءً ورجالاً.
يضاف إلى ذلك أن ارتداء اللباس وما فيه من حشمة هو سمة الإنسان المتحضِّر، المتميز عن المخلوقات الأخرى، كما يثبت قول الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ *} [الأعرَاف: 26]. فهو يشمل لباس الرجل والمرأة على السواء، وفيه ضمان لإخفاء العورة، وستر البدن، واحترام الذات، وصون الكرامة. فهل نترك ذلك كله ونُقبل على التعرّي، ونبتعد عن الناحية الجمالية والإنسانية التي أرادنا الله سبحانه وتعالى عليها؟
ثُمَّ، أليست المرأة أولى من الرجل بالمحافظة على هذه الناحية الجمالية والأدبية في حياتها حتى لا تكون عورة مكشوفة للرجال، إن في داخل بيتها، وإن في الأسواق والمتاجر والطرقات.. وأين، من هذه الناحية الإنسانية والجمالية، ما يشهده هذا العالم اليوم من عُرْي على شواطئ البحار، وفي النوادي والحفلات، حيث تتزيّن نساء هذا العصر لإبراز مفاتنهن وكأنهن يعرضن أجسادهنَّ سلعةً على الرجالِ، دون أيِّ وازعٍ دينيٍّ أو أخلاقيٍّ أو إنسانيّ؟..
هذا ما يأباه الإسلام على أهله، ويحول دون انتشاره في المجتمع النظيف.
ولذلك فرض الله تعالى على النساء المسلمات لباساً أوجب عليهن التقيد به. كما فرض على نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) حجاباً خاصاً بهن لأنهن لسنَ كغيرهن من النساء فهنَّ أمهات المؤمنين. ومن هنا كان رأينا بأن على المرأة المسلمة أن ترتدي اللباس الذي يغطي كل أجزاء بدنها، ولا يبرز شيئاً من أعضائها، دون أن تستر وجهها وكفيها، وعليها أن تخرج في هذا اللباس إلى ميدان الحياة لمشاركة الرجل في كل ما يهم شؤونها وشؤونه، وشؤون المجتمع الذي يعيشان فيه.
السـحر والتنجيم
السحر، في اللغة، معناه الصرف. يقال: سَحَرَه أي أبعده وصرفه عن هذا الشيء أو ذاك. وليس السحر من الأشياء الواقعية بل هو مجرد نوع من التضليل أو الإيهام أو التخيّل، يقوم به أشخاص يسمون بالسحرة، ويراد به الصرف عن الحقيقة والواقع. وإنّ من يمارس تلك الأساليب من التضليل يتمتع عادة بقدرة قوية في التأثير والسيطرة على الناس، حتى ليخيّل إلى الرائي بأن ما يقوم به الساحر هو شيء حقيقي.
ويسود الظّن لدى كثيرٍ من الناس بأنَّ من يملكون القدرة في التأثير على الناس، والذين يقولون عن أنفسهم بأنهم سحرة، يتوهمون بأنهم ذوو شأن عظيم، ويستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون. وهذا غير صحيح على الإطلاق إذ لو كان من يدَّعون السحر قادرين فعلاً على إتيان المعجزات بسحرهم، وخرق النواميس التي خلقها الله تعالى، لأمكنهم أن يكونوا أكبر الأغنياء في العالم، وأكثر الناس سلطة وقوة ونفوذاً، بينما نراهم بأمِّ العين فقراء مدقعين، لا يملكون شيئاً بل هم يكسبون لقمة عيشهم بألاعيبهم وشعوذتهم. أوليس في هذه الحقيقة ما يؤكد أن السحرة هم مجرد مخادعين، مضللين، لا يقدرون على شيء سوى التضليل والإيهام؟..
ولقد ظهر في أيامنا هذه ما هو أدهى من ادعاء السحر، وهو ما نشهده في الغرب المتمدن المتحضّر، حيث بدأت تسيطر على عقول رعاياه ظاهرة ادعاء استحضار الأرواح، كما هو ظاهر في الأفلام والبرامج التلفزيونية، التي تدل على واقع تلك البلدان، وتأثر الناس بهذه الظاهرة الجديدة، التي تُنشأُ لها معاهد ومؤسسات، وتُقامُ لها جلسات وحلقات حيث يحضر «الوسيط» الذي يتصل بأرواح الأموات كما يدَّعون، ويحادثها بما يرغب به الأقرباء والأحباء. وهذا الاتصال في الحقيقة خداع بخداع، ولا أساس له من الصحة!..
كما أن العالم كله، في الشرق والغرب، ينساق اليوم وراء التنجيم أو علم الأبراج الذي يتوالى ظهور المؤلفات حوله، وتخصص له البرامج في الإذاعات والتلفزيونات. وهو يدور حول التنبؤ بأحوال الناس، وما سوف يكونون عليه أو ما قد يحصل لهم، بما يوحي بأن من يدَّعون هذا العلم كأنهم يعلمون الغيب. وهو كفر صراح في الإسلام لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، عالم الغيب في السماوات والأرض، وهو - سبحانه - لم يعط عِلمه في الغيب لأحدٍ من خلقه، حتى لرسوله وحبيبه وخيرة خلقه، فقد قال له في سورة الأعراف: {قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ} [الأعرَاف: 188]. بل جلُّ ما اختصَّ به بعض عباده الصالحين نوعٌ من الوحي أو الإلهام في أمور معينة، ولحكمة يشاؤها العزيز الحكيم..
هذا مع الإشارة إلى أن علم الأبراج أو التنجيم هو غير علم الفلك تماماً، إذ إنَّ علمَ الفلك علمٌ قديمٌ ومتطورٌ على مر العصور، وهو علم قائم بذاته. وقد قدَّم ولا يزال يقدم للبشرية خدمات جلَّى، وبواسطته استطاع الإنسان غزو الفضاء، والوصول إلى القمر. وما يزال هذا العلم مستمراً في التَّقدُّمِ، وسوف يحقق معارف جديدةً وكبيرةً في مقبل الأيام.
مما تقدم يتبين لنا أن السحر والتنجيم هما من الأمور القديمة التي ابتكرتها عقول شيطانية. وكانت تسود في الأوساط والمجتمعات التي تبعد عن الدين، وعن التعبّد للخالق العظيم. وأما سرُّ انتشارها فلأن الإنسان شغوف بمعرفة المستقبل. فكلما انحرف أو ضعف إيمانه بخالقه الواحد الأحد لجأ إلى السحر والتنجيم، وأحياناً للتبصير بالحصى أو الرمل، أو بورق «الشدّة» أو بالكف أو بفنجان القهوة بعد شربها، كشفاً لما ينتظره في المستقبل. والمؤمن يعلم علم اليقين أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فيسلِّم أمره إليه ويتوكل عليه حق التوكل.
وحقيقة الأمر في الماضي والحاضر أن تأثير هذه الأمور مجتمعة كان دائماً أقوى وأفعل في أوساط الكفار والمجوس وأهل الوثنية والشرك الذين كانوا يعبدون الأصنام، أو الكواكب والنجوم، أو النار والشجر وغيرها من الأوثان التي لا تنفع ولا تضر. أما لماذا هذا التأثير على الناس؟ ولماذا يدهشون لأعمال السحرة؟ فالجواب هو أنّ حواسهم تُخدع من جراء تلك المهارة الفائقة التي يمارسها السحرة، وتنصرف أذهانهم إلى التخيُّل الذي يُسيطر عليها. مع ما يسبق ذلك من الظن بأن الساحر إنما يستعين بقوى خفية يسخّرها لخدمته، ويجعلها خاضعة لإرادته، قادرة على اجتراح المعجزات.. بينما في الحقيقة ليس هنالك سوى أساليب من الشعوذة والتمويه، والإيهام والتخيل لا تتصل بالواقع ولا بالحقيقة بأي صلة على الإطلاق. مما يعني أن السحر هو كذب بكذب، وأنه لا يمكن لسحر أو لساحر أن يغيّر من طبيعة أي شيء، أو من خاصيّة أي شيء التي فطره الله تعالى عليها.
والدليل واضح في القرآن الكريم، فعندما جمع فرعون السحرة من جميع أنحاء مصر، وألقوا أمام الملأ حبالهم وعصيّهم ظن الناسُ أنها أفاعٍ تسعى بل وخيّل لموسى نفسه (عليه السلام) كذلك، ولكن إلى برهة وجيزة، فألقى موسى (عليه السلام) عصاه التي تحولت إلى حيةٍ حقيقيةٍ تسعى وتلقف كل ما صنعوا. فهنا تدخّلَ أمر الله - العلي القدير - وحوَّلَ العصا إلى أفعى تبتلع كل تلك العصي والحبال. وبعد أن ظهرت المعجزة الإلهية على يد موسى (عليه السلام)، أعاد الله تعالى عصاه إلى سابق عهدها من الخشب. وهذا ما جعل السحرة يؤمنون على الفور برب موسى، ويتخلّون عن السحر، ويعصون أوامر فرعون..
أما الخدعة التي استعملها السحرة في ذلك اليوم فهي أنهم استعملوا مادة الزئبق في طلي الحبال والعصي - كما يقول المفسرون - أو ربما صنعوا عصياً وحبالاً شفافة وأدخلوا فيها مادة الزئبق، حتى إذا نشروها جرى تمدد الزئبق بفعل حرارة الشمس، وصار يتحرك تحت تأثير هذه الحرارة، فخيل للناظرين أن تلك العصي والحبال - التي ربما يكونون قد صنعوها على شكل الأفاعي أيضاً - أنها حيات تسعى. وهكذا تمت الحيلة على أعين الناس. ولكن الله عزَّ وجلََّّ نصر نبيه موسى (عليه السلام) عندما أودع في عصاه الجامدة حياةً وحوَّلها إلى أفعى حقيقيّةٍ تلقف حبالهم، وتلقفُ كل ما أتَوْا به من تزويرٍ وخداعٍ وتضليل..
ويؤكد القرآن الكريم بطلان السحر وعدم فعاليته، وبأنه صرف عن الحقيقة ليس إلاَّ، بقول الله تعالى: {فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ} [الأعرَاف: 116] أي خدعوها وصرفوها عن الواقع المحسوس، وقوله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى *} [طه: 66]، أي من قوة تضليلهم وتمويههم وقدرتهم على التأثير على أعين الناس جعلوا الرائي يتوهم ويرى غير الحقيقة والواقع..
وليس أدلّ على كذب الساحر أيضاً من عجزه عن تحويل أي شيء عما خلقه الله تعالى عليه. فهل رأيت ساحراً يوماً يسلب النار خاصية الإحراق، أو يسلب السكين أو السيف قوة القطع، أو يحوِّل فأراً إلى هر، أو أرنباً إلى سلحفاة، أو حمامة إلى عصفور.. من الطبيعي القول بأنه لا يقدر على شيء من ذلك أبداً. إذاً فكيف يمكنه أن يجترحَ المعجزات، ويصنعَ العجائب؟ بل كيف يمكنه أن يغير مجرى حياة إنسان، أو يعرف مستقبل أيامه؟... والحقيقة أنّ كل ما يحصل في حياة الإنسان، منوط بمشيئة الله عزَّ وجلَّ، وبفعل الإنسان نفسه واختياره، أو بما يدبّره له غيره من الناس، ولكن بعيداً عن الخوارق والمعجزات!..
نعم قد نرى الساحر يطيِّر كثيراً من الحمام ولا نعرفُ من أين أتى به، وهو في الحقيقة يكون قد خبأه بطريقة فنية، أو قد نراه يضع في صندوق فتاةً جميلة، ويُحكم عليها إغلاقه من جميع جوانبه، ثم يأتي بالسيوف الحادة القاطعة فيدخلها في الصندوق حتى ليظن المشاهد بأن الحسناء قد تمزقت إرباً إرباً.. فإذا فتح الصندوق ظهرت سليمة لم تُصبْ بأذى. إنها أيضاً لعبة من ألاعيب الساحر وخداعه، حيث يكون قد حبس الفتاة في ناحية من الصندوق لا تصل إليها سيوفه، ولكنه بمهارته، وقدرته على التمويه، وخفة حركته التي تمرَّن عليها، يجعلنا نشاهد ما نشاهد، ونعجب مما نرى من فعاله..
وخلاصة القول: إن السحر، أياً كانت الأشكال التي يمارس فيها، لا يعدو كونه مجرد أساليب يستخدمها أشخاص قد تمرنوا على خفة الحركة، وعلى القدرة في السيطرة، وتحويل الحواس عن الواقع إلى نوع من التخيّل والتصوّر غير الحقيقي والواقعي. ولذلك كان السحر تضليلاً، وكان محرماً تعاطيه وممارسته. وإن من يدّعي السحر يكون مذموماً ومأثوماً لأنه يأتي بأفعال الكذب والتمويه والخداع، وهي تزوير للحقيقة والواقع، وافتراء على الناس، من شأنها الإضرار بهم. ويكفي أن تخدع حواسهم وعقولهم لفترة من الزمن، حتى تكون شراً وضرراً.
وما قلنا بشأن السحر، ينطبق أيضاً على التنجيم، وهو كما أشرنا إليه ادّعاء بعض الأشخاص أنهم يستطيعون معرفة مدى تأثير الأبراج على حياة الإنسان من خلال معرفة اليوم والشهر اللذين ولد فيهما. وهذا محض افتراء لا أساس له من الصحة. وقد جاء في مقالة مشهورة: «كذب المنجمون ولو صدقوا». كما أن الإمام عليًّا (عليه السلام) يحذِّر منه، في نهج البلاغة، ويقول: «أيها الناس، إياكم وتعلَّمَ النجوم إلا ما يهتدى به في برٍّ أو بحرٍ، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار».
نعم يمكن مراقبة بعض النجوم والاهتداء بها إلى الجهات، وإلى أوقات معينةٍ من الليل، وهذا دليل على الذكاء والمعرفة. وكان لكثيرٍ من العلماء شأن كبير في هذا المجال، وذلك قبل اختراع الآلات الحديثة، والاهتداء بها في البر والبحر.. ولكنَّ معرفة النجوم هي غير التنجيم الذي هو ادعاء بمعرفة تأثير النجوم والأبراج على مستقبل حياة الناس. ولذلك كان تعاطي التنجيم محرماً في الإسلام. بل إنه ليصل إلى حدِّ الكفر عندما يزعم المنجم أنه يعلم الغيب، ويدعي أنه يكشف عن المستقبل. والغيب من العلوم التي اختصَّ بها الله - سبحانه - نفسه ولا يعلمه سواه.
وهكذا كل أمرٍ أو شيءٍ مستجدٍّ يجب أن نعرف حكم الله العلي الحكيم فيه، وأن ننظر إليه على هدى الشرع الحنفيف.
وعليه فقد باتت واضحةً طريقتنا في بحث المسائل التي عالجناها، كالتصوير وغيره، من خلال الطريقة العملية للاجتهاد، أي أننا فهمنا الدليل أولاً من الكتاب والسنة وطبقناه على الواقع، ثم فهمنا هذا الواقع، وطبقنا عليه الدليل. فتبيّن لنا أولاً واقع التصوير بصورة جليّة، ثم استنطقنا الكتاب والسنة لنرى ما ورد فيهما حول هذا الأمر، أو هذا الشيء أو المسألة وبين ما ورد بشأنها في الكتاب والسنة. ثم ربطنا بين واقع الشيء أو الحدث أو المسألة وبين ما ورد بشأنها في الكتاب والسنة. حتى ترجَّح عندنا، ونتيجة لغلبة ظننا، بأن هذا هو حكم الله تعالى في هذا الشيء أو في هذه المسألة. فإن كنا قد أصبنا كان لنا أجران، وإن كنا قد أخطأنا كان لنا أجر واحد. وحسبُنا أننا بذلنا ما في وسعنا ولم نعد قادرين على أن نقدِّم أكثر من ذلك. والتوفيقُ، أولاً وأخيراً، لا يكون إلاَّ من عند الله العليم الحكيم.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢