نبذة عن حياة الكاتب
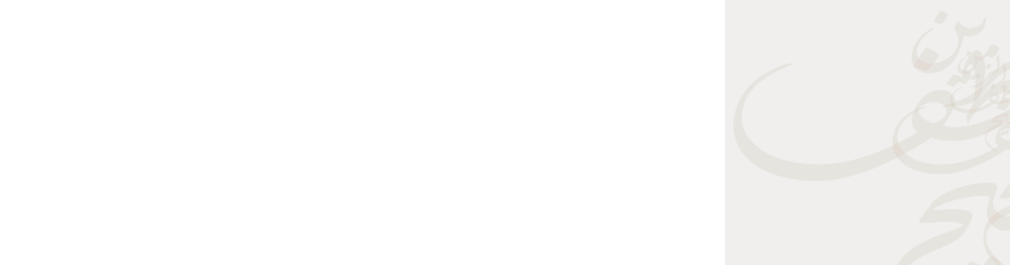
X
معجم الأمثال في القرآن الكريم
الخاتمة
من المأثور في تربيتنا الإيمانية أنَّ المسلمَ يُسأل مرتين: مرة في قبره، ومرةً يوم الحساب، عمَّا كان يؤمن به في الحياة الدنيا، فيجيب المؤمنُ الصادقُ، وبدون أدنى تردُّدٍ:
اللّهُ ربي. والإسلامُ ديني، والقرآنُ كتابي، ومحمدٌ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) نبيِّي، والكعبة قِبلتي..
وأشهد أنَّ الجنةَ حقٌّ، والنارَ حقٌّ، وأنَّ الساعةَ آتيةُ لا ريبَ فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، وإليه النشور.
وحَسُنَ، واللهِ، قولاً يصدِّق به اللسانُ ما انعقد عليه القلب.. وهذه الشهادة من المؤمن تختصر عمره كله في الحياة الدنيا؛ فقد أرادَ الله تعالى به خيراً، فقام على طاعته، وطاعة رسوله الكريم، وأتى من الحسنات والأعمال الصالحات ما يلقى به ربَّهُ الكريم آمناً مطمئناً، وذلك بفضل رحمته التي حفَّت به، فأدخلته في الصالحين، الذين يرجعون إلى ربّهم بنفوس مطمئنةٍ راضيةٍ، مصداقاً لقوله تعالى: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً *فَادْخُلِي فِي عِبَادِي *وَادْخُلِي جَنَّتِي *} [الفَجر: 27-30].
ومثل هذه التربية الإيمانية هي ما تتوخى الأمثال في القرآن الكريم تعليمنا إيَّاها، حتى يمكن أن نستوعبَ القضايا الأخرى التي تتناولها هذه الأمثال، نظراً لما تزخر به من المفاهيم، والتعاليم، والعظات والمثل العليا؛ وما تحفل به من الأدلة، والشواهد والبراهين التي تغطي مساحات واسعة مما يحيط بالإنسان والحياة والكون من الحقائق، والسنن التي أنشأها العليّ القدير ليقوم عليها الوجود بأسره.
ويشرّفنا أنْ نختم كتابنا هذا بتناول أمرين اثنين:
أ - المثل عن محمد رسول الله وصحابته الكرام؛ وما اختص به ربُّ العالمين نساءَ هذا النبيّ الأعظم من ميزة جعلتهنَّ لسن كـأحد من النساء، إنْ قامت حياتهنّ على التقوى التي تليق بانتمائهنّ إلى بيتٍ له خصوصية النبوَّة، وهي التي جعلتهنَّ أمهات المؤمنين.
ب - بيان أهمية الإيمان بالإسلام، فإنْ آمن الناس بـمثل ما آمن به أهل هذا الدين فقد اهتدوا، لأنه دين الله، وهو صبغة الله فيما شاءَ سبحانه وتعالى لعباده من الصلاح والفلاح، حيث أكمل لهم دينهم، وأتمَّ عليهم نعمته، بما أنزل على النبيِّ الهادي من قرآن مجيد، فلا يحتاج أهل الأرض إلى غيره إنْ راموا الهداية، والسير على نهج الإسلام، كما أراد لهم ذلك ربُّهم العزيز الحكيم.
والأمثال الكريمة، حول هذين الأمرين، والتي هي حسن الختام، قد هدانا ربُّنا تبارك وتعالى إليها في ثلاثة أمثال..
1 - مَثَلُ صفاتٍ محمدٍ رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وأصحابه: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
يقول الله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا *} [الفَتْح: 29].
في هذه الآية المباركة بيان لبعض من صفات محمد رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وصفات أصحابه الكرام، وردت بهذه الصورة الوضيئة، وبهذا الثناء الجميل على الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي الله تعالى عنها، وبلَّغها رضاه المبين بقوله العزيز: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *} [التّوبَة: 100].
وقد ورد في سورة «الفتح» النصُّ على اسم النبيّ «محمّدٍ» (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ليزيل كل شبهة بشأنه، فقال الحقُّ تبارك وتعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} [الفَتْح: 29]، كما ورد كذلك في السورة الكريمة التي سمّيت باسمه (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ *} [محَمَّد: 2].. فلا شبهة بعد، ولا شك، ولا مرية، والله تعالى يشهد بأنَّ محمداً رسول الله، وبأنْ ما نزَّل على محمّدٍ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) هو الحق من ربِّ المؤمنين، وربّ العالمين.. ثم إنَّ الرسولية، وهي بعث إنسانٍ لحملِ رسالة الله العلي العظيم إلى دنيا الناس، ليست شأناً بشرياً، بل شأنٌ إلهيٌّ، هو منتهى ما يطمح إليه أحدٌ من البشر، عرف ربَّهُ تعالى بالفطرة، فتهيَّأت نفسُهُ وجوارحُهُ للالتزام بميثاق الإيمان الذي أخذه الله جلَّ وعلا على بني آدم، وهم في عالم الذرّ، حتى إذا شاءَ الله وجاء أمره سبحانه، بعثَ هذا الإنسان من بني البشر، دون غيره، نبيّاً رسولاً، ليتلقَّى التكليف بإبلاغ رسالة الله إلى أهل الأرض.. فالرسالة، إذاً، فيها اصطفاءٌ وانتقاءٌ، وامتيازٌ، وفيها عهدةٌ إلى مَن قدَّر له ربُهُ الحكيم تحملَ عبء الأمانة، والقيام بما يفرضه التكليف.. وهي مزية فريدة لقلّةٍ قليلةٍ من البشر، يحمل المختار منهم وسام الرضى والرحمة، وشرف الرفعة والسموّ، لينعم، من ثمَّ - هذا الذي اختاره الله بشراً رسولاَ - بالعطاء الجزيل، والفضل العظيم من ربّ العالمين.. والرسولية بأصولها، ومقاصدها ومصاديقها ليس معنًى مجرَّداً يمكن أنْ يضاف إلى سماتِ بشرٍ معين، بل هي تفاعل حيويٌّ لقيادة البشرية إلى خيرها وصلاحها، وإلى انعتاقها الفكري، وأمنها النفسي، بما تتلقى من نور الحقّ الذي تحمله الرسالة، فتطهر قلوبُها.. ويصفو وجدانُها.. وهذا كله مدعاةٌ لأن يجلبَ لها الطمأنينة والسعادة.. فالرسالة السماوية، وبهذه المعاني، هي الجوهر لروح حركة هذا التفاعل الزاخر مع الحياة، والمنهاج الصادق لإصلاح الحياة، والتطلع المستبصر إلى ما بعد هذه الحياة.. فصلوات الله وسلامه على من بعث من عباده أنبياءً، ورسلَ هداية..
وإذا كان الله عزَّ وجلَّ يقول: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} [الفَتْح: 29] فحريٌّ بالناس أنْ يدركوا قدسية هذا الرسول عند ربه الكريم، الذي لا إلهَ إلاَّ هو إلهٌ واحدٌ في السماوات والأرض، فلا إلهَ غيره، ولا معبود - في الكون - إلاَّ إيَّاهُ، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير.. فإذا كان الوحيُ من الله قد أذن بأنَّ محمّداً رسولُ الله وقد خاطبه سبحانه من عليائه بقوله الكريم: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ *} [القَلَم: 4]، فذلك ليكون في علم أهل الأرض، وفي علم أهل السماء، أنَّ أهمَّ سبيل للإيمان بـالله تعالى، والعمل بهدى الله، إنّما هو التصديق بنبوة ورسالة محمَّد (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) .. الأمر الذي يستدعي من الذين عاشوا في زمانه الالتفاف حوله، ونصرته في نشر الإسلام، كما يستدعي من الأجيال اللاحقة، بل ومن كل الناس الذين يأتون إلى هذه الدنيا، وحتى قيام الساعة، الإيمانَ بما أُنزل على محمّد (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وهو الحق من ربّه، امتثالاً لقوله تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون } [الأعرَاف: 156-157].. ومن يبتغِ غيرَ دين محمَّدٍ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ، وهو الإسلام الذي يحمل الرسالة السماوية الخاتمة، والشرعةَ والمنهاجَ الكاملين، فلن يقبل منه، لأنه دين الله الحق؛ مصداقاً لقوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عِمرَان: 19]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ *} [آل عِمرَان: 85].
ولأنَّ التكليف الذي يحمل أعباءَ الرسالة السماوية الخاتمة له شأنٌ عظيمٌ عند الله تعالى، ولأنه سبحانه قد اختار لهذا التكليف محمد ابن عبد الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) بالذات، فكان من الرحمة الربانية بالناس أن يوجّه آيُ الذكر الحكيم عنايتهم كي يتبيَّنوا بعض صفات حامل هذه الرسالة، وبعض صفات الذين آمنوا به وصدقوه، كما يهدي إليها قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً} [الفَتْح: 29].
أما عن محمّدٍ رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) فيكفي في الدلالة على صفاته، ما أكرمَهُ ربُّهُ تعالى به عندما قال له: «وإنك لعلي خلقٍ عظيمٍ». وأما عن صفات أصحابه الكرام فقد قيل إنه بلغ من تشدّد أولئك الصحابة الأبرار، أنهم كانوا يتحرَّزون من ثياب الكفار والمشركين حتى لا تَمَسَّ ثيابهم، بينما بلغ من تراحمهم فيما بينهم، أنه كان لا يَرى مؤمنٌ مؤمناً إلاَّ صافحه، ثم تودَّد إليه وتواضع له، حتى لتحسبه ذليلاً بين يديه.. في حين إذا صادف كافراً رأيته يشمخ بأنفه عنه، ويترفَّع عن مجالسته ومحاكاته في شيءٍ من قول أو فعل!.. فكان أولئك المؤمنون كما قال عنهم ربّهم تبارك وتعالى: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المَائدة: 54]. أولئك أصحاب «محمّد» (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ، الذين رافقوه في معترك إبلاغ الدعوة، والذين حملوا لواءها منذ بُعث هذا الرسول الكريم.. وكذلك الذين سيظلون يعملون على نشر الإسلام إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.. ذلك أنَّ من اتَّبع الإِسلام، واعتنق تعاليمه قولاً وعملاً، بنيةٍ خالصة، ومن عامَلَ الناس بأخلاق الإِسلام، وقام بتربية الأفراد والجماعات على أسس إسلامية، هو مع محمّدٍ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، مهما ابتعد زمانه عنه، أو امتدت به العصور..
فإذا كنت - أيها الإنسان المسلم - تريد أنْ تكون من أصحاب «محمّدٍ» (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) فأمامك القرآنُ الكريم والسنة النبوية الشريفة، فاتَّبعهما واعمل بوحيهما وهديهما، لتتمَّ صحابتك مع رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم).. ويا لها من صحبة سوف تتلقَّى آثارها ومفاعيلها وأنت تقف بين يدي الله الواحد القهار، يوم الدين، وقد استقبلك رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) يرحِّب بلقياك صحابيّاً مؤمناً، محتسباً، عاملاً، أحببت الله ورسوله، فأحبك اللَّهُ ورسولُه!.
والتراحم بين صحابة محمّد (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) هو تقارب بين القلوب والأفكار، وهو تعاون على البر والتقوى، وابتعاد عن الإِثم والعدوان؛ كما أنه التفاعل الدائم بين المسلمين على أساس الإِسلام، فلا تنابذ، ولا تناحر، ولا تقاتل، ولا عصبية مذهبية ولا طائفية.. بل توجه إسلاميّ صرف، ودعوة خالصة إلى الله ورسوله.. فهل نحن، اليوم، مسلمونَ رحماءُ، حتى نفكّر بأنْ نكون أشدّاء على الكفار، رحماءَ بين بعضنا البعض؟!
ومن صفات الذين كانوا من صحابة محمّد (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، أنك {تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً} [الفَتْح: 29]، فهم بصلاتهم: راكعون ساجدون، يلتمسون زيادة النعمة من رضى الله تعالى.. وليس أعظم وأجل من رضى الله على عبدٍ من عباده، لأنَّ من نال هذا الرضى فقد فاز في الدارين...
ومن صفاتهم كذلك أنَّ {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفَتْح: 29] فهذه العلامة التي تظهر في وجوههم، أو على جباههم، هي من كثرة السجود، حيث ترى الوضاءة والإِشراق والنورانية تكاد تشع من تلك الوجوه المؤمنة. وقد اختار لفظ {السُّجُودِ} [الفَتْح: 29] لأنه يمثّل حالة الخشوع والخضوع والعبودية لله تعالى في أكمل صورها. فكان أثر هذا الخشوع في الجبهة، أو في ملامح الوجه حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء، والتعالي والغطرسة، ويحل مكانها التواضع النبيل، الذي يزيد المؤمن لُطفاً، وكياسةً ورحمةً. وهذه الصورة ليست مستحدثة، بل هي ثابتة لهم في لوحة القدر؛ ومن ثم فهي قديمة، جاء ذكرها في التوراة: {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ} [الفَتْح: 29] لتعبِّر عن صفتهم التي عرّفهم الله تعالى بها في الكتاب الذي أنزل على النبيّ موسى (عليه السّلام)، ومن ثم أعيد ذكرها في الكتاب الذي أنزله على النبيّ عيسى ابن مريم (عليها السّلام) {وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ} [الفَتْح: 29]، وخاصة فيما حمل هذان الكتابان - التوارة والإنجيل - من البشارة بـالنبيّ الأميّ العربي، حتى يكون التطابق والتكامل لصفات صحابة أولئك الرسل، متطابقاً في الرسالات السماوية الثلاث - التي أنزلت في التوارة والإنجيل والقرآن - فيقتدي بهم المؤمنون الصادقون، الذين هم في الحقيقة، يعتبرون أنصار الله على مدى الزمان...
أما مثل «محمّدٍ» (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وأصحابه - وبتلك الأوصاف التي وردت في الكتب السماوية الثلاثة - فهو في التشبيه القرآني {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ} [الفَتْح: 29]، فهو زرعٌ نامٍ قويٌّ، يخرج فرخه نضراً من قوته وخصوبته. وهذا الفرخ لا يُضعف العود بل يشده، فيؤازره، مثلـما أنَّ العود يؤازر فرخه ويشده ليستغلظ الزرع، وترتفع ساقه وتمتليء، ثم ليستويَ على سوقه، لا عوج فيه ولا انحناء، بل استقامة وامتلاء.. فهذه صورة الزرع المبارك، أما وقعه في نفوس أهل الخبرة من الزرّاع، العارفين بالنامي منه والذابل، المثمر منه والبائر، فهو وقع البهجة والإِعجاب {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ} [الفَتْح: 29]. وأما صاحب هذا الزرع النامي المخصب البهيج فهو رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) الذي اعتمد أسلوبَ التثقيف بتحفيظ الآيات التي تُنَزَّل عليه، وتبيان معانيها للمسلمين الأوائل، الذين انضووا في كنف الإسلام، فحق لأولئك الأبرار، وهم معه منذ فجر الدعوة، أن يكونوا صحابته الكرام، وأنْ يسيروا على نهجه، حيث بدأوا في قلة وضعف، ثم كثروا وقووا على أحسن الوجوه، فكان وقع فعالهم يثير الغيظ، والكمد والحقد في نفوس الكفار.. وتعمُّد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة الله، وزرعة رسوله، فكان حريًّا أن تكون هذه الزرعة أتباعَ محمّد (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، الذين جعلهم الله تعالى أداةً لإِغاظة أعدائه. وهكذا يثبت الله العليم الحكيم في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة، صحابة رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، التي تنبت في صلب الوجود كله، وتتجاوب معها أرجاؤه بالنفحة العلوية التي تجعل الخلائق تعي فعالَ أولئك الأخيار من البشر الذين آمنوا بالله رباً عزيزاً مقتدراً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّدٍ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) خاتماً للنبيين، وسيداً للمرسلين.. ليكونوا، من ثمَّ النموذجَ، والمثال للأجيال البشرية من بعدهم، فتقبل على الإِيمان الصادق بربّ هذا الوجود، وعلى العمل في سعيها للإصلاح والصلاح في حياة الناس.. لقد كرَّمهم العليُّ العظيم بما وصفهم به في كتابه المبين، تشريفاً لـرسوله الكريم، وزادهم فضلاً ورحمةً بما وعدهم من المغفرة والأجر العظيم {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا *} [الفَتْح: 29].. وهذا الأجر العظيم هو الجنة التي هي وعدٌ من الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدخلونها بمغفرة من الله ورحمة، وحسن أولئك رفيقاً مع النبيين والصدّيقين، مصداقاً لقوله تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ *} [النّحل: 31].. أجل، وكما وعد الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن تكون لهم مغفرة وأجرٌ عظيمٌ بدخول جنات عدنٍ، {كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ *} [النّحل: 31] مثل جزائهم.
وهكذا يكون القرآن الكريم قد أعادَ المثلَ الذي ضربَهُ اللَّهُ تعالى في التوراة، وفي الإِنجيل، لتنطبق أوصافه على محمّدٍ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وأصحابه.. فالزرع هو محمّد (عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام)، والشَّطْءُ (أي ما يفرّخ هذا الزرع) هم أهل بيته، والصحابة، والمؤمنون الذين عملوا الصالحات.. وعادة ما يكون أول الزرع دقيقاً، ثم يغلظ ويقوى ويتلاحم، فالمؤمنون، وجميع من كان حول رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، في أول الأمر، كانوا يتلقَّون الأذى والعذاب، ولكن لم يهنوا في إسلامهم، ولم يضعفوا في نفوسهم، وبفعل إيمانهم القويّ، راح عددهم يتكاثر، مع الوقت، وبدأت قوتهم تتماسك، حتى استووا على أمرهم، فاستغلظوا، وصاروا تلك الجماعة المتلاحمة المتراصة، التي يشد بعضها أزر بعض كـالبنيان المرصوص، والتي أغاظت الكفار والمشركين، وأربكتهم بما وصلت إليه من وحدة إسلامية متماسكة، ذات منعةٍ وشدة، بحيث لم يعد العدو قادراً على قهرها والقضاء عليها، كما كان يأمل، ويتمنَّى!..
وبالفعل فإنَّ الجماعة الإسلامية لم تبلغ ما بلغت إلاَّ بعد عناء طويل، ومشاق مريرة وصعاب لا تحصى. وكان الهمُّ الأكبر يقع على عاتق الرسول، لأنه هو صاحب الرسالة، وحامل الدعوة، ولأنَّ أمر المؤمنين من مسؤوليته، ولذلك كانت دعوةُ ربّه تعالى إليه أن يصبر، ويتحمل مهما كابد وعانى، مصداقاً لقوله تبارك وتعالى:
{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ *لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ *فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ *} [القَلَم: 48-50].
فقد كان على رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) أنْ يصبر لحكم ربّه، الذي قَضَى أن يكون نبيّاً ورسولاً ليبلِّغ خاتمةَ رسالاته السماوية إلى الأرض. ومن مضامين هذا الصبر الذي يوجهه إليه ربُّهُ الذي بعثَهُ، ألاَّ يقاتل المشركين، مهما ناله من أذاهم، ومن عنتهم وعداوتهم، حتى يُؤذَنَ له بالقتال، فيأتيه حينئذٍ النصر من عند الله، الذي ينصر أولياءه، ويقهر أعداءه..
وإذا كان في هذه الدعوة للصبر مواساةٌ للرسول (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) على ما كان يلاقيه من عَنَتِ القوم وجبروتهم، إلاَّ أنها تحمل أيضاً النهي بألاَّ يكون كـالنبيّ يونس (عليه السّلام)، الذي لم يصبر على جهل قومه وكفرهم، فاستعجل في الخروج من بينهم مغضباً، مستاءً، متبرّماً، قبل أنْ يستأذن ربَّهُ تعالى في هذا الخروج، فكان أنْ أوكله الله تعالى إلى حوت كبير ابتلعه في جوفه، ليقبع، في ظلمات ثلاث شديدة، فيعاني ويكابد في ظلمة الليل البهيم، وظلمة البحر القاتم، وظلمة بطن الحوت الخانق. وإنّه، وهو في وسط تلك الظلمات، مكظومٌ، مهمومٌ مغمومٌ، لم يجد إلاَّ التوجّه بدعاء الندم والتوبة، وطلب العفو والرحمة، من الله الذي لا إله إلا هو، إذ نادى: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ *} [الأنبيَاء: 87]. فاستجاب سبحانَهُ لدعائه، وأدركته رحمته، ولولا أنْ تداركته هذه النعمة من ربّه الكريم لبقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، أو لنبذ، وقذف به من بطن الحوت إلى الأرض العراء وهو مذموم أي ملوم (لأنه أتى بما يُلام عليه)، ولكنَّ الرحمة الربانية تداركته، فاجتباه ربّه، وجعله نبياً من الصالحين.
2 - نساءُ النبيّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) لَسْنَ كـأحدٍ من النساءِ إن اتَّقَيْنَ
يخاطب اللَّهُ تعالى نساءَ النبيّ بقوله عزَّ وجلَّ: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا *} [الأحزَاب: 32].
لقد جاء القرآن الكريم يحدّد القيم الأساسية في تصور الإِسلام للحياة. وهذه القيم ينبغي أن تجد ترجمتها الحيَّة في بيت النبيّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وحياته الخاصة، لأن النبيّ هو الأسوة، والقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولأنَّ سيرته في نبوتّه، وعمله، وقوله وبيته يجب أن تظل منارةً ومحطاً لأنظار المؤمنين إلى يوم الدين.
وفي ذلك البيت النبوي الكريم، الرفيع العماد نزلت آيتان تخيِّران نساءَ النبيّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وتحددان لهنَّ الطريق: فإمّا أنْ يُرِدْنَ الحياة الدنيا وزينتها، وإمّا أنْ يُرِدْنَ اللَّهَ تعالى ورسولَهُ الكريم والدار الآخرة. وذلك في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً *} [الأحزَاب: 28] ! }.
.. فقد اختار النبيُّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) لنفسه ولأهل بيته عيش الكفاف، ولم يُعِرْ متاعَ الدنيا أقلَّ عناية. ولم يكن ذلك بسبب العجز عن المتاع، فقد قدّمت له زوجُهُ الطاهرة خديجة مالها كله، وكانت العرب تقدِّر ذلك المال بثروةٍ طائلة، فبذله الرسول الأكرم في سبيل الله. ثم تابع الدعوة حتى فُتحت له الأرضُ في شبه الجزيرة، وكثرت الغنائمُ، وعمَّ الفيءُ واغتنى مِن أتباعِهِ مَن لم يكن له مال ولا زاد، ومع ذلك ظلَّ هو وأهل بيته يعيشون حياة التقشف، يجود بالصدقات والخيرات، ويقدم الهبات والهدايا، مختاراً العزوف عما هو فانٍ زائل، والاستعلاء على زينة الحياة الدنيا ومتاعها، لا يبتغي إلاّ ما عند الله خالصاً لوجهه الكريم. وقد لا يعجب مثل هذا النمط من شظف العيش، والزهد في الدنيا بأسرها، نساءَ هذا النبيّ المؤمن، فيخاطبه ربُّه تعالى بأنْ يقول لأزواجه: أنتنَّ في الخيار بين أمرين: إنْ كُنتُنَّ تُرِدْن الحياة الدنيا، والانصرافَ إلى زينتِها فلكُنَّ مِنَ المَتاعِ حقٌ معلومٌ، ثم أُسَرِّحْكُنَّ وأنتُنَّ راضياتٍ، حامدات.. وإنْ كنتُنَّ تُرِدْن الله ورسوله والدارَ الآخرة فقد أعدَّ الله تعالى للمحسنات منكنَّ (بالصبر على شظف العيش، وعلى طاعة الله ورسوله) أجراً عظيماً، ستلقاه في الآخرة .. ومن الطبيعيّ، وهُنَّ أزواجُهُ وأمهاتُ المؤمنين، أنْ يُردْنَ اللَّهَ ورسوله والدار الآخرة، تطبيقاً لمنهج الله في بيت النبوة، وتجاوباً مع نور الرسالة الذي يشع في أرجاء ذلك البيت، وامتثالاً للاختيار النبويّ، النابع من ذاتيةٍ أحبّت اللَّهَ تعالى، فعملت بتقواه ومرضاته..
ثم يتوجهُ الخطاب الربانيُّ مباشرةً، إلى زوجاته - أمهات المؤمنين - مبيّناً لهنَّ خصوصيّةً ليست لغيرهنَّ من النساء بقوله سبحانه: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزَاب: 32].. إذاً فنساء النبيّ لسن كـغيرهنَّ من النساء، بل ولَسْنَ كـأحدٍ من النساء، لكونهن أزواجاً للـنبيّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) الذي اختاره الله تعالى ليكون خاتمَ النبيين، وسيّدَ المرسلين، فأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه كما يصلّي هو سبحانه وملائكتُهُ عليه في السماوات، مصداقاً لقوله المبين: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *} [الأحزَاب: 56].. فهذا النبيّ جعل له باعثُهُ ميزةً على الأنبياء جميعاً، ويكفيه شرفاً ومقاماً ودرجة رفيعة أنْ الله تعالى يصلي عليه، وأنَّ ملائكته يصلون عليه، فكان أمر الله للمؤمنين بأنْ يصلّوا، ويسلّموا عليه في كل أذان للصلاة، وفي كل صلاة، بل وكلما طابَ للمؤمنين تطهير ألسنتهم بالصلاة الطيبة[*]. وإذا كان النبيّ محمّد (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ليس كـأحد في الأنبياء، فإنه ليس كـغيره من الرجال أيضاً؛ ولذلك وجب ألا تكون نساؤه كـغيرهنَّ من النساء.. فإن اتقين الله، كان لهُنَّ من الأجر عند ربهنَّ ما ليس للنساء، ولكن عليهنَّ ألاَّ يفعلن ما قد يفعله غيرهنَّ. فالمرأة قد يصدر عنها ما يلفت انتباه الرجل مثل نبرة صوتها، أو تأثرها بحديثه فتخضع بالقول، وتترفق باللفظ في مخاطبته، مما قد يثير الطمع في قلبه، ويهيج الفتنة في نفسه.. فهذه ميزة في الضعف البشريّ حيث تجد القلوب المريضة، التي تُثار وتطمع في كل آنٍ، وتجاه كل امرأة، ولو كانت زوجاً للـنبيّ الكريم (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وأُمّاً للمؤمنين. ولذلك كان من قواعد السلوك عند المسلمين أنه لا طهارة كاملةً من الدنس، ولا تخلُّص تامّاً من الرجس، حتى تمتنع الأسباب المثيرة لذلك من الأساس..
وإذا كان التحذير من الله تعالى يأتي إلى نساء النبيّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، اللواتي كنَّ موضع إجلالٍ وإكبار من المسلمين، فكيف الحال بنساء المجتمعات الحاضرة، التي تعيش السمَّ الزعاف في كل شيء؟!.. ألا ترى في هذه المجتمعات، كيف أنَّ النساء يتخَّنثن في نبراتهن، ويتميَّعن في أصواتهن، ويجمعن كل فتنة الأنثى وزينتها، وكل هتاف الجنس ومثيراته، ثم يطلقنه في تأنّثٍ صارخ، وتَعَرٍّ فاضح حتى أصبحت أكثريتهنَّ أبعد ما تكون عن الطهارة؟!.. بل كيف يمكن أن يرفَّ الطهر في هذا الجوِّ الملوَّث، والنساء - بذواتهن، وحركاتهنَّ، وأصواتهنَّ - يُنظر إليهنَّ، في الغالب، على أنهنَّ مصدر الفتنة والإغواء، وكلُّ ما يمكن أنْ يُعدُّ رجساً ممقوتاً؟! ذلك الرجس، إنَّما أراد الله أنْ يذهبه عن أهل بيت نبيّه الكريم، وأنْ يطهرهم تطهيراً، ليكونوا قدوة صالحة لجميع خلق الله من النساء والرجال.. ولذلك ينبّه العزيز الحكيم نساء النبيّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) بقوله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} [الأحزَاب: 32] لا في القول ولا في الفعل.. ثم أمرههن في ختام الآية المباركة: {وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا *} [الأحزَاب: 32] خيِّراً، عفيفاً، دالاًّ على الإحسان في الحديث، فتكُنَّ قدوةً لغيركنَّ، إذ لا ينبغي أن يكون بين امرأة ورجل من غير محارمها، بل وأي رجل غير زوجها، لحنٌ، ولا إيماءٌ، ولا هذرٌ، ولا هزلٌ، ولا دعابةٌ، كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى الخضوع، والاستمالة، ومن ثمَّ إلى السوء الذي قد يأتي بالفاحشة..
والله الخالق العظيم، العليمُ بخلقه وبطبيعة تكوينهم، هو الذي يوجّه الأمر والتحذير لأمهات المؤمنين الطاهرات، كي يراعين القول مع الناس، مع أنَّ زمانهن كان خير الأزمنة ديناً، وإيماناً، وطاعةً، وأخلاقاً في ظل الإسلام، الذي استقرَّ نوراً يملأ العقول والأفئدة.. وكان وجوباً على المرأة المسلمة، حيثما عاشت في المكان والزمان، أنْ تمتثل لقول الله تعالى، فتراعي حكمه الذي خاطب به أمهات المؤمنين، حتى يعمَّ الطهر بدل الفساد، ويسود القول المعروف بدل القول الفاحش..
3 - الإسلام صبغة الله تعالى في الأديان
يقول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ *} [البَقَرَة: 137-138].
الآية الأولى - هنا - تعني في مدلولها، وفي اشتراطها أنَّ اليهود والنصارى، إنْ آمنوا بما آمنتم به أيها المسلمون، من حيث أَنَّ الإسلام هو دين الله الحق، وأنَّ القرآن هو كلامُ الله المنزل على عبده ورسوله محمد بن عبد اللَّه (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، ثم شهدوا بشهادة أنَّه «لا إلهَ إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله»، فقد اهتدوا، لما تسكب هذه الشهادة في قلب المؤمن من الهداية والرشد. ولذلك كان توجيه الخطاب إلى المسلمين بأنَّهُ إنْ آمن أهل الكتاب - وأهل الأرض - بما آمنتم به، فقد اهتدوا، وسلكوا الطريق المستقيم. وإنْ تولَّوا، وانصرفوا عن هذا الدين، وجحدوه ولم يعترفوا به ديناً خاتماً للرسالات السماوية، وديناً تامّاً للناس كافة، فإنما هم في شقاق ونزاع، وخلاف في قرارة نفوسهم، وفي تعاملهم معكم، لأنهم يكونون قد فارقوا الحق الذي يدعو إليه دينكم، وتمسّكوا بالباطل الذي تزيِّنه لهم أهواؤهم، فصاروا مخالفين لما أراد الله لعباده، سائرين في طريق الخصام، وسلوك درب العداوة والحرب التي يتسلحون بها، لتصريف أمورهم وشؤونهم، تماماً كما كان يفعل الكفار والمشركون والمنافقون على عهد النبيّ (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، ولكنَّ السميع العليم مطلعٌ على كل شيء، ولذلك {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} [البَقَرَة: 137] يا محمّد بما يعدك من النصر، وبما يكفيك ويظهرك على أعداء دينك، لأنه هو اللَّهُ الذي لا إلهَ إلاَّ هو، وهو يسمع أقوالهم في السر والجهر، ويعلم أحوالهم، وما يعملون ويخططون ليصدوا عن سبيل الله، ويوقعوا بالمسلمين..
والتعبير في قوله تعالى: {صِبْغَةَ اللَّهِ} [البَقَرَة: 138][*] هو مصدر مؤكّد، ولذلك جاء منصوباً لفعل مقدَّر (صبغنا). أي أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى قد صَبَغَنا بهذا الدين صبغةً تظهر علينا، كما يظهر الصباغ في الثوب، ويميّزه بألوانه.. وفي المعنى أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى قد أنزلَ هذا الدين كاملاً في كل شيء يحتاج إليه أهل الأرض، وبيّن أحكامه عن طريق رسوله الكريم (صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم) التي لا يطرأ عليها نقصان أو تعديل أو زوال. فصار تشبيهها بالصباغ الأصليّ الذي يُصبغ به الثوب فيصير بمثابة أصله، غير قابل للمحو أو البوار.
وتتأكد صبغة الله في الإِسلام بقوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عِمرَان: 19]. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ *} [آل عِمرَان: 85]. وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} [البَقَرَة: 138]، أي من يقدر أنْ يأتي بـمثل ما يأتي به اللَّهُ تعالى، بل ومن أحسن من الله تعالى صُنعاً وصبغةً؟ فهو سبحانه قد أنزل هذا الدين كما يشاء، لأنه القادر على ذلك، ولا أحد إلاَّ الله يحسن هذا الصنيع الجميل، ولا أحد إلاَّ الله يفعل ما يريد. فهو الصانع، وهو الباعث، وهو والعالم بما هو أنفع وأصلح لعباده.. وإنَّ من يتّبع هذا الدين القيم، الذي أحسنَ الله تعالى صبغته، وأحسن تزيينه وتجميله، يكون من عباده الصالحين العابدين..
ونحن نختم كتابنا هذا بقوله تعالى: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} [البَقَرَة: 138]، ونحمده بأنْ منَّ علينا وقدّرنا بأنْ ننقِّح هذه الطبعة من كتاب «الأمثال في القرآن المجيد» لكي يأتي تبيان وإبراز بعض جوانب عظمة هذه الأمثال بصورة أفضل، فيسهل معها على القارىء الكريم فهمُ عِبَرِها وعظَاتِها، وأبعادِها وغاياتِها. ونرجوه تعالى أنْ يتقبّل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢