نبذة عن حياة الكاتب
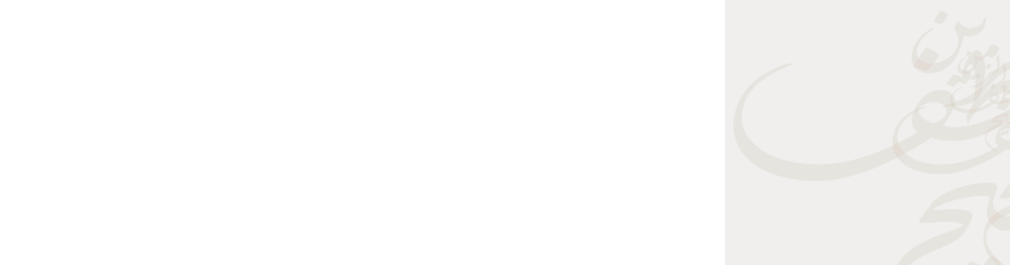
X
المقَدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}
صَدق الله العظيم
سورة المائدة 49
أيُّهَا المسْلمُون:
انظرُوا الواقعَ الأليمَ الذي تَعيشون، واسأَلوا أَنفسَكُم:
هَل أنتم راضونَ بهَذا الواقع؟
وَهل تُرْضُون الله تعَالى بما تُقدِّمون بين أَيديكم؟
ولماذا لا تفكِّرون أفرادًا وجماعاتٍ، بل أمةً إسْلاميّةً بأسرها ـــــــ بما حلَّ ويحلُّ بكمْ من تناحرٍ وتفكُّكٍ، وشقاقٍ وتنابذٍ، وقتالٍ واقتتالٍ، مِمَّا يؤدِّي إلى الضعْف والقَهْر والحرمان؟
يًا أيُّهَا الناسُ جميعًا:
فكِّروا في ما أنتم فيهِ من قلقٍ واضطرابٍ وأمراضٍ فتَّاكة، وبما اقتحمَ ديَاركم من مصاعبَ وأخطارٍ وجوائِحَ مدمِّرة...
واعلَموا ـــــــ كمُسلمين وغيرِ مسلمين ـــــــ أَن الله سُبحانه قد حذَّر الذينَ يتولَّون عَن بعض ما أَنزل على نَبِيِّه محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بكم وقد تركتم جميع ما أنزَلَهُ تعَالى عَليه وعلى سَائِر رُسُله عليهم السلام.
{ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة: 50).
المقَدمة
لئن كان الحكم على الأمم يقوم على مقدار ما وصلت إليه من رقيٍّ أو تخلفٍ ماديّ، إلا إنه ــــــ في الحقيقة ـــــــ لا يمكن إعطاء حكمٍ صحيحٍ على أمة من الأمم إلَّا بعد معرفة وقائع حياتها، وطريقة تفكيرها في هذه الحياة. ذلك أن التفكير الحصيف المركَّز هو السبيلُ لرُقيّها وتقدمها. وهو بهذا المفهوم، يعدّ أعظم ثروة لها في حياتها، وخصوصاً في مرحلة نشوئها... كما أنه يُعدّ أعظم ميراثٍ يتسلَّمه الخلف من السلف، على تعاقب الأجيال، عندما تكون الأمة عريقةً في فكرها وتُراثها، وغنيَّةً في أفكارها الخلاقة المبدعة المنتجة.
والفكر العميق المستنير هو الذي ينشئ عادةً الحضارات، وهو الذي يبني صرُوح المدنية، وهو الذي يجعل الأمة في حالة تقدمٍ مستمرٍّ، قادرةً على مواكبة عوامل التطور الذي يوصل إلى الإنتاج والإبداع، والإتيان بكل جديد في مختلف المجالات والميادين. إذًا فالثروة الحقيقية لأيّ أمةٍ من الأمم، تنحصر في هذا البناء الفكريِّ المتواصل في إنتاجه وإبداعه. في حين أن الثروات الأخرى لا تعدو أن تكون ثروات مادية تحتاج إلى من يحرِّكها ويستمثرها، وهي مهما تعاظمت أو تكاثرت تبقى انعكاسًا أو نتاجًا طبيعيًّا للثروة الفكرية. فإذا ما دُمِّرت الثروة الماديَّة مثلًا للأمة، فإن في إمكانها أن تعوض هذه الثروة وأن تجددها ما دامت محتفظة بثروتها الفكرية. أما إذا تداعت الثروة الفكرية فإن ذلك يعني أن الأمة تكون قد فقدت طريقة التفكير المنتجة لديها، الأمر الذي يجعلها ترتدُّ إلى الوراء وتفقد كلَّ ما لديها من ثروات مادية، ثم لا يتأتى لها حينئذٍ أن تملك شيئًا من أسباب الاكتشافات والاختراعات، بل قد تضيّع كل ما لديها من أسباب الحياة المادية والمعنوية، وتفقد بالتالي كيانها كأمة بين الأمم...
ولعل في تطبيق هذه المفاهيم على واقع الأمة الإسلامية ما يظهر لنا بوضوح كيف أن هذه الأمة راحت تفقد تدريجًا طريقة التفكير المنتجة حتى وصلت إلى حالتها الراهنة من الضعف والتفكك، ومن التأخر والتخلّف. وكان من الطبيعي أن يُرى المسلمون اليوم في حالة فقر على الرغم من توافر الثروات المادية في بلادهم ـــــــ علمًا أن بعض دُول العالم الإسلامي، في وقتنا الحاضر تعدُّ غنية من زاوية النظرة المادية ـــــــ وأن يعدّوا في حالة فقدان للقدرة على الاكتشافات العلمية، والمخترعات الصناعية، على الرغم من دراسة أبنائهم نظريًّا للمكتشفات والمخترعات، ومعرفتهم بِما وصل إليه الغرب في هذا المضمار...
ودليلنا على ذلك أن هذا الجيل من أبناء الأمة الإسلامية يُرى خاليًا من الفكر العميق المستنير، وفاقدًا لكل طريقة من طرق التفكير المنتجة. وسببه ذلك الانحدار، طوال حقبة قرون ستة، ممًّا جعله يرث الأفكار الإسلامية كونها فلسفة خيالية، ويرث الإسلام كونه طقوسًا وشعائر للتديُّن ليس إلَّا. فاكتفى جيلنا الحاضر ـــــــ كما اكتفت الأجيال التي سبقته ـــــــ بالطقوس والشعائر من غير أن يبحث عن الأفكار الإسلامية في منابعها الصحيحة، أو من حيث فلسفتها، ومدى انطباقها على وقائع الحياة، لكي يقدر على إيجاد الحلول للمشاكل المنبثقة عن هذه الوقائع... ولذا عاش المسلمون، إبان تلك الحقبة التاريخية الطويلة على هامش الحياة، بل في ضياع وتفرقة وتشتتٍ، فكان محتمًا على الجيل الحاضر أن يعيش مأساة الاغتراب عن دينه، خاليًا من التفكير العميق، يتلقّى عن غيره تلقينًا واستسلامًا من غير أي تقصٍّ أو تمحيصٍ لما يتلقَّى، حتى فقد، كما فقد أسلافُه، كل تصوُّرٍ عن النظام الإسلاميّ الصحيح، كما طُبق في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيام الخلفاء الراشدين، وكما هو ثابت في القرآن المبين، وفي السنّة النبوية الشريفة، اللذَين يستحيل من دونهما على المسلمين أن يتلمَّسوا طريقهم في الحياة، وأن ينشئوا النُّظم التي تُصلح أوضاع حياتهم، وتقوِّم ما فيها من اعوجاجٍ، وتزيل ما يعترضها من عثرات...
ولعلَّ في هامشية تفكير المسلمين اليوم أحد أهم الأسباب التي فسحت في المجال لأعداء الإسلام بالتقول على النظام الإسلامي، فمقولة أعداء هذا الدين كانت ـــــــ ولا تزال ـــــــ مقولةً باطلة، وقد اتخذت عدة أشكال كاذبة ومتناقضة، من مثل قولهم:
لم تكن للإسلام دولة ذات نظامٍ في التاريخ.
أو كانت دولة الإسلام دولة دينية (روحية).
أو إن الدين غير الدولة، والدولة غير الدين.
أو وجوب فصل الدين عن الدولة.
أما أنه لم تكن للإسلام دولة في التاريخ، فهذا تزوير للحقيقة يدحضه الواقع والتاريخ على حدٍّ سواء. فإجماع المؤرخين الصادقين، من جميع الأمم والشعوب، معقود على أنه كانت للإسلام دولة، وقد نشأت منذ السنة الأولى التي استقر فيها رسول الإسلام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام في المدينة المنورة بعد هجرته من مكة المكرمة. فقد أقام الرسول الأعظم دولة الإسلام مكتملة العناصر والمقومات الداخلية والخارجية، وعيّن الولاة في الأقاليم التابعة لتلك الدولة، ليحكموا بين الناس طِبْقًا لشريعة الله تعالى المطبقة في الدولة الأم، ولتعليمهم الإسلام دينًا يحتوي العبادة والنظام والقانون... ثم امتد نفوذ تلك الدولة الإسلامية إلى أمصار بعيدة أيام الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعقب ذلك حكمُ الأمويين... وحكمُ العباسيين حيث ترامت أطراف الدولة الإسلامية إلى كثير من الأقطار في طول الأرض وعرضها، كما عبَّر عن ذلك الخليفة العباسي هارون الرشيد عندما خاطب الغمامة قائلًا: "اذهبي أيتها الغمامة أنّى شئت فإنَّ خراجَك سيعود إليَّ". ثم جاء الحكم العثمانيّ وأنشأ امبراطورية شاسعة لمئات السنين. وطوال تلك العهود جميعًا أي من السنة الأولى للهجرة وحتى سنة 1342 هجرية (الموافقة لسنة 1924 ميلادية)، ظلت الدولة الإسلامية قائمة، حتى سقطَت في هذه السنة الأخيرة الخلافة الإسلامية على أيدي أعداء الإسلام، من جراء تآمرهم على هذا الدين وأهله، ونجاحهم في تآمرهم لإزالة دولة الإسلام من الوجود كي يتسنّى لهم أن يستعمروا بلاد المسلمين، وأن يحكموا أبناءها وفقًا لمصالحهم وأهوائهم. فهل يمكن تجاهل هذه الحقيقة التاريخية، والتنكر لأعظم دولة فتية وقفت في وجه الامبراطوريتين الرومية والفارسية اللتين كانتا من أعظم الامبراطوريات في العالم في ذلك العهد؟ إنه لمن السخف أن ينكر أحدٌ ذلك كله ويقول بأنه لم تكن للإسلام دولة في التاريخ. وإخالنا نحيل المنكرين المفترين ــــــ ببداهةٍ ـــــــ على كتب التاريخ الذي ـــــــ على الرغم تزويره من قبل الحاقدين على الإسلام ـــــــ ما زال يصفع وجوههم، ويُبطل أكاذيبهم وادِّعاءاتهم المضلِّلة... نعم بهذه البداهة، وببساطة كلية، نردُّ هؤلاء المنكرين لقيام دولة الإسلام إلى مراجعة ما في بطون الكتب ليرَوا، ويطَّلعوا، ويخجلوا!...
أمَّا من يفترون على الإسلام بأنه كانت له دولة دينية (روحية) فإنه لم يبيِّن لنا أحد من المؤرخين، حتى ولا أشدّهم بغضًا للإسلام، كيف كانت تلك الدولة دينية (روحية)؟ أو متى قامت في وقت من أوقات التاريخ؟ وكيف تكون للإسلام دولة دينية، وهم يعرفون، ولا يستطيعون أن ينكروا، بأن الإسلام لم يجعل، على الإطلاق، للروح دولةً أو سلطانًا، حتى في العبادات نفسها، لأن للروح في الإسلام مفهومًا معيَّنًا يختلف كليًّا عن مفهوم الغرب له؟. فالفرائض الدينية الراتبة في الإسلام ـــــــ كالصلاة مثلًا ــــــ يؤديها المستطيع واقفًا، والمريض العاجز جالسًا، والذي لا يقدر على الجلوس يؤديها نائمًا، والذي لا يستطيع الكلام يصلِّي بالإيماء، حتى لنرى لها تنظيمًا ربَّانيًا دقيقًا يلاحظ القيام بالفرض إلى جانب راحة الفرد المكلَّف وسلامته... فلا شيء في الإسلام بلا نظام، وإلّا فكيف حكم الإسلام نصف الكرة الأرضية أربعة عشر قرنًا بلا نظام، وبلا دولة؟.
وأما القول إن الدين في الإسلام غير الدولة، أو إن الدولة غير الدين، فإنما يُطلَق بباعث جهل أو تجاهل أو مغالطة. وإن من يعرفون الإسلام على حقيقته، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، يدركون أن الدولة الإسلامية لا تعني إلا دولة الدين الإسلامي، أي الدولة التي تحكم بموجب الدين الإسلامي فحسب، لأنك تجد في صميم الإسلام القوانينَ والنظمَ والتشريعات لبناء الدولة الكاملة. وهذه الدولة وحدها هي التي يجب أن تقوم على رعاية أمور البشر، لأنَّ شرعها وتشريعها من لدن رب العالمين، ولذلك هي وحدها التي قدر لها أن تقيم حكم الله تعالى على الأرض. وكيف نقول بدولة إسلامية لا يطبق فيها دين الإسلام الذي هو بحقيقته نظامٌ وتشريعٌ يصلح لكل زمانٍ ومكانٍ، منذ وُجد وإلى أن ينتهي الدوَران؟...
وأما المناداة بفصل الدين عن الدولة فإنها تصح بالنسبة إلى الغرب الذي ابتدع النظريات والنظم التي تهدف، فيما تهدف، إلى حل الخلافات بين الكنيسة والحكام، وإنهاء تنازعهما على السلطان. وهذا الأمر لا يعني المسلمين بشيء، لأن دينهم الإسلام ودولتهم لا تقوم إلا على أساس دينهم، فلا انفصال بين الإسلام دينًا، ودولة الإسلام حكمًا، فإما أن يقوم الحكم على أساس الإسلام، وإما ألَّا يكون هنالك دولة إسلامية. ومن المستحيل أن يعيش المسلمون كمسلمين، من غير دولة يُظلها الإسلام، ثم يبقى لهم كيانهم أو وجودهم الإسلامي. فكيف نفصل بين الدين الإسلامي والدولة الإسلامية وأوامر الله تعالى للمسلمين تفرض عليهم فرضًا واجبًا إقامة الحكم وفقًا لما شرعه دينهم؟ أليس القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله ربُّ العالمين وبيَّن فيه قواعد الحكم للدولة الإسلامية؟ لنقرأ في هذا القرآن المجيد تحديده لنظام الحكم في قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ} (المائدة: 49). {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (المائدة: 44). {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (المائدة: 45). {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (المائدة: 47). ولْنستمعْ إلى هذا التوكيد الإلهيّ، والاشتراك المليء بالتحذير والتنبيه، أن الحكم بين الناس لا يقوم إلا على العدل بقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} (النساء: 58)، ثم لِنتأملْ هذا الخطاب الموجَّه للمؤمنين يأمرهم بطاعة الله والرسول، ثم بطاعة الحكم الذي يطبق منهاج الله تعالى على الأرض بقوله عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (النساء: 59).
ثم لِنلاحظْ هذا التكامل في قواعد الحكم، والله سبحانه يوجهُ رسولَهُ محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم إلى طريقة الحكم الصحيح بقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} (المائدة: 48)، وقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} (النساء: 65). فهذا بيان واضح من رب العالمين بأن الحكم الحق هو بما أنزل الله تعالى، وأنَّ الناس لا يؤمنون بالدين الحق، ولا يؤمنون بالعقيدة الصحيحة والمبدأ الأول والنهائي إلَّا أن يحكِّموا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافاتهم، ويتّبعوا قضاءه الذي قضى به؛ وحكم الرسول الأعظم لم يكن، ولا يكون إلَّا بما أنزل الله في كتابه، مما يجعل القاعدة سارية ونافذة أبدًا ما دام القرآن الكريم قائمًا فينا، وما دام هذا القرآن محفوظًا من مُنَزِّلِهِ وحتى يرث الله تعالى الأرض ومَن عليها.
هذه هي القاعدة الإسلامية في الحكم التي لا تحول ولا تزول: الحكم بما أنزل الله، وبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قضاءه تفسير وتبيان للقرآن، ولِمَا شرع الله تعالى في القرآن... أمَّا مَن لا يحكمون بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون، والظالمون، والفاسقون...
فيا أيها المسلون، ويا أيها الناس!... ابتعدوا عن أن تكونوا كافرين، أو ظالمين، أو فاسقين، واحكموا بما أنزل الله، وبما قضى به رسولُه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تستقيم حياة الأرض وتتخلَّص من كفرها، وظلمها، وفسقها، وفجورها، وفسادها... نعم احكموا بما أنزل ربُّكم حتى تسعدوا في هذه الحياة الدنيا وحتى تفوزوا في الآخرة، ولا تكونوا من الخاسرين. نعم هذه هي الحقيقة، وهذا ما يحكم به الدين والعقل. فالإسلام هو الدين الحقّ، وهو أيضًا منهاج للحياة. وفي صلب هذا المنهاج نظام للحكم متكامل في جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما إقامة الدولة، كنظام سياسيّ، إلّا جزء من النظام الشامل الكامل الذي أتى به الإسلامُ ليسوّيَ حياة الناس، ولن تستويَ هذه الحياة ما لم تقم الدولة الإسلامية كما كانت في صدر الإسلام. لقد كانت يومذاك دولة سياسية بجميع خصائصها، ولم تكن لها أيّ صفة روحية، ولم تتمتع بأي صفة من صفات القداسة، حتى إن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، باستثناء قداسته كنبيّ ورسول، لم تكن له صفة القديسين المستمدة من كونه رئيسًا للدولة الإسلامية. هذا، على الرغم من أنه في مجال الحكم كان أعدل من عرفته الأرض حاكمًا لأنه لم يحكم إلَّا بما أنزل الله تعالى عليه وبحسب التشريع الموحى به إليه... ثم إنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثالث رئيس للدولة الإسلامية، كان يقول للناس: "من رأى فيَّ اعوجاجًا فليقوّمه" فيقول له أحدهم: "لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا"، فلا يزيد الخليفة ورئيس الدولة على أن يقول: "الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوّم اعوجاج عمر بحد السيف". فأي قداسة يمكن أن تكون لعمر أو لأبي بكر أو لعثمان أو لعلي رضي الله عنهم، وهي لم تكن أصلًا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كحاكمٍ وكرئيسٍ لدولته؟
إذًا فكون الإسلام دينًا أمر لا جدال فيه، كما أن دولة الإسلام لا تحكم إلَّا بالدين الإسلامي أمر مفروغ منه، ولا مجال أيضًا للبحث فيه...
وإلَّا فلماذا نزلت الآيات الكثيرة التي تدل على الحكم وعلى مئات التشريعات والأنظمة؟...
ومن يطبق أحكامها؟
وعلى من تطبَّق؟ فالدولة الإسلامية ليست دعوى يدَّعيها المسلمون، بل هي حقيقة لا تحتاج إلى برهان أو دليل، مثلما لا يحتاج النهار إلى دليل على وجوده.
وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتــاج النهار إلى دليـــل
وإذا لم يكن حكم الدولة الإسلامية قضيةً بنظر المسلمين من قبل، فقد بات هذا الأمر اليومَ قضية محورية وأساسية لهم، أي قيام الدولة الإسلامية فعلًا، واستئناف الحياة الإسلامية في الحكم. والمسلمون المعاصرون قد عقدوا العزم ـــــــ بإذن الله تعالى ـــــــ على استئناف هذه الحياة مهما كلف الأمر، لأن الحكم الإسلامي ضروري لهم ضرورة الماء والهواء للحياة على الأرض، كون النظام الإسلامي هو الأساس لإعادة كيانهم، ولإصلاح حياتهم، بل لإصلاح حياة الناس كافة، لأن الظلم الذي يحيق بالأرض في عصرنا الحاضر، لا يمحوه إلَّا عدلُ الإسلام، ولا تزيله إلَّا دولة الحقِّ والدِّين.
وينبغي أن يعرف المسلمون أن إعادة الدولة الإسلامية، والتصميم على إقامة الحكم الإسلامي، أمور تحتاج إلى جهود غير عادية، وإلى أعمال ضخمة، وأنه سوف تصطدم جهودهم وأعمالهم بعقبات كأداء ومصاعب جمّة، وفي مقدمتها عناد أعداء الإسلام، ومواصلة حربهم الضروس للحؤول دون قيام الحكم الإسلامي الذي يفضح ظلمهم وباطلهم. ولا شيء يثنيهم عن ذلك وهم ـــــــ كما نعلم ـــــــ قد أوغلوا في ماديتهم، ونبذوا كل القيم الخلقية، وعطلوا كل المفاهيم الصحيحة، لكي يبقى لهم النفوذ وإحكام السيطرة على مختلف بقاع العالم.
نعم دون هدف المسلمين مشقات وحواجز... لكن حماسة الإيمان، والجرأة والإقدام، والامتثال لأوامر الله تعالى ونواهيه، وامتشاق سلاح الحق، والسعي لمرضاة الله، والصبر على المكاره، والثبات في وجه الأعداء، والجهاد في سبيل الله... كلَّ هذه الصفات التي يتحلَّى بها المؤمنون الصادقون تجعل إيمانهم بضرورة وجود الحكم الإسلامي يعلو على كل شيء، وإن ثقتهم بنصر الله تعالى لهم تسهِّل عليهم كل صعب، لأن ربّهم تعالى يقول: {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (محمد: 7) ويقول تعالى: {إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ} (آل عمران: 160). ولعل من الأسس الأولية لتطبيق الإسلام كاملًا: تجنب الترقيع، والابتعاد عن الحل الوسط، ومحاربة التجزئة، والصبر على المشقات، والتصميم على النجاح وتحقيق النصر...
ولا بد من التذكير بأن عودة الحكم الإسلامي لا يكون بتعمير المساجد، وحفظ الأخلاق، ومنع المحرمات فقط... فهذه أمور جوهرية فعلًا وبلا شك، لكنها ليست وحدها الهدف أو الغاي، فالله تعالى يقول: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (التوبة: 19). {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (البقرة: 177).
إذًا فإعادة الحكم الإسلامي لا يكون إلا بتطبيق الإسلام تطبيقًا شاملًا، وهذا من شأنه أن يقلب المفاهيم السائدة حاليًّا رأسًا على عقب، لكي يعود دستوره، وتعود قوانينه، فتعالج شؤون الحياة جميعًا على ضوئها. لذلك كان حقًّا على المسلمين أن يبيّنوا للناس ماهية النظام الإسلامي حتى يعرفوه على حقيقته، وأن يعملوا في الوقت نفسه على إيجاد دولة الإسلام التي تطبّق هذا النظام، فينالوا ما وعدهم ربُّهم به بقوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ} (النور: 55). {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَر} (الحج: 41).
والنظام الإسلامي يحتوي يقينًا على النظام السياسي الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية، ولكن لا بدَّ من أن يُعلم بأنه نظام خاصّ لدولةٍ كاملةٍ عادلةٍ خاصة، بمعنى أن تطبيقه لا يكون إلا على أساس الكتاب والسنّة، وطاعة أولي الأمر من المسلمين... أمَّا نظام الحكم الديمقراطي المطبَّق حاليًّا في العالم فقد أعلن إفلاسه، ناهيك بالأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية وسائر الأنظمة التي أثبتت التجارب فشلها في إصلاح أمور الناس، والتي جلبت عليهم الويلات والمصائب، حتى صار العالم كله ـــــــ بما فيه العالم الإسلامي والعالم العربي ـــــــ يعاني من الأزمات والمشاكل التي تتخبط بها الأنظمة بصورة مستمرة... وعلى الرغم من هذا الواقع المرير، فإننا نخشى ــــــ وقد عشنا محكومين بأنظمة تناقض الإسلام زمنًا طويلًا ـــــــ أن يكون لتلك الأنظمة تأثيرها فينا، بما يجعلنا نألف نوع الحكم القائم، فنتخذ منه مقياسًا لتصورنا عن الحكم في الإسلام. وهذا ما يفرض علينا بالضرورة أن ندع أي شكل من أشكال الحكم الحالية جانبًا، لنبني حكمًا إسلاميًّا خالصًا، من غير موازنة أو مقارنة بباقي الأنظمة، ومن غير اتباع أهوائنا في تفسيرٍ خاطئ لنجعله مطابقًا أو مشابهًا لغيره من النظم، لأن المطلوب ليس معالجة النظام الإسلامي بحسب مشاكل العصر، بل معالجة مشاكل العصر بنظام إسلامي عادل، لأنه هو النظام الأصلح والأوفى لجميع شؤون الحياة، ولإنسانية الإنسان.
النظام الاقتصادي:
وما قيل عن نظام الحكم السياسي ينطبق أيضًا على النظام الاقتصادي. فمن المعروف أن هنالك أنظمة كثيرة في العالم، لكن أشهرها وأعمّها اثنان: النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. والدول يأخذ بعضها بهذا النظام، وبعضُها بذاك، وبعضها الآخر يخلط ما بينهما... ولا تزال النظم التي أوجدها الغرب هي السائدة على الرغم مما فيها من مساوئ ومفاسد، وخصوصاً فيما يعود إلى الاحتكارات والمضاربات، واستغلال الفئات الشعبية، وسوء توزيع الثروة، وما إلى ذلك من المثالب التي أظهرت عقم هذه النظم في تلبية حاجات الناس بصورةٍ عامة.
وقد أخذ المسلمون بتلك النظم وطبّقوها في بلادهم ـــــــ تحت وطأة حكم المستعمر ـــــــ إذ فرضها عليهم بأساليب ووسائل شتى. ومن اللافت أن العالم الإسلامي كان ميله عمومًا إلى الرأسمالية أكثر من غيرها من النظم. ولعلَّ هذا الميل نابع من توهمه بنجاح الرأسمالية، وانبهاره بمظاهرها الخداعة، وأخذه لها على علّاتها، لا من إدراكه لحقيقتها واقتناعه بها، وذلك لعدم معرفته بالفكرة الرأسمالية معرفة حقيقية، وجهلِه بالأفكار الإسلامية التي تضرب الرأسمالية في مبادئها وأسسها. وهذا بالذات ما أوصله إلى حالة الشعور بعجز النظام الإسلامي عن معالجة مشاكل الحياة وتعقيداتها، وضرورة أخذ المعالجات الرأسمالية كما هي، لأنها ـــــــ في ظنه ـــــــ تتيح له السير قدمًا لمواكبة عامل التطور، وتمكنه بالتالي من اللحاق بقافلة الأمم الرأسمالية أو الشعوب التي تطبق الاشتراكية في سيرها نحو الشيوعية، باعتبار أن تلك الأمم والشعوب ـــــــ بحسب تصوره الواهم ــــــ هي الأمم والشعوب الراقية... ولكن من حيث الواقع هل تمكن فعلًا العالم الإسلامي من السير قدمًا في معترك الحياة ومن مواكبة التطور والوصول إلى ما وصل إليه الغرب؟ أبدًا... وإلَّا لما كانت بلاد المسلمين تعدُّ من دول العالم الثالث، الموصوف من قبل أعدائه المستعمرين، والمستغلين لثرواته وخيراته، بأوصاف شتى مثل: التخلف والتأخر والفقر وما شاكل ذلك، من دون تمييز بين دول مسلمةٍ ودول غير مسلمةٍ في هذا الشأن...
ومن المفارقات الغريبة أن تقوم فئة من المسلمين، لها ميل وولوع بالأفكار الرأسمالية، بمحاولات يائسة للتوفيق بين النظام الإسلامي والنظام الرأسمالي. إلا إن تلك الفئة فشلت فشلًا ذريعًا في محاولاتها التوفيقية، ولم تترك أي أثر إصلاحيٍّ في المجتمع الإسلامي، وفي العلاقات القائمة فعلًا بين الناس.
ولعلّ المعاناة الشديدة التي يكابدها المسلمون في واقع حياتهم إنما هي ناجمة عن تطبيقهم للأفكار والنظم الاقتصادية التي ما فتئ الغرب يفرضها عليهم، ويروِّج لها حتى تلاقي القبول لديهم. وهذا ما يفسر لنا كيف أن الأمة الإسلامية تحكم بالنظام السياسي الديمقراطي ـــــــ شكليًّا ـــــــ في حين أنها تحكم بالنظام الاقتصادي الرأسمالي ـــــــ عمليَّا ـــــــ وذلك في جميع نواحي الحياة الاقتصادية. من هنا كان لزامًا على المسلمين التعرّض للأفكار التي تقوم عليها المعالجات الرأسمالية أو الاشتراكية، لإيضاح زيفها وتقويض أُسسها أولًا، ومن ثمَّ لدراسة الآثار التي خلَّفتها في حياة الأمة الإسلامية حتى يمكن إزالة تلك الآثار برمَّتها، والانتقال في ما بعد، إلى دراسة وقائع الحياة في تنوعها وتجددها، ومعالجة مختلف القضايا عن طريق الأحكام الإسلامية كونها أحكامًا شرعية تستوجب الأخذ بها، لكونها مستنبطة من الكتاب والسنّة أو مما أرشد إليه الكتاب والسنّة من أدلة، لا من حيث صلاحيتها للعصر أو عدم صلاحيتها، إذ إن هذا الأمر غير واردٍ على الإطلاق بالنسبة إلى النظام الإسلاميِّ الذي جعله الله تعالى صالحًا لكل زمانٍ ومكانٍ... وبمعنى آخر يجب أن تؤخذ الأحكام الإسلامية عقائديًّا لا لتأمين مصالح آنية أو مرحلية بغضّ النظر الوهميِّ ـــــــ عن مدى نفعها أو فسادها ـــــــ أي أن تكون الغاية تطبيق النظام الإسلامي الذي يستطيع أن يقلب الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي رأسًا على عقب، ويحرر المسلمين من الفقر والعوز والجوع والمرض، وغيرها من الآفات الناجمة عن سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المسلمون في ظل الرأسمالية. والمعالجة لا تكون إلَّا بإعطاء الصورة الواضحة للنظام الاقتصادي الرأسمالي حتى يلمس عشاق هذا النظام مدى فساده وتناقضه مع النظام الإسلامي، ومدى قدرة نظامنا على معالجة المشاكل الاقتصادية معالجة سليمة تجعله طرازًا خاصًّا في الحياة، لا علاقة له ـــــــ من قريبٍ أو بعيدٍ ـــــــ بالنظام الرأسمالي أو بالنظام الاشتراكي أو الشيوعي أو بغيرها من النظم على اختلافها...
تلك نظرة. وبعد هذه النظرة السريعة عن نظام الحكم السياسي والنظام الاقتصادي، ماذا هناك عن النظام الاجتماعي؟
النظام الاجتماعي:
يطلق الغربُ ـــــــ وكل من يأخذ بأفكاره عادةً ـــــــ على جميع أنظمة الحياة تسمية "النظم الاجتماعية". وهذا خطأ إذ يجب أن يطلق عليها تسمية "أنظمة المجتمع" لأنها في حقيقتها تنظّم العلاقات بين الناس الذين يعيشون في مجتمع معين بغض النظر عن اجتماعهم أو تفرقهم. وأنظمة الحياة، ولا ريب، متعددة ومتنوعة بحسب تعدد العلاقات وتنوعها. ويمكن أن تتناول الاقتصاد، والحكم، والسياسة، والتعليم، والعقوبات، والمعاملات والبيّنات إلخ... فكان إطلاق "النظم الاجتماعية" عليها لا يأتلف مع واقعها وحقيقتها، لأن كلمة "النظام" إنما تعني تنظيم المشاكل أو العلاقات التي تنشأ بين الناس. وكلمة "الاجتماعي" كصفة للنظام إنما تعني تنظيم المشاكل والعلاقات التي تنشأ عن الاجتماع، أي عن اجتماع الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل ـــــــ مثلًا ــــــ وليس عن اجتماع الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة، لأن هذا الاجتماع لا تنشأ عنه مشاكل وعلاقات تحتاج إلى نظام، وإنما تنشأ عنه مصالح تحتاج إلى التنظيم. وبمعنًى آخر أن اجتماع الرجل بالمرأة أو اجتماع المرأة بالرجل هو الذي تنشأ عنه علاقات أو مشاكل تحتاج إلى التنظيم بنظام، فكان الأولى أن يطلق "النظام الاجتماعي" على ما ينظم العلاقات بين الرجل والمرأة، وكل ما يتفرع عن هذه العلاقات في المجتمع. وبهذا فإن تجارة المرأة مع الرجل مثلًا هي من أنظمة المجتمع لا من النظام الاجتماعي، لأنها تدخل في دائرة النظام الاقتصادي. أما منع الخلوة بين الرجل والمرأة، أو متى تملك المرأة حق الطلاق لنفسها، أو متى يكون لها حق حضانة الصغير، فمثل هذه الأمور هي من النظام الاجتماعي، وعلى ذلك يكون تعريف النظام الاجتماعي بأنه "النظام الذي ينظم اجتماع المرأة بالرجل أو اجتماع الرجل بالمرأة، وكل ما ينشأ عن هذا الاجتماع من علاقات وتفرعات" وبصورة أعمّ وأشمل أن النظام الاجتماعي هو الذي يحدد ويكفل حقوق الأفراد والجماعات في علاقاتهم كافة وسائر مشاكلهم، وإن كنّا قد مثّلنا هنا بحال المرأة دون غيرها.
وهذا المفهوم للنظام الاجتماعي قد اضطرب فهمه على المسلمين بسبب بعدهم من أفكار الإسلام وأحكامه، وأخذهم للأفكار والنظم الغربية من دون تدارك الآثار التي تخلفها في حياتهم. فقد رأوا أن المرأة الغربية قد ظهرت عليها أشكال مدنية، وظهرت هي بأشكال مدنية، فحاولوا تقليد هذه المظاهر من دون أن يدركوا أن ذلك، وإن كان يتفق مع حضارة الغرب ومفاهيمه عن الحياة، لا يتفق أبدًا مع حضارة الإسلام ومفاهيمه. وعلى هذا الأساس سلَّموا بظهور الأشكال المدنية الغربية على المرأة المسلمة أو ظهورها هي بتلك الأشكال المدنية، واقتنعوا بوقوف المرأة المسلمة إلى جانب الرجل في المجتمع وفي الاجتماع، ونادوا بضمان الحرية الشخصية للمرأة المسلمة وإعطائها الحق بأن تفعل ما تشاء ودعوا تبعًا لذلك إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، ولو من غير حاجة، وإلى التبرج وإبداء زينة المرأة، وإلى توليها الحكم... معتبرين ـــــــ جهلًا ـــــــ أن هذه الاتجاهات هي السبيل إلى التقدم والدليل على النهضة.
وكان من نتائج تلك الاتجاهات، وهي في غالبها تقليد أعمى، أن أُطلقت الحرية الشخصية للمرأة المسلمة إطلاقًا كليًّا، وجرى الاتصال بينها وبين الرجل حتى من غير دواعٍ، ممَّا ترك أسوأ الآثار على سائر فئات المجتمع الإسلامي. فالتعاون بين المرأة والرجل لم يحصل بل حصل عكسه: انحلال في الأخلاق، وفساد في الذوق، وزعزعة في الثقة، وتفكك في الأسرة، وبالتالي انحراف في التفكير وهدم لجميع المقاييس الدينية والخلقية والاجتماعية. والمسلمون، وهم يجارون الغرب، لم يلاحظوا بأن المجتمع الغربي لا يأبه لصلات الذكورة والأنوثة، ولا يرى فيها أيّ معرَّة أو طعن أو مخالفة للسلوك القويم، بل لا أي مساسٍ في الأخلاق. في حين أن المجتمع الإسلامي يُعدّ صلات الذكورة والأنوثة بغير وجهٍ شرعي من الكبائر التي تفرض عقوبة الجلد، أو الرجم لأنها تؤدي إلى اختلاط النسل وضياع الأصل وضياع الحقوق. ومن يرتكب الكبائر هو عاصٍ ومنحطٌ في الإسلام، ويجب على المجتمع أن ينبذه ويزدريه، لأن من مقومات أخلاقنا الحفاظ على العِرض وصونه، وعلى النسل وصفائه وحقوقه، وبذل المهج للدفاع عن ذلك... على أنه وبسبب التقليد الأعمى لعادات الغرب لبست الدعوة إلى نهضة المرأة ثوب الإباحية، والخلاعة، والابتذال، وحمل المقلدون شعار: نهضة المرأة من أجل إنهاض الأم، من دون درايةٍ منهم أنهم يعملون على تهديم أقدس العلاقات وتدمير الحياة الاجتماعية عند المسلمين. وعمَّ هذا البلاء قرانا ومدننا على حد سواء، حتى صرت تنظر فلا ترى أي أثر للسيماء الإسلامية على أحياء عواصمنا، لا فرق في ذلك بين استنبول والقاهرة، ولا بين كراتشي وبغداد، أو بين تونس وبيروت، فكلها غابت عنها المسحة الإسلامية، وغرقت في ظاهرة التمدن الغربي الخليعة...
وكان من الطبيعي أن ينهض لمكافحة تلك الأفكار الدخيلة على الحياة الإسلامية، وأن يهب لمحاربة الدعوات الخادعة، جمهرة من خاصة المسلمين وعامتهم، فقامت جماعات تدعو إلى وجوب المحافظة على المرأة المسلمة وصيانة الفضيلة في المجتمع، ولكن من غير فهمٍ كافٍ للأنظمة الإسلامية، ومن غير تبيان للأحكام الشرعية، متخذة أساسًا لدعوتها القبول بأن تكون المصلحة التي يراها العقل هي محور البحث، والمقياس للآراء والأشياء... كما انبرت جماعات أخرى تنادي بالمحافظة على العادات والتقاليد والتمسك بالأخلاق، ولكن من غير إدراك بأن القاعدة في الإصلاح هي العقيدة الإسلامية وليست العادات والتقاليد، وأن المقياس لذلك هو الأحكام الشرعية المنبثقة عن العقيدة ليس إلَّا: كما هي مفروضة في القرآن والسنّة من دون سواهما.
ومن المؤسف أنه ظهر في تلك الدعوات كثير من المبالغة إلى حد الإفراط... ومن قبيل ذلك التعصب الأعمى فيما خصّ حجاب المرأة حتى قيل بمنعها من الخروج من منزلها لقضاء حاجاتها أو لمباشرة شؤونها بنفسها، لا في تجارة، ولا في زراعة، ولا في صناعة. كما جرى تحريم ممارستها لحق الانتخاب، والحظر عليها أن تكون صاحبة رأي في السياسة أو الحكم أو الاقتصاد أو الاجتماع، حتى إن بعض الفقهاء جعلوا للمرأة خمس عورات: عورة في الصلاة، وعورة عند الرجال المحارم، وعورة عند الرجال الأجانب، وعورة عند النساء المسلمات، وعورة عند النساء غير المسلمات... بل قالوا إن بعض الآيات القرآنية قد نزلت تخاطب الرجال من دون النساء، مما حال بين المرأة المسلمة والحياة حتى أصبحت المرأة المسلمة قلقة حائرة: بين أن تنقل عن الغرب مدنيته الزائفة أو مظاهر حضارته السافرة من دون وعيٍ أو تفهم للتناقض فيما يقدمه لها الغرب وفيما تقدمه لها الحضارة الإسلامية في حقيقتها، وأن تظل جامدة لا تنفع نفسها ولا ينتفع المسلمون بجهدها وطاقتها... كل ذلك بسبب عدم تلقيها للإسلام تلقيًا فكريًّا، وعدم فهمها للنظام الاجتماعي في الإسلام فهمًا صحيحًا.
ولذلك كان لا بد من دراسة النظام الاجتماعي في الإسلام دراسة شاملة لكي ندرك أن المشكلة الاجتماعية تنحصر باجتماع الرجل والمرأة وما ينبثق عن هذا الاجتماع من علاقات كثيرة ومتنوعة، وأن علاج هذه المشكلة ليس بما يمليه العقل وبل بما يدلُّ عليه الشرع، من دون أن نهمل أثر العقل في فهم الحكم الشرعي فهمًا صحيحًا لا يناقض الدين، ولا يناقض واقع الحياة وتطورها، وأن بناء النظام الاجتماعي الإسلامي يحتّم على الرجل والمرأة طرازًا فريدًا من العيش، وفق ما أمر الله به في كتابه العزيز، وطبقه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في السنّة الشريفة، بغضّ النظر عما إذا كان هذا النظام يناقض نظم الغرب ومدنيته الزائفة، أو يخالف ما اعتاد عليه الآباء والجدود في تقليدهم المتحجِّر الجامد.
ونخلص في نهاية هذه المقدمة إلى القول بأن ما أصاب المسلمين من اضطراب فكريّ، وانحراف عن فهم العقيدة وتطبيقها إنما يرجع إلى تلك الغزوة الكاسحة التي غزانا بها الغرب ليتحكم في تفكيرنا وأحاسيسنا، وليغيِّر مفاهيمنا عن الحياة، ومقاييسنا للأشياء، وليقتل فينا الغيرة على إسلامنا وتعظيمنا لمقدساتنا... وَلْنعترف بأن الغرب قد نجح في ذلك نجاحًا كبيرًا...
وقد ساعد الغرب على نجاحه هذا فئة من المقلدِّين والناقلين حاولت أن تصوِّر لنا المدنية الغربية بمختلف أشكالها المادية على أنها هي الحضارة المرجوة، من دون تمييز أو تفرقة بين المدنية والحضارة، ومن دون إدراك منها بأن المدنية لا تعني الحضارة في شيء! لأن الحضارة هي مجموعة من المفاهيم عن الحياة والكون والإنسان. وهي لا تأتي إلا من خلال طريقة التفكير المنتجة التي تنشئ وتبني وتطور، في حين أن المدنية لا تعدو أن تكون الأشكال المادية، والوسائل والأدوات التي تستعمل في الحياة بغض النظر عن المفاهيم والأفكار البنَّاءة... وهذا الخلط في أذهان الناقلين والمقلِّدين هو الذي جعلهم بعيدين من الإدراك بأن ما تقوم عليه الحضارة الغربية يتناقض في أساسها مع الحضارة الإسلامية، ولذلك كان نقلُهم للمفاهيم الغربية نقلَ تقليد من دون أي فهم أو تدبّر، وكأنهم في ذلك مثْلُ ناسخٍ لكتابٍ يصور فيه الحروف والكلمات تصويرًا، من دون الوقوف على معانيها ومراميها.
ومثل هذا النقل، وذاك التقليد هو ما يجب تركه والتخلي عنه بصورة نهائية، والعودة إلى منابع الفكر الإسلامي، وخصوصًا أن في الأمة علماء كثرًا، لا يقلُّون في عطائهم عن المجتهدين الأوائل، وعن أصحاب المذاهب في العلم والاطلاع، كما أن لدى الأمة ثروة تشريعية وفكرية لا تدانيها أيّ ثروة لدى الأمم الأخرى. فعلينا أن نتخلّى عن الجمود والتقليد، وأن نُعمل الفكر والعقل لِنَفهم ديننا الحنيف، ونفقه ما فيه من أحكام وتشريعات وقوانين نستطيع بموجبها أن نبني نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على هدي وبصيرة الشرع الذي بين أيدينا في كتابنا الكريم وفي سنَّة نبيِّنا العظيم. وبذلك نخدم أبناء هذه الأمة، ونرفع من شأنها. فعسى ـــــــ بذلك ـــــــ أن يرضى الله تعالى عنا ويسدِّد خطانا إلى ما فيه خير أمتنا. ومنه وحده نطلب العون على ذلك، فإنه نعم المولى ونعم النّصير.
وإليكم فكرة صحيحة سليمة عن نظام الحكم السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي في الإسلام.
الحكْم
لمن يرجع إليه إصدار الحكم
الشرع أم العقل؟
من أهمّ الأبحاث المتعلقة بالحكم وأولاها وألزمها بيانًا معرفَةُ مَنِ الذي يرجعُ له إصدارُ الحكمِ، أي مَنْ الحاكمُ؟ إذ على معرفتِهِ تتوقّفُ معرفةُ الحكمِ ونوعِهِ. والمرادُ بالحاكمِ مَنْ يملكُ إصدارَ الحكم على الأفعالِ والأشياءِ: لأن ما في الوجود من المحسوساتِ لا يخرجُ عن كونه أفعالًا للإنسان أو أشياءَ ليست من صُنْعِ الإنسانِ. ولما كَانَ الإنسانُ بصفته يحيا في هذا الكونِ هو موضعَ البحثِ، وكان إصدارُ الحكمِ متعلقًا به ومن أجله، فإنه لا بدَّ من الحكم على أفعال الإنسان وعلى الأشياء المتعلّقة بها. فمن الذي له وحدَهُ أنْ يصدرَ الحكمَ على ذلكَ؟ هل هو الله أمِ الإنسانُ نفسه؟ وبعبارةٍ أخرى هل هو الشّرعُ أم العقلُ؟ لأنّ الذي يدلّنا على حكم الله هو الشّرعُ، وعلى حكم الإنسان هو العقلُ، فمن الّذي يحكمُ إذًا؟
أما موضوعُ إصدارِ الحكمِ على الأفعالِ والأشياء فهو الحسنُ والقبحُ، لأنّ المقصودَ من إصدار الحكمِ هو تعيينُ موقفِ الإنسان تجاه الفعلِ، هلْ يفعلُهُ أم يخَيّرُ بينَ تركِهِ وفعلِهِ؟ وتعيين موقفهِ تجاهَ الأشياءِ المتعلقة بها أفعالهُ، هل يأخذُها أم يتركها، أم يخيّرُ بينَ الأخذِ والتركِ؟ وكلُّ هذا متوقفٌ على نظرتِهِ للشيء، هل هو حسنٌ أم قبيحٌ، أم ليس بالحسنِ ولا بالقبيحِ؟ ولهذا كان موضوعُ الحكمِ المطلوب هو الحسنُ والقبحُ، فهل الحكمُ بالحسن والقبح هو للعقلِ أم للشّرع؟ إذْ لا ثالثَ لهما في إصدارِ هذا الحكم.
والجوابُ عن ذلك هو أنّ الحكمَ على الأفعالِ والأشياء إمّا أن يكونَ من ناحيةِ واقعها ما هو؟ وإمّا من ناحية ملاءمتِها لطبع الإنسانِ وميولهِ الفطريةِ أو منافرتها له، وإما من ناحيةِ المدحِ على فعلها والذمِّ على تركِها، أي من ناحية الثّوابِ والعقابِ. فيكونُ حكمُ الإنسان على الأشياء يتمثّل بثلاث جهاتٍ:
1 ـــــــ مِنْ حيثُ واقعها ما هو؟
2 ـــــــ مِنْ حيثُ ملاءمتها لطبعِ الإنسانِ ومنافرتها له.
3 ـــــــ مِنْ حيثُ الثّوابُ والعقابُ أو المدحُ والذم.
فأمّا الحكمُ على الأشياء من ناحيةٍ واقعها ومن جهةِ ملاءمتِها للطّبعِ ومنافرتِها له، فلا شكَّ في أنَّ ذلك كلّهُ إنّما هو للإنسانِ نفسهِ أيْ هو للعقلِ لا للشّرعِ، فالعقلُ هو الّذي يحكمُ على الأفعالِ والأشياء في هاتين الناحيتين. ولا يحكمُ الشّرعُ في أيٍّ منهما، إذ لا دخلَ للشّرع فيهما. وذلك مثل: العلمُ حسنٌ والجهلُ قبيحٌ، فإنّ واقعَهما ظاهرٌ منه الكمال والنّقصُ، ومثل: إنقاذُ الغريقِ حسنٌ وتركهُ يهلكُ قبيحٌ، فإن الطّبعَ يميلُ إلى إسعافِ المشرفِ على الهلاكِ. فهذا وما شاكَلهُ يعودُ إلى طبعِ الإنسانِ وفطرتِهِ وهو يشعرُ به ويدركهُ، ولذلكَ كان إصدار الحكمِ على الأفعالِ والأشياء من هاتين الجهتين هو للإنسان أي إن الحاكم فيهما هو الإنسانُ.
أما الحكمُ على الأفعالِ والأشياء من ناحية المدحِ أو الذمِّ في الدنيا، والثوابِ والعقابِ عليها في الآخرة فلا شَكَّ في أنّهُ لله وحدَهُ وليس للإنسانِ، أي هو للشّرع وليس للعقلِ. وذلك كحسْنِ الإيمان وقبحِ الكفرِ، وحسنِ الطّاعةِ وقبحِ المعصيةِ... وهكذا... والعقلُ هو إحساسٌ وواقعٌ ومعلوماتٌ سابقةٌ ودماغٌ. فالإحساسُ جزءٌ جوهريٌّ من مقوّماتِ العقلِ. فإذا لم يحسّ الإنسانُ بالشّيء لا يمكنُ لعقلهِ أن يصدرَ حكمًا عليه، لأنَّ العقلَ مقيّدٌ حكمهُ على الأشياء بكونِها محسوسة، ويستحيل عليه إصدارُ حكمٍ على غير المحسوسات. فكون الظّلم مما يُمدحُ أو يذمُّ ليس شيئًا محسوسًا أي يخضع لحواس الإنسان. وبذلك فهو لا يمكن أن يُعقل أو لا يمكن إعمالٌ العقل فيه. وبالتالي لا يمكنُ للعقل إصدار حكمٍ عليه، وإن كان الإنسان يشعر بفطرته أن مدحَ الظلم مكروهٌ وأن ذمَّهُ مقبولٌ. وبما أن الشعور وحده لا يكفي، ولا ينفع لكي يصدر العقلُ حكمَهُ على شيء أو فعلٍ، فلا يمكن للعقل إذًا أن يحكم على شيء أو على فعل بالحسن أو القبح، كما لا يمكنه أن يصدر حكمه عليهما بالمدح أو الذم. فهو لا يتأتى له أصلًا إصدار هذا الحكم، بل هو يستحيل عليه ذلك. ومن ناحية أخرى لا يجوزُ أن يترك له إصدارُ هذا الحكم في الوقت الذي يستحيلُ عليه ذلك. ولا يجوزُ أن يجعل إصدارُ الحكمِ بالمدحِ والذمِّ لميولِ الإنسانِ الفطريّةِ لأن هذه الميولَ تصدرُ الحكم بالمدح على ما يوافقها، وبالذّمِّ على ما يخالفها. وقد يكونُ ما يوافقها مما يذمُّ كالزنا واللواط والاسترقاقِ، وقد يكونُ ما يخالفها مما يمْدحُ، كقتالِ الأعداء والصّبرِ على المكارِهِ وقولِ الحقِّ حتى في حالاتِ تحقّق الأذى البالغ.
ولذلك كان جعلُ الحكمِ للميولِ والأهواء خطأ محضًا، لأن الحكم يأتي عندئذٍ مخالفًا للواقعِ، إذ إنّ الحكم بالمدحِ والذمِّ، في هذه الحالة، يأتي بحسبَ الهوى والشهواتِ. ولهذا لا يجوزُ أن يُجعلَ للإنسان إصدارُ الحكم بالمدحِ والذمّ، فالذي يصدرُ حكمَهُ بالمدحِ والذمِّ هو الله سبحانهُ وتعالى وليس الإنسانَ، وذلك من خلال الشرع لا من خلال العقل. ثم إنه لو ترِكَ للإنسانِ أن يحكمَ على الأفعال والأشياء بالمدح والذمِّ لاختلف الحكمُ باختلافِ الأشخاصِ والأزمان. وليس في مقدورِ الإنسانِ أن يحكم عليها حكمًا ثابتًا. إذ من المشاهد المحسوسِ أنَّ الإنسان يحكمُ على أشياء أنها حسنةٌ اليومَ، ثمّ يحكمُ عليها العكس غدًا. وقد يكونُ حكم على أشياء أنها قبيحةٌ، ثمّ يعودُ فيحكمُ عليها نفسها أنها حسنة. وبذلك يختلف الحكمُ على الشّيء الواحدِ ولا يكونُ حكمًا ثابتًا فيحصلُ الخطأ في الحكمِ، لذلك لا يجوزُ أن يُجعلَ للعقلِ أو للإنسانِ الحكمُ بالمدحِ والذمِّ. وعليه فلا بدَّ من أن يكونَ الحاكمُ على أفعالِ العبادِ وعلى الأشياء المتعلّقة بها من حيثُ المدحُ والذمُّ هو الله سبحانَهُ وتعالى وليس الإنسان، أي إن الحكم يكون للشّرعِ وليس للعقلِ...
هذا من حيثُ الدّليلُ العقليّ على الحسنِ والقبحِ. أما من حيثُ الدّليلُ الشرعيُّ فإنِّ الشرعَ التزم التحسين والتقبيح في أي أمرٍ باتّباعِ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذمِّ الهوى. لذلك كان من المقطوعِ به شرعًا أن الحسَن ما حسّنه الشّرعُ والقبيحَ ما قبّحهُ الشّرعُ، من حيثُ الذمُّ والمدحُ. والحكمُ على الأفعال والأشياء بالمدحِ والذمِّ هو لتعيينِ موقفِ الإنسان منها. فالشرع بالنّسبة إلى الأشياء يبيّن هل هي حلالٌ فيُجَوِّزُ له أَخْذَها، أو هي حرام فيجب عليه تركها، ولا يتصورُ غير ذلك من حيثُ الواقع. وبالنّسبةِ إلى أفعالِ الإنسان يبين له هل يطلبُ منه أن يقومَ بها أو يطلبُ منه أن يتركها أو يخيّرُ بين الفعلِ والترك. ولما كان هذا الحكم من هذه الجهة لا يكون غلًّا للشرع لذلك يجب أن تكونَ الأحكامُ العائدة إلى أفعال الإنسانِ، والأحكامُ المتعلقة بالأشياء راجعةً للشّرعِ لا للعقل.
الشريعَة الإسلاميّة
لا تقعُ واقعةٌ ولا تطرأُ مشكلةٌ ولا تحدثُ حادثةٌ إلّا ولكلٍّ منها حكم في الشريعة الإسلامية. فقد أحاطت هذه الشّريعةُ بجميعِ الأشياء إحاطَةً تامّةً شاملةً: لم يقعْ شيءٌ في الماضي ولا يعرضُ شيءٌ في الحاضرِ ولا يحدث شيءٌ في المستقبل إلّا ولكلِّ ذلك حكمٌ في الشّريعة الإسلامية. قالَ الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ} (النحل: 89). وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (المائدة: 3). فالشريعةُ لم تهملْ شيئًا من أفعال العبادِ مهما كان. وهي إمّا أن تنَصِّبَ للشيء أو للفعل دليلًا بنصٍّ من القرآن والحديث، وإمّا أن تضعَ أمارةً في القرآن والحديث تنبّه المكلَّفَ على مقصدها فيه، وعلى الباعث على تشريعه، لأجل أن ينطبق على تلك الأمارة أو هذا الباعث. ولا يمكنُ شرعًا أن يوجد فعلٌ للعبدِ ليس له دليلٌ أو أمارةٌ تدلُّ على حكمِهِ لعمومِ قولِهِ تعالى: {تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْء} وبيانًا للنصِّ الصّريحِ بأنّ الله قد أكملَ هذا الدّين. فإذا زعم أحدٌ أن بعضَ الوقائعِ خاليةٌ من الحكمِ الشّرعيّ فإنّه يعني أن هناك شيئًا لم يبيّنه الكتابُ، وأنَّ هذه الشريعة لم يكملها الله تعالى، بدليل وجودِ فعلٍ لم يذكرْ حكمهُ فهي شرعةٌ ناقصةٌ. هذا الزعمُ معارضٌ لنصِّ القرآن، لذلك يكونُ زعمًا باطلًا حتى لو وُجدتْ أحاديثُ عن الرّسولِ صلى الله عليه وآله وسلم تتضمّنُ هذا المعنى، أي وجودَ بعضِ أفعال العبادِ لم تأتِ الشّريعة بحكمٍ لها، فإنّ مثل هذه الأحاديث تُردُّ دراية لمعارضتِها لنصِّ القرآنِ القطعيّ الثبوتِ والدلالةِ لأنّ آيةَ {تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْء} وآية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} قطعيّةُ الثبوت، قطعيّةُ الدلالةِ. فأيُّ خبر آحادٍ يعارضُها يردُّ درايةً. ولهذا لا يحقّ لمسلمٍ بعد التفقّهِ في هاتين الآيتين القطعيتين أن يقولَ بوجود واقعةٍ واحدةٍ من أفعال الإنسان لم يبيِّن الشّرعُ لها محلَّ حكمٍ ولا بوجه من الوجوه.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢

الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢